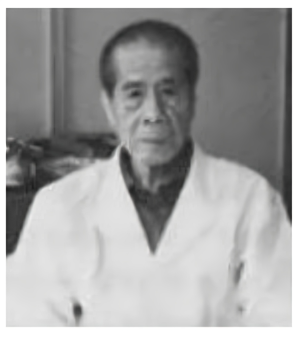في غرفة المداولة، كان الصمت محبوسا كأنه سجينٌ مُدان، لم تكن الجدران وحدها صماء؛ بل حتى الأنفاس التي تكاد تنكسر قبل أن تخرج من صدور الحاضرين، خجِلةً من أن تُسمَع. وكان الأب واقفًا، رأسُه منحنٍّ كغصنٍ تحت ثقل الثلج، عيناه تهربان من كل نظرة، حتى من عيني القاضي، كأن الحقيقة أمامه ليست كلماتٍ تُقال، بل جدارٌ من لهيبٍ يلتف حول جسده الهزيل.[/HEADING]
أقسم اليمين، فارتعشت شفتاه كورقةٍ في مهبّ ريحٍ عاتية. حاول الكلام، فاختنق لسانه بعقدٍ من الندم والخوف، ثم انفجر باكيًا بكاءً مرًّا، كأن سدًّا قديمًا قد انهار فجأةً أمام طوفانٍ من السنين الضائعة.
أمهله القاضي، بصبرٍ لا يخلو من وجعٍ دفين. ثم سأله مجددًا. فرفع الرجل عينين غائمتين بالدموع، لكنه أسرع بإغراقهما في الأرض، وكأن التراب أرحم من النظر إليه. مدّ يده المرتعشة، وأخرج من جيبه أوراقًا مطويّة، كأنها جثثٌ صغيرة تحمل آثار جريمةٍ لا تُغتفر.
كانت محادثات "واتساب"، لكنها لم تكن مجرد كلمات. كانت شهادةً صامتةً تصرخ بصوتٍ أعلى من كل صراخ:
- لا أتزوج عاهرة.
توسّل الأب، صوته يذوب بين الخجل والرجاء:
- وماذا تريد منّا يا ولدي؟
فجاء الردّ كالثلج على الجرح:
- تعود لي كما كانت، ولن أتزوجها.
ولما ألحّ، هدّد ببرودٍ يقطع الأوصال: "إن لم تُرسلها إليّ غدًا، نشرتُ ما بيدي على الملأ."
لم يُفلح التوسل. ففي اليوم التالي، انفجرت الفضيحة كقنبلةٍ رقمية: صورٌ، مقاطعُ، كلماتٌ عارية، فيديوهات للقاءات جنسية، تتدحرج عبر الشاشات كالأفاعي، تلسع هنا، وتلدغ هناك، حتى صارت الفتاة اسما يُهمس به في زوايا الجامعة المرموقة، ويُتناقل في صالونات النادي الراقي كوشاية ساخنةٍ من العار.
سقطت الأم فجأة، كطائرٍ أصابه الرصاص في منتصف طيرانه وخَرَّ الأب صريع ضغطٍ مفاجئ، يُحمل إلى المستشفى، لا بجسده فقط، بل بروحٍ قد تفتّتت إلى شظايا.
أثبت القاضي ما جاء في الأوراق. لم يطلب إعادة شيءٍ مما لا يُعاد. فالكلمات المكتوبة لا تكذب، لكنها لا ترحم أيضًا.
أما الفتاة، فلم تكن سوى ثمرةٍ تساقطت من شجرةٍ مشغولةٍ بالعطاء عن نفسها. ابنة أستاذين جامعيين، يمضيان أيامهما بين قاعات الدرس وصيدلياتٍ تتفرّع كالأوهام، حتى صار لقاؤهما بها حدثًا عابرًا في المصعد، إن حدث. لياليها كانت تُبتلع في صمتٍ عميق، لا يوقظها إلا طَرْق الفجر على بابٍ لم يعد يعرف من يسكن خلفه.
في فراغها، وجدت شابًّا طائشًا مثلها تمامًا، يتيمَ عنايةٍ، والداه بالخارج، ويعيش مع جدّةٍ لا تراه إلا حين يعود آخر الليل، إن عاد. ثلاث سنواتٍ من الحرية الزائفة، يخرجان بلا سؤال، يعودان بلا مساءلة. ثم انزلقت الغريزة، كسيلٍ بلا سدّ، وصارت اللقاءات تُوثّق بكاميراتٍ لا تعرف الرحمة، كأنهما يبنيان سجنًا من الذكريات، لا يعلمان أنه سيُستخدم يومًا كدليل إدانة.
وحين دخلت الجامعة، استيقظت فجأةً، كمن يفيق من حلمٍ طويل. حاولت القطع، لكن الوحش إذا جاع... افترس. فانقلب عليها طوفانٌ أعمى، يجرف آخر ذرّةٍ من سترها.
انفضّت الجلسة. بدأ الحاضرون يغادرون، كأنهم يهربون من ظلّ الحكاية. لكن القاضي استوقف الأب، وسأله بصوتٍ باردٍ، نافذٍ كالسكين:
- أين كنتما أنت وأمّها؟
انحنى الرجل، شفتاه ترتعشان، وعيناه غائرتان في صمتٍ أبدي. ثم همس، كأن الكلمة نفسها تخجل من أن تُقال:
- المشاغل...
ومضى، متعثّر الخطى، تاركًا وراءه صدى الكلمة يتردد في أرجاء القاعة، كأنها حكمٌ أبديّ اختزل كل الحكاية في مفردةٍ واحدة "المشاغل" التي تأكل الأبناء، وتصنع من الحبّ غربةً، ومن البيت سجنًا بلا قضبان.
أقسم اليمين، فارتعشت شفتاه كورقةٍ في مهبّ ريحٍ عاتية. حاول الكلام، فاختنق لسانه بعقدٍ من الندم والخوف، ثم انفجر باكيًا بكاءً مرًّا، كأن سدًّا قديمًا قد انهار فجأةً أمام طوفانٍ من السنين الضائعة.
أمهله القاضي، بصبرٍ لا يخلو من وجعٍ دفين. ثم سأله مجددًا. فرفع الرجل عينين غائمتين بالدموع، لكنه أسرع بإغراقهما في الأرض، وكأن التراب أرحم من النظر إليه. مدّ يده المرتعشة، وأخرج من جيبه أوراقًا مطويّة، كأنها جثثٌ صغيرة تحمل آثار جريمةٍ لا تُغتفر.
كانت محادثات "واتساب"، لكنها لم تكن مجرد كلمات. كانت شهادةً صامتةً تصرخ بصوتٍ أعلى من كل صراخ:
- لا أتزوج عاهرة.
توسّل الأب، صوته يذوب بين الخجل والرجاء:
- وماذا تريد منّا يا ولدي؟
فجاء الردّ كالثلج على الجرح:
- تعود لي كما كانت، ولن أتزوجها.
ولما ألحّ، هدّد ببرودٍ يقطع الأوصال: "إن لم تُرسلها إليّ غدًا، نشرتُ ما بيدي على الملأ."
لم يُفلح التوسل. ففي اليوم التالي، انفجرت الفضيحة كقنبلةٍ رقمية: صورٌ، مقاطعُ، كلماتٌ عارية، فيديوهات للقاءات جنسية، تتدحرج عبر الشاشات كالأفاعي، تلسع هنا، وتلدغ هناك، حتى صارت الفتاة اسما يُهمس به في زوايا الجامعة المرموقة، ويُتناقل في صالونات النادي الراقي كوشاية ساخنةٍ من العار.
سقطت الأم فجأة، كطائرٍ أصابه الرصاص في منتصف طيرانه وخَرَّ الأب صريع ضغطٍ مفاجئ، يُحمل إلى المستشفى، لا بجسده فقط، بل بروحٍ قد تفتّتت إلى شظايا.
أثبت القاضي ما جاء في الأوراق. لم يطلب إعادة شيءٍ مما لا يُعاد. فالكلمات المكتوبة لا تكذب، لكنها لا ترحم أيضًا.
أما الفتاة، فلم تكن سوى ثمرةٍ تساقطت من شجرةٍ مشغولةٍ بالعطاء عن نفسها. ابنة أستاذين جامعيين، يمضيان أيامهما بين قاعات الدرس وصيدلياتٍ تتفرّع كالأوهام، حتى صار لقاؤهما بها حدثًا عابرًا في المصعد، إن حدث. لياليها كانت تُبتلع في صمتٍ عميق، لا يوقظها إلا طَرْق الفجر على بابٍ لم يعد يعرف من يسكن خلفه.
في فراغها، وجدت شابًّا طائشًا مثلها تمامًا، يتيمَ عنايةٍ، والداه بالخارج، ويعيش مع جدّةٍ لا تراه إلا حين يعود آخر الليل، إن عاد. ثلاث سنواتٍ من الحرية الزائفة، يخرجان بلا سؤال، يعودان بلا مساءلة. ثم انزلقت الغريزة، كسيلٍ بلا سدّ، وصارت اللقاءات تُوثّق بكاميراتٍ لا تعرف الرحمة، كأنهما يبنيان سجنًا من الذكريات، لا يعلمان أنه سيُستخدم يومًا كدليل إدانة.
وحين دخلت الجامعة، استيقظت فجأةً، كمن يفيق من حلمٍ طويل. حاولت القطع، لكن الوحش إذا جاع... افترس. فانقلب عليها طوفانٌ أعمى، يجرف آخر ذرّةٍ من سترها.
انفضّت الجلسة. بدأ الحاضرون يغادرون، كأنهم يهربون من ظلّ الحكاية. لكن القاضي استوقف الأب، وسأله بصوتٍ باردٍ، نافذٍ كالسكين:
- أين كنتما أنت وأمّها؟
انحنى الرجل، شفتاه ترتعشان، وعيناه غائرتان في صمتٍ أبدي. ثم همس، كأن الكلمة نفسها تخجل من أن تُقال:
- المشاغل...
ومضى، متعثّر الخطى، تاركًا وراءه صدى الكلمة يتردد في أرجاء القاعة، كأنها حكمٌ أبديّ اختزل كل الحكاية في مفردةٍ واحدة "المشاغل" التي تأكل الأبناء، وتصنع من الحبّ غربةً، ومن البيت سجنًا بلا قضبان.