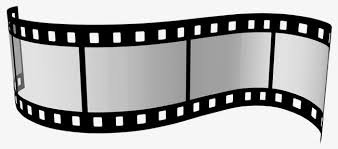مرحبا.. وأصل هذه «المرحبا» من اللغة الآرامية «مار- حبا» أي «الله محبة»، ويمكنني القول «الله سلام» أو السلام عليكم، فالسلام ضروريٌ كما كانت توصيني جدتي «آمون» -وآمون هو إله القمر عند المصريين القدماء- وتحكي لي حكاية الشاطر حسن: حين قام بإحدى مغامراته، التقى فجأة بغولٍ مرعب، قال له خائفاً:
السلام عليك، فجاءه رد الغول المفاجئ: «لولا سلامك ما سبق كلامك كنت أكلتك وفصفصت عضامك»… هكذا تشكّلت مخيلتي، واحتضنتُ بشغف حتى اليوم حكاياتٍ ورثتُها عن جدتي، وورثتْها هي عن رواةٍ كانوا يخبرونها بأعاجيبَ وأحداثِ بلدانٍ لم تزرها، ولم أزرها أنا أيضاً، لكننا رأيناها في مخيلتنا أشهى وأكثر غرائبية وجمالاً.
تتقاطع الحكايات في العالم لدرجة تجعلنا نعتقد أحياناً أن كاتبها هو شخص واحد، لكنه يختبئ كشخوص حكاياته مرة على هيئة صيّاد عجوز، ومرة على شكل نمرٍ يتحدث لغة البشر، ومرات على هيئة شجرة أو طائر نادر.. راوٍ واحد يختزن تجاربَ أناس بسطاء حكوا معاناتهم ووجع سنين من الحرمان والتعب، وتوارثوها مع أبنائهم وأحفادهم، لتتم الإضافة عليها لاحقاً بحسب أهل ذاك الزمان وطبيعة تلك الأمكنة، تماماً كحكايات «ألف ليلة وليلة» التي لم يُعرف من هو كاتبها الحقيقي، ورجّحت الدراسات -بحسب الكاتب العظيم خورخي لويس بورخس- أنها شاعت بدايةً في الهند، ثم بلاد فارس، ثم جُمِع بعضُها في القرن الخامس عشر في الإسكندرية، مدينة الإسكندر المقدوني الذي يسمّى «ذي القرنين» لأنه حكم قرني الشرق والغرب معاً، واكتملَ جمْعُها في القاهرة لتصبح كما نعرفها اليوم بـ «ألف ليلة وليلة»، وقيل إنها حُوِّرت وأضيف إليها بحسب ذوق الرواة، ورغبة الولاة، وحاجة الرعاة، وإنها تعرّضت لأكبر عملية حجب وحذف لقصص وأشعار جنسية، كانت تعكس روح تلك الأزمنة، بحجّة أنها «غير مهذبّة» وغير لائقة.
ربما ليس مهماً في عالم الحكايات معرفة من هو صانُعها أو مؤلفها الحقيقي، لكن ما لفتَ نظري واهتمامي هو أن الراوي في «ألف ليلة وليلة» امرأةٌ/ شهرزاد الشهيرة، في حين إن الراوي في كتاب «مدن الخيال» للإيطالي إيتالو كالفينو «ترجمة الدكتور محمود موعد» هو الرحالة المعروف ماركو بولو الذي يعدّ كتاب رحلاته على «طريق الحرير» مصدر انكشافٍ للغرب على الشرق العظيم، كذلك هناك عدّة رواة في الكتاب الضخم «الديكاميرون» الجامع لقصص من التراث الإيطالي(ترجمة صالح علماني) إذ إن تعدد الرواة هنا يذكّر بمن كانوا يسمَّون «رجال الليل» المجهولين الذين قرؤوا للإسكندر المقدوني قصصاً ساحرة للتخفيف من أرقه.
ما يهمّني حقيقة هو: هل هناك فرقٌ جوهريٌّ بين الراوي الأنثى والراوي الذكر؟ هل تختلف فكرة الروي ذاتها بين تلك العلاقة التي جمعت شهريار بشهرزاد، والعلاقة التي جمعت السلطان قبلاي خان بماركو بولو؟. نكتشف أن لا وجود -على ما بدا- لصداقة بين ملكٍ يستمع ويستمتع بحديث شهرزاد، حيث تنجدل الرغبات مع الحكايات لتصبح واقعاً يغوصان فيه بقدرة السِّحْر في عالمٍ تصبح فيه الأنثى هي المسيطرة، هي التي تسحب السلطة من السلطان، أو المُلْكَ من المَلِك، لكننا نجد أيضاً أن الصداقة التي تطورت بين ماركو بولو وقبلاي خان تتحول إلى منافسة مضمرة، وغيرة خفيّة، بل إلى بوحٍ حقيقي تمّحي فيه، هنا أيضاً، حدود السلطان، ليصبحا معاً تحت الشرط الوجودي نفسه؛ مسرنَمين يمشيان على أرض الحكايات، هائمين لا يريدان أكثر مما يعلق على أجفانهما من وهم كنوزٍ وحضارات زائلة، إذ «ليس صحيحاً أن قبلاي خان كان يصدّق كل ما يرويه ماركو بولو، وهو يصف له المدنَ التي زارها، لكن إمبراطور التتار على أي حال، واصل الإصغاء إلى الشاب الفينيسيّ بفضول واهتمام أكبر مما أصغى إلى أيٍّ من رسله وموفديه» الذين أرسلهم إلى أراضي إمبراطوريته الشاسعة!
تصديق الوهم، بل التمتع به.. هكذا في لحظة يأس مطبِقة يكتشف الأباطرة أنهم وُرِّثوا الانهيار البطيء لأولئك الملوك الذين انتصروا عليهم، لتأتي «الحكايات» فتنقذهم (أنقول لتنقذ الإنسان عموماً؟) من الموت يأساً، لهذا كان قبلاي خان يستطيع أن يدرك في حكايات ماركو و«عبر الأسوار والأبراج الآيلة للسقوط خيوطَ رسْمٍ دقيقٍ بما يكفي لينجو من عضّاتِ دويبة الخشب»، والمقصود في اعتقادي هو أن ينجو من عضّات اليأس القاتلة!
وذاك التصديق الواهم للحكايات هو ما يسوق لنا مقاطعَ حوارية مذهلة بين الخان وماركو، في رحلة اكتشاف ليس فقط للمدن الخيالية الساحرة التي يصفها ماركو على شكل أعاجيب، إنما رحلة انكشافٍ نفسيٍّ داخليّ يتبادلان فيها المواقع إذ يتحول الخان إلى شخصٍ عادي يتساءل عن «كيف ستكون علاقته بمستقبله إن كان كل ما يقوله ماركو ليس إلا أفكاراً في ذهنٍ لفّته رطوبة المساء!»، كما يتحول ماركو بولو إلى صوت الخان العميق الذي يتصادى في حكاياته، ففي الحقيقة كانا «يظلان صامتين، عيونهما نصف مغمضة، وهما يستلقيان متكئين على الوسائد، يتأرجحان في سريريهما المعلّقين، يدخنان غليونيهما الكهرمانيين، وكان ماركو بولو يتخيل بأنه يجيب، أو يتخيل قبلاي خان هذا الجواب(..) وفي هذه اللحظة كان الخان يقاطعه في الكلام، أو يتخيّل أنه يقاطعه، أو أن ماركو يتخيّل أنه قوطِعَ بسؤال من نوع: هل ما تراه هو وراءَك دائماً؟، أو هل تجري رحلتك في الماضي فحسب؟، فيجيب ماركو بولو: عندما يصل المسافر إلى مدينة جديدة فإنه يلتقي جزءاً من ماضيه، الغرابة في أنّ ما لم تعدْ تكونه، أو ما لم تعد تمتلكه، ينتظرك لدى مرورك في أمكنة غريبة لم تمتلكها بعد».. وهكذا، كأنهما في لعبة مرايا متقابلة، في متاهة لا يعرفان فيها بالضبط هل الخان هو ماضي ماركو بولو بشكلٍ ما، أم إن الأخير هو مستقبَّلُ الخان الذي لم يأتِ بعد؟!.
لتُقفَل دائرة الروي عن المدن والرغبات، المدن والأسماء، المدن والأموات، المدن المستمرة، والمدن المخفية بكلام يائس من الخان: «كل شيء بلا جدوى، إذا لم يكن الوصول الأخير سوى الرسوّ في مدينة الجحيم، إذا كان التيار يشدُّنا إلى الأعماق في طريق لولبي يضيق شيئاً فشيئاً نحو النهاية»، فيجيبه ماركو بولو بمسحةٍ من تفاؤلٍ حذر: جحيم الأحياء ليس قادماً من المستقبل، إذا كان ثمَّ جحيم فهو هنا، الجحيم الذي نصنعه لأنفسنا مجتمعين، وهناك طريقتان لتجنب آلامه، الأولى ينجح فيها معظم الناس وهي أن تقبل الجحيم وتصبح جزءاً منه إلى درجة ألا تراه، والثانية تتطلب حذراً وتعلُّماً مستمرين؛ أن تبحث في قلب الجحيم عمّن وعمّا هو ليس جحيماً وتحْسن معرفته، وتعمل على استمراره وإفساح المكان له».
إن عالم السحر والغرابة والتشويق والنهايات السعيدة المنتظرة وتلك الحزينة المؤلمة، هو شبكة الحرير التي يعلق فيها الأطفال وهم يصغون للحكايات، وينجذبون إليها كبرادة حديد تلتصق بمغناطيس، لكن الكبار أيضاً يتحولون إلى صغار حين تُحكى لهم حكاية، فيمتصّونها ويستدمجونها في كيانهم، ويغفون على إيقاع تنفّس الكون فيها.
السلام عليك، فجاءه رد الغول المفاجئ: «لولا سلامك ما سبق كلامك كنت أكلتك وفصفصت عضامك»… هكذا تشكّلت مخيلتي، واحتضنتُ بشغف حتى اليوم حكاياتٍ ورثتُها عن جدتي، وورثتْها هي عن رواةٍ كانوا يخبرونها بأعاجيبَ وأحداثِ بلدانٍ لم تزرها، ولم أزرها أنا أيضاً، لكننا رأيناها في مخيلتنا أشهى وأكثر غرائبية وجمالاً.
تتقاطع الحكايات في العالم لدرجة تجعلنا نعتقد أحياناً أن كاتبها هو شخص واحد، لكنه يختبئ كشخوص حكاياته مرة على هيئة صيّاد عجوز، ومرة على شكل نمرٍ يتحدث لغة البشر، ومرات على هيئة شجرة أو طائر نادر.. راوٍ واحد يختزن تجاربَ أناس بسطاء حكوا معاناتهم ووجع سنين من الحرمان والتعب، وتوارثوها مع أبنائهم وأحفادهم، لتتم الإضافة عليها لاحقاً بحسب أهل ذاك الزمان وطبيعة تلك الأمكنة، تماماً كحكايات «ألف ليلة وليلة» التي لم يُعرف من هو كاتبها الحقيقي، ورجّحت الدراسات -بحسب الكاتب العظيم خورخي لويس بورخس- أنها شاعت بدايةً في الهند، ثم بلاد فارس، ثم جُمِع بعضُها في القرن الخامس عشر في الإسكندرية، مدينة الإسكندر المقدوني الذي يسمّى «ذي القرنين» لأنه حكم قرني الشرق والغرب معاً، واكتملَ جمْعُها في القاهرة لتصبح كما نعرفها اليوم بـ «ألف ليلة وليلة»، وقيل إنها حُوِّرت وأضيف إليها بحسب ذوق الرواة، ورغبة الولاة، وحاجة الرعاة، وإنها تعرّضت لأكبر عملية حجب وحذف لقصص وأشعار جنسية، كانت تعكس روح تلك الأزمنة، بحجّة أنها «غير مهذبّة» وغير لائقة.
ربما ليس مهماً في عالم الحكايات معرفة من هو صانُعها أو مؤلفها الحقيقي، لكن ما لفتَ نظري واهتمامي هو أن الراوي في «ألف ليلة وليلة» امرأةٌ/ شهرزاد الشهيرة، في حين إن الراوي في كتاب «مدن الخيال» للإيطالي إيتالو كالفينو «ترجمة الدكتور محمود موعد» هو الرحالة المعروف ماركو بولو الذي يعدّ كتاب رحلاته على «طريق الحرير» مصدر انكشافٍ للغرب على الشرق العظيم، كذلك هناك عدّة رواة في الكتاب الضخم «الديكاميرون» الجامع لقصص من التراث الإيطالي(ترجمة صالح علماني) إذ إن تعدد الرواة هنا يذكّر بمن كانوا يسمَّون «رجال الليل» المجهولين الذين قرؤوا للإسكندر المقدوني قصصاً ساحرة للتخفيف من أرقه.
ما يهمّني حقيقة هو: هل هناك فرقٌ جوهريٌّ بين الراوي الأنثى والراوي الذكر؟ هل تختلف فكرة الروي ذاتها بين تلك العلاقة التي جمعت شهريار بشهرزاد، والعلاقة التي جمعت السلطان قبلاي خان بماركو بولو؟. نكتشف أن لا وجود -على ما بدا- لصداقة بين ملكٍ يستمع ويستمتع بحديث شهرزاد، حيث تنجدل الرغبات مع الحكايات لتصبح واقعاً يغوصان فيه بقدرة السِّحْر في عالمٍ تصبح فيه الأنثى هي المسيطرة، هي التي تسحب السلطة من السلطان، أو المُلْكَ من المَلِك، لكننا نجد أيضاً أن الصداقة التي تطورت بين ماركو بولو وقبلاي خان تتحول إلى منافسة مضمرة، وغيرة خفيّة، بل إلى بوحٍ حقيقي تمّحي فيه، هنا أيضاً، حدود السلطان، ليصبحا معاً تحت الشرط الوجودي نفسه؛ مسرنَمين يمشيان على أرض الحكايات، هائمين لا يريدان أكثر مما يعلق على أجفانهما من وهم كنوزٍ وحضارات زائلة، إذ «ليس صحيحاً أن قبلاي خان كان يصدّق كل ما يرويه ماركو بولو، وهو يصف له المدنَ التي زارها، لكن إمبراطور التتار على أي حال، واصل الإصغاء إلى الشاب الفينيسيّ بفضول واهتمام أكبر مما أصغى إلى أيٍّ من رسله وموفديه» الذين أرسلهم إلى أراضي إمبراطوريته الشاسعة!
تصديق الوهم، بل التمتع به.. هكذا في لحظة يأس مطبِقة يكتشف الأباطرة أنهم وُرِّثوا الانهيار البطيء لأولئك الملوك الذين انتصروا عليهم، لتأتي «الحكايات» فتنقذهم (أنقول لتنقذ الإنسان عموماً؟) من الموت يأساً، لهذا كان قبلاي خان يستطيع أن يدرك في حكايات ماركو و«عبر الأسوار والأبراج الآيلة للسقوط خيوطَ رسْمٍ دقيقٍ بما يكفي لينجو من عضّاتِ دويبة الخشب»، والمقصود في اعتقادي هو أن ينجو من عضّات اليأس القاتلة!
وذاك التصديق الواهم للحكايات هو ما يسوق لنا مقاطعَ حوارية مذهلة بين الخان وماركو، في رحلة اكتشاف ليس فقط للمدن الخيالية الساحرة التي يصفها ماركو على شكل أعاجيب، إنما رحلة انكشافٍ نفسيٍّ داخليّ يتبادلان فيها المواقع إذ يتحول الخان إلى شخصٍ عادي يتساءل عن «كيف ستكون علاقته بمستقبله إن كان كل ما يقوله ماركو ليس إلا أفكاراً في ذهنٍ لفّته رطوبة المساء!»، كما يتحول ماركو بولو إلى صوت الخان العميق الذي يتصادى في حكاياته، ففي الحقيقة كانا «يظلان صامتين، عيونهما نصف مغمضة، وهما يستلقيان متكئين على الوسائد، يتأرجحان في سريريهما المعلّقين، يدخنان غليونيهما الكهرمانيين، وكان ماركو بولو يتخيل بأنه يجيب، أو يتخيل قبلاي خان هذا الجواب(..) وفي هذه اللحظة كان الخان يقاطعه في الكلام، أو يتخيّل أنه يقاطعه، أو أن ماركو يتخيّل أنه قوطِعَ بسؤال من نوع: هل ما تراه هو وراءَك دائماً؟، أو هل تجري رحلتك في الماضي فحسب؟، فيجيب ماركو بولو: عندما يصل المسافر إلى مدينة جديدة فإنه يلتقي جزءاً من ماضيه، الغرابة في أنّ ما لم تعدْ تكونه، أو ما لم تعد تمتلكه، ينتظرك لدى مرورك في أمكنة غريبة لم تمتلكها بعد».. وهكذا، كأنهما في لعبة مرايا متقابلة، في متاهة لا يعرفان فيها بالضبط هل الخان هو ماضي ماركو بولو بشكلٍ ما، أم إن الأخير هو مستقبَّلُ الخان الذي لم يأتِ بعد؟!.
لتُقفَل دائرة الروي عن المدن والرغبات، المدن والأسماء، المدن والأموات، المدن المستمرة، والمدن المخفية بكلام يائس من الخان: «كل شيء بلا جدوى، إذا لم يكن الوصول الأخير سوى الرسوّ في مدينة الجحيم، إذا كان التيار يشدُّنا إلى الأعماق في طريق لولبي يضيق شيئاً فشيئاً نحو النهاية»، فيجيبه ماركو بولو بمسحةٍ من تفاؤلٍ حذر: جحيم الأحياء ليس قادماً من المستقبل، إذا كان ثمَّ جحيم فهو هنا، الجحيم الذي نصنعه لأنفسنا مجتمعين، وهناك طريقتان لتجنب آلامه، الأولى ينجح فيها معظم الناس وهي أن تقبل الجحيم وتصبح جزءاً منه إلى درجة ألا تراه، والثانية تتطلب حذراً وتعلُّماً مستمرين؛ أن تبحث في قلب الجحيم عمّن وعمّا هو ليس جحيماً وتحْسن معرفته، وتعمل على استمراره وإفساح المكان له».
إن عالم السحر والغرابة والتشويق والنهايات السعيدة المنتظرة وتلك الحزينة المؤلمة، هو شبكة الحرير التي يعلق فيها الأطفال وهم يصغون للحكايات، وينجذبون إليها كبرادة حديد تلتصق بمغناطيس، لكن الكبار أيضاً يتحولون إلى صغار حين تُحكى لهم حكاية، فيمتصّونها ويستدمجونها في كيانهم، ويغفون على إيقاع تنفّس الكون فيها.