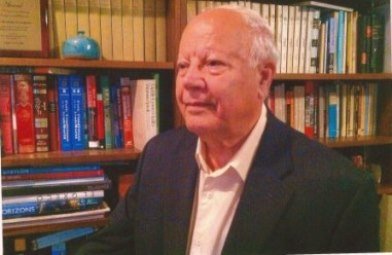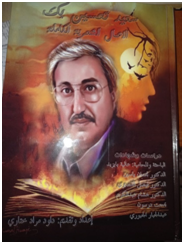-1-
إن من أبرز القضايا الفكرية التي يواجهها العالم العربي مشكلة وجود لغة تستعمل في الحياة اليومية (وهي العامية) إلى جانب اللغة الفصيحة التي تختلف اختلافاً واضحاً في تركيبها ونظامها اللغويين، وفي وظائفها ومجالات استعمالها. فاللغة الفصيحة، من حيث الوظيفة، تستعمل كلغة للإيصال المحدود أو المقيد، أي أنها لغة المطبوعات، بصورة عامة، ولغة المحاضرات، ولغة المناسبات الرسمية، وهي تكاد تكون متجانسة أو واحدة في العالم العربي، أي أنها لا تتقيد بالحدود الإقليمية القائمة فيه، وهي إلى جانب ذلك كله تتمتع بمنزلة دينية، وسياسية وأدبية، أما اللهجة أو العامية فإنها من حيث الوظيفة، لغة الحياة اليومية، اللغة الطبيعية للفرد في كل قطر عربي، وغالباً ما تستعمل في الكلام وإن كانت تكتب أحياناً.. والعامية – بخلاف العربية الفصيحة – ليست متجانسة بل تتغير من منطقة إلى أخرى داخل كل قطر عربي، أو من قطر إلى آخر، وتفتقر – بحكم الظروف التي مرت بها- إلى المنزلة الأدبية أو السياسية أو الدينية التي تمتاز بها الفصحى.
وإذا قارنا بينهما من الناحية التركيبية فمن الممكن حصر الفروق البارزة في قولنا بأن الفصحى تختلف عن العامية بنظامها الصوتي ونظامها الإعرابي المعقد، وبوجود ظاهرة التثنية في الأفعال والأسماء بخلاف التثنية في العامية التي لم تعد تلاحظ في الأفعال والضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، كما تتميز العامية بالميل إلى التخلص من كثير من الأدوات والحروف التي تسبق الأسماء أو الأفعال في الفصحى وتسبب في معظم الحالات تغييراً في وضعها الإعرابي.
وليست هذه القضية بظاهرة جديدة، بل لها جذور عميقة في تاريخنا تمتد إلى العصر الجاهلي في رأي عدد من الكتاب، غير أن ظهورها كمشكلة في تاريخنا الحديث يمكن أن يحدد بأواخر القرن التاسع عشر حين بدأ الاستعمار الغربي محاولته الفاشلة في الدعوة إلى التخلي عن اللغة العربية الفصيحة، واتخاذ العامية وسيلة للتعبير والتعلم في مجالي الحياة العلمية والثقافية، وكان في طليعة أصحاب هذه الدعوة السير وليام ولكوكس الذي ألقى خطبة في نادي الأزبكية (في القاهرة سنة 1893) بعنوان “لمَ لمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين؟” أشار فيها إلى أن العامل الأول في فقد قوة الاختراع لدى المصريين استخدامهم اللغة العربية الفصيحة في القراءة والكتابة، وقد حثهم على الالتزام بالعامية أداة للتعبير الأدبي اقتداءً بالأمم الأخرى، واستشهد بشعبه قائلاً عنه بأنه أفاد فائدة كبيرة منذ هجر اللاتينية التي كانت يوماً لغة الكتابة والعلم(1).
وظلت القضية منذ ذلك اليوم موضع جدل و نقاش بين الكتاب و المفكرين العرب وغير العرب، بين فريق يؤيد التمسك بالعربية الفصيحة، والدعوة إلى القضاء على العامية، وآخر يدعو إلى تفضيل العامية على الفصحى كلغة الحياة اليومية والثقافية وفريق ثالث يحاول أن يقف موقفاً وسطاً في دعوته إلى الالتزام بالفصيحة والإفادة من العامية ـ في الوقت نفسه ـ كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ومن الواضح أن هذه المشكلة الناجمة عن الثنائية في التعبير ليست لغوية فحسب، بل هي مشكلة عامةلها آثارها في حقول ثقافية مختلفة كالتعليم وعلم النفس والأدب، كما لها صلتها الوثيقة بعوامل سياسية ودينية لا مجال لذكرها في هذا المقام. أما آثار المشكلة في الأدب ـ و هي موضوع مقالناـ فمن المستطاع أن نوضح بعد النظر في ما يبديه بعض الكتاب من رأي حول مدى ضرورة استعمال ” العامية ” أو اللهجة في العمل الأدبي، كالقصة والرواية والمسرحية والشعر جنباً إلى جنب مع اللغة الفصيحة. ولابد أن نشير هنا إلى أن مسألة استعمال العامية في العمل الأدبي تختلف عن موضوع الأدب الشعبي ” الفولكلور Folklor ” ووجوب تشجيعه إذ أننا لا نواجه في الأدب الشعبي أية مشكلة تتصل بالثنائية في التعبير لأن وسيلته التعبيرية الوحيدة في معظم الأحوال هي العامية، ولا تلعب اللغة الفصيحة فيه دوراً كبيراً .. غير أن الأمر يختلف بالنسبة إلى الفنون الأدبية الأخرى كالقصة والمسرحية والشعر والمقالة إذ أن هذه الفنون اعتادت، إلا في حالات نادرة، أن تعتمد على اللغة الفصحى اعتماداً يكاد يكون كلياً وفقاً للتقليد الذي التزم به الأديب العربي، ومسألة اشتراك العامية مع الفصحى في العمل الأدبي مسألة حديثة، و هي مرتبطة بظهور المسرحية والقصة والرواية ـ بمعناهما الفني ـ في أدبنا الحديث، و يحسن بنا أن نتبين طبيعة المشكلة في ضوء ما يراه أنصار استعمال العامية في بعض الفنون الأدبية وما يراه معارضوه ..
ـ 2 ـ
لقد استمعنا قبل أكثر من أربعين سنة، الكاتب اللبناني الشهير ميخائيل نعيمة يحدثنا عن العقبات التي صادفها في تأليف مسرحيته “الآباء و البنون” وفي مقدمتها اللغة العامية، والمقام الذي يجب أن تعطى في مثل هذه المسرحية(2)، قائلاً بأن أشخاص الرواية يجب أن يخاطبونا باللغة التي تعودوا التعبير بها عن عواطفهم وأفكارهم وأغراضهم، وأن الكاتب الذي يحاول أن يجعل فلاحاً أمياً يتكلم بلغة الدواوين الشعرية والمؤلفات اللغوية، أي بأسلوب لغوي لا يلائم مستواه، يظلم فلاحه ونفسه وقارئه وسامعه بل يظهر أشخاصه في مظهر الهزل حيث لا يقصد الهزل ويقترف جرماً ضد فن جماله في تصوير الإنسان حسبما نراه في مشاهد الحياة الحقيقية(3).
ومن الواضح أن المسرحية ـ بصورة خاصةـ والرواية أو القصة (في كثير من الأحيان) تعتمد على الحوار في نقل التجربة أو الأفكار أو العواطف التي يدور حولها العمل الأدبي، والصدق الفني وما يسمى بمبدأ “مشاكلة الواقع” يتطلب أن يكون الحوار على ألسنة أشخاص الرواية أو المسرحية ملائماً لثقافتهم ومستواهم وتفكيرهم ومن أهم أسباب تحقيق هذه “المشاكلة” الأسلوب أو اللغة التي يستعملها أشخاص القصة أو المسرحية ولهذا نرى أن كثيراً من كتاب القصة والرواية في العالم كمارك توين وهمنغواي وفوكنر يلجأون، في تصوير أشخاصهم وفي أعمالهم، إلى اللهجة التي يستعملها عملياً أشخاص الرواية أو القصة في حياتهم اليومية بالرغم من أنها تختلف عن اللغة الأدبية التي يعتمدها الكتاب أنفسهم عندما يصفون الأحداث أو يروونها حتى أن “همنغواي” تطرق في إحدى رواياته “تلال أفريقيا الخضراء” إلى موضوع استعمال اللهجة في القصة، وموقف بعض كبار الكتاب الأمريكيين منه، فأشار إلى أنهم لم يكونوا يستعملون الكلمات التي يستعملها الناس دائما في حياتهم، تلك الكلمات التي تبقى حية في اللغة(4).
ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الأمريكي الشهير “مارك توين” يعتبر في مقدمة الكتاب المعاصرين الذين اتخذوا من “اللهجة” وسيلة ناجحة لتحديد شخصية أبطال القصة أو الرواية، مستهدفين نقل الواقع وتصوير الحقيقة من غير تكلف أو التواء(5)، كما اعتبر أشهر كتاب القرن التاسع عشر من حيث إيثاره العبارة العامية على الأسلوب الأدبي(6).
فالدعوة إلى استعمال “اللهجة”، إذن، ليست مقصورة على الأدب العربي بل لها مجالها في الآداب الأخرى حيث لا تختلف اللهجة فيها اختلافاً كبيراً عن اللغة الأدبية كما هي الحال عندنا بالنسبة إلى الاختلاف القائم بين العامية واللغة الفصيحة.
ومما يدعم هذه الدعوة أن العامية، كأية لغة أخرى، تحمل في طياتها ثقافة المتحدثين بها، وفيها من وسائل التعبير والمفردات ما يوحي بأفكار أو مشاعر أو صور معينة، وليس من العمل الفني الناجح ألا تستغل هذه “الطاقة” التعبيرية الكامنة فيها، وقد كان ميخائيل نعيمة على حق في قوله بأن اللغة العامية تستر تحت ثوبها الخشن كثيراً من فلسفة الشعب واختباراته في الحياة وأمثاله واعتقاداته، وأن من يحاول أن يؤديها بلغة فصيحة يكون كمن يترجم أشعاراً وأمثالاً عن لغة أعجمية.
ولاحظ “نعيمة” أن المسرحية (أو الرواية التمثيلية كما أسماها) لا تستطيع الاستغناء عن العامية، غير أنه وجد ـ في الوقت نفسه ـ أننا لو تابعنا هذه القاعدة لوجب أن نكتب كل رواياتنا باللغة العامية، وذلك يعني ـ في رأيه ـ انقراض لغتنا الفصحى، وقد رأى بعد تفكير طويل، أن يجعل المتعلمين من أشخاص مسرحيته (الآباء والبنون) يتكلمون الفصحى والأميين يتكلمون اللغة العامية.
ويعنى الكتاب المعاصرون في البلاد العربية، وفي الأقطار الأخرى، عناية خاصة بمبدأ “مشاكلة الواقع” في الأدب القصصي أو المسرحي، ويحاولون جهدهم تجنب فرض أسلوبهم الخاص على أشخاص قصصهم أو مسرحياتهم، ويوضح هذا الاتجاه ما جاء في مقدمة المؤلف الفرنسي “بومارشيه” لروايته “فيغارو” حين أجاب عن سؤال حول سر احتواء روايته على جمل مهلهلة ليست من أسلوبه قائلا :
“من أسلوبي يا سيدي ؟ لو شاء النحس أن يكون لي أسلوب لحاولت أن أنساه عندما أكتب مسرحية، وأنا لا أعرف أتفه طعماً من تلك المسرحيات التي نرى كل شيء فيها جميلاً وردياً، كل شيء هو المؤلف نفسه كيفما كان “ثم يستمر قائلاً”:
عندما يتملكني موضوعي استدعي شخصياتي وأضع كلاً في محله، و أنا لا أعرف ماذا سيقولون وإنما سيعنيني ما سيفعلون وعندما يأخذون في الحركة أكتب ما يملونه علي إملاءً سريعاً، واثقاً من أنهم لن يخدعوني، فلنأخذ إذن في فحص أفكارهم لا في البحث عما إذا كان من واجبي أن أعيرهم أسلوبي”(7).
ويتبلور التأكيد على استعمال لغة البطل واضحاً في ما كتبه حسين مروة عن الموضوع(8)، وما دعا إليه حين عبر عن إيمانه بأن ليس هنالك شيء يفسد العمل الفني الروائي مثل أن يجئ الحوار بلغة غير لغة البطل، كلغة المؤلف مثلاً، على أساس أن لغة البطل في الحوار هي قوام عنصر الشخصية الإنسانية، قوام شخصيته، ويعني هذا أن نحس، كما يقول مروة، وجود البطل في لغته ولهجته خلال الحوار ..
وهنالك أمر ثالث يخص علاقة لغة المسرحية بالمشاهدين يتخذه الكتاب مبرراً لاستعمال العامية، إذ أن الكاتب المسرحي يدرك بأن المسرحية توضع للمسرح أو الشاشة و إنه يخاطب المشاهدين من خلال المسرحية بمختلف طبقاتهم و مستوياتهم، مما يستلزم اختيار أسلوب لغوي يضمن تفهمهم السريع وتتبعهم لما يقال، من غير تردد أو تأن، إذ أن صعوبة اللغة المستعملة أو صعوبة بعض فقراتها أو جملها تؤدي إلى تأخر المشاهد [أو المستمع، إن كانت المسرحية تذاع]، عن متابعة أحداث المسرحية، أو إلى سوء فهمه لها، كما تسبب ضياع الأثر الفني، أو ضعفا فيه.
* * *
وهكذا نلاحظ أن مسألة استعمال العامية في الأدب القصصي أو المسرحي مرتبطة بثلاثة أمور متلازمة : الصدق الفني، واستغلال اللغة في نقل الأفكار و المشاعر أو تصوير الشخصية في المسرحية والقصة، وعلاقة لغة المسرحية بالمشاهدين، وقد ظلت هذه الأمور – ولا تزال- تشغل بال الكاتب القصصي أو المسرحي في العراق وغير العراق من الأقطار العربية، فنجد مثلاً “عبد الملك نوري” يؤكد أن “اللغة عنصر مهم من حياة الشخص ووجوده الواقعي فإذا جرده الكاتب منها أتلف جزءاً كثيراً من حيويته وواقعيته”(9)، ويحاول أن يطبق هذا المبدأ الفني في إنتاجه القصصي، كما نجد توفيق الحكيم يقوم بمحاولات متعددة لمعالجة قضية الفصحى والعامية في مسرحياته تارة باستعمال الفصحى المبسطة، أو العامية المرتفعة، وأخيراً هذه اللغة التي استعملها في مسرحيته “الصفقة” وهي لغة تجمع بين الطريقتين دون أن تجافي ـ كما يقول الحكيم نفسه ـ قواعد الفصحى، وهي في الوقت نفسه ـ مما يمكن أن ينطقه الأشخاص ولا ينافي طبائعهم أو جو حياتهم ـ وقد قال عنها الحكيم بأنها لغة سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل إقليم ويمكن أن تجري على الألسنة، وقد يبدو لقارئها [أي المسرحية] أنها مكتوبة بالعامية، ولكنها إذا أعاد قراءتها طبقاً لقواعد الفصحى ¬فإنه يجدها منطبقة عليها على قدر الإمكان(10).
وبالرغم من قول محمود تيمور بأن التعبير في الفصحى في طليعة ما يجب أن يلتزمه الأديب، فإنه يدافع عن مبدأ استعمال اللهجة في المسرحية، و يذهب إلى أن مخاطبة الجمهور على تباين طبقاته تحتم على الكاتب المسرحي أن يطرق الآذان بما ألفت من لغة، ويرى أن الفصحى “لغة الكتابة لا لغة الحديث، وترجمان الثقافة الخاصة لا ثقافة الشعب وأنها بهذه الصفة لا تستطيع أن تبلغ رسالة المسرحية إلى أشتات الطبقات التي تشهد دور التمثيل”(11)، وقد رأيناه يحاول تطبيقاً لما يدين به، ويدعو إليه، أن يجعل لبعض مسرحياته أسلوبين: أحدهما فصيح لجمهرة المثقفين، والآخر عامي لبقية الناس كما فعل بمسرحيته “أبو علي الفنان”.
وخلاصة القول أن ما يبرر استعمال اللهجة في الأدب القصصي أو المسرحي هو حرص الكاتب من جهة على مراعاة العناصر الفنية في تكوين عمله الأدبي، وفي مقدمتها الصدق الفني والواقعية واستغلال اللغة في تجسيد الأفكار والانفعالات وحرصه من جهة أخرى على إيصال معانيه بصورة مؤثرة إلى أكبر عدد ممكن من مشاهدي مسرحيته أو المستمعين إليها، وهذا الإيصال في مجتمع ـ كمجتمعنا ـ تغلب عليه الأمية، لا يمكن أن يتحقق من غير اللجوء إلى لغة ـ كالعامية ـ يمكن أن تدرك بيسر ووضوح.
* * *
أما استعمال العامية في شعرنا العربي فلم يكن مشكلة يوما ما، إذ أنه بقى محظوراً إلا في حالات محدودة استعمل فيها بعض الشعراء كلمات عامية لا بسبب حرصهم على مراعاة ” العامية ” كعنصر فني بل بسبب ضعفهم اللغوي أو ميلهم إلى الهزل في كثير من الحالات. ولم يلق شعرنا العامي نفسه اهتماماً كبيراً من لدن نقادنا أو أدبائنا أو القراء نتيجة شيوع روح الازدراء تجاهه و تجاه الأدب الشعبي عامة بالرغم من أننا نسمع بين حين وآخر إطراء لما يمتاز به من صدق أو واقعية، كما نرى ذلك مثلا في قول توفيق عواد “فالصدق هو المزية الأولى للشعر العامي، وإذا قلنا عن شعر أنه صادق فقد اعترفنا له بالركن الأساسي الذي بدونه لا يقوم شعر في أية أمة من الأمم ..”(12) أو كما يقول مارون عبود “إن الشعور بالحياة وإدراكها الكامل لا يكونان تامين إذا عبرت عنهما بغير اللغة الدائرة على الألسنة و بهذا يثير شاعرنا العامي النفوس إثارة يعجز عنها أكبر شعرائنا الرسميين .. عشتم، يا إخوتي، فأنتم شعراؤنا .. إن شعركم منبثق من نفوسنا، من قلوبنا، من أعماق حياتنا، من ظلمات أوديتنا..”(13).
ولا يزال الشعراء العرب يترددون في استغلال الشعر الشعبي أو الأغاني الشعبية، و هم لم يجربوا بعد قيمته كوسيلة تعبيرية تسهم مع العناصر الفنية الأخرى في بناء القصيدة العربية الفصيحة، و مما يجدر ذكره أن الشاعر العراقي “سعدي يوسف” قد حاول أن يفيد من مطلع أغنية عراقية شعبية “للناصرية”، في بناء إحدى قصائده “حادثة في الدواسر” وقد اتخذ من هذه الأغنية وسيلة ناجحة لتصوير عمق العلاقة التي تشده إلى ضحية الحادثة المذكورة، و ما تذكره به هذه العلاقة من ذكريات الطفولة الحلوة :
أبدا وراءك يركضون
فعيونهم تخشى عيونك،
لكنهم قد يقتلونك،
لن يذكروا يا طفل عبد الله أغنية سخية
كنا نغنيها معا: للناصرية،
تعطش وشربك ماي.. للناصرية..
وللمشكلة جانب آخر يمثل المناوئين لتشجيع العامية أو استعمالها في العمل الأدبي و هم يبنون مناوءتهم لها على أسس مختلفة، ويقفون منها مواقف متفاوتة من حيث شدة التعصب للفصحى أو استنكارهم لاقتحام العامية في القصة أو المسرحية، ويبلغ ببعضهم السخط على الدعوة إلى استعمال العامية حداً يدفعهم إلى إلقاء الأحكام العاطفية والتهم و الباطلة على أنصار العامية فيقف “العقاد” – مثلاً- متهماً إياهم بأنهم آلة “في أيدي الهدامين من دعاة الفوضى والهرج والتعطيل وهم مغيظون محنقون من كل أدب يقيم دعائم المجتمع، ولاسيما اللغة الفصحى و القيم الروحية . .”(14 ) ويذهب إلى أن للعلم والأدب لغة هي غير لغة السوق والمعيشة اليومية (15)، و ينبري “أنور المعداوي” مؤيداً أستاذه العقاد في ثورته على دعاة التجديد فيتهمهم بالعجز عن التعبير باللغة الفصيحة، “وأنهم يريدون العامية لأنهم عوام أو أشبه بالعوام !”(16).
وليس من شك في أن من أهم الأسباب التي يتذرع بها المعارضون لاستعمال العامية إيمانهم بأن اللغة العامية عامل تفرقة (17). مادام لكل عربي لغة محلية خاصة به، غير أن هذا الإيمان لا يسنده أساس متين، إذ أن أنصار استعمال العامية في الأدب لا يتخذونها وسيلة أساسية للتعبير بدلا من اللغة العربية الفصيحة، بل يدعون إلى الاستعانة بها في التعبير الأدبي ضمن إطار اللغة الأدبية المشتركة، إذن، ليست فكرة هدامة ـ كما يقولون ـ “تقطع أواصر الوطن العربي وتفقده وسيلة التفاهم الفكري والوجداني وتخمد في أنحائه تجاوب الآمال والآلام..”(18) بل هي فكرة تستمد من مراعاتها العناصر الفنية للعمل الأدبي كما يحددها المفهوم الواقعي الحديث لطبيعة الأدب ووظيفته، وهذا المفهوم كما ـرأيناـ يؤكد ضرورة مراعاة لغة الأشخاص الحقيقية، في الحوار القصصي أو المسرحي، لا من أجل ضمان جو واقعي لحوادث القصة أو المسرحية، بل لأن اللغة التي يستعملها الأشخاص بمفرداتها وجملها وما توحي أو تقترن به من معان و ذكريات و انفعالات تسهم إسهاما كبيراً في التعبير الفني المؤثر لا يضمنه الكاتب إن حاول ترجمتها إلى اللغة العربية الفصيحة.
وليس في هذا ما يبرر القول بأن العمل الأدبي الذي يستخدم العامية يبقى محصوراً في دائرة إقليمية لا يتعداها إلى الأقطار العربية الأخرى، بدعوى أن العامية لا تفهم خارج حدودها الطبيعية فتضفي على العمل الأدبي طابعا محليا كما قال المستشرق كب قبل أكثر من ثلاثين سنة (19)، أو كما يقول غيره من الكتاب العرب(20)، اذ انه من الممكن تفهم الألفاظ المحلية عن طريق السياق أو قيام المؤلف بتفسيرها في الهوامش أو ملحق خاص بها في نهاية الكتاب أو تعلمها نتيجة التعرض لها بين حين و آخر، و قد وجدنا أن عدداً كبيراً من الأعمال الأدبية المصرية مثلاً تتجاوز حدودها الإقليمية، و تحظى بإعجاب القراء في مختلف الأقطار العربية بالرغم مما يستعمل فيها من ألفاظ أو تعابير عامية محلية، ومن السهل أن تلاحظ أننا نتفهم الأفلام أو الأغاني المصرية، من غير صعوبة كبيرة، بسبب وقوعنا تحت تأثيرها زمنا طويلا، وقد لا يصعب على أحد أن يدرك أن استعمال اللغات العامية المحلية، ضمن الأعمال الأدبية يؤدي ـ بمرور الزمن ـ إلى توطيد التفاهم بين متكلميها في مختلف أرجاء العالم العربي بخلاف ما يتصوره المتحاملون على العامية، كما نرى ذلك واضحا في ظاهرة تفهم كثير من المواطنين العرب اللهجة المصرية.
ويحارب بعضهم العامية بدافع الحرص على العربية والادعاء بأن استعمالها في العمل الأدبي يعرقل تقدم الفصحى، وما أسرع ما ينهار هذا الادعاء، و ذلك الدافع، حين نذكرهم بما للفصحى من مجالات أدبية أو علمية أو ثقافية عامة أخرى تقوم فيها بوظيفتها من غير منافسة العامية لها، أو حين نذكرهم بأننا نعيش العامية في حياتنا، وفي ما نسمع من أغان أو أزجال صباح مساء من غير أن يحول ذلك دون تقدم الفصحى أو شيوعها.
ومما يدعو إلى الاستغراب أن يقع عدد كبير من كتابنا في خطأ الإحساس بأن العامية لا تصلح للاستعمال الأدبي أو “لن تصلح إطاراً لفن حضاري”، كما يذهب إلى ذلك إبراهيم الأبياري قائلاً بأن “العامية لا تصلح ولن تصلح إطاراً لفن حضاري يعيش في مجتمع إنساني يحترم حقيقة وجوده، فن يراد له أن يعيش بالمجتمع ومن أجل المجتمع الناهض الساعي إلى وحدته الكبرى، يشق بها طريقه إلى الخلاص …” (21 )
وإذا كان من السهل تفهم وجهة نظر المتعصبين للفصحى أمثال الأبياري، فإنه من الصعب أن نغفر لكاتب قصصي كالمازني أن يقع في الخطأ نفسه وأن يرى بأن العامية “لا تصلح أداة للكتابة لكثرة ما ينقصها من عناصر التعبير ولحاجتها الشديدة إلى الضبط والإحكام ولأنها لم تستوف بعد أوضاعها..”(22)، يقولون هذا الكلام كله عن اللغة العامية وهم على علم بحقيقة الواقع اللغوي وازدواجيته في بلادنا، وبأن وسيلة التفاهم اليومي بين المواطنين، هي العامية ثم يتجاهلون ما للعامية من أدب شعبي في مختلف فنونه، له أثره في نفوس الناس، وإن كنا قد أهملناه ـ ولا نزال نهمله ـ ترفعا عنه، وازدراءً به من غير مبرر، كما يتجاهلون ما تقوم به العامية عملياً من دور خطير وما تدركه من نجاح في أغانينا، في مسرحياتنا، وأفلامنا السينمائية وبعض أحاديث الإذاعة وتعليقاتها، أفلا يدل كل هذا على صلاح العامية للاستعمال الأدبي وعلى ما يتوافر فيها من عناصر التعبير؟!
وليس من العسير القول بأن مما يدفع كتابنا إلى تجنب استعمال العامية في العمل الأدبي أنه يتطلب جهدا أكبر مما تتطلبه الفصحى أحياناً، أو أنه يحتم على الكاتب القصصي أو المسرحي أن يكون دقيقا في اختيار الأصوات أو الألفاظ و الجمل التي يستخدمها حقاً أبطاله أو أشخاصه في الحياة اليومية لا أن يفرض عليهم استعمالات لهجة تختلف عن لهجاتهم مما لا يمكن أن يتحقق من غير توافر قدرة بارعة على التعبير بين لهجات الأشخاص، ومن طريف ما يذكر أن بعض النقاد الغربيين أشاروا في عدد من الدراسات إلى أن القارئ يستطيع أن يتبين الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها أشخاص القصة أو المسرحية استنادا إلى ما يدور على ألسنتهم من ألفاظ أو جمل، أي أن الاستعمال اللغوي وحده كفيل ـ أحيانا ـ بأن يدل على طبيعة الشخص أو البطل إن كان الكاتب قادراً على انتقاء الاستعمال اللغوي الحقيقي بكل دقة وتمحيص، غير أن بعض كتابنا يرون بأن “الحوار ليس في كلماته فحسب بل في معناه وتعابيره، أي في عرض طريقة تفكير الشخص فإذا استطاع الكاتب أن يعرض لنا مستوى ونموذج تفكير الشخص وطريقة حديثه بلغة فصحى دون أن يجعل القارئ يشعر بالفارق بين الشخصية الواقعية والشخصية الروائية فلا شك أنه يكون قد كسب المعركة وانتصر على مشكلة الحوار..”(23) ولهذا السبب يفضل شاكر خصباك أن يستعمل “التعابير والكلمات التي تستعمل بالعامية ويمكن كتابتها بالفصحى..” كما ترى ذلك واضحاً مثلاً في أسلوب الحوار الذي لجأ إليه في قصة “حياة قاسية” لنقل ما يدور بين حليمة وأمها على النمط التالي:
ـ صار الغدا يا حليمة؟
تساءلت أمها وهي مكبة على قميص بين يديها ترتق فتوقه، فأجابت حليمة بخشونة: لا
فقالت الأم دون أن ترفع عينيها عن القميص:
متى سنتغدى إذن؟ .. سأموت من الجوع ..
فهتفت حليمة في حنق: وماذا أعمل لك؟ أأنا أسرع من النار ؟ فكفت الأم عن عملها ورفعت إليها عينين ساخرتين و تساءلت في غيظ : تعالي كليني .. أأنت بنت السلطان لا يستطيع أحد أن يكلمك؟!
فصاحت الأم مهتاجة: الله لا يمهلك على هذا التعدي، ترد علي كلمة كلمة.
وكانت الجدة جالسة على سجادتها وهي متلفعة بردائها الأبيض وقد فرغت لتوها من صلاة الظهر، قالت دون أن ترفع رأسها عن سبحتها : أنت تتحرشين بها ثم تلوميها على ما تقول، هذا ليس إنصافاً …”(24)
وأنه لمن السهل أن يلاحظ القارئ محاولة “خصباك” سبك التعبير العامي في أسلوب أقرب إلى الفصيح غير أن هذه المحاولة لا تخلو من تكلف واضح و تشويه لكلام الأشخاص نتيجة الخلط بين الأسلوب العامي في التعبير، وسبكه في لغة فصيحة.
ويميل الأستاذ عبد المجيد لطفي إلى تجنب العامية في قصصه، لا استكباراً عليها، كما يقول، بل لأنه يعتبر الفصحى اللغة الأم المحافظة على كل جمالها البسيط المهذب ووافية بكل احتياجاته دون تعسف، ثم يذكر سبباً آخر متصلاً برأي “خصباك” يجعله غير متضجر من وجود العامية قائلا: “والجوهري في الموضوع، موضوع الحوار هو شكلية الحوار ومستواه.. أن اللغة وسيلة تعبيرية فأنا حين أكتب حوارا ألاحظ مستوى بطلي في الكلام فلا أضع حوارا لا يمر في ذهن فلاح على لسان فلاح ولا أضع حوارا مسفاً على لسان بطل جامعي، فالخلخلة المؤسفة في الحوار لا تتأتى من صيغة الحوار بالفصحى أو العامية، وإنما عن طريق التعليق والشرح والإبانة أي عن مستوى الفكر، ووضع الشيء في غير مكانه، فالنبو ليس في الكلام وإنما في المعنى، فالذين يكتبون حواراً فصيحاً يقعون في خطأ نسيان واقع الحال وهو أنهم حين يكتبون حوارهم بلغة فصحى يفكرون تفكيراً أعلى فينسون المستوى، مستوى البطل، أما أنا فلا أنسى.. لا أنسى مستوى بطلي فأنا لا أضع في كلامه حواراً أرقى مما يتداول في واقعه..” (25).
وعبد المجيد لطفي يختلف عن شاكر خصباك في معالجته لمشكلة الحوار في القصة، فهو لا يحاول التقيد بسبك الأسلوب العامي في لغة فصيحة، بل يترجم لغة الأشخاص إلى حوار فصيح يتناسب ومستوى كل شخص، مما يجعله في مأمن من التكلف اللغوي الناتج عن الخلط بين العامية واللغة الفصيحة في تركيب الحوار.
ويشير دعاة استعمال الفصحى في الحوار إلى عامل آخر يشجعهم على تجنب العامية لما يسبب استخدامها إلى جانب الفصحى من التنافر اللغوي، وهم يرون أن استعمال الفصحى لكتابة السياق أو الوصف، والعامية للحوار يخلق تنافراً في الكتابة يصدم القارئ عند انتقاله من لغة إلى لغة ويقترحون أن تكتب القصة كلها إما بالفصحى أو العامية ليقضي على هذا التباين الشاذ و”تحل محله الألفة والتناسب، وبما أن اللغة العربية هي لغة الكتابة وجب علينا إذن أن نكتب القصة جميعها _أوصافها وحوارها- باللغة العربية..”(26).
ويرى عبد المجيد لطفي أن هذا التلوين في الأدب مضحك إلى درجة كبيرة، ويعني بالتلوين كتابة السياق أو بسرده بالفصحى و كتابة الحوار بالعامية، ويتساءل قائلاً: “إذا كان المكتوب هو لمن يستطيع أن يقرأ فلم نضع أمامه حواراً رديئاً عامياً فهو يفهم الفصحى ويتذوقها وهو بالتالي ليس بحاجة إلى العامية لأنه ليس متهافتاً في مستوى إدراكه ومفهوماته الأدبية وإذا كانت مكتوبة ـ أعني القصة أو المقالة ـ للعامي فلم يكتب السياق بالفصحى، فالأفضل في هذه الأحوال أن يكتب الجميع بلغة واحدة، أعني سياق الحكاية وكلامها..”.
وبالرغم مما يبدو في هذا الرأي من وجاهة، فإن من الممكن القول مرة أخرى بأن الصدق الفني والواقعية، واستغلال لهجات الأشخاص في تصوير أفكارهم وأعمالهم وصفاتهم، عوامل تستلزم اللجوء إلى العامية في الحوار، في القصة أو المسرحية وهذا ما يلاحظ عملياً في أعمال كبار الكتاب العالميين كفوكنر؛ وهمنغواي وغيرهما ممن لا يجدون ضيراً في حصول التباين اللغوي بسبب استعمال اللغة الأدبية إلى جانب العامية، رغبة في مراعاة العناصر الفنية التي أشرنا إليها قبل قليل..
وإذا كان هنالك من مسوغ للتردد في قبول فكرة الاستعمال الأدبي للعامية في القصة أو الرواية، فليس من الصحيح ألا يؤخذ بها في المسرحية لاسيما في مجتمع كمجتمعنا، وفي مرحلة كمرحلتنا، حيث تتخذ المسرحية وسيلة فعالة في سبيل التثقيف وإشاعة الوعي والتسلية البريئة، لا من أجل طبقة أو فئات محدودة من المواطنين، بل من أجل أكثرية الشعب الساحقة.
() نشرت في مجلة المثقف 3 (15/ كانون الثاني ـ شباط، 1960) ص ص 6ـ17 وفي مقالات مختارة (بغداد: اتحاد الأدباء العراقيين 1961) ص ص 65 ـ 82. واعيد نشرها في كتاب المؤلف قضايا اللغة العربية المعاصرة(بيروت:دار الغاوون 2011)ص ص7-24.
(1) عمر الدسوقي: في الأدب الحديث (القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، 1950).
(2) ميخائيل نعيمة: الآباء والبنون – (نيويورك: شركة الفنون، 1917)ص ص 6-7.
(3) المصدر نفسه – أو راجع – الغربال – ميخائيل نعيمة –( القاهرة: دار المعارف، طبعة 1951) ص 27.
(4) Hemingway. Green Hills of Africa (N.Y, Perma Books,1954) p. 18.
(5)Summer Ives. “A theory of Literal Dialects” Tulane Studies in English 2: 137-138 1950).
(6) John B. Hoben. “Mark Twain: On the Writer’s Use of Language”
American Speech 31(1956) : 164
(7) محمد مندور: في الميزان الجديد (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1944) ص 36.
(8) حسين مروة: قضايا أدبية (القاهرة: دار الفكر، 1956)ص 47-51.
(9) عبد الملك نوري: “دفاع عن اللهجة العامية” الأسبوع 1: (15 نيسان 953) 20-21.
(10) محمد مندور: قضايا جديدة في أدبنا الحديث –( بيروت: دار الآداب، 1958) 133-139.
(11) محمد تيمور: فن القصص –( القاهرة: مجلة الشرق الجديد، 1945) ص71.
(12) توفيق عواد: “الشعر العامي” المشرق 28 (1930) ص 508.
(13) مارون عبود: “الشعر العامي اللبناني” الآداب – آب (1953).
(14) عباس محمودالعقاد: مشكلات الأدب العصري” الكتاب 12 (1953): 234.
(15) عباس محمودالعقاد : “حرب اللغة” الكتاب 11 (1952): 536.
(16) أنور المعداوي: “الأدب الجديد والأدب القديم” الكتاب 12: 709-710.
(17) طه حسين: خصام ونقد ( بيروت: دار العلم للملايين، 1955)ص191
(18) إبراهيم الأبياري ورضوان إبراهيم: أزمة التعبير الأدبي بين العامية والفصحى (القاهرة: دار الطباعة الحديثة، 1959) ص 68.
(19)H. A. R.Gibb, “Studies in Contemporary Arabic Literature”, Bulletin of the School of Oriental Studies 4 (1928):752
(20) راجع مثلاً: إسحاق موسى الحسيني: أزمة الفكر العربي( بيروت: دار بيروت، 9541،) ص75 .
(21) إبراهيم الأبياري ورضوان إبراهيم: أزمة التعبير الأدبي، ص 7.
(22) إبراهيم عبد القادر المازني: إبراهيم الكاتب( القاهرة: مكتبة مصر، 1945) ص ص 8-9.
(23) من رسالة شخصية بعث بها الدكتور خصباك بتاريخ 20-4-1957
(24) شاكر خصباك: حياة قاسية بغداد ،، منشورات الثقافة الجديدة 1959، ص ص 12-13.
(25) عبد المجيد لطفي في رسالة شخصية مؤرخة في 14/4/1957.
(26) محمود تيمور: الشيخ جمعة وأقاصيص أخرى( القاهرة: المطبعة السلفية، 1927)، ص 15.
* عن
أ. د. صالح جواد الطعمة : اللغة العامية واستعمالها في العمل الأدبي(*)
إن من أبرز القضايا الفكرية التي يواجهها العالم العربي مشكلة وجود لغة تستعمل في الحياة اليومية (وهي العامية) إلى جانب اللغة الفصيحة التي تختلف اختلافاً واضحاً في تركيبها ونظامها اللغويين، وفي وظائفها ومجالات استعمالها. فاللغة الفصيحة، من حيث الوظيفة، تستعمل كلغة للإيصال المحدود أو المقيد، أي أنها لغة المطبوعات، بصورة عامة، ولغة المحاضرات، ولغة المناسبات الرسمية، وهي تكاد تكون متجانسة أو واحدة في العالم العربي، أي أنها لا تتقيد بالحدود الإقليمية القائمة فيه، وهي إلى جانب ذلك كله تتمتع بمنزلة دينية، وسياسية وأدبية، أما اللهجة أو العامية فإنها من حيث الوظيفة، لغة الحياة اليومية، اللغة الطبيعية للفرد في كل قطر عربي، وغالباً ما تستعمل في الكلام وإن كانت تكتب أحياناً.. والعامية – بخلاف العربية الفصيحة – ليست متجانسة بل تتغير من منطقة إلى أخرى داخل كل قطر عربي، أو من قطر إلى آخر، وتفتقر – بحكم الظروف التي مرت بها- إلى المنزلة الأدبية أو السياسية أو الدينية التي تمتاز بها الفصحى.
وإذا قارنا بينهما من الناحية التركيبية فمن الممكن حصر الفروق البارزة في قولنا بأن الفصحى تختلف عن العامية بنظامها الصوتي ونظامها الإعرابي المعقد، وبوجود ظاهرة التثنية في الأفعال والأسماء بخلاف التثنية في العامية التي لم تعد تلاحظ في الأفعال والضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، كما تتميز العامية بالميل إلى التخلص من كثير من الأدوات والحروف التي تسبق الأسماء أو الأفعال في الفصحى وتسبب في معظم الحالات تغييراً في وضعها الإعرابي.
وليست هذه القضية بظاهرة جديدة، بل لها جذور عميقة في تاريخنا تمتد إلى العصر الجاهلي في رأي عدد من الكتاب، غير أن ظهورها كمشكلة في تاريخنا الحديث يمكن أن يحدد بأواخر القرن التاسع عشر حين بدأ الاستعمار الغربي محاولته الفاشلة في الدعوة إلى التخلي عن اللغة العربية الفصيحة، واتخاذ العامية وسيلة للتعبير والتعلم في مجالي الحياة العلمية والثقافية، وكان في طليعة أصحاب هذه الدعوة السير وليام ولكوكس الذي ألقى خطبة في نادي الأزبكية (في القاهرة سنة 1893) بعنوان “لمَ لمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين؟” أشار فيها إلى أن العامل الأول في فقد قوة الاختراع لدى المصريين استخدامهم اللغة العربية الفصيحة في القراءة والكتابة، وقد حثهم على الالتزام بالعامية أداة للتعبير الأدبي اقتداءً بالأمم الأخرى، واستشهد بشعبه قائلاً عنه بأنه أفاد فائدة كبيرة منذ هجر اللاتينية التي كانت يوماً لغة الكتابة والعلم(1).
وظلت القضية منذ ذلك اليوم موضع جدل و نقاش بين الكتاب و المفكرين العرب وغير العرب، بين فريق يؤيد التمسك بالعربية الفصيحة، والدعوة إلى القضاء على العامية، وآخر يدعو إلى تفضيل العامية على الفصحى كلغة الحياة اليومية والثقافية وفريق ثالث يحاول أن يقف موقفاً وسطاً في دعوته إلى الالتزام بالفصيحة والإفادة من العامية ـ في الوقت نفسه ـ كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ومن الواضح أن هذه المشكلة الناجمة عن الثنائية في التعبير ليست لغوية فحسب، بل هي مشكلة عامةلها آثارها في حقول ثقافية مختلفة كالتعليم وعلم النفس والأدب، كما لها صلتها الوثيقة بعوامل سياسية ودينية لا مجال لذكرها في هذا المقام. أما آثار المشكلة في الأدب ـ و هي موضوع مقالناـ فمن المستطاع أن نوضح بعد النظر في ما يبديه بعض الكتاب من رأي حول مدى ضرورة استعمال ” العامية ” أو اللهجة في العمل الأدبي، كالقصة والرواية والمسرحية والشعر جنباً إلى جنب مع اللغة الفصيحة. ولابد أن نشير هنا إلى أن مسألة استعمال العامية في العمل الأدبي تختلف عن موضوع الأدب الشعبي ” الفولكلور Folklor ” ووجوب تشجيعه إذ أننا لا نواجه في الأدب الشعبي أية مشكلة تتصل بالثنائية في التعبير لأن وسيلته التعبيرية الوحيدة في معظم الأحوال هي العامية، ولا تلعب اللغة الفصيحة فيه دوراً كبيراً .. غير أن الأمر يختلف بالنسبة إلى الفنون الأدبية الأخرى كالقصة والمسرحية والشعر والمقالة إذ أن هذه الفنون اعتادت، إلا في حالات نادرة، أن تعتمد على اللغة الفصحى اعتماداً يكاد يكون كلياً وفقاً للتقليد الذي التزم به الأديب العربي، ومسألة اشتراك العامية مع الفصحى في العمل الأدبي مسألة حديثة، و هي مرتبطة بظهور المسرحية والقصة والرواية ـ بمعناهما الفني ـ في أدبنا الحديث، و يحسن بنا أن نتبين طبيعة المشكلة في ضوء ما يراه أنصار استعمال العامية في بعض الفنون الأدبية وما يراه معارضوه ..
ـ 2 ـ
لقد استمعنا قبل أكثر من أربعين سنة، الكاتب اللبناني الشهير ميخائيل نعيمة يحدثنا عن العقبات التي صادفها في تأليف مسرحيته “الآباء و البنون” وفي مقدمتها اللغة العامية، والمقام الذي يجب أن تعطى في مثل هذه المسرحية(2)، قائلاً بأن أشخاص الرواية يجب أن يخاطبونا باللغة التي تعودوا التعبير بها عن عواطفهم وأفكارهم وأغراضهم، وأن الكاتب الذي يحاول أن يجعل فلاحاً أمياً يتكلم بلغة الدواوين الشعرية والمؤلفات اللغوية، أي بأسلوب لغوي لا يلائم مستواه، يظلم فلاحه ونفسه وقارئه وسامعه بل يظهر أشخاصه في مظهر الهزل حيث لا يقصد الهزل ويقترف جرماً ضد فن جماله في تصوير الإنسان حسبما نراه في مشاهد الحياة الحقيقية(3).
ومن الواضح أن المسرحية ـ بصورة خاصةـ والرواية أو القصة (في كثير من الأحيان) تعتمد على الحوار في نقل التجربة أو الأفكار أو العواطف التي يدور حولها العمل الأدبي، والصدق الفني وما يسمى بمبدأ “مشاكلة الواقع” يتطلب أن يكون الحوار على ألسنة أشخاص الرواية أو المسرحية ملائماً لثقافتهم ومستواهم وتفكيرهم ومن أهم أسباب تحقيق هذه “المشاكلة” الأسلوب أو اللغة التي يستعملها أشخاص القصة أو المسرحية ولهذا نرى أن كثيراً من كتاب القصة والرواية في العالم كمارك توين وهمنغواي وفوكنر يلجأون، في تصوير أشخاصهم وفي أعمالهم، إلى اللهجة التي يستعملها عملياً أشخاص الرواية أو القصة في حياتهم اليومية بالرغم من أنها تختلف عن اللغة الأدبية التي يعتمدها الكتاب أنفسهم عندما يصفون الأحداث أو يروونها حتى أن “همنغواي” تطرق في إحدى رواياته “تلال أفريقيا الخضراء” إلى موضوع استعمال اللهجة في القصة، وموقف بعض كبار الكتاب الأمريكيين منه، فأشار إلى أنهم لم يكونوا يستعملون الكلمات التي يستعملها الناس دائما في حياتهم، تلك الكلمات التي تبقى حية في اللغة(4).
ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الأمريكي الشهير “مارك توين” يعتبر في مقدمة الكتاب المعاصرين الذين اتخذوا من “اللهجة” وسيلة ناجحة لتحديد شخصية أبطال القصة أو الرواية، مستهدفين نقل الواقع وتصوير الحقيقة من غير تكلف أو التواء(5)، كما اعتبر أشهر كتاب القرن التاسع عشر من حيث إيثاره العبارة العامية على الأسلوب الأدبي(6).
فالدعوة إلى استعمال “اللهجة”، إذن، ليست مقصورة على الأدب العربي بل لها مجالها في الآداب الأخرى حيث لا تختلف اللهجة فيها اختلافاً كبيراً عن اللغة الأدبية كما هي الحال عندنا بالنسبة إلى الاختلاف القائم بين العامية واللغة الفصيحة.
ومما يدعم هذه الدعوة أن العامية، كأية لغة أخرى، تحمل في طياتها ثقافة المتحدثين بها، وفيها من وسائل التعبير والمفردات ما يوحي بأفكار أو مشاعر أو صور معينة، وليس من العمل الفني الناجح ألا تستغل هذه “الطاقة” التعبيرية الكامنة فيها، وقد كان ميخائيل نعيمة على حق في قوله بأن اللغة العامية تستر تحت ثوبها الخشن كثيراً من فلسفة الشعب واختباراته في الحياة وأمثاله واعتقاداته، وأن من يحاول أن يؤديها بلغة فصيحة يكون كمن يترجم أشعاراً وأمثالاً عن لغة أعجمية.
ولاحظ “نعيمة” أن المسرحية (أو الرواية التمثيلية كما أسماها) لا تستطيع الاستغناء عن العامية، غير أنه وجد ـ في الوقت نفسه ـ أننا لو تابعنا هذه القاعدة لوجب أن نكتب كل رواياتنا باللغة العامية، وذلك يعني ـ في رأيه ـ انقراض لغتنا الفصحى، وقد رأى بعد تفكير طويل، أن يجعل المتعلمين من أشخاص مسرحيته (الآباء والبنون) يتكلمون الفصحى والأميين يتكلمون اللغة العامية.
ويعنى الكتاب المعاصرون في البلاد العربية، وفي الأقطار الأخرى، عناية خاصة بمبدأ “مشاكلة الواقع” في الأدب القصصي أو المسرحي، ويحاولون جهدهم تجنب فرض أسلوبهم الخاص على أشخاص قصصهم أو مسرحياتهم، ويوضح هذا الاتجاه ما جاء في مقدمة المؤلف الفرنسي “بومارشيه” لروايته “فيغارو” حين أجاب عن سؤال حول سر احتواء روايته على جمل مهلهلة ليست من أسلوبه قائلا :
“من أسلوبي يا سيدي ؟ لو شاء النحس أن يكون لي أسلوب لحاولت أن أنساه عندما أكتب مسرحية، وأنا لا أعرف أتفه طعماً من تلك المسرحيات التي نرى كل شيء فيها جميلاً وردياً، كل شيء هو المؤلف نفسه كيفما كان “ثم يستمر قائلاً”:
عندما يتملكني موضوعي استدعي شخصياتي وأضع كلاً في محله، و أنا لا أعرف ماذا سيقولون وإنما سيعنيني ما سيفعلون وعندما يأخذون في الحركة أكتب ما يملونه علي إملاءً سريعاً، واثقاً من أنهم لن يخدعوني، فلنأخذ إذن في فحص أفكارهم لا في البحث عما إذا كان من واجبي أن أعيرهم أسلوبي”(7).
ويتبلور التأكيد على استعمال لغة البطل واضحاً في ما كتبه حسين مروة عن الموضوع(8)، وما دعا إليه حين عبر عن إيمانه بأن ليس هنالك شيء يفسد العمل الفني الروائي مثل أن يجئ الحوار بلغة غير لغة البطل، كلغة المؤلف مثلاً، على أساس أن لغة البطل في الحوار هي قوام عنصر الشخصية الإنسانية، قوام شخصيته، ويعني هذا أن نحس، كما يقول مروة، وجود البطل في لغته ولهجته خلال الحوار ..
وهنالك أمر ثالث يخص علاقة لغة المسرحية بالمشاهدين يتخذه الكتاب مبرراً لاستعمال العامية، إذ أن الكاتب المسرحي يدرك بأن المسرحية توضع للمسرح أو الشاشة و إنه يخاطب المشاهدين من خلال المسرحية بمختلف طبقاتهم و مستوياتهم، مما يستلزم اختيار أسلوب لغوي يضمن تفهمهم السريع وتتبعهم لما يقال، من غير تردد أو تأن، إذ أن صعوبة اللغة المستعملة أو صعوبة بعض فقراتها أو جملها تؤدي إلى تأخر المشاهد [أو المستمع، إن كانت المسرحية تذاع]، عن متابعة أحداث المسرحية، أو إلى سوء فهمه لها، كما تسبب ضياع الأثر الفني، أو ضعفا فيه.
* * *
وهكذا نلاحظ أن مسألة استعمال العامية في الأدب القصصي أو المسرحي مرتبطة بثلاثة أمور متلازمة : الصدق الفني، واستغلال اللغة في نقل الأفكار و المشاعر أو تصوير الشخصية في المسرحية والقصة، وعلاقة لغة المسرحية بالمشاهدين، وقد ظلت هذه الأمور – ولا تزال- تشغل بال الكاتب القصصي أو المسرحي في العراق وغير العراق من الأقطار العربية، فنجد مثلاً “عبد الملك نوري” يؤكد أن “اللغة عنصر مهم من حياة الشخص ووجوده الواقعي فإذا جرده الكاتب منها أتلف جزءاً كثيراً من حيويته وواقعيته”(9)، ويحاول أن يطبق هذا المبدأ الفني في إنتاجه القصصي، كما نجد توفيق الحكيم يقوم بمحاولات متعددة لمعالجة قضية الفصحى والعامية في مسرحياته تارة باستعمال الفصحى المبسطة، أو العامية المرتفعة، وأخيراً هذه اللغة التي استعملها في مسرحيته “الصفقة” وهي لغة تجمع بين الطريقتين دون أن تجافي ـ كما يقول الحكيم نفسه ـ قواعد الفصحى، وهي في الوقت نفسه ـ مما يمكن أن ينطقه الأشخاص ولا ينافي طبائعهم أو جو حياتهم ـ وقد قال عنها الحكيم بأنها لغة سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل إقليم ويمكن أن تجري على الألسنة، وقد يبدو لقارئها [أي المسرحية] أنها مكتوبة بالعامية، ولكنها إذا أعاد قراءتها طبقاً لقواعد الفصحى ¬فإنه يجدها منطبقة عليها على قدر الإمكان(10).
وبالرغم من قول محمود تيمور بأن التعبير في الفصحى في طليعة ما يجب أن يلتزمه الأديب، فإنه يدافع عن مبدأ استعمال اللهجة في المسرحية، و يذهب إلى أن مخاطبة الجمهور على تباين طبقاته تحتم على الكاتب المسرحي أن يطرق الآذان بما ألفت من لغة، ويرى أن الفصحى “لغة الكتابة لا لغة الحديث، وترجمان الثقافة الخاصة لا ثقافة الشعب وأنها بهذه الصفة لا تستطيع أن تبلغ رسالة المسرحية إلى أشتات الطبقات التي تشهد دور التمثيل”(11)، وقد رأيناه يحاول تطبيقاً لما يدين به، ويدعو إليه، أن يجعل لبعض مسرحياته أسلوبين: أحدهما فصيح لجمهرة المثقفين، والآخر عامي لبقية الناس كما فعل بمسرحيته “أبو علي الفنان”.
وخلاصة القول أن ما يبرر استعمال اللهجة في الأدب القصصي أو المسرحي هو حرص الكاتب من جهة على مراعاة العناصر الفنية في تكوين عمله الأدبي، وفي مقدمتها الصدق الفني والواقعية واستغلال اللغة في تجسيد الأفكار والانفعالات وحرصه من جهة أخرى على إيصال معانيه بصورة مؤثرة إلى أكبر عدد ممكن من مشاهدي مسرحيته أو المستمعين إليها، وهذا الإيصال في مجتمع ـ كمجتمعنا ـ تغلب عليه الأمية، لا يمكن أن يتحقق من غير اللجوء إلى لغة ـ كالعامية ـ يمكن أن تدرك بيسر ووضوح.
* * *
أما استعمال العامية في شعرنا العربي فلم يكن مشكلة يوما ما، إذ أنه بقى محظوراً إلا في حالات محدودة استعمل فيها بعض الشعراء كلمات عامية لا بسبب حرصهم على مراعاة ” العامية ” كعنصر فني بل بسبب ضعفهم اللغوي أو ميلهم إلى الهزل في كثير من الحالات. ولم يلق شعرنا العامي نفسه اهتماماً كبيراً من لدن نقادنا أو أدبائنا أو القراء نتيجة شيوع روح الازدراء تجاهه و تجاه الأدب الشعبي عامة بالرغم من أننا نسمع بين حين وآخر إطراء لما يمتاز به من صدق أو واقعية، كما نرى ذلك مثلا في قول توفيق عواد “فالصدق هو المزية الأولى للشعر العامي، وإذا قلنا عن شعر أنه صادق فقد اعترفنا له بالركن الأساسي الذي بدونه لا يقوم شعر في أية أمة من الأمم ..”(12) أو كما يقول مارون عبود “إن الشعور بالحياة وإدراكها الكامل لا يكونان تامين إذا عبرت عنهما بغير اللغة الدائرة على الألسنة و بهذا يثير شاعرنا العامي النفوس إثارة يعجز عنها أكبر شعرائنا الرسميين .. عشتم، يا إخوتي، فأنتم شعراؤنا .. إن شعركم منبثق من نفوسنا، من قلوبنا، من أعماق حياتنا، من ظلمات أوديتنا..”(13).
ولا يزال الشعراء العرب يترددون في استغلال الشعر الشعبي أو الأغاني الشعبية، و هم لم يجربوا بعد قيمته كوسيلة تعبيرية تسهم مع العناصر الفنية الأخرى في بناء القصيدة العربية الفصيحة، و مما يجدر ذكره أن الشاعر العراقي “سعدي يوسف” قد حاول أن يفيد من مطلع أغنية عراقية شعبية “للناصرية”، في بناء إحدى قصائده “حادثة في الدواسر” وقد اتخذ من هذه الأغنية وسيلة ناجحة لتصوير عمق العلاقة التي تشده إلى ضحية الحادثة المذكورة، و ما تذكره به هذه العلاقة من ذكريات الطفولة الحلوة :
أبدا وراءك يركضون
فعيونهم تخشى عيونك،
لكنهم قد يقتلونك،
لن يذكروا يا طفل عبد الله أغنية سخية
كنا نغنيها معا: للناصرية،
تعطش وشربك ماي.. للناصرية..
وللمشكلة جانب آخر يمثل المناوئين لتشجيع العامية أو استعمالها في العمل الأدبي و هم يبنون مناوءتهم لها على أسس مختلفة، ويقفون منها مواقف متفاوتة من حيث شدة التعصب للفصحى أو استنكارهم لاقتحام العامية في القصة أو المسرحية، ويبلغ ببعضهم السخط على الدعوة إلى استعمال العامية حداً يدفعهم إلى إلقاء الأحكام العاطفية والتهم و الباطلة على أنصار العامية فيقف “العقاد” – مثلاً- متهماً إياهم بأنهم آلة “في أيدي الهدامين من دعاة الفوضى والهرج والتعطيل وهم مغيظون محنقون من كل أدب يقيم دعائم المجتمع، ولاسيما اللغة الفصحى و القيم الروحية . .”(14 ) ويذهب إلى أن للعلم والأدب لغة هي غير لغة السوق والمعيشة اليومية (15)، و ينبري “أنور المعداوي” مؤيداً أستاذه العقاد في ثورته على دعاة التجديد فيتهمهم بالعجز عن التعبير باللغة الفصيحة، “وأنهم يريدون العامية لأنهم عوام أو أشبه بالعوام !”(16).
وليس من شك في أن من أهم الأسباب التي يتذرع بها المعارضون لاستعمال العامية إيمانهم بأن اللغة العامية عامل تفرقة (17). مادام لكل عربي لغة محلية خاصة به، غير أن هذا الإيمان لا يسنده أساس متين، إذ أن أنصار استعمال العامية في الأدب لا يتخذونها وسيلة أساسية للتعبير بدلا من اللغة العربية الفصيحة، بل يدعون إلى الاستعانة بها في التعبير الأدبي ضمن إطار اللغة الأدبية المشتركة، إذن، ليست فكرة هدامة ـ كما يقولون ـ “تقطع أواصر الوطن العربي وتفقده وسيلة التفاهم الفكري والوجداني وتخمد في أنحائه تجاوب الآمال والآلام..”(18) بل هي فكرة تستمد من مراعاتها العناصر الفنية للعمل الأدبي كما يحددها المفهوم الواقعي الحديث لطبيعة الأدب ووظيفته، وهذا المفهوم كما ـرأيناـ يؤكد ضرورة مراعاة لغة الأشخاص الحقيقية، في الحوار القصصي أو المسرحي، لا من أجل ضمان جو واقعي لحوادث القصة أو المسرحية، بل لأن اللغة التي يستعملها الأشخاص بمفرداتها وجملها وما توحي أو تقترن به من معان و ذكريات و انفعالات تسهم إسهاما كبيراً في التعبير الفني المؤثر لا يضمنه الكاتب إن حاول ترجمتها إلى اللغة العربية الفصيحة.
وليس في هذا ما يبرر القول بأن العمل الأدبي الذي يستخدم العامية يبقى محصوراً في دائرة إقليمية لا يتعداها إلى الأقطار العربية الأخرى، بدعوى أن العامية لا تفهم خارج حدودها الطبيعية فتضفي على العمل الأدبي طابعا محليا كما قال المستشرق كب قبل أكثر من ثلاثين سنة (19)، أو كما يقول غيره من الكتاب العرب(20)، اذ انه من الممكن تفهم الألفاظ المحلية عن طريق السياق أو قيام المؤلف بتفسيرها في الهوامش أو ملحق خاص بها في نهاية الكتاب أو تعلمها نتيجة التعرض لها بين حين و آخر، و قد وجدنا أن عدداً كبيراً من الأعمال الأدبية المصرية مثلاً تتجاوز حدودها الإقليمية، و تحظى بإعجاب القراء في مختلف الأقطار العربية بالرغم مما يستعمل فيها من ألفاظ أو تعابير عامية محلية، ومن السهل أن تلاحظ أننا نتفهم الأفلام أو الأغاني المصرية، من غير صعوبة كبيرة، بسبب وقوعنا تحت تأثيرها زمنا طويلا، وقد لا يصعب على أحد أن يدرك أن استعمال اللغات العامية المحلية، ضمن الأعمال الأدبية يؤدي ـ بمرور الزمن ـ إلى توطيد التفاهم بين متكلميها في مختلف أرجاء العالم العربي بخلاف ما يتصوره المتحاملون على العامية، كما نرى ذلك واضحا في ظاهرة تفهم كثير من المواطنين العرب اللهجة المصرية.
ويحارب بعضهم العامية بدافع الحرص على العربية والادعاء بأن استعمالها في العمل الأدبي يعرقل تقدم الفصحى، وما أسرع ما ينهار هذا الادعاء، و ذلك الدافع، حين نذكرهم بما للفصحى من مجالات أدبية أو علمية أو ثقافية عامة أخرى تقوم فيها بوظيفتها من غير منافسة العامية لها، أو حين نذكرهم بأننا نعيش العامية في حياتنا، وفي ما نسمع من أغان أو أزجال صباح مساء من غير أن يحول ذلك دون تقدم الفصحى أو شيوعها.
ومما يدعو إلى الاستغراب أن يقع عدد كبير من كتابنا في خطأ الإحساس بأن العامية لا تصلح للاستعمال الأدبي أو “لن تصلح إطاراً لفن حضاري”، كما يذهب إلى ذلك إبراهيم الأبياري قائلاً بأن “العامية لا تصلح ولن تصلح إطاراً لفن حضاري يعيش في مجتمع إنساني يحترم حقيقة وجوده، فن يراد له أن يعيش بالمجتمع ومن أجل المجتمع الناهض الساعي إلى وحدته الكبرى، يشق بها طريقه إلى الخلاص …” (21 )
وإذا كان من السهل تفهم وجهة نظر المتعصبين للفصحى أمثال الأبياري، فإنه من الصعب أن نغفر لكاتب قصصي كالمازني أن يقع في الخطأ نفسه وأن يرى بأن العامية “لا تصلح أداة للكتابة لكثرة ما ينقصها من عناصر التعبير ولحاجتها الشديدة إلى الضبط والإحكام ولأنها لم تستوف بعد أوضاعها..”(22)، يقولون هذا الكلام كله عن اللغة العامية وهم على علم بحقيقة الواقع اللغوي وازدواجيته في بلادنا، وبأن وسيلة التفاهم اليومي بين المواطنين، هي العامية ثم يتجاهلون ما للعامية من أدب شعبي في مختلف فنونه، له أثره في نفوس الناس، وإن كنا قد أهملناه ـ ولا نزال نهمله ـ ترفعا عنه، وازدراءً به من غير مبرر، كما يتجاهلون ما تقوم به العامية عملياً من دور خطير وما تدركه من نجاح في أغانينا، في مسرحياتنا، وأفلامنا السينمائية وبعض أحاديث الإذاعة وتعليقاتها، أفلا يدل كل هذا على صلاح العامية للاستعمال الأدبي وعلى ما يتوافر فيها من عناصر التعبير؟!
وليس من العسير القول بأن مما يدفع كتابنا إلى تجنب استعمال العامية في العمل الأدبي أنه يتطلب جهدا أكبر مما تتطلبه الفصحى أحياناً، أو أنه يحتم على الكاتب القصصي أو المسرحي أن يكون دقيقا في اختيار الأصوات أو الألفاظ و الجمل التي يستخدمها حقاً أبطاله أو أشخاصه في الحياة اليومية لا أن يفرض عليهم استعمالات لهجة تختلف عن لهجاتهم مما لا يمكن أن يتحقق من غير توافر قدرة بارعة على التعبير بين لهجات الأشخاص، ومن طريف ما يذكر أن بعض النقاد الغربيين أشاروا في عدد من الدراسات إلى أن القارئ يستطيع أن يتبين الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها أشخاص القصة أو المسرحية استنادا إلى ما يدور على ألسنتهم من ألفاظ أو جمل، أي أن الاستعمال اللغوي وحده كفيل ـ أحيانا ـ بأن يدل على طبيعة الشخص أو البطل إن كان الكاتب قادراً على انتقاء الاستعمال اللغوي الحقيقي بكل دقة وتمحيص، غير أن بعض كتابنا يرون بأن “الحوار ليس في كلماته فحسب بل في معناه وتعابيره، أي في عرض طريقة تفكير الشخص فإذا استطاع الكاتب أن يعرض لنا مستوى ونموذج تفكير الشخص وطريقة حديثه بلغة فصحى دون أن يجعل القارئ يشعر بالفارق بين الشخصية الواقعية والشخصية الروائية فلا شك أنه يكون قد كسب المعركة وانتصر على مشكلة الحوار..”(23) ولهذا السبب يفضل شاكر خصباك أن يستعمل “التعابير والكلمات التي تستعمل بالعامية ويمكن كتابتها بالفصحى..” كما ترى ذلك واضحاً مثلاً في أسلوب الحوار الذي لجأ إليه في قصة “حياة قاسية” لنقل ما يدور بين حليمة وأمها على النمط التالي:
ـ صار الغدا يا حليمة؟
تساءلت أمها وهي مكبة على قميص بين يديها ترتق فتوقه، فأجابت حليمة بخشونة: لا
فقالت الأم دون أن ترفع عينيها عن القميص:
متى سنتغدى إذن؟ .. سأموت من الجوع ..
فهتفت حليمة في حنق: وماذا أعمل لك؟ أأنا أسرع من النار ؟ فكفت الأم عن عملها ورفعت إليها عينين ساخرتين و تساءلت في غيظ : تعالي كليني .. أأنت بنت السلطان لا يستطيع أحد أن يكلمك؟!
فصاحت الأم مهتاجة: الله لا يمهلك على هذا التعدي، ترد علي كلمة كلمة.
وكانت الجدة جالسة على سجادتها وهي متلفعة بردائها الأبيض وقد فرغت لتوها من صلاة الظهر، قالت دون أن ترفع رأسها عن سبحتها : أنت تتحرشين بها ثم تلوميها على ما تقول، هذا ليس إنصافاً …”(24)
وأنه لمن السهل أن يلاحظ القارئ محاولة “خصباك” سبك التعبير العامي في أسلوب أقرب إلى الفصيح غير أن هذه المحاولة لا تخلو من تكلف واضح و تشويه لكلام الأشخاص نتيجة الخلط بين الأسلوب العامي في التعبير، وسبكه في لغة فصيحة.
ويميل الأستاذ عبد المجيد لطفي إلى تجنب العامية في قصصه، لا استكباراً عليها، كما يقول، بل لأنه يعتبر الفصحى اللغة الأم المحافظة على كل جمالها البسيط المهذب ووافية بكل احتياجاته دون تعسف، ثم يذكر سبباً آخر متصلاً برأي “خصباك” يجعله غير متضجر من وجود العامية قائلا: “والجوهري في الموضوع، موضوع الحوار هو شكلية الحوار ومستواه.. أن اللغة وسيلة تعبيرية فأنا حين أكتب حوارا ألاحظ مستوى بطلي في الكلام فلا أضع حوارا لا يمر في ذهن فلاح على لسان فلاح ولا أضع حوارا مسفاً على لسان بطل جامعي، فالخلخلة المؤسفة في الحوار لا تتأتى من صيغة الحوار بالفصحى أو العامية، وإنما عن طريق التعليق والشرح والإبانة أي عن مستوى الفكر، ووضع الشيء في غير مكانه، فالنبو ليس في الكلام وإنما في المعنى، فالذين يكتبون حواراً فصيحاً يقعون في خطأ نسيان واقع الحال وهو أنهم حين يكتبون حوارهم بلغة فصحى يفكرون تفكيراً أعلى فينسون المستوى، مستوى البطل، أما أنا فلا أنسى.. لا أنسى مستوى بطلي فأنا لا أضع في كلامه حواراً أرقى مما يتداول في واقعه..” (25).
وعبد المجيد لطفي يختلف عن شاكر خصباك في معالجته لمشكلة الحوار في القصة، فهو لا يحاول التقيد بسبك الأسلوب العامي في لغة فصيحة، بل يترجم لغة الأشخاص إلى حوار فصيح يتناسب ومستوى كل شخص، مما يجعله في مأمن من التكلف اللغوي الناتج عن الخلط بين العامية واللغة الفصيحة في تركيب الحوار.
ويشير دعاة استعمال الفصحى في الحوار إلى عامل آخر يشجعهم على تجنب العامية لما يسبب استخدامها إلى جانب الفصحى من التنافر اللغوي، وهم يرون أن استعمال الفصحى لكتابة السياق أو الوصف، والعامية للحوار يخلق تنافراً في الكتابة يصدم القارئ عند انتقاله من لغة إلى لغة ويقترحون أن تكتب القصة كلها إما بالفصحى أو العامية ليقضي على هذا التباين الشاذ و”تحل محله الألفة والتناسب، وبما أن اللغة العربية هي لغة الكتابة وجب علينا إذن أن نكتب القصة جميعها _أوصافها وحوارها- باللغة العربية..”(26).
ويرى عبد المجيد لطفي أن هذا التلوين في الأدب مضحك إلى درجة كبيرة، ويعني بالتلوين كتابة السياق أو بسرده بالفصحى و كتابة الحوار بالعامية، ويتساءل قائلاً: “إذا كان المكتوب هو لمن يستطيع أن يقرأ فلم نضع أمامه حواراً رديئاً عامياً فهو يفهم الفصحى ويتذوقها وهو بالتالي ليس بحاجة إلى العامية لأنه ليس متهافتاً في مستوى إدراكه ومفهوماته الأدبية وإذا كانت مكتوبة ـ أعني القصة أو المقالة ـ للعامي فلم يكتب السياق بالفصحى، فالأفضل في هذه الأحوال أن يكتب الجميع بلغة واحدة، أعني سياق الحكاية وكلامها..”.
وبالرغم مما يبدو في هذا الرأي من وجاهة، فإن من الممكن القول مرة أخرى بأن الصدق الفني والواقعية، واستغلال لهجات الأشخاص في تصوير أفكارهم وأعمالهم وصفاتهم، عوامل تستلزم اللجوء إلى العامية في الحوار، في القصة أو المسرحية وهذا ما يلاحظ عملياً في أعمال كبار الكتاب العالميين كفوكنر؛ وهمنغواي وغيرهما ممن لا يجدون ضيراً في حصول التباين اللغوي بسبب استعمال اللغة الأدبية إلى جانب العامية، رغبة في مراعاة العناصر الفنية التي أشرنا إليها قبل قليل..
وإذا كان هنالك من مسوغ للتردد في قبول فكرة الاستعمال الأدبي للعامية في القصة أو الرواية، فليس من الصحيح ألا يؤخذ بها في المسرحية لاسيما في مجتمع كمجتمعنا، وفي مرحلة كمرحلتنا، حيث تتخذ المسرحية وسيلة فعالة في سبيل التثقيف وإشاعة الوعي والتسلية البريئة، لا من أجل طبقة أو فئات محدودة من المواطنين، بل من أجل أكثرية الشعب الساحقة.
() نشرت في مجلة المثقف 3 (15/ كانون الثاني ـ شباط، 1960) ص ص 6ـ17 وفي مقالات مختارة (بغداد: اتحاد الأدباء العراقيين 1961) ص ص 65 ـ 82. واعيد نشرها في كتاب المؤلف قضايا اللغة العربية المعاصرة(بيروت:دار الغاوون 2011)ص ص7-24.
(1) عمر الدسوقي: في الأدب الحديث (القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، 1950).
(2) ميخائيل نعيمة: الآباء والبنون – (نيويورك: شركة الفنون، 1917)ص ص 6-7.
(3) المصدر نفسه – أو راجع – الغربال – ميخائيل نعيمة –( القاهرة: دار المعارف، طبعة 1951) ص 27.
(4) Hemingway. Green Hills of Africa (N.Y, Perma Books,1954) p. 18.
(5)Summer Ives. “A theory of Literal Dialects” Tulane Studies in English 2: 137-138 1950).
(6) John B. Hoben. “Mark Twain: On the Writer’s Use of Language”
American Speech 31(1956) : 164
(7) محمد مندور: في الميزان الجديد (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1944) ص 36.
(8) حسين مروة: قضايا أدبية (القاهرة: دار الفكر، 1956)ص 47-51.
(9) عبد الملك نوري: “دفاع عن اللهجة العامية” الأسبوع 1: (15 نيسان 953) 20-21.
(10) محمد مندور: قضايا جديدة في أدبنا الحديث –( بيروت: دار الآداب، 1958) 133-139.
(11) محمد تيمور: فن القصص –( القاهرة: مجلة الشرق الجديد، 1945) ص71.
(12) توفيق عواد: “الشعر العامي” المشرق 28 (1930) ص 508.
(13) مارون عبود: “الشعر العامي اللبناني” الآداب – آب (1953).
(14) عباس محمودالعقاد: مشكلات الأدب العصري” الكتاب 12 (1953): 234.
(15) عباس محمودالعقاد : “حرب اللغة” الكتاب 11 (1952): 536.
(16) أنور المعداوي: “الأدب الجديد والأدب القديم” الكتاب 12: 709-710.
(17) طه حسين: خصام ونقد ( بيروت: دار العلم للملايين، 1955)ص191
(18) إبراهيم الأبياري ورضوان إبراهيم: أزمة التعبير الأدبي بين العامية والفصحى (القاهرة: دار الطباعة الحديثة، 1959) ص 68.
(19)H. A. R.Gibb, “Studies in Contemporary Arabic Literature”, Bulletin of the School of Oriental Studies 4 (1928):752
(20) راجع مثلاً: إسحاق موسى الحسيني: أزمة الفكر العربي( بيروت: دار بيروت، 9541،) ص75 .
(21) إبراهيم الأبياري ورضوان إبراهيم: أزمة التعبير الأدبي، ص 7.
(22) إبراهيم عبد القادر المازني: إبراهيم الكاتب( القاهرة: مكتبة مصر، 1945) ص ص 8-9.
(23) من رسالة شخصية بعث بها الدكتور خصباك بتاريخ 20-4-1957
(24) شاكر خصباك: حياة قاسية بغداد ،، منشورات الثقافة الجديدة 1959، ص ص 12-13.
(25) عبد المجيد لطفي في رسالة شخصية مؤرخة في 14/4/1957.
(26) محمود تيمور: الشيخ جمعة وأقاصيص أخرى( القاهرة: المطبعة السلفية، 1927)، ص 15.
* عن
أ. د. صالح جواد الطعمة : اللغة العامية واستعمالها في العمل الأدبي(*)