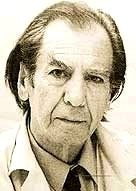عن واحد وثمانين عاما، رحل مساء الثلاثاء 5/11 في هدوء وصمت يليقان بالكبار من أنداده وأضرابه، المفكر والفقيه الدستوري والكاتب المستشار محمد سعيد العشماوي (1932- 2013)، بعد أن ترك لنا ما يربو على الخمسة والثلاثين كتابا وضعها بالعربية والإنجليزية والفرنسية.
رسالة الوجود..تاريخ الوجودية في الفكر البشري..ضمير العصر..حصاد العقل.. أصول الشريعة..جوهر الإسلام..روح العدالة..الإسلام السياسي..الخلافة الإسلامية..العقل في الإسلام..ديوان الأخلاق..إسلاميات وإسرائيليات..حقيقة الحجاب وحجية الحديث..على منصة القضاء.. الإنسانية والكونية.. الأصول المصرية لليهودية …إلخ، و:development of religion, islam and religionô, contre l`inte`grisime islamiste,، وسواها من الأسفار الفريدة التي تفصح عن طراز نادر من الباحثين، بل المقاتلين الأشاوس الذين نهضوا بالتصدي العلمي للجماعات الظلامية وما تبثه من مقولات ومفاهيم مغلوطة تجافي روح العصر والتقدم ومنطقهما؛ معززا الاقتناع الإيديولوجي بأهمية القيم الديمقراطية واحترام الحقوق الرئيسة للإنسان، ولاسيما حقوق كل الأقليات، مؤمنا بأن قوة هذه الأفكار ستكون أمضى من ردود الفعل المناهضة للحداثة كافة؛ مما أدى إلى بسط الحماية الأمنية على منزله منذ يناير1980، حتى وافته المنية.
لهذا لم ينِ يدرس ما وراء دعوة الفقيه الدستوري د.عبد الرزاق السنهوري إلى مبايعة الملك فؤاد خليفة للمسلمين من مغازٍ تكشف عن علاقة المثقف بالسلطة، وطبيعة مشروعه، ومدى تفاعله مع تحديات عصره،أوتصالحه مع مواضعات واقعه الرديء وتأمين مصالحه،على نحو ما جاء في كتابه (السنهوري) الصادر بالفرنسية عام 1928 بعنوان ‘الخلافة الإسلامية’، وما نهض به د.توفيق الشاوي مترجم الكتاب- من حذف لصفحات وفقرات كاملة ؛ حتى يطمس دوره في الترويج والتأييد لهذه البيعة ذات المرامي السياسية الواضحة. كما عمد إلى معالجة اتسمت بنفاذ الرؤية وجِدة التحليل لشخصية ذلك الجلاد غير المسبوق؛ المعروف باسم ‘الحجاج بن يوسف الثقفي’، وما رافق نشأته وتطور حياته من ملابسات وأحداث أوصلته إلى ما وصل إليه، وذلك في كتابه المهم ‘الخلافة الإسلامية’. ومن ثَمَّ، لم يدخر المستشار محمد سعيد العشماوي وسعا في تناول التاريخ الإسلامي بالدراسة النقدية التاريخية، طارحا رهاناته المستقبلية المترتبة على نظرته هذه؛ من حيث الوقوف على محدداته وشرائطه، وإنصافه بوصفه وليد ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية محددة، وعدم الخلط بين الشريعة من ناحية، وبين الفقه والسياسة والتاريخ من ناحية أخرى، أي بين ما هو إلهي.. متعالٍ.. مفارق لنا.. وبين ما هو بشري يقبل الخطأ والصواب، ويتمحور حول النسبي والظرفي والمؤقت؛ مما من شأنه أن يحرِّر العقل، ويفتح باب الاجتهاد على مصاريعه دون تأثيم ولا تجريم.
وقد أفاد الرجل ـ لا ريب- من عمله في سلك القضاء، بعد أن تخرَّج في كلية الحقوق- جامعة القاهرة في السنوات الأولى من الخمسينيات؛ حين كان التعيين في مضمار النيابة العامة يتم بغير وساطة، بل بترتيب التخرج؛ الأسبق فالأسبق، أو الأعلى فمن يليه، ثم استكمل دراساته في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميريكية، ليتولى مناصبه المتعددة: وكيلا للنائب العام، وقاضيا بالمحاكم، ورئيسا للنيابة العامة، ووكيلا عاما للإدارة العامة للتشريع، ومستشارا بمحكمة استئناف القاهرة العليا، فرئيسا لمحكمتي الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا، ومستشارا بالأمم المتحدة؛ فكرَّس حياته للحق والعدالة وألزم نفسه الجادة وكلَّفها الأصول، حريصا على أن ‘يبحث ويدرس ما وراء القول، وما حول الرأي، من أسباب وأسانيد وحجج وأدلة، مهما كان البحث مضنيا، أو كان الدرس مُجهدا’، مرددا دوما حقيقة أن ‘القضاء هو صمام الأمن في أي بلد، وأن القاضي العادل المستقل أفضل من مئات القوانين، وأن العدل، والعدل وحده، أساس الملك’، بعد أن ألفى ‘الوسط القضائي رصينا، متماسكا، صلبا، كُفوا، محترما، يتخاطب ويتعامل أعضاؤه مع بعضهم البعض، في لياقات واضحة، ومراسم محددة، وأصوات خفيضة، واحترام بالغ، لا غيبة ولا نميمة، ولا انفعال ولا افتعال، ولا جنوح إلى اليمين، ولا جموح إلى اليسار، بل إنهم في الوسط دائما، وعلى العدل أبدا’وفق تعبيره.
الأمرالذي أهَّله لممارسة دوره التنويري الذي بدأ منذ عام 1979، ودفع من أجله ثمنا غاليا، مفكرا وقاضيا، أدى بوزارة العدل إلى تغيير اختصاصه واستبعاده من نظر القضايا السياسية، بعد أن نهض بتفريغ بعض القوانين سيئة السمعة الخاصة بتجريم الرأي والفكر من مضمونها، وجعلها حبرا على ورق؛ بحيث لا يعاقب أحد على رأيه إطلاقا، بل رأى أنه إذا حدث اتفاق على العنف، ولم تقع الجريمة، فلا يرتِّب هذا شيئا على أصحابه ؛ما لم يتصل لدى كل متهم على حدة بالاتجاه إلى فرض الرأي بالقوة، وفسِّر الفكر بالعنف، بل أن تحدث القوة بالفعل، وأن يقع العنف في الواقع. فأصبحت هذه النصوص ملغاة بالفعل،لا سبيل إلى تطبيقها، على نحو ما حدث في القضية المعروفة باسم الحزب الشيوعي، رقم 2668 لسنة 1980، قسم عابدين، 52 لسنة 1980، كلي وسط القاهرة، وأفرج عن المتهمين جميعا، بل استفاد من أثر هذا الحكم متهمون آخرون لم يحاكموا أمام هيئة المستشار العشماوي، وكانوا يقضون في السجن العقوبة التي حكم عليهم بها من هيئة أخرى . وهو ما تكرر في قضيتيْن أخرييْن؛ سميت الأولى بالتنظيم الناصري، رقم 2830 لسنة 1986، قسم عابدين، كلي وسط القاهرة؛ فأثار ثائرة الأجهزة الأمنية والسياسية، ودفع المستشار رجاء العربي المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا وقتها إلى أن يحمل على الحكم حملة شعواء، وأن يصف المستشار العشماوي بقاضي البراءة، وهو أمر غير مسبوق منذ أنشئ القضاء عام1883، والأخرى نظر وحاكم فيها أفرادا من الجماعة الإسلامية ومن جماعة الجهاد عام 1984، وبرأهم على الرغم من اختلافه الجِذري مع أفكارهم، وانتقاده الدائم لها وتعقبهم له لقتله ؛ مستندا في حكمه إلى ضعف تحريات الشرطة وعدم اقتناعه بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية وتعذيبهم الوحشي على يد زبانية جهاز أمن الدولة لحملهم قسرا على الاعتراف بما لم يفعلوه، وأثبت أن ما قُدِّم إلى هيئته لا يرقى إلى مستوى الأدلة القانونية التي تدين بريئا؛ مما أغضب بعض ذوي الإربة، فتكاتفت-على حد تعبيره- عصبة راحت تتعقبه للإضرار به وإلحاق الأذى بمصالحه. لكن ‘لجنة المحامين الدولية’ منحته جائزة العام سنة 1994، عن’حكم القانون وحقوق الإنسان’؛ بسبب أحكامه التي لم ترضَ عنها الحكومة، وإن سعى من خلالها إلى تأكيد القانون واحترام الحقوق. ولم يألُ جهدا في الرد على شيخ أسبق للأزهر، في مقال نشره بجريدة ‘الأهالي’- لسان حال حزب التجمع الوطني التقدمي المصري- أصدر فتوى نشرت بمجلة الأزهر تصم الأقباط واليهود بالشرك؛ بناء على طلب من ‘الرابطة الإسلامية’. وما إن قام بتفنيدها، وفضح خطلها، حتى قامت جريدة ‘المسلمون’ السعودية، وجريدتا ‘الأخبار’ و’الشعب’ المصريتان بمهاجمته بمانشيتات مقذعة، تحرِّض على قتله وإهدار دمه. وعندما حاول الدفاع عن نفسه، والرد عليهم، رفضت الصحف جميعها، بما فيها ‘الأهالي’، نشر أي شيء له، أو توضيح وجهة نظره، أو إعطاءه الفرصة لدحض ترهاتهم التي بها يهرفون. وتركوه وحيدا يتلقى الطعنات. فخاطب رئيس الجمهورية طالبا منه التدخل لحمايته، فجرت بينه وبين العاهل السعودي فهد مكالمة أوقفت الحملة الضارية ضده، وحضر هشام حافظ صاحب جريدتي ‘المسلمون’ و’الشرق الأوسط’ إلى منزله معتذرا له، مبديا أسفه لما حدث، مُنْهِيا إليه أنه من قرائه ومن المعجبين بفكره، وأنه يشتري مائتي نسخة من أي مؤلَّف له، ويوزعها على أصدقائه وأصفيائه بنفسه! وفي 7 من يناير 1992، اتجهت لجنة من مجمع البحوث الإسلامية إلى مقر دار سينا للنشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأوقعت التحفظ على خمسة من كتبه هي: أصول الشريعة.. الإسلام السياسي.. الربا والفائدة في الإسلام.. معالم الإسلام.. الخلافة الإسلامية، على الرغم من أن هذه الكتب الخمسة مطروحة في الأسواق منذ فترات تتراوح بين ثلاث عشرة سنة وسنتيْن، وعلى الرغم من أن صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية ليس مصادرة الكتب، ولكن مواجهتها بالتصحيح والرد؛ فالكتاب يرد على الكتاب، والبحث يفنِّد البحث، والمقال يناقش المقال،وهكذا. والطريف أن اللجنة لم تبرز أي قرار بالمصادرة، أو تذكر مضمونه، أو تبيِّن تاريخ صدوره، أو تحدِّد أسبابا له. ورفض وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف ظهوره الدائم في التلفزيون المصري، وكان يلجأ إلى حيلتيْن؛ أولاهما أن يقوم باستضافته وتصويره، ثم يمتنع عن إذاعة ما قال؛ بزعم أن خطأ فنيّا شاب التسجيل، وأدى إلى إتلاف الشريط! والأخرى استضافته بالصدفة، وعلى فترات متباعدة، وفي وقت جِد محدود؛ مما لا يتيح له شيئا يبحثه، ولا موضوعات مهمة يتناولها. وبذلك يجري حصاره داخل دائرة محدودة لا تأثير لها. ومن ثم؛ رفضت جريدة ‘الأهرام’ فتح صفحاتها له باستمرار، وأخيرا سمحوا له بالكتابة في مجلة لا يقرؤها أحد تدعى ‘أكتوبر’، أنشأها الرئيس أنور السادات مجاملة لصديقه أنيس منصور! ثم باغتوه يوما برفع الحماية الأمنية عنه عام 2004 من دون مبرر واضح ؛ سوى إرهابه وجعله أكثر طواعية وليونة؛ فلم يخف.
غير أن تقدير العالم له عوَّضه عن جوْر ذوي القربى وتحيفهم بحقه عالما جليلا يحمل لواء التجديد، فظل ما بقي له من عمر أستاذا محاضرا في أصول الدين والشريعة الإسلامية والقانون المقارن، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي جامعات هارفارد وبرنستون وييل وبراون ويوتا وسواها من جامعات الولايات المتحدة الأميركية، وجامعات السربون بباريس، وبرلين بألمانيا، ومدريد بإسبانيا، والجامعة الإسلامية بالهند…إلخ، وسجل له الكونغرس ونشر في طبعة خاصة كتابه’religion for the future’في يناير 1993. لكن الرجل لم يأبه لما يحدث له، وأعلنها صريحة أن الحكومة بموقفها هذا منه تزايد على الجماعات الإسلامية، وتريد أن تثبت للكافة أنها أكثر إسلاما منها؛ والنتيجة أن التلفزيون منذ سنة 1970حتى الآن، هو الذي أدخل التطرف في كل بيت، بصورة أو بأخرى. وظل فخورا حتى مماته، بأنه لا توجد في تاريخه القضائي، دعوى رد واحدة، أو دعوى مخاصمة.
أجل.. لقد كان المستشار محمد سعيد العشماوي أول مَنْ سكَّ مفهوم الإسلام السياسي، وفرَّق في كتابه ‘الإسلام السياسي’ بين الإسلام البدوي، والإسلام الحضري، بل كان أول من استخدم هذه التسميات والتوصيفات التي شاعت وذاعت بعد ذلك، ودوَّن في كتابه’معالم الإسلام’ أن الإسلام ليس به صراع طبقي، إنما هو صراع حضري، وقد تحدث ‘أرنولد توينبي’عن الإله المصري ‘ست’ إله الشر والصحراء، وهجوم البداوة على الحضارة. بَيْدَ أنه قدَّم تفسيرات أخرى مبثوثة في ثنايا كتبه، ورأى أن العقل الإسلامي ضُرب بسبب الإيديولوجيا، أي إن السياسة عندما تستغل العقيدة، فإنها تحوِّلها إلى إيديولوجيا، وحينما تستعمل الحزبيةُ الشريعةَ، فإنها تبدِّلها إلى تنظيم. وبهذا يتوارى الإيمان وراء المعتقدية الجافة الشمولية، وتحتجب معالم المنهج الديني خلف تنظيم بشري صارم. وكانت نتيجة ما حدث في التاريخ الإسلامي كما يقول المستشار العشماوي- من تحول العقيدة إلى إيديولوجيا، وتبدل الشريعة إلى تنظيم، علني أو سري، أن ضاع جوهر العقيدة، ومَاعَ صميم الشريعة. وقد بدا ذلك واضحا، في نحل الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- خدمة لغرض سياسي، أو دعما لهدف حزبي، وفي اختلاف الروايات لدعم تفسير ديني، أو لوضع مفاهيم دينية، أو لتأييد فرقة معينة، أو لتعضيد شيعة خاصة، وهكذا، وفي تفسير آيات القرآن الكريم في غير المعنى الذي تنزلت فيه، واستخدامه كشعارات سياسية، بعد اقتطاعها من السياق، وتفسيرها على عموم الألفاظ، بعيدا عن أسباب التنزيل؛ مما حجب العقل الإسلامي عن أي استنارة، وكما رآه في محاولة المعتزلة فرض آرائهم وأفكارهم على الناس عندما وصلوا إلى الحكم، وهناك مرسوم صدر من الخليفة المأمون يقضي بعدم تعيين أي إنسان في وظيفة حكومية، ولا تقبل شهادته أمام القاضي، إلا إذا آمن بأن القرآن مخلوق، ولم يقف أمامهم إلا الإمام ‘أحمد بن حنبل’ الذي قال إن القرآن أزلي. وفي عصر المتوكل وصل السلف إلى السلطة؛ فاستبدوا بالمعتزلة، وأوسعوهم ضربا وقتلا، وراحوا يرددون مقولة إن العقل قاصر، وإنه لا يستطيع أن يصل إلى تحسين ولا تقبيح، أي لا يستطيع التمييز بين الخير والشر. وقد أتت فكرة الأزلية هذه، والكلام عن خلق القرآن على حد قوله- من المسيحية، ومن الأبحاث التي تناولت السيد المسيح بوصفه كلمة: وهل الكلمة قديمة.. أزلية، أم إنها مخلوقة؟ وبما أن القرآن كلام الله، فقد واجه المشكلة ذاتها. لهذا أدرك المستشار العشماوي أن الديمقراطية لا تتحمل الإيديولوجيا؛ إذ بمجرد أن تدخل الإيديولوجيا ساحة الديمقراطية تقوم بنفيها، مذكرا بدرس هتلر في انتخابات سنة 1933؛ حيث حصل على 30 ‘ من الأصوات؛ فقال قولته المشهورة: لن نترك الأمة في راحة؛ حتى نصل إلى الحكم. وقام هتلر وحزبه بتنظيم المظاهرات وتدبير الانفجارات، إلى أن قبل رئيس الدولة تعيين هتلر مستشارا له، ثم دسوا لرئيس الدولة السم، وقتلوه؛ فأعان ذلك هتلر على الوصول إلى الحكم. ثم ألغى كل شيء، وسيطر على كل شيء، وأدخل ألمانيا في حرب مع العالم كله ؛ مما أدى إلى قتل الملايين، وخلق لنا مشكلة إسرائيل. وانتهى الأمر بتقسيم ألمانيا التي أصيبت بالذلة والمسكنة. ولذلك لو لم يحكم هتلر ألمانيا، لكانت زعيمة أوروبا منذ زمن بعيد، وهي الآن قاطرة أوروبا. وهنا يورد المستشار العشماوي تجربة علي بلحاج في الجزائر؛ حين خرجت المظاهرات تهتف: تسقط الديمقراطية، وتنادي بالشورى. ونحن نعلم أن الشورى مُعْلِمَة، وليست مُلزمة. الأمر الذي يتيح للحاكم أن يستبد ويبطش. لكن الديمقراطية شيء لا بد منه، وضرورة أساسية للمجتمع المدني.. غير أننا إذا لم نُقمْها على أساس سليم، فسوف تسوء الأمورأكثر مما كانت عليه، وتمسي ديمقراطية مزيفة. وفي هذا السياق، يفرِّق المستشار العشماوي بين الدولة ونظام الحكم، مفضِّلا استخدام كلمة ‘نظام الحكم’بدلا من ‘الدولة’؛ لأن الدولة تشمل البلد كله، ويمكن أن تشمل التاريخ كله، في حين أن نظام الحكم يشمل النظام القائم. لكنه وجد أن جماعات الإسلام السياسي لا تميِّز بين الأشياء، وتطلق على الكل: القانون الوضعي، والنظام الوضعي، بمعنى أن البشر هم الذين وضعوه، في حين أن النظام الآخر وضعه الله سبحانه وتعالى. وقد قال ‘إخوان الصفا’: إن الوضعي في الشريعة هو الأحكام المفصَّلة؛ لأن كلمة وضعي تقابل كلمة فطري. وهناك القانون الفطري، وهو الضمير. أما القانون الوضعي فهو القانون المفصَّل. ورأى الرجل أن الناس يستخدمون كلمة’الوضعية’؛ للتدليل على أن القوانين مختلقة أو بشرية. لهذا عَدَّ التعبير خاطئا؛ لأن لفظ وضعي- في المفهوم العلمي- يعني المحدَّد والمفصَّل، مستشهدا بإخوان الصفا الذين يذهبون إلى أن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وغيرهما هي الشريعة الوضعية، أي الشريعة المُحدَّدة والمُفصَّلة. لذا هناك فرق بين ‘خلافة’و’خالِف’، أي إن هناك فرقا بين شخص يتلو آخر في الزمان، وبين مَنْ يرث حقوقه القانونية وسواها. وشدَّد على أهمية هذه التفرقة، محذرا من تقليل البعض من ضرورتها؛ لأنه يعتقد أن كلمة’خلافة’ أضرت بالعقل الإسلامي، مثل إطلاق بعض الخلفاء على أنفسهم لقب ‘خليفة الله على الأرض’؛ ومن ثم، أدت الخلافة إلى نتائج عكسية.. مؤكدا أن أصحاب الإيديولوجيات، دينية كانت أم قومية، هم الذين يضطلعون بمهمة نفي الآخر، إما عن طريق اتهام الآخر بالكفر، من خلال ما يسمى ب’اغتيال الشخصية’، وإما عن طريق التحريض على القتل. وأضاف أن الدولة العثمانية سلكت طريق الغزو؛ فانتصرت لمدة قرن.. ثم ذُلت وأُهينت لمدة قرنيْن.. وأن كل مسلمي أوروبا يدفعون الثمن الآن؛ لأن أوروبا تخشى أن يطالبوا ب’بلغاريا’، والأندلس وسواهما.. وأننا الآن ندفع فاتورة الدولة العثمانية التي أسهمت في تأخير العالم العربي، وتدهورأحواله؛ مما أدى إلى بزوغ حركة القومية العربية للرد على الظلم الذي حاق بنا على يد الأتراك. ونوَّه بأن السيد جمال الدين الأفغاني هو الذي أدخل الإسلام السياسي في العصر الحديث، ثم انقسم إلى مدرستيْن: مدرسة الشيخ محمد عبده، ومدرسة الشيخ رشيد رضا.غير أن الشيخ محمد عبده، عندما أصبح مفتيا، صار عالما؛ يفكر بهدوء ورويَّة، وقطع صلته بالسياسة. وهو رجل له فتاوى كثيرة متقدمة ومستنيرة. بَيْدَ أنه- من وجهة نظره- كان يفتقد العقلية التنظيرية، أي إنه لم يستطع وضع نظريات. أما المدرسة الأخرى التي تزعمها الشيخ رشيد رضا، فقد جلبت علينا الكوارث والمآسي؛ لأنه- على حد تعبيره- هو الذي قلب الحركة الإسلامية، ثم وجَّهها صوب السعودية. وقد تربى ‘حسن البنا’ في مدرسته، وتلقى تعاليمه الأساس منها. غير أن من آثار الشمولية التي يحذرنا منها المستشار العشماوي، أي خلط الدين بالسياسة، ضرب العقل الإسلامي، كما حدث في الفتنة الكبرى، وفي القرن الخامس الهجري إلى الآن.. وكان صاحب الضربة القاضية للعقل ‘أبو حامد الغزَّالي’، وهو أشعري ..كان لا يني يردد: أكثر نظر الخلق مقصور على الأسباب القريبة السافلة، مقطوع عن الترقي إلى سبب الأسباب’، أي إن الإنسان لا يأتي أي فعل، وما يتصوره من أن الماء قد أحدث البلل، أو أن عود الثقاب قد أحدث النار، توهم لا غير. مع أن القرآن كله مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والدعوة إلى التفكير والتدبر. وهكذا ظللنا معلقين خارج نطاق الزمان. لذا لن يتاح للمسلمين- وفق رأيه- الدخول في اللحظة التاريخية، إلا إذا فهموا أن الوجود حركة في التاريخ، وأن مفهوم الحركة والسكون- بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى- إنما هو مفهوم قديم، وأن العقل وصل الآن، وسوف يصل، إلى مفاهيم صحيحة.. وأن الزمان- وفقا لنظرية أينشتين- دائري، كل نقطة فيه تصلح لأن تكون بداية ونهاية. ومن ثم؛ تكون هي الأبد، وهي الأزل، وهي الماضي، وهي الحاضر، وهي المستقبل.. مضيفا أن هذا فهم جديد لا بد أن نعيه؛ حتى يتيسر لنا الخروج من السجن الذي نعيش فيه، وندخل التاريخ.. بدلا من أن يكون شغلنا الشاغل فقط اعتبار سوانا كفارا، لا عمل لهم إلا خدمتنا فحسب، ناسين أن مَنْ يخدمني، سيدافع عني، ومَنْ يدافع عني سيستعبدني، وهكذا دواليك. وخلص المستشار العشماوي من هذا كله، إلى أن المرجعية الإسلامية المنشودة التي لا علاقة لها بالتاريخ الإسلامي، ولا برأي أصحاب الإسلام السياسي، تكمن في قوله تعالى: ‘الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا’. وبذلك تتحدد المرجعية الإسلامية التي نبتغيها في الأخلاق، والإيمان بالله، واحترام العقل، والتسامح مع الناس جميعا، وإعلاء إنسانية الإنسان، وعدم العدوان على الغير، وكل المعاني الكريمة. ولذا يتعين ـ كما يقول- أن تكون مملكة الدين هي القلب والأخلاقيات فحسب، ولا تتعداهما إلى سواه من شؤون العلم وحقوله. لكن الإسلام السياسي،للأسف، مازال متعلقا بالخلافة، حاصرا الإسلام في النظام السياسي، أو التنظيم الحزبي، غير قادر على تفهم قيمة العقل، وأهميته في حياتنا،عادّا إياه’العقل’وسوسة شيطان! وهنا يتساءل: لكن منذ متى بدأ الإسلام السياسي في العصر الحديث؟ يقول: إذا عدنا إلى الوراء، فسنجد أن ‘محمد علي’ بعد توليه السلطة، نُصح من قِبل مستشاريه الفرنسيين، بإقامة نظام حكم مدني (وأنا أفضِّل- في الحقيقة- كلمة ‘حكم مدني’، بدلا من كلمة’حكم عَلماني’)؛ لأنه لو أنشأ حكومة دينية لجعل للسلطان العثماني شرعية لتدخله الدائم في شؤون مصر، فضلا عن أن تركيبة مصر قسمة موزعة بين المسلمين والمسيحيين؛ الأمر الذي لا تستوعبه الدولة المسماة بالدينية، ويجد التعبير الأنقى عنه في دولة عصرية يتعايش فيها الجميع على قدم المساواة.. كما أن لدى مصر اتصالا دائما بأوروبا وأثينا وإيطاليا.وهذه هي فكرة ‘طه حسين’ في كتابه المعروف ‘مستقبل الثقافة في مصر’؛ حيث رأى أن التفات مصر إنما يجب أن يكون لأوروبا. ثم يُضيف قائلا: وفي كتابي ‘ديوان الأخلاق’ أثبت أن كل الحضارة الإغريقية نُقول من المصرية. ف’هوميروس’، مثلا، مصري، واسمه إما تأغرق، وإما أخذ اسما إغريقيّا في مصر، على نحو ما شرحته في كتابي هذا. وأرجو ألَّا يفهم من كلامي هذا، أنه محاولة للتضخيم من كياننا المصري، ولكنه اتجاه أصيل لديَّ لربط كل حلقات التاريخ بعضها ببعض، بذات الدرجة التي أعمل من خلالها، على الربط بين كل العقائد؛ باعتبارها جاءت جميعها من الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، وتكوين جماعة إنسانية، قِبلتها الله، ومحورها الإنسان. غير أن المستشار العشماوي يرى أن إنجلترا انزعجت من المقاومة المصرية للاحتلال، فراحت تبحث عن وسيلة تواجهها بها. وحدث أن عقد في عام 1908مؤتمر للخلافة الإسلامية في مصر، فكان أول مَنْ دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن تكون الخلافة في بلد عربي، هو السير ‘ألفريد سكاون بلنت’ مؤلف كتاب’التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر’ وصديق الزعيم أحمد عرابي والشيخ محمد عبده، وفق ما جاء في كتابه ‘الخلافة الإسلامية’. ومن ثم؛ كان هناك اتجاه بريطاني كما يقول- لاستخدام الشريعة الإسلامية على نحو ما، خلافا لما فعله محمد علي الذي أخذ بنصيحة المستشارين الفرنسيين، بينما كان لإنجلترا اتجاه آخر. وفي سنة 1928، تلقفت’جماعة الإخوان المسلمين’ في الإسماعيلية هذه الدعوة وتبنتها. لهذا يرى المستشار العشماوي أن ما أريد إرساؤه في مصر، ليس قيام دولة إسلامية؛ حتى يقال إن هناك نظاما إسلاميّا، في مواجهة نظام وضعي ؛ فهذا كلام غير صحيح؛ لأن الجميع إسلاميون.غير أن الحادث الآن، هو وجود نظام كهنوتي.. شمولي، وآخر مدني، وكلاهما مرجعيته إسلامية. وإذا نظرنا إلى الإسلام على أنه الإيمان بالله، وبالأخلاقيات الكريمة، وبالإنسانيات الرفيعة، وبالحقوق، والمساواة بين المرأة والرجل…و…إلخ، فإننا نقدم الإسلام المستنير. لكن انظرْ إلى جماعات الإسلام السياسي التي تطالب بتطبيق الشريعة، تجدْ أنها لم تدرس القانون.لأن القانون المدني المصري يمكن تخريجه على قواعد الفقه الإسلامي بأكمله، بمعنى أن كل مادة في القانون المدني، يمكن أن نجد أصلا لها في الفقه الإسلامي. ومن ثم، نرى أن الباقي لا يتعدى- في مجمله- أربعة حدود هي: حد قطع اليد.. وحد قذف المحصنات.. وحد الجلد للزنا.. وحد الحرابة (أي قطع الطريق). ويفسر لنا المستهدف من دعوتهم هذه، بأنها أتت لضرب النظام القانوني المصري بدعوى أنه مستمد من القانون الفرنسي. ألم نأخذ من أوروبا وسائل الحياة المادية الحديثة ؟ ولِمَ نقف عند الجزئية السابقة فقط دون غيرها؟ ثم يتزيد بعضهم فيقول: إن القانون المدني هو أحكام الفقه المالكي، تسربت من إسبانيا إلى فرنسا!
وبذلك وضعوا الشريعة أمام القانون، ووضعوا الأمة أمام الدولة، ولاحظوا أن الأمة هنا تعبير مهذب عن القبيلة، في حين أن الدولة نظام قانوني ينبني على دستور وقوانين ومؤسسات. وخطورة هذا الكلام تجيء- في رأيه- من أن تفكيك نظام الدولة من أجل أن تقول لي إنك واحد من أفراد الأمة الإسلامية كلها، يعطيك مبررا لأن تحارب في أفغانستان، ثم تأتي بالأفغان والإيرانيين إلى هنا؛ بحجة محاربة اليهود، في الوقت الذي يُمنع فيه المصري من محاربة إسرائيل نكاية في الدولة المصرية التي يرفض أن يدفع لها الضرائب، أو أن يحارب عدوها، أو أن يدافع عن الروابط التي تشده إلى أخيه المصري، أو أن يذود عن ولائه لبلده الذي وقر في ذهنه أنه مجرد طين وأرض، أو أن يخامره الإحساس بقيمة الانتماء إلى تاريخه الذي يرى أن تراثه الفرعوني، مثلا، ليس إلا محض أوثان؛ لذا هو غير مستعد للدفاع عنها لحساب الأجانب المهتمين بها! وهذا الكلام في حقيقته- من الإسرائيليات التي سبق للمستشار العشماوي أن تناوله في سلسلة مقالات ضمها كتاب له بعنوان ‘إسلاميات وإسرائيليات’. لذا يرى المستشار العشماوي أن الإسلام السياسي دائم إظهار العداوة للعالم، وإعلان المواجهة مع الجميع، مع أنه لا يملك أسباب الحرب الحديثة ومقوماتها ولا يعرف تقنيتها، بل يعارض الحضارة العالمية ويرفض نقل التقنية بزعم أن ذلك غزو فكري، وكل ما يرفعه عبارة غامضة غير محددة هي ‘المشروع الإسلامي’. وهو تعبير ظهر أصلا في الغرب لدى بعض الكتَّاب المستشرقين وغيرهم؛ قصد التدليل على أن العالم الإسلامي لا يسير ولن يسير في طريق الحضارة العالمية؛ لأن له مشروعا يخالف ويضاد المشروع الحضاري العالمي. ويضيف: أي إن تعبير ‘المشروع الإسلامي’ يؤكد ويكرِّس فكرة العزل والتفريق بين الشرق والغرب، وهو ترديد معاصر لمقولة رديارد كبلنج القديمة من أن الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا. لهذا نذر نفسه لمحاربة الأفكار المنحرفة التي تنهض على الأقوال المرسلة، والآراء المطلقة، والأحاديث الضعيفة، والأحكام الشاردة، داعيا إلى ‘إعادة دراسة الأحاديث’السنة’ المروية عن النبي- صلى الله عليه وسلَّم- دراسة تقوم على أسس علمية راسخة، وتنبني على منهج نقدي فحصي سليم، وتستوي على فهم متكامل شامل. وبغير ذلك، فسوف يظل الهرم مقلوبا، والصورة سالبة’، محذرا دوما من’اختلاط التراث الشعبي بالمفهوم الديني، وأن تتداخل العادات الاجتماعية في التحديد الشرعي ؛ إذ مؤدى ذلك-إن حدث- أن يضطرب المفهوم الديني، وأن يهتز الميزان الشرعي، فيدخل على هذا وذاك، ما ليس منه وما هو غريب عنه؛ وبذلك يصبح التراث الشعبي مفهوما دينيّا على غير الحق، وتصير العادات الاجتماعية أوضاعا شرعية دون أي أساس، ويغيم الأمر لدى الناس فلا يستطيعون تمييز الديني من الموروث الشعبي، ولا يقدرون على استبانة العادات الجارية من الحكم الشرعي؛ وهو أمر يسيء إلى الدين أيما إساءة’. وضرب لنا مثلا على ذلك بمسألة الحجاب؛ حيث ذهبت جماعات إلى أن ‘الحجاب فريضة إسلامية’، كان منها فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية عام1994الذي لخَّص رأيه بقوله:’ وإن كل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما أمر الله تعالى بستره مهما كان شأنها ومهما كانت صفتها هي آثمة وعاصية لله تعالى، وأمرها بعد ذلك مفوَّض إليه- سبحانه- وحده’، بينما رأى آخرون أن ‘الحجاب شعار سياسي’، وكان من أنصار هذا الرأي المستشار محمد سعيد العشماوي الذي دخل في سجال مع المفتي على صفحات مجلة ‘روز اليوسف’ حول هذا الموضوع عام 1994، انتهى فيه إلى أن ‘ما يسمى بالحجاب حالا’حاليا’- وهو وضع غطاء على الرأس، غالبا مع وضع المساحيق والأصباغ- ليس فرضا دينيّا، لكنه عادة اجتماعية، لا يدعو الأخذ بها أو الكف عنها إلى إيمان أو تكفير، مادام الأصل القائم هو الاحتشام والعفة’. الأمر الذي دفع المستشار العشماوي إلى تحرير المصطلحات ‘أو ضبطها، واتباع منهجية واضحة ونظامية مطردة’ حتى يخلص إلى ‘أقرب الآراء إلى الصحة وأدناها إلى الصواب حتى لو خالفت المألوف وعارضت المعروف’.. لكن المشكلة الحقيقية لديه ‘ليست في الوصول إلى الصواب ولا في الحديث على مقتضاه، وإنما في الرفض المسبق من القارئ أو السامع لقبول الرأي الآخر أو السماح بأي كلمة تهدد فكره المغلوط أو تقوِّض رأيه المخطئ أو تفكِّك حماسته للأوهام. ومع كل ذلك، فإن القافلة لا بد أن تسير؛ لأن العواء سوف يخفت ثم يصمت أمام قوة الحق وقدرة الصدق’. لهذا لم يلتفت وراءه قط، وظلت عينه دائما على المستقبل، لا يبغي ولا يروم سوى إنشاء مجتمع مدني، يكون فيه الدين فعَّالا؛ من حيث عناصره الأساس والجوهرية فقط، مثل عبادة الله سبحانه وتعالى، واحترام آدمية الناس مهما اختلفت عقائدهم، وحريتهم في اختبار عقائدهم بعقولهم؛ لتصفيتها من اللغو الذي شابها، وأدى إلى منع تقدم الأمة الإسلامية ولايزال. فنحن- حسب تعبيره- لا ننقد الماضي، وإنما نحن نفكك هذه الأفكار الخاطئة؛ لكي نعيد بناء المجتمع الإنساني بصورة صحيحة بحيث يكون العقل هو الأساس، ويكون الخلق دافعا رئيسا، ويكون الإيمان بالله – سبحانه وتعالى – إيمانا صافيا، وننكر تماما كل الدعاوى التي تخلط الدين بالسياسة، أو التي تريد أن تضرب علينا الجهالة، وتمنع مصرنا من أن تأخذ مكانها اللائق بها بمفهوم إنساني وعلمي.
ورحم الله شاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري إذ يقول:
أجللتُ فيك من الميزات خالدةَ = حريةَ الفكر والحرمانَ والغضبا
مجموعة قد وجدناهنَّ مفردة = لدى سواك فما أغنيننا أربا
جيش من المثل الدنيا يَمُدُّ به = ذوو المواهب جيشَ القوة اللَّجبا
*كاتب وناقد من مصر
رسالة الوجود..تاريخ الوجودية في الفكر البشري..ضمير العصر..حصاد العقل.. أصول الشريعة..جوهر الإسلام..روح العدالة..الإسلام السياسي..الخلافة الإسلامية..العقل في الإسلام..ديوان الأخلاق..إسلاميات وإسرائيليات..حقيقة الحجاب وحجية الحديث..على منصة القضاء.. الإنسانية والكونية.. الأصول المصرية لليهودية …إلخ، و:development of religion, islam and religionô, contre l`inte`grisime islamiste,، وسواها من الأسفار الفريدة التي تفصح عن طراز نادر من الباحثين، بل المقاتلين الأشاوس الذين نهضوا بالتصدي العلمي للجماعات الظلامية وما تبثه من مقولات ومفاهيم مغلوطة تجافي روح العصر والتقدم ومنطقهما؛ معززا الاقتناع الإيديولوجي بأهمية القيم الديمقراطية واحترام الحقوق الرئيسة للإنسان، ولاسيما حقوق كل الأقليات، مؤمنا بأن قوة هذه الأفكار ستكون أمضى من ردود الفعل المناهضة للحداثة كافة؛ مما أدى إلى بسط الحماية الأمنية على منزله منذ يناير1980، حتى وافته المنية.
لهذا لم ينِ يدرس ما وراء دعوة الفقيه الدستوري د.عبد الرزاق السنهوري إلى مبايعة الملك فؤاد خليفة للمسلمين من مغازٍ تكشف عن علاقة المثقف بالسلطة، وطبيعة مشروعه، ومدى تفاعله مع تحديات عصره،أوتصالحه مع مواضعات واقعه الرديء وتأمين مصالحه،على نحو ما جاء في كتابه (السنهوري) الصادر بالفرنسية عام 1928 بعنوان ‘الخلافة الإسلامية’، وما نهض به د.توفيق الشاوي مترجم الكتاب- من حذف لصفحات وفقرات كاملة ؛ حتى يطمس دوره في الترويج والتأييد لهذه البيعة ذات المرامي السياسية الواضحة. كما عمد إلى معالجة اتسمت بنفاذ الرؤية وجِدة التحليل لشخصية ذلك الجلاد غير المسبوق؛ المعروف باسم ‘الحجاج بن يوسف الثقفي’، وما رافق نشأته وتطور حياته من ملابسات وأحداث أوصلته إلى ما وصل إليه، وذلك في كتابه المهم ‘الخلافة الإسلامية’. ومن ثَمَّ، لم يدخر المستشار محمد سعيد العشماوي وسعا في تناول التاريخ الإسلامي بالدراسة النقدية التاريخية، طارحا رهاناته المستقبلية المترتبة على نظرته هذه؛ من حيث الوقوف على محدداته وشرائطه، وإنصافه بوصفه وليد ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية محددة، وعدم الخلط بين الشريعة من ناحية، وبين الفقه والسياسة والتاريخ من ناحية أخرى، أي بين ما هو إلهي.. متعالٍ.. مفارق لنا.. وبين ما هو بشري يقبل الخطأ والصواب، ويتمحور حول النسبي والظرفي والمؤقت؛ مما من شأنه أن يحرِّر العقل، ويفتح باب الاجتهاد على مصاريعه دون تأثيم ولا تجريم.
وقد أفاد الرجل ـ لا ريب- من عمله في سلك القضاء، بعد أن تخرَّج في كلية الحقوق- جامعة القاهرة في السنوات الأولى من الخمسينيات؛ حين كان التعيين في مضمار النيابة العامة يتم بغير وساطة، بل بترتيب التخرج؛ الأسبق فالأسبق، أو الأعلى فمن يليه، ثم استكمل دراساته في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميريكية، ليتولى مناصبه المتعددة: وكيلا للنائب العام، وقاضيا بالمحاكم، ورئيسا للنيابة العامة، ووكيلا عاما للإدارة العامة للتشريع، ومستشارا بمحكمة استئناف القاهرة العليا، فرئيسا لمحكمتي الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا، ومستشارا بالأمم المتحدة؛ فكرَّس حياته للحق والعدالة وألزم نفسه الجادة وكلَّفها الأصول، حريصا على أن ‘يبحث ويدرس ما وراء القول، وما حول الرأي، من أسباب وأسانيد وحجج وأدلة، مهما كان البحث مضنيا، أو كان الدرس مُجهدا’، مرددا دوما حقيقة أن ‘القضاء هو صمام الأمن في أي بلد، وأن القاضي العادل المستقل أفضل من مئات القوانين، وأن العدل، والعدل وحده، أساس الملك’، بعد أن ألفى ‘الوسط القضائي رصينا، متماسكا، صلبا، كُفوا، محترما، يتخاطب ويتعامل أعضاؤه مع بعضهم البعض، في لياقات واضحة، ومراسم محددة، وأصوات خفيضة، واحترام بالغ، لا غيبة ولا نميمة، ولا انفعال ولا افتعال، ولا جنوح إلى اليمين، ولا جموح إلى اليسار، بل إنهم في الوسط دائما، وعلى العدل أبدا’وفق تعبيره.
الأمرالذي أهَّله لممارسة دوره التنويري الذي بدأ منذ عام 1979، ودفع من أجله ثمنا غاليا، مفكرا وقاضيا، أدى بوزارة العدل إلى تغيير اختصاصه واستبعاده من نظر القضايا السياسية، بعد أن نهض بتفريغ بعض القوانين سيئة السمعة الخاصة بتجريم الرأي والفكر من مضمونها، وجعلها حبرا على ورق؛ بحيث لا يعاقب أحد على رأيه إطلاقا، بل رأى أنه إذا حدث اتفاق على العنف، ولم تقع الجريمة، فلا يرتِّب هذا شيئا على أصحابه ؛ما لم يتصل لدى كل متهم على حدة بالاتجاه إلى فرض الرأي بالقوة، وفسِّر الفكر بالعنف، بل أن تحدث القوة بالفعل، وأن يقع العنف في الواقع. فأصبحت هذه النصوص ملغاة بالفعل،لا سبيل إلى تطبيقها، على نحو ما حدث في القضية المعروفة باسم الحزب الشيوعي، رقم 2668 لسنة 1980، قسم عابدين، 52 لسنة 1980، كلي وسط القاهرة، وأفرج عن المتهمين جميعا، بل استفاد من أثر هذا الحكم متهمون آخرون لم يحاكموا أمام هيئة المستشار العشماوي، وكانوا يقضون في السجن العقوبة التي حكم عليهم بها من هيئة أخرى . وهو ما تكرر في قضيتيْن أخرييْن؛ سميت الأولى بالتنظيم الناصري، رقم 2830 لسنة 1986، قسم عابدين، كلي وسط القاهرة؛ فأثار ثائرة الأجهزة الأمنية والسياسية، ودفع المستشار رجاء العربي المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا وقتها إلى أن يحمل على الحكم حملة شعواء، وأن يصف المستشار العشماوي بقاضي البراءة، وهو أمر غير مسبوق منذ أنشئ القضاء عام1883، والأخرى نظر وحاكم فيها أفرادا من الجماعة الإسلامية ومن جماعة الجهاد عام 1984، وبرأهم على الرغم من اختلافه الجِذري مع أفكارهم، وانتقاده الدائم لها وتعقبهم له لقتله ؛ مستندا في حكمه إلى ضعف تحريات الشرطة وعدم اقتناعه بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية وتعذيبهم الوحشي على يد زبانية جهاز أمن الدولة لحملهم قسرا على الاعتراف بما لم يفعلوه، وأثبت أن ما قُدِّم إلى هيئته لا يرقى إلى مستوى الأدلة القانونية التي تدين بريئا؛ مما أغضب بعض ذوي الإربة، فتكاتفت-على حد تعبيره- عصبة راحت تتعقبه للإضرار به وإلحاق الأذى بمصالحه. لكن ‘لجنة المحامين الدولية’ منحته جائزة العام سنة 1994، عن’حكم القانون وحقوق الإنسان’؛ بسبب أحكامه التي لم ترضَ عنها الحكومة، وإن سعى من خلالها إلى تأكيد القانون واحترام الحقوق. ولم يألُ جهدا في الرد على شيخ أسبق للأزهر، في مقال نشره بجريدة ‘الأهالي’- لسان حال حزب التجمع الوطني التقدمي المصري- أصدر فتوى نشرت بمجلة الأزهر تصم الأقباط واليهود بالشرك؛ بناء على طلب من ‘الرابطة الإسلامية’. وما إن قام بتفنيدها، وفضح خطلها، حتى قامت جريدة ‘المسلمون’ السعودية، وجريدتا ‘الأخبار’ و’الشعب’ المصريتان بمهاجمته بمانشيتات مقذعة، تحرِّض على قتله وإهدار دمه. وعندما حاول الدفاع عن نفسه، والرد عليهم، رفضت الصحف جميعها، بما فيها ‘الأهالي’، نشر أي شيء له، أو توضيح وجهة نظره، أو إعطاءه الفرصة لدحض ترهاتهم التي بها يهرفون. وتركوه وحيدا يتلقى الطعنات. فخاطب رئيس الجمهورية طالبا منه التدخل لحمايته، فجرت بينه وبين العاهل السعودي فهد مكالمة أوقفت الحملة الضارية ضده، وحضر هشام حافظ صاحب جريدتي ‘المسلمون’ و’الشرق الأوسط’ إلى منزله معتذرا له، مبديا أسفه لما حدث، مُنْهِيا إليه أنه من قرائه ومن المعجبين بفكره، وأنه يشتري مائتي نسخة من أي مؤلَّف له، ويوزعها على أصدقائه وأصفيائه بنفسه! وفي 7 من يناير 1992، اتجهت لجنة من مجمع البحوث الإسلامية إلى مقر دار سينا للنشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأوقعت التحفظ على خمسة من كتبه هي: أصول الشريعة.. الإسلام السياسي.. الربا والفائدة في الإسلام.. معالم الإسلام.. الخلافة الإسلامية، على الرغم من أن هذه الكتب الخمسة مطروحة في الأسواق منذ فترات تتراوح بين ثلاث عشرة سنة وسنتيْن، وعلى الرغم من أن صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية ليس مصادرة الكتب، ولكن مواجهتها بالتصحيح والرد؛ فالكتاب يرد على الكتاب، والبحث يفنِّد البحث، والمقال يناقش المقال،وهكذا. والطريف أن اللجنة لم تبرز أي قرار بالمصادرة، أو تذكر مضمونه، أو تبيِّن تاريخ صدوره، أو تحدِّد أسبابا له. ورفض وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف ظهوره الدائم في التلفزيون المصري، وكان يلجأ إلى حيلتيْن؛ أولاهما أن يقوم باستضافته وتصويره، ثم يمتنع عن إذاعة ما قال؛ بزعم أن خطأ فنيّا شاب التسجيل، وأدى إلى إتلاف الشريط! والأخرى استضافته بالصدفة، وعلى فترات متباعدة، وفي وقت جِد محدود؛ مما لا يتيح له شيئا يبحثه، ولا موضوعات مهمة يتناولها. وبذلك يجري حصاره داخل دائرة محدودة لا تأثير لها. ومن ثم؛ رفضت جريدة ‘الأهرام’ فتح صفحاتها له باستمرار، وأخيرا سمحوا له بالكتابة في مجلة لا يقرؤها أحد تدعى ‘أكتوبر’، أنشأها الرئيس أنور السادات مجاملة لصديقه أنيس منصور! ثم باغتوه يوما برفع الحماية الأمنية عنه عام 2004 من دون مبرر واضح ؛ سوى إرهابه وجعله أكثر طواعية وليونة؛ فلم يخف.
غير أن تقدير العالم له عوَّضه عن جوْر ذوي القربى وتحيفهم بحقه عالما جليلا يحمل لواء التجديد، فظل ما بقي له من عمر أستاذا محاضرا في أصول الدين والشريعة الإسلامية والقانون المقارن، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي جامعات هارفارد وبرنستون وييل وبراون ويوتا وسواها من جامعات الولايات المتحدة الأميركية، وجامعات السربون بباريس، وبرلين بألمانيا، ومدريد بإسبانيا، والجامعة الإسلامية بالهند…إلخ، وسجل له الكونغرس ونشر في طبعة خاصة كتابه’religion for the future’في يناير 1993. لكن الرجل لم يأبه لما يحدث له، وأعلنها صريحة أن الحكومة بموقفها هذا منه تزايد على الجماعات الإسلامية، وتريد أن تثبت للكافة أنها أكثر إسلاما منها؛ والنتيجة أن التلفزيون منذ سنة 1970حتى الآن، هو الذي أدخل التطرف في كل بيت، بصورة أو بأخرى. وظل فخورا حتى مماته، بأنه لا توجد في تاريخه القضائي، دعوى رد واحدة، أو دعوى مخاصمة.
أجل.. لقد كان المستشار محمد سعيد العشماوي أول مَنْ سكَّ مفهوم الإسلام السياسي، وفرَّق في كتابه ‘الإسلام السياسي’ بين الإسلام البدوي، والإسلام الحضري، بل كان أول من استخدم هذه التسميات والتوصيفات التي شاعت وذاعت بعد ذلك، ودوَّن في كتابه’معالم الإسلام’ أن الإسلام ليس به صراع طبقي، إنما هو صراع حضري، وقد تحدث ‘أرنولد توينبي’عن الإله المصري ‘ست’ إله الشر والصحراء، وهجوم البداوة على الحضارة. بَيْدَ أنه قدَّم تفسيرات أخرى مبثوثة في ثنايا كتبه، ورأى أن العقل الإسلامي ضُرب بسبب الإيديولوجيا، أي إن السياسة عندما تستغل العقيدة، فإنها تحوِّلها إلى إيديولوجيا، وحينما تستعمل الحزبيةُ الشريعةَ، فإنها تبدِّلها إلى تنظيم. وبهذا يتوارى الإيمان وراء المعتقدية الجافة الشمولية، وتحتجب معالم المنهج الديني خلف تنظيم بشري صارم. وكانت نتيجة ما حدث في التاريخ الإسلامي كما يقول المستشار العشماوي- من تحول العقيدة إلى إيديولوجيا، وتبدل الشريعة إلى تنظيم، علني أو سري، أن ضاع جوهر العقيدة، ومَاعَ صميم الشريعة. وقد بدا ذلك واضحا، في نحل الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- خدمة لغرض سياسي، أو دعما لهدف حزبي، وفي اختلاف الروايات لدعم تفسير ديني، أو لوضع مفاهيم دينية، أو لتأييد فرقة معينة، أو لتعضيد شيعة خاصة، وهكذا، وفي تفسير آيات القرآن الكريم في غير المعنى الذي تنزلت فيه، واستخدامه كشعارات سياسية، بعد اقتطاعها من السياق، وتفسيرها على عموم الألفاظ، بعيدا عن أسباب التنزيل؛ مما حجب العقل الإسلامي عن أي استنارة، وكما رآه في محاولة المعتزلة فرض آرائهم وأفكارهم على الناس عندما وصلوا إلى الحكم، وهناك مرسوم صدر من الخليفة المأمون يقضي بعدم تعيين أي إنسان في وظيفة حكومية، ولا تقبل شهادته أمام القاضي، إلا إذا آمن بأن القرآن مخلوق، ولم يقف أمامهم إلا الإمام ‘أحمد بن حنبل’ الذي قال إن القرآن أزلي. وفي عصر المتوكل وصل السلف إلى السلطة؛ فاستبدوا بالمعتزلة، وأوسعوهم ضربا وقتلا، وراحوا يرددون مقولة إن العقل قاصر، وإنه لا يستطيع أن يصل إلى تحسين ولا تقبيح، أي لا يستطيع التمييز بين الخير والشر. وقد أتت فكرة الأزلية هذه، والكلام عن خلق القرآن على حد قوله- من المسيحية، ومن الأبحاث التي تناولت السيد المسيح بوصفه كلمة: وهل الكلمة قديمة.. أزلية، أم إنها مخلوقة؟ وبما أن القرآن كلام الله، فقد واجه المشكلة ذاتها. لهذا أدرك المستشار العشماوي أن الديمقراطية لا تتحمل الإيديولوجيا؛ إذ بمجرد أن تدخل الإيديولوجيا ساحة الديمقراطية تقوم بنفيها، مذكرا بدرس هتلر في انتخابات سنة 1933؛ حيث حصل على 30 ‘ من الأصوات؛ فقال قولته المشهورة: لن نترك الأمة في راحة؛ حتى نصل إلى الحكم. وقام هتلر وحزبه بتنظيم المظاهرات وتدبير الانفجارات، إلى أن قبل رئيس الدولة تعيين هتلر مستشارا له، ثم دسوا لرئيس الدولة السم، وقتلوه؛ فأعان ذلك هتلر على الوصول إلى الحكم. ثم ألغى كل شيء، وسيطر على كل شيء، وأدخل ألمانيا في حرب مع العالم كله ؛ مما أدى إلى قتل الملايين، وخلق لنا مشكلة إسرائيل. وانتهى الأمر بتقسيم ألمانيا التي أصيبت بالذلة والمسكنة. ولذلك لو لم يحكم هتلر ألمانيا، لكانت زعيمة أوروبا منذ زمن بعيد، وهي الآن قاطرة أوروبا. وهنا يورد المستشار العشماوي تجربة علي بلحاج في الجزائر؛ حين خرجت المظاهرات تهتف: تسقط الديمقراطية، وتنادي بالشورى. ونحن نعلم أن الشورى مُعْلِمَة، وليست مُلزمة. الأمر الذي يتيح للحاكم أن يستبد ويبطش. لكن الديمقراطية شيء لا بد منه، وضرورة أساسية للمجتمع المدني.. غير أننا إذا لم نُقمْها على أساس سليم، فسوف تسوء الأمورأكثر مما كانت عليه، وتمسي ديمقراطية مزيفة. وفي هذا السياق، يفرِّق المستشار العشماوي بين الدولة ونظام الحكم، مفضِّلا استخدام كلمة ‘نظام الحكم’بدلا من ‘الدولة’؛ لأن الدولة تشمل البلد كله، ويمكن أن تشمل التاريخ كله، في حين أن نظام الحكم يشمل النظام القائم. لكنه وجد أن جماعات الإسلام السياسي لا تميِّز بين الأشياء، وتطلق على الكل: القانون الوضعي، والنظام الوضعي، بمعنى أن البشر هم الذين وضعوه، في حين أن النظام الآخر وضعه الله سبحانه وتعالى. وقد قال ‘إخوان الصفا’: إن الوضعي في الشريعة هو الأحكام المفصَّلة؛ لأن كلمة وضعي تقابل كلمة فطري. وهناك القانون الفطري، وهو الضمير. أما القانون الوضعي فهو القانون المفصَّل. ورأى الرجل أن الناس يستخدمون كلمة’الوضعية’؛ للتدليل على أن القوانين مختلقة أو بشرية. لهذا عَدَّ التعبير خاطئا؛ لأن لفظ وضعي- في المفهوم العلمي- يعني المحدَّد والمفصَّل، مستشهدا بإخوان الصفا الذين يذهبون إلى أن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وغيرهما هي الشريعة الوضعية، أي الشريعة المُحدَّدة والمُفصَّلة. لذا هناك فرق بين ‘خلافة’و’خالِف’، أي إن هناك فرقا بين شخص يتلو آخر في الزمان، وبين مَنْ يرث حقوقه القانونية وسواها. وشدَّد على أهمية هذه التفرقة، محذرا من تقليل البعض من ضرورتها؛ لأنه يعتقد أن كلمة’خلافة’ أضرت بالعقل الإسلامي، مثل إطلاق بعض الخلفاء على أنفسهم لقب ‘خليفة الله على الأرض’؛ ومن ثم، أدت الخلافة إلى نتائج عكسية.. مؤكدا أن أصحاب الإيديولوجيات، دينية كانت أم قومية، هم الذين يضطلعون بمهمة نفي الآخر، إما عن طريق اتهام الآخر بالكفر، من خلال ما يسمى ب’اغتيال الشخصية’، وإما عن طريق التحريض على القتل. وأضاف أن الدولة العثمانية سلكت طريق الغزو؛ فانتصرت لمدة قرن.. ثم ذُلت وأُهينت لمدة قرنيْن.. وأن كل مسلمي أوروبا يدفعون الثمن الآن؛ لأن أوروبا تخشى أن يطالبوا ب’بلغاريا’، والأندلس وسواهما.. وأننا الآن ندفع فاتورة الدولة العثمانية التي أسهمت في تأخير العالم العربي، وتدهورأحواله؛ مما أدى إلى بزوغ حركة القومية العربية للرد على الظلم الذي حاق بنا على يد الأتراك. ونوَّه بأن السيد جمال الدين الأفغاني هو الذي أدخل الإسلام السياسي في العصر الحديث، ثم انقسم إلى مدرستيْن: مدرسة الشيخ محمد عبده، ومدرسة الشيخ رشيد رضا.غير أن الشيخ محمد عبده، عندما أصبح مفتيا، صار عالما؛ يفكر بهدوء ورويَّة، وقطع صلته بالسياسة. وهو رجل له فتاوى كثيرة متقدمة ومستنيرة. بَيْدَ أنه- من وجهة نظره- كان يفتقد العقلية التنظيرية، أي إنه لم يستطع وضع نظريات. أما المدرسة الأخرى التي تزعمها الشيخ رشيد رضا، فقد جلبت علينا الكوارث والمآسي؛ لأنه- على حد تعبيره- هو الذي قلب الحركة الإسلامية، ثم وجَّهها صوب السعودية. وقد تربى ‘حسن البنا’ في مدرسته، وتلقى تعاليمه الأساس منها. غير أن من آثار الشمولية التي يحذرنا منها المستشار العشماوي، أي خلط الدين بالسياسة، ضرب العقل الإسلامي، كما حدث في الفتنة الكبرى، وفي القرن الخامس الهجري إلى الآن.. وكان صاحب الضربة القاضية للعقل ‘أبو حامد الغزَّالي’، وهو أشعري ..كان لا يني يردد: أكثر نظر الخلق مقصور على الأسباب القريبة السافلة، مقطوع عن الترقي إلى سبب الأسباب’، أي إن الإنسان لا يأتي أي فعل، وما يتصوره من أن الماء قد أحدث البلل، أو أن عود الثقاب قد أحدث النار، توهم لا غير. مع أن القرآن كله مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والدعوة إلى التفكير والتدبر. وهكذا ظللنا معلقين خارج نطاق الزمان. لذا لن يتاح للمسلمين- وفق رأيه- الدخول في اللحظة التاريخية، إلا إذا فهموا أن الوجود حركة في التاريخ، وأن مفهوم الحركة والسكون- بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى- إنما هو مفهوم قديم، وأن العقل وصل الآن، وسوف يصل، إلى مفاهيم صحيحة.. وأن الزمان- وفقا لنظرية أينشتين- دائري، كل نقطة فيه تصلح لأن تكون بداية ونهاية. ومن ثم؛ تكون هي الأبد، وهي الأزل، وهي الماضي، وهي الحاضر، وهي المستقبل.. مضيفا أن هذا فهم جديد لا بد أن نعيه؛ حتى يتيسر لنا الخروج من السجن الذي نعيش فيه، وندخل التاريخ.. بدلا من أن يكون شغلنا الشاغل فقط اعتبار سوانا كفارا، لا عمل لهم إلا خدمتنا فحسب، ناسين أن مَنْ يخدمني، سيدافع عني، ومَنْ يدافع عني سيستعبدني، وهكذا دواليك. وخلص المستشار العشماوي من هذا كله، إلى أن المرجعية الإسلامية المنشودة التي لا علاقة لها بالتاريخ الإسلامي، ولا برأي أصحاب الإسلام السياسي، تكمن في قوله تعالى: ‘الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا’. وبذلك تتحدد المرجعية الإسلامية التي نبتغيها في الأخلاق، والإيمان بالله، واحترام العقل، والتسامح مع الناس جميعا، وإعلاء إنسانية الإنسان، وعدم العدوان على الغير، وكل المعاني الكريمة. ولذا يتعين ـ كما يقول- أن تكون مملكة الدين هي القلب والأخلاقيات فحسب، ولا تتعداهما إلى سواه من شؤون العلم وحقوله. لكن الإسلام السياسي،للأسف، مازال متعلقا بالخلافة، حاصرا الإسلام في النظام السياسي، أو التنظيم الحزبي، غير قادر على تفهم قيمة العقل، وأهميته في حياتنا،عادّا إياه’العقل’وسوسة شيطان! وهنا يتساءل: لكن منذ متى بدأ الإسلام السياسي في العصر الحديث؟ يقول: إذا عدنا إلى الوراء، فسنجد أن ‘محمد علي’ بعد توليه السلطة، نُصح من قِبل مستشاريه الفرنسيين، بإقامة نظام حكم مدني (وأنا أفضِّل- في الحقيقة- كلمة ‘حكم مدني’، بدلا من كلمة’حكم عَلماني’)؛ لأنه لو أنشأ حكومة دينية لجعل للسلطان العثماني شرعية لتدخله الدائم في شؤون مصر، فضلا عن أن تركيبة مصر قسمة موزعة بين المسلمين والمسيحيين؛ الأمر الذي لا تستوعبه الدولة المسماة بالدينية، ويجد التعبير الأنقى عنه في دولة عصرية يتعايش فيها الجميع على قدم المساواة.. كما أن لدى مصر اتصالا دائما بأوروبا وأثينا وإيطاليا.وهذه هي فكرة ‘طه حسين’ في كتابه المعروف ‘مستقبل الثقافة في مصر’؛ حيث رأى أن التفات مصر إنما يجب أن يكون لأوروبا. ثم يُضيف قائلا: وفي كتابي ‘ديوان الأخلاق’ أثبت أن كل الحضارة الإغريقية نُقول من المصرية. ف’هوميروس’، مثلا، مصري، واسمه إما تأغرق، وإما أخذ اسما إغريقيّا في مصر، على نحو ما شرحته في كتابي هذا. وأرجو ألَّا يفهم من كلامي هذا، أنه محاولة للتضخيم من كياننا المصري، ولكنه اتجاه أصيل لديَّ لربط كل حلقات التاريخ بعضها ببعض، بذات الدرجة التي أعمل من خلالها، على الربط بين كل العقائد؛ باعتبارها جاءت جميعها من الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، وتكوين جماعة إنسانية، قِبلتها الله، ومحورها الإنسان. غير أن المستشار العشماوي يرى أن إنجلترا انزعجت من المقاومة المصرية للاحتلال، فراحت تبحث عن وسيلة تواجهها بها. وحدث أن عقد في عام 1908مؤتمر للخلافة الإسلامية في مصر، فكان أول مَنْ دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن تكون الخلافة في بلد عربي، هو السير ‘ألفريد سكاون بلنت’ مؤلف كتاب’التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر’ وصديق الزعيم أحمد عرابي والشيخ محمد عبده، وفق ما جاء في كتابه ‘الخلافة الإسلامية’. ومن ثم؛ كان هناك اتجاه بريطاني كما يقول- لاستخدام الشريعة الإسلامية على نحو ما، خلافا لما فعله محمد علي الذي أخذ بنصيحة المستشارين الفرنسيين، بينما كان لإنجلترا اتجاه آخر. وفي سنة 1928، تلقفت’جماعة الإخوان المسلمين’ في الإسماعيلية هذه الدعوة وتبنتها. لهذا يرى المستشار العشماوي أن ما أريد إرساؤه في مصر، ليس قيام دولة إسلامية؛ حتى يقال إن هناك نظاما إسلاميّا، في مواجهة نظام وضعي ؛ فهذا كلام غير صحيح؛ لأن الجميع إسلاميون.غير أن الحادث الآن، هو وجود نظام كهنوتي.. شمولي، وآخر مدني، وكلاهما مرجعيته إسلامية. وإذا نظرنا إلى الإسلام على أنه الإيمان بالله، وبالأخلاقيات الكريمة، وبالإنسانيات الرفيعة، وبالحقوق، والمساواة بين المرأة والرجل…و…إلخ، فإننا نقدم الإسلام المستنير. لكن انظرْ إلى جماعات الإسلام السياسي التي تطالب بتطبيق الشريعة، تجدْ أنها لم تدرس القانون.لأن القانون المدني المصري يمكن تخريجه على قواعد الفقه الإسلامي بأكمله، بمعنى أن كل مادة في القانون المدني، يمكن أن نجد أصلا لها في الفقه الإسلامي. ومن ثم، نرى أن الباقي لا يتعدى- في مجمله- أربعة حدود هي: حد قطع اليد.. وحد قذف المحصنات.. وحد الجلد للزنا.. وحد الحرابة (أي قطع الطريق). ويفسر لنا المستهدف من دعوتهم هذه، بأنها أتت لضرب النظام القانوني المصري بدعوى أنه مستمد من القانون الفرنسي. ألم نأخذ من أوروبا وسائل الحياة المادية الحديثة ؟ ولِمَ نقف عند الجزئية السابقة فقط دون غيرها؟ ثم يتزيد بعضهم فيقول: إن القانون المدني هو أحكام الفقه المالكي، تسربت من إسبانيا إلى فرنسا!
وبذلك وضعوا الشريعة أمام القانون، ووضعوا الأمة أمام الدولة، ولاحظوا أن الأمة هنا تعبير مهذب عن القبيلة، في حين أن الدولة نظام قانوني ينبني على دستور وقوانين ومؤسسات. وخطورة هذا الكلام تجيء- في رأيه- من أن تفكيك نظام الدولة من أجل أن تقول لي إنك واحد من أفراد الأمة الإسلامية كلها، يعطيك مبررا لأن تحارب في أفغانستان، ثم تأتي بالأفغان والإيرانيين إلى هنا؛ بحجة محاربة اليهود، في الوقت الذي يُمنع فيه المصري من محاربة إسرائيل نكاية في الدولة المصرية التي يرفض أن يدفع لها الضرائب، أو أن يحارب عدوها، أو أن يدافع عن الروابط التي تشده إلى أخيه المصري، أو أن يذود عن ولائه لبلده الذي وقر في ذهنه أنه مجرد طين وأرض، أو أن يخامره الإحساس بقيمة الانتماء إلى تاريخه الذي يرى أن تراثه الفرعوني، مثلا، ليس إلا محض أوثان؛ لذا هو غير مستعد للدفاع عنها لحساب الأجانب المهتمين بها! وهذا الكلام في حقيقته- من الإسرائيليات التي سبق للمستشار العشماوي أن تناوله في سلسلة مقالات ضمها كتاب له بعنوان ‘إسلاميات وإسرائيليات’. لذا يرى المستشار العشماوي أن الإسلام السياسي دائم إظهار العداوة للعالم، وإعلان المواجهة مع الجميع، مع أنه لا يملك أسباب الحرب الحديثة ومقوماتها ولا يعرف تقنيتها، بل يعارض الحضارة العالمية ويرفض نقل التقنية بزعم أن ذلك غزو فكري، وكل ما يرفعه عبارة غامضة غير محددة هي ‘المشروع الإسلامي’. وهو تعبير ظهر أصلا في الغرب لدى بعض الكتَّاب المستشرقين وغيرهم؛ قصد التدليل على أن العالم الإسلامي لا يسير ولن يسير في طريق الحضارة العالمية؛ لأن له مشروعا يخالف ويضاد المشروع الحضاري العالمي. ويضيف: أي إن تعبير ‘المشروع الإسلامي’ يؤكد ويكرِّس فكرة العزل والتفريق بين الشرق والغرب، وهو ترديد معاصر لمقولة رديارد كبلنج القديمة من أن الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا. لهذا نذر نفسه لمحاربة الأفكار المنحرفة التي تنهض على الأقوال المرسلة، والآراء المطلقة، والأحاديث الضعيفة، والأحكام الشاردة، داعيا إلى ‘إعادة دراسة الأحاديث’السنة’ المروية عن النبي- صلى الله عليه وسلَّم- دراسة تقوم على أسس علمية راسخة، وتنبني على منهج نقدي فحصي سليم، وتستوي على فهم متكامل شامل. وبغير ذلك، فسوف يظل الهرم مقلوبا، والصورة سالبة’، محذرا دوما من’اختلاط التراث الشعبي بالمفهوم الديني، وأن تتداخل العادات الاجتماعية في التحديد الشرعي ؛ إذ مؤدى ذلك-إن حدث- أن يضطرب المفهوم الديني، وأن يهتز الميزان الشرعي، فيدخل على هذا وذاك، ما ليس منه وما هو غريب عنه؛ وبذلك يصبح التراث الشعبي مفهوما دينيّا على غير الحق، وتصير العادات الاجتماعية أوضاعا شرعية دون أي أساس، ويغيم الأمر لدى الناس فلا يستطيعون تمييز الديني من الموروث الشعبي، ولا يقدرون على استبانة العادات الجارية من الحكم الشرعي؛ وهو أمر يسيء إلى الدين أيما إساءة’. وضرب لنا مثلا على ذلك بمسألة الحجاب؛ حيث ذهبت جماعات إلى أن ‘الحجاب فريضة إسلامية’، كان منها فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية عام1994الذي لخَّص رأيه بقوله:’ وإن كل مسلمة بالغة لا تلتزم بستر ما أمر الله تعالى بستره مهما كان شأنها ومهما كانت صفتها هي آثمة وعاصية لله تعالى، وأمرها بعد ذلك مفوَّض إليه- سبحانه- وحده’، بينما رأى آخرون أن ‘الحجاب شعار سياسي’، وكان من أنصار هذا الرأي المستشار محمد سعيد العشماوي الذي دخل في سجال مع المفتي على صفحات مجلة ‘روز اليوسف’ حول هذا الموضوع عام 1994، انتهى فيه إلى أن ‘ما يسمى بالحجاب حالا’حاليا’- وهو وضع غطاء على الرأس، غالبا مع وضع المساحيق والأصباغ- ليس فرضا دينيّا، لكنه عادة اجتماعية، لا يدعو الأخذ بها أو الكف عنها إلى إيمان أو تكفير، مادام الأصل القائم هو الاحتشام والعفة’. الأمر الذي دفع المستشار العشماوي إلى تحرير المصطلحات ‘أو ضبطها، واتباع منهجية واضحة ونظامية مطردة’ حتى يخلص إلى ‘أقرب الآراء إلى الصحة وأدناها إلى الصواب حتى لو خالفت المألوف وعارضت المعروف’.. لكن المشكلة الحقيقية لديه ‘ليست في الوصول إلى الصواب ولا في الحديث على مقتضاه، وإنما في الرفض المسبق من القارئ أو السامع لقبول الرأي الآخر أو السماح بأي كلمة تهدد فكره المغلوط أو تقوِّض رأيه المخطئ أو تفكِّك حماسته للأوهام. ومع كل ذلك، فإن القافلة لا بد أن تسير؛ لأن العواء سوف يخفت ثم يصمت أمام قوة الحق وقدرة الصدق’. لهذا لم يلتفت وراءه قط، وظلت عينه دائما على المستقبل، لا يبغي ولا يروم سوى إنشاء مجتمع مدني، يكون فيه الدين فعَّالا؛ من حيث عناصره الأساس والجوهرية فقط، مثل عبادة الله سبحانه وتعالى، واحترام آدمية الناس مهما اختلفت عقائدهم، وحريتهم في اختبار عقائدهم بعقولهم؛ لتصفيتها من اللغو الذي شابها، وأدى إلى منع تقدم الأمة الإسلامية ولايزال. فنحن- حسب تعبيره- لا ننقد الماضي، وإنما نحن نفكك هذه الأفكار الخاطئة؛ لكي نعيد بناء المجتمع الإنساني بصورة صحيحة بحيث يكون العقل هو الأساس، ويكون الخلق دافعا رئيسا، ويكون الإيمان بالله – سبحانه وتعالى – إيمانا صافيا، وننكر تماما كل الدعاوى التي تخلط الدين بالسياسة، أو التي تريد أن تضرب علينا الجهالة، وتمنع مصرنا من أن تأخذ مكانها اللائق بها بمفهوم إنساني وعلمي.
ورحم الله شاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري إذ يقول:
أجللتُ فيك من الميزات خالدةَ = حريةَ الفكر والحرمانَ والغضبا
مجموعة قد وجدناهنَّ مفردة = لدى سواك فما أغنيننا أربا
جيش من المثل الدنيا يَمُدُّ به = ذوو المواهب جيشَ القوة اللَّجبا
*كاتب وناقد من مصر