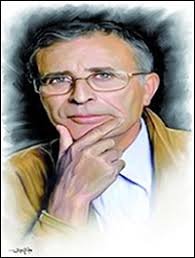اسمحوا لي أن أذكر أنه سبق لي أن قدمت- في إطار آخر- اقتراحات واضحة حول دور المثقف في المجتمع، فسواء أكان محافظاً أو مجدداً أو مبتكراً فإنه يقوم بعدة وظائف متفاوتة منها: وظيفة بيداغوجية، تقنية: إذ يُمرس غيره على قضايا الفكر والفن، بحيث يعطي المثال بنفسه. وظيفة اجتماعية: فسواء أكان ملاحظاً أو عنصراً فعالاً أو مجرد ناشر للمعرفة، فإن المثقف يقوم بدور تنبيه الفكر لذكاء وحساسية عصره. لقد كان المثقف دائماً، وفي جميع المجتمعات، يلعب دور الوسيط بين الحاكمين والمحكومين، وسبق له أن تعاطى السياسة، لكنه نادراً ما استمر في ممارستها، لأن عمله الأصلي هو تحريك الفكر، وتحليل المجتمع، لا إدارته. وظيفة أخلاقية: فسواء أكان مناصراً للعقل المطلق أو للحكمة في خدمة الإنسان، أو كان مناصراً لقضية أو لمثل أعلى، فهو مطالب بأن يتكيف باستمرار مع المبادئ والقيم التي يدافع عنها، وبالتالي فهو مرغم على سلوك موجّه لذاته.
لكن استبطان قانون الفكر يعني الاستقلال والملاحظة، ملاحظة النفس كحامل لحرية تفكير مستمرة، إذ بدونها كيف سيصبح المثقف عنصراً فعالاً في المجتمع المدني. فالمراس والتكيف وإرغام النفس هي مهام المثقف، مهامه في المدينة، حتى ولو كان متجاوزاً لعصره.
إذن، كل مثقف ينتمي إلى عصره، إلا أن عصرنا يعرف في نهاية هذا القرن تغييراً حاسماً، أي تقسيماً جديداً للعالم إلى مناطق نفوذ، حسب تكتل جهوي لمجموعات كبيرة قائمة، أو في طور التكوين.
ويؤدي هذا التكتل إلى تراتب بين مجموعات البلدان الحضارية، حيث تشكل «الليبرالية الديموقراطية» رأس رمح الأيديولوجية السائدة، باعتبارها أسمى قيمة للإنسانية العالمية، و«لنظام العالمي الجديد»، فمن جهة تشكل هذه القيمة نموذجاً مرجعياً لحقوق الإنسان وللمجتمع المدني، ومن جهة أخرى تبريراً لكل بنية تقنية (صناعية وعسكرية واقتصادية وثقافية وإعلامية).
ثقافات عابرة للموقع
هذا وبسرعة تقنية وعلمية تُحدث ظاهرة جديدة لا يمكننا تخمين كافة عواقبها الآن. ألا وهي «لا تموقع» الثقافات التي تَقْلب المعالم والتي يرجع إليها هذا المجتمع أو ذاك. ويوجد من بين هذه المعالم ما يسمى بالتراث في جميع أشكاله: المكتوبة والشفوية والصوتية والحركية والبصرية. كل هذه الآثار تشكل ذاكرة ثقافة، أو حضارة نقلت إلينا وهي من بين أنفس ممتلكاتنا. بيد أن هذا التراث يخضع لقانون تصنيع الذاكرة وسوقها.
وقبل أن أتحدث عن هذه النقطة، أود أن أقدم نفسي من جديد:
وإذا تقدمت إليكم من جديد على أنني باحث مغربي، فإني أفترض إما أن تنحصر إنسانيتي في مغربيتي (التي تصبح بالنسبة لي علامة هوية)، وإما أن تعتبر مغربيتي كمفهوم وكتعبير عن العالمية، الشيء الذي يجعلني قريباً من أي إنسان، حي أو ميت، في كل زمان ومكان، وإما أن أحمل مغربيتي بصفتها تصوراً دقيقاً نسبياً، أو صورة لما هو مفروض أن أكونه كأحد أعضاء المجموعة التي أنتمي إليها.
لنتابع، وإذا تقدمت إليكم أولاً بكوني مسلماً، يمكن أن يكون ذلك بصفتي وحدة دينية أو وارثاً لرسالة عالمية. آنذاك سيتأرجح تحليل هويتي الدينية بين اتجاه وآخر.
لو كنا نتوفر على وقت كاف، لتابعت هذا الحديث في شكل حوار من صميم الديموقراطية ومعرفة الآخر. ذلك أنه يجب في الحوار، أن نبتدئ بالإقرار أن محاورنا مصيب شيئاً ما فيما يعبر عنه. وهكذا، فإن العقل يغتني ويغني المتحاورين إذ يوجد بينهم مجال للحوار والمعرفة وممارسة الفكر والتسامح، التسامح مع النفس ومع الآخر، في حدود القانون والأخلاق يتعدى مسألة «لا تموقع» الثقافات إذ المكان ليس إحالة على بلد معين وإنما هو أيضاً إحالة على ثقافته وتاريخه وتراثه ومرجعياته، وباختصار على معالم هويته.
إن «اللا تموقع» الذي أحدثته التقنيات والنظام الجديد للسوق وعولمتهما المزعومة لا يمكن أن يدرك من قبل أولئك الذين يعارضون بين الحضارة والتقنية، لقد فهم العرب القدامى ذلك بما فيه المجال الفني إذ كانوا يقولون مثلاً: بأن الشعر صناعة والموسيقى صناعة.
ومواكبة للحضارة الصناعية وضعت التقنية نسقاً كونياً للمعلومات، في حين أن الثورة الرقمية تعيش مسلسل ابتكارات تقنية لا تحصى، إنها تؤثر في سياساتنا واقتصادياتنا وثقافتنا وعاداتنا بل حتى في حساسيتنا وجسدنا، إذ يتعين على المثقف أن يسجل هذا المسلسل، ذلك أن المعرفة في ميدان العلوم الإنسانية مثلاً تغير وسيطات تحليلها. فهي تتجه بقوة متزايدة، نحو عالم جديد، هو عالم التقنَعِلمية. فقد حلّ محل الحوار القديم القائم بين الفلسفة والعلوم الإنسانية حتماً حوار آخر، حوار أصبحت فيه التقنَعِلمية تفرض، بسرعة اختراعاتها وسيطرتها (من المعلوميات إلى الجراحة الوراثية مروراً بجميع المعارف العلمية الجديدة). لقد أصبح مفهوم العلوم الإنسانية يتغير اليوم.
هناك اشتكى باحث مؤخراً من قلة المراسلات بالجامعة المغربية. ولكن التطور المتوازي للإنسان والآلة، يضعنا أمام أشكال وأنماط أخرى للاتصال اللا مادي. لقد أشرت في مذكرتي التقديمية إلى أن المفكر يواجه اليوم التطور السريع للمعرفة وللمهارة التقنية وللعولمة. هذا التطور الذي يحدث منافسة بين الثقافات وحواراً بينها على أساس معطيات جديدة في حالة إسهامنا في ذلك الحوار.
سياسة الذاكرة
هل يخضع هذا الحوار الذي يشكل مهمة ما يسمى بمجموعة المثقفين، إن على المستوى الوطني أو الدولي لوسيطات جديدة؟ ما هي؟ ما معنى مجموعة المثقفين الدولية اليوم؟ في عالم تخضع فيه الثقافة أكثر فأكثر لاقتصاد ضاغط في الانتاج والتدبير والتوزيع. ما هي البلدان القادرة اليوم على نقل ثقافتها وبيعها على الصعيد الدولي؟ خصوصاً وأن التراث الحضاري متعدد المراكز من جهة، ومن جهة أخرى يشكل وجيهة من تصنيع الذاكرة الذي يندرج ضمنه تراث الشعوب الوارثة له.
هكذا، يجد المثقف نفسه أمام معلومات غير محدودة، بسبب ذلك التصنيع للذاكرة، وللمعلومات نفسها قدرة كبيرة على إنتاج الثقافات الحالية، وهكذا توجه المعلومات التفكير وتؤثر في الرأي العام وتندرج ضمن ما يمكن أن نصطلح علي تسميته «بسياسة الذاكرة».
لنأخذ مثلاً طفلاً ينتمي إلى بلد ما وينجذب يومياً، ولو لساعة واحدة إلى الرسوم المتحركة الأميركية، دون أن يشعر بتحول في خياله. فقد قيل لي في شهر نوفمبر الماضي، وأنا بأطلانطا في استديوهات «س. ن. ن» أثناء زيارة استطلاعية، إن هذه القناة والقنوات التابعة لها تصل إلى 220 مليون بيت عبر العالم. وذلك يدل على مدى أهمية تحديد الهوية الثقافية والرمزية للمشاهدين من خلال هذه العمليات التجارية الضخمة للصورة.
كما يدل على أن مفاهيم الوراثة والنقل التي تعزز الهوية الثقافية تمر عبر طرق أخرى، فإذا كانت الصورة تنتج حياة حلم للترفيه عن الفكر وعن الجسد، فيجب أن نتساءل من خلال حياة الحلم هاته، كيف ينتصب توزيع جديد للعالم، أي قوى حديثة سياسية واقتصادية وإعلامية، كما يجب تحديد ما يتهدد التنوع الحقيقي للحضارات ولتراثها الذي يوجد كوجيهة بين المعلومات ووسائل الإعلام والسياحة وقنواتها الدولية.
الترجمة عابرة الحدود
كان الدور التقليدي لعابر الحدود بين الثقافات يكمن وما يزال في الترجمة، فالمترجم هو رجل الحوار بين الحضارات من خلال اللغة. والترجمة مهمة حتمية لتحيين المعرفة والتعرف على الآخر.
وهكذا يجب أن نترجم المؤلفات القديمة والحديثة للبشرية التي تطبع عصرنا ولو للاطلاع على ما تنتجه مجموعة المثقفين الدولية.
أعتقد أن الترجمة أي معرفة حضارات أخرى تقي البشرية من هيمنة «الفكر الوحيد». إنها تعدد الحوار بين الحضارات ونضال سياسي على واجهات مختلفة، وحين نعلم أن الكتاب الذي ينتجه مثقفون عرب لا يستطيع أن يتجاوز الحدود العربية فمن حقنا أن نقْلق على عدم انتشار الحضارة العربية في العالم، وعلى مكانة مثقفينا في المجموعة الثقافية والعلمية الدولية، يتعين إذن احتلال هذه المكانة وهي غير شاغرة.
فالمثقفون المهاجرون العرب يشكلون حيزاً بين الثقافة والعولمة، ويحظون بنفس أهمية المترجمين، وذلك يعني أن العربي هو الذي يدّعي أنه كذلك حيثما وُجد. وقد أصبح هذا المثقف أجنبياً احترافياً قادراً على إدراك الظاهرة الدولية للاتموقع. إن تجربة المنفى ليست فقط حالة تمزق وحنين، بل هي كذلك درس مفيد للحياة وللفكر. إن التداخل الثقافي يعلمه يومياً ممارسة التشابه والاختلاف بين البشر والثقافات والمجتمعات. فهو كمواطن عالمي يشعر بمسألة التسامح وعدمه. إن الإسهام العلمي والثقافي لهؤلاء العرب ملك نفيس للجميع، بما في ذلك الحضارة العربية. فحيث ما جُلت عبر العالم إلا ووجدت علماء وفنانين ومثقفين عرباً رفيعي المستوى، هم بكيفية ما سفراء حضارتهم الخاصة.
استراتيجية مزدوجة
لنعد إلى المثقف العربي الذي يعيش في بلده. لقد تحدثت إلى حد الآن وكأني لم أميزْ بين المثقف والمفكر، فالمفكر مختص في ميدان معين، إذ نرجع إليه باعتباره خبيراً أو مسؤولاً عن الدراسات غير أنه حين يتوجه إلى الرأي العام الوطني أو الدولي، فإنه يلعب دوراً ثانياً هو دور المثقف في المجتمع.
إننا نعرف أن الرأي العام الدولي يتأثر أكثر فأكثر بتقنيات الاتصال وبوسائل الإعلام. ودون أن ينمحي؛ فالمثقف الملتزم من أمثال طه حسين وجون بول سارتر يُعوّض بظهور شخوص آخرين من مثقفين صحافيين أو إعلاميين أو خبراء أو مدبرين أو صانعي الرأي العام وثقافة الفرجة. هناك إذن تحول في دور المثقف وليس انمحاء. ومن الملح أن نحدد مهمته إزاء الرأي العام الدولي، وبالتالي إزاء حوار الثقافات في هذا المعطى الجديد.
إنه يحتاج في نظري إلى استراتيجية مزدوجة، فمن جهة يتعين عليه أن يحافظ على استقلالية فكره ليشكل هوية جديدة تتلاءم مع مسلسل العولمة واللا تموقع. ومن جهة أخرى يتعين عليه أن يتحاور مع المختصين في الفكر والباحثين والمبتكرين والخبراء الذين يصنعون الرأي العام الدولي.
ففي ما يخص الجانب الأول تشكل الجامعات والمعاهد المصدر الأول لمعلوماته، إلا أن الجامعة نفسها تعرف تحولات كبيرة بفعل المعلوماتيات وشبكاتها المختلفة. فمثلاً بالنسبة للتعليم عن بعد وللجامعات «المحتملة»، فمن مصلحة المثقف أن يعمل جنباً إلى جنب مع خبراء التقنيات والاختراعات الجديدة، وأن يظل ملتزماً بالدفاع عن إنسيّة متفتحة تروم تعدد مراكز الحضارات وخصوصياتها واختلافاتها، وتروم من خلالها الدفاع عن الشعوب المهمشة.
فلا أنسى قط أنه توجد بين الثقافات منافسة إن لم أقل حرباً مستمرة. وبما أن العنف مندمج في الحياة، يجب ألا ننكره بل أن نخلصه من اللا معقول.
إذ يظل الفن الحليف الطبيعي للدفاع عن الإنسان في مواجهة ذاته وضد عنفه الذاتي. علاوة على كونه ترفيهاً عن النفس فإن الفن تجل للحياة. إذ لا يجعلنا نحلم فقط وإنما ينقل قوة حياة نحتاجها جميعاً لمواجهة حركية العالم. لكل حضارة معالمها وتاريخها وأصالتها. لذا يتعين التعريف بالحضارة العربية وجعلُها أكثر تنافسية في إطار العولمة.
.........................................................
نشر هذا المقال في كتاب: السياسة والتسامح، ترجمة عز الدين الكتاني الإدريسي، الرباط 1999، منشورات عكاظ ص (7- 18)
لكن استبطان قانون الفكر يعني الاستقلال والملاحظة، ملاحظة النفس كحامل لحرية تفكير مستمرة، إذ بدونها كيف سيصبح المثقف عنصراً فعالاً في المجتمع المدني. فالمراس والتكيف وإرغام النفس هي مهام المثقف، مهامه في المدينة، حتى ولو كان متجاوزاً لعصره.
إذن، كل مثقف ينتمي إلى عصره، إلا أن عصرنا يعرف في نهاية هذا القرن تغييراً حاسماً، أي تقسيماً جديداً للعالم إلى مناطق نفوذ، حسب تكتل جهوي لمجموعات كبيرة قائمة، أو في طور التكوين.
ويؤدي هذا التكتل إلى تراتب بين مجموعات البلدان الحضارية، حيث تشكل «الليبرالية الديموقراطية» رأس رمح الأيديولوجية السائدة، باعتبارها أسمى قيمة للإنسانية العالمية، و«لنظام العالمي الجديد»، فمن جهة تشكل هذه القيمة نموذجاً مرجعياً لحقوق الإنسان وللمجتمع المدني، ومن جهة أخرى تبريراً لكل بنية تقنية (صناعية وعسكرية واقتصادية وثقافية وإعلامية).
ثقافات عابرة للموقع
هذا وبسرعة تقنية وعلمية تُحدث ظاهرة جديدة لا يمكننا تخمين كافة عواقبها الآن. ألا وهي «لا تموقع» الثقافات التي تَقْلب المعالم والتي يرجع إليها هذا المجتمع أو ذاك. ويوجد من بين هذه المعالم ما يسمى بالتراث في جميع أشكاله: المكتوبة والشفوية والصوتية والحركية والبصرية. كل هذه الآثار تشكل ذاكرة ثقافة، أو حضارة نقلت إلينا وهي من بين أنفس ممتلكاتنا. بيد أن هذا التراث يخضع لقانون تصنيع الذاكرة وسوقها.
وقبل أن أتحدث عن هذه النقطة، أود أن أقدم نفسي من جديد:
وإذا تقدمت إليكم من جديد على أنني باحث مغربي، فإني أفترض إما أن تنحصر إنسانيتي في مغربيتي (التي تصبح بالنسبة لي علامة هوية)، وإما أن تعتبر مغربيتي كمفهوم وكتعبير عن العالمية، الشيء الذي يجعلني قريباً من أي إنسان، حي أو ميت، في كل زمان ومكان، وإما أن أحمل مغربيتي بصفتها تصوراً دقيقاً نسبياً، أو صورة لما هو مفروض أن أكونه كأحد أعضاء المجموعة التي أنتمي إليها.
لنتابع، وإذا تقدمت إليكم أولاً بكوني مسلماً، يمكن أن يكون ذلك بصفتي وحدة دينية أو وارثاً لرسالة عالمية. آنذاك سيتأرجح تحليل هويتي الدينية بين اتجاه وآخر.
لو كنا نتوفر على وقت كاف، لتابعت هذا الحديث في شكل حوار من صميم الديموقراطية ومعرفة الآخر. ذلك أنه يجب في الحوار، أن نبتدئ بالإقرار أن محاورنا مصيب شيئاً ما فيما يعبر عنه. وهكذا، فإن العقل يغتني ويغني المتحاورين إذ يوجد بينهم مجال للحوار والمعرفة وممارسة الفكر والتسامح، التسامح مع النفس ومع الآخر، في حدود القانون والأخلاق يتعدى مسألة «لا تموقع» الثقافات إذ المكان ليس إحالة على بلد معين وإنما هو أيضاً إحالة على ثقافته وتاريخه وتراثه ومرجعياته، وباختصار على معالم هويته.
إن «اللا تموقع» الذي أحدثته التقنيات والنظام الجديد للسوق وعولمتهما المزعومة لا يمكن أن يدرك من قبل أولئك الذين يعارضون بين الحضارة والتقنية، لقد فهم العرب القدامى ذلك بما فيه المجال الفني إذ كانوا يقولون مثلاً: بأن الشعر صناعة والموسيقى صناعة.
ومواكبة للحضارة الصناعية وضعت التقنية نسقاً كونياً للمعلومات، في حين أن الثورة الرقمية تعيش مسلسل ابتكارات تقنية لا تحصى، إنها تؤثر في سياساتنا واقتصادياتنا وثقافتنا وعاداتنا بل حتى في حساسيتنا وجسدنا، إذ يتعين على المثقف أن يسجل هذا المسلسل، ذلك أن المعرفة في ميدان العلوم الإنسانية مثلاً تغير وسيطات تحليلها. فهي تتجه بقوة متزايدة، نحو عالم جديد، هو عالم التقنَعِلمية. فقد حلّ محل الحوار القديم القائم بين الفلسفة والعلوم الإنسانية حتماً حوار آخر، حوار أصبحت فيه التقنَعِلمية تفرض، بسرعة اختراعاتها وسيطرتها (من المعلوميات إلى الجراحة الوراثية مروراً بجميع المعارف العلمية الجديدة). لقد أصبح مفهوم العلوم الإنسانية يتغير اليوم.
هناك اشتكى باحث مؤخراً من قلة المراسلات بالجامعة المغربية. ولكن التطور المتوازي للإنسان والآلة، يضعنا أمام أشكال وأنماط أخرى للاتصال اللا مادي. لقد أشرت في مذكرتي التقديمية إلى أن المفكر يواجه اليوم التطور السريع للمعرفة وللمهارة التقنية وللعولمة. هذا التطور الذي يحدث منافسة بين الثقافات وحواراً بينها على أساس معطيات جديدة في حالة إسهامنا في ذلك الحوار.
سياسة الذاكرة
هل يخضع هذا الحوار الذي يشكل مهمة ما يسمى بمجموعة المثقفين، إن على المستوى الوطني أو الدولي لوسيطات جديدة؟ ما هي؟ ما معنى مجموعة المثقفين الدولية اليوم؟ في عالم تخضع فيه الثقافة أكثر فأكثر لاقتصاد ضاغط في الانتاج والتدبير والتوزيع. ما هي البلدان القادرة اليوم على نقل ثقافتها وبيعها على الصعيد الدولي؟ خصوصاً وأن التراث الحضاري متعدد المراكز من جهة، ومن جهة أخرى يشكل وجيهة من تصنيع الذاكرة الذي يندرج ضمنه تراث الشعوب الوارثة له.
هكذا، يجد المثقف نفسه أمام معلومات غير محدودة، بسبب ذلك التصنيع للذاكرة، وللمعلومات نفسها قدرة كبيرة على إنتاج الثقافات الحالية، وهكذا توجه المعلومات التفكير وتؤثر في الرأي العام وتندرج ضمن ما يمكن أن نصطلح علي تسميته «بسياسة الذاكرة».
لنأخذ مثلاً طفلاً ينتمي إلى بلد ما وينجذب يومياً، ولو لساعة واحدة إلى الرسوم المتحركة الأميركية، دون أن يشعر بتحول في خياله. فقد قيل لي في شهر نوفمبر الماضي، وأنا بأطلانطا في استديوهات «س. ن. ن» أثناء زيارة استطلاعية، إن هذه القناة والقنوات التابعة لها تصل إلى 220 مليون بيت عبر العالم. وذلك يدل على مدى أهمية تحديد الهوية الثقافية والرمزية للمشاهدين من خلال هذه العمليات التجارية الضخمة للصورة.
كما يدل على أن مفاهيم الوراثة والنقل التي تعزز الهوية الثقافية تمر عبر طرق أخرى، فإذا كانت الصورة تنتج حياة حلم للترفيه عن الفكر وعن الجسد، فيجب أن نتساءل من خلال حياة الحلم هاته، كيف ينتصب توزيع جديد للعالم، أي قوى حديثة سياسية واقتصادية وإعلامية، كما يجب تحديد ما يتهدد التنوع الحقيقي للحضارات ولتراثها الذي يوجد كوجيهة بين المعلومات ووسائل الإعلام والسياحة وقنواتها الدولية.
الترجمة عابرة الحدود
كان الدور التقليدي لعابر الحدود بين الثقافات يكمن وما يزال في الترجمة، فالمترجم هو رجل الحوار بين الحضارات من خلال اللغة. والترجمة مهمة حتمية لتحيين المعرفة والتعرف على الآخر.
وهكذا يجب أن نترجم المؤلفات القديمة والحديثة للبشرية التي تطبع عصرنا ولو للاطلاع على ما تنتجه مجموعة المثقفين الدولية.
أعتقد أن الترجمة أي معرفة حضارات أخرى تقي البشرية من هيمنة «الفكر الوحيد». إنها تعدد الحوار بين الحضارات ونضال سياسي على واجهات مختلفة، وحين نعلم أن الكتاب الذي ينتجه مثقفون عرب لا يستطيع أن يتجاوز الحدود العربية فمن حقنا أن نقْلق على عدم انتشار الحضارة العربية في العالم، وعلى مكانة مثقفينا في المجموعة الثقافية والعلمية الدولية، يتعين إذن احتلال هذه المكانة وهي غير شاغرة.
فالمثقفون المهاجرون العرب يشكلون حيزاً بين الثقافة والعولمة، ويحظون بنفس أهمية المترجمين، وذلك يعني أن العربي هو الذي يدّعي أنه كذلك حيثما وُجد. وقد أصبح هذا المثقف أجنبياً احترافياً قادراً على إدراك الظاهرة الدولية للاتموقع. إن تجربة المنفى ليست فقط حالة تمزق وحنين، بل هي كذلك درس مفيد للحياة وللفكر. إن التداخل الثقافي يعلمه يومياً ممارسة التشابه والاختلاف بين البشر والثقافات والمجتمعات. فهو كمواطن عالمي يشعر بمسألة التسامح وعدمه. إن الإسهام العلمي والثقافي لهؤلاء العرب ملك نفيس للجميع، بما في ذلك الحضارة العربية. فحيث ما جُلت عبر العالم إلا ووجدت علماء وفنانين ومثقفين عرباً رفيعي المستوى، هم بكيفية ما سفراء حضارتهم الخاصة.
استراتيجية مزدوجة
لنعد إلى المثقف العربي الذي يعيش في بلده. لقد تحدثت إلى حد الآن وكأني لم أميزْ بين المثقف والمفكر، فالمفكر مختص في ميدان معين، إذ نرجع إليه باعتباره خبيراً أو مسؤولاً عن الدراسات غير أنه حين يتوجه إلى الرأي العام الوطني أو الدولي، فإنه يلعب دوراً ثانياً هو دور المثقف في المجتمع.
إننا نعرف أن الرأي العام الدولي يتأثر أكثر فأكثر بتقنيات الاتصال وبوسائل الإعلام. ودون أن ينمحي؛ فالمثقف الملتزم من أمثال طه حسين وجون بول سارتر يُعوّض بظهور شخوص آخرين من مثقفين صحافيين أو إعلاميين أو خبراء أو مدبرين أو صانعي الرأي العام وثقافة الفرجة. هناك إذن تحول في دور المثقف وليس انمحاء. ومن الملح أن نحدد مهمته إزاء الرأي العام الدولي، وبالتالي إزاء حوار الثقافات في هذا المعطى الجديد.
إنه يحتاج في نظري إلى استراتيجية مزدوجة، فمن جهة يتعين عليه أن يحافظ على استقلالية فكره ليشكل هوية جديدة تتلاءم مع مسلسل العولمة واللا تموقع. ومن جهة أخرى يتعين عليه أن يتحاور مع المختصين في الفكر والباحثين والمبتكرين والخبراء الذين يصنعون الرأي العام الدولي.
ففي ما يخص الجانب الأول تشكل الجامعات والمعاهد المصدر الأول لمعلوماته، إلا أن الجامعة نفسها تعرف تحولات كبيرة بفعل المعلوماتيات وشبكاتها المختلفة. فمثلاً بالنسبة للتعليم عن بعد وللجامعات «المحتملة»، فمن مصلحة المثقف أن يعمل جنباً إلى جنب مع خبراء التقنيات والاختراعات الجديدة، وأن يظل ملتزماً بالدفاع عن إنسيّة متفتحة تروم تعدد مراكز الحضارات وخصوصياتها واختلافاتها، وتروم من خلالها الدفاع عن الشعوب المهمشة.
فلا أنسى قط أنه توجد بين الثقافات منافسة إن لم أقل حرباً مستمرة. وبما أن العنف مندمج في الحياة، يجب ألا ننكره بل أن نخلصه من اللا معقول.
إذ يظل الفن الحليف الطبيعي للدفاع عن الإنسان في مواجهة ذاته وضد عنفه الذاتي. علاوة على كونه ترفيهاً عن النفس فإن الفن تجل للحياة. إذ لا يجعلنا نحلم فقط وإنما ينقل قوة حياة نحتاجها جميعاً لمواجهة حركية العالم. لكل حضارة معالمها وتاريخها وأصالتها. لذا يتعين التعريف بالحضارة العربية وجعلُها أكثر تنافسية في إطار العولمة.
.........................................................
نشر هذا المقال في كتاب: السياسة والتسامح، ترجمة عز الدين الكتاني الإدريسي، الرباط 1999، منشورات عكاظ ص (7- 18)