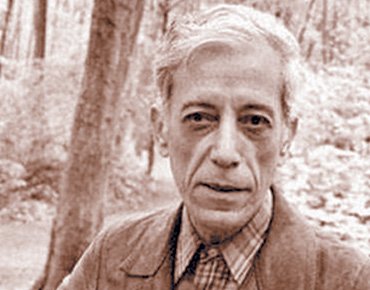بدخول العام 2019 يكون قد مر قرن كامل على ولادة واحد من أكبر الروائيين الجزائريين والمغاربيين والأفارقة الذين يكتبون بالفرنسية، إنه الكاتب محمد ديب، لكن يبدو أن لا شيء في الأفق يوحي بالاحتفاء بهذه المناسبة، فالمؤسسات الثقافية صامتة، والجامعات نائمة، ومخابر البحث مقبرة، وكأن لا حدث.
لم تكن الجزائر السياسية والأدبية والثقافية رحيمة بمحمد ديب لا في حياته ولا في مماته، فلقد ظل مهمشا، مضروبا عليه بالصمت القاتل، وهو القلم الذي أوصل صورة الجزائر قبل اندلاع الثورة إلى غرف نوم الكلونياليين في المتروبول وفي المستعمَرَة، ليؤرقهم في أسرّتهم، وهو يعري فظائع الاستعمار وهمجيته منذ أول عمل سردي نشره وهو “ثلاثية الجزائر: البيت الكبير- النول – الحريق”، كان ذلك بداية الخمسينات من القرن الماضي.
كانت هذه الثلاثية الروائية البسيطة في أسلوبها الشعري الشعبي ناقوسا أعلن بنبوءة أدبية عن موعد الثورة التحريرية التي اندلعت لاحقا في أول نوفمبر 1954.
ولم تكن الجزائر رحيمة بمحمد ديب في موته (توفي في 2 مايو 2003)، فقد دفن في تراب باريس البارد، محروما من دفء تراب مدينته التي أحبها، تلمسان، وأحب من خلالها الجزائر كلها. دفن في باريس وهو الذي كان منتظرا أن يوارى الثرى في مقبرة العظماء في بلاده، لكن النظام السياسي لم يكن منشغلا بكاتب بحجم محمد ديب، بل كان يفكر في أمر بقائه.
تجاهل النظامُ الجزائري نخبه من الدياسبورا المبدعة والمفكرة المتميزة عالميا، من أمثال محمد ديب ومحمد أركون ورابح بلعمري وجمال الدين بن الشيخ وعلي مراد… والذين ماتوا الواحد بعد الآخر، على امتداد عشرية واحدة تقريبا، ودفنوا جميعهم خارج البلد، ولم يحرك هذا النظام ساكنا.
عبر محمد ديب الحياة كاتبا كبيرا، وكلمة كبير لها معنى حين ترتبط باسم محمد ديب، عبرها روائيا و شاعرا وقصاصا ومسرحيا وكاتب أدب أطفال ومناضلا سياسيا وثقافيا إنسانيا. عشرات الروايات ومثلها المجاميع الشعرية والقصصية هي حصيلة مسيرته الأدبية، ستة عقود من الكتابة، وفي كل ذلك ظل وفيا لخطه الإنساني، لم يبدل ولم يتبدل.
يمكن قراءة تجربة محمد ديب الإبداعية الممتدة على مدى ستين سنة وفق ثلاث محطات أساسية. المحطة الأولى التي تغطي سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية وتمتد حتى استقلال الجزائر العام 1962، وفيها نكتشف انخراطه بشكل قوي وعضوي في معركة التحرير والاستقلال، نصوص مقاومة بسردية شعبية للاستعمار وأجهزته القمعية العسكرية والسياسية والاقتصادية والهوياتية، وهي مرحلة كتب فيها نصوصا روائية وقصصية خالدة، تعد بالفعل شهادة عن المعركة التحريرية للمجتمع بطبقته الفقيرة المحرومة والمنسجمة مع نخبه الطليعية التي تنير الطريق نحو الانعتاق والحرية، ويمكن ذكر “ثلاثية الجزائر: الدار الكبيرة – النول – الحريق” وأيضا مجموعته القصصية “في المقهى”، وتميزت الكتابة عند محمد ديب في هذه الفترة بالواقعية الاجتماعية على طريقة بلزاك، ولكن بحس محلي شعبي جزائري، وفيها حاول محمد ديب نفخ الروح الشعبية الجزائرية في اللغة الفرنسية.
أما المحطة الثانية فتمتد من روايته “من الذي يذكر البحر” مرورا بروايته الاستثنائية “هابيل” (وقد قمتُ بترجمتها إلى العربية) وصولا إلى “ثلاثية الشمال: سطوح أرصول – إغفاءة حواء – ثلوج من رخام” ونصوص شعرية أخرى كـ”الفجر إسماعيل”، وتميزت هذه المحطة بكتابة معقدة جدا، على مستوى البناء السردي كما على مستوى النحت اللغوي الذي استثمره في محاصرة أفكاره المعقدة الغارقة في التصوف الإسلامي واليهودي “الكابالا”، ورسم العوالم الداخلية وطرح أسئلة الوجود والخلق والمعاملات، كما أن كتابة ديب في هذه المرحلة تناغمت قليلا مع بعض أساليب مدرسة الرواية الفرنسية الجديدة، بل تجاوزتها. وفي هذه المرحلة خرج ديب نهائيا من الكتابة الواقعية وابتعد عن سؤال “المحلي الجزائري” ليدخل سؤال “الإنسان”، سؤال “الوجود والغموض والمصير”.
أما المحطة الثالثة فقد عاد فيها محمد ديب مرة أخرى إلى الجزائر وإلى تلمسان أرض الطفولة والذكريات البريئة، وكأنما أنهى دورته حول العالم. عاد ليقرأ الحرب، لكنها ليست الحرب ضد المستعمِر كما كتبها في المحطة الأولى، إنها حرب أكثر فظاعة، إنها حرب الإرهاب الديني المتوحش، حرب الأخ ضد أخيه، والأب ضد ابنه، وفيها قراءة لعنف العشرية الدموية التي عاشتها الجزائر (1990-2000) دون السقوط في التصويرية المباشرة أو الخطابات الأيديولوجية المسطحة أو التقريرية الصحافية، ومن عناوينه المتميزة في هذه المرحلة يمكن التذكير بمجموعاته القصصية: “الليلة المتوحشة” و“شجرة الأقوال” و“سيمورغ” و“لايزا” ورواية “إذا شاء الشيطان”.
بمرور قرن على ولادة الكاتب والروائي الحكيم محمد ديب نتساءل: ماذا قدمت الجزائر لقلم بهذا التميز العالمي، وهو الذي كان اسمه على قائمة جائزة نوبل لمرات متتالية؟ ماذا قدمت له سوى الصمت والنكران؟ لم تطلق اسمه على مكتبة أو جامعة أو مؤسسة ثقافية أو تربوية معتبرة، لم تمنحه الجزائر الواسعة حتى بعض أمتار من ترابها كي يضم جسده النحيف وهو الذي عاش عاشقا للجزائر ولتلمسان ومات على عشقه هذا دون أن يبدل أو يتبدل.
أمين الزاوي
لم تكن الجزائر السياسية والأدبية والثقافية رحيمة بمحمد ديب لا في حياته ولا في مماته، فلقد ظل مهمشا، مضروبا عليه بالصمت القاتل، وهو القلم الذي أوصل صورة الجزائر قبل اندلاع الثورة إلى غرف نوم الكلونياليين في المتروبول وفي المستعمَرَة، ليؤرقهم في أسرّتهم، وهو يعري فظائع الاستعمار وهمجيته منذ أول عمل سردي نشره وهو “ثلاثية الجزائر: البيت الكبير- النول – الحريق”، كان ذلك بداية الخمسينات من القرن الماضي.
كانت هذه الثلاثية الروائية البسيطة في أسلوبها الشعري الشعبي ناقوسا أعلن بنبوءة أدبية عن موعد الثورة التحريرية التي اندلعت لاحقا في أول نوفمبر 1954.
ولم تكن الجزائر رحيمة بمحمد ديب في موته (توفي في 2 مايو 2003)، فقد دفن في تراب باريس البارد، محروما من دفء تراب مدينته التي أحبها، تلمسان، وأحب من خلالها الجزائر كلها. دفن في باريس وهو الذي كان منتظرا أن يوارى الثرى في مقبرة العظماء في بلاده، لكن النظام السياسي لم يكن منشغلا بكاتب بحجم محمد ديب، بل كان يفكر في أمر بقائه.
تجاهل النظامُ الجزائري نخبه من الدياسبورا المبدعة والمفكرة المتميزة عالميا، من أمثال محمد ديب ومحمد أركون ورابح بلعمري وجمال الدين بن الشيخ وعلي مراد… والذين ماتوا الواحد بعد الآخر، على امتداد عشرية واحدة تقريبا، ودفنوا جميعهم خارج البلد، ولم يحرك هذا النظام ساكنا.
عبر محمد ديب الحياة كاتبا كبيرا، وكلمة كبير لها معنى حين ترتبط باسم محمد ديب، عبرها روائيا و شاعرا وقصاصا ومسرحيا وكاتب أدب أطفال ومناضلا سياسيا وثقافيا إنسانيا. عشرات الروايات ومثلها المجاميع الشعرية والقصصية هي حصيلة مسيرته الأدبية، ستة عقود من الكتابة، وفي كل ذلك ظل وفيا لخطه الإنساني، لم يبدل ولم يتبدل.
يمكن قراءة تجربة محمد ديب الإبداعية الممتدة على مدى ستين سنة وفق ثلاث محطات أساسية. المحطة الأولى التي تغطي سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية وتمتد حتى استقلال الجزائر العام 1962، وفيها نكتشف انخراطه بشكل قوي وعضوي في معركة التحرير والاستقلال، نصوص مقاومة بسردية شعبية للاستعمار وأجهزته القمعية العسكرية والسياسية والاقتصادية والهوياتية، وهي مرحلة كتب فيها نصوصا روائية وقصصية خالدة، تعد بالفعل شهادة عن المعركة التحريرية للمجتمع بطبقته الفقيرة المحرومة والمنسجمة مع نخبه الطليعية التي تنير الطريق نحو الانعتاق والحرية، ويمكن ذكر “ثلاثية الجزائر: الدار الكبيرة – النول – الحريق” وأيضا مجموعته القصصية “في المقهى”، وتميزت الكتابة عند محمد ديب في هذه الفترة بالواقعية الاجتماعية على طريقة بلزاك، ولكن بحس محلي شعبي جزائري، وفيها حاول محمد ديب نفخ الروح الشعبية الجزائرية في اللغة الفرنسية.
أما المحطة الثانية فتمتد من روايته “من الذي يذكر البحر” مرورا بروايته الاستثنائية “هابيل” (وقد قمتُ بترجمتها إلى العربية) وصولا إلى “ثلاثية الشمال: سطوح أرصول – إغفاءة حواء – ثلوج من رخام” ونصوص شعرية أخرى كـ”الفجر إسماعيل”، وتميزت هذه المحطة بكتابة معقدة جدا، على مستوى البناء السردي كما على مستوى النحت اللغوي الذي استثمره في محاصرة أفكاره المعقدة الغارقة في التصوف الإسلامي واليهودي “الكابالا”، ورسم العوالم الداخلية وطرح أسئلة الوجود والخلق والمعاملات، كما أن كتابة ديب في هذه المرحلة تناغمت قليلا مع بعض أساليب مدرسة الرواية الفرنسية الجديدة، بل تجاوزتها. وفي هذه المرحلة خرج ديب نهائيا من الكتابة الواقعية وابتعد عن سؤال “المحلي الجزائري” ليدخل سؤال “الإنسان”، سؤال “الوجود والغموض والمصير”.
أما المحطة الثالثة فقد عاد فيها محمد ديب مرة أخرى إلى الجزائر وإلى تلمسان أرض الطفولة والذكريات البريئة، وكأنما أنهى دورته حول العالم. عاد ليقرأ الحرب، لكنها ليست الحرب ضد المستعمِر كما كتبها في المحطة الأولى، إنها حرب أكثر فظاعة، إنها حرب الإرهاب الديني المتوحش، حرب الأخ ضد أخيه، والأب ضد ابنه، وفيها قراءة لعنف العشرية الدموية التي عاشتها الجزائر (1990-2000) دون السقوط في التصويرية المباشرة أو الخطابات الأيديولوجية المسطحة أو التقريرية الصحافية، ومن عناوينه المتميزة في هذه المرحلة يمكن التذكير بمجموعاته القصصية: “الليلة المتوحشة” و“شجرة الأقوال” و“سيمورغ” و“لايزا” ورواية “إذا شاء الشيطان”.
بمرور قرن على ولادة الكاتب والروائي الحكيم محمد ديب نتساءل: ماذا قدمت الجزائر لقلم بهذا التميز العالمي، وهو الذي كان اسمه على قائمة جائزة نوبل لمرات متتالية؟ ماذا قدمت له سوى الصمت والنكران؟ لم تطلق اسمه على مكتبة أو جامعة أو مؤسسة ثقافية أو تربوية معتبرة، لم تمنحه الجزائر الواسعة حتى بعض أمتار من ترابها كي يضم جسده النحيف وهو الذي عاش عاشقا للجزائر ولتلمسان ومات على عشقه هذا دون أن يبدل أو يتبدل.
أمين الزاوي