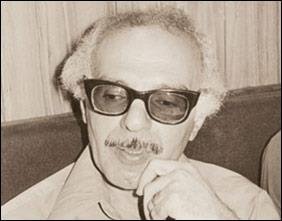تعرفت على البشير جمكار في نهاية العقد الستيني الماضي (بين 1968 و1969) عن طريق صديقنا القاص الكبير إدريس الخوري. تم التعارف في حي المعاريف بالدار البيضاء، وبمقهى»La presse» الرياضية الشهيرة، التي كان يرتادها ابّا ادريس بانتظام، يجلس في لاتيراس ماداً رجليه، وهو ينفخ في الهواء دخان كازاسبور. أذكر أني تعرفت على المرحوم البشير صبيحة ذات أحد، حين تتحول»لابريس»إلى خلية نحل من لاعبي التييرسي، وثرثرة صغار الموظفين ومستخدمي الشركات، وصفقات سماسرة العقار، إضافة إلى بعض أفراد من جالية السبنيول والبرطقيز.. وبصفة خاصة أبناء «درب غلّف» الواقع شمال شرقي المعاريف يتزعمهم الشاعر ورجل المواهب المتعددة أحمد صبري، الملقب آنئذ ب»الجنّ».
رأيت البشير يقبل محتشما بقامة متوسطة، أقرب إلى النحول، وبوجه ذي سمرة حادة، وشعر فاحم السواد، ناعمه. كان فعلا ذا وجه مليح، وصوت هادئ، وبشاشة لا تنقطع. مذها عرفته منصتا أكثر منه متكلما، ومن يجرؤ على الكلام أمام»الجن»، الذي عقيرته تصطخب في المكان، يخوض في مواضيع النيا والآخرة، وجميع الأزمنة، وعليك أن تجمع الفصحى والعامية والفرنسية،والعامية الفرنسية،زيادة عن»غوص»درب غلف،و»بذاءات»أولاد الدرب الظريفة، لتصل إلى قصده، ولن تصل! كان البشير من أولاد الدرب هؤلاء، وإن لم يكن حقا من طينتهم،لأنني سأدرك تدريجيا أن الرجل وهو يبدو غُفلا ومندمجا، يسعى للتفرد بطينة خاصة به، حتى ولو لم يعترف بها الآخرون،الذين يريدون منك أن تشبههم دائما؛ ومثل أولاد دربه اؤلئك فهو ينتقل إلى المعاريف ليفوّج عن نفسه، مثل المغاربة ينتقلون من أحيائهم الشعبية يوم الأحد يذهبون إلى»لمدينة»،إلى»Centre» كأنهم يسكنون في البوادي والحقول. المدينة هناك، وهي قريبة، حيث «النصارى» أو كانو.. وهو يأتي دائما نظيفا، حسن الهندام على قدر الاستطاعة. شعره مصفف وملمع ومخرّص أحيانا. إنه في يوم عطلة، وهو رجل معلم،تحس به مرتاحا ويريد بطرق شتى وبسيطة أن يغنم يوم راحته،وإذا دخن فباستحياء..لكن البشير عموما لم يكن من رواد لابريس،اؤلئك الصناديد الذين يقفون وراء الكونطوار ساعات وهم يتساقون أربعا في أربع. عرفته بسيطا بعفوية، دمثا، معتدلا في كل شيء، نصف» مديني»، نصف»عروبي»غير لجوج ولا مماحك، قريب إلى تصديق كل ما يقال له وحوله، مقتصد في مصروفه،لأنه يعول دائما على نفسه، ولم يتوقف يوما عن بناء هذه النفس بطرق شتى كانت الكتابة، والعمل الدؤوب، والكسب الحلال أقواها، وبذا فإن أهم خصلة في الراحل طبعت حياته كلها وميزت شخصيته هي عصاميته.
إنما الحالة المركزية عنده،على الزمن الذي أتحدث عنه،هي علاقته بصاحب «حزن في الرأس وفي القلب»، فيها الحل والعقد، عندي على الأقل، ومنها تتجمع الخيوط وتتفرق. عمليا يعتبر البشير أن»لابريس» ليس عالمه، ولا هواه فيها. راح يبحث عن هواه في مكان آخر، ويركزه في بؤرة مختلفة، وطريقه إليها بدأت من تعارفه مع ولد الدرب إدريس الكص في درب غلف،الذي انتقل إلى السكنى في زنقة «فوريز» بالمعاريف، وهو عاطل، و»طابّّي» (بلغته)، في تلك السطيحة المعلنة الشهيرة، برعاية وعناية منتظمة من الراحل. من المؤكد أن ما جمعهما، أوبالأحرى جعل سعي هذا الأخير إلى صاحبه، من سيصبح شيخه، هو «الكتابة» هذا العالم الواسع، الغامض، والدغل الكثيف الذي ظل البشير حياة طويلة يبحث له فيها عن طريق وموقع وأداة للتعبير عن مواجعه ومشاغله، وإحساس ظل يلازمه بوجود الظلم في المجتمع،وهو باعتباره أحد المظلومين، لمجرد لانتمائه إلى محيط بسيط ومتواضع. ظل دليله وهديه زمنا لشق هذا الطريق هو ابا ادريس،أي في البداية، و»وسط الطريق»، وبعد ذلك تفرقت بهما وبنا السبل،» ومضى كل إلى غايته». سأحاول أن ألم من الذاكرة بعض الشتات:
كان البشير أول ما يحضر في الصبيحة يجتمع إلى شيخه في مقهى صغير على بعد خطوات عن لابريس تقع في راس الزنقة، هنا القهوة وأتاي،» فقط،لا غير!» فينتقل سيدي حبيبي على مضض لمجالسة المريد الذي يبدأ بالحديث والسؤال، مستفسرا، ومتلعثما،عن الأدب بصفة عامة، والقصة القصيرة، بصفة خاصة. يتنقل البشير من سؤال وموضوع إلى آخر، وقراءة وأخرى، معبرا عن إحساس مرتبك، ورغبة حذرة في الكتابة، ودائما بعبارات متقطعة، وقبالته من «ينبه» ويعترض، ويوجه في الوقت نفسه. كان ابا ادريس ما زال بدوره يشق طريقه ويبحث له عن مكان آمن في غابة الدار البيضاء التي ليست له، وعالم الكتابة الذي يؤثته تدريجيا بالكتب، و»لمّاسق»، والأعلام في سطيحة فوريز، وعلى صفحات بعض المجلات والجرائد،»العلم» خاصة ب»مذكرات تحت الشمس» وبعض القصص، هناك حيث كان هو والراحل محمد زفزاف كفرسي رهان، يجذران مفهوما متطورا نوعا ما للواقعية، بحساسية ذاتية ورؤية ذاهبة نحو الانفتاح، تحاول أن تقطع مع واقعية هادفة جدا حد الفجاجة.
في هذا المحيط، المعاريف دائما،كوسط حضري مديني، كان هناك أحمد جارك، الموسوس جدا بالقصة القصيرة، وأمور أخرى، والذي فاجأ الجميع بموته، وتحوله. وبالطبع، أحمد الجوماري القادم بدوره من خارج هذا الوسط، منتقلا من الحي المحمدي، من زنقة أبي علي القالي، حاملا معه هوس مناصرة فريق الطاس، إلى أن يظهر الحق،، ومحمد زفزاف القادم من برزخ القنيطرة الرباط ليعلم الدراري في «ظهر ولد عيشة» ويحفر دقيقا وعميقا في تجاويف القص الذي سيصبح من أعلامه مغربيا وعربيا، وهما معا يحدبان على البشير، يجرؤ عل الاقتراب من الجوماري أكثر لرومانسيته، وتطبعه،أيضا، بعقلية»ولد الدرب» بينما يظل على مسافة من زفزاف،هذا الواقعي،العقلاني، ولأنه كان يهابه؛أوليس من قامة شيخه؟!
أحمد المجاطي، وأنا، كنا نتردد على المعاريف فقط،لأنها هي ما كان ينزل إلينا في مدينتنا المترامية بين»مرس السلطان» و»شارع محمد الخامس» والبشير تبقى مدينته دائما هي المعاريف، وبلاده هي درب غلف، مع أماكن أخرى ينتقل إليها وحده لم ألتق به باستثناء مناسبات ثقافية محدودة أبعد منه، لنعلم أنه كان من فصيلة ثعلب زفزاف» يظهر ويختفي»، ولكنه لم يكن ماكرا أبدا، وإنما امتلك حذرا فطريا، يتراوح بين الخجل والحيطة،والرغبة في عدم التورط،لأنه وقتها، بخلاف ابا ادريس،»مولى اوليدات»،وتحضرني عبارته كلما حاولنا إغراءه بمرافقة مزاجنا: «آبا احمد، بصراحة انتوما واعرين عليا!».
في نهاية الستينات، تلك، ومطالعها، كان حال الأدب والثقافة عموما، ووضع الكاتب، شيئا
مختلفا تماما عن راهننا الغريب، وشبه المفلس اليوم. لا مجال للإسهاب هنا في هذه القضية،
كل ما في الأمر أن الإيمان بالكتابة كأداة للانتماء والالتزام الاجتماعي والوطني لا يعدله
شيء، كما أن العبور إلى ضفتها، والوجود في سياقها وحسب مقتضياتها الجدية كان يتطلب
جهدا حقيقيا ودأبا بلا انقطاع، وهراءٌ ما يردده بعض معوّقي الأدب اليوم من أن المرحلة تلك
انحصرت في شروط إيديولوجية الالتزام بها كفيل لتأهيل الكاتب ومروره إلى مجال النشر.
إن هذا يساعد بعضهم الآن على التحلل من أي التزام ، بما في ذلك قواعد النحو والإملاء،
دعك من افتقار الموهبة أساسا، وهي مطلوبة في كل وقت. أسوق هذا وأنا أتذكر كم عانى
الراحل جمكار، وهو يحاول أن يضع قدميه في الأرض الزلقة للقصة القصيرة، حسب أن
نقل صعاب معينة لأفراد وتصوير حالات اجتماعية لفئات محرومة كاف لتأهيل فني دون تمثل خصائص وضبط عيار الفن ذاته، كما أن بعض نقاشه مع شيخه انصب على رغبة متعجلة منه للنشر،كان ابا ادريس يكبحها، بالأحرى يحاول تأجيلها إلى أن تتستوي» الطبخة» نوعا ما،ولم يك يفعل هذا معه وحده، ولا هو بمفرده، فلكم قصد زفزاف أفرادٌ يحملون قراطيس محشوة بكثير لايجد فيها هو إلا أقل القليل، فيحاول أن يهديهم سواء السبيل، بما أوتي من حنكة وصبر وحسن تخلص،أيضا. لقد كانت طريق الأدب شاقة حقا، وطفق جمكار يستشعر ذلك وقد خاض عاما بعد عام غمار القص، والنشر، أيضا، في عدد من الدوريات واليوميات، هنا وهناك. هكذا تعلم الرجل الدأب والمثابرة، كما فعل في كل شؤون حياته، وهو ما يحتاج إليه الكاتب حقا، أما تقويم أعماله من النواحي المخصوصة بها فذلك شأن آخر، خارج عن هذا المقام.
ولعل آخر ما يمكن أن أقف عنده، وعرفته عن كثب من شؤونه الشخصية انتقاله الحاسم إلى
منطقة النواصر، بضاحية برشيد،المعروفة اليوم باتساعها الصناعي ومجال النقل الجوي.
بين عشية وضحاها، انتقل البشير، غادر الدار البيضاء، ليمارس التعليم هناك. كان يعي جيدا ما يفعل، الحقيقة أنه أراد فعل نوع من العودة إلى الجذور، رغم أن النواصر قريبة، إلا أنها منذئذ، قبل ثلاثين عاما كانت ريفا بعد، ريف ارتاح إليه دائما، وبين أجوائه وأسواقه تنقل وفيها جال وتبضع،لا عجب أن يكون للون بشرته خصوبة أرض التيرس المشهورة في الشاوية، فضلا عن طباع متأصلة فيه، لم أحسست أنه،على قلة احتكاكي به، وهجرتي التي نأت بي عن عالمه، يريد التمسك بها للضعن أبدا في بداوته، والحذر من أخلاق المدينة، لذلك كنت تسمعه يفكر بصوت مرتفع وهو يديم طرح السؤال تلو السؤال، لا يحفل بكثير من الشكليات والمواضعات، ربما لهذا السبب ظلت علاقته بالكتابة موسومة إلى حد بالمعالجة المباشرة والاحتفاء بأكثر ما هو شعبي، شعبوي أحيانا، وعلى قدر كبير من الإخلاص للنفس ومحيطها،ما أسعده.. حيا وميتا. وهذا شأن مهم في مسار من اختط لنفسه هذا الطريق، وتبقى مسألة الإنصاف من عدمها نسبية، ومرتهنة لشروط ليست عرضية ولا أخلاقية، فالكاتب كتابته قبل كل شيء، والبقية تأويل وخميل. فلا الطيبة تصنع أدبا، ولا الفظاظة تنقص منه .
غادر إدريس الخوري قبله إلى الرباط للعمل في جريدة «العلم» قبل أن يعود إلى كازا برحاب الباطوار، في «المحرر». ما أعرفه أن المريد لم ينقطع عن شيخه خلال هذه المدة، بل ظل يزوره كما ليتبرك، يحمل له دائما الباروك الذي كان جمكار يعرف مادته البدوية. ومرة التقيته صدفة بالبيضاء فعاتبته مازحا عن انقطاعه، فاحتج أنه لم يسل صاحبه أبدا، وحديث القصة بينهما لم ينقطع، من غير أن أعرف محتواه أو نبرته ولا سعيت إلى ذلك بعد أن بدأ الزمن يتغير، وغادرت إلى باريس لتنقطع صلتي بالمرحوم، وإن لم تبرح صورته ذاكرتي،وقبله صور الأدباء الأفذاذ الخلان: أحمد المجاطي، أحمد الجوماري، محمد زفزاف،
وشهداء ومناضلو الدار اليضاء والمغرب كثر في قرة العين منهم الحبيبان عمر بن جلون ومصطفى القرشاوي، يأتي هذا الرحيل الجديد لقاص وإنسان فريد في كلماته وشيمه ليذكرنا بأن الأدب، والقص تحديدا لعبة جدية، وأن الحياة ُتبنى ساعة ساعة بالإيمان والإخلاص والوفاء، كما تستمر بالمثابرة والمحبة، لعمري كلها اجتمعت فيك يا البشير، فأبشر.
أحمد المديني
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 05 - 2009
رأيت البشير يقبل محتشما بقامة متوسطة، أقرب إلى النحول، وبوجه ذي سمرة حادة، وشعر فاحم السواد، ناعمه. كان فعلا ذا وجه مليح، وصوت هادئ، وبشاشة لا تنقطع. مذها عرفته منصتا أكثر منه متكلما، ومن يجرؤ على الكلام أمام»الجن»، الذي عقيرته تصطخب في المكان، يخوض في مواضيع النيا والآخرة، وجميع الأزمنة، وعليك أن تجمع الفصحى والعامية والفرنسية،والعامية الفرنسية،زيادة عن»غوص»درب غلف،و»بذاءات»أولاد الدرب الظريفة، لتصل إلى قصده، ولن تصل! كان البشير من أولاد الدرب هؤلاء، وإن لم يكن حقا من طينتهم،لأنني سأدرك تدريجيا أن الرجل وهو يبدو غُفلا ومندمجا، يسعى للتفرد بطينة خاصة به، حتى ولو لم يعترف بها الآخرون،الذين يريدون منك أن تشبههم دائما؛ ومثل أولاد دربه اؤلئك فهو ينتقل إلى المعاريف ليفوّج عن نفسه، مثل المغاربة ينتقلون من أحيائهم الشعبية يوم الأحد يذهبون إلى»لمدينة»،إلى»Centre» كأنهم يسكنون في البوادي والحقول. المدينة هناك، وهي قريبة، حيث «النصارى» أو كانو.. وهو يأتي دائما نظيفا، حسن الهندام على قدر الاستطاعة. شعره مصفف وملمع ومخرّص أحيانا. إنه في يوم عطلة، وهو رجل معلم،تحس به مرتاحا ويريد بطرق شتى وبسيطة أن يغنم يوم راحته،وإذا دخن فباستحياء..لكن البشير عموما لم يكن من رواد لابريس،اؤلئك الصناديد الذين يقفون وراء الكونطوار ساعات وهم يتساقون أربعا في أربع. عرفته بسيطا بعفوية، دمثا، معتدلا في كل شيء، نصف» مديني»، نصف»عروبي»غير لجوج ولا مماحك، قريب إلى تصديق كل ما يقال له وحوله، مقتصد في مصروفه،لأنه يعول دائما على نفسه، ولم يتوقف يوما عن بناء هذه النفس بطرق شتى كانت الكتابة، والعمل الدؤوب، والكسب الحلال أقواها، وبذا فإن أهم خصلة في الراحل طبعت حياته كلها وميزت شخصيته هي عصاميته.
إنما الحالة المركزية عنده،على الزمن الذي أتحدث عنه،هي علاقته بصاحب «حزن في الرأس وفي القلب»، فيها الحل والعقد، عندي على الأقل، ومنها تتجمع الخيوط وتتفرق. عمليا يعتبر البشير أن»لابريس» ليس عالمه، ولا هواه فيها. راح يبحث عن هواه في مكان آخر، ويركزه في بؤرة مختلفة، وطريقه إليها بدأت من تعارفه مع ولد الدرب إدريس الكص في درب غلف،الذي انتقل إلى السكنى في زنقة «فوريز» بالمعاريف، وهو عاطل، و»طابّّي» (بلغته)، في تلك السطيحة المعلنة الشهيرة، برعاية وعناية منتظمة من الراحل. من المؤكد أن ما جمعهما، أوبالأحرى جعل سعي هذا الأخير إلى صاحبه، من سيصبح شيخه، هو «الكتابة» هذا العالم الواسع، الغامض، والدغل الكثيف الذي ظل البشير حياة طويلة يبحث له فيها عن طريق وموقع وأداة للتعبير عن مواجعه ومشاغله، وإحساس ظل يلازمه بوجود الظلم في المجتمع،وهو باعتباره أحد المظلومين، لمجرد لانتمائه إلى محيط بسيط ومتواضع. ظل دليله وهديه زمنا لشق هذا الطريق هو ابا ادريس،أي في البداية، و»وسط الطريق»، وبعد ذلك تفرقت بهما وبنا السبل،» ومضى كل إلى غايته». سأحاول أن ألم من الذاكرة بعض الشتات:
كان البشير أول ما يحضر في الصبيحة يجتمع إلى شيخه في مقهى صغير على بعد خطوات عن لابريس تقع في راس الزنقة، هنا القهوة وأتاي،» فقط،لا غير!» فينتقل سيدي حبيبي على مضض لمجالسة المريد الذي يبدأ بالحديث والسؤال، مستفسرا، ومتلعثما،عن الأدب بصفة عامة، والقصة القصيرة، بصفة خاصة. يتنقل البشير من سؤال وموضوع إلى آخر، وقراءة وأخرى، معبرا عن إحساس مرتبك، ورغبة حذرة في الكتابة، ودائما بعبارات متقطعة، وقبالته من «ينبه» ويعترض، ويوجه في الوقت نفسه. كان ابا ادريس ما زال بدوره يشق طريقه ويبحث له عن مكان آمن في غابة الدار البيضاء التي ليست له، وعالم الكتابة الذي يؤثته تدريجيا بالكتب، و»لمّاسق»، والأعلام في سطيحة فوريز، وعلى صفحات بعض المجلات والجرائد،»العلم» خاصة ب»مذكرات تحت الشمس» وبعض القصص، هناك حيث كان هو والراحل محمد زفزاف كفرسي رهان، يجذران مفهوما متطورا نوعا ما للواقعية، بحساسية ذاتية ورؤية ذاهبة نحو الانفتاح، تحاول أن تقطع مع واقعية هادفة جدا حد الفجاجة.
في هذا المحيط، المعاريف دائما،كوسط حضري مديني، كان هناك أحمد جارك، الموسوس جدا بالقصة القصيرة، وأمور أخرى، والذي فاجأ الجميع بموته، وتحوله. وبالطبع، أحمد الجوماري القادم بدوره من خارج هذا الوسط، منتقلا من الحي المحمدي، من زنقة أبي علي القالي، حاملا معه هوس مناصرة فريق الطاس، إلى أن يظهر الحق،، ومحمد زفزاف القادم من برزخ القنيطرة الرباط ليعلم الدراري في «ظهر ولد عيشة» ويحفر دقيقا وعميقا في تجاويف القص الذي سيصبح من أعلامه مغربيا وعربيا، وهما معا يحدبان على البشير، يجرؤ عل الاقتراب من الجوماري أكثر لرومانسيته، وتطبعه،أيضا، بعقلية»ولد الدرب» بينما يظل على مسافة من زفزاف،هذا الواقعي،العقلاني، ولأنه كان يهابه؛أوليس من قامة شيخه؟!
أحمد المجاطي، وأنا، كنا نتردد على المعاريف فقط،لأنها هي ما كان ينزل إلينا في مدينتنا المترامية بين»مرس السلطان» و»شارع محمد الخامس» والبشير تبقى مدينته دائما هي المعاريف، وبلاده هي درب غلف، مع أماكن أخرى ينتقل إليها وحده لم ألتق به باستثناء مناسبات ثقافية محدودة أبعد منه، لنعلم أنه كان من فصيلة ثعلب زفزاف» يظهر ويختفي»، ولكنه لم يكن ماكرا أبدا، وإنما امتلك حذرا فطريا، يتراوح بين الخجل والحيطة،والرغبة في عدم التورط،لأنه وقتها، بخلاف ابا ادريس،»مولى اوليدات»،وتحضرني عبارته كلما حاولنا إغراءه بمرافقة مزاجنا: «آبا احمد، بصراحة انتوما واعرين عليا!».
في نهاية الستينات، تلك، ومطالعها، كان حال الأدب والثقافة عموما، ووضع الكاتب، شيئا
مختلفا تماما عن راهننا الغريب، وشبه المفلس اليوم. لا مجال للإسهاب هنا في هذه القضية،
كل ما في الأمر أن الإيمان بالكتابة كأداة للانتماء والالتزام الاجتماعي والوطني لا يعدله
شيء، كما أن العبور إلى ضفتها، والوجود في سياقها وحسب مقتضياتها الجدية كان يتطلب
جهدا حقيقيا ودأبا بلا انقطاع، وهراءٌ ما يردده بعض معوّقي الأدب اليوم من أن المرحلة تلك
انحصرت في شروط إيديولوجية الالتزام بها كفيل لتأهيل الكاتب ومروره إلى مجال النشر.
إن هذا يساعد بعضهم الآن على التحلل من أي التزام ، بما في ذلك قواعد النحو والإملاء،
دعك من افتقار الموهبة أساسا، وهي مطلوبة في كل وقت. أسوق هذا وأنا أتذكر كم عانى
الراحل جمكار، وهو يحاول أن يضع قدميه في الأرض الزلقة للقصة القصيرة، حسب أن
نقل صعاب معينة لأفراد وتصوير حالات اجتماعية لفئات محرومة كاف لتأهيل فني دون تمثل خصائص وضبط عيار الفن ذاته، كما أن بعض نقاشه مع شيخه انصب على رغبة متعجلة منه للنشر،كان ابا ادريس يكبحها، بالأحرى يحاول تأجيلها إلى أن تتستوي» الطبخة» نوعا ما،ولم يك يفعل هذا معه وحده، ولا هو بمفرده، فلكم قصد زفزاف أفرادٌ يحملون قراطيس محشوة بكثير لايجد فيها هو إلا أقل القليل، فيحاول أن يهديهم سواء السبيل، بما أوتي من حنكة وصبر وحسن تخلص،أيضا. لقد كانت طريق الأدب شاقة حقا، وطفق جمكار يستشعر ذلك وقد خاض عاما بعد عام غمار القص، والنشر، أيضا، في عدد من الدوريات واليوميات، هنا وهناك. هكذا تعلم الرجل الدأب والمثابرة، كما فعل في كل شؤون حياته، وهو ما يحتاج إليه الكاتب حقا، أما تقويم أعماله من النواحي المخصوصة بها فذلك شأن آخر، خارج عن هذا المقام.
ولعل آخر ما يمكن أن أقف عنده، وعرفته عن كثب من شؤونه الشخصية انتقاله الحاسم إلى
منطقة النواصر، بضاحية برشيد،المعروفة اليوم باتساعها الصناعي ومجال النقل الجوي.
بين عشية وضحاها، انتقل البشير، غادر الدار البيضاء، ليمارس التعليم هناك. كان يعي جيدا ما يفعل، الحقيقة أنه أراد فعل نوع من العودة إلى الجذور، رغم أن النواصر قريبة، إلا أنها منذئذ، قبل ثلاثين عاما كانت ريفا بعد، ريف ارتاح إليه دائما، وبين أجوائه وأسواقه تنقل وفيها جال وتبضع،لا عجب أن يكون للون بشرته خصوبة أرض التيرس المشهورة في الشاوية، فضلا عن طباع متأصلة فيه، لم أحسست أنه،على قلة احتكاكي به، وهجرتي التي نأت بي عن عالمه، يريد التمسك بها للضعن أبدا في بداوته، والحذر من أخلاق المدينة، لذلك كنت تسمعه يفكر بصوت مرتفع وهو يديم طرح السؤال تلو السؤال، لا يحفل بكثير من الشكليات والمواضعات، ربما لهذا السبب ظلت علاقته بالكتابة موسومة إلى حد بالمعالجة المباشرة والاحتفاء بأكثر ما هو شعبي، شعبوي أحيانا، وعلى قدر كبير من الإخلاص للنفس ومحيطها،ما أسعده.. حيا وميتا. وهذا شأن مهم في مسار من اختط لنفسه هذا الطريق، وتبقى مسألة الإنصاف من عدمها نسبية، ومرتهنة لشروط ليست عرضية ولا أخلاقية، فالكاتب كتابته قبل كل شيء، والبقية تأويل وخميل. فلا الطيبة تصنع أدبا، ولا الفظاظة تنقص منه .
غادر إدريس الخوري قبله إلى الرباط للعمل في جريدة «العلم» قبل أن يعود إلى كازا برحاب الباطوار، في «المحرر». ما أعرفه أن المريد لم ينقطع عن شيخه خلال هذه المدة، بل ظل يزوره كما ليتبرك، يحمل له دائما الباروك الذي كان جمكار يعرف مادته البدوية. ومرة التقيته صدفة بالبيضاء فعاتبته مازحا عن انقطاعه، فاحتج أنه لم يسل صاحبه أبدا، وحديث القصة بينهما لم ينقطع، من غير أن أعرف محتواه أو نبرته ولا سعيت إلى ذلك بعد أن بدأ الزمن يتغير، وغادرت إلى باريس لتنقطع صلتي بالمرحوم، وإن لم تبرح صورته ذاكرتي،وقبله صور الأدباء الأفذاذ الخلان: أحمد المجاطي، أحمد الجوماري، محمد زفزاف،
وشهداء ومناضلو الدار اليضاء والمغرب كثر في قرة العين منهم الحبيبان عمر بن جلون ومصطفى القرشاوي، يأتي هذا الرحيل الجديد لقاص وإنسان فريد في كلماته وشيمه ليذكرنا بأن الأدب، والقص تحديدا لعبة جدية، وأن الحياة ُتبنى ساعة ساعة بالإيمان والإخلاص والوفاء، كما تستمر بالمثابرة والمحبة، لعمري كلها اجتمعت فيك يا البشير، فأبشر.
أحمد المديني
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 05 - 2009