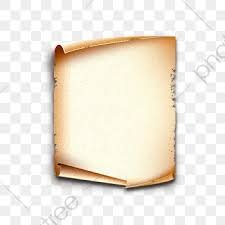منذ هزتني رياح رغبة الكتابة كان ما أراه منشوراً هو نصوص كبار الكتاب ، ودواوين الشعراء القدماء، وفي تلك اللحظة البعيدة من طفولتي ، يوم خططت حروفي الأولى ، شتاء سنة 1962 لم يكن في غرفتي الخاصة، غير كلمات الكبار من كتاب العصور السابقة، أو إبداعات عصر النهضة العربية: بإحيائييها ورومانسييها، من الشعراء العرب الذين كانت قاماتهم عالية جدا، أمام نظر القارئ الطفل الذي كنته، وما أن اكتشفت بعض أشعار المغاربة فيما كان قد تراكم في بيتنا من أعداد مجلة (دعوة الحق)،ومجلات مغربية أخرى، حتى بدأت أحس ببعض الألفة، فعلى الصفحات الأخيرة من أحد أعداد المجلة المذكورة،كان قد صدر أواخر الخمسينات قرأت خبراً عن نية الشاعر المرحوم مصطفى المعداوي إصدار ديوانه، وأتذكر أنني ذات جلسة على الغداء مع عائلتي قد عبرتُ عن مثل تلك النية، ولم يكن قد مضى على بدايتي الكتابة إلا أشهر، فلم يستطع التعليق أحد غير أبي قائلاً: لا تتعجل، أو كلاما يفيد نفس المعنى، فلم أعد إلى التعبير عن مثل نيتي تلك ، حتى بعد أن مضت سنون طويلة، رأيت من أصدقائي في كلية الآداب بفاس من يدفعون بقصائدهم الأولى إلى المطبعة، بل لقد كنت أرافق الشاعر الصديق محمد بنيس إلى مطبعة النهضة وهو يقف على طبع ديوانه الأول (ما قبل الكلام) دون أن تحدثني نفسي على أن أجرؤ على أن أفعل مثله، حتى ولو أن ما كان قد نشر لي من قصائد بالملحق الثقافي لجريدة العلم ، يزيد كمّاً على ما كان قد ظهر لهذا الشاعر الصديق. وقد كنت مكثراً حقاً، لا أكاد أكتب القصيدة ليلاً، حتى أبعث بها إلى النشر صبيحة اليوم التالي، وقد كنت بالفعل أكتب برغبة جامحة، لا أهتم بما أجهله، وإن كنت أتوقف لبعض الوقت، أمام بعض الكتابات التنظيرية، محاولا تلمس الإجابة عن بعض ما كان يحيرني من أسئلة الإبداع الشعري ، إلا أن أكثر ما كنت أتتبعه كان إبداعات الشعراء خاصة، ولقد كان أكثر ما يغريني في الكتابة التعبير عن عوالمي الذاتية، واستبطان تجارب حياتي، ومواقفي الخاصة ونظرتي إلى العالم والأشياء، في مرحلة أُدِنتٌ فيها بالفردية والارتداد ، إذ كان النقد الإيديولوجي يرفع في أوجهنا شعارات الواقعية، ويدعو إلى سقوط كل ما عداها.
وفي فترة الأحلام الأولى وأنا مازلت على مشارف عامي الثالث العشرين ،مع بداية السبعينات، بدأت رغبة الكتاب الأول تنتابني ، وقد انتقلت إلى الدارالبيضاء ،صحبة كثير من أصدقائي في آداب فاس والرباط ،فكنتُ إذا عدت إلى شفشاون ، استغرقني التأمل في ما أعانيه، من احتياجات، مادية وفكرية، وقد أصبحت أستاذاً، لم يكن بينها الزواج مثلا، بل ظل الشعر حاجتي الأولى، ودوافع تثيرها تجربة الكتابة، من بينها هاجس تلك الرغبة، خاصة وأنني لم أنقطع أو أتوقف عن الكتابة.
ذات مساء ، وقد تأخر بي الجلوس في مقهى ال (كوت دازور ) بشارع 11يناير بوسط الدار البيضاء، فاجأني وأنا أقرأ مسرحية لنعمان عاشور ، أظن أنها كانت (برج المدابغ) الصديق عبد الغفار العاقل ، الذي أخذ مني الكتاب الذي كان بين يدي وجعل يزنه على كفه اليمنى كما توزن أي بضاعة ، مما أثار ني : فقلت له: ما هكذا يعرف وزن الكتاب ، فقال لي : أعرف، ولكني أريد معرفة ما يتعلق بوزن ورقه، ونوعيته،فأنا أعمل في هذه الأيام، بمطبعة دار النشر المغربية ، وإذا كان لديك ما تريد طبعه ... وقبل أن يتم قلت له : أرجوك لا تسخر مني ، فكيف تستطيع طبع شيء وأنت جديد على الدار، فقال لي ، والله العظيم ، إنني لجاد ،فلم أصدقه : ووضعت أمامه شرطاً يستطيع أن يحد من سخريته، قائلا: إذا كنت حقا جادا، فأنا أقترح عليك أن تطبع ديوانين لشاعرين أنا متأكد من أننا نشترك في تقديرهما ، هما الشاعران عبد الكريم الطبال ومحمد الميموني ، ثم يأتي كتابي أنا بعدهما.
وما زلت إلى اليوم، لا أعرف من أملى عليَّ مثل هذا الشرط، خاصة وأن كلا من الشاعرين المذكورين كان يعيش في جهة بعيدة عني ، الأول: في شفشاون. والثاني: في تطوان. فهل كنت أريد إحراج صديقي تلك الليلة؟
أم هل كنت أريد أن أرد بعض الجميل لشاعرين أقدرهما حقاً، وأعرف أن صديقي كان يعزهما بنفس القدر؟ أم أنني لم أكن أصدق اقتراح الصديق عبد الغفارالعاقل، الذي فوجئ بطلبي، ولم أدر نوع الشعور الذي انتابه، وهو يقول لي: أتركْ لي مهلة يوم واحد، أستشير فيه مدير دارالنشر مصطفى عمار، ولنلتق غدا في نفس الموعد هنا.
وفي مساء اليوم التالي ، أتاني صديقي مستبشراً، يطلب مني أن أتصل بالشاعر الصديق عبد الكريم الطبال ,وبشقيقي محمد الميموني طالبا منهما أن يوافياني بديوانين تطبعهما دار النشر المغربية، فكان أن حظي الشعر المغربي بديوان رائدين هما: ( الأشياء المنكسرة) لصديقي الشاعر عبد الكريم الطبال، وديوان( آخر أعوام العقم ) لشقيقي الشاعر محمد الميموني، . اللذين ظهرا قبل ديواني الأول (تخطيطات حديثة في هندسة الفقر) ،فهل كنت في تلك الليلة، تحت تأثير روح صوفية، حملتني إلى أن أخلص الود لشاعرين كانا أول من قرأ كلماتي الأولى ، يوم حمل شقيقي إلى صديقه دفترًا مدرسياً ، امتلأت أوراقه عن آخرها، بما كان طفل الثالثة عشرة ، في ذلك الشتاء البعيد سنة 1962 يسميه أشعاره الأولى، التي ضاعت كأوراق ، وإن لم تضع الرغبة التي ولدت معها في أعماقي وما زالت إلى الآن..
أذكر أن ذلك كان ذات يوم ، من شهر غشت1974، وقد كنت مشردا في الدار البيضاء ، أو كالمشرد، وقد صورَْت بعضُ قصائدي في كتابي الأول ما كنت أعيش عليه من ضياع وجودي، وغربة فنية، وقلق وعدم استقرار اجتماعيين،فغلب على ديواني هذا توجُّهٌ ذاتيٌّ وروح فردية ، عدا أمراً مشينا، وعيبا فاضحاً، رأى النقد الإيديولوجي الذي كان سيد الميدان في تلك المرحلة فيهما تأخراً عن أداء ضريبة الوعي، الأمر الذي ضغط عليَّ للتوجُّه إلى الكتابة الشعرية السياسية المباشرة، زاعقة النبرة، والتي تمثلت في مسرحيتي الشعرية الأولى(نار تحت الجلد) التي ظهرت عامين بعد كتابي الأول. ومن الناحية الفنية ، فإن معظم قصائد (تخطيطات...) جاءت من نوع قصيدة النثر ما جعلها في حينها، غريبة على الذائقة الشعرية في زمانها،وهكذا كنت غريباً، فلسفياً: وأنا أتغنى بما هو ذاتيٌّ، وشعريا: لأن النموذج الذي كان سائدا كان تقليديا شكلا ومضمونا في معظمه، أو تفعيليا في جانبه الحداثي الذي كان يجاهد للظهور.
شفشاون في : 04/12/2011
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 01 - 2012
وفي فترة الأحلام الأولى وأنا مازلت على مشارف عامي الثالث العشرين ،مع بداية السبعينات، بدأت رغبة الكتاب الأول تنتابني ، وقد انتقلت إلى الدارالبيضاء ،صحبة كثير من أصدقائي في آداب فاس والرباط ،فكنتُ إذا عدت إلى شفشاون ، استغرقني التأمل في ما أعانيه، من احتياجات، مادية وفكرية، وقد أصبحت أستاذاً، لم يكن بينها الزواج مثلا، بل ظل الشعر حاجتي الأولى، ودوافع تثيرها تجربة الكتابة، من بينها هاجس تلك الرغبة، خاصة وأنني لم أنقطع أو أتوقف عن الكتابة.
ذات مساء ، وقد تأخر بي الجلوس في مقهى ال (كوت دازور ) بشارع 11يناير بوسط الدار البيضاء، فاجأني وأنا أقرأ مسرحية لنعمان عاشور ، أظن أنها كانت (برج المدابغ) الصديق عبد الغفار العاقل ، الذي أخذ مني الكتاب الذي كان بين يدي وجعل يزنه على كفه اليمنى كما توزن أي بضاعة ، مما أثار ني : فقلت له: ما هكذا يعرف وزن الكتاب ، فقال لي : أعرف، ولكني أريد معرفة ما يتعلق بوزن ورقه، ونوعيته،فأنا أعمل في هذه الأيام، بمطبعة دار النشر المغربية ، وإذا كان لديك ما تريد طبعه ... وقبل أن يتم قلت له : أرجوك لا تسخر مني ، فكيف تستطيع طبع شيء وأنت جديد على الدار، فقال لي ، والله العظيم ، إنني لجاد ،فلم أصدقه : ووضعت أمامه شرطاً يستطيع أن يحد من سخريته، قائلا: إذا كنت حقا جادا، فأنا أقترح عليك أن تطبع ديوانين لشاعرين أنا متأكد من أننا نشترك في تقديرهما ، هما الشاعران عبد الكريم الطبال ومحمد الميموني ، ثم يأتي كتابي أنا بعدهما.
وما زلت إلى اليوم، لا أعرف من أملى عليَّ مثل هذا الشرط، خاصة وأن كلا من الشاعرين المذكورين كان يعيش في جهة بعيدة عني ، الأول: في شفشاون. والثاني: في تطوان. فهل كنت أريد إحراج صديقي تلك الليلة؟
أم هل كنت أريد أن أرد بعض الجميل لشاعرين أقدرهما حقاً، وأعرف أن صديقي كان يعزهما بنفس القدر؟ أم أنني لم أكن أصدق اقتراح الصديق عبد الغفارالعاقل، الذي فوجئ بطلبي، ولم أدر نوع الشعور الذي انتابه، وهو يقول لي: أتركْ لي مهلة يوم واحد، أستشير فيه مدير دارالنشر مصطفى عمار، ولنلتق غدا في نفس الموعد هنا.
وفي مساء اليوم التالي ، أتاني صديقي مستبشراً، يطلب مني أن أتصل بالشاعر الصديق عبد الكريم الطبال ,وبشقيقي محمد الميموني طالبا منهما أن يوافياني بديوانين تطبعهما دار النشر المغربية، فكان أن حظي الشعر المغربي بديوان رائدين هما: ( الأشياء المنكسرة) لصديقي الشاعر عبد الكريم الطبال، وديوان( آخر أعوام العقم ) لشقيقي الشاعر محمد الميموني، . اللذين ظهرا قبل ديواني الأول (تخطيطات حديثة في هندسة الفقر) ،فهل كنت في تلك الليلة، تحت تأثير روح صوفية، حملتني إلى أن أخلص الود لشاعرين كانا أول من قرأ كلماتي الأولى ، يوم حمل شقيقي إلى صديقه دفترًا مدرسياً ، امتلأت أوراقه عن آخرها، بما كان طفل الثالثة عشرة ، في ذلك الشتاء البعيد سنة 1962 يسميه أشعاره الأولى، التي ضاعت كأوراق ، وإن لم تضع الرغبة التي ولدت معها في أعماقي وما زالت إلى الآن..
أذكر أن ذلك كان ذات يوم ، من شهر غشت1974، وقد كنت مشردا في الدار البيضاء ، أو كالمشرد، وقد صورَْت بعضُ قصائدي في كتابي الأول ما كنت أعيش عليه من ضياع وجودي، وغربة فنية، وقلق وعدم استقرار اجتماعيين،فغلب على ديواني هذا توجُّهٌ ذاتيٌّ وروح فردية ، عدا أمراً مشينا، وعيبا فاضحاً، رأى النقد الإيديولوجي الذي كان سيد الميدان في تلك المرحلة فيهما تأخراً عن أداء ضريبة الوعي، الأمر الذي ضغط عليَّ للتوجُّه إلى الكتابة الشعرية السياسية المباشرة، زاعقة النبرة، والتي تمثلت في مسرحيتي الشعرية الأولى(نار تحت الجلد) التي ظهرت عامين بعد كتابي الأول. ومن الناحية الفنية ، فإن معظم قصائد (تخطيطات...) جاءت من نوع قصيدة النثر ما جعلها في حينها، غريبة على الذائقة الشعرية في زمانها،وهكذا كنت غريباً، فلسفياً: وأنا أتغنى بما هو ذاتيٌّ، وشعريا: لأن النموذج الذي كان سائدا كان تقليديا شكلا ومضمونا في معظمه، أو تفعيليا في جانبه الحداثي الذي كان يجاهد للظهور.
شفشاون في : 04/12/2011
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 01 - 2012