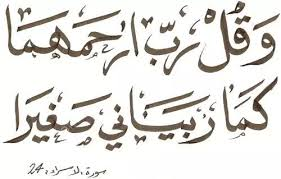واجهة العالم
هى مدينة شاءت لها الجغرافية أن تكون واجهة مصر ومرآتها العاكسة، وشاء لها التارخ أن تكون حائط الدفاع الأول عن المحروسة فى تاريخها الحديث والمعاصر .. هى ليست مجرد مدينة حاربت وحدها ثلاث دول كبرى، وساهمت بعقيدة المقاومة وحب الحياة وعشق الوطن فى إستهلال صفحة جديدة من التاريخ الانسانى .. هى ليست مجرد مدينة تحوّل أبناؤها إلى بارود حى وآيات تحدى ونشيد صمود فى نكسة 67 وحرب الإستنزاف وعبور أكتوبر 73.. هى ليست ألاف المهاجرين الذين هُجروا قسراً حاملين معهم مدينتهم الحلم إلى كل القرى والمدن المصرية فى رحلة غربة واغتراب دامت ست سنوات بين الحربين الأخيرتين، هى ليست مجرد أغانى للمقاومة والحب والبحر، غناها ـ الصحبجية ـ على أوتار السمسمية فى مسائاتهم البعيدة لتبتل قلوبهم بالبحر وأرواحهم بالحرية، كذلك هى ليست المدينة الملونة بألوان الانفتاح الوهمى فى زمن أنور السادات ( 1971 – 1981 )، وليست مدينة ( الباله – الملابس المستعملة – ) فى زمن مبارك ( 1981 – 2011 ) بورسعيد مدينة مثلها مثل البحر، تخمد مثله أحياناً وتثور فى أحيان أخرى، ننساها مثلما ننساه، ونهجرها مثلما نهجره، لكنه – البحر – ولكنها – بورسعيد – قابعان فى الذاكرة كحقيقة دائمة ومستمرة ..
بورسعيد جنية بحر متمردة، لم تقنع يوماً بقاع البحر وغيابه، وعلت دوماً سطح الماء، وسكنت فى نور لمعته .. تلك ليست مشاعر خاصة وشوفينية تجاه مدينة أفخر أننى من أبنائها، بل حقيقة ناصية العالم وواجهته الأمامية التى تغيرت وتبدلت لكن أمواج البحر ما زالت تجرى فى روحها ..
نشيد المقاومة
لم أجد يوماً فارقاً بين مفهومى المقاومة والحياة، فمعنى أن تحيا وتقاوم وتبدع تحت أقسى الشروط وأحلك الظروف فانت تحارب بالحياة من أجل الحياة ، فالجندى المرابط على الجبهة ليس ببعيد عن الانسان المفعم بالحياة المدافع عنها، فالاثنان يدافعان عن قيمة ومعنى الوجود تحت سماء أرض واحدة …
أعتقد ان مفهوم المقاومة المصرية تحديداً يعود إلى الفترة التى أعقبت هزيمة يونيو 1967 والتى كانت فيها الدولة المصرية فى صيغتها الناصرية (1954 – 1970) بحاجة الى دفقة حياة أخرى وبديلة بعد الهزيمة المريعة تحت أقدام جيش الدفاع الاسرائيلى، لذلك صاغ محمد حسنين هيكل ( عراب الدولة الناصرية ) بوعى وحذق تعبير ( النكسة ) بديلاً عن الهزيمة على اعتبار أن ما حدث مجرد انتكاسة طارئة سيعود من بعدها عصفور النار ليتجدد من العدم ويحلق من جديد خاصة أن الحلم الناصرى ما زال قابعاً فى الصدور، وآثار الهزيمة الموجعة والجسيمة لم تتكشف بكافة تفاصيلها بعد، ولأن المصريين عاشوا بالفعل عشرة سنوات مبهحة ( 1956 – 1966 ) اقتربت فيها أحلامهم من السماء وتماهوا مع حلم عبد الناصر فى دولة فتية تمتد راياتها من البحر إلى المحيط، اختاروا الصمود والتحدى والمقاومة سيما انهم لم يعرفوا طريقا بديلاً لطريق الزعيم، وبغض النظر عن صدق نوايا الطرفين السلطة والشعب أو بمعنى أدق الجماهير والقائد، أرى الآن – وبشكل شخصى – أن المشروع الناصرى لم يكن فى أحسن أحواله سوى اعادة انتاج لوهم الخلافة الاسلامية بعد اضافة مفاهيم جديدة تتناسب والنصف الثانى من القرن العشرين، حتى وان بدت الدولة الناصرية بعيدة فى تفاصيل عديدة منها عن دولة الخلافة لكنها تشابهت معها فى الاطار العام خاصة فى اعتمادها على الزعيم المقدس والجماهير المغيبة عن أى فعل، وفى دحضها لمفاهيم الحرية والديمقراطية، وفى حلمها بالتمدد خارج حدود الدولة الوطنية إلى دول الجوار، وما يوكد ذلك اعتماد سلفيه( السادات ومبارك على شرعيته شبه المقدسة فى تثبيت أركان حكمهما برغم انتهاجهما لسياسات تختلف كل الاختلاف عنه، لكن ليس هذا شأننا فهناك من آمن بالحلم ودافع عنه، وهناك من صمد وقاوم من أجل الوطن، وهناك من كان مفعماً بالحياة وعاش لأجلها ومن أجلها، وهناك من قدموا أبلغ التضحيات خلال الثلاث حروب: النكسة، الاستنزاف، أكتوبر، وهناك خمسة شخصيات عاشوا تلك الفترة ولم يجدوا اختلافاً بين حبهم للحياة وعشقهم للوطن، فكانوا نسيجاً خاصاً من البشر ..
الكل فى واحد .. عبد الرحمن عرنوس ( 1934 ـ 2009 )
برغم أنني لم أكن من حوارييه إلا أنني وجدته دائما حالة إنسانية وشعبية ومن قبل ومن بعد حالة مصرية خاصة جداً، فالفنان الذي حوّل وجع الهزيمة والنكسة إلى طاقة صمود وتحدى وإرادة حياة، حتماً هو ابن لشمس تلك التربة الثرية المنجبة التي ننعتها بمصر ونسميها وطناً، فهي نقطة بدئنا ومنتهانا من الميلاد وحتى الرحيل، والرجل الذي قدم مسرح الشارع ومسرح المقهى ومسرح العربة ومسرح الصيادين ومسرح البواخر بالتأكيد كانت قضيته الناس، فالمسرح للناس وبالناس، فى فرجته تزول المسافة ويصبح الكل في واحد ..
ثورة يوليو 52 وما تلاها من أحداث وتفاصيل جسام، هي من حوّلت ـ عرنوس ـ المدرس الالزامى فى مدرسة الفاتح الابتدائية ببورسعيد إلى فنان شعبي، أسس فرقتي: شباب البحر وولاد الأرض في مهجره بالقاهرة، ليحاول مع صحبته استعادة الروح المصرية السليبة عقب هزيمة السابع والستين، وليتنسموا نسمات بحر مدينتهم البعيد، ويستحضروا نوارسها من سحابات الغربة القاسية، وـ لعرنوس ـ ما يزيد عن مئتى أغنية وطنيه وشعبية، تغنى بها وصحبته على أنغام وأوتار السمسية الخمس. فالغناء لديه أداة من أدوات الحرب، الغناء حياة، والغناء أمل، والغناء تحدى للأرجل الغليظة التي دنست أرض سيناء..
ولا يوجد أي فارق بين ـ عرنوس ـ المغنى الشعبي، وـ عرنوس ـ الفنان المسرحي، فالاثنان امتلكا بوصلة واحدة لا تشير إلا على الوطن، ولا تتجه إلا إلى قلوب الناس، لذا كانت لحظة تلاقى الفنان والمغنى الكاملة والتامة، هي لحظة وداع الزعيم: جمال عبد الناصر، عند غناء ـ عرنوس ـ مع الناس وبالناس …
الوداع ياجمال ياحبيب الملايين ……. الوداع
ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين ……. الوداع
انت عايش في قلوبنا ياجمال الملايين ……. الوداع
انت ثورة انت جمرة لجل كل الشقيانين ……. الوداع
انت نواره بلدنا وإحنا لوعنا الحنين ……. الوداع
فلكل إنسان لحظة يصل فيها إلى معناه، وإلى سره، وإلى ملامحه، وإلى رؤيته الكاملة، تتشابه تلك اللحظة مع لحظة اكتمال البدر، الذي يكتمل في وقته وميعاده، ولحظة اكتمال ـ عرنوس ـ توافقت مع رحيل الزعيم، ففيها تحققت رؤيته في الفن، حينما صار الكل في واحد، ليس فقط حزناً على الراحل، بل رغبة من الجميع فى استعادة الروح من جديد ..
وبغياب ـ عرنوس ـ ورحيله أدركنا أن الفن الشعبي ليس فقط اختياراً، بل زمناً يتوحد فيه الجميع على شيء واحد ..
وتد مشدود …. ( قاسم سعد عليوة 1945 – 2014 )
سكن بجسده فى بورسعيد، وطاف بحواسه وروحه كل بقعة على خريطة الوطن، دائماً ما كان على سفر، من مكان إلى مكان، ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، يجوب الأماكن ويستطلع الزمن، ويرتحل مستشكشفاً وكاتباً وباحثاً، ومن قبل ومن بعد حكاءًا يقص حكاياته على القريب والبعيد .. يرتبط تاريخه بتاريخ الثقافة الجماهيرية، فهو أحد أوتادها العظام على مدار تاريخها كله، يكاد أن يكون المعادل الإنسانى لها، حضر نشأتها فى ستينات القرن الفائت عام ( 1965 ) حينما كانت تبث الثقافة والفنون إلى كل الأماكن الفقيرة والمنسية والمهمشة، تماثلت قناعاته بالعدل الاجتماعى وحق الفقراء فى الحياة مع ما تقدمه مؤسسة الفقراء الشعبية .. شارك كمقاتل فى حرب أكتوبر 1973، وله أعمال عديدة عن الحرب وتفاصيلها، أعتقل عام 1974 ضمن خمسين مبدعاً وسياسياً مصرياً عقب أزمة مسرحية مسرحية ” رواية النديم عن هوجة الزعيم بعد أن تحول العرض الى حركة احتجاج ضد نظام السادات …
وطوال العقود الأخيرة كان رمزاً من رموز الثقافة الجماهيرية، ووجهاً من وجوهها المعروفة، كان القلب الحي والنابض لكافة المؤتمرات العامة والاقليمية سواء فى فترات ازدهار المؤسسة أواخر الستينات ، أو فى فترات انكسارها وانحسارها فيما بعد ذلك، وحتى لحظتنا الراهنة ..
ولم يكن ” قاسم عليوة ” مجرد قاص أو روائى بل انسان له موقف، انتمى إلى حزب التجمع اليسارى منذ نشأته، وترشح على قائمته فى انتخابات مجلس الشعب عامى 1984 ، 1987، وتحمل راضياً الوقوف فى صفوف المعارضة الرسمية التى تآكلت مع الوقت ودخلت فى كنف الدولة، وارتبط بفن القصة القصيرة، وأبدع فيها ثلاثة عشرة مجموعة قصصية أهمها: الضحك، تنويعات بحرية، صخرة التأمل، غير المألوف، خبرات أنثوية، لا تبحثوا عن عنوان .. انها الحرب، وتر مشدود، عربة خشبية خفيفة، حكايات عن البحر والولد الفقير .. وله رواية واحدة بعنوان الغزالة، وتدور حول علاقة خاصة بين معلم وطالب أو بمعنى آخر بين شيخ ومُريد، ومعهما غزالة تتشابه مع غزالة المتصوف العربى الكبير محيى الدين بن عربى، والرواية رحلة لاكتشاف الذات والعالم، رحلة مجردة غير معلومة المكان والزمان، رحلة تتلاقى فيها شخصية المعلم والشيخ مع شخصيات عديدة فى الأدب العربى والعالمى، وتتوازى بشكل أو بآخر مع شخصية قاسم عليوة ” نفسه، الذى عاش عمره كله مُعلماً ومرشداً لمن حوله، خاصة انه ارتبط بمدينته ولم يغادرها إلى ” القاهرة ” مثل أقرانه ومُجايليه ، وقضى عمره موظفاً دؤوباً فى محافظة بورسعيد ، وأديباً ” رحالة ” لا يكف عن الترحال ، ووتداً مشدوداً ” فى خيمة الثقافة المصرية، وشجرة ظليلة يقصدها العابرون إلى عالم الأدب وفضاءاته المدهشة ..
ابن البحر … محمود ابراهيم ( 1942 – 2006 )
خرج إلينا من الماء، خرج إلينا بصلابة عينيه وحدتها، ووقف منتصباً على أعلى صخرة مُخاطباً البحر عيناً بعين وصوتاً بصوت، وغاب بعدها فى مسائات وراء مسائات وسنوات وراء سنوات حتى عاد وإلتقانا …
كنا خمسة التقينا به والتقى بنا. كلنا مبدعون، نبدع أدباً ونحب السينما . قال لنا: أنا ابن البحر وابن السينما، جعل بارقة الحلم تسطع أمامنا. كان أقوانا وأقدرنا، لم نشعر بمسحة يأس واحدة في عينيه، قلبه كان ناصعاً كخضرة السنابل، وتتساقط حوله الشهب كقناديل صغيرة متوهجة، أتى إلينا من الشاطئ الآخر ” إيطاليا ” بعد خمسة وعشرين عاماً، غاب فيها عن مدينته الملونة بالأبيض والأسود وبأناشيد الوداع يا جمال يا حبيب الملايين ” جمال عبد الناصر ” الذى غاب بصوته وطار بأحلامه بعيداً عن الهواء العابر من القاهرة المحروسة بضوئها، إلى المدن المحروسة ببحرها، وإلى القرى المُبللة بسكون النيل ..
آتى ” محمود ابراهيم ” إلينا مُحملاً بدهشة السينما الايطالية، وحوله تحوم كل فراشات المساء، عرفنا منه أنطونيونى، بازولينى، فيلينى، وعرف منا احباطات ساعات الصباح، عرفنا منه أن السينما موجات من الأحلام الرقيقة، وعرف منا الإستسلام الكسول لقيلولة المهزومين، عرفنا منه أن نصنع دانتيلا واعية من خيوط الشخصيات، وعرف منا أحلام الليل المهدرة في قراءات متقطعة وكتابة قليلة لحمقى صغار يريدون رؤية القمر من مجرد نافذة صغيرة.. كان قوياً بدرجة جبل، اختار الخروج والصعود إلى حلمه، وكنا أضعف من أوراق القش المتناثرة بجوار البيوت القديمة. فغادرنا وغادرناه، قرر أن ينسج حلمه تحت غبار ” القاهرة ” وزحام أرواحها، وقررنا أن نبقى في مدينتنا كعرائس من الصمت والسكون، تدفعها الموجات أينما تدافعت …
” ابن البحر ” الذي قارب وقتها الستين عاماً إختار أن يدافع عن حلمه حتى دفقة هوائه الأخيرة، اختار أن يُنقب عن سينما يتمناها وتتمناه، والحمقى الصغار استمرءوا الخوف من صدى صوت القطار الذي يعبر إلى المدن البعيدة مُحملاً ببراءة الأناشيد وجسارة الأحلام، ابن البحر ذهب إلى غروبه على قدميه، وشهق شهقة حلمه الأخيرة على مقهاه، ومات حالماً على ضوء أمله الواهن الذى سيبزغ حتماً على جبل آخر تحت سماء أخرى، وعلى حافة بحر تلمع فيها القناديل بوهج أحلامها ..
وبالفعل لمع الحلم ووصل الى زروته على يد شقيقه الأصغر الفنان زكريا ابراهيم الذى حافظ على وهج وأحلام الصحبجية، ونشيج غنائهم منذ لحظة حفر القناة وحتى لحظتنا الحالية، وذلك حينما بدأ خطوته الاولى فى عام 1980فى تأسيس فرقة الطنبورة، وطرح فكرته على المقربين منه من المثقفيين والفنانيين، وتشكك الجميع فى نجاح مشروعه حتى شعر وقتها بأنه كالصارخ فى فضاء الصحراء وخوائها أو على حد تعبيره شعراً: وحيداً / وحيداً فى الصحراء / ولا أحد / أصرخ .. / لا أحد .. / فأصرخ .. / ربما خلف هذا الجبل البعيد / يسمعنى أحد …. وبعد تسعة سنوات ( 1989 ) بنى اول لبنات حلمه، وتمدد الحلم حتى صار ثلاثة عشرة فرقة شعبية بطول وعرض الخريطة المصرية تطرح كل فنون التربة المصرية الشعبية الأصيلة …
بائع المحبة … السيد الشرايدى ( 1950 – 2008 )
لا تحيا الأساطير فى السماء، لكنها تمشى بيننا على الأرض …
ليس مجرد شخص عادى تلتقى به وتنساه بمجرد غيابه فى زحام البشر، لكنه حالة انسانية كاملة تقبع داخلك منذ النظرة الاولى وحتى غيابك الأخير .. أتى الينا حكاءًا يبذر حكاياته على حدائق أرواحنا..
يسير بخطوات وئيدة وكأنه يمشى على الماء، ويدخلنا بمجرد جلوسه بيننا على المقهى، يحكى مع تصاعد دخان نرجليته عن الحياة، وكأنها نشيد إنسانى حميم، يحكى ويحكى حتى يغيب فى دخانه بيننا ..
لم يرتبط أحد بمدينته مثلما ارتبط بها، ولم يصل أحد إلى أسرار بحرها مثل ذلك الكائن الذى لا تدرك خفته، عاش فناناً برغم أنه لم يبدع حرفاً أو لحناً أو رسماً لكنه أبدع حياة ..
عرفناه في المقطع قبل الأخير من حياته، كان يقضى ساعات يومه فى مكتبة عائلته بائعاً للهدايا والأدوات المكتبية وأدوات الرسم، كان قابعاً فيها مثل طائر يعرف خريطة أشجاره ومحطات روحه. وقتها تفرد بتشكيلاته الفريدة من علب الهدايا بأبسط الأدوات وأجملها، فذاع صيته وصيت مكتبته حتى عرفه المُحبون فى طفرات حبهم الأولى، والرسامون بعد إغوائهم باللون، والباحثون الذين وجدوا فى قطرات كلامه ومضات من الله على الأرض ..
تحت هدأة الليل حكى لنا مرة عن فترة خدمته بالجيش أثناء حرب 1973 ، لم يتكلم بحرف عن الحرب، لكنه تحدث عن علاقة حميمة ربطت بينها وبين سيارة عتيقة من سيارات الجيش، تحولا معاً إلى كائن واحد، يعرفها مثلما تعرفه، يتحركان معاً كقاطعى طريق محترفين اختارا أن يستمرا معاً حتى الغياب وراء البحر، حمل فيها كل مُتع المجندين المُلونة من أطعمة وسجائر ومجلات مغبشة بالحياة، حملها إليهم فى صحرائهم الفقيرة بفقرهم والبعيدة بطول البعد عن الأهل والصحبة..
ولمّا حكى المجندون عن سارق الفرح اليهم، قضى ظلمات وحدته فى غرفة سجنه التى ضاقت بحريته ورغبته فى الانفلات إلى الضوء ..
وبعد الخروج من أسر الصحراء والحرب، عاد إلى مدينته بعد انتقالها من خط الدم والحرب إلى خط المدينة الملونة بألوان بضائعها وزحام البشر النازحين بفقرهم إليها ..
كان يلف حول جسده الضئيل ” أتواب ” القماش المُهربة متجاوزاً بحنكة وحذق ابن الحياة حاجز الدائرة الجمركية، وبعدها يعود وحيداً إلى البحر ملقياً بجسده على الرمل مستسلماً للمعة الشمس البعيدة على مائه .. بعدها غاص بعربته” البيجو 7 ” بين زحام المهربين مُختطفاً لحظات اغوائه فى الانفلات من الناس إلى الناس، يلملم حكايات البشر ثم ينسجها من جديد بخيوط من روحه ..
عرفه المغامرون والكتاب والشعراء والرسامون، وجدوا فى قلبه قلب طفل يعرف طريق الحقيقة من أقصر طرقها، ومعنى الحياة من منابع دهشتها المغوية، فارتحلوا إليه كمريدين لشيخ صعد الجبل وحده وما زالت شهقة صعوده معه ..
عاش الحياة كعاشق يعب منها ما استطاع إليه سبيلاً، وزاهد منها يتركها مُتخلياً فيها عن كل شىء ..
تقول رفيقته وحبيبته أنه قضى عاماً كاملاً قبل زواجه أسير غرفته مستغرقاً فى مناجاة ذاته حتى اهتدى إلى الحب طريقاً للنجاة ..
قرر الحب فوجده، وتواطأت السماء معه، ووضعت فى طريقه من تحبه وترى فيه شحروراً أسراً وأثيراً يتنقل بين شجيرات التوت كمن يتنقل بين أساطيره اليومية …
حدثوها البنات عن ملامح فرسان أحلامهم البعيدة عنه، فحدثتهم عن أُلفته التى ظلت معه حتى رحيله، والتى حفرها بمودته فى كل القلوب التى عرفها وعرفته ..
مسيح مدينتنا … ( أحمد عبد الحميد 1959 – )
ولد ” مسيح مدينتنا” و ” عبد الناصر ” أعلى الجبل يرسم على قبة السماء أحلامنا، وجيوش الفقراء تحج إلى ثورة يوليو من العام إلى العام .. دخل ” مسيحنا ” مدارس ” عبد الناصر ” وتعلم أن الكل في واحد، والوطن محفة بيضاء تحملها القلوب والأرواح، وحين غادر ” الزعيم ” الأرض إلى السماء كان ” مسيحنا “طفلاً يصنع أسطورته بيديه، ويقص على أقرانه حكايات منسوجة من رمل البحر وشفرات عيون العجائز، بعدها تخرج و” السادات ” يمحو من السماء أحلام طبقته حلماً وراء حلم، فلجأ” مسيحنا ” إلى الله، وعاش لفترة قصيرة فى غياب الجماعات الدينية، ولم يُنقذه سوى الشعر، فتح طائر الشعر أبواب قلبه على لمعة السماء، ودخل مشدوهاً إلى نار الشعر المقدسة بغير دفاع، واحترق فيها حتى الرماد، ومن الرماد خرج إلينا مسيحاً ومعلماً، تعلمنا عليه غواية الحروف وإغوائها لسنوات وراء سنوات ..
في بيته الفقير، يتحدث إليك بلغة العارفين، ويصمت عنك صمت أصحاب الأسرار سابحاً من فضاء إلى فضاء إلى غياب. يُقدس الشعر، ويصلى لبدائعه صلاة العابد المتبتل، وينحني احتراماً لقصائده ومُعلقاته على حوائط الزمن متتبعاً بصبر المُتيم قصائده القديمة والحديثة والمخبوئة في سدرة المنتهى مجاورةً للرب، يجثو محبة وإجلالاً ” لأبى العلاء ” مُتمنياً أن تجمعهما صحراء واحدة في الجنة، ويضيء بمرآة قلبه بدائع ” المتنبي” بديعة إثر بديعة إلى العابرين عند مطلع كل صباح، ويدخل على ” محمد عفيفي مطر ” مقتحماً وحدته ليقبض على حروفه قبل انفلاتها إلى الغياب، ويقف مع ” سعدي يوسف” كقاطعي طريق محترفين أمام جحافل الجراد من الشعراء ليحفظا للشعر بكارته وبهائه، ويُنشد مع ” محمود درويش ” – مديح الظل العالي – تحت قمر يلتمع بوجيهما معاً، ويضع فى قصاصات أوراقه عناوين القصائد وأسماء الشعراء، وينثرها بذوراً على الأرض لتنمو أشجار الشعر في روحه متوهجة أبدية ..
وكأن للفقر مفتاح وللكتابة أيضاً..
في مساء جمع بيننا تحدث لي بأسى المهزومين قائلاً: الكتابة مفتاح الفقر، فتخيلت حروف الكتابة أيقونات صغيرة مُلونة تومض وتخفت أعلى رأسه وتأبى المغادرة، لأنه مهموم بالكتابة حد التصوف، ويحيا دائماً على حافة سحرها الأسر والأثير، وعاش حياته نبياً منبوذاً، يحيا قلبه فى مدارات الشعر، ولا يرضى بغيرها بديل ..
وتغيب السنوات بيني وبينه، وما زالت عبارته تطاردني، وكأن الكتابة هي حلمنا المفقود. فتشت عنه، ركبت قطارات الصباح، وجالت قدماي في شوارع الصمت، وشوارع الصخب بحثاً عن جسده المختبئ في الضواحي البعيدة، بعد أن انتقل من منفى إلى منفى، ومن غياب إلى غياب، وحين فقدت أمل العثور عليه، أتى، وفى عينيه رماد الغياب الطويل . قال : انتهى كل شيء، سألت عن السبب، أجاب بإشعاله النار في كراسات أشعاره وكتاباته، وارتكن جانباً، و تركني – دون أن يُبدى أى مُقاومة – أُطفئ بماء صداقتنا حريق أشعاره، وحين استطعت، أعطيته كراساته وغادرته وغادرنى إلى غياب جديد، وتركته وحيداً، وتركني وحيداً .
كلانا واحد رغم أننا جسدان مختلفان، هو يختفي في منافيه، وأنا أختفي في أحلامى الصغيرة، هو يحاول إيقاد نار محبته للحروف، ويهرب من لظّاها الأخاذ، وأنا ما زلت متيقناً أن غيمات السماء ستمطر، ولو بعد حين .. أُعاود البحث عنه، ويُعاود الاختفاء منى، عاش عمره روحاً هائمة تحوم حول أصدقائه، يتلصص على رحيق مودتهم، ويجوس بأسراره بين عيونهم، لأنه يعلم بحاجتهم لصوته النبيل .. أعرف أن الكتابة مفتاح الفقر، وأن ” مسيح مدينتنا ” سيعود مرة أخرى وكتفاه مثقلان بهم الكتابة وهم الحياة، ” فمسيح مدينتنا ” ليس مسيحاً واحداً، فلكل مدينة مسيحها …
هى مدينة شاءت لها الجغرافية أن تكون واجهة مصر ومرآتها العاكسة، وشاء لها التارخ أن تكون حائط الدفاع الأول عن المحروسة فى تاريخها الحديث والمعاصر .. هى ليست مجرد مدينة حاربت وحدها ثلاث دول كبرى، وساهمت بعقيدة المقاومة وحب الحياة وعشق الوطن فى إستهلال صفحة جديدة من التاريخ الانسانى .. هى ليست مجرد مدينة تحوّل أبناؤها إلى بارود حى وآيات تحدى ونشيد صمود فى نكسة 67 وحرب الإستنزاف وعبور أكتوبر 73.. هى ليست ألاف المهاجرين الذين هُجروا قسراً حاملين معهم مدينتهم الحلم إلى كل القرى والمدن المصرية فى رحلة غربة واغتراب دامت ست سنوات بين الحربين الأخيرتين، هى ليست مجرد أغانى للمقاومة والحب والبحر، غناها ـ الصحبجية ـ على أوتار السمسمية فى مسائاتهم البعيدة لتبتل قلوبهم بالبحر وأرواحهم بالحرية، كذلك هى ليست المدينة الملونة بألوان الانفتاح الوهمى فى زمن أنور السادات ( 1971 – 1981 )، وليست مدينة ( الباله – الملابس المستعملة – ) فى زمن مبارك ( 1981 – 2011 ) بورسعيد مدينة مثلها مثل البحر، تخمد مثله أحياناً وتثور فى أحيان أخرى، ننساها مثلما ننساه، ونهجرها مثلما نهجره، لكنه – البحر – ولكنها – بورسعيد – قابعان فى الذاكرة كحقيقة دائمة ومستمرة ..
بورسعيد جنية بحر متمردة، لم تقنع يوماً بقاع البحر وغيابه، وعلت دوماً سطح الماء، وسكنت فى نور لمعته .. تلك ليست مشاعر خاصة وشوفينية تجاه مدينة أفخر أننى من أبنائها، بل حقيقة ناصية العالم وواجهته الأمامية التى تغيرت وتبدلت لكن أمواج البحر ما زالت تجرى فى روحها ..
نشيد المقاومة
لم أجد يوماً فارقاً بين مفهومى المقاومة والحياة، فمعنى أن تحيا وتقاوم وتبدع تحت أقسى الشروط وأحلك الظروف فانت تحارب بالحياة من أجل الحياة ، فالجندى المرابط على الجبهة ليس ببعيد عن الانسان المفعم بالحياة المدافع عنها، فالاثنان يدافعان عن قيمة ومعنى الوجود تحت سماء أرض واحدة …
أعتقد ان مفهوم المقاومة المصرية تحديداً يعود إلى الفترة التى أعقبت هزيمة يونيو 1967 والتى كانت فيها الدولة المصرية فى صيغتها الناصرية (1954 – 1970) بحاجة الى دفقة حياة أخرى وبديلة بعد الهزيمة المريعة تحت أقدام جيش الدفاع الاسرائيلى، لذلك صاغ محمد حسنين هيكل ( عراب الدولة الناصرية ) بوعى وحذق تعبير ( النكسة ) بديلاً عن الهزيمة على اعتبار أن ما حدث مجرد انتكاسة طارئة سيعود من بعدها عصفور النار ليتجدد من العدم ويحلق من جديد خاصة أن الحلم الناصرى ما زال قابعاً فى الصدور، وآثار الهزيمة الموجعة والجسيمة لم تتكشف بكافة تفاصيلها بعد، ولأن المصريين عاشوا بالفعل عشرة سنوات مبهحة ( 1956 – 1966 ) اقتربت فيها أحلامهم من السماء وتماهوا مع حلم عبد الناصر فى دولة فتية تمتد راياتها من البحر إلى المحيط، اختاروا الصمود والتحدى والمقاومة سيما انهم لم يعرفوا طريقا بديلاً لطريق الزعيم، وبغض النظر عن صدق نوايا الطرفين السلطة والشعب أو بمعنى أدق الجماهير والقائد، أرى الآن – وبشكل شخصى – أن المشروع الناصرى لم يكن فى أحسن أحواله سوى اعادة انتاج لوهم الخلافة الاسلامية بعد اضافة مفاهيم جديدة تتناسب والنصف الثانى من القرن العشرين، حتى وان بدت الدولة الناصرية بعيدة فى تفاصيل عديدة منها عن دولة الخلافة لكنها تشابهت معها فى الاطار العام خاصة فى اعتمادها على الزعيم المقدس والجماهير المغيبة عن أى فعل، وفى دحضها لمفاهيم الحرية والديمقراطية، وفى حلمها بالتمدد خارج حدود الدولة الوطنية إلى دول الجوار، وما يوكد ذلك اعتماد سلفيه( السادات ومبارك على شرعيته شبه المقدسة فى تثبيت أركان حكمهما برغم انتهاجهما لسياسات تختلف كل الاختلاف عنه، لكن ليس هذا شأننا فهناك من آمن بالحلم ودافع عنه، وهناك من صمد وقاوم من أجل الوطن، وهناك من كان مفعماً بالحياة وعاش لأجلها ومن أجلها، وهناك من قدموا أبلغ التضحيات خلال الثلاث حروب: النكسة، الاستنزاف، أكتوبر، وهناك خمسة شخصيات عاشوا تلك الفترة ولم يجدوا اختلافاً بين حبهم للحياة وعشقهم للوطن، فكانوا نسيجاً خاصاً من البشر ..
الكل فى واحد .. عبد الرحمن عرنوس ( 1934 ـ 2009 )
برغم أنني لم أكن من حوارييه إلا أنني وجدته دائما حالة إنسانية وشعبية ومن قبل ومن بعد حالة مصرية خاصة جداً، فالفنان الذي حوّل وجع الهزيمة والنكسة إلى طاقة صمود وتحدى وإرادة حياة، حتماً هو ابن لشمس تلك التربة الثرية المنجبة التي ننعتها بمصر ونسميها وطناً، فهي نقطة بدئنا ومنتهانا من الميلاد وحتى الرحيل، والرجل الذي قدم مسرح الشارع ومسرح المقهى ومسرح العربة ومسرح الصيادين ومسرح البواخر بالتأكيد كانت قضيته الناس، فالمسرح للناس وبالناس، فى فرجته تزول المسافة ويصبح الكل في واحد ..
ثورة يوليو 52 وما تلاها من أحداث وتفاصيل جسام، هي من حوّلت ـ عرنوس ـ المدرس الالزامى فى مدرسة الفاتح الابتدائية ببورسعيد إلى فنان شعبي، أسس فرقتي: شباب البحر وولاد الأرض في مهجره بالقاهرة، ليحاول مع صحبته استعادة الروح المصرية السليبة عقب هزيمة السابع والستين، وليتنسموا نسمات بحر مدينتهم البعيد، ويستحضروا نوارسها من سحابات الغربة القاسية، وـ لعرنوس ـ ما يزيد عن مئتى أغنية وطنيه وشعبية، تغنى بها وصحبته على أنغام وأوتار السمسية الخمس. فالغناء لديه أداة من أدوات الحرب، الغناء حياة، والغناء أمل، والغناء تحدى للأرجل الغليظة التي دنست أرض سيناء..
ولا يوجد أي فارق بين ـ عرنوس ـ المغنى الشعبي، وـ عرنوس ـ الفنان المسرحي، فالاثنان امتلكا بوصلة واحدة لا تشير إلا على الوطن، ولا تتجه إلا إلى قلوب الناس، لذا كانت لحظة تلاقى الفنان والمغنى الكاملة والتامة، هي لحظة وداع الزعيم: جمال عبد الناصر، عند غناء ـ عرنوس ـ مع الناس وبالناس …
الوداع ياجمال ياحبيب الملايين ……. الوداع
ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين ……. الوداع
انت عايش في قلوبنا ياجمال الملايين ……. الوداع
انت ثورة انت جمرة لجل كل الشقيانين ……. الوداع
انت نواره بلدنا وإحنا لوعنا الحنين ……. الوداع
فلكل إنسان لحظة يصل فيها إلى معناه، وإلى سره، وإلى ملامحه، وإلى رؤيته الكاملة، تتشابه تلك اللحظة مع لحظة اكتمال البدر، الذي يكتمل في وقته وميعاده، ولحظة اكتمال ـ عرنوس ـ توافقت مع رحيل الزعيم، ففيها تحققت رؤيته في الفن، حينما صار الكل في واحد، ليس فقط حزناً على الراحل، بل رغبة من الجميع فى استعادة الروح من جديد ..
وبغياب ـ عرنوس ـ ورحيله أدركنا أن الفن الشعبي ليس فقط اختياراً، بل زمناً يتوحد فيه الجميع على شيء واحد ..
وتد مشدود …. ( قاسم سعد عليوة 1945 – 2014 )
سكن بجسده فى بورسعيد، وطاف بحواسه وروحه كل بقعة على خريطة الوطن، دائماً ما كان على سفر، من مكان إلى مكان، ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، يجوب الأماكن ويستطلع الزمن، ويرتحل مستشكشفاً وكاتباً وباحثاً، ومن قبل ومن بعد حكاءًا يقص حكاياته على القريب والبعيد .. يرتبط تاريخه بتاريخ الثقافة الجماهيرية، فهو أحد أوتادها العظام على مدار تاريخها كله، يكاد أن يكون المعادل الإنسانى لها، حضر نشأتها فى ستينات القرن الفائت عام ( 1965 ) حينما كانت تبث الثقافة والفنون إلى كل الأماكن الفقيرة والمنسية والمهمشة، تماثلت قناعاته بالعدل الاجتماعى وحق الفقراء فى الحياة مع ما تقدمه مؤسسة الفقراء الشعبية .. شارك كمقاتل فى حرب أكتوبر 1973، وله أعمال عديدة عن الحرب وتفاصيلها، أعتقل عام 1974 ضمن خمسين مبدعاً وسياسياً مصرياً عقب أزمة مسرحية مسرحية ” رواية النديم عن هوجة الزعيم بعد أن تحول العرض الى حركة احتجاج ضد نظام السادات …
وطوال العقود الأخيرة كان رمزاً من رموز الثقافة الجماهيرية، ووجهاً من وجوهها المعروفة، كان القلب الحي والنابض لكافة المؤتمرات العامة والاقليمية سواء فى فترات ازدهار المؤسسة أواخر الستينات ، أو فى فترات انكسارها وانحسارها فيما بعد ذلك، وحتى لحظتنا الراهنة ..
ولم يكن ” قاسم عليوة ” مجرد قاص أو روائى بل انسان له موقف، انتمى إلى حزب التجمع اليسارى منذ نشأته، وترشح على قائمته فى انتخابات مجلس الشعب عامى 1984 ، 1987، وتحمل راضياً الوقوف فى صفوف المعارضة الرسمية التى تآكلت مع الوقت ودخلت فى كنف الدولة، وارتبط بفن القصة القصيرة، وأبدع فيها ثلاثة عشرة مجموعة قصصية أهمها: الضحك، تنويعات بحرية، صخرة التأمل، غير المألوف، خبرات أنثوية، لا تبحثوا عن عنوان .. انها الحرب، وتر مشدود، عربة خشبية خفيفة، حكايات عن البحر والولد الفقير .. وله رواية واحدة بعنوان الغزالة، وتدور حول علاقة خاصة بين معلم وطالب أو بمعنى آخر بين شيخ ومُريد، ومعهما غزالة تتشابه مع غزالة المتصوف العربى الكبير محيى الدين بن عربى، والرواية رحلة لاكتشاف الذات والعالم، رحلة مجردة غير معلومة المكان والزمان، رحلة تتلاقى فيها شخصية المعلم والشيخ مع شخصيات عديدة فى الأدب العربى والعالمى، وتتوازى بشكل أو بآخر مع شخصية قاسم عليوة ” نفسه، الذى عاش عمره كله مُعلماً ومرشداً لمن حوله، خاصة انه ارتبط بمدينته ولم يغادرها إلى ” القاهرة ” مثل أقرانه ومُجايليه ، وقضى عمره موظفاً دؤوباً فى محافظة بورسعيد ، وأديباً ” رحالة ” لا يكف عن الترحال ، ووتداً مشدوداً ” فى خيمة الثقافة المصرية، وشجرة ظليلة يقصدها العابرون إلى عالم الأدب وفضاءاته المدهشة ..
ابن البحر … محمود ابراهيم ( 1942 – 2006 )
خرج إلينا من الماء، خرج إلينا بصلابة عينيه وحدتها، ووقف منتصباً على أعلى صخرة مُخاطباً البحر عيناً بعين وصوتاً بصوت، وغاب بعدها فى مسائات وراء مسائات وسنوات وراء سنوات حتى عاد وإلتقانا …
كنا خمسة التقينا به والتقى بنا. كلنا مبدعون، نبدع أدباً ونحب السينما . قال لنا: أنا ابن البحر وابن السينما، جعل بارقة الحلم تسطع أمامنا. كان أقوانا وأقدرنا، لم نشعر بمسحة يأس واحدة في عينيه، قلبه كان ناصعاً كخضرة السنابل، وتتساقط حوله الشهب كقناديل صغيرة متوهجة، أتى إلينا من الشاطئ الآخر ” إيطاليا ” بعد خمسة وعشرين عاماً، غاب فيها عن مدينته الملونة بالأبيض والأسود وبأناشيد الوداع يا جمال يا حبيب الملايين ” جمال عبد الناصر ” الذى غاب بصوته وطار بأحلامه بعيداً عن الهواء العابر من القاهرة المحروسة بضوئها، إلى المدن المحروسة ببحرها، وإلى القرى المُبللة بسكون النيل ..
آتى ” محمود ابراهيم ” إلينا مُحملاً بدهشة السينما الايطالية، وحوله تحوم كل فراشات المساء، عرفنا منه أنطونيونى، بازولينى، فيلينى، وعرف منا احباطات ساعات الصباح، عرفنا منه أن السينما موجات من الأحلام الرقيقة، وعرف منا الإستسلام الكسول لقيلولة المهزومين، عرفنا منه أن نصنع دانتيلا واعية من خيوط الشخصيات، وعرف منا أحلام الليل المهدرة في قراءات متقطعة وكتابة قليلة لحمقى صغار يريدون رؤية القمر من مجرد نافذة صغيرة.. كان قوياً بدرجة جبل، اختار الخروج والصعود إلى حلمه، وكنا أضعف من أوراق القش المتناثرة بجوار البيوت القديمة. فغادرنا وغادرناه، قرر أن ينسج حلمه تحت غبار ” القاهرة ” وزحام أرواحها، وقررنا أن نبقى في مدينتنا كعرائس من الصمت والسكون، تدفعها الموجات أينما تدافعت …
” ابن البحر ” الذي قارب وقتها الستين عاماً إختار أن يدافع عن حلمه حتى دفقة هوائه الأخيرة، اختار أن يُنقب عن سينما يتمناها وتتمناه، والحمقى الصغار استمرءوا الخوف من صدى صوت القطار الذي يعبر إلى المدن البعيدة مُحملاً ببراءة الأناشيد وجسارة الأحلام، ابن البحر ذهب إلى غروبه على قدميه، وشهق شهقة حلمه الأخيرة على مقهاه، ومات حالماً على ضوء أمله الواهن الذى سيبزغ حتماً على جبل آخر تحت سماء أخرى، وعلى حافة بحر تلمع فيها القناديل بوهج أحلامها ..
وبالفعل لمع الحلم ووصل الى زروته على يد شقيقه الأصغر الفنان زكريا ابراهيم الذى حافظ على وهج وأحلام الصحبجية، ونشيج غنائهم منذ لحظة حفر القناة وحتى لحظتنا الحالية، وذلك حينما بدأ خطوته الاولى فى عام 1980فى تأسيس فرقة الطنبورة، وطرح فكرته على المقربين منه من المثقفيين والفنانيين، وتشكك الجميع فى نجاح مشروعه حتى شعر وقتها بأنه كالصارخ فى فضاء الصحراء وخوائها أو على حد تعبيره شعراً: وحيداً / وحيداً فى الصحراء / ولا أحد / أصرخ .. / لا أحد .. / فأصرخ .. / ربما خلف هذا الجبل البعيد / يسمعنى أحد …. وبعد تسعة سنوات ( 1989 ) بنى اول لبنات حلمه، وتمدد الحلم حتى صار ثلاثة عشرة فرقة شعبية بطول وعرض الخريطة المصرية تطرح كل فنون التربة المصرية الشعبية الأصيلة …
بائع المحبة … السيد الشرايدى ( 1950 – 2008 )
لا تحيا الأساطير فى السماء، لكنها تمشى بيننا على الأرض …
ليس مجرد شخص عادى تلتقى به وتنساه بمجرد غيابه فى زحام البشر، لكنه حالة انسانية كاملة تقبع داخلك منذ النظرة الاولى وحتى غيابك الأخير .. أتى الينا حكاءًا يبذر حكاياته على حدائق أرواحنا..
يسير بخطوات وئيدة وكأنه يمشى على الماء، ويدخلنا بمجرد جلوسه بيننا على المقهى، يحكى مع تصاعد دخان نرجليته عن الحياة، وكأنها نشيد إنسانى حميم، يحكى ويحكى حتى يغيب فى دخانه بيننا ..
لم يرتبط أحد بمدينته مثلما ارتبط بها، ولم يصل أحد إلى أسرار بحرها مثل ذلك الكائن الذى لا تدرك خفته، عاش فناناً برغم أنه لم يبدع حرفاً أو لحناً أو رسماً لكنه أبدع حياة ..
عرفناه في المقطع قبل الأخير من حياته، كان يقضى ساعات يومه فى مكتبة عائلته بائعاً للهدايا والأدوات المكتبية وأدوات الرسم، كان قابعاً فيها مثل طائر يعرف خريطة أشجاره ومحطات روحه. وقتها تفرد بتشكيلاته الفريدة من علب الهدايا بأبسط الأدوات وأجملها، فذاع صيته وصيت مكتبته حتى عرفه المُحبون فى طفرات حبهم الأولى، والرسامون بعد إغوائهم باللون، والباحثون الذين وجدوا فى قطرات كلامه ومضات من الله على الأرض ..
تحت هدأة الليل حكى لنا مرة عن فترة خدمته بالجيش أثناء حرب 1973 ، لم يتكلم بحرف عن الحرب، لكنه تحدث عن علاقة حميمة ربطت بينها وبين سيارة عتيقة من سيارات الجيش، تحولا معاً إلى كائن واحد، يعرفها مثلما تعرفه، يتحركان معاً كقاطعى طريق محترفين اختارا أن يستمرا معاً حتى الغياب وراء البحر، حمل فيها كل مُتع المجندين المُلونة من أطعمة وسجائر ومجلات مغبشة بالحياة، حملها إليهم فى صحرائهم الفقيرة بفقرهم والبعيدة بطول البعد عن الأهل والصحبة..
ولمّا حكى المجندون عن سارق الفرح اليهم، قضى ظلمات وحدته فى غرفة سجنه التى ضاقت بحريته ورغبته فى الانفلات إلى الضوء ..
وبعد الخروج من أسر الصحراء والحرب، عاد إلى مدينته بعد انتقالها من خط الدم والحرب إلى خط المدينة الملونة بألوان بضائعها وزحام البشر النازحين بفقرهم إليها ..
كان يلف حول جسده الضئيل ” أتواب ” القماش المُهربة متجاوزاً بحنكة وحذق ابن الحياة حاجز الدائرة الجمركية، وبعدها يعود وحيداً إلى البحر ملقياً بجسده على الرمل مستسلماً للمعة الشمس البعيدة على مائه .. بعدها غاص بعربته” البيجو 7 ” بين زحام المهربين مُختطفاً لحظات اغوائه فى الانفلات من الناس إلى الناس، يلملم حكايات البشر ثم ينسجها من جديد بخيوط من روحه ..
عرفه المغامرون والكتاب والشعراء والرسامون، وجدوا فى قلبه قلب طفل يعرف طريق الحقيقة من أقصر طرقها، ومعنى الحياة من منابع دهشتها المغوية، فارتحلوا إليه كمريدين لشيخ صعد الجبل وحده وما زالت شهقة صعوده معه ..
عاش الحياة كعاشق يعب منها ما استطاع إليه سبيلاً، وزاهد منها يتركها مُتخلياً فيها عن كل شىء ..
تقول رفيقته وحبيبته أنه قضى عاماً كاملاً قبل زواجه أسير غرفته مستغرقاً فى مناجاة ذاته حتى اهتدى إلى الحب طريقاً للنجاة ..
قرر الحب فوجده، وتواطأت السماء معه، ووضعت فى طريقه من تحبه وترى فيه شحروراً أسراً وأثيراً يتنقل بين شجيرات التوت كمن يتنقل بين أساطيره اليومية …
حدثوها البنات عن ملامح فرسان أحلامهم البعيدة عنه، فحدثتهم عن أُلفته التى ظلت معه حتى رحيله، والتى حفرها بمودته فى كل القلوب التى عرفها وعرفته ..
مسيح مدينتنا … ( أحمد عبد الحميد 1959 – )
ولد ” مسيح مدينتنا” و ” عبد الناصر ” أعلى الجبل يرسم على قبة السماء أحلامنا، وجيوش الفقراء تحج إلى ثورة يوليو من العام إلى العام .. دخل ” مسيحنا ” مدارس ” عبد الناصر ” وتعلم أن الكل في واحد، والوطن محفة بيضاء تحملها القلوب والأرواح، وحين غادر ” الزعيم ” الأرض إلى السماء كان ” مسيحنا “طفلاً يصنع أسطورته بيديه، ويقص على أقرانه حكايات منسوجة من رمل البحر وشفرات عيون العجائز، بعدها تخرج و” السادات ” يمحو من السماء أحلام طبقته حلماً وراء حلم، فلجأ” مسيحنا ” إلى الله، وعاش لفترة قصيرة فى غياب الجماعات الدينية، ولم يُنقذه سوى الشعر، فتح طائر الشعر أبواب قلبه على لمعة السماء، ودخل مشدوهاً إلى نار الشعر المقدسة بغير دفاع، واحترق فيها حتى الرماد، ومن الرماد خرج إلينا مسيحاً ومعلماً، تعلمنا عليه غواية الحروف وإغوائها لسنوات وراء سنوات ..
في بيته الفقير، يتحدث إليك بلغة العارفين، ويصمت عنك صمت أصحاب الأسرار سابحاً من فضاء إلى فضاء إلى غياب. يُقدس الشعر، ويصلى لبدائعه صلاة العابد المتبتل، وينحني احتراماً لقصائده ومُعلقاته على حوائط الزمن متتبعاً بصبر المُتيم قصائده القديمة والحديثة والمخبوئة في سدرة المنتهى مجاورةً للرب، يجثو محبة وإجلالاً ” لأبى العلاء ” مُتمنياً أن تجمعهما صحراء واحدة في الجنة، ويضيء بمرآة قلبه بدائع ” المتنبي” بديعة إثر بديعة إلى العابرين عند مطلع كل صباح، ويدخل على ” محمد عفيفي مطر ” مقتحماً وحدته ليقبض على حروفه قبل انفلاتها إلى الغياب، ويقف مع ” سعدي يوسف” كقاطعي طريق محترفين أمام جحافل الجراد من الشعراء ليحفظا للشعر بكارته وبهائه، ويُنشد مع ” محمود درويش ” – مديح الظل العالي – تحت قمر يلتمع بوجيهما معاً، ويضع فى قصاصات أوراقه عناوين القصائد وأسماء الشعراء، وينثرها بذوراً على الأرض لتنمو أشجار الشعر في روحه متوهجة أبدية ..
وكأن للفقر مفتاح وللكتابة أيضاً..
في مساء جمع بيننا تحدث لي بأسى المهزومين قائلاً: الكتابة مفتاح الفقر، فتخيلت حروف الكتابة أيقونات صغيرة مُلونة تومض وتخفت أعلى رأسه وتأبى المغادرة، لأنه مهموم بالكتابة حد التصوف، ويحيا دائماً على حافة سحرها الأسر والأثير، وعاش حياته نبياً منبوذاً، يحيا قلبه فى مدارات الشعر، ولا يرضى بغيرها بديل ..
وتغيب السنوات بيني وبينه، وما زالت عبارته تطاردني، وكأن الكتابة هي حلمنا المفقود. فتشت عنه، ركبت قطارات الصباح، وجالت قدماي في شوارع الصمت، وشوارع الصخب بحثاً عن جسده المختبئ في الضواحي البعيدة، بعد أن انتقل من منفى إلى منفى، ومن غياب إلى غياب، وحين فقدت أمل العثور عليه، أتى، وفى عينيه رماد الغياب الطويل . قال : انتهى كل شيء، سألت عن السبب، أجاب بإشعاله النار في كراسات أشعاره وكتاباته، وارتكن جانباً، و تركني – دون أن يُبدى أى مُقاومة – أُطفئ بماء صداقتنا حريق أشعاره، وحين استطعت، أعطيته كراساته وغادرته وغادرنى إلى غياب جديد، وتركته وحيداً، وتركني وحيداً .
كلانا واحد رغم أننا جسدان مختلفان، هو يختفي في منافيه، وأنا أختفي في أحلامى الصغيرة، هو يحاول إيقاد نار محبته للحروف، ويهرب من لظّاها الأخاذ، وأنا ما زلت متيقناً أن غيمات السماء ستمطر، ولو بعد حين .. أُعاود البحث عنه، ويُعاود الاختفاء منى، عاش عمره روحاً هائمة تحوم حول أصدقائه، يتلصص على رحيق مودتهم، ويجوس بأسراره بين عيونهم، لأنه يعلم بحاجتهم لصوته النبيل .. أعرف أن الكتابة مفتاح الفقر، وأن ” مسيح مدينتنا ” سيعود مرة أخرى وكتفاه مثقلان بهم الكتابة وهم الحياة، ” فمسيح مدينتنا ” ليس مسيحاً واحداً، فلكل مدينة مسيحها …