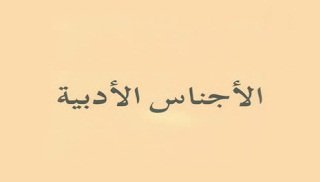بيانٌ لو نطَقَ بالتقريع لانقضّ على لسان العاصفة انقضاضاً! ولو هدد الفساد والمفسدين لتفجر براكين لها أضواء وأصوات! ولو دعا إلى تأمل لرافق فيك منشأ الحس وأصل التفكير فساقك إلى ما يريده سوقاً ووصلك بالكون وصلا!
ويندمج الشكل بالمعنى اندماج الحرارة بالنار والضوء بالشمس والهواء بالهواء، فما أنت إزاءه إلا ما يكون المرء قبالة السيل إذ ينحدر والبحر إذ يتموج والريح إذ تطوف!
أما إذا تحدث إليك عن بهاء الوجد وجمال الخلق، فإنما يكتب على قلبك بمداد من نجوم السماء!
ومن اللفظ ما له وميض البرق، وابتسامة السماء في ليالي الشتاء!
هذا من حيث المادة. أما من حيث الأسلوب، فعلي بن أبي طالب ساحر الأداء. والأدب لا يكون إلا بأسلوب، فالمبنى ملازم فيه للمعنى، والصورة لا تقل في شيء عن المادة. وأي فن كانت شروط الإخراج فيه أقل شأناً من شروط المادة!
وإن قسط علي بن أبي طالب من الذوق الفني، أو الحس الجمالي، لمما يندر وجوده. وذوقه هذا كان المقياس الطبيعي الضابط للطبع الأدبي عنده. أما طبعه هذا فهو طبع ذوي الموهبة والأصالة الذين يرون فيشعرون ويدركون فتنطق ألسنتهم بما تجيش به قلوبهم وتنكشف عنه مداركهم انطلاقاً عفوياً. لذلك تميز أدب عليّ بالصدق كما تميزت به حياته. وما الصدق إلا ميزة الفن الأولى ومقياس الأسلوب الذي لا يخادع.
وإن شروط البلاغة، التي هي موافقة الكلام لمقتضى الحال، لم تجتمع لأديب عربي كما اجتمعت لعلي بن أبي طالب. فإنشاؤه مثلٌ أعلى لهذه البلاغة، بعد القرآن. فهو موجز على وضوح، قوي جياش، تام الانسجام لما بين ألفاظه ومعانيه وأغراضه من ائتلاف، حلو الرنة في الأذن موسيقي الوقع. وهو يرفق ويلين في المواقف التي لا تستدعي الشدة. ويشتد ويعنف في غيرها من المواقف، ولا سيما ساعة يكون القول في المنافقين والمراوغين وطلاب الدنيا على حساب الفقراء والمستضعفين وأصحاب الحقوق المهدورة. فأسلوب علي صريح كقلبه وذهنه، صادق كطويته، فلا عجب أن يكون نهجاً للبلاغة.
وقد بلغ أسلوب علي من الصدق حداً ترفع به حتى السجعُ عن الصنعة والتكلف. فإذا هو على كثرة ما فيه من الجمل المتقاطعة الموزونة المسجعة، أبعد ما يكون عن الصنعة، وأقرب ما يكون من الطبع الزاخر.
فانظر إلى هذا الكلام المسجع وإلى مقدار ما فيه من سلامة الطبع: (يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات، واختلاف الحيتان في البحار الغامرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات!).
وإذا قلنا إن أسلوب علي تتوفر فيه صراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق، فإنما نشير بالرجوع إلى (روائع نهج البلاغة) هذا ليرى كيف تتفجر كلمات علي من ينابيع بعيدة القرار في مادتها. وبأية حلة فنية رائعة الجمال تمور وتجري. وإليك هذه التعابير الحسان في قوله: (المرء مخبوء تحت لسانه) وفي قوله: (الحلم عشيرة) أو في قوله: (مَن لان عوده كثفت أغصانه) أو في قوله: (كل وعاء يضيق بما جُعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع) أو في قوله أيضاً: (لو أحبني جبل لتهافت). أو في هذه الأقوال الرائعة: (العلم يحرسك وأنت تحرس المال. رب مفتون بحسن القول فيه. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. ليكن أمر الناس عندك في الحق سواء. افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإن صغيره كبير وقليله كثير. هلك خزان المال وهم أحياء. ما متع غني إلا بما جاع به فقير!).
ثم استمع إلى هذا التعبير البالغ قمة الجمال الفني وقد أراد به أن يصف تمكنه من التصرف بمدينة الكوفة كيف شاء، قال: (ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها..).
فأنت ترى ما في أقواله هذه من الأصالة في التفكير والتعبير، هذه الأصالة التي تلازم الأديب الحق بصورة مطلقة ولا تفوته إلا إذا فاتته الشخصية الأدبية ذاتها.
ويبلغ أسلوب علي قمة الجمال في المواقف الخطابية، أي في المواقف التي تثور بها عاطفته الجياشة، ويتقد خياله فتعتلج فيه صور حارة من أحداث الحياة التي تمرس بها. فإذا بالبلاغة تزخر في قلبه وتتدفق على لسانه تدفق البحار. ويتميز أسلوبه، في مثل هذه المواقف، بالتكرار بغية التقرير والتأثير، وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. وقد تتعاقب فيه ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار. وتكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. وفي ذلك ما فيه من معنى البلاغة وروح الفن. وإليك مثلاً على هذا خطبة الجهاد المشهورة، وقد خطب علي بها الناس لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على مدينة الأنبار بالعراق وقتل عامله عليها: (هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالاً صالحين.
وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، فينزع حِجلها، وقُلبها، ورِعاثها، ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلمٌ، ولا أريق لهم دم، فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً، ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً.
فيا عجبا! والله يميت القلب ويجلب الهمّ اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً يُرمى: يغار عليكم ولا تغيرون، وتُغزون ولا تَغزون، ويُعصى الله وترضون!).
فانظر إلى مقدرة الإمام في هذه الكلمات الموجزة. فإنه تدرّج في إثارة شعور سامعيه حتى وصل بهم إلى ما يصبو إليه. وسلك إلى ذلك طريقاً تتوفر فيه بلاغة الأداء وقوة التأثير. فإنه أخبر قومه بغزو سفيان بن عوف الأنبار، وفي ذلك ما فيه من عار يلحق بهم. ثم أخبرهم بأن هذا المعتدي إنما قتل عامل أمير المؤمنين في جملة ما قتل، وبأن هذا المعتدي لم يكتف بذلك بل أغمد سيفه في نحور كثيرة من رجالهم وأهليهم.
وفي الفقرة الثانية من الخطبة توجه الإمام إلى مكان الحمية من السامعين، إلى مثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي، وهو شرف المرأة. وعليّ يعلم أن من العرب مَن لا يبذل نفسه غلا للحفاظ على سمعة امرأة وعلى شرف فتاة، فإذا هو يعنف هؤلاء القوم على القعود دون نصرة المرأة التي استباح الغزاة حماها ثم انصرفوا آمنين، ما نالت رجلاً منهم طعنة ولا أريق لهم دم.
ثم إنه أبدى ما نفس نفسه من دهش وحيرة من أمر غريب: (فإن أعداءه يتمسكون بالباطل فيناصرونه، ويدينون فيغزون الأنبار في سبيله، فيما يقعد أنصاره حتى عن مناصرة الحق فيخذلونه ويفشلون عنه.
ومن الطبيعي أن يغضب الإمام في مثل هذا الموقف، فإذا بعبارته تحمل كل ما في نفسه من هذا الغضب، فتأتي حارة شديدة مسجعة مقطعة ناقمة: فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً يُرمى: يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون. ويعصى الله وترضون!).
والخطباء العرب كثيرون، والخطابة من الأشكال الأدبية التي عرفوها في الجاهلية والاسلام ولاسيما في عصر النبي والخلفاء الراشدين لما كان لهم بها من حاجة. أما خطيب العهد النبوي الأكبر فالنبي لا خلاف في ذلك. أما في العهد الراشدي، وفي ما تلاه من العصور العربية قاطبةً، فإن أحداً لم يبلغ ما بلغ إليه علي بن أبي طالب في هذا النحو. فالنطق السهل لدى علي كان من عناصر شخصيته وكذلك البيان القوي بما فيه من عناصر الطبع والصناعة جميعاً. ثم إن الله يسّر له العدة الكاملة لما تقتضيه الخطابة من مقومات أخرى. فقد ميزه الله بالفطرة السليمة، والذوق الرفيع، والبلاغة الآسرة، ثم بذخيرة من العلم انفرد بها عن أقرانه، وبقوة إقناع دامغة، وعبقرية في الارتجال نادرة. أضف إلى ذلك صدقه الذي لا حدود له وهو ضرورة في كل خطبة ناجحة، وتجاربه الكثيرة المرة التي كشفت العقله الجبار عن طبائع الناس وأخلاقهم وصفات المجتمع ومحركاته. ثم تلك العقيدة الصلبة التي تصعب مداراتها وذلك الألم العميق الممزوج بالحنان العميق، وبطهارة القلب وسلامة الوجدان وشرف الغاية.
وإنه من الصعب أن تجد في شخصيات التاريخ مَن اجتمعت لديه كل هذه الشروط التي تجعل من صاحبها خطيباً فذاً، غير علي بن أبي طالب ونفَرٍ من الخلق قليل، وما عليك إلا استعراض هذه الشروط، ثم استعراض مشاهير الخطباء في العالمين الشرقي والغربي، لكي تدرك أن قولنا هذا صحيح لا غلو فيه.
وابن أبي طالب على المنبر رابط الجأش شديد الثقة بنفسه وبعدل القول. ثم إنه قوي الفراسة سريع الإدراك يقف على دخائل الناس وأهواء النفوس وأعماق القلوب، زاخر جنانه بعواطف الحرية والانسانية والفضيلة، حتى إذا انطلق لسانه الساحر بما يجيش به قلبه أدرك القوم بما يحرك فيهم الفضائل الراقدة والعواطف الخامدة.
من الألفاظ ما هو فخم كأنه يجر ذيول الأرجوان أنفةً وتيها. ومنها ما هو ذو قعقعة كالجنود الزاحفة في الصفيح. ومنها ما هو كالسيف ذي الحدين. ومنها ما هو كالنقاب الصفيق يُلقى على بعض العواطف ليستر من حدتها ويخفف من شدتها. ومنها ما له ابتسامة السماء في ليالي الشتاء! من الكلام ما يفعل كالمقرعة، ومنه ما يجري كالنبع الصافي.
كل ذلك ينطبق على خطب علي في مفرداتها وتعابيرها. هذا بالاضافة إلى أن الخطبة تحسن إذا انطبعت بهذه الصفات اللفظية على رأي صاحب الصناعتين؛ فكيف بها إذا كانت كخطب ابن أبي طالب، تجمع روعة هذه الصفات في اللفظ إلى روعة المعنى وقوته وجلاله!
وخطب علي جميعاً تتضح بدلائل الشخصية حتى لكأن معانيها وتعابيرها هي خوالج نفسه بالذات، وأحداث زمانه التي تشتعل في قلبه كما تشتعل النار في موقدها تحت نفخ الشمال. فإذا هو يرتجل الخطبة حساً دافقاً وشعوراً زاخراً وإخراجاً بالغاً غاية الجمال.
وكذلك كانت كلمات علي بن أبي طالب المرتجلة، فهي أقوى ما يمكن للكلمة المرتجلة أن تكون من حيث الصدق، وعمق الفكرة، وفنية التعبير، حتى أنها ما نطقت بها شفتاه ذهبت مثلاً سائراً.
فمن روائعه المرتجلة قوله لرجل أفرط في مدحه بلسانه وأفرط في اتهامه بنفسه: (أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك).
ومن ذلك أنه لما اعتزم أن يقوم وحده لمهمة جليلة تردد فيها أنصاره وتخاذلوا، جاءه هؤلاء وقالوا له وهم يشيرون إلى أعدائه: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم. فقال من فوره: (ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكوا حيف رعاتها، فإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة).
ولما قتل أصحاب معاوية محمداً بن أبي بكر فبلغه خبر مقتله، قال: (إن حزننا عليه قدر سرورهم به، ألا إنهم نقصوا بغيضاً ونقصنا حبيباً).
وسئل: أيهما أفضل؟ العدل أم الجود؟ فقال: (العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما).
وقال في صفة المؤمن، مرتجلاً: (المؤمن بشره في وجهه، وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدراً، وأذل شيء نفساً. يكره الرفعة، ويشنأ السمعة، طويل غمّه، بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، سهل الخليقة، ليّن العريكة!).
وسأله جاهل متعنت عن معضلة، فأجابه على الفور: (اسأل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وإن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت!).
ويندمج الشكل بالمعنى اندماج الحرارة بالنار والضوء بالشمس والهواء بالهواء، فما أنت إزاءه إلا ما يكون المرء قبالة السيل إذ ينحدر والبحر إذ يتموج والريح إذ تطوف!
أما إذا تحدث إليك عن بهاء الوجد وجمال الخلق، فإنما يكتب على قلبك بمداد من نجوم السماء!
ومن اللفظ ما له وميض البرق، وابتسامة السماء في ليالي الشتاء!
هذا من حيث المادة. أما من حيث الأسلوب، فعلي بن أبي طالب ساحر الأداء. والأدب لا يكون إلا بأسلوب، فالمبنى ملازم فيه للمعنى، والصورة لا تقل في شيء عن المادة. وأي فن كانت شروط الإخراج فيه أقل شأناً من شروط المادة!
وإن قسط علي بن أبي طالب من الذوق الفني، أو الحس الجمالي، لمما يندر وجوده. وذوقه هذا كان المقياس الطبيعي الضابط للطبع الأدبي عنده. أما طبعه هذا فهو طبع ذوي الموهبة والأصالة الذين يرون فيشعرون ويدركون فتنطق ألسنتهم بما تجيش به قلوبهم وتنكشف عنه مداركهم انطلاقاً عفوياً. لذلك تميز أدب عليّ بالصدق كما تميزت به حياته. وما الصدق إلا ميزة الفن الأولى ومقياس الأسلوب الذي لا يخادع.
وإن شروط البلاغة، التي هي موافقة الكلام لمقتضى الحال، لم تجتمع لأديب عربي كما اجتمعت لعلي بن أبي طالب. فإنشاؤه مثلٌ أعلى لهذه البلاغة، بعد القرآن. فهو موجز على وضوح، قوي جياش، تام الانسجام لما بين ألفاظه ومعانيه وأغراضه من ائتلاف، حلو الرنة في الأذن موسيقي الوقع. وهو يرفق ويلين في المواقف التي لا تستدعي الشدة. ويشتد ويعنف في غيرها من المواقف، ولا سيما ساعة يكون القول في المنافقين والمراوغين وطلاب الدنيا على حساب الفقراء والمستضعفين وأصحاب الحقوق المهدورة. فأسلوب علي صريح كقلبه وذهنه، صادق كطويته، فلا عجب أن يكون نهجاً للبلاغة.
وقد بلغ أسلوب علي من الصدق حداً ترفع به حتى السجعُ عن الصنعة والتكلف. فإذا هو على كثرة ما فيه من الجمل المتقاطعة الموزونة المسجعة، أبعد ما يكون عن الصنعة، وأقرب ما يكون من الطبع الزاخر.
فانظر إلى هذا الكلام المسجع وإلى مقدار ما فيه من سلامة الطبع: (يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات، واختلاف الحيتان في البحار الغامرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات!).
وإذا قلنا إن أسلوب علي تتوفر فيه صراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق، فإنما نشير بالرجوع إلى (روائع نهج البلاغة) هذا ليرى كيف تتفجر كلمات علي من ينابيع بعيدة القرار في مادتها. وبأية حلة فنية رائعة الجمال تمور وتجري. وإليك هذه التعابير الحسان في قوله: (المرء مخبوء تحت لسانه) وفي قوله: (الحلم عشيرة) أو في قوله: (مَن لان عوده كثفت أغصانه) أو في قوله: (كل وعاء يضيق بما جُعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع) أو في قوله أيضاً: (لو أحبني جبل لتهافت). أو في هذه الأقوال الرائعة: (العلم يحرسك وأنت تحرس المال. رب مفتون بحسن القول فيه. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. ليكن أمر الناس عندك في الحق سواء. افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإن صغيره كبير وقليله كثير. هلك خزان المال وهم أحياء. ما متع غني إلا بما جاع به فقير!).
ثم استمع إلى هذا التعبير البالغ قمة الجمال الفني وقد أراد به أن يصف تمكنه من التصرف بمدينة الكوفة كيف شاء، قال: (ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها..).
فأنت ترى ما في أقواله هذه من الأصالة في التفكير والتعبير، هذه الأصالة التي تلازم الأديب الحق بصورة مطلقة ولا تفوته إلا إذا فاتته الشخصية الأدبية ذاتها.
ويبلغ أسلوب علي قمة الجمال في المواقف الخطابية، أي في المواقف التي تثور بها عاطفته الجياشة، ويتقد خياله فتعتلج فيه صور حارة من أحداث الحياة التي تمرس بها. فإذا بالبلاغة تزخر في قلبه وتتدفق على لسانه تدفق البحار. ويتميز أسلوبه، في مثل هذه المواقف، بالتكرار بغية التقرير والتأثير، وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. وقد تتعاقب فيه ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار. وتكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. وفي ذلك ما فيه من معنى البلاغة وروح الفن. وإليك مثلاً على هذا خطبة الجهاد المشهورة، وقد خطب علي بها الناس لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على مدينة الأنبار بالعراق وقتل عامله عليها: (هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالاً صالحين.
وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، فينزع حِجلها، وقُلبها، ورِعاثها، ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلمٌ، ولا أريق لهم دم، فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً، ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً.
فيا عجبا! والله يميت القلب ويجلب الهمّ اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً يُرمى: يغار عليكم ولا تغيرون، وتُغزون ولا تَغزون، ويُعصى الله وترضون!).
فانظر إلى مقدرة الإمام في هذه الكلمات الموجزة. فإنه تدرّج في إثارة شعور سامعيه حتى وصل بهم إلى ما يصبو إليه. وسلك إلى ذلك طريقاً تتوفر فيه بلاغة الأداء وقوة التأثير. فإنه أخبر قومه بغزو سفيان بن عوف الأنبار، وفي ذلك ما فيه من عار يلحق بهم. ثم أخبرهم بأن هذا المعتدي إنما قتل عامل أمير المؤمنين في جملة ما قتل، وبأن هذا المعتدي لم يكتف بذلك بل أغمد سيفه في نحور كثيرة من رجالهم وأهليهم.
وفي الفقرة الثانية من الخطبة توجه الإمام إلى مكان الحمية من السامعين، إلى مثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي، وهو شرف المرأة. وعليّ يعلم أن من العرب مَن لا يبذل نفسه غلا للحفاظ على سمعة امرأة وعلى شرف فتاة، فإذا هو يعنف هؤلاء القوم على القعود دون نصرة المرأة التي استباح الغزاة حماها ثم انصرفوا آمنين، ما نالت رجلاً منهم طعنة ولا أريق لهم دم.
ثم إنه أبدى ما نفس نفسه من دهش وحيرة من أمر غريب: (فإن أعداءه يتمسكون بالباطل فيناصرونه، ويدينون فيغزون الأنبار في سبيله، فيما يقعد أنصاره حتى عن مناصرة الحق فيخذلونه ويفشلون عنه.
ومن الطبيعي أن يغضب الإمام في مثل هذا الموقف، فإذا بعبارته تحمل كل ما في نفسه من هذا الغضب، فتأتي حارة شديدة مسجعة مقطعة ناقمة: فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً يُرمى: يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون. ويعصى الله وترضون!).
والخطباء العرب كثيرون، والخطابة من الأشكال الأدبية التي عرفوها في الجاهلية والاسلام ولاسيما في عصر النبي والخلفاء الراشدين لما كان لهم بها من حاجة. أما خطيب العهد النبوي الأكبر فالنبي لا خلاف في ذلك. أما في العهد الراشدي، وفي ما تلاه من العصور العربية قاطبةً، فإن أحداً لم يبلغ ما بلغ إليه علي بن أبي طالب في هذا النحو. فالنطق السهل لدى علي كان من عناصر شخصيته وكذلك البيان القوي بما فيه من عناصر الطبع والصناعة جميعاً. ثم إن الله يسّر له العدة الكاملة لما تقتضيه الخطابة من مقومات أخرى. فقد ميزه الله بالفطرة السليمة، والذوق الرفيع، والبلاغة الآسرة، ثم بذخيرة من العلم انفرد بها عن أقرانه، وبقوة إقناع دامغة، وعبقرية في الارتجال نادرة. أضف إلى ذلك صدقه الذي لا حدود له وهو ضرورة في كل خطبة ناجحة، وتجاربه الكثيرة المرة التي كشفت العقله الجبار عن طبائع الناس وأخلاقهم وصفات المجتمع ومحركاته. ثم تلك العقيدة الصلبة التي تصعب مداراتها وذلك الألم العميق الممزوج بالحنان العميق، وبطهارة القلب وسلامة الوجدان وشرف الغاية.
وإنه من الصعب أن تجد في شخصيات التاريخ مَن اجتمعت لديه كل هذه الشروط التي تجعل من صاحبها خطيباً فذاً، غير علي بن أبي طالب ونفَرٍ من الخلق قليل، وما عليك إلا استعراض هذه الشروط، ثم استعراض مشاهير الخطباء في العالمين الشرقي والغربي، لكي تدرك أن قولنا هذا صحيح لا غلو فيه.
وابن أبي طالب على المنبر رابط الجأش شديد الثقة بنفسه وبعدل القول. ثم إنه قوي الفراسة سريع الإدراك يقف على دخائل الناس وأهواء النفوس وأعماق القلوب، زاخر جنانه بعواطف الحرية والانسانية والفضيلة، حتى إذا انطلق لسانه الساحر بما يجيش به قلبه أدرك القوم بما يحرك فيهم الفضائل الراقدة والعواطف الخامدة.
من الألفاظ ما هو فخم كأنه يجر ذيول الأرجوان أنفةً وتيها. ومنها ما هو ذو قعقعة كالجنود الزاحفة في الصفيح. ومنها ما هو كالسيف ذي الحدين. ومنها ما هو كالنقاب الصفيق يُلقى على بعض العواطف ليستر من حدتها ويخفف من شدتها. ومنها ما له ابتسامة السماء في ليالي الشتاء! من الكلام ما يفعل كالمقرعة، ومنه ما يجري كالنبع الصافي.
كل ذلك ينطبق على خطب علي في مفرداتها وتعابيرها. هذا بالاضافة إلى أن الخطبة تحسن إذا انطبعت بهذه الصفات اللفظية على رأي صاحب الصناعتين؛ فكيف بها إذا كانت كخطب ابن أبي طالب، تجمع روعة هذه الصفات في اللفظ إلى روعة المعنى وقوته وجلاله!
وخطب علي جميعاً تتضح بدلائل الشخصية حتى لكأن معانيها وتعابيرها هي خوالج نفسه بالذات، وأحداث زمانه التي تشتعل في قلبه كما تشتعل النار في موقدها تحت نفخ الشمال. فإذا هو يرتجل الخطبة حساً دافقاً وشعوراً زاخراً وإخراجاً بالغاً غاية الجمال.
وكذلك كانت كلمات علي بن أبي طالب المرتجلة، فهي أقوى ما يمكن للكلمة المرتجلة أن تكون من حيث الصدق، وعمق الفكرة، وفنية التعبير، حتى أنها ما نطقت بها شفتاه ذهبت مثلاً سائراً.
فمن روائعه المرتجلة قوله لرجل أفرط في مدحه بلسانه وأفرط في اتهامه بنفسه: (أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك).
ومن ذلك أنه لما اعتزم أن يقوم وحده لمهمة جليلة تردد فيها أنصاره وتخاذلوا، جاءه هؤلاء وقالوا له وهم يشيرون إلى أعدائه: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم. فقال من فوره: (ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكوا حيف رعاتها، فإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة).
ولما قتل أصحاب معاوية محمداً بن أبي بكر فبلغه خبر مقتله، قال: (إن حزننا عليه قدر سرورهم به، ألا إنهم نقصوا بغيضاً ونقصنا حبيباً).
وسئل: أيهما أفضل؟ العدل أم الجود؟ فقال: (العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما).
وقال في صفة المؤمن، مرتجلاً: (المؤمن بشره في وجهه، وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدراً، وأذل شيء نفساً. يكره الرفعة، ويشنأ السمعة، طويل غمّه، بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، سهل الخليقة، ليّن العريكة!).
وسأله جاهل متعنت عن معضلة، فأجابه على الفور: (اسأل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وإن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت!).