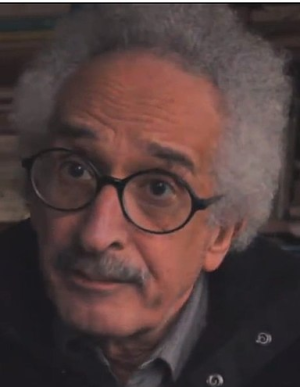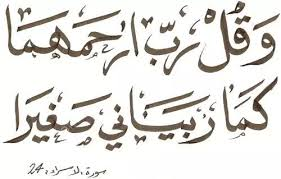- 1 - في ليل القرى..
في القرية التي قضيت فيها فترة تعليمي الابتدائي و الإعدادي بأرياف أسيوط إبان عقد الستينيات من القرن الماضي و قبل الانتهاء من بناء السد العالي و إنجاز مشروع كهربة الريف كانت الإضاءة الصناعية في القرية عدة أنواع :
1 - أولها الإضاءة الكهربائية المحدودة و توجد في بعض الشوارع و الأماكن الحكومية كالوحدة المجمعة مثلا و بعض بيوت قليلة لسراة القرية و في مقدمتها سراية العمدة مثلا ، و مصدر هذا النوع من الإضاءة ماكينة توليد كهرباء تعمل بالديزل و تبدأ نشاطها في أعقاب غروب الشمس مباشرة و عند منتصف الليل تتوقف عن العمل و يتوقف كل ما يستفيد بكهربائها كجهاز التليفزيون العام مثلا ، فقد زودت الدولة بعد بدء البث التليفزيوني عام 1960 كل وحدة مجمعة بجهاز تليفزيون ( و الوحدة المجمعة عبارة عن مجمع خدمات قروية ( مجانية ) تتضمن مدرسة نموذجية و مستشفى و صيدلية و مكتبة عامة و نادي رياضي و سنترال و مركز لتحسين الإنتاج الحيواني و منحل و برج حمام ، و ملحق بالوحدة فيلا لإقامة الطبيب مدير المستشفى و فيلا للإخصائي الاجتماعي ، و قد بنت حكومة ثورة يوليو في الخمسينيات ما يقرب من 3000 وحدة مجمعة ) ، و قد وصل إلى القرية التي كان والدي - رحمة الله عليه - يعمل بها و نقيم معه فيها عام 1962 أو 1963 تقريبا جهاز تليفزيون ( أبيض و أسود طبعا ) فلم يظهر التليفزيون ذو الألوان إلا أوائل عقد السبعينيات ، خصصوا للجهاز الجديد إحدى الصالات المفتوحة الواسعة و زودوها بالأرائك الطويلة ( الدكك ) و الكراسي الخشبية ، في أول المساء كل يوم إبان إجازتي منتصف الدراسة ( الشتاء ) و نهاية الدراسة ( الصيف ) و في ليالي الخميس من كل أسبوع كنا نذهب إلى الوحدة المجمعة التي تقع على الجسر بمدخل القرية الرئيسي لنحتل أماكن قريبة من شاشة التليفزيون الصغيرة و نغدو في شبه غيبوبة حين نندمج مع بعض ما يذيعه هذا الصندوق السحري العجيب من مواد فنية كالأفلام العربية في الغالب و الأجنبية أحيانا أو المسلسلات الدرامية كمسلسل " هارب من الأيام " و مسلسل " بنت الحتة " الذي كان توفيق الدقن يهتف فيه من حين إلى آخر بعبارات صارت علامة عليه و انتشرت على ألسنة الناس مثل : " آلوه يا همبكة " و " آلوه يا أمم " ، و نفيق من غيبوبة الاندماج حين تتوقف ماكينة توليد الكهرباء في منتصف الليل فينطفئ التليفزيون ، و من عجائب الذاكرة أنه كلما أذيع على قناة " روتانا كلاسيك " أو أي قناة من مثيلاتها اللاتي أدمن مشاهدتها فيلم " أخطر رجل في العالم " بطولة فؤاد المهندس أتذكر عند مشهد معين منه لحظة انطفاء تليفزيون القرية و نحن مندمجون في مشاهدته منذ أكثر من 50 عاما ، حينها خرجت مع أترابي من الأطفال عائدين إلى بيوتنا على أطراف القرية في غاية " الضيق و العكننة "، أحيانا كنت أندمج لأسباب شتى في مادة تليفزيونية معينة فيتسرب أترابي الذين لم تعجبهم المادة الفنية و عندما أفيق من غيبوبة الاندماج لحظة انطفاء النور أكتشف أني وحدي الذي بقيت من الأطفال و أن علي بمفردي الخوض في لجج الظلام الدامس طوال الطريق من الوحدة المجمعة حتى بيتنا الذي كان يقع على أطراف القرية و لكن من جانب آخر و أظل وسط حلكة الليل خائفا أترقب فهنا قتل فلان و له صاروخ ( عفريت ) يخرج بالليل و هنا قتل علان ؛ و هناك بيت عائلة فلان الذين يخطفون الأطفال و يذبحونهم من أجل استخراج الكنز ، و أتخبط في الشوارع و الأزقة الضيقة محاولا بقدر الإمكان ألا تدوس قدمي على رجل كلب أو ذنبه أو بطنه أو رقبته فيهب نابحا في وجهي و ربما يعضني أو ينشب أظفاره في جلدي حتى أصل إلى البيت بسلامة الله و تفتح لي أمي - رحمة الله عليها - الباب و تدخلني بهدوء إذا كان أبي نائما حتى تقيني سورة غضبه إذا صحا و فطن لتأخري إلى هذا الوقت من الليل خارج البيت ، و مع قدوم اليوم التالي أنسى معاناتي في الليلة السابقة و أذهب مرة أخرى مع أترابي لنشاهد التليفزيون مع وعد أقطعه لأمي ألا أتأخر في العودة ، و لكن هيهات .
2 - النوع الثاني من الإضاءة هو الكلوبات ( جمع كلوب ) و الكلوبات العامة توجد في بعض الشوارع الرئيسية معلقة على أعمدة أسطوانية من الخشب يطلق على الواحدة منها اسم ( قزقة ) و تجمع على ( قزق ) و القاف تنطق في الصعيد كما ينطق القاهريون و البحاروة عموما حرف الجيم ، و يرفع الكلوب إلى أعلى القزقة بسلك معدني غليظ ( واير ) ، قبل غروب الشمس بقليل كان يأتي المشاعلي التابع لمجلس القرية ( البلدية ) و الموكل بتشغيل تلك الكلوبات ليضغ " منافلة " صغيرة في البكرة المثبتة في منتصف القزقة تقريبا و ينزل الكلوب إلى ما قبل سطح الأرض بمترين أو متر و نصف تقريبا ثم يجلس المشاعلي على ركبتيه و يفتح الغطاء الزجاجي أسفل الكلوب المحمي بشبكة من السلك لينظف الزجاج و يزود خزان الكلوب بالكيروسين ثم يوجه نارا شديدة تخرج من فوهة وابور جاز يدوي يسميه ( وابور الجنب ) إلى المواسير الرفيعة أعلى " الرتينة " التي يمر فيها الجاز حتى تحمر من شدة السخونة ، عندئذ تنتفخ ( الرتينة ) و هي في الأصل كيس حريري صغير يثبت أول مرة في نهاية الفوهة التي تنتهي بها تلك المواسير و كلما انتفخت الرتينة توهجت و ابيضت و أضاءت و عندما تصل إلى أقصى غاية من التوهج و الإضاءة يغلق المشاعلي غطاء الكلوب و يرفعه إلى أعلى القزقة مرة أخرى بالمنافلة ثم يغادر المكان ليعود إليه في نفس الموعد من اليوم التالي ، و لا أكتمكم سرا أني حتى الآن لا أعرف كيف للرتينة الواهنة وهن بيت العنكبوت أن تنتفخ و تتوهج و تضيء ؟ و هي التي إن لمستها بإصبعك مجرد لمس تتساقط على الأرض رمادا أبيض و حينها يلزم تركيب رتينة جديدة للكلوب ، و يستخدم أهل القرية كلوبات خاصة في المناسبات بسرادقات الأفراح و المآتم و الموالد كما يستخدمها بعض ذوي اليسار منهم في بيوتهم و في المناضر و الدواوير بصفة خاصة .
3 - النوع الثالث عبارة عن صناديق زجاجية مثبتة عاليا في الحوائط ببعض الحارات و الأزقة و بداخل كل صندوق مصباح ( لمبة نمرة 10 ) و نمرة 10 تمييزا لها عن اللمبة الصغرى منها و تسمى ( لمبة نمرة 5 ) ، يأتي المشاعلي الموكل بهذه المصابيح كل يوم قبيل الغروب و في كتفه سلم خشبي صغير يسند طرفه الأعلى إلى الحائط أسفل الصندوق الزجاجي قليلا ثم يصعد عليه ثم يفتح باب الصندوق ليستخرج اللمبة فينظف زجاجتها ( البنورة ) بخرقة قماش مبللة بقليل من الماء أو يتفل في الزجاجة إن لم تكن الخرقة مبللة ، ثم يخرج من جيبه مقصا صغيرا فيسوي به طرف العويل ( الفتيل ) حتى لا تكون الشعلة مرتفعة من ناحية و منخفصة من الناحية الأخرى و بعد أن ينتهي من ذلك يركب البنورة في مكانها من رأس اللمبة يضبط ارتفاع الشعلة من مفتاح الضبط الصغير المستدير بحيث يكون ارتفاع الشعلة متوسطا ثم يضع اللمبة داخل الصندوق و يغلق عليها الباب و ينزل فيحمل السلم مرة أخرى في كتفه ليذهب إلى مكان آخر ليضيئه .
في بيوت الأسر الفقيرة مثل أسرتي و أغلب أهل القرية في نفس المستوى كانت الإضاءة تعتمد على اللمبة أو اللنضة نمرة 5 ، و في مواسم الامتحانات كانوا يضعون لي على الطبلية التي أذاكر عليها و هي غير طبلية الأكل ( لمبة ) نمرة 10كنوع من الاهتمام و التشجيع على الاجتهاد في المذاكرة ، و على تلك الإضاءة البائسة حصلت على الشهادة الابتدائية ( شهادة القبول كما كانوا يسمونها ) عام 1966 بتفوق ، و في غرفة النوم و أعلى اللمبة نمرة 5 كانت أمي - رحمة الله - عليها تعلق الدماسة الألومنيوم و بها حفنة من الفول و كمية مناسبة من الماء ، تعلقها من يدها ( يد الدماسة ) في مسمار و قد ألبست فوهة القمع المثبت أسفلها بالفوهة العليا للبنورة ، و على صهد لهيب شعلة اللمبة المتصاعد طوال الليل و المركز من خلال فوهة القمع على قعر الدماسة ينضج الفول كأحسن ما يكون النضج فنفطر به في الصباح الباكر مع الزيت و الليمون أو السمن البلدي قبل انطلاقي إلى المدرسة و مغادرة أبي إلى محل عمله بنقطة الشرطة.
4 - في " بيت الخلاء " أو " بيت الراحة " أو " محل الأدب " أو " الكنيف " و كلها أسماء لمكان واحد ، أو في فجوة من الحائط ( طاقة مسدودة ) عند بعض زوايا البيت و بالاخص الزاوية التي يوجد بها " الزير " حيث مياه الشرب أو المناطق غير المأنوسة في البيت كانت توجد أردأ أنواع الإضاءات و هي التي تصدر من لمبة بدون زجاجة ( بنورة ) و تسمى ( لمبة بعويل ) أو اللمبة أم عويل أو اللمبة الصاروخ و قد سمعت و أنا صغير أنها كانت تسمى في بيوت الفقراء بمدينة الإسكندرية ( الشيخ علي ) و لا أدري حتى الآن هل ما سمعته عن تلك التسمية صحيح أم لا ؟ و إذا كان صحيحا فما تفسير التسمية بالشيخ علي ؟ و بهذا الخصوص تحكى في القرية حكاية طريفة ملخصها أن أحد بلدياتنا كان في زيارة لأقارب له بأحد أحياء الإسكندرية الشعبية و كانوا يعيشون في بيت قديم بدائي و أراد دخول بيت الخلاء و هو في الطابق الأسفل من البيت فقالوا له بيت الخلاء تحت انزل و هتلاقي عندك هناك الشيخ علي و ظل بلدياتنا أمام بيت الخلاء ساعة ينتظر خروج الشيخ علي حتى يدخل و امتلأ بالحرج و الخجل حين عرف ما المقصود بالشيخ علي ، نسيت أن أعرفكم أن اللمبة أم عويل عبارة عن علبة مقفلة من الصفيح في حجم علبة المياه الغازية لكن السمكري جعل لها فتحتين إحداهما لتملأ من خلالها بالوقود و الأخرى تتوسط أعلى العلبة و يخرج منها طرف شريط من الخيط المفتول يرقد معظمه داخل العلبة مغموسا في الكيروسين ( يسمى العويل أو الفتيل ) ، و الإضاءة التي تصدر من لمبة العويل ضعيفة جدا لا تكفي إلا لرؤية ما حولك ( طشاشا ) أي أدنى حد من الرؤية ، و يخرج مصاحبا لشعلة الإضاءة في تلك اللمبة البدائية كم كبير من الهباب و السخام الأسود يتجمع و يتراكم أعلى المكان الذي توجد به اللمبة ، و عملية إزالة هذا الهباب أو ذلك السخام و التخلص منه أمر في غاية الصعوبة و يمثل خطرا على من يعاني من مشاكل في التنفس .
5 - و أخيرا من وسائل الإضاءة لمبة صغيرة في حجم قبضة اليد لها زجاجة مناسبة ( بنورة ) لحجمها تسمى تلك اللمبة ( السهارة ) و تسمى بهذا الاسم لأنها حين تطفأ جميع الأنوار تظل هي وحدها المضاءة ليتحرك على ضوئها الضئيل الخافت أهل البيت حركتهم الاضطرارية ليلا دون أن يتعثروا في شيء من الأثاث أو المفروشات أو يصطدموا بحائط أو باب و ما إلى ذلك .
***
- 2 - رمضان في القرى..
بدأت أصوم و أنا في سن التاسعة من عمري و كنت حينها في الصف الثالث الابتدائي و لم أفطر سوى يوم واحد كانت المدارس فيه تحتفل بأحد الأعياد القومية و في مثل هذه الأعياد لا سيما عيد النصر و موعده 23 ديسمبر يخرج تلاميذ المدارس و يصطفون مدرسة مدرسة في طوابير و في مقدمة كل مدرسة التلاميذ حملة الأعلام المختلفة و فرق الموسيقات المدرسية و نخترق شوارع القرية الرئيسية من شارع إلى شارع و نحن ننشد مع الموسيقى الأناشيد الوطنية مثل نشيد : " الله أكبر " و أغنية " ناصر كلنا بنحبك .. ناصر وحنفضل جنبك .. ناصر يا حبيب الكل يا ناصر " يحف بنا المدرسون لضمان انتظام السير في الطوابير ، و لأنني كنت من التلاميذ طوال القامة فقد اختاروني ضمن ما كان يسمى بالشرطة المدرسية و أعطوني شريطا أحمر طرز عليه بخيوط من الحرير الأصفر عبارة ( الشرطة المدرسية ) و كان ذلك مثار زهو لي بين زملائي وعندما حللت هذه المشاعر فيما بعد اكتشفت أن الإنسان منذ نعومة أظفاره نزاع إلى أن يكون متميزا أو بتعبير أدق صاحب سلطة على من سواه لا سيما إذا كان من سواه في نفس سنه ، و بسبب المجهود الذي بذلته أو تخيلت أني بذلته في مشاركة مدرسينا في الحفاظ على نظام سير طوابير زملائي من التلاميذ بوصفي من الشرطة المدرسية فقد عطشت عطشا شديدا و لم أستطع الصيام إلى أخر اليوم .
كانت أمي - رحمة الله - عليها في غاية الفرح بصيامي لأن أبي بسبب طبيعة عمله كثيرا ما كان يفطر خارج البيت ، و تعودي الصيام معناه أنها وجدت من يشاركها هذه الفريضة الجليلة و طقوسها المختلفة لا سيما طقس الإفطار الذي يبدأ بتجهيز الطعام و انتطار سماع شيخ الجامع حين يؤذن لصلاة المغرب من فوق المئذنة فلم تكن قد انتشرت في ذلك الزمان مكبرات الصوت المزعجة لا سيما بالقرى ، كان أطفال الحي يتجمعون و أنا واحد منهم قبل أذان المغرب بجوار جامع الحي نلعب و نتهارش كالكلاب الصغيرة و نتبادل حكاياتنا الطفولية ، و حين يصعد الشيخ فوق المئذنة و يؤذن للمغرب يجري كل منا إلى منزله ليؤكد لأهله أن الشيخ قد أذن لصلاة المغرب ، و كنت عندما أدخل البيت أصعد السلم قفزا و أنا أهتف بهذه الجملة : " افطر يا صايم ع الكعك العايم " و هذه الجملة لا تخص تراث أسيوط و قراها بل تخص أرياف سوهاج جنوبا و قد لقنتها من أمي فوالداي من إحدى القرى التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، و أحيانا أفطر مع أمي على أذان الراديو و بعد الإفطار ننصت إلى الحلقة الجديدة من (ألف ليلة و ليلة) التي كان يكتبها للإذاعة الشاعر طاهر أبو فاشا و يخرجها المخرج الإذاعي الشهير محمد محمود شعبان ، و كانت أمي تنضج الطعام بأكثر من وسيلة فإذا كان هناك لحم أو طيور فالأصلح له كوعاء للطبخ (البرام) و البرام إناء أشبه بالحلة يصنع من الهمر و هو طينة مخصوصة ذات لون وردي ، و كان برام أمي ذا عروتين ( يدين ) و يوضع البرام على الكانون الذي يوقد بالحطب ( عيدان نبات القطن ) أو البوص ( عيدان نبات الذرة ) أما إن كان الطعام دون ذلك كالبيض حين يقلي او يسلق او الفول المدمس أو البصارة أو المسقعة و ما إلى ذلك فكانت تنضجه أمي على نار وابور الجاز البريموس ( كان اشهر أنواعه الأوبتيموس و البريموس) و تضعه في ركن الغرفة التي ننام فيها فيدفئ جوها في ليالي الشتاء و الوابور كان يصنع من النحاس و له ثلاثة أرجل أطرافها من أعلى تعمل كحوامل لما يوضع فوقه من الآنية و للوابور فتحة بمحبس يزود من خلالها بالكيروسين و كباس في الجنب لكبس الجاز كي يندفع من ثقب (الفونية) و يحدث الاشتعال ، كما كان هناك مفتاح صغير لجعل الشعلة أهدأ حين لا تكون هناك حاجة إلى نار شديدة و إذا سدت رواسب الجاز ثقب الفونية يسلك بإبرة تسمى إبرة الوابور و نشتريها من دكان البقال بخمسة فضة أو تعريفة ( خمسة مليمات ) ست إبر في كيس صغير من الورق ، و بمناسبة البرام كانت هناك (الدوكة) التي تحمر أمي اللحم و الطيور فيها بعد استخراجها ناضجة من البرام و تسمى الدوكة أحيانا ب(الزبدية) ، و في أرياف أسيوط تسمى (المرجسية) - و في ظني أن هناك فروقا بين تلك الأواني - ولكن الأسماء تداخلت لأن الفروق طفيفة أو أن تعدد الأسماء لمسمى واحد كان بسبب اختلاف البيئات مثل مشكلة المترادفات في اللغة العربية الفصيحة ، و بخلاف الزبدية أو المرجسية كانت هناك (الزروية) التي تشبه في شكلها الخارجي قدرة الفول لكن أضيق في خصرها و يخزن فيها السمن البلدي ( و بالمناسبة كنت و أنا صغير اغافل أمي لا سيما حين تكون مشغولة و أدخل إلى حيث الزروية فأرفع الغطاء عن فوهتها و أدس يدي الصغيرة داخلها و أغرف مما بها من سمن متجمد مقدار قبضة يدي أملأ فمي بها ، و غالبا ما كانت أمي تكتشف فعلتي بسبب ما كان يعلق بوجهي و جلابيتي من آثار فتعنفني ) ، هناك أيضا (المنطال) و هو وعاء من الهمر أيضا كباقي الأواني التي ذركرتها ، و أهم ما كان ينضج في المنطال من الأطعمة الفول و العدس الأسود أو (العدس أبو جبة) الذي كانت أمي تملأ منه الطبق ثم تدس فيه ملعقة السمن البلدي الكبيرة إلا أنني لم أكن أحبه و أتضايق بل يملأ نفسي النكد عندما أعرف أننا سنأكل اليوم عدسا بجبة على عكس (العدس الأصفر) الذي كنت و مازلت من عشاقه ، و في القاهرة حين كنت أعيش لوحدي قبل مجيء الأسرة كنت أذهب خصيصا إلى مطعم آخر ساعة أو مطعم القزاز في وسط البلد لأستمتع بوجبة عدس أصفر مع شرائح البصل المنقوعة في الخل خاصة في ليالي الشتاء ، المنطال لا يوصع لإنضاج ما فيه على الكانون في الغالب و لا على وابور الجاز مطلقا و إنما كان يدفن في جمهرة نار الفرن من الخلف بعد الانتهاء من خبز العيش الشمسي أو البتاو .
كان الراديو في تلك الأيام تسلية أمي الوحيدة لا سيما أننا لسنا من أهل القرية و بالتالي ليس لنا وسط عائلي من الأقارب نتواصل معهم اللهم نساء جيراننا اللائي كان يحلو لهن الجلوس في بعض الليالي على عتبة بيتنا و تبادل الأحاديث حول موضوعات شتى مع أمي التي لم تكن تخرج البتة من البيت ، و إلى أين تخرج و ليس لنا أقارب نزورهم أو يزوروننا ؟ ، أتذكر أنها لم تخرج من البيت حتى عندما انتقلنا للحياة في أسيوط كي ألتحق بالمدرسة الثانوية إلا ثلاث مرات فقط إحداهما للطبيب في وعكة ألمت بها و الثانية حين توفي خالي فسافر بها أبي إلى البلد لحضور الجنازة و الثالثة حين انتهيت من دراستي الجامعية فقرر العودة إلى البلد تاركا إياي في أسيوط معللا ذلك بأن مهمته تجاهي قد انتهت و علي منذ الآن الاعتماد على نفسي ، و بالرغم من أن أمي لم تكن تعرف القراءة و الكتابة إلا أنها من طول ملازمة الراديو الذي اقتناه والدي منذ أواخر الأربعينيات أي قبل ولادتي بسنوات ، و كان الراديو بداية وعيي له في سنوات ما قبل المدرسة قبل اختراع البطاريات الجافة و قبل ظهور الراديو الترانزستور يعمل ببطارية كبيرة في حجم أقل قليلا من حجم بطارية السيارة الآن ، و كان للراديو سلك أو إريال علوي ( هوائي ) و آخر سفلي يوضع طرفه في مكان رطب ( أرضي ) لست أدري لماذا ؟ ، تكونت لدى أمي ثقافة سمعية فقد كانت تواظب على سماع معظم مواد إذاعة البرنامج العام لا سيما في عدم وجود والدي الذي كان مغرما بسماع النشرات الأخبارية و بصفة خاصة من إذاعة صوت العرب ، و من أهم مواد الإذاعة في رمضان بخلاف (ألف ليلة و ليلة) برنامج " المسحراتي " الذي أصبح بأشعار فؤاد حداد و صوت الشيخ سيد مكاوي من العلامات المميزة للشهر الكريم ( الرجل تدب مطرح ما تحب و انا مسحراتي في البلد جوال ) و برنامج " أحسن القصص " الذي كان يبدأ بصوت إذاعي مميز يقرأ قوله تعالى : ( نحن نقص عليك .. ) إلى آخر الآية ، و كان في البرنامج ما يشيع الرعب في قلبي كطفل أحيانا مثل صوت عصف الرياح في الصحراء و صوت عواء الذئب و صوت المرأة العجوز التي كانت تصرخ بصوت مبحوح مرتعش في قصة نبي الله يوسف و إخوته بني إسرائيل : اقتلوا يوسف .. اقتلوا يوسف ، و أمي التي لم تكن تقرأ أو تكتب هي التي عشقت من خلالها سماع البرامج الغنائية مثل : قسم و أرزاق ( يا ترى انت فين يا مرزوق ؟ ، هو دا البحر المالح اللي ما لوش قرار .. يا لطيف اللطف يا رب ، أخلع عليك تاج الجزيرة ) و عوف الأصيل ( سيد طبوش العكر من الأعيان حارة أولاد جيعان ، و أغنية يا حلو ناديلي لكارم محمود و الإكسسوارات الصوتية المصاحبة للأغنية من مثل : هو سي عوف عنده حاجة وحشة ) و عذراء الربيع و علي بابا ( افتح ياسمسم افتح يا فول افتح يا عدس ، و يرحمكم الله يا بوسريع ، و غني يا مرجانة ) و خوفو ( أنا خوفو باني الهرم الأكبر ) و عواد باع أرضه ( يا أرضنا ياجنة مفروشة ورد و حنة .. عواد بقى مش منا .. عواد ماعاد عواد ، و شم الطين يا عواد ، فيه ريحة عرقك و عرق أبوك و أجدادك ) و الدندرمة ( مصنوعة بذوق و ايدين توفيق الدندرمة ، الصبح قامت فيه خناقة بين سي توفيق العياقة و صبي قهوة عيسى موسى ، طول عمرة سايق ف الحداقة محمود صبي قهوة عيسى موسى ، و الغالي يرخص عشان زكية ) و الراعي الأسمر و معروف الإسكافي الذي غنى فيه عبد الحليم حافظ قبل أن يشتهر ، و أمي هي التي عرفتني أن نجاة الصغيرة تلقب بالصغيرة للتمييز بينها و بين مطربة سابقة عليها اسمها نجاة علي .
في الرمضانات الشتوية بالقرية كانت أمي تستعين لتدفئة الغرفة ب(ماجور) كسرت إحدى حوافه فلم يعد صالحا لأن تعجن فيه الدقيق الذي ستصنع منه الخبز (العيش الشمسي) و يكون من دقيق القمح أو (البتاو) و يكون من دقيق الذرة الرفيعة و يوضع مع دقيق الذرة حين يعجن لصنع البتاو بعضا من الحلبة المطحونة التي تعطي لخبز البتاو طعما مميزا و يسمون الحلبة في أرياف أسيوط " الحياقة " بشدة و فتحة على الياء ، في الماجور المكسور بعد صلاة العشاء تضع أمي كمية مناسبة من الحطب أو قوالح الذرة الشامية و تشعلها خارج الغرفةحتى تصفو نارها و يتوقف دخانها حينئذ تدخل الماجور الغرفة و تضعه في المسافة بين الكنبة التي يجلس و بنام عليها أبي و السرير الخشبي العريض الذي أنام عليه معها ، و مما كانت أمي تحرص على سماعه في الراديو خلاف مسلسل الساعة الخامسة و الربع مساء قرآن الصباح الذي كان يذاع بأصوات أجمل أصوات في العالم ، أصوات قرائنا العظام مثل الشيوخ : محمد رفعت و محمد صديق المنشاوي و الحصري و البنا و عبد الباسط عبد الصمد و طه الفشني والبهتيمي و الشعشاعي و شعيشع و عبد العظيم زاهر و لا أدري السر في أن صوت الشيخ عبد العظيم زاهر على وجه التحديد ظل عالقا بوجداني أكثر من غيره فعندما أسمع صوته أشعر كأنه مبلل بندى الصباح و أستحضر عند سماعه كل طقوس فترة الصباح حين كانت أمي تجهزني للانطلاق إلى المدرسة في تلك السنوات الجميلة البعيدة ؟ ، كذلك كانت تتابع أمي في رمضان و غير رمضان قرآن الساعة الثامنة مساء و حديث الصباح بعد القرآن و ما زال أتذكر صوت الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت و صوت الشيخ محمد فتح الله بدران و صوت الدكتور زكي المهندس رحمة الله عليهم جميعا .
من ذكرياتي الرمضانية في القرية أنني كنت أنخرط مع أطفال الحي في طقس رمضاني جميل نؤديه كل ليلة تقريبا بعد صلاة العشاء فقد كنا نتجمع : كل طفل بفانوسه ( لم تكن الفوانيس تضاء آنذاك بحجر بطارية كما هي الآن بل كانت بالشمع فكل فانوس بداخله شمعة يشعلها الطفل بعود الكبريت أو يشعلها له من هو أكبر منه إذا كان صغيرا ) و ننطلق في شوارع الحي و بعض حاراته و نحن نغني وحوي يا وحوي و نتوقف عند أبواب بعض البيوت و نحن نقول : ادونا العادة .. لبة و قلادة .. الفانوس طقطق والعيال ناموا ، و العادة هي ما يمنحنا أهل البيت الذي وقفنا قدام بابه من بلح أو فول سوداني أو طوفي أو مكعبات سكر و تسمى تلك القوالب ( سكر مكنة ) تمييزا له عن السكر الذي كان يباع في شكل أقماع كبيرة تكسر بالشاكوش إلى قطع بحسب الحاجة من أجل استخدامها في تحلية الشاي أو أي مشروب آخر ) ، و عندما تنتهي جولتنا نجلس تحت أحد الكلوبات و نفرش على قطعة قماش العطايا أو الغنائم التي غنمناها في جولتنا لنوزعها بالعدل على بعضنا البعض.
حين ذكرت أقماع السكر تذكرت أن القمع كان يباع في الدكان ملفوفا بورق و الورق يكون محزوما بخيط نطلق عليه اسم ( فتلة ) و هي أغلظ من خيط الحياكة و أنحف من الدوبارة ، و هذه الفتلة كنا نشمعها أي ندلكها بالشمع و نستخدمها في تدوير النحل ، فكل طفل تقريبا في القرية لديه في بيته نحلة أو أكثر و النحلة قطعة خشبية في شكل البصلة تنتهي من أسفل بسن معدني ، نضع طرف الفتلة الأول على السن و نلفه على جسم النحلة دوائر دوائر و طرف الخيط الثاني في قبضة يدنا ثم نطلق النحلة لتنزل على الأرض المستوية و يجب أن تكون الأرض مستوية حتى تدور النحلة مدة أطول و بشكل منتظم ، و أعتقد أن قطعة الخشب بصلية الشكل سميت النحلة لأنها تلف و تدور كما تفعل النحلة الطبيعية ، و أتذكر أننا كنا نشتري الدوم و نكسر الدومة و نخرج من داخلها نواتها التي في حجم بيضة الحمامة أو أكبر قليلا نقشر ما عليها من غشاء بني بقطعة زجاج مكسورة و ننحتها حتى تأخذ شكل نحلة صغيرة ذات لون أبيض و ملمس خارجي ناعم أشبه بملمس العاج و لكنها لم تكن تسمى بالنحلة بل تسمى ( البظو ) و لا أدري أصل هذه المفردة و إن كان لها أشباه كمفردة ( البغو ) مثلا و تطلق مفردة البغو على أي شيء غض طري كعود النبات في مقتبل نموه مثلا فيقال عليه ( بغو ) و تطلق مجازا على الشخص صغير السن قليل الجلد و التحمل أي الذي لم يصلب عوده بعد .
****
- 3 - التعليم في القرى
كان بجوار نقطة الشرطة التي كان يعمل بها والدي رحمة الله عليه بيت الشيخ محمود حفني ناظر المدرسة الابتدائية القديمة بالقرية ( كان بالقرية أربع مدارس ابتدائية ، اثنتان للبنين و منها مدرستي واحدة للبنات و أحدثها مشتركة و كانت جزءا من الوحدة المجمعة ) و قد تعرف والدي على الشيخ محمود و توثقت العلاقة بينهما في فترة قصيرة و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال : " الأرواح جنوذ مجندة ماتعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف " و رآني حضرة الناظر ذات يوم ألعب في الشارع قريبا و كان يجلس مع أبي قدام باب النقطة فسأله : متى يبلغ ابنك سن دخول المدرسة ؟ فأجابه والدي : سعد عنده خمس سنين ؛ يعني السنة اللي جاية إن شاء الله هيكون عندك يا حضرة الناظر ، فقال له حضرة الناظر : و ليه السنة اللي جاية ؟ ، السنة الدراسية الجديدة هتبتدي الشهر القادم و سأقبل ابنك مستمعا في المدرسة حتى إذا جاء موعد دخوله المدرسة رسميا يدخلها و هو على الأقل قد عرف مبادئ القراءة و الكتابة فيكون في الفصل متفوقا على زملائه ، اهتمت أمي بالأمر و فرحت فرحا شديدا فأرسلت القماش الذي اشتراه أبي من تيل نادية ( لونه بيج و كان يلبسه تلاميذ المدارس الابتدائية بنين و بنات في ذلك الزمان ) إلى حميدة الضحاكة ( هكذا كان أهل القرية يسمونها ربما لأنها كانت كثيرة الضحك ) ففصلت لي مريلة بجيبين أماميين و حزام ، و ذهب بي أبي إلى الجزماتي فأخذ مقاس رجلي على كرتونة و ترددت عليه مرتين للتجربة حتى انتهى من صنعها فلبستها على المريلة الجديدة و دخلت المدرسة مستمعا أي من غير أن يكون اسمي مقيدا بدفاترها رسميا .
لم تكن لي في تلك السنة أية مزايا مما يصيبها زملائي بالفصل فلا كتب و لا تغذية و لا أي شيء ، و كان أشد ما يحز في نفسي أن كل تلميذ من زملائي يحصل يوميا على رغيف من خبز الطوابين و يسمونه في القرية " العيش المصري " أما أنا فلا ، و كان هذا النوع من الخبز يمثل لنا - نحن أطفال القرية - فاكهة لأنه مختلف عن رغيف " الخبز الشمسي " و عن " البتاو " سواء كان بتاو قمح أو بتاو ذرة ، و أتذكر أنه عندما يكون أبي ذاهبا إلى أسيوط المدينة كان طلبي الوحيد منه أن يجيئني معه من أسيوط بقرطاس طعمية و رغيفين مصريين ، و عندما أسأل عن السبب في عدم حصولي على رغيف كزملائي تكون الإجابة : لأنك غير مقيد ؟ و لأني صغير ساذج كنت لا أعرف المعنى المجازي للقيد فأقول لهم و أنا أمد يدي الصغيرتين ، قيدوني منذ الآن و أعطوني رغيفا مثل زملائي فيضحك أبي أو تضحك أمي أو يضحك كل من يحدث أمامه هذا الحوار .
عوضني أبي عن الرغيف بتعريفة ( خمسة مليمات ) كان ينفحنيها كل صباح و أنا منطلق إلى المدرسة بعد أن تلبسني أمي المريلة ذات الجيبين الأمامين و الحزام و تضع في يدي قلم رصاص موصية ألا أضيعه كما أضعت قلم اليوم السابق و لكن التوصية غالبا ما كانت تذهب أدراج الرياح فلكي ألعب مع زملائي في حوش المدرسة خلال الفسحة أضع القلم في أحد الجيبين فيتأرجح تبعا لحركتي في اللعب و عندما أفيق من اندماجي في اللعب يكون القلم قد سقط و التقطه من لا يعيده ، وهكذا كان الأمر كل يوم تقريبا حتى ابتكرت أمي وسيلة ليس لمنع تكرار ضياع القلم فهذا ما لا سبيل إلى تحقيقه و لكن على الأقل للتقليل من حدوثه فربطته في مريلتي بفتلة غليظة ( دوبارة ) ، كتاب المطالعة الذي حصلت عليه في النصف الثاني من السنة هدية من حضرة الناظر لوالدي خاف والدي أن يتفسخ فخاط ورقة سميكة بكعبه مما شوه من شكله و جعلني أخجل منه أمام زملائي لا سيما أن الورقة السميكة كانت من النوع الذي يلف فيه الجزارون مبيعاتهم من اللحمة و لذلك كانوا و حتى الآن يسمون هذا النوع من الورق " ورق اللحمة " .
أتذكر أن سنة الاستماع تلك كانت على الأرجح آخر سنة يتم التعامل فيها مع نظام الألواح في المدارس فقد كان لكل تلميذ لوح لا أتذكر مادة صنعه و لكن أتذكر أنه كان أسود و محاط بإطار من الخشب و يكتب التلميذ على لوحه بنوع من الطباشير يسمى " طباشير الأردواز " و عند نهاية اليوم الدراسي يضعه في فتحة الدرج و يتركه إلى اليوم التالي ، كان معظم مدرسينا في ذلك الوقت مطربشين و نخاطب المدرس منهم و نناديه بيا (أفندي ) و لم نكن حينها نعرف مفردة ( أستاذ ) المدنية .
انتهت سنة الاستماع و دخلت المدرسة رسميا مقيدا في الدفاتر لا مقيد اليدين كما كنت أظن و كان ذلك مطلع العام الدراسي 1960/ 1961 و مدرس فصلنا أو بتعبير أدق أفندينا الذي يتولى تدريسنا كل المواد ما عدا الموسيقى و الألعاب و الرسم كان اسمه عبد المحسن حسن - رحمة الله عليه - و لم يكن طويلا كما لم يكن قصيرا بل كان رجلا ربعة و يستعين في تصحيح ما كتبناه في كراساتنا بنظارة طبية و بجوار كراسة التحضير كانت دائما هناك دائما قطعة من سير جلدي يستخدمها في عقابنا على التقصير في الواجبات أو الشقاوة في الفصل ، كما أتذكر أن الكراسة المدرسية في ذلك الزمان كانت صفحاتها مسطرة سطورا واسعة ، و مع ذلك كان من الصعب علي في بداية عهدي بالكتابة الحفاظ على استقامة خطي في شكل أفقي ، لذا كنت عندما أقف بجوار منضدة عبد المحسن أفندي كثيرا ما أنال على الجزء العاري من رجلي تحت المريلة لسوعتين من جلدته ، و على الصفحة الخلفية للكراسة كنت تجد مجموعة من العبارات الجميلة ما زلت أحفظ بعضها حتى الآن من مثل :
1 - كلنا سيد في ظل الجمهورية .
2 - حريتك أثمن من حياتك .
3 - لا تكن ثرثارا بين الناس .
4 - احترم مدرستك فإن لها حرمة المعبد .
5 - اغسل يديك قبل الأكل و بعده .
6 - العمل حق ؛ العمل واجب ؛ العمل حياة .
في أحد أيام إجازة السنة الثانية الابتدائية جاءني صاحبي و ابن زميل أبي في العمل كان اسمه الذي نناديه به رمضان جاد و لكن اسمه الرسمي في المدرسة سالم ، جاء عندنا في البيت و أخبرني أنهم افتتحوا في الوحدة المجمعة ناديا باسم ( النادي الريفي ) و يمكننا الاشتراك في النادي لنلعب الكرة و غيرها من ألعاب و الاشتراك بقرش صاغ فقط في الشهر ، و أعطاني أبي قرشا فذهبت مع رمضان أو سالم إلى النادي بالوحدة المجمعة ، صفنا غلام أكبر منا سنا و أتى بكرة قال إنها كرة اليد و تلعب بأطراف الأصابع لا بجماع اليد و أنه سيلقي بالكرة إلى الطفل الأول في الصف و عليها أن يردها إليه بأطراف أصابعه فيلقي بها إلى الطفل الذي يليه و هكذا حتى أخر طفل في الصف ثم يكر راجعا طفلا طفلا حتى أول الصف مرة أخرى ، عند أول تجربة لي مع كرة اليد حين ألقاها الي الغلام المدرب فشلت في التعامل معها فضربتها بمجامع يدي فسخر مني كما يفعل معه فيما يبدو المدرب الكبير ، و لأنني من يومي لا أحب أن يدوس أحد لي على طرف فأنا الابن الوحيد لوالدي و أبي صعيدي قح و بالرغم من أنه رجل فقير كان ملتزما بثلاثة أمور في حياته :
أولا : لم يكن يسمح لأحد أيا كان أن يخدش كرامته بأي شكل .
ثانيا : لا يستضيف أحدا من أصدقائه في البيت و يقول : صديقي على القهوة و في الشارع مش في البيت .
ثالثا : لا يشتري أبدا شيئا بالأجل ( شكك ) مهما كان احتياجه إليه .
تركت صف لعب الكرة و ناداني الغلام المدرب لأعود إلى الصف فرفضت و ذهبت أتجول هنا و هناك داخل المنطقة القريبة من الملعب بالوحدة المجمعة ريثما ينتهي صاحبي رمضان من التدرب على لعبة كرة اليد فنعود معا إلى البيت ، كانت الوحدة المجمعة آنذاك أشبه بحديقة غناء مسورة بنبات " عنب الديب " المقصوصة أطرافه من أعلى و من الجوانب و تنتشر فيها الأشجار الكبيرة و الصغيرة من أنواع شتى و أحواض الزهور في كل مكان و الأرض حول المباني كلها تغطيها الحشائش الخضر ( النجيلة ) ، و فجأة وجدت بابا عريضا مفتوحا على قاعة تتناثر في وسطها مناضد مستديرة يجلس على بعضها أطفال قليل منهم في مثل سني و أكثرهم أكبر قليلا و تستند إلى حوائط القاعة دواليب بأرفف رصت عليها كتب كثيرة ذات ألوان زاهية .
و للحديث بقية إن شاء الله .
***
4 - الكتب و القراءة في القرى
عندما شد انتباهي المشهد و ترددت جيئة و ذهابا أمام باب المكتبة أكثر من مرة ، و في كل مرة أتطلع إلى داخل القاعة كنوع من الفضول الطفولي لمحني الرجل النحيل الأسمر الذي يجلس إلى مكتب صغير قريبا من الباب فأشار إلي أن أدخل و حين دخلت أجلسني إلى منضدة شاغرة و وضع قدامي على المنضدة قصة تمتلئ صفحاتها بالرسوم و القليل من الكلمات كبيرة الحروف ، لا أتذكر بالطبع الآن اول قصة أقرؤها خارج منهج التربية و التعليم و لكني أتذكر أن الرسوم التي كانت بها تتضمن أسدا و ثعلبا كلاهما يلبس ( بدلة ) و في رقبته ( ببيونة ) و تتضمن أشجارا و بيوتا ذوات أسطح مخروطية و مداخن من طراز البيوت في أرياف أوربا قديما .
اقرأ .. قال لي الأستاذ محمد أبو طالب أمين المكتبة - رحمة الله عليه - فقرأت كما تعودت بصوت عال ، فأوقفني و قال لي اقرأ في سرك أي بعينيك دون أن تصدر صوتا ، و كان هذا أول درس قراءة لي خارج المدرسة و أول مرة أتعلم فيها القراءة بدون صوت أو القراءة السرية كما يسميها التربويون .
منذ تلك اللحظة التي لعبت فيها المصادفة دورا كبيرا بدأت رحلتي مع القراءة الحرة كهواية تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الإدمان بل الإدمان نفسه إن صح تسمية عشق القراءة و الولع الشديد بالكتب إدمانا ، كنت كل يوم أذهب مع صاحبي رمضان جاد إلى الوحدة المجمعة فيذهب هو إلى ملعب الكرة و أذهب أنا إلى المكتبة .
لاحظ أمين المكتبة أني أقرأ كثيرا في فترة عمل المكتبة بالنهار ففي حين يقرأ غيري من الأطفال رواد المكتبة قصة أو قصتين أكون أنا قد قرأت أربع قصص أو خمسا ، و كان كثيرا من الأيام حين يأتي ليفتح المكتبة الساعة العاشرة صباحا يجدني جالسا أنتظر على سور حوض الزهور أمامها ، و كان من حق كل طفل من رواد المكتبة أن يستعير قصة يأخذها معه إلى البيت حيث يقرؤها و يعيدها في أي يوم خلال أسبوع ، أنا كنت آخذ القصة و أعود بها للمكتبة ليس خلال الأسبوع بل في الفترة المسائية للمكتبة من نفس اليوم فقد كانت المكتبة تعمل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ثم من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء ، لذلك كافأني الأستاذ محمد أبوطالب طيب الله ثراه فجعل لي وحدي ميزة أن أستعير من المكتبة مرتين في اليوم الواحد ، فعند انتهاء الفترة الصباحية أخرج بقصة أقرؤها في البيت عقب تناول الغداء ثم أعيدها في الفترة المسائية و أستعير أخرى سواها .
جعلتني القراءة الحرة أشعر بيني و بين نفسي أني متميز عن زملائي بل إنني أحطت من خلال القراءة بما لم يحط به بعض من كانوا يدرسونني من الأفندية ( الأساتذة المدرسين ) ، كنت مثلا أعرف عن طريق كامل كيلاني اسم شيكسبير و حواديت مسرحياته : يوليوس قيصر و العاصفة و تاجر البندقية و أعرف من خلال قراءاتي أسطورة إيكاروس و ديدالوس و كثيرا من أسماء و أحداث الإلياذة و الأوديسا لهوميروس و الإنيادة لفرجيل و الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري و أعرف روبنسون كروزو لدانيال ديفو و رحلات جليفر لجوناثان سويفت و حي بن يقظان لابن طفيل و دون كيشوته لسرفانتس و خرافات إيسوب و لافونتين و حكايات الأخوين جريم ، و الملك آرثر و سيف بن ذي يزن و تبع اليماني و شق و سطيح و نوادر جحا و طرائف كثيرة من حياة العرب كطرائف الحمقى و الطفيليين و طرائف الحجاج بن يوسف الثقفي و حكايات النعمان بن المنذر و أبطال غزوات الرسول (ص) و عشرات بل مئات غيرها من المعلومات المتنوعة ، كل ذلك من قصص الأطفال التي لم أكن في تلك السن الباكرة أقرؤها بل كنت ألتهمها التهاما .
أتذكر أني ذات مرة عدت للبيت و معي قصة " علي بابا " لكامل كيلاني و بعد الغداء أخرجت القصة من جيب جلابيتي و جلست على حافة السرير الذي كنت أنام عليه مع أمي و في مواجهتي أعلى الكنبة التي كان ينام عليها والدي رف مثبت بالحائط يقبع عليه الراديو الترانسزتور و بالمصادفة و أنا أبدأ في قراءة القصة بدأوا في الراديو يذيعون أحدالبرامج الغنائية التي جعلتني أمي أعشقها و كان البرنامج " علي بابا " و بالرغم من الفروق ما بين القصة كما كتبها كامل كيلاني و البرنامج الذي كان من تأليف إبراهيم رجب و ألحان عبد الحليم علي و إخراج المخرج الإذاعي الشهير عبد الوهاب يوسف إلا أنني استمعت حينها متعة مزدوجة بالقصة و البرنامج معا مازلت أجد حلاوتها في نفسي حتى الآن .
انتقلت المكتبة خلال سنوات النصف الأول من عقد الستينيات إلى مكان أخر خارج الوحدة المجمعة ثم عادت إلى مكانها القديم في النصف الثاني و ظللت زبونها الأول طوال عقد الستينيات حيثما تكون ، و لم تكن عطلتها الأسبوعية يوم الجمعة فقط بل كانت تعطل أيضا يوم الاثنين لا أدري لماذا ؟ و كنت أكره هذا اليوم لذلك السبب و إن كنت أتحسب له دائما باستعارة قصتين لا قصة واحدة عقب انتهاء الفترة المسائية ليوم الأحد ، و لم يكن أمين المكتبة مجرد خازن للكتب أو إداري مسؤول فقط عن تشغيلها بل كان لديه حس تربوي و يتدخل أحيانا بالتوجيه فيما يتعلق بسلوكيات القراءة ، أتذكر أني ذات يوم شدني عنوان كتاب فأردت استعارته فقال لي هذا الكتاب غير مناسب لسنك و لما وجدني مصرا على استعارته تركني أستعيره و هو يقول لي : هذا الكتاب بالذات عندما تعيده لابد أن تشرح لي ماذا فهمت منه ؟ و أخذت الكتاب و في اليوم التالي اعترفت للأستاذ بأني أخطأت في استعارته فلم أفهم منه إلا النزر اليسير فقال لي مبتسما : ألم أقل لك إنه غير مناسب لسنك ؟ .
كان ما يعجب أمين المكتبة في أنني أقر أ الكتب بانتظام فعندما بدأت في قراءة مجموعة كامل كيلاني و كانت تطبعها لسنوات طويلة مكتبة دار المعارف كنت أتتبع كل قصص المجموعة الموجودة بالمكتبة حتى انتهي منها بالكامل ثم أبدأ في مجموعة أخرى ، فعلت ذلك أيضا مع مجموعة المكتبة الخضراء للأطفال التي كانت تصدرها دار المعارف و مجموعة المكتبة المدرسية لمحمد سعيد العريان و آخرين و قصص محمد أحمد برانق و محمد عطية الإبراشي و عبد الحميد جودة السحار و مجموعة أولادنا و يحكى أن وحكايات جدتي و مجموعة قصص الأساطير : أساطير من الهند ، أساطير من الصين ، أساطير من اليونان و أساطير من فارس ، و مجموعة حكايات ألف ليلة و ليلة و كليلة و دمنة و غيرها .
إن الذاكرة الإنسانية لغريبة أحيانا فقد تفلت الذاكرة أمورا قريبة الحدوث زمنيا و تحتفظ بأمور توالت عليها عقود من السنين و قد تقبض بقوة على أسماء و أشياء ضئيلة أو قليلة الأهمية و يتسرب من بين ثقوبها كثير من الأسماء و الأشياء الخطيرة و المهمة ، فما زالت ذاكرتي مثلا تحتفظ حتى الآن باسم تلميذ زاملني لسنة واحدة فقط في المدرسة الابتدائية هي السنة الأولى و لكنه في الإجازة الصيفية نزل ليعوم في مياه الفيضان بجوار البيت فغرق ( كانت مياه الفيضان قبل بناء السد العالي تغمر سنويا كل أراضي الوادي و يسمى الأهالي الفيضان : الدميرة ) ، اسم هذا التلميذ الزميل الذي فقدته مبكرا جدا ( رشاد عبد الحكيم ) ، تحتفظ ذاكرتي أيضا حتى الآن بعبارة قرأتها و أنا في تلك السن الصغيرة في إحدى قصص كامل كيلاني التي استلهمها من حكايات كليلة و دمنة لا أتذكر عنوانها بالضبط ربما ( دمنة و شتربة ) ربما ، لكن العبارة بالنص هي : " كنت يا دمنة بارعا ذكيا ، و كان عيشك سائغا هنيا ، فبدلك الحسد و أغواك و حير عقلك و أعماك فظلمت نفسك و قتلت أخاك " .
***
5 - مكتبات المدارس و تعليم الموسيقى في القرى
كانت بمدرستي الابتدائية مكتبة و لكن مع الأسف لم أدخلها إلا قليلا رغم رغبتي الشديدة في ذلك و تكرار محاولاتي فقد كانوا يتعاملون مع كتبها كعهدة مدرسية يخشى عليها من التلف و الضياع كما أن المكتبة في عرفهم شأنها شأن حصص الألعاب و الموسيقى و الرسم لا أهمية لها ولذلك كثيرا ما كان يتم السطو على تلك الحصص لصالح الحساب و العلوم و اللغة العربية ، بل كانت القراءة الحرة غالبا ما يعدها المدرسون نوعا من تضييع الوقت فيما لا جدوى كبيرة من ورائه ، أذكر أن الأستاذ حسن علي نصر - رحمة الله عليه - و هو من المدرسين الشباب غير الأفندية المطربشين أي يلبس الزي الإفرنجي ( قميصا و بنطلونا ) كان يلزمنا بأن نصطحب معنا في الفسحة الكبيرة كتابا لمادة الحساب التي كان يدرسها لنا في الصف الخامس الابتدائي لكن ما حدث أنني تحت ضغط عشقي للقراءة خارج المقررات الدراسية اصطحبت مع كتاب الحساب قصة أذكر عنوانها حتى الآن - و هو أمر يمكن إضافته إلى عجائب الذاكرة الإنسانية - ، كان عنوانها ( بدر البدور ) ، وضعت القصة في وسط الكتاب و كنت منشغلا بالقراءة فيها بدلا من الانشغال بالقراءة في كتاب الحساب و في أثناء اندماجي على درجة من درجات السلم الخارجي للمدرسة فوجئت بمن يدس وجهه معي في القصة و كان ذلك المدرس ، و خصني بذلك لأنه كان يخطط لحصول بعض تلاميذه من " الشطار " أمثالي على الدرجة النهائية في مادتيه بامتحان آخر السنة ( و قد حصل ذلك في امتحان نهاية الشهادة الابتدائية ) ، و قد وبخني على محاولتي خداعه و في حصة الحساب بعد الفسحة عاقبني بضربتين من عصاه النحيلة الصلبة على يدي ، و لم يكن في إمكاني في ذلك الزمان أن أشتكي لأبي من الاستاذ حسن أوغيره حين نتعرض لعقوباتهم فقد ينتج عن ذلك توبيخ و عقوبة أخرى من أبي لأن معنى أن المدرس عاقبني - و هو دائما مؤتمن و مصدق - في كل الأحوال أنني دون أدنى شك قد قصرت في أمر من أمور الدراسة أو أنني أتيت من السلوكيات غير الحسنة ما أستحق عليه التوبيخ و العقوبة ، هكذا كانت الأمور في حياتنا التعليمية في عقد الستينيات ، و مما أتذكره فآسف عليه أن حصص الألعاب و الموسيقى و الرسم كما سبق أن ذكرت لم يكن لها أهمية تذكر و إن أنس لا أنس ما كان يفعله تلاميذ المدرسة مع الأستاذ جلال مدرس الموسيقى بالمدرسة ، كان الأستاذ جلال يعطينا دروسا في الموسيقى نستخدم فيها كراسة خاصة ندون فيها بعض العلامات الموسيقية كما كان يعزف أمامنا كل صباح على الأكورديون و نحن نردد بشكل جماعي مصاحبين للحن المعزوف نشيد ( الله أكبر ) و هو النشيد الذي كتب كلماته عبد الله شمس الدين شاعر جمعيات الشبان المسلمين كما كان يلقب و تلحين الموسيقار محمود الشريف صاحب الألحان التي أصفها دائما بأنها ألحان " سكر زيادة " و النشيد الوطني " و الله زمان يا سلاحي " و هو من كلمات صلاح جاهين أحد أهم أساطين شعر العامية المصرية و تلحين الموسيقار كمال الطويل ، النشيد الذي استبدل به السادات بعد توقيعه معاهدة كامب ديفيد المشؤومة نشيد " بلادي .. بلادي " بعد أن خفف جرعة الحماسة فيه مختار السيد حين أعاد توزيعه أوركستراليا و عبث بإيقاعه الأصلي تحت إشراف اللواء الدكتور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، فعل ذلك السادات إيمانا منه بضرورة السلام مع أصدقائه الصهاينة و إكراما لعيون أمريكا و الغرب .
أعود إلى الأستاذ المسكين جلال مدرس الموسيقى الذي لم يكن من أهل القرية و مثله مدرسا الألعاب و الرسم ، رآه بعض التلاميذ من إحدى الدفعات السابقة علينا في المدرسة يكسر بيضتين في كوب زجاجي و يخلطهما بعود خشبي ثم يشربهما فلقبوه بعبارة توارثتها أجيال تلاميذ المدرسة لسنوات حتى انتقل إلى المدينة ، هذه العبارة هي : " الأستاذ جلال شرب البيضة " ، كان التلاميذ الأشقياء - و الشقاوة في أوساط الأطفال تعدي - يزفون الأستاذ جلال كل يوم و هو طريقه من المدرسة حتى الوحدة المجمعة على الجسر خارج القرية ليستقل الأوتوبيس عائدا إلى أسيوط بعبارة " الأستاذ جلال شرب البيضة " و انتشرت العبارة بين أطفال المدارس الابتدائية الأربع فلم يكن من يزفونه تلاميذ مدرستي فقط لاسيما أن التلاميذ كانوا يخرجون من مدارسهم عقب نهاية اليوم الدراسي في وقت واحد و ما أدراك كيف يكون تلاميذ المدارس الابتدائية حين ينفلتون من عقالهم الدراسي و ينتشرون في شوارع القرية كقطعان الأغنام الشوارد و يتهارشون طوال الطريق إلى منازلهم كما تتهارش جراء الكلاب الصغيرة .
كان ناظر المدرسة يسمح للأستاذ جلال أن يغادر المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي ليجنبه بعضا مما يتعرض له من التلاميذ ، و السبب من وجهة نظري في ذلك حين حاولت تفسيره فيما بعد هو هوان شأن مدرس الموسيقى ( و مدرسي الأنشطة بشكل عام ) على منظومة التربية والتعليم بالكامل في مصر هذا بالإضافة إلى تدني الوعي في الأرياف بقيمة الفن بصفة عامة و الموسيقى بصفة خاصة إلا إذا كانت في إطار معين كالموسيقى الشعبية التي يتعاطون معها في أوقات و مناسبات معينة كالأفراح و الموالد و ما إلى ذلك .
حببني كامل كيلاني في الشعر الذي كان يزود به كثيرا من قصصه فكنت أحفظه و كان يزاحم في ذاكرتي الصغيرة آنذاك ما كنت أحفظه في الكتاب من أيات الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم ( عم و تبارك و قد سمع ) لكن أول بيت حفظته خارج منهج المحفوظات المقررة علينا في سنوات الدراسة كان بيتا يستشهد به الأستاذ عبد الصبور جنيدي أحد مدرسينا المطربشين ( الأفندية ) حين يسأل زميلي بالفصل فتح الباب - و كان مع الأسف بليدا - سؤالا يتعلق بما فهمه من الدرس فلا يجيب و إذا أجاب فالإجابة على الدوام خطأ ، حينئذ يقول المدرس له :
سموك فتح الباب ما أنصفوا .. ياليتهم سموك " قفل الباب "
ثم يتلو البيت بقوله : اجلس لا بارك الله فيك .
كما سبق أن ذكرت جعلتني القراءة الحرة أشعر بيني وبين نفسي أني متميز عن زملائي و ربما عن بعض أساتذتي بالرغم من صغر سني بحصيلتي من المعلومات المتنوعة التي جمعتها من قراءة القصص ، و شحذت القراءة من ذاكرتي فكنت سريع الحفظ و كنت أقرأ و أكتب بشكل يحسدني عليه زملائي لا أقصد الخط ( أخفقت مع الأسف بالرغم من محاولاتي الكثيرة في تحسين خطي ) بل أقصد القراءة الصحيحة و الكتابة التي تندر فيها الأخطاء ، و قد اكتشف ذلك بعض مدرسي فجعلوني بدءا من صفي الرابع في المدرسة ألفا الطابور الذي يهتف و يهتف وراءه تلاميذ المدرسة الأصغر منه سنا و الأكبر بتحية العلم و يقرأ كلمة الصباح ثم يدير الطابور ليذهب كل تلاميذ فصل إلى فصلهم ، و ذات مرة وقف ناظر المدرسة الأستاذ حسن عبد الفتاح دسوقي بحذائه ذي اللون الأسود و الأبيض ليسأل هذا السؤال : من منكم يا أولاد يعرف اسم ضيف مصر الكبير في هذه الأيام ؟ فوجم الجميع و لم ينبس أحد ببنت شفة و رفعت إصبعي فرآني أحد مدرسي فشدني من يدي و أوقفني أمام الناظر قائلا : ياحضرة الناظر : الولد دا بيعرف الكفت ( و لكني حتى الآن لا أعرف ماهو الكفت ) ، فأعاد علي الناظر السؤال فقلت له : الأسقف مكاريوس رئيس قبرص فصفق لي حضرة الناظر و أمر كل تلاميذ المدرسة و المدرسين ( المتطربشين و المتبنطلين ) أن يفعلوا ذلك ، و في أحد احتفلات المدرسة بعيد الأم و كنت في الصف الثالث وضعوا لي كرسيا فوق منضدة و أصعدوني على الكرسي لكي أخطب في زملائي خطبة حول موضوع قرأته كقصة في مكتبة الوحدة المجمعة عن ضرورة البر بالوالدين حتى إن كانوا كفارا ، و مرة أخرى في أحد الأعياد القومية و كنت في الصف الخامس و بعد طواف طوابير المدارس بالقرية وقفت الطوابير أمام نقطة البوليس حيث يعمل أبي و ورفعوني على كرسي فوق منصدة ليراني الجميع فقد كنت طفلا صغيرا لم أتجاوز العاشرة من عمري لألقي كلمة مقتبسة من الميثاق الوطني الذي حفظني مدرس التربية الوطنية نصفه تقريبا خلال عدة أشهر من أجل أن استخدم فقراته ذات الأسلوب المميز في كلمات الصباح ( و لا غرو فإن لجنة ذات مستوى رفيع علما و ثقافة هم من قاموا بوضعه ، أما لمسات الصياغة الأسلوببة النهائية فكانت لهيكل و هيكل أديب في زي صحفي ) كانت الكلمة التي ما زلت أحفظها حتى الآن و غيرها من فقرات و عبارات الميثاق فهي كما يلي :
" إن قطعة من الأرض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة أو التاريخ لحركة عنصرية عدوانية أرادها المستعمر سوطا في يده يلهب به ظهر النضال العربي إذا استطاع يوما أن يتخلص من المهانة " .
حكى أبي لأمي ما حدث أمام محل عمله و كان فخورا بي و إن لم يبد ذلك لي صراحة فقد كان صعيديا قحا كما سبق أن ذكرت و من سمات الصعيدي القح - و هذا عيب فيه - أنه لا يفصح كثيرا عن مشاعره بالرغم من أن وجدانه يجيش بها ، في تلك الليلة أشعلت أمي قليلا من الحطب في طبق فخار و وضعت على النار بعد أن هدأت حفنةمن الشيح و المستكة و حبة البركة و اللبان الدكر و بخرتني ببخورها لوقايتي من الحسد وكانت تتلو المعوذتين و تردد بعض الدعوات في أثناء عملية التبخير .
***
6 - الصحة و المستشفيات في القرى
كنت بعد أن أخرج من مكتبة الوحدة المجمعة مع نهاية فترتها الصباحية و في جيب جلابيتي القصة التي استعرتها كي أقرأها بالبيت بعد الغداء أتخذ طريقي إلى حيث يلعب صاحبي رمضان جاد كي نعود معا إلى البيت و لكن بسبب فضولي الطفولي الشديد أحرص دائما على المرور بصيدلية الوحدة لا لشيء إلا للفرجة من خارج الصيدليةعلى مسوخ الأجنة المغمورة في الفورمالين داخل برطامانات كبيرة و المرصوصة على أرفف خشبية عالية بامتداد حوائط الصيدلية الداخلية ، و حين أتيح لي دخول المستشفى بجوار الصيدلية نزيلا لمدة ثلاثة عشر يوما في بداية صيف عام 1964 و كنت حينها تلميذا بالصف الرابع الابتدائي سألت كبيرة الممرضات بالمستشفى عن مسوخ الأجنة تلك فأخبرتني أنها أطفال ولدت ميتة و قد استكملت معلوماتي بشأنها بعد ذلك من عدة مصادر فعرفت أنها خدائج أجنة أي أجنة ولدت غير مكتملة النمو بعد أن أصيبت داخل بطون الأمهات بما ألحق بها تشوهات شتى ، و لأنها حالات جديرة بالدراسة الطبية فقد وضعت هكذا في مواد حافظة داخل البرطمانات و لكن ما لم أتمكن من الوصول إلى إجابة شافية عنه هو لماذا هي موجودة في الصيدلية ؟ و لماذا هي معروضة بهذا الشكل بحيث يراها رواد الصيدلية و كل من يمر أمامها مثلي ؟ .
تتبع تلك الصيدلية مستشفى الوحدة المجمعة و تعمل مصاحبة لعمل المستشفى ، فبعد أن يقطع المريض تذكرة الكشف التي لم يكن يزيد ثمنها آنذاك على قرشين صاغ تقريبا، ينتظر المريض على إحدى الدكك خارج حجرة الكشف حتى يحين دوره ف
يدخل ليكشف عليه الطبيب ثم يكتب له روشتة العلاج فيذهب بعد ذلك إلى الصيدلية كي يصرفها مجانا ، و. كنت ألاحظ أن معظم زبائن المستشفى و الصيدلية يوميا من النساء و الأطفال ما قبل سن المدرسة ، و كلما مررت قدام الصيدلية صباحا وجدت طابورا من السواد : الجلابيب السود و الشقق ( جمع شقة و هي نوع من الطرح الكبيرة ) و الطرح ، و ما زالت ذاكرتي تحتفظ باسم أشهر الأدوية التي كانت تصرف للمرضى في ذلك الزمان : الراوند و شربة الملح الإنجليزي و المزيج ( و لا أدري ماهو المزيج و لكن اسمه يدل على أنه خلطة من عدة مواد طبية ) و اليزول و الميكروكروم للجروح .
و مادمت جئت على سيرة دخول المستشفى فلا بأس من أحكي عنها حكايتين : الأولى حين تورم باطن ذراعي و كان يؤلمني و شرد ألمه النوم من عيني عدة ليال و لم تفلح فيه لبخات أمي البلدية فذهب بي أبي إلى المستشفى و كنت حينها بالصف الثالث الابتدائي ، كشفت الطبيبة على ذراعي فقالت لأبي : لما يستوي الورم ، تعال به بعد يومين أو ثلاثة ، و قبل أن يسألها أبي عن معنى ( يستوي ) قالت له عندما يتحول لون الورم إلى اللون الأحمر ، و بعد ثلاثة أيام كنا في حجرة الكشف و كشفت على ذراعي و رشت على الورم مخدرا موضعيا ( إتير ) ثم خاطبتني قائلة : راجل و تستحمل و الا عيل ؟ فقلت لها : راجل طبعا ، فابتسمت و هي تضع المشرط في بطن الورم و تحركه إلى أعلى و إلى أسفل و هي تضغط لكي تفرغ كل ما به من الصديد و كان ألما هائلا لا يطاق و وددت لو أستطيع البكاء ، و لكن كيف يبكي من أقر بأنه ر جل و ليس عيلا ؟ ، و ضمدت الطبيبة الجرح بعد أن وضعت بداخله فتيلا قائلة لوالدي : بعد ثلاثة أو أربعة أيام جئ به لنفك الضمادة ، و حين خرجت مع أبي كانت قد زال الكثير الوجع الذي عانيته مدة أسبوعين منذ ظهر بذراعي الورم و لم يتبق سوى وجع الجراحة الذي سرعان ما انتهى .
الحكاية الثانية أنني دخلت المستشفى أو بتعبير أدق احتجزت به بعد اصابتي بحمى روماتيزنية جعلت رجلي لا تقويان على حملي و كنت حينها كما أسلفت في الصف الرابع ، وضعوني حين احتجزت في عنبر كبير به أكثر من خمسة أسرة و لم يكن بالعنبر نزيل سواي و كان هناك أكثر من عنبر آخر و كلها بالدور الثاني من المستشفى ، حين دخلت المستشفى كان بالعنبر المجاور لعنبري ثلاثة رجال كهول ينتظرون موعد إجراء عملية البواسير فقد كانت المستشفى مزودة بغرفة عمليات كما أن الجراحة كانت تخصص مديرة المستشفى ، أحد الكهول الثلاثة كان خفيف الظل صاحب دعابة فبينما رفيقه يتعب الممرضة و يرهقها من أمرها عسرا في تناول حصته المقررة ثلاث مرات باليوم من زيت الخروع ، و هذا من أجل تنظيف بطنه تماما من فضلات الطعام حتى يصبح جاهزا لإجراء العملية كان هو يلحس بإصبعه جدران الكوب من الداخل و كأن ما به عسل نحل و ليس زيت الخروع الذي تجزع أنفس كثير من الناس و أنا منهم من مجرد رؤيته ، ثالثهم كان شديد السمرة و يحفظ أجزاء كثيرة من السيرة الهلالية أسمعني بعضها و حببني فيها كما كان يحفظ قدرا غير قليل من المواويل أذكر منها موالا سمعته لأول مرة في حياتي منه يقول : " الخسيس قال للأصيل : تعالى اعمل عندنا خدام ، تاكل و تشرب و تبقى من زمرة الخدام ، قال الأصيل عجبي عليك يا زمان ، دا أنا أسكن الجبال مع الحدادي و الغربان ، تاكلني الوحوشة و الغيلان ، و لا يقولوا الأصيل عند الخسيس خدام " ، هكذا حفظته منه و هو يختلف عن صيغته المتداولة بعض الاختلافات الطفيفة .
لليلتين عقب إجراء الكهول الثلاثة للعملية لم أكن أستطيع النوم بسبب أنينهم و توجعهم المستمر بعد انتهاء مفعول المخدر ( البنج ) أما حين أزيل من كل منهم ( الخابور ) الذي يضمد الجروح محل العملية و يمتص ما تنزفه من دماء فقد كان شيئا لا يمكن وصفه ، و قد ظللت طول عمري بعد ذلك أتحسب من الإصابة بالبواسير و يتلبسني رعب هائل إن ألمت بي أعراض كأعراضها .
نسيت أن أقول إن المستشفى كان في غاية النظافة ، يوميا تمسح أرضياته بالمنظفات و المعقمات فتبدو كأنها أرضيات فندق من فنادق الدرجة الممتازة و هذا في قرية لا تعد في الأرض و لا يوجد ما يماثل تلك المستشفى الآن في كثير من المدن .
عقب الحقنة الثانية تقريبا انفك عقال الروماتيزم عن رجلي و لكنهم أبقوني ثلاثة عشر يوما محتجزا بالمستشفى لاستكمال العلاج ، كان طعام الإفطار صباحا بيضتين مسلوقتين و كوب حليب ساخن ، و في الغداء خضار و أرز و لحمة و في العشاء قطعة جبن أبيض و قطعة حلاوة طحينية و زبادي و كل ذلك مجانا بالكامل : العلاج و الغذاء ، و مع ذلك أتذكر أن أمي - رحمة الله عليها - أرسلت إلي مع أبي طعاما مخصوصا مرتين أو ثلاثة و لا غرو فهكذا قلب الأم ، و لأني لم أكن أحب الحلاوة الطحينية فقد كنت أضع ما أعطاه منها داخل درج الكوميدينو بجوار السرير حتى إذا تجمعت عدة قطع يأتيني بعض أصدقائي من الأطفال و يقفون في الحديقة أسفل العنبر الذي أقيم فيه و قد استعار كل منهم قصة من المكتبة باسمه و يقذفون إلي بها من أسفل فأتلقفها أنا من أحد شبابيك العنبر الكبيرة و في مقابل ذلك ألقي إليهم بقطع الحلاوة فيتلقفونها في حجور جلابياتهم ، حدث ذلك مرتين أو ثلاث مرات خلال تواجدي بالمستشفى ، و من عجائب الذاكرة اني اتذكر اسم قصة قراتها بسريري في المستشفى و كان ( سميحة و مديحة ) و هي إحدى قصص المكتبة المدرسية لمحمد سعيد العريان و آخرين .
حين خرجت من المستشفى إلى البيت و لزمت البيت لأسبوعين آخرين لا أستطيع الخروج للعب مع أطفال الحي و لا يمكنني الذهاب إلى المكتبة لأقرأ فيها و أستعير منها و لكن الله عوضني خيرا فقد منحتني بنت جيراننا الطالبة أنذاك بالسنة الخامسة ( النهائية ) في مدرسة دار المعلمات روايتي ( واسلاماه ) و ( سيرة شجاع ) لعلي أحمد باكثير و يبدو أنهما كانا مقررتين للدراسة على طلاب و طالبات دور المعلمين و المعلمات فأجهزت عليهما في عدة أيام و لما لم أجد بعدهما ما أقرؤه فقد لجأت إلى الاجترار ، و أعني هنا بالاجترار إعادة قراءة ما قرأته من قبل مرة أخرى ، فكنت كل حين أنزل إلى الدور الأرضي من البيت لأفتح دولابا مثبتا في الحائط الذي يعلو المصطبة بمدخل البيت ألصقت بأحد مصراعيه من الخارج ورقة كتبت عليها بحبر أحمر ( المكتبة) و هي أول مكتبة أكونها في حياتي و إن كان ما بها من مقتنيات لا يزيد على خمس أو ست قصص و ثلاثة أو أربعة أعداد من مجلة سندباد لا أدري الآن من أين جاءتني ؟ كيف ؟ لكنها أصبحت بشكل أو آخر ملكي ، فأستخرج منها ما قرأته من قبل لأقرأه مرة ثانية و مرة ثالثة ، و كان هذا مفيدا فقد كنت مع كل قراءة أكتشف شيئا خفي علي في القراءات السابقة ، و الآن أتذكر عبارة للمفكر العلامة عباس محمود العقاد أشهر قارئ عربي في القرن العشرين يقول فيها : " أن تقرأ كتابا ثلاث مرات خير لك من أن تقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة".
***
7 - العيد في القرى
قبل أن ينتهي شهر رمضان أي قبل مجيء العيد بعشرة أيام تقريبا أو أسبوع على الأقل كان يأخذني أبي إلى محل بالقرية لبيع الأقمشة فأختار لون الجلابية أو البيجامة التي ستكون زي العيد ، لم نكن في القرى نعرف أن البيجامة ملبس مخصص للنوم فقط و كأطفال كنا نفضل أن يفصل القماش الجديد كبيجامة لأنها أشبه بالبدلة من ناحية و من ناحية أخرى تعطي فرصة كبيرة للحركة في أثناء اللعب ، و نوع القماش بحسب وقت مجيء عيد رمضان في الصيف أو الشتاء ، و كما سبق أن ذكرت كان وقت رمضان طوال الستينيات هو فصل الشتاء و لذلك كان الكستور هو القماش المناسب لكسوة عيد رمضان و كان الكستور نوعين : كستور بفروة و كستور مبرد ( أي بدون فروة ) .
و يصحبني أبي بعد شراء القماش الذي اخترته إلى دكان الخياط الذي يأخذ مقاساتي بعد أن يسألني : جلابية و الا بيجامة ؟ ، و قبل العيد بيوم أو اثنين أذهب مع أبي إلى الخياط لاستلام الجلابية أو البيجامة الجديدة .
أما بالنسبة لأمي رحمة الله عليها فهي تنشغل مع نساء الجيران في عمل كعك العيد و البسكويت فيجهزون " صواني الصاج " التي ترص فيها المخبوزات ( الكعك و القرص أو البسكويت أو الكعك أبو سكر ) و أتذكر أنهم كانوا يرسلونني إلى مكان معين قريبا من سويقة القرية لأشتري لهن لوازم عجينة الكعك من الخميرة و البيكنبودر و الكركم و الأخير هو ما يعطي الكعك لونه الأصفر أو المائل للصفرة بحسب مقدار ما يضاف منه إلى العجينة .
كانت عملية " خبز الكعك " تستمر لعدة أيام و كلها لدينا في البيت و ينضج كل الكعك سواء كعكنا أو كعك الجيران في فرننا فأمي كما سبق أن ذكرت لا تخرج من البيت و لو حتى إلى بيت الجيران الملاصق لناو لا الذي أمامنا ، و لكل بيت من بيوت الجيران يوم كامل و يعمل النساء جميعا كفريق واحد كل منهن تتولى جانبا من جوانب عملية " الخبز " تكون فيها أمهر و أكثر خبرة .
بالنسبة لعمل البسكويت كانت تثبت الماكينة ( ماكينة عمل البسكويت و هي غالبا مفرمة اللحمة مع تغيير الوجه أي منفذ خروج العجين ) بحافة الطبلية و توضع العجينة في فتحتها العليا و عندما تدار يد الماكينة يخرج العجين من فم الماكينة في شكل متصل فيقطع في أشكال مختلفة و يرص في صواني الصاج ، و قد كنت أساعد أمي و هي تصنع " الكعك أبو سكر " فقد كانت تستعين بي لنقش ذلك النوع من الكعك و فائدة النقوش أن السكر المطحون عندما يرش فوق الكعكة يستقر في الخدوش الغائرة التي أحدثتها أداة النقش ( المنقاش) ، و لم نكن في الأرياف نعرف السكر المطحون الذي نراه في مخابز الحلويات الآن ، كان السكر في القرى آنذاك يباع في شكلين : سكر المكنة " و هو عبارة عن مكعبات صغيرة و يستخدم أساسا في تحلية الشاي بحسب حجم كوب الشاي و عادة الشارب في تحليته ، و سكر القمع و يعرف بهذا الاسم لأنه قطعة واحدة كبيرة في شكل قمع ، و قمع السكر كان يكسر بالشاكوش و القطع المكسرة يتم طحنها في " الهون " طحنا جيدا و السكر الطحين أو المطحون هو ما يرش على الكعك المنقوش .
قليل من الكعك و القرص ( تنطق بضمة ففتحة ) بعد إنضاجه في الفرن يترك ليأكل طريا وحده أو يأكل بعد غمسه في الحليب الساخن أو الشاي الممزوج بالحليب أو بالشاي فقط ، أما معظم الكعك و القرص فيتم تشريكها أي تقطيعها في شكل شرائح و إعادتها إلى الفرن مرة أخرى لتحميصها ( يسمى فايش في كثير من المناطق و لكنه في جنوب سوهاج و شمال قنا يسمى شريك ) و هذا ما يجعلها تستخدم لفترة أطول بكثير مما لو تركت بدون تحميص.
ليلة العيد ليلة عظيمة بالنسبة للأطفال و بخاصة الأطفال في القرى ، كنت أكاد لا أستطيع النوم هذه الليلةمن شدة الانفعال ، ففي الصباح سألبس كسوة العيد الجديدة و غالبا ما يكون مع الكسوة الجديدة حذاء جديد و أذهب مع أبي إلى الجامع للمشاركة في تكبيرات و تهليلات العيد ثم صلاة ركعتي العيد و سماع الخطبة ثم أعود معه بعد ذلك إلى البيت لنفطر ثم أنطلق بعد أن أحصل على العيدية من أبي و أمي مع أترابي من أطفال الحي للاستماع بمباهج العيد المختلفة ، كان أبي يحرص قبل العيد على أن يفك بضعة جنيهات إلى فئات أصغر : شلنات (الشلن خمسة قروش ) و أنصاف ريالات ( نصف الريال عشرة قروش ) لكي يوزعها كعيديات على و على أمي و على أطفال الجيران و أصدقائي المقربين عندما يأتون معي إلى البيت ، و هكذا يفعل معي آباء أطفال الجيران و آباء أصدقائي عندما ننتقل من بيت إلى بيت كجزء من طقوس العيد ، فلوس العيد تصرف على شراء البلالين ( النفاخات أو النفافيخ كما كنا نسميها في الريف ) و على شراء الحلويات المختلفة كحلاوة خد الجميل و غزل البنات و براغيت الست و العسلية و شراء قصب خد الجميل ( و هو نوع غض من القصب ، لونه إما أحمر أو مموه من الأحمر و الأصفر ) غيرها ، و على البمب و الزمارات ذات الأصوات العالية و غالبا ما كان استخدامها هي و البمب يعرضنا لسماع عبارات التوبيخ و كلمات الزجر من كبار السن في الحي و غالبا ما ينتهي الأمر بسبب عدم توقفنا عن النفخ في الزمارات المزعجة و فرقعة البمب بالطرد من المكان ، و أكثر ما يكسبه أصحاب الدكاكين في القرية أيام العيد يكون من الأطفال ، كما كنا نذهب إلى المراجيح ( في اللعة الفصيحة أراجيح و مفردها أرجوحة) حيث نصبها الموالدية في جانب من القرية و المراجيح التي كنا نعرفها ليست كالمراجيح التي يعرفها أطفال المدن آنذاك و لا كما يعرفها أطفال القرى الآن ، هي مراجيح بدائية للغاية فهي مجرد قطعة عريضة و سميكة من الخشب معلقة بحبلين غليظين بين نخلتين أو شجرتين لا أكثر ( في قرى جنوب سوهاج و شمال قنا يسمون المرجيجة طلطيحة ) ، و بالمشاركة بين أكثر من طفل كنا نشتري أحيانا كرة جلدية نلعب بها في الأماكن الرحبة بالحي و كانت نتيجة لعب الكرة التعرض لما تعرضنا له بسبب الزمارات و البمب فاللعب لا يتم في صمت و كيف يصمت الأطفال و هم يلعبون ؟! و إنما يصحب اللعب دائما الكثير من المشاجرات الطفولية و الصياح ، لم نكن نشعر طول يوم العيد بأي تعب بالرغم من كثرة الحركة و التنقل كما لا تساورنا رغبة في العودة إلى البيوت مما يضطر الأمهات لإرسال الآباء أو صبيان أكبر سنا لإعادتنا إلى البيوت و غالبا ما تخفق هذه المحاولات و تقابل بالرفض الصريح ثم الروغان ( الزوغان ) منهم لاستكمال اللعب و الاستمتاع بمباهج العيد ، و إذا حدث و لم أجد بدا من العودة إلى البيت فإنني أكون مكدرا للغاية و لا يفلح ما تضعه أمي أمامي على الطبلية من طعام مميز في هذا اليوم يكون اللحم (الزفر ) قوامه الأساسي في التخفيف من كدري ( أهم شيء لدى الطفل هو اللعب ) حتى أنفلت مرة أخرى إلى الشارع و لم يكن شيء يحول دون ذلك إلا وجود أبي في البيت و استعانة أمي به على كبح جماحي و إجباري على المكوث بالبيت على الأقل فترة القيلولة لا سيما إذا كان الجو حارا.
تعرضت ذات عيد في يومه الثاني أو الثالث لعلقة ساخنة من أبي لأن طفلا سأله أبي عني و هو يمر أمام نقطة البوليس حيث يعمل ليعود بي إلى البيت فأخبره الطفل كذبا لا أدري لماذا ؟ أنه رآني مع طفلين آخرين نركب الأوتوبيس الذاهب إلى مدينة أسيوط ، و لما تأخرت في اللعب مع أترابي فلم أرجع إلى البيت إلا بعد أن نفدت معظم طاقتي الحيوية و قرصني بمقارصه الجوع الذي لم أكن أشعر به طوال اندماجي في اللعب ، لم أفلح في إقناع والدي أني لم أذهب إلى أي مكان خارج القرية و استشهدت بطفلي الجيران اللذين كان معي طوال النهار ، و لم يقتنع بكلامي الذي كان مختلطا بالبكاء و النشيج إلا بعد تأكيدهما صدق كلامي ، حينئذ هدأت ثائرته ( كان رحمة الله عصبيا و شديدا في معاملتي بالرغم من كوني طفله الوحيد ) و راح يربت على كتفي و يمسح رأسي بيده مبررا ضربه لي بخوفه علي و كان بالطبع صادقا و عندما أقرأ بيت الشاعر الذي يقول :
فقسا ليزدجروا ، و من يك حازما .. فليقس أحيانا على من يرحم .
أتذكر هذه الواقعة و واقعات أخرى شبيهة بها .
***
8 - الصيف في القرى " أ "
لا أتذكر الصيف في السنوات الأولى من حياتي إلا من خلال الماء فقد ارتبط الماء و الصيف في ذاكرتي ارتباطا وثيقا ، و أبعد المشاهد التي أتذكرها حين كنت في الثالثة من عمري تقريبا هو مشهد المياه و هي تتدفق على الأرض و تنداح فتملأ الشقوق و الأماكن المنخفضة ، و جحافل الحشرات كالنمل و الصراصير و بعض الفئران هي تجري أمام أطراف المياه المتدفقة باحثة عن منجى من الغرق ، كان المشهد مثيرا و غريبا بالنسبة لطفل في تلك السن الصغيرة ، كانت القرى قبل تحويل مجرى النيل و بناء السد العالي حين يأتي الفيضان و يجتاح أراضي الحياض حول المدن و القرى تتحول القرى على وجه التحديد إلى جزر وسط المياه و يكون التنقل حينئذ ما بينها في أغلب الأحوال بالمراكب الصغيرة ( الفلوكة ) ، و كانت مياه الفيضان حين تصل إلى " نجع سبع " حيث ولدت تحيط بها و تكون على بعد عشرات الأمتار فقط من البيت الذي نسكن فيه ، و أتذكر أنه ذات يوم أغراني بعض الأطفال الصغار من أترابي بخلع ملابسي و النزول معهم في تلك المياه ، و لا أدري كيف عرف والدي بالأمر ؟ كان عائدا من لدن البقال و يحمل بين يديه بضعة أكياس ملح ( كان وزن الكيس كيلو و ثمنه قرش صاغ إن لم تخني الذاكرة ) حين وجدني على الحالة التي وصفتها فشدني من يدي و جررني وراءه و أنا أبكي حتى مدخل البيت ، و عندما رأى أمي شتمها و قذفها بأكياس الملح التي تمزقت فوق رأسها ( كانت أكياس الملح ورقية ) متهما إياها بالإهمال في ملاحظتي ، و يمكنكم أن تتفهموا طبيعة ما حدث في ضوء معرفتكم أني كنت الطفل الوحيد لوالدي فكل ما أنجباه قبلي من أطفال - مع الأسف - لم يقدر لهم الاستمرار في الحياة فكانوا يموتون لأسباب شتى قبل أن يتجاوزوا الخامسة من أعمارهم ، و المشهد الثاني أو الثالث و هو مشهد مأساوي رويته في قصة قصيرة بعنوان " المأساة " نشرتها عام 2007 تقريبا بمجلة القصة التي كان يصدرها نادي القصة ، و خلاصة المشهد الذي ظل محفورا في ذاكرتي بشكل غريب أن جروا صغيرا سقط في لجة من مياه الفيضان لا أدري كيف ، أمن تلقاء نفسه أم بفعل فاعل ؟ و كان الجرو حين رأيته يحاول الوصول إلى حافة اللجة ليخرج و لكن شرذمة من الأطفال الأكبر مني قليلا ( أطفال و لكنهم شريرون ) كانوا يرشقونه بالأحجار و قطع الطوب و الزلط كلما اقترب من الحافة فيغطس في اللجة ثانية ثم يكرر محاولاته للخروج و لكن هيهات فقد ظل الأطفال الأشرار يصوبون قذائفهم إلى رأسه حتى فاضت روحه ، عندئذ فقط تفرقوا و هم يتصايحون و يتضاحكون .
خوف والدي علي من الغرق جعلهما يخوفانني من الماء و النتيجة أني كبرت دون أن أن أتعلم السباحة ، و قد ظللت سنوات طويلة حين أذهب مع زوجتي و أولادي إلى المصيف أكتفي بالجلوس على الشاطئ و قصارى ما كنت أفعله أن أغمس رجلي في مياه المد التي أعرف أنها سرعان ما تنحسر عنها مرة أخرى ، و لكنني رويدا رويدا و شيئا فشيئا بدأت أتجرأ و أنزل إلى الماء ، ثم تجاسرت حتى قدرت أن أقف هناك أو أتمدد على ظهري فوق سطح المياه لبضع دقائق قليلة و أنا ممسك بالحبل الحاجز الذي تبدأ بعده المنطقة التي لا يصلح أمثالي للوجود فيها .
حين انتقلنا من قرية نجع سبع التي ولدت فيها عام 1954 إلى قرية " موشا " و كان ذلك عام 1958 تقريبا أتذكر أن ذلك كان في الصيف ، و قد حملتنا و كل محتويات بيتنا من أثاث و مفروشات و آنية نحاسية و فخارية و ما إلى ذلك سيارة نقل جلس أبي بجوار سائقها و لذت أنا بحضن أمي في الجزء الخلفي من السيارة وراء كابينة القيادة مباشرة ، و أقمنا الليلتين الأوليين بموشا في ضيافة أسرة أحد زملاء والدي بنقطة البوليس ثم انتقلنا إلى بيت الست فهيمة و أتذكر أنها كانت سيدة مسيحية كفيفة تعيش في الدور الارضي قريبا من باب البيت الذي استأجرناه و يأتي إليها بطعامها و شرابها يوميا أولاد ابنها أو بنتها الذين يسكنون في شارع قريب من البيت ، لم نمكث كثيرا في هذا البيت و انتقلنا منه إلى بيت أفضل و أوسع في شارع النقطة ( نقطة البوليس ) ملك رجل يلقب بأبي فهيم و كان رجلا كبيرا في السن و يسكن في الدور الأرضي من البيت وحيدا بعد أن ماتت زوجته و لم يكن له أولاد منها ، حظيت أمي خلال الفترة القصيرة التي سكناها في بيت الست فهيمة بأول صديقة لها في " موشا " هي الست " أم شعبان " و كانت سيدة فقيرة مات زوجها من سنوات و لم يتيسر لها الزواج ثانية ( يطلقون على من في مثل حالتها تلك لقب : هجالة ) ، و كان لها بنت وحيدة زوجتها مبكرا و تعيش في قرية قريبة ، و لما سألتها ذات مرة لماذا تلقب بأم شعبان و أين هو شعبان ؟ أخبرتني أن أول مواليدها كان طفلا أسمته شعبان و لكنه مات صغيرا و اعتاد الناس منذ ذلك الزمان أن ينادوها بأم شعبان ، كانت أم شعبان ترتزق من التردد على البيوت لتبيع احتياجات النساء من الحرد ( و لوازم تفصيل الحردة كالترتر و الخرز و غيره ) و الفلايات و الدبابيس و الكباسين و الإبر و بنسات الشعر و الفازلين و زجاجات الريحة ( العطور ) و ما إلى ذلك و ظلت تلك السيدة تترد على أمي إلى أن انتقلنا عام 1970 إلى مدينة أسيوط و أظن أنها زارتنا في بيتنا بأسيوط عدة مرات قبل أن تقعدها الشيخوخة و المرض ( رحمة الله عليها ) ، و ظل أبي يبحث عن مكان أفضل و المكان الأفضل في عرف الناس في ذلك الوقت هو " بيت من بابه " أي مكان مستقل للسكنى لا يشاركنا فيه أحد كالبيتين السابقين ، و بعد عدة شهور وجد أبي بيتا في حي الشهابية بالطرف الجنوبي من القرية في ذلك الوقت ، كان البيت يتكون من دورين : بالأرضي غرفة مبلطة كان أبي يضع بها بضعة أشولة القمح و زكايب الدقيق مؤونة البيت لمدة 6 أشهر على الأقل و في جانب منها كانت هناك منضدة مستديرة و كرسيان ؛ و قد كانت المنضدة مكان مذاكرتي المفضل أوقات الامتحانات أما في غير ذلك من الأوقات فالمذاكرة على الطبلية ، و خارج الغرفة خلف باب البيت مباشرة تقع باحة البيت الأمامية وكان الجزء الأكبر منها مسقوفا و الجزء الآخر مفتوحا على السماء ، أما خلف الباحة و الغرفة فيقع الجزء الداخلي من البيت الذي يبدأ بالركن الذي يقبع فيه الزير مصدر مياه الشرب و الطبخ و ما إلى ذلك ثم إذا انحرفت يسارا تجد باحة البيت الخلفية حيث تقبع الفرن في المنطقة غير المسقوفة منها أما المنطقة المسقوفة ففيها صومعة تخزن فيها الحبوب و غريفة صغيرة كانت أمي تضع فيها زروية السمن و بلاص الجبنة القديمة و المش كما كان في تلك الغريفة قطرة الأرنبة الوالدة ( القطرة جحر طويل يخص الأرانب ) ؛ و قدرة مليئة بالنخالة ( تسمى النخالة أيضا في القرية باسم آخر هو الدشيش ) كانت أمي تدفن فيها بيض الدجاج الذي تربيه في المساحات خارج الغرف سواء بالدور الأرضي أو الدور الأول.
و في الدور الأول كان هناك غرفتان إحداهما صغيرة و الأخرى كبيرة ( الكبيرةكانت بمثابة غرفة النوم لأسرتنا الصغيرة و في الأيام الأولى لنا بالبيت قامت أمي بتلييس حوائطها بالكامل ، و التلييس هو تغطية الحائط بالطين المخلوط بالتبن ( حطام سيقان القمح أو القش ) فلا تكون هناك أية شقوق مفتوحة يخشى خروج حشرات مؤذية منها كالعقارب و غيرها ) و الصغيرة يدخل إليها من الكبيرة و لكل منهما شبابيك على الشارع الذي يفصل بيننا و بين جيراننا " بيت مهران الخطيب " كان شيخا شحيما لحيما و تختلف عنه زوجته لبيبة فهي نحيفة نحيلة ( جلد على عظم ) يجدها الداخل إلى بيتهم على الداوم تفترش جزة ( فروة كبش ) على " شلتة " و مسندة ظهرها إلى الحائط بجوار الباب الذي كان في أغلب الأوقات مفتوحا على مصراعيه و يتقاسم غرف البيت أسفل و أعلى أولاده الثلاثة : مصطفى و عبد الصبور و فتحي ، خارج الغرفتين صالة تفصل بين الغرفتين و بقية سطح المنزل الذي لم يكن ينقصه سوى السقف ليشكل غرفة كبيرة و لكن صاحب البيت تركه دون سقف و في هذا المكان الذي كانت الشمس تغمره بضوئها و حرارتها صيفا و شتاء كانت أمي تربي بعض الدجاج والبط وأحيانا جديا أو معزة ، أما في الغرفة الصغيرة المسقوفة التي أشرت إليها من قبل فكانت تربي حماما و أرانب .
حين انتقلنا إلى موشا و في الفترة القصيرة التي سكنا في أثنائها ببيت أبو فهيم كان ماء الدميرة " أي الفيضان " بدأ ينحسر و في هذا الوقت بالذات يبدأ الأهالي المزارعون في إصلاح أراضيهم و إعدادها للزراعة فيخرجون بألواح اللوق لتسوية أراضيهم التي ما تزال أوشال المياه المنحسرة راكدة في أجزائها المنخفضة ، و مما تحتفظ به ذاكرتي من تلك الأيام حادثة مقتل " إبراهيم بهنساوي " زين شباب عائلة بهنساوي برصاص عائلة بيت عسقلاني و هما من كبار عائلات القرية و كان بينهما ثأر و دماء لسنوات طويلة ( حتى منتصف الستينيات تقريبا ) إلى أن أفلحت السلطات و رجال المصالحات العائلية و حكماء العائلتين في تسوية و إنهاء ما كان بينهما من مشاكل حتى إنهما فيما أعلم قد ارتبطا بعد ذلك بعلاقات نسب و مصاهرة و انطوت صفحة كئيبة و بغيضة من حياة العائلتين و حياة القرية بالكامل .
و مما تحتفظ به ذاكرتي من تلك الأيام أيضا - و إن كنت غير متأكد من ذلك - أغنية لليلى مراد كانت فيما يبدو من أغنياتها الجديدة في أواخر الخمسينيات لأنها كانت تذاع كثيرا في الراديو لذلك و تتردد على ألسنة الناس و هي : " آنا زي مانا و انت بتتغير " من كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد و تلحين أخيها موسيقار الأغاني الخفيفة و الظريفة منير مراد ، و قريبا منها في الزمن إن لم تخني الذاكرة أغنية : " يا اما القمر على الباب " لفايزة أحمد كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز و تلحين الموسيقار محمد الموجي .
في أشهر الصيف لا يجد الأطفال في القرية سوى اللعب في الشوارع و الأزقة و الحارات لتزجية الوقت حتى تنتهي الإجازة المدرسية فيعود جزء كبير منهم إلى المدرسة ، و لكن أبي في أيام الإجازة كان حريصا على أن يلحقني بالكتاب لأحفظ ما تيسر لي من القرآن الكريم ، في البداية التحقت بكتاب الشيخ شعيب ( كان معي في ذلك الكتاب أطفال مسيحيون يتعلمون القراءة و الكتابة ) و لكن ذلك الكتاب لم يستمر طويلا فألحقني بكتاب الشيخ علي الجبود و كنت يوميا أذهب إلى الكتاب و معي لوحي ( من الصفيح و يكون وقت شرائه جديدا براقا لامعا جدا فلا يثبت عليه الحبر عند الكتابة سواء كانت أداة الكتابة الريشة أو قلم الغاب لذلك كان تعالج تلك المشكلة بأن نسكب عليه كمية من الحبر و نتركه حتى يجف فيغدو بعدها صالحا للكتابة عليه ) و رواد الكتاب منهم تلاميذ بالمدارس و منهم أطفال يلحقهم أهلوهم بالكتاب كي يتأهلوا لدخول المدرسة و منهم من لم يلتحقوا من قبل بالتعليم و التحقوا بالكتاب كي يتأهلوا لدخول الأزهر و هؤلاء هم الفئة التي تحظى بأغلب اهتمام شيخ الكتاب و يبدو أنه كان يحصل على مكافأة نظير كل صبي يتأهل من كتابه لدخول الأزهر ، كل طفل حين يدخل الكتاب صباحا يكتب الشيخ له في لوحه حصته من آيات القرآن ، و إن كان من الصغار الذين لم يدخلوا المدرسة بعد يكتب لهم حصتهم من حروف الأبجدية كل حرف بتشكيلاته الثلاثة الضمة و الكسرة و الفتحة فيظل الطفل الصغير طوال اليوم يقرأ مثلا ( باء فتحة با ، باء ضمة بو ، باء كسرة بي و هكذا ) ، كتاب الشيخ علي الجبود عبارة عن صالة كبيرة تتوسطه بعض دكك للأطفال الصغار الذين يتعلمون مبادئ القراءة و الكتابة و مصطبة بارتفاع نصف متر مفروشة بالحصر ( جمع حصير ) ملاصقة لثلاثة حوائط عدا الحائط التي يفتح فيه الباب و بجواره مصطبة الشيخ التي يجلس عليها و هي أعلى قليلا من مصطبة التلاميذ ، و هناك مدخل من داخل الكتاب يفتح على بيت الشيخ و في بداية المدخل وضع زير المياه الذي يعلوه غطاء خشبي فوقه كوب من الصفيح مربوط بدوبارة طويلة في أحد أرجل الحامل .
كل من رواد الكتاب كبارا و صغارا يقرأ حصته التي حددها له الشيخ من وقت دخوله الكتاب في الصباح حتى موعد الخروج قبل أذان العصر و بيد الشيخ دائما جريدة طويلة يصيب بها دون أن يتحرك من مكانه رأس من يجده توقف عن القراءة أو انشغل بالحديث مع جاره و تتداخل الأصوات في القراءة بشكل كلما أتذكره لا أعرف كيف كان الشيخ يميز الأخطاء في قراءة كل هؤلاء ، و في حالة عدم حفظ أحدهم الحصة المقررة أو إحداث بعض الصغار شغبا شديدا فهنا لا يكون ثمة مفر من التعليق من الرجلين في الفلقة ( و ينطقها بعضهم الفلكة ) التي يحملها من طرفيها صبيان كبيران و ينال المقصر أو المشاغب على بطني قدميه بضع ضربات بعصا قصيرة و صلبة من الجريد و أحيانا يصاحب الضرب تجريسة بالضرورة بين تلاميذ الكتاب و ذلك عندما يكون المعاقب بدون سروال داخلي ، و غير قليل من أطفال و صبيان القرية في ذلك الزمان كانوا هكذا .
***
9 - الصيف في القرى " ب"
لم أكن في الكتاب أحظى باهتمام كبير من الشيخ فهو يعرف أن أبي يرسلني إلى الكتاب لا لحفظ القرآن كله كغيري و لا حتى نصفه بل كان غرضه الأساسي ألا تضيع الإجازة كلها في ما لا جدوى من ورائه من وجهة نظره في اللعب ، و مع ذلك فقد حفظت بضعة أجزاء منه و ما زلت أحفظها ، و في الكتاب فضلا عن حفظي ما تيسر لي من القرآن الكريم استفدت بضع خبرات منها مثلا معرفة الكثير من أحكام التلاوة ، و منها أيضا معرفة كيفية صنع المداد ( الحبر ) السائل في البيت من بودرة الحبر الجاف ، و أن أجعل الحبر السائل غليظ القوام بعض الشيء ليعلق باللوح عند الكتابة عليه و ذلك بإضافة قليل من الصمغ إليه ( كنت أجمع الصمغ في شكل فصوص من شجر السنط و هو كثير بالقرية) ، و لكي لا ينسكب الحبر من الدواة أضع بداخلها قطعة من الإسفنج أو القطن ( تسمى ليقة ) لتمتص الحبر فلا تسمح بانسكابه عندما تميل الدواة ( المحبرة ) على جانبها لسبب أو آخر ، و بالطبع هذا أرخص كثيرا من شراء الحبر السائل في دويان ( جمع دواة ) معلبة ، و بالمناسبة فقد لحقت إبان دراستي الابتدائية المرحلة الأخيرة من استخدام الحبر السائل في الكتابة ، و أدراج التلاميذ ( كانت تسمى تخت بضم ففتح و مفردها تختة ) حين كانت تصنع فمن أهم ما يميزها تلك الفجوة التي تستقر فيها دواة الحبر التي كان التلميذ يغمس فيها ريشته التي يكتب بها في الكراسة أو يملأ منها خزان القلم ( قلم بجلدة أو قلم بكباس ) و بجوار فجوة الدواة كان هناك مجرى طويل محفور قرب حافة التختة ليكون مستقرا للريشة في حالة عدم استخدامها ، و تعلمت أيضا كيف أصنع بنفسي قلم البسط أو قلم البوص أو القصب ( في فقه اللغة للثعالبي نقرأ : كل نبات كانت ساقه أنابيب و كعوبا فهو قصب ) و يصنع هذا النوع من الأقلام من أنابيب نبات الغاب (كعوبه) ، فكنت أقطع رأس الكعب بميل معين بأداة قطع حادة كالسكين و غيرها ثم أشق طرفه الدقيق قليلا ليمتص بعضا من الحبر عندما يغمس في الدواة ، و لكنني كنت أفضل الريشة في الكتابة على لوحي ، و الريشة تتكون من جزئين : جسم الريشة ( في طول قلم الرصاص تقريبا ) الذي تقبض عليه اليد عند الكتابة و جسم الريشة يصنع في الغالب من الخشب و ينتهي في أعلاه بدائرة معدنية صغيرة يثبت فيها سن معدني مشقوق ( يسمى سن الريشة ) و هو الذي يغمس في الدواة عند الرغبة في الكتابة .
كان الطلاب الأساسيون في الكتاب هم أولئك الذين يؤهلهم الشيخ لدخول الأزهر ( معهد فؤاد الأول الديني بمدينة أسيوط ) ، لذلك عندما ينتهي أحدهم من حفظ القرآن كاملا كان أهله يفرحون و يحتفلون بذلك الإنجاز فيرسلون مثلا إلى الشيخ زجاجة شربات و قمعين من السكر و أشياء أخرى لا تمر على الكتاب بل تذهب مباشرة إلى بيت الشيخ و هي غالبا من لحوم الذبائح و الطيور و العيش الشمسي و ما إلى ذلك ، و في أحيان قليلة كان يصيب كل تلميذ في الكتاب من حلوى الفرح بختم القرآن قطعة طوفي أو ملبسة أو مكعب صغير من السكر .
كانت هناك إعانات رسمية للكتاتيب من وزارة الأقاف فيما أعلم و لكنها قليلة لا تكفي ، لذلك فبالإضافة إلى الإعانة يحصل الشيخ من الأهالي إبان مواسم الحصاد المختلفة نصيبا من المحصول ، و صباح الخميس يذهب كل تلميذ إلى الكتاب و معه قرشان صاغ يسلمهما للشيخ عند دخوله و تسمى هذه الجعالة الأسبوعية باسم " الصرافة " ، و يطرد الشيخ التلميذ الذي نسي أن يحضر معه الصرافة في هذا اليوم .
بخلاف التردد اليومي على الكتاب الذي ينتهي كل يوم عند الساعة الواحدة بالنسبة لتلميذ غير أساسي بالكتاب مثلي كنت كشأن الأطفال في كل زمان و مكان أكمل بقية اليوم في اللعب مع أترابي و كثيرة هي ألعاب الأطفال في الريف ، كنا مثلا نجمع أغطية زجاجات الكوكاكولا و زجاجات سيكو الليمون و سيكو البرتقال و عندما يصل العدد إلى 33 غطاء نقوم بثقبها جميعا في المنتصف و ندخل فيها خيط أستك نعقده في نهايته فتصبح الأغطية المنظومة في خيط الأستك كأنها سوار ، حينئذ نضع في وسط سوار الأغطية بكرة خيط خشبية ( كانت الخيوط آنذاك تلف على بكرة من الخشب و ليس الورق كما يحدث الآن ) فيصبح لدينا عجلة و نصنع عجلة أخرى بنفس الطريقة ، و في طرفي قطعة سميكة من الخشب لايزيد طولها عن 40 سم إلا قليلا نثبت العجلتين ، و في وسط تلك القطعة السميكة نثبت قطعة خشب طويلة ( متر و نصف تقريبا ) نستخدمها في تحريك العجلتين ، و إن لم يكن لدينا رغبة في صناعة العجل فيمكننا استخدام الأغطية في لعبة أخرى وتكون بين متنافسين اثنين في الغالب يضع أحدهما غطاء جديدا على الأرض و يحاول اللاعب الآخر عن طريق الضغط على سطح الغطاء الموضوع على الأرض بطرف أحد الأغطية التي تخصه فإذا أسفر الضغط بطريقة معينة عن انقلاب الغطاء على ظهره فإنه يصبح ملكا له ، و إذا فشل في ذلك فعليه أن يضع غطاء من عنده على الأرض ليأتي دور خصمه الذي يجرب حظه في محاولة قلب الغطاء و هكذا ، و الفائز في نهاية اللعبة هو من استطاع كسب أكبر عدد من أغطية خصمه .
ومن ألعاب الطفولة التي أفلتت من عمليات جمع التراث الشعبي على كثرة القائمين به ربما لأنها اختفت منذ فترة زمنية طويلة لعبة تسمى " النكيتة " بكسر و تشديد النون و الكاف و اسم اللعبة من الفعل " نكت " بمعنى غرس أو غرز و اللعبة كانت مرتبطة بانحسار مياه الفيضان حيث تكون الارض لينة بعض الشيء قبل أن تجففها تماما حرارة الشمس فتتشقق ، يجتمع حول قطعة الارض اللينة مجموعة من الأطفال كل منهم في يده قطعة قصيرة صلبة ذات رأس مسنون من الخشب أو الحطب ( سيقان نبات القطن ) و تسمى أداة اللعب أيا كانت خامتها ( الدكم ) بضم الدال و سكون الكاف ( يشبه الأهالي الشخص الربعة متين البنيان بالدكم ) و يرفع الطفل يده بالدكم ثم ينزل بها و قبل الاقتراب من الأرض يفلت من يده الدكم الذي ينغرس في الأرض بمقدار قوة يد الطفل و خبرته في اللعبة و تمتلئ قطعة الأرض الصغيرة بالدكوم أو الأدكم التي انغرزت في الأرض ، و تعاد الكرة بنفس الترتيب الذي بدأت به و إذا نزل دكم أحد اللاعبين فخلع دكما من الأرض للاعب آخر و حل محله يكون الدكم المخلوع من حقه .
ومن الألعاب التي أفلتت أيضا من عمليات جمع الموروث الشعبي لعبة نسيت اسمها و لكنها كانت تلعب بنوى البلح و يسمى نوى البلح في القرية باسم ( الفصا ) و تبدأ اللعبة بأن يكون لكل لاعب في حجره كمية من النوى و تحفر بينهما في الأرض حفرة صغيرة و عميقة بعض الشيء ، يمسك اللعب الأول بنواتين بأصابعه الثلاث الإبهام و السبابة و الإبهام ثم يقربهما من شفتيه فينفث فيهما ثم يلقي بهما في الحفرة فإذا سقطت النواتان داخل الحفرة فله أن يحاول مرة أخرى أما إذا سقطت النواتان خارج الحفرة فهنا يبدأ دور اللاعب الآخر أما إن ظلت إحداهما في قعر الحفرة و قفزت الأخرى إلى خارجها فعلى اللاعب الخصم حينئذ أن يملأ المسافة ما بين النواة خارج الحفرة و الحفرة بنوى من عنده .
و من ألعاب الأطفال و الكبار في القرية لعبة السيجة و لست في حاجة إلى وصفها فهي معروفة لأغلب الناس و هي تشبه في بعض جوانبها لعبة الشطرنج و لكنها أفضل منها و قد وصفها وصفا لا استزادة عندها لمستزيد المفكر القومي عصمت سيف الدولة في الجزء الأول من سيرته الذاتية التي نشرها على جزئين في كتاب الهلال بعنوان " مذكرات قرية ، مشايخ جبل البداري " و ما أثار إعجابي أكثر من وصفه اللعبة تلك الموازنة التي عقدها بين السيجة و الشطرنج و انتصر فيها للسيجة على الشطرنج من خلال رصده عدة فوارق لكل منها دلالته الفكرية و الاجتماعية ، فالسيجة مثلا كل قطعها متساوية في القيمة و في مجال الحركة ؛ لا فضل و لا ميزة لقطعة منها على الأخرى ، بينما قطع الشطرنج تراتبية فهناك الملك و بعده الوزير و الفارس و الطابية و الفيل و أخيرا البيادق ، و امتيازات قطعة الشطرنج في الحركة بحسب مكانتها ، لذلك فلعبة السيجة لعبة ديمقراطية و مران عليها بينما لعبة الشطرنج أرستقراطية و ممارسة لها بحسب تعبيره ، و مما يؤكد ذلك أن قطع اللعب في السيجة من الأحجار أو الطوب الصغير ( يطلق عليها كلاب السيجة ) و تنقر مواقع صف القطع ( العيون ) في التراب و يمارسها لاعبوها و هم يجلسون على الأرض لكن في الشطرنج فإن قطع اللعب تصنع من الخشب الثمين أو من العاج و يجلس لاعبوها على كراسي أو مقاعد مريحة ، و كل القوى في لعبة الشطرنج مسخرة لحماية الملك ( الشاه ) و لا يجوز قتل الملك إلا بعد تحذيره بقول اللاعب ( كش ) و لكن في السيجة القطعة التي تسقط تسقط فداء لقطعة أخرى و الهزيمة هزيمة جماعية ، و يسهب عصمت سيف الدولة في بيان عدم صحة القول بأن السيجة أبسط من الشطرنج و أقل اقتصادا فيما يبذل فيها من جهد ذهني .
و لأن الصيف في القرى يكون دائما مصحوبا بانتشار الحشرات من كل نوع لاسيما الذباب و الناموس و و المن و الهاموش و يكون فيه الهواء ثقيلا و مشبعا بالروائح ( الزخم ) المنبعثة من الزرائب التي لا يخلو بيت منها حيث تربى الحيوانات المختلفة كالجاموس و الأبقار و الغنم و الضأن و الحمير و غيرها و كذلك الطيور الداجنة كالدجاج و الإوز و البط ، و تكون الأرض ملتهبة من شدة الحرارة فالشمس لا تفتأ تصليها بأشعتها الملتهبة طوال النهار فإن الأطفال هم أكثر الفئات اتساخا و تعرضا للأمراض فهم يلعبون في كل مكان ، ربما يلوذون بالأماكن الظليلة أحيانا و لكن في أغلب الأحيان يضطرهم الاندماج في اللعب إلى اللعب تحت أي ظرف فهم لا يأبهون لأية أمور ما عدا لوازم اللعب و مقتضياته ، و قد تميزت عن أترابي في الحي بشيء أساسي بسبب أني طفل وحيد والديه هو أن أمي كانت تحميني ( تسبحني في لغة أهل القرية) مرتين و ربما ثلاثة خلال الأسبوع بينما الأطفال الآخرون لا تحميهم أمهاتهم إلا مرة واحدة في الأسبوع و موعد ذلك هو صباح الجمعة ، و لكنه تميز بضريبة أو بثمن هو تعرض كامل جسدي ثلاث مرات لا مرة واحدة لخشونة ليفة النخل التي كانت تستخدمها أمي في تحميمي و تعرض عيني ثلاث مرات لحرقة الصابون قبل أن تستجيب أمي لتوسلاتي فتسكب الماء على رأسي للتخفيف من معاناتي ، كانت أمي تفعل ذلك مع الضرب ( التسكيع ) أحيانا لأتوقف عن البكاء و كان محل الاستحمام هو الطست ( الطشت ) تضعه قريبا من الكانون أو وابور الجاز الذي تسخن عليه الماء و تخلط الماء الساخن بماء آخر بارد و تزداد الآلام ألما ثالثا عندما تكون كمية الماء الساخن أكثر فأصرخ و أتقافز داخل الطست متوجعا .
عندما كانت تمر عربة الرش التابعة للبلدية لتثبيت التربة و التخفيف قليلا من سخونتها - و هي عبارة عن صهريج كبير مملوء بالمياه و محمول على عجلتين كبيرتين من الخشب يجرها بغل أو حصان أعجف - يجري الأطفال وراء العربة و هم يتصايحون و يضحكون ( أغلبهم حفاة لا بسبب الفقر بل عادة و سلوكا ) و قد شمروا جلابيهم من الأمام ليتلقوا على بطونهم و أرجلهم المياه المندفعة من ثقوب ماسورتي الرش الخلفيتين ، و بالرغم من رغبتي الطفولية العارمة في مشاركتهم هذا الأمر إلا أنني لم أكن أستطيع لأن معنى ذلك التعرض لتجربة التحميم القاسية في الطست مرة رابعة .
نشاط الأطفال الحقيقي بشكل عام نشاط نهاري يقل عندما يأتي الليل و أغلب الأطفال في القرى ينامون بعد تناول وجبة العشاء و قليلا ما كان يسهر الأطفال في ذلك الزمان و إذا سهر بعضهم بجوار الراديو في البيت فمن النادر و يكون ذلك مرتبطا بسماع مادة مشوقة هي في الأغلب تمثيلية كتمثيليات : أدهم الشرقاوي أو عابد المداح أو أيوب و غيرها ، و لم يكن يعرف الأطفال السهر حتى منتصف الليل إلا بعد دخول التليفزيون إلى القرية في الوحدة المجمعة ، و قبل ذلك كنت و بعض أترابي من أطفال الحي نتحلق على الأرض في بقعة الضوء التي يلقيها كلوب المقهى خارج الباب و نتبادل الحكايات التي يختلط في كثير منها الواقع بالخيال ، و تمثل خرافات و أساطير القرى جزءا أساسيا من تلك الحكايات و يستحضر مناخ الليل دائما حكايات العفاريت و الجن و الغيلان ، بعض الأطفال يحكون ما يحكونه عن تلك الكائنات الخيالية وكأنها واقع لا يقبل الجدال بل إن منهم من يؤكد و هو يحكي أنه رأى ذلك بأم عينيه و منهم من يؤكد أن هذا حدث معه شخصيا ، و أتذكر أنه عندما أحدثنا ضجيجا و نحن جلوس أمام المقهى طردنا صاحبها و كان القمر مكتملا فلجأنا إلى جذر نخلة ضخم استخرج من باطن الأرض في أثناء حفرها لبناء جدار ، كان جذر النخلة اشبه بجثة فيل صغير ، اتخذناه متكأ في الليالي المقمرة نمارس و نحن جلوس فوقه - كمجموعة من القردة الصغار - طقوسنا الليلية في تبادل الحكايات ، و عندما أتذكر بعض تلك الحكايات أجد أن بعضا منها عابر لحدود الجغرافيا و الجنسية و بعضها قرأته أو قرأت ما يشبهه ضمن أقاصيص هانز كريستيان أندرسون أو خرافات إيسوب أو أمثولات لافونتين أو حكايات كلية و دمنة ، من الحكايات التي كنا نتداولها و نحن أطفال صغار في القرية حكاية خلاصتها أن ثعبانا كبيرا كان كل ليلة يخرج من جحره ليبحث عن شيء يقتات به و لكن الظلام دامس - هكذا تقول الحكاية – لذلك فهو يخرج من جوفه جوهرة ذات بريق وهاج يبحث على ضوئها عما يقتات به فإذا ما انتهى من ذلك عاد فابتلعها مرة أخرى ، و قد رآه ذات ليلة رجل يركب حصانا و يلبس طربوشا فطمع في الجوهرة و نزل الرجل عن حصانه ثم ألقى بطربوشه فوق الجوهرة فحجب بريقها مما تسبب في موت الثعبان كمدا و حزنا ( نص الحكاية أنه طق مات )على جوهرته ، و قد أثرى الرجل ثراء عريضا عندما باع الجوهرة ، هذه الحكاية سمعتها في الإمارات حين كنت أعمل هناك إبان عقد الثمانينيات من القرن الماضي و إن كنت لا أتذكر بالضبط هل سمعتها من مواطن إماراتي أم من وافد عربي مثلي ؟ و لكنه غير مصري ، الفارق الوحيد بين الحكاية كما سمعتها و أنا طفل في القرية و الحكاية كما سمعتها و أنا شاب في الإمارات أن الرجل لم يكن يلبس طربوشا بل يضع على رأسه عمامة و سائر تفاصيل الحكاية الخيالية كما هي .
***
10 - و مازلنا في الابتدائي
قضيت في مدرستي التي هي أقدم مدرسة ابتدائية بالقرية سنتين بالإضافة إلى السنة التي دخلت فيها مستمعا فقط أي ثلاث سنوات ثم نقلت مع فصلي بالكامل إلى ملحق للمدرسة في نفس المنطقة و لكن على بعد 200 متر تقريبا منها ، و كان الأهالي يسمون ذلك الملحق " مدرسة الجمعية " ربما لأنها كانت فيما يبدو جمعية زراعية قبل تحويلها إلى ملحق للمدرسة ، ما أتذكره أن الفصل الذي وضعنا فيه كان واسعا رحبا على خلاف بقية فصول الملحق و له عدة شبابيك على الشارع الجانبي تدخل منه الشمس و يمرق الهواء كتيار عندما يكون الباب مفتوحا ، و فوق السبورة صورة للرئيس جمال عبد الناصر و على بعد منها صورة مرسومة لطفل يمسك في يده اليمنى بمنديل و أسفل الصورة كتبت هذه الجملة : " المنديل للتلميذ النظيف " ، و كان مدرس التربية الفنية ( الرسم ) في بداية العام الدراسي يكلف أحد التلاميذ بأن يجمع من كل تلميذ بالفصل تعريفة ( خمس مليمات ) و عند الانتهاء من عملية الجمع يعطي المبلغ لزميلين أو ثلاثة من زملائنا لشراء ورق القص و اللزق الملون و ورق الزينة ( الكريشة ) و صمغ و دبابيس و بالونات ( نفاخات ) و غيرها لتجميل الفصل كجزء من النشاط الفني ، و لكني لم أكن أشارك في تلك الأعمال إلا بدفع التعريفة فقط فلم يكن لي حظ البتة من المهارات المطلوبة لفعل ذلك .
و مازلت أحتفظ في ذاكرتي ببعض محفوظات المرحلة الابتدائية ، إليكم مثلا من نشيد " يا ربنا " من مقررات الصف الأول هذا الجزء الصغير : " يا ربنا يا ذا الكرم / يا واهبا كل النعم / هذا أبي ، نعم الأب / و أمنا كم تتعب / باركهما يا ربنا / و احفظهما دوما لنا " و من محفوظات الصف الثاني الابتدائي إليكم هذه الفقرات من نشيد " ما أجمل الضياء " : " تشقشق الطيور / فرحانة بالنور / تقول في سرور / ما أجمل الضياء // و الرجل الكبير و الولد الصغير / يقول في سرور / ما أجمل الضياء // و الحقل و الزهور / و النهر و الغدير / يقول في سرور / ما أجمل الضياء " ، و ما زلت أيضا أتذكر الجملة التي كان يقولها الأرنب المتبطر على طعامه لأمه في درس القراءة " الأرنب الغضبان " و هي : " كل يوم خس وجزر ، كل يوم خس و جزر .. أنا خارج لأبحث عن طعام " ، و أتذكر كذلك عدة جمل من أنشودة كنا نغنيها في حصة الموسيقى بالصف الثاني تقريبا تقول : " قطتي صغيرة و اسمها نميرة / شعرها طويل / و ذيلها قصير / لعبها يسلي / و هي لي كظلي / عندها المهارة / كي تصيد فارة " و قد كنت بالرغم من صغر سني أستسخف تلك الأنشودة و قد ظللت عدة سنوات بعد ذلك لا أفهم ماذا تعني هذه الكتلة من الحروف ( كظلي ) ؟ ، لم أميز في ذلك الوقت كاف التشبيه التي تسبق ( ظلي ) فتعاملت مع ( كظلي ) على أنها كلمة واحدة ، و لا أدري لماذا لم أطلب من المدرس أن يفسرها لي ؟ ، و على أية حال فهذا من عيوب التعليم المزمنة في مدارسنا فما زال الطفل حتى الآن يخشى التصريح لمدرسه أنه لم يفهم الدرس أو بعضه ، و المدرس حتى الآن أيضا يرفض أن يناقشه التلاميذ فيما يقول ، و من محفوظات الصف الثالث كان هناك نشيد بعنوان " الفلاح " أو " يحيا العمل " و منه هذه الفقرات : " احمل الفأس و هيا / نزرع الأرض سويا // سوف أجني بيديا / ثمرا منها شهيا / فاحمل الفأس و هيا // في غد تزهو الحقول / ذاك قمح ذاك فول / كل ما فيها جميل / سوف ينمو و يطول / فاحمل الفأس وهيا " ، و من محفوظات الصف السادس أتذكر نصين لأمير الشعراء أحمد شوقي أحدهما عن العمال يقول في بدايته : " أيها العمال أفنوا العمر كدا و اكتسابا / و اعمروا الأرض فلولا سعيكم كانت خرابا " و آخر رمزي أوله : " برز الثعلب يوما .. في ثياب الواعظينا " .
كنا نحصل على رغيف مصري يوميا كما كنا نحصل على قطعة جبنة مثلثة ( نستو ) و أحيانا قطعة من الجبنة الفلمنك و أحيانا كيس فول سوداني أو قطعة حلاوة طحينية ، و لعدة مرات وزع على كل تلميذ منا في المدرسة علبة سمنة و كيس لبن جاف كبير و على كليهما وضع شعار المعونة الأمريكية ( يدان متصافحتان ) و ذلك بالرغم من تناقض توجهات مصر بعد ثورة 52 مع سياسات الإدارة الأمريكية التي كانت تسعى إلى السيطرة و الهيمنة على المنطقة العربية تطبيقا لسياسة تبنتها أصطلح على تسميتها في الأدبيات السياسية و الصحفية بـ " سياسة ملء الفراغ " و يقصد بالفراغ الحالة التي حدثت في الشرق العربي على وجه التحديد بعد انسحاب بريطانيا عقب هزيمتها في معركة السويس عام 1956 ، و كأن دول تلك المنطقة لا يجوز أن تكون حرة بالكامل من أية سيطرة أو هيمنة استعمارية مباشرة أو غير مباشرة ، و قبل خروجي من البيت صباحا للذهاب إلى المدرسة كان أبي رحمة الله عليه ينفحني تعريفة ( خمسة مليمات ) كمصروف جيب ارتفع إلى قرش صاغ في الصف السادس تقريبا ، و كنت في الغالب أشتري بالتعريفة ثم القرش من البقالة المجاورة للمدرسة إداما ( غموسا ) للرغيف الذي يوزع علينا بالمدرسة ( حلاوة طحينية أو جبنة بيضاء ) فالجبنة النستو المثلثة لم يكن طعمها مستساغا لنا نحن أطفال الأرياف في ذلك الزمان كما ذكرت من قبل ، و أحيانا أشتري بالتعريفة حلاوة عسلية من بياعها بجوار المدرسة ، و كثيرا ما كان بعض الأطفال يأتون في خرائطهم ( الخريطة حقيبة مصنوعة من القماش يضع التلميذ فيها كتبه و كراساته و أدواته الكتابية و يحملها في كتفه ) بكسر من خبز البتاو بسطت عليها مسحة من جبنة قديمة أو جبنة قريش يأكلونها في الفسحة الكبيرة أما التلاميذ الذين تقع بيوتهم بالقرب من المدرسة فهؤلاء محظوظون لأنه يمكنهم الذهاب إلى بيوتهم حيث يأكلون ما أتيح لهم أن يأكلوا ثم يعودون قبل موعد انتهاء الفسحة .
على باب المدرسة كان يجلس دائما العم حسين و هو رجل أسمر نحيف ذو عين كريمة ( تعبير يطلقه الأهالي على من فقد إحدى عينيه لتجنب الإشارة إلى عاهته) يرتزق من إصلاح الأحذية ( إسكافي ، صرماتي ، و بلغة أهل سوهاج : نقاقلي ) و أدواته البسيطة عبارة عن جردل به كمية من المياه و سندان مغروس في الأرض و شاكوش و صندوق خشبي به كمية مسامير صغيرة و قطع جلدية مختلفة الأنواع و الألوان منها قطع من جلود الأبقارأو الجاموس المجففة و سكين حادة يقطع به الجلد و يسويه ، و معظم القرويين كانوا في ذلك الزمان يلبسون الأحذية لغرض أساسي هو حماية أقدامهم من الأذى ( حشرات و زواحف مؤذية كالعقارب و الثعابين أو قطع زجاج مكسور أو أشواك ) و ليس للوجاهة ، لذلك فعندما يحتاج حذاء قروي إلى رقعة فليس من المهم أن تكون من نفس لون الحذاء و إن كان يفضل ذلك ، و تسمى الرقعة إذا كانت في جانب الحذاء من الأمام " لوزة " و تتم خياطة الرقعة بإبرة طويلة تسمى ( المخراز ) و إذا كان الحذاء قد بلي من أسفل فلابد من تركيب نعل له أو نصف نعل بحسب الحاجة و غالبا ما يكون النعل من جلد الجاموس أو البقر لأنه سميك لا يبلى سريعا ، يغمر العم حسين قطعة الجلد الجافة التي تكون أحيانا بشعرها في ماء الجردل حتى تلين ثم يثبتها أسفل الحذاء بالمسامير و يقص الزيادات بمقص كبير و يهذب جوانب النعل بالسكين و في بعض الأحيان يتم تثبيت النعل بالخيط المشمع عن طريق المخراز و لكن لكل من المسامير و الخيط مزاياه و عيوبه ، كنا كأطفال في أثناء الفسحة الكبيرة بعد أن نأكل و يصيبنا الإرهاق من اللعب هنا و هناك حول المدرسة نتحلق أحيانا حول العم حسين ، يتسلى هو بالحديث معنا و هو يعمل في إصلاح الأحذية و المداسات القديمة و نتسلى نحن بالفرجة عليه قبل أن يدعونا جرس المدرسة للعودة إلى الفصول .
كان عدد طلاب فصلي 33 تلميذا تقريبا و ما زلت حتى الآن أتذكر أسماء كثيرين منهم و لكن مع الأسف لا يتواصل أحد منهم الآن معي سوى صديقي عبد الفتاح عبد العليم عبد المطلب ( طبيب تخرج في طب الأزهر هو الآن على المعاش و يقيم بمدينة أسوان ) ، مات أبوه حين كنا بالصف الثالث الابتدائي تقريبا ثم أمه بعد ذلك بسنوات قليلة و لم يكن له من أهل يلوذ بهم سوى جدته المسنة و أخيه حسن الطالب بدار المعلمين ، كان عبد الفتاح من أصدقائي المقربين و يسكن في حارة متفرعة من شارع النقطة ( نقطة البوليس ) و كثيرا ما كنا نذهب كل ليلة في الإجازات إلى الوحدة المجمعة لمشاهدة التليفزيون و كان يمثل لنا في تلك السن الصغيرة متعة بصرية لا حدود لها ثم نعود معا إلى البيت عند منتصف الليل أو قبله بقليل ، كما أنه عندما انتقل فصلنا و نحن في الصف الخامس من ملحق المدرسة إلى المدرسة الأساسية كان عبد الفتاح يشاركني الدرج الذي أجلس عليه و بالرغم من ظروفه الاجتماعية و الاقتصادية المضطربة فقد كان نشيطا و مجتهدا دراسيا و ساعده في اجتهاده تمتعه بذكاء فطري ، و عقب انتهاء سنة الصف الخامس أخذه أخوه و نزحا معا إلى مدينة السويس ليعيشا فيها و لكنهما عادا ثانية إلى القرية بعد حدوث نكسة 1967 .
بدءا من الصف الخامس كان زي التلميذ يتغير فبدلا من المريلة يكون زي التلميذ البنطلون و القميص و يشغل تلاميذ الصف الخامس أول فصل على يمين بوابة المدرسة و يقابله أول فصل على يسار المدخل و يشغله طلاب الصف السادس ، و تغيير زينا المدرسي إلى البنطلون و القميص معناه أننا لم نعد أطفالا ، و تزداد عناية إدارة المدرسة بالصفين الخامس و السادس فيخصص لهم أفضل المدرسين و أكثرهم خبرة فمجال التنافس بين مدارس القرية هو امتحانات القبول ( نهاية المرحلة الابتدائية ) و تلك يتم شحن التلاميذ و تحفيزهم على التفوق فيها بدءا من الصف الخامس ، و كل مدرسة تسعى أن يكون نصيبها من الطلاب المتفوقين في امتحانات القبول أكبر من زميلاتها و من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مواد الامتحانات و هي مواد أربع : اللغة العربية و الحساب و التربية الوطنية و العلوم .
على الرغم من حرصي على التفوق في مواد الدراسة إلا أن إدماني للقراءة الحرة ( خارج المنهج ) لم يتوقف بل تطور حين تعرفت و أنا في السنة السادسة الابتدائية إلى الأدب المترجم البسيط من خلال وقوع بعض الروايات العالمية في يدي و أتذكر منها ماجدولين لألفونس كار ( و لم تكن الترجمة للمنفلوطي ) و راسبوتين لوليم ليكيه و روايتين بوليسيتين إحداهما من سلسلة مغامرت شرلوك هولمز لآرثر كونان دويل و الثانية من سلسلة مغامرات أرسين لوبين لموريس لبلان ، و لأول مرة في حياتي اشتريت ذات يوم من بياع الجرائد قصة من قصص أرسين لوبين و دفعت فيها حينئذ قرشين صاغ تقريبا و كانا بالنسبة لي مبلغا ضخما كلفني مصروف جيب أربعة أيام تخليت فيها عن شراء إدام ( غموس ) لرغيفي و اضطررت لأكله بقطعة الجبنة النستو التي لم أكن أستسيغ طعمها كما سبق أن ذكرت ، كان كل يوم صباحا يأتي في أول أوتوبيس من مدينة أسيوط العم مختار بياع الجرائد ( الأهرام و الأخبار و الجمهورية و بعض المجلات الأسبوعية و الشهرية ) ، كان دائما يلبس جاكتا كاكي فاتح اللون على جلابية و يضح تحت إبطه المطبوعات وسط غلاف كبير من ورق الكرتون ، يمر على المدارس حيث ينتظره بعض المدرسين ممن اعتادوا قراءة الجرائد فيشتري كل منهم ما يفضله منها كما يمر على بعض البيوت في القرية و بعض زبائنه كانوا يشترون منه مجلات أطفال لأولادهم مثل مجلتي سمير و ميكي و مجلات ثقافية عامة مثل الهلال و العربي الكويتية و كانت مجلة ملونة فخمة تزخر بالصور الزاهية الجذابة ، و كان بعض المدرسين يستخدمون صورها في عمل مجلات حائط يزينون بها جدران فصول التلاميذ بالصفين الخامس و السادس على وجه الخصوص .
جاء موعد امتحانات القبول و جمعوا كل طلاب الصف السادس بالمدارس الأربع بالقرية ليمتحنوا في مكان واحد يسع جميع الطلاب في الوحدة المجمعة و كل طالب يجلس بحسب رقم جلوسه ‘ و قد تعرضت في أثناء امتحان إحد ى المواد الأربع لمشكلة فقد سقط قلم الحبر الذي كنت أكتب به و لم يكن معي سواه فأصيب بشرخ تسرب منه الحبر فملأ أصابع يدي اليمنى و لم أستطع التعامل معه في الكتابة خشية أن ينسكب الحبر على ورقة الإجابة فتوقفت متحيرا و تعطلت لمدة تزيد عن ربع الساعة أصابني خلاله توتر شديد حتى أسعفتني تلميذة لا أعرفها كان موقعها أمامي في لجنة الامتحانات ، تفضلت علي بناء على طلب أحد المراقبين فأعطتني قلمها الاحتياطي و قد أديت الامتحان في حالة لا أحسد عليها ، و عدت إلى البيت مع والدي الذي كان ينتظرني خارج اللجنة و قد علم بما حدث معي من أحد زملائي الذين خرجوا قبلي فاكتئب و ظل متوجسا من النتيجة في تلك المادة حتى ظهرت و كانت مشرفة فقد حصلت على الدرجة النهائية في مادتي الحساب و التربية الوطنية و قد حصل مدرسي في المادتين على مكافأة عن ذلك ، و كان ترتيبي الثالث على جميع طلاب القبول بمدارس القرية الاربعة ، و كما كان يأتي عقب نهاية كل سنة العم سيد فراش المدرسة ليسلم أبي شهادة السنة الخضراء جاء هذه المرة ليخبرأبوي بالنتيجة الباهرة و يحصل على حلاوته و كانت هذه المرة أكثر من أي مرة سابقة .
كنا و نحن طلاب في الصفين الخامس و السادس نتطلع إلى اليوم الذي نصبح فيه طلابا بالمدرسة الإعدادية فقد كنا نشاهد طلابها و هم يلعبون كرة القدم في ملعب المدرسة و يتنافسون في مهرجانات الألعاب الرياضية النهارية التي تقيمها المدرسة و في حفلات العروض الفنية المسائية التي يدعى إليها أولياء أمور التلاميذ و أهالي القرية بشكل عام ، و كان كثيرا ما تشد انتباهنا فلاشات الكاميرات التي يصور بها بعضهم أقاربهم المشاركين من التلاميذ في فقرات التمثيل و الغناء على خشبة المسرح ، كان بيتنا قريبا من حي الشهابية الذي نسكن فيها و كنت أحيانا أذهب و أنا طفل صغير مع بعض أترابي لننبش في كومة المهملات الملقاة على بعد من المدرسة فنجد فيها قطعا من الطباشير الملونة و بعض بقايا أقلام الرصاص و ألوان الشمع و الأخشاب و أشياء أخرى نستخدمها في ألعابنا بالحي ، كما كنا في الإجازات نذهب إلى ملعب المدرسة حيث نلعب كرة القدم و كانت كرتنا عبارة عن جورب قديم محشو بكمية من قطع الإسفنج الملفوفة جيدا بالخيوط ( تسمى كورة الشراب ) ، لم يكن يزعجنا و نحن نفعل ذلك إلا الخوف من التعرض لهجمات كلاب عائلة عسقلاني الشرسة فالمدرسة الإعدادية بجوار بيوتهم بل إن المبنى ملكهم و مؤجر للتربية و التعليم ، و أتذكر الآن كيف أن الشدة الأكثر من اللازم في تعامل الآباء مع الأبناء بحجة ضرورة تنشئتهم تنشئة خشنة تؤهلهم لتحمل ظروف الحياة القاسية قد تفضي إلى أمور لا تحمد عقباها ‘ فقد عقرني ذات يوم أحد كلاب عائلة عسقلاني و ظلت آثار أنيابه التي انغرست في باطن ساقي من الخلف تؤلمني عدة أيام و لكني لم أجرؤ على مصارحة أبي و لا حتى أمي بما حدث خشية التعرض لعقابهما على عدم تنفيذ تحذيراتهما بعدم الذهاب ناحية المدرسة الإعدادية ، و لو كان الكلب الذي هاجمني حينذاك مسعورا لما قدر لي أن أكتب هذه السطور و لما قدر لكم أن تقرؤوها الآن .
***
في القرية التي قضيت فيها فترة تعليمي الابتدائي و الإعدادي بأرياف أسيوط إبان عقد الستينيات من القرن الماضي و قبل الانتهاء من بناء السد العالي و إنجاز مشروع كهربة الريف كانت الإضاءة الصناعية في القرية عدة أنواع :
1 - أولها الإضاءة الكهربائية المحدودة و توجد في بعض الشوارع و الأماكن الحكومية كالوحدة المجمعة مثلا و بعض بيوت قليلة لسراة القرية و في مقدمتها سراية العمدة مثلا ، و مصدر هذا النوع من الإضاءة ماكينة توليد كهرباء تعمل بالديزل و تبدأ نشاطها في أعقاب غروب الشمس مباشرة و عند منتصف الليل تتوقف عن العمل و يتوقف كل ما يستفيد بكهربائها كجهاز التليفزيون العام مثلا ، فقد زودت الدولة بعد بدء البث التليفزيوني عام 1960 كل وحدة مجمعة بجهاز تليفزيون ( و الوحدة المجمعة عبارة عن مجمع خدمات قروية ( مجانية ) تتضمن مدرسة نموذجية و مستشفى و صيدلية و مكتبة عامة و نادي رياضي و سنترال و مركز لتحسين الإنتاج الحيواني و منحل و برج حمام ، و ملحق بالوحدة فيلا لإقامة الطبيب مدير المستشفى و فيلا للإخصائي الاجتماعي ، و قد بنت حكومة ثورة يوليو في الخمسينيات ما يقرب من 3000 وحدة مجمعة ) ، و قد وصل إلى القرية التي كان والدي - رحمة الله عليه - يعمل بها و نقيم معه فيها عام 1962 أو 1963 تقريبا جهاز تليفزيون ( أبيض و أسود طبعا ) فلم يظهر التليفزيون ذو الألوان إلا أوائل عقد السبعينيات ، خصصوا للجهاز الجديد إحدى الصالات المفتوحة الواسعة و زودوها بالأرائك الطويلة ( الدكك ) و الكراسي الخشبية ، في أول المساء كل يوم إبان إجازتي منتصف الدراسة ( الشتاء ) و نهاية الدراسة ( الصيف ) و في ليالي الخميس من كل أسبوع كنا نذهب إلى الوحدة المجمعة التي تقع على الجسر بمدخل القرية الرئيسي لنحتل أماكن قريبة من شاشة التليفزيون الصغيرة و نغدو في شبه غيبوبة حين نندمج مع بعض ما يذيعه هذا الصندوق السحري العجيب من مواد فنية كالأفلام العربية في الغالب و الأجنبية أحيانا أو المسلسلات الدرامية كمسلسل " هارب من الأيام " و مسلسل " بنت الحتة " الذي كان توفيق الدقن يهتف فيه من حين إلى آخر بعبارات صارت علامة عليه و انتشرت على ألسنة الناس مثل : " آلوه يا همبكة " و " آلوه يا أمم " ، و نفيق من غيبوبة الاندماج حين تتوقف ماكينة توليد الكهرباء في منتصف الليل فينطفئ التليفزيون ، و من عجائب الذاكرة أنه كلما أذيع على قناة " روتانا كلاسيك " أو أي قناة من مثيلاتها اللاتي أدمن مشاهدتها فيلم " أخطر رجل في العالم " بطولة فؤاد المهندس أتذكر عند مشهد معين منه لحظة انطفاء تليفزيون القرية و نحن مندمجون في مشاهدته منذ أكثر من 50 عاما ، حينها خرجت مع أترابي من الأطفال عائدين إلى بيوتنا على أطراف القرية في غاية " الضيق و العكننة "، أحيانا كنت أندمج لأسباب شتى في مادة تليفزيونية معينة فيتسرب أترابي الذين لم تعجبهم المادة الفنية و عندما أفيق من غيبوبة الاندماج لحظة انطفاء النور أكتشف أني وحدي الذي بقيت من الأطفال و أن علي بمفردي الخوض في لجج الظلام الدامس طوال الطريق من الوحدة المجمعة حتى بيتنا الذي كان يقع على أطراف القرية و لكن من جانب آخر و أظل وسط حلكة الليل خائفا أترقب فهنا قتل فلان و له صاروخ ( عفريت ) يخرج بالليل و هنا قتل علان ؛ و هناك بيت عائلة فلان الذين يخطفون الأطفال و يذبحونهم من أجل استخراج الكنز ، و أتخبط في الشوارع و الأزقة الضيقة محاولا بقدر الإمكان ألا تدوس قدمي على رجل كلب أو ذنبه أو بطنه أو رقبته فيهب نابحا في وجهي و ربما يعضني أو ينشب أظفاره في جلدي حتى أصل إلى البيت بسلامة الله و تفتح لي أمي - رحمة الله عليها - الباب و تدخلني بهدوء إذا كان أبي نائما حتى تقيني سورة غضبه إذا صحا و فطن لتأخري إلى هذا الوقت من الليل خارج البيت ، و مع قدوم اليوم التالي أنسى معاناتي في الليلة السابقة و أذهب مرة أخرى مع أترابي لنشاهد التليفزيون مع وعد أقطعه لأمي ألا أتأخر في العودة ، و لكن هيهات .
2 - النوع الثاني من الإضاءة هو الكلوبات ( جمع كلوب ) و الكلوبات العامة توجد في بعض الشوارع الرئيسية معلقة على أعمدة أسطوانية من الخشب يطلق على الواحدة منها اسم ( قزقة ) و تجمع على ( قزق ) و القاف تنطق في الصعيد كما ينطق القاهريون و البحاروة عموما حرف الجيم ، و يرفع الكلوب إلى أعلى القزقة بسلك معدني غليظ ( واير ) ، قبل غروب الشمس بقليل كان يأتي المشاعلي التابع لمجلس القرية ( البلدية ) و الموكل بتشغيل تلك الكلوبات ليضغ " منافلة " صغيرة في البكرة المثبتة في منتصف القزقة تقريبا و ينزل الكلوب إلى ما قبل سطح الأرض بمترين أو متر و نصف تقريبا ثم يجلس المشاعلي على ركبتيه و يفتح الغطاء الزجاجي أسفل الكلوب المحمي بشبكة من السلك لينظف الزجاج و يزود خزان الكلوب بالكيروسين ثم يوجه نارا شديدة تخرج من فوهة وابور جاز يدوي يسميه ( وابور الجنب ) إلى المواسير الرفيعة أعلى " الرتينة " التي يمر فيها الجاز حتى تحمر من شدة السخونة ، عندئذ تنتفخ ( الرتينة ) و هي في الأصل كيس حريري صغير يثبت أول مرة في نهاية الفوهة التي تنتهي بها تلك المواسير و كلما انتفخت الرتينة توهجت و ابيضت و أضاءت و عندما تصل إلى أقصى غاية من التوهج و الإضاءة يغلق المشاعلي غطاء الكلوب و يرفعه إلى أعلى القزقة مرة أخرى بالمنافلة ثم يغادر المكان ليعود إليه في نفس الموعد من اليوم التالي ، و لا أكتمكم سرا أني حتى الآن لا أعرف كيف للرتينة الواهنة وهن بيت العنكبوت أن تنتفخ و تتوهج و تضيء ؟ و هي التي إن لمستها بإصبعك مجرد لمس تتساقط على الأرض رمادا أبيض و حينها يلزم تركيب رتينة جديدة للكلوب ، و يستخدم أهل القرية كلوبات خاصة في المناسبات بسرادقات الأفراح و المآتم و الموالد كما يستخدمها بعض ذوي اليسار منهم في بيوتهم و في المناضر و الدواوير بصفة خاصة .
3 - النوع الثالث عبارة عن صناديق زجاجية مثبتة عاليا في الحوائط ببعض الحارات و الأزقة و بداخل كل صندوق مصباح ( لمبة نمرة 10 ) و نمرة 10 تمييزا لها عن اللمبة الصغرى منها و تسمى ( لمبة نمرة 5 ) ، يأتي المشاعلي الموكل بهذه المصابيح كل يوم قبيل الغروب و في كتفه سلم خشبي صغير يسند طرفه الأعلى إلى الحائط أسفل الصندوق الزجاجي قليلا ثم يصعد عليه ثم يفتح باب الصندوق ليستخرج اللمبة فينظف زجاجتها ( البنورة ) بخرقة قماش مبللة بقليل من الماء أو يتفل في الزجاجة إن لم تكن الخرقة مبللة ، ثم يخرج من جيبه مقصا صغيرا فيسوي به طرف العويل ( الفتيل ) حتى لا تكون الشعلة مرتفعة من ناحية و منخفصة من الناحية الأخرى و بعد أن ينتهي من ذلك يركب البنورة في مكانها من رأس اللمبة يضبط ارتفاع الشعلة من مفتاح الضبط الصغير المستدير بحيث يكون ارتفاع الشعلة متوسطا ثم يضع اللمبة داخل الصندوق و يغلق عليها الباب و ينزل فيحمل السلم مرة أخرى في كتفه ليذهب إلى مكان آخر ليضيئه .
في بيوت الأسر الفقيرة مثل أسرتي و أغلب أهل القرية في نفس المستوى كانت الإضاءة تعتمد على اللمبة أو اللنضة نمرة 5 ، و في مواسم الامتحانات كانوا يضعون لي على الطبلية التي أذاكر عليها و هي غير طبلية الأكل ( لمبة ) نمرة 10كنوع من الاهتمام و التشجيع على الاجتهاد في المذاكرة ، و على تلك الإضاءة البائسة حصلت على الشهادة الابتدائية ( شهادة القبول كما كانوا يسمونها ) عام 1966 بتفوق ، و في غرفة النوم و أعلى اللمبة نمرة 5 كانت أمي - رحمة الله - عليها تعلق الدماسة الألومنيوم و بها حفنة من الفول و كمية مناسبة من الماء ، تعلقها من يدها ( يد الدماسة ) في مسمار و قد ألبست فوهة القمع المثبت أسفلها بالفوهة العليا للبنورة ، و على صهد لهيب شعلة اللمبة المتصاعد طوال الليل و المركز من خلال فوهة القمع على قعر الدماسة ينضج الفول كأحسن ما يكون النضج فنفطر به في الصباح الباكر مع الزيت و الليمون أو السمن البلدي قبل انطلاقي إلى المدرسة و مغادرة أبي إلى محل عمله بنقطة الشرطة.
4 - في " بيت الخلاء " أو " بيت الراحة " أو " محل الأدب " أو " الكنيف " و كلها أسماء لمكان واحد ، أو في فجوة من الحائط ( طاقة مسدودة ) عند بعض زوايا البيت و بالاخص الزاوية التي يوجد بها " الزير " حيث مياه الشرب أو المناطق غير المأنوسة في البيت كانت توجد أردأ أنواع الإضاءات و هي التي تصدر من لمبة بدون زجاجة ( بنورة ) و تسمى ( لمبة بعويل ) أو اللمبة أم عويل أو اللمبة الصاروخ و قد سمعت و أنا صغير أنها كانت تسمى في بيوت الفقراء بمدينة الإسكندرية ( الشيخ علي ) و لا أدري حتى الآن هل ما سمعته عن تلك التسمية صحيح أم لا ؟ و إذا كان صحيحا فما تفسير التسمية بالشيخ علي ؟ و بهذا الخصوص تحكى في القرية حكاية طريفة ملخصها أن أحد بلدياتنا كان في زيارة لأقارب له بأحد أحياء الإسكندرية الشعبية و كانوا يعيشون في بيت قديم بدائي و أراد دخول بيت الخلاء و هو في الطابق الأسفل من البيت فقالوا له بيت الخلاء تحت انزل و هتلاقي عندك هناك الشيخ علي و ظل بلدياتنا أمام بيت الخلاء ساعة ينتظر خروج الشيخ علي حتى يدخل و امتلأ بالحرج و الخجل حين عرف ما المقصود بالشيخ علي ، نسيت أن أعرفكم أن اللمبة أم عويل عبارة عن علبة مقفلة من الصفيح في حجم علبة المياه الغازية لكن السمكري جعل لها فتحتين إحداهما لتملأ من خلالها بالوقود و الأخرى تتوسط أعلى العلبة و يخرج منها طرف شريط من الخيط المفتول يرقد معظمه داخل العلبة مغموسا في الكيروسين ( يسمى العويل أو الفتيل ) ، و الإضاءة التي تصدر من لمبة العويل ضعيفة جدا لا تكفي إلا لرؤية ما حولك ( طشاشا ) أي أدنى حد من الرؤية ، و يخرج مصاحبا لشعلة الإضاءة في تلك اللمبة البدائية كم كبير من الهباب و السخام الأسود يتجمع و يتراكم أعلى المكان الذي توجد به اللمبة ، و عملية إزالة هذا الهباب أو ذلك السخام و التخلص منه أمر في غاية الصعوبة و يمثل خطرا على من يعاني من مشاكل في التنفس .
5 - و أخيرا من وسائل الإضاءة لمبة صغيرة في حجم قبضة اليد لها زجاجة مناسبة ( بنورة ) لحجمها تسمى تلك اللمبة ( السهارة ) و تسمى بهذا الاسم لأنها حين تطفأ جميع الأنوار تظل هي وحدها المضاءة ليتحرك على ضوئها الضئيل الخافت أهل البيت حركتهم الاضطرارية ليلا دون أن يتعثروا في شيء من الأثاث أو المفروشات أو يصطدموا بحائط أو باب و ما إلى ذلك .
***
- 2 - رمضان في القرى..
بدأت أصوم و أنا في سن التاسعة من عمري و كنت حينها في الصف الثالث الابتدائي و لم أفطر سوى يوم واحد كانت المدارس فيه تحتفل بأحد الأعياد القومية و في مثل هذه الأعياد لا سيما عيد النصر و موعده 23 ديسمبر يخرج تلاميذ المدارس و يصطفون مدرسة مدرسة في طوابير و في مقدمة كل مدرسة التلاميذ حملة الأعلام المختلفة و فرق الموسيقات المدرسية و نخترق شوارع القرية الرئيسية من شارع إلى شارع و نحن ننشد مع الموسيقى الأناشيد الوطنية مثل نشيد : " الله أكبر " و أغنية " ناصر كلنا بنحبك .. ناصر وحنفضل جنبك .. ناصر يا حبيب الكل يا ناصر " يحف بنا المدرسون لضمان انتظام السير في الطوابير ، و لأنني كنت من التلاميذ طوال القامة فقد اختاروني ضمن ما كان يسمى بالشرطة المدرسية و أعطوني شريطا أحمر طرز عليه بخيوط من الحرير الأصفر عبارة ( الشرطة المدرسية ) و كان ذلك مثار زهو لي بين زملائي وعندما حللت هذه المشاعر فيما بعد اكتشفت أن الإنسان منذ نعومة أظفاره نزاع إلى أن يكون متميزا أو بتعبير أدق صاحب سلطة على من سواه لا سيما إذا كان من سواه في نفس سنه ، و بسبب المجهود الذي بذلته أو تخيلت أني بذلته في مشاركة مدرسينا في الحفاظ على نظام سير طوابير زملائي من التلاميذ بوصفي من الشرطة المدرسية فقد عطشت عطشا شديدا و لم أستطع الصيام إلى أخر اليوم .
كانت أمي - رحمة الله - عليها في غاية الفرح بصيامي لأن أبي بسبب طبيعة عمله كثيرا ما كان يفطر خارج البيت ، و تعودي الصيام معناه أنها وجدت من يشاركها هذه الفريضة الجليلة و طقوسها المختلفة لا سيما طقس الإفطار الذي يبدأ بتجهيز الطعام و انتطار سماع شيخ الجامع حين يؤذن لصلاة المغرب من فوق المئذنة فلم تكن قد انتشرت في ذلك الزمان مكبرات الصوت المزعجة لا سيما بالقرى ، كان أطفال الحي يتجمعون و أنا واحد منهم قبل أذان المغرب بجوار جامع الحي نلعب و نتهارش كالكلاب الصغيرة و نتبادل حكاياتنا الطفولية ، و حين يصعد الشيخ فوق المئذنة و يؤذن للمغرب يجري كل منا إلى منزله ليؤكد لأهله أن الشيخ قد أذن لصلاة المغرب ، و كنت عندما أدخل البيت أصعد السلم قفزا و أنا أهتف بهذه الجملة : " افطر يا صايم ع الكعك العايم " و هذه الجملة لا تخص تراث أسيوط و قراها بل تخص أرياف سوهاج جنوبا و قد لقنتها من أمي فوالداي من إحدى القرى التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، و أحيانا أفطر مع أمي على أذان الراديو و بعد الإفطار ننصت إلى الحلقة الجديدة من (ألف ليلة و ليلة) التي كان يكتبها للإذاعة الشاعر طاهر أبو فاشا و يخرجها المخرج الإذاعي الشهير محمد محمود شعبان ، و كانت أمي تنضج الطعام بأكثر من وسيلة فإذا كان هناك لحم أو طيور فالأصلح له كوعاء للطبخ (البرام) و البرام إناء أشبه بالحلة يصنع من الهمر و هو طينة مخصوصة ذات لون وردي ، و كان برام أمي ذا عروتين ( يدين ) و يوضع البرام على الكانون الذي يوقد بالحطب ( عيدان نبات القطن ) أو البوص ( عيدان نبات الذرة ) أما إن كان الطعام دون ذلك كالبيض حين يقلي او يسلق او الفول المدمس أو البصارة أو المسقعة و ما إلى ذلك فكانت تنضجه أمي على نار وابور الجاز البريموس ( كان اشهر أنواعه الأوبتيموس و البريموس) و تضعه في ركن الغرفة التي ننام فيها فيدفئ جوها في ليالي الشتاء و الوابور كان يصنع من النحاس و له ثلاثة أرجل أطرافها من أعلى تعمل كحوامل لما يوضع فوقه من الآنية و للوابور فتحة بمحبس يزود من خلالها بالكيروسين و كباس في الجنب لكبس الجاز كي يندفع من ثقب (الفونية) و يحدث الاشتعال ، كما كان هناك مفتاح صغير لجعل الشعلة أهدأ حين لا تكون هناك حاجة إلى نار شديدة و إذا سدت رواسب الجاز ثقب الفونية يسلك بإبرة تسمى إبرة الوابور و نشتريها من دكان البقال بخمسة فضة أو تعريفة ( خمسة مليمات ) ست إبر في كيس صغير من الورق ، و بمناسبة البرام كانت هناك (الدوكة) التي تحمر أمي اللحم و الطيور فيها بعد استخراجها ناضجة من البرام و تسمى الدوكة أحيانا ب(الزبدية) ، و في أرياف أسيوط تسمى (المرجسية) - و في ظني أن هناك فروقا بين تلك الأواني - ولكن الأسماء تداخلت لأن الفروق طفيفة أو أن تعدد الأسماء لمسمى واحد كان بسبب اختلاف البيئات مثل مشكلة المترادفات في اللغة العربية الفصيحة ، و بخلاف الزبدية أو المرجسية كانت هناك (الزروية) التي تشبه في شكلها الخارجي قدرة الفول لكن أضيق في خصرها و يخزن فيها السمن البلدي ( و بالمناسبة كنت و أنا صغير اغافل أمي لا سيما حين تكون مشغولة و أدخل إلى حيث الزروية فأرفع الغطاء عن فوهتها و أدس يدي الصغيرة داخلها و أغرف مما بها من سمن متجمد مقدار قبضة يدي أملأ فمي بها ، و غالبا ما كانت أمي تكتشف فعلتي بسبب ما كان يعلق بوجهي و جلابيتي من آثار فتعنفني ) ، هناك أيضا (المنطال) و هو وعاء من الهمر أيضا كباقي الأواني التي ذركرتها ، و أهم ما كان ينضج في المنطال من الأطعمة الفول و العدس الأسود أو (العدس أبو جبة) الذي كانت أمي تملأ منه الطبق ثم تدس فيه ملعقة السمن البلدي الكبيرة إلا أنني لم أكن أحبه و أتضايق بل يملأ نفسي النكد عندما أعرف أننا سنأكل اليوم عدسا بجبة على عكس (العدس الأصفر) الذي كنت و مازلت من عشاقه ، و في القاهرة حين كنت أعيش لوحدي قبل مجيء الأسرة كنت أذهب خصيصا إلى مطعم آخر ساعة أو مطعم القزاز في وسط البلد لأستمتع بوجبة عدس أصفر مع شرائح البصل المنقوعة في الخل خاصة في ليالي الشتاء ، المنطال لا يوصع لإنضاج ما فيه على الكانون في الغالب و لا على وابور الجاز مطلقا و إنما كان يدفن في جمهرة نار الفرن من الخلف بعد الانتهاء من خبز العيش الشمسي أو البتاو .
كان الراديو في تلك الأيام تسلية أمي الوحيدة لا سيما أننا لسنا من أهل القرية و بالتالي ليس لنا وسط عائلي من الأقارب نتواصل معهم اللهم نساء جيراننا اللائي كان يحلو لهن الجلوس في بعض الليالي على عتبة بيتنا و تبادل الأحاديث حول موضوعات شتى مع أمي التي لم تكن تخرج البتة من البيت ، و إلى أين تخرج و ليس لنا أقارب نزورهم أو يزوروننا ؟ ، أتذكر أنها لم تخرج من البيت حتى عندما انتقلنا للحياة في أسيوط كي ألتحق بالمدرسة الثانوية إلا ثلاث مرات فقط إحداهما للطبيب في وعكة ألمت بها و الثانية حين توفي خالي فسافر بها أبي إلى البلد لحضور الجنازة و الثالثة حين انتهيت من دراستي الجامعية فقرر العودة إلى البلد تاركا إياي في أسيوط معللا ذلك بأن مهمته تجاهي قد انتهت و علي منذ الآن الاعتماد على نفسي ، و بالرغم من أن أمي لم تكن تعرف القراءة و الكتابة إلا أنها من طول ملازمة الراديو الذي اقتناه والدي منذ أواخر الأربعينيات أي قبل ولادتي بسنوات ، و كان الراديو بداية وعيي له في سنوات ما قبل المدرسة قبل اختراع البطاريات الجافة و قبل ظهور الراديو الترانزستور يعمل ببطارية كبيرة في حجم أقل قليلا من حجم بطارية السيارة الآن ، و كان للراديو سلك أو إريال علوي ( هوائي ) و آخر سفلي يوضع طرفه في مكان رطب ( أرضي ) لست أدري لماذا ؟ ، تكونت لدى أمي ثقافة سمعية فقد كانت تواظب على سماع معظم مواد إذاعة البرنامج العام لا سيما في عدم وجود والدي الذي كان مغرما بسماع النشرات الأخبارية و بصفة خاصة من إذاعة صوت العرب ، و من أهم مواد الإذاعة في رمضان بخلاف (ألف ليلة و ليلة) برنامج " المسحراتي " الذي أصبح بأشعار فؤاد حداد و صوت الشيخ سيد مكاوي من العلامات المميزة للشهر الكريم ( الرجل تدب مطرح ما تحب و انا مسحراتي في البلد جوال ) و برنامج " أحسن القصص " الذي كان يبدأ بصوت إذاعي مميز يقرأ قوله تعالى : ( نحن نقص عليك .. ) إلى آخر الآية ، و كان في البرنامج ما يشيع الرعب في قلبي كطفل أحيانا مثل صوت عصف الرياح في الصحراء و صوت عواء الذئب و صوت المرأة العجوز التي كانت تصرخ بصوت مبحوح مرتعش في قصة نبي الله يوسف و إخوته بني إسرائيل : اقتلوا يوسف .. اقتلوا يوسف ، و أمي التي لم تكن تقرأ أو تكتب هي التي عشقت من خلالها سماع البرامج الغنائية مثل : قسم و أرزاق ( يا ترى انت فين يا مرزوق ؟ ، هو دا البحر المالح اللي ما لوش قرار .. يا لطيف اللطف يا رب ، أخلع عليك تاج الجزيرة ) و عوف الأصيل ( سيد طبوش العكر من الأعيان حارة أولاد جيعان ، و أغنية يا حلو ناديلي لكارم محمود و الإكسسوارات الصوتية المصاحبة للأغنية من مثل : هو سي عوف عنده حاجة وحشة ) و عذراء الربيع و علي بابا ( افتح ياسمسم افتح يا فول افتح يا عدس ، و يرحمكم الله يا بوسريع ، و غني يا مرجانة ) و خوفو ( أنا خوفو باني الهرم الأكبر ) و عواد باع أرضه ( يا أرضنا ياجنة مفروشة ورد و حنة .. عواد بقى مش منا .. عواد ماعاد عواد ، و شم الطين يا عواد ، فيه ريحة عرقك و عرق أبوك و أجدادك ) و الدندرمة ( مصنوعة بذوق و ايدين توفيق الدندرمة ، الصبح قامت فيه خناقة بين سي توفيق العياقة و صبي قهوة عيسى موسى ، طول عمرة سايق ف الحداقة محمود صبي قهوة عيسى موسى ، و الغالي يرخص عشان زكية ) و الراعي الأسمر و معروف الإسكافي الذي غنى فيه عبد الحليم حافظ قبل أن يشتهر ، و أمي هي التي عرفتني أن نجاة الصغيرة تلقب بالصغيرة للتمييز بينها و بين مطربة سابقة عليها اسمها نجاة علي .
في الرمضانات الشتوية بالقرية كانت أمي تستعين لتدفئة الغرفة ب(ماجور) كسرت إحدى حوافه فلم يعد صالحا لأن تعجن فيه الدقيق الذي ستصنع منه الخبز (العيش الشمسي) و يكون من دقيق القمح أو (البتاو) و يكون من دقيق الذرة الرفيعة و يوضع مع دقيق الذرة حين يعجن لصنع البتاو بعضا من الحلبة المطحونة التي تعطي لخبز البتاو طعما مميزا و يسمون الحلبة في أرياف أسيوط " الحياقة " بشدة و فتحة على الياء ، في الماجور المكسور بعد صلاة العشاء تضع أمي كمية مناسبة من الحطب أو قوالح الذرة الشامية و تشعلها خارج الغرفةحتى تصفو نارها و يتوقف دخانها حينئذ تدخل الماجور الغرفة و تضعه في المسافة بين الكنبة التي يجلس و بنام عليها أبي و السرير الخشبي العريض الذي أنام عليه معها ، و مما كانت أمي تحرص على سماعه في الراديو خلاف مسلسل الساعة الخامسة و الربع مساء قرآن الصباح الذي كان يذاع بأصوات أجمل أصوات في العالم ، أصوات قرائنا العظام مثل الشيوخ : محمد رفعت و محمد صديق المنشاوي و الحصري و البنا و عبد الباسط عبد الصمد و طه الفشني والبهتيمي و الشعشاعي و شعيشع و عبد العظيم زاهر و لا أدري السر في أن صوت الشيخ عبد العظيم زاهر على وجه التحديد ظل عالقا بوجداني أكثر من غيره فعندما أسمع صوته أشعر كأنه مبلل بندى الصباح و أستحضر عند سماعه كل طقوس فترة الصباح حين كانت أمي تجهزني للانطلاق إلى المدرسة في تلك السنوات الجميلة البعيدة ؟ ، كذلك كانت تتابع أمي في رمضان و غير رمضان قرآن الساعة الثامنة مساء و حديث الصباح بعد القرآن و ما زال أتذكر صوت الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت و صوت الشيخ محمد فتح الله بدران و صوت الدكتور زكي المهندس رحمة الله عليهم جميعا .
من ذكرياتي الرمضانية في القرية أنني كنت أنخرط مع أطفال الحي في طقس رمضاني جميل نؤديه كل ليلة تقريبا بعد صلاة العشاء فقد كنا نتجمع : كل طفل بفانوسه ( لم تكن الفوانيس تضاء آنذاك بحجر بطارية كما هي الآن بل كانت بالشمع فكل فانوس بداخله شمعة يشعلها الطفل بعود الكبريت أو يشعلها له من هو أكبر منه إذا كان صغيرا ) و ننطلق في شوارع الحي و بعض حاراته و نحن نغني وحوي يا وحوي و نتوقف عند أبواب بعض البيوت و نحن نقول : ادونا العادة .. لبة و قلادة .. الفانوس طقطق والعيال ناموا ، و العادة هي ما يمنحنا أهل البيت الذي وقفنا قدام بابه من بلح أو فول سوداني أو طوفي أو مكعبات سكر و تسمى تلك القوالب ( سكر مكنة ) تمييزا له عن السكر الذي كان يباع في شكل أقماع كبيرة تكسر بالشاكوش إلى قطع بحسب الحاجة من أجل استخدامها في تحلية الشاي أو أي مشروب آخر ) ، و عندما تنتهي جولتنا نجلس تحت أحد الكلوبات و نفرش على قطعة قماش العطايا أو الغنائم التي غنمناها في جولتنا لنوزعها بالعدل على بعضنا البعض.
حين ذكرت أقماع السكر تذكرت أن القمع كان يباع في الدكان ملفوفا بورق و الورق يكون محزوما بخيط نطلق عليه اسم ( فتلة ) و هي أغلظ من خيط الحياكة و أنحف من الدوبارة ، و هذه الفتلة كنا نشمعها أي ندلكها بالشمع و نستخدمها في تدوير النحل ، فكل طفل تقريبا في القرية لديه في بيته نحلة أو أكثر و النحلة قطعة خشبية في شكل البصلة تنتهي من أسفل بسن معدني ، نضع طرف الفتلة الأول على السن و نلفه على جسم النحلة دوائر دوائر و طرف الخيط الثاني في قبضة يدنا ثم نطلق النحلة لتنزل على الأرض المستوية و يجب أن تكون الأرض مستوية حتى تدور النحلة مدة أطول و بشكل منتظم ، و أعتقد أن قطعة الخشب بصلية الشكل سميت النحلة لأنها تلف و تدور كما تفعل النحلة الطبيعية ، و أتذكر أننا كنا نشتري الدوم و نكسر الدومة و نخرج من داخلها نواتها التي في حجم بيضة الحمامة أو أكبر قليلا نقشر ما عليها من غشاء بني بقطعة زجاج مكسورة و ننحتها حتى تأخذ شكل نحلة صغيرة ذات لون أبيض و ملمس خارجي ناعم أشبه بملمس العاج و لكنها لم تكن تسمى بالنحلة بل تسمى ( البظو ) و لا أدري أصل هذه المفردة و إن كان لها أشباه كمفردة ( البغو ) مثلا و تطلق مفردة البغو على أي شيء غض طري كعود النبات في مقتبل نموه مثلا فيقال عليه ( بغو ) و تطلق مجازا على الشخص صغير السن قليل الجلد و التحمل أي الذي لم يصلب عوده بعد .
****
- 3 - التعليم في القرى
كان بجوار نقطة الشرطة التي كان يعمل بها والدي رحمة الله عليه بيت الشيخ محمود حفني ناظر المدرسة الابتدائية القديمة بالقرية ( كان بالقرية أربع مدارس ابتدائية ، اثنتان للبنين و منها مدرستي واحدة للبنات و أحدثها مشتركة و كانت جزءا من الوحدة المجمعة ) و قد تعرف والدي على الشيخ محمود و توثقت العلاقة بينهما في فترة قصيرة و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال : " الأرواح جنوذ مجندة ماتعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف " و رآني حضرة الناظر ذات يوم ألعب في الشارع قريبا و كان يجلس مع أبي قدام باب النقطة فسأله : متى يبلغ ابنك سن دخول المدرسة ؟ فأجابه والدي : سعد عنده خمس سنين ؛ يعني السنة اللي جاية إن شاء الله هيكون عندك يا حضرة الناظر ، فقال له حضرة الناظر : و ليه السنة اللي جاية ؟ ، السنة الدراسية الجديدة هتبتدي الشهر القادم و سأقبل ابنك مستمعا في المدرسة حتى إذا جاء موعد دخوله المدرسة رسميا يدخلها و هو على الأقل قد عرف مبادئ القراءة و الكتابة فيكون في الفصل متفوقا على زملائه ، اهتمت أمي بالأمر و فرحت فرحا شديدا فأرسلت القماش الذي اشتراه أبي من تيل نادية ( لونه بيج و كان يلبسه تلاميذ المدارس الابتدائية بنين و بنات في ذلك الزمان ) إلى حميدة الضحاكة ( هكذا كان أهل القرية يسمونها ربما لأنها كانت كثيرة الضحك ) ففصلت لي مريلة بجيبين أماميين و حزام ، و ذهب بي أبي إلى الجزماتي فأخذ مقاس رجلي على كرتونة و ترددت عليه مرتين للتجربة حتى انتهى من صنعها فلبستها على المريلة الجديدة و دخلت المدرسة مستمعا أي من غير أن يكون اسمي مقيدا بدفاترها رسميا .
لم تكن لي في تلك السنة أية مزايا مما يصيبها زملائي بالفصل فلا كتب و لا تغذية و لا أي شيء ، و كان أشد ما يحز في نفسي أن كل تلميذ من زملائي يحصل يوميا على رغيف من خبز الطوابين و يسمونه في القرية " العيش المصري " أما أنا فلا ، و كان هذا النوع من الخبز يمثل لنا - نحن أطفال القرية - فاكهة لأنه مختلف عن رغيف " الخبز الشمسي " و عن " البتاو " سواء كان بتاو قمح أو بتاو ذرة ، و أتذكر أنه عندما يكون أبي ذاهبا إلى أسيوط المدينة كان طلبي الوحيد منه أن يجيئني معه من أسيوط بقرطاس طعمية و رغيفين مصريين ، و عندما أسأل عن السبب في عدم حصولي على رغيف كزملائي تكون الإجابة : لأنك غير مقيد ؟ و لأني صغير ساذج كنت لا أعرف المعنى المجازي للقيد فأقول لهم و أنا أمد يدي الصغيرتين ، قيدوني منذ الآن و أعطوني رغيفا مثل زملائي فيضحك أبي أو تضحك أمي أو يضحك كل من يحدث أمامه هذا الحوار .
عوضني أبي عن الرغيف بتعريفة ( خمسة مليمات ) كان ينفحنيها كل صباح و أنا منطلق إلى المدرسة بعد أن تلبسني أمي المريلة ذات الجيبين الأمامين و الحزام و تضع في يدي قلم رصاص موصية ألا أضيعه كما أضعت قلم اليوم السابق و لكن التوصية غالبا ما كانت تذهب أدراج الرياح فلكي ألعب مع زملائي في حوش المدرسة خلال الفسحة أضع القلم في أحد الجيبين فيتأرجح تبعا لحركتي في اللعب و عندما أفيق من اندماجي في اللعب يكون القلم قد سقط و التقطه من لا يعيده ، وهكذا كان الأمر كل يوم تقريبا حتى ابتكرت أمي وسيلة ليس لمنع تكرار ضياع القلم فهذا ما لا سبيل إلى تحقيقه و لكن على الأقل للتقليل من حدوثه فربطته في مريلتي بفتلة غليظة ( دوبارة ) ، كتاب المطالعة الذي حصلت عليه في النصف الثاني من السنة هدية من حضرة الناظر لوالدي خاف والدي أن يتفسخ فخاط ورقة سميكة بكعبه مما شوه من شكله و جعلني أخجل منه أمام زملائي لا سيما أن الورقة السميكة كانت من النوع الذي يلف فيه الجزارون مبيعاتهم من اللحمة و لذلك كانوا و حتى الآن يسمون هذا النوع من الورق " ورق اللحمة " .
أتذكر أن سنة الاستماع تلك كانت على الأرجح آخر سنة يتم التعامل فيها مع نظام الألواح في المدارس فقد كان لكل تلميذ لوح لا أتذكر مادة صنعه و لكن أتذكر أنه كان أسود و محاط بإطار من الخشب و يكتب التلميذ على لوحه بنوع من الطباشير يسمى " طباشير الأردواز " و عند نهاية اليوم الدراسي يضعه في فتحة الدرج و يتركه إلى اليوم التالي ، كان معظم مدرسينا في ذلك الوقت مطربشين و نخاطب المدرس منهم و نناديه بيا (أفندي ) و لم نكن حينها نعرف مفردة ( أستاذ ) المدنية .
انتهت سنة الاستماع و دخلت المدرسة رسميا مقيدا في الدفاتر لا مقيد اليدين كما كنت أظن و كان ذلك مطلع العام الدراسي 1960/ 1961 و مدرس فصلنا أو بتعبير أدق أفندينا الذي يتولى تدريسنا كل المواد ما عدا الموسيقى و الألعاب و الرسم كان اسمه عبد المحسن حسن - رحمة الله عليه - و لم يكن طويلا كما لم يكن قصيرا بل كان رجلا ربعة و يستعين في تصحيح ما كتبناه في كراساتنا بنظارة طبية و بجوار كراسة التحضير كانت دائما هناك دائما قطعة من سير جلدي يستخدمها في عقابنا على التقصير في الواجبات أو الشقاوة في الفصل ، كما أتذكر أن الكراسة المدرسية في ذلك الزمان كانت صفحاتها مسطرة سطورا واسعة ، و مع ذلك كان من الصعب علي في بداية عهدي بالكتابة الحفاظ على استقامة خطي في شكل أفقي ، لذا كنت عندما أقف بجوار منضدة عبد المحسن أفندي كثيرا ما أنال على الجزء العاري من رجلي تحت المريلة لسوعتين من جلدته ، و على الصفحة الخلفية للكراسة كنت تجد مجموعة من العبارات الجميلة ما زلت أحفظ بعضها حتى الآن من مثل :
1 - كلنا سيد في ظل الجمهورية .
2 - حريتك أثمن من حياتك .
3 - لا تكن ثرثارا بين الناس .
4 - احترم مدرستك فإن لها حرمة المعبد .
5 - اغسل يديك قبل الأكل و بعده .
6 - العمل حق ؛ العمل واجب ؛ العمل حياة .
في أحد أيام إجازة السنة الثانية الابتدائية جاءني صاحبي و ابن زميل أبي في العمل كان اسمه الذي نناديه به رمضان جاد و لكن اسمه الرسمي في المدرسة سالم ، جاء عندنا في البيت و أخبرني أنهم افتتحوا في الوحدة المجمعة ناديا باسم ( النادي الريفي ) و يمكننا الاشتراك في النادي لنلعب الكرة و غيرها من ألعاب و الاشتراك بقرش صاغ فقط في الشهر ، و أعطاني أبي قرشا فذهبت مع رمضان أو سالم إلى النادي بالوحدة المجمعة ، صفنا غلام أكبر منا سنا و أتى بكرة قال إنها كرة اليد و تلعب بأطراف الأصابع لا بجماع اليد و أنه سيلقي بالكرة إلى الطفل الأول في الصف و عليها أن يردها إليه بأطراف أصابعه فيلقي بها إلى الطفل الذي يليه و هكذا حتى أخر طفل في الصف ثم يكر راجعا طفلا طفلا حتى أول الصف مرة أخرى ، عند أول تجربة لي مع كرة اليد حين ألقاها الي الغلام المدرب فشلت في التعامل معها فضربتها بمجامع يدي فسخر مني كما يفعل معه فيما يبدو المدرب الكبير ، و لأنني من يومي لا أحب أن يدوس أحد لي على طرف فأنا الابن الوحيد لوالدي و أبي صعيدي قح و بالرغم من أنه رجل فقير كان ملتزما بثلاثة أمور في حياته :
أولا : لم يكن يسمح لأحد أيا كان أن يخدش كرامته بأي شكل .
ثانيا : لا يستضيف أحدا من أصدقائه في البيت و يقول : صديقي على القهوة و في الشارع مش في البيت .
ثالثا : لا يشتري أبدا شيئا بالأجل ( شكك ) مهما كان احتياجه إليه .
تركت صف لعب الكرة و ناداني الغلام المدرب لأعود إلى الصف فرفضت و ذهبت أتجول هنا و هناك داخل المنطقة القريبة من الملعب بالوحدة المجمعة ريثما ينتهي صاحبي رمضان من التدرب على لعبة كرة اليد فنعود معا إلى البيت ، كانت الوحدة المجمعة آنذاك أشبه بحديقة غناء مسورة بنبات " عنب الديب " المقصوصة أطرافه من أعلى و من الجوانب و تنتشر فيها الأشجار الكبيرة و الصغيرة من أنواع شتى و أحواض الزهور في كل مكان و الأرض حول المباني كلها تغطيها الحشائش الخضر ( النجيلة ) ، و فجأة وجدت بابا عريضا مفتوحا على قاعة تتناثر في وسطها مناضد مستديرة يجلس على بعضها أطفال قليل منهم في مثل سني و أكثرهم أكبر قليلا و تستند إلى حوائط القاعة دواليب بأرفف رصت عليها كتب كثيرة ذات ألوان زاهية .
و للحديث بقية إن شاء الله .
***
4 - الكتب و القراءة في القرى
عندما شد انتباهي المشهد و ترددت جيئة و ذهابا أمام باب المكتبة أكثر من مرة ، و في كل مرة أتطلع إلى داخل القاعة كنوع من الفضول الطفولي لمحني الرجل النحيل الأسمر الذي يجلس إلى مكتب صغير قريبا من الباب فأشار إلي أن أدخل و حين دخلت أجلسني إلى منضدة شاغرة و وضع قدامي على المنضدة قصة تمتلئ صفحاتها بالرسوم و القليل من الكلمات كبيرة الحروف ، لا أتذكر بالطبع الآن اول قصة أقرؤها خارج منهج التربية و التعليم و لكني أتذكر أن الرسوم التي كانت بها تتضمن أسدا و ثعلبا كلاهما يلبس ( بدلة ) و في رقبته ( ببيونة ) و تتضمن أشجارا و بيوتا ذوات أسطح مخروطية و مداخن من طراز البيوت في أرياف أوربا قديما .
اقرأ .. قال لي الأستاذ محمد أبو طالب أمين المكتبة - رحمة الله عليه - فقرأت كما تعودت بصوت عال ، فأوقفني و قال لي اقرأ في سرك أي بعينيك دون أن تصدر صوتا ، و كان هذا أول درس قراءة لي خارج المدرسة و أول مرة أتعلم فيها القراءة بدون صوت أو القراءة السرية كما يسميها التربويون .
منذ تلك اللحظة التي لعبت فيها المصادفة دورا كبيرا بدأت رحلتي مع القراءة الحرة كهواية تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الإدمان بل الإدمان نفسه إن صح تسمية عشق القراءة و الولع الشديد بالكتب إدمانا ، كنت كل يوم أذهب مع صاحبي رمضان جاد إلى الوحدة المجمعة فيذهب هو إلى ملعب الكرة و أذهب أنا إلى المكتبة .
لاحظ أمين المكتبة أني أقرأ كثيرا في فترة عمل المكتبة بالنهار ففي حين يقرأ غيري من الأطفال رواد المكتبة قصة أو قصتين أكون أنا قد قرأت أربع قصص أو خمسا ، و كان كثيرا من الأيام حين يأتي ليفتح المكتبة الساعة العاشرة صباحا يجدني جالسا أنتظر على سور حوض الزهور أمامها ، و كان من حق كل طفل من رواد المكتبة أن يستعير قصة يأخذها معه إلى البيت حيث يقرؤها و يعيدها في أي يوم خلال أسبوع ، أنا كنت آخذ القصة و أعود بها للمكتبة ليس خلال الأسبوع بل في الفترة المسائية للمكتبة من نفس اليوم فقد كانت المكتبة تعمل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ثم من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء ، لذلك كافأني الأستاذ محمد أبوطالب طيب الله ثراه فجعل لي وحدي ميزة أن أستعير من المكتبة مرتين في اليوم الواحد ، فعند انتهاء الفترة الصباحية أخرج بقصة أقرؤها في البيت عقب تناول الغداء ثم أعيدها في الفترة المسائية و أستعير أخرى سواها .
جعلتني القراءة الحرة أشعر بيني و بين نفسي أني متميز عن زملائي بل إنني أحطت من خلال القراءة بما لم يحط به بعض من كانوا يدرسونني من الأفندية ( الأساتذة المدرسين ) ، كنت مثلا أعرف عن طريق كامل كيلاني اسم شيكسبير و حواديت مسرحياته : يوليوس قيصر و العاصفة و تاجر البندقية و أعرف من خلال قراءاتي أسطورة إيكاروس و ديدالوس و كثيرا من أسماء و أحداث الإلياذة و الأوديسا لهوميروس و الإنيادة لفرجيل و الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري و أعرف روبنسون كروزو لدانيال ديفو و رحلات جليفر لجوناثان سويفت و حي بن يقظان لابن طفيل و دون كيشوته لسرفانتس و خرافات إيسوب و لافونتين و حكايات الأخوين جريم ، و الملك آرثر و سيف بن ذي يزن و تبع اليماني و شق و سطيح و نوادر جحا و طرائف كثيرة من حياة العرب كطرائف الحمقى و الطفيليين و طرائف الحجاج بن يوسف الثقفي و حكايات النعمان بن المنذر و أبطال غزوات الرسول (ص) و عشرات بل مئات غيرها من المعلومات المتنوعة ، كل ذلك من قصص الأطفال التي لم أكن في تلك السن الباكرة أقرؤها بل كنت ألتهمها التهاما .
أتذكر أني ذات مرة عدت للبيت و معي قصة " علي بابا " لكامل كيلاني و بعد الغداء أخرجت القصة من جيب جلابيتي و جلست على حافة السرير الذي كنت أنام عليه مع أمي و في مواجهتي أعلى الكنبة التي كان ينام عليها والدي رف مثبت بالحائط يقبع عليه الراديو الترانسزتور و بالمصادفة و أنا أبدأ في قراءة القصة بدأوا في الراديو يذيعون أحدالبرامج الغنائية التي جعلتني أمي أعشقها و كان البرنامج " علي بابا " و بالرغم من الفروق ما بين القصة كما كتبها كامل كيلاني و البرنامج الذي كان من تأليف إبراهيم رجب و ألحان عبد الحليم علي و إخراج المخرج الإذاعي الشهير عبد الوهاب يوسف إلا أنني استمعت حينها متعة مزدوجة بالقصة و البرنامج معا مازلت أجد حلاوتها في نفسي حتى الآن .
انتقلت المكتبة خلال سنوات النصف الأول من عقد الستينيات إلى مكان أخر خارج الوحدة المجمعة ثم عادت إلى مكانها القديم في النصف الثاني و ظللت زبونها الأول طوال عقد الستينيات حيثما تكون ، و لم تكن عطلتها الأسبوعية يوم الجمعة فقط بل كانت تعطل أيضا يوم الاثنين لا أدري لماذا ؟ و كنت أكره هذا اليوم لذلك السبب و إن كنت أتحسب له دائما باستعارة قصتين لا قصة واحدة عقب انتهاء الفترة المسائية ليوم الأحد ، و لم يكن أمين المكتبة مجرد خازن للكتب أو إداري مسؤول فقط عن تشغيلها بل كان لديه حس تربوي و يتدخل أحيانا بالتوجيه فيما يتعلق بسلوكيات القراءة ، أتذكر أني ذات يوم شدني عنوان كتاب فأردت استعارته فقال لي هذا الكتاب غير مناسب لسنك و لما وجدني مصرا على استعارته تركني أستعيره و هو يقول لي : هذا الكتاب بالذات عندما تعيده لابد أن تشرح لي ماذا فهمت منه ؟ و أخذت الكتاب و في اليوم التالي اعترفت للأستاذ بأني أخطأت في استعارته فلم أفهم منه إلا النزر اليسير فقال لي مبتسما : ألم أقل لك إنه غير مناسب لسنك ؟ .
كان ما يعجب أمين المكتبة في أنني أقر أ الكتب بانتظام فعندما بدأت في قراءة مجموعة كامل كيلاني و كانت تطبعها لسنوات طويلة مكتبة دار المعارف كنت أتتبع كل قصص المجموعة الموجودة بالمكتبة حتى انتهي منها بالكامل ثم أبدأ في مجموعة أخرى ، فعلت ذلك أيضا مع مجموعة المكتبة الخضراء للأطفال التي كانت تصدرها دار المعارف و مجموعة المكتبة المدرسية لمحمد سعيد العريان و آخرين و قصص محمد أحمد برانق و محمد عطية الإبراشي و عبد الحميد جودة السحار و مجموعة أولادنا و يحكى أن وحكايات جدتي و مجموعة قصص الأساطير : أساطير من الهند ، أساطير من الصين ، أساطير من اليونان و أساطير من فارس ، و مجموعة حكايات ألف ليلة و ليلة و كليلة و دمنة و غيرها .
إن الذاكرة الإنسانية لغريبة أحيانا فقد تفلت الذاكرة أمورا قريبة الحدوث زمنيا و تحتفظ بأمور توالت عليها عقود من السنين و قد تقبض بقوة على أسماء و أشياء ضئيلة أو قليلة الأهمية و يتسرب من بين ثقوبها كثير من الأسماء و الأشياء الخطيرة و المهمة ، فما زالت ذاكرتي مثلا تحتفظ حتى الآن باسم تلميذ زاملني لسنة واحدة فقط في المدرسة الابتدائية هي السنة الأولى و لكنه في الإجازة الصيفية نزل ليعوم في مياه الفيضان بجوار البيت فغرق ( كانت مياه الفيضان قبل بناء السد العالي تغمر سنويا كل أراضي الوادي و يسمى الأهالي الفيضان : الدميرة ) ، اسم هذا التلميذ الزميل الذي فقدته مبكرا جدا ( رشاد عبد الحكيم ) ، تحتفظ ذاكرتي أيضا حتى الآن بعبارة قرأتها و أنا في تلك السن الصغيرة في إحدى قصص كامل كيلاني التي استلهمها من حكايات كليلة و دمنة لا أتذكر عنوانها بالضبط ربما ( دمنة و شتربة ) ربما ، لكن العبارة بالنص هي : " كنت يا دمنة بارعا ذكيا ، و كان عيشك سائغا هنيا ، فبدلك الحسد و أغواك و حير عقلك و أعماك فظلمت نفسك و قتلت أخاك " .
***
5 - مكتبات المدارس و تعليم الموسيقى في القرى
كانت بمدرستي الابتدائية مكتبة و لكن مع الأسف لم أدخلها إلا قليلا رغم رغبتي الشديدة في ذلك و تكرار محاولاتي فقد كانوا يتعاملون مع كتبها كعهدة مدرسية يخشى عليها من التلف و الضياع كما أن المكتبة في عرفهم شأنها شأن حصص الألعاب و الموسيقى و الرسم لا أهمية لها ولذلك كثيرا ما كان يتم السطو على تلك الحصص لصالح الحساب و العلوم و اللغة العربية ، بل كانت القراءة الحرة غالبا ما يعدها المدرسون نوعا من تضييع الوقت فيما لا جدوى كبيرة من ورائه ، أذكر أن الأستاذ حسن علي نصر - رحمة الله عليه - و هو من المدرسين الشباب غير الأفندية المطربشين أي يلبس الزي الإفرنجي ( قميصا و بنطلونا ) كان يلزمنا بأن نصطحب معنا في الفسحة الكبيرة كتابا لمادة الحساب التي كان يدرسها لنا في الصف الخامس الابتدائي لكن ما حدث أنني تحت ضغط عشقي للقراءة خارج المقررات الدراسية اصطحبت مع كتاب الحساب قصة أذكر عنوانها حتى الآن - و هو أمر يمكن إضافته إلى عجائب الذاكرة الإنسانية - ، كان عنوانها ( بدر البدور ) ، وضعت القصة في وسط الكتاب و كنت منشغلا بالقراءة فيها بدلا من الانشغال بالقراءة في كتاب الحساب و في أثناء اندماجي على درجة من درجات السلم الخارجي للمدرسة فوجئت بمن يدس وجهه معي في القصة و كان ذلك المدرس ، و خصني بذلك لأنه كان يخطط لحصول بعض تلاميذه من " الشطار " أمثالي على الدرجة النهائية في مادتيه بامتحان آخر السنة ( و قد حصل ذلك في امتحان نهاية الشهادة الابتدائية ) ، و قد وبخني على محاولتي خداعه و في حصة الحساب بعد الفسحة عاقبني بضربتين من عصاه النحيلة الصلبة على يدي ، و لم يكن في إمكاني في ذلك الزمان أن أشتكي لأبي من الاستاذ حسن أوغيره حين نتعرض لعقوباتهم فقد ينتج عن ذلك توبيخ و عقوبة أخرى من أبي لأن معنى أن المدرس عاقبني - و هو دائما مؤتمن و مصدق - في كل الأحوال أنني دون أدنى شك قد قصرت في أمر من أمور الدراسة أو أنني أتيت من السلوكيات غير الحسنة ما أستحق عليه التوبيخ و العقوبة ، هكذا كانت الأمور في حياتنا التعليمية في عقد الستينيات ، و مما أتذكره فآسف عليه أن حصص الألعاب و الموسيقى و الرسم كما سبق أن ذكرت لم يكن لها أهمية تذكر و إن أنس لا أنس ما كان يفعله تلاميذ المدرسة مع الأستاذ جلال مدرس الموسيقى بالمدرسة ، كان الأستاذ جلال يعطينا دروسا في الموسيقى نستخدم فيها كراسة خاصة ندون فيها بعض العلامات الموسيقية كما كان يعزف أمامنا كل صباح على الأكورديون و نحن نردد بشكل جماعي مصاحبين للحن المعزوف نشيد ( الله أكبر ) و هو النشيد الذي كتب كلماته عبد الله شمس الدين شاعر جمعيات الشبان المسلمين كما كان يلقب و تلحين الموسيقار محمود الشريف صاحب الألحان التي أصفها دائما بأنها ألحان " سكر زيادة " و النشيد الوطني " و الله زمان يا سلاحي " و هو من كلمات صلاح جاهين أحد أهم أساطين شعر العامية المصرية و تلحين الموسيقار كمال الطويل ، النشيد الذي استبدل به السادات بعد توقيعه معاهدة كامب ديفيد المشؤومة نشيد " بلادي .. بلادي " بعد أن خفف جرعة الحماسة فيه مختار السيد حين أعاد توزيعه أوركستراليا و عبث بإيقاعه الأصلي تحت إشراف اللواء الدكتور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، فعل ذلك السادات إيمانا منه بضرورة السلام مع أصدقائه الصهاينة و إكراما لعيون أمريكا و الغرب .
أعود إلى الأستاذ المسكين جلال مدرس الموسيقى الذي لم يكن من أهل القرية و مثله مدرسا الألعاب و الرسم ، رآه بعض التلاميذ من إحدى الدفعات السابقة علينا في المدرسة يكسر بيضتين في كوب زجاجي و يخلطهما بعود خشبي ثم يشربهما فلقبوه بعبارة توارثتها أجيال تلاميذ المدرسة لسنوات حتى انتقل إلى المدينة ، هذه العبارة هي : " الأستاذ جلال شرب البيضة " ، كان التلاميذ الأشقياء - و الشقاوة في أوساط الأطفال تعدي - يزفون الأستاذ جلال كل يوم و هو طريقه من المدرسة حتى الوحدة المجمعة على الجسر خارج القرية ليستقل الأوتوبيس عائدا إلى أسيوط بعبارة " الأستاذ جلال شرب البيضة " و انتشرت العبارة بين أطفال المدارس الابتدائية الأربع فلم يكن من يزفونه تلاميذ مدرستي فقط لاسيما أن التلاميذ كانوا يخرجون من مدارسهم عقب نهاية اليوم الدراسي في وقت واحد و ما أدراك كيف يكون تلاميذ المدارس الابتدائية حين ينفلتون من عقالهم الدراسي و ينتشرون في شوارع القرية كقطعان الأغنام الشوارد و يتهارشون طوال الطريق إلى منازلهم كما تتهارش جراء الكلاب الصغيرة .
كان ناظر المدرسة يسمح للأستاذ جلال أن يغادر المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي ليجنبه بعضا مما يتعرض له من التلاميذ ، و السبب من وجهة نظري في ذلك حين حاولت تفسيره فيما بعد هو هوان شأن مدرس الموسيقى ( و مدرسي الأنشطة بشكل عام ) على منظومة التربية والتعليم بالكامل في مصر هذا بالإضافة إلى تدني الوعي في الأرياف بقيمة الفن بصفة عامة و الموسيقى بصفة خاصة إلا إذا كانت في إطار معين كالموسيقى الشعبية التي يتعاطون معها في أوقات و مناسبات معينة كالأفراح و الموالد و ما إلى ذلك .
حببني كامل كيلاني في الشعر الذي كان يزود به كثيرا من قصصه فكنت أحفظه و كان يزاحم في ذاكرتي الصغيرة آنذاك ما كنت أحفظه في الكتاب من أيات الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم ( عم و تبارك و قد سمع ) لكن أول بيت حفظته خارج منهج المحفوظات المقررة علينا في سنوات الدراسة كان بيتا يستشهد به الأستاذ عبد الصبور جنيدي أحد مدرسينا المطربشين ( الأفندية ) حين يسأل زميلي بالفصل فتح الباب - و كان مع الأسف بليدا - سؤالا يتعلق بما فهمه من الدرس فلا يجيب و إذا أجاب فالإجابة على الدوام خطأ ، حينئذ يقول المدرس له :
سموك فتح الباب ما أنصفوا .. ياليتهم سموك " قفل الباب "
ثم يتلو البيت بقوله : اجلس لا بارك الله فيك .
كما سبق أن ذكرت جعلتني القراءة الحرة أشعر بيني وبين نفسي أني متميز عن زملائي و ربما عن بعض أساتذتي بالرغم من صغر سني بحصيلتي من المعلومات المتنوعة التي جمعتها من قراءة القصص ، و شحذت القراءة من ذاكرتي فكنت سريع الحفظ و كنت أقرأ و أكتب بشكل يحسدني عليه زملائي لا أقصد الخط ( أخفقت مع الأسف بالرغم من محاولاتي الكثيرة في تحسين خطي ) بل أقصد القراءة الصحيحة و الكتابة التي تندر فيها الأخطاء ، و قد اكتشف ذلك بعض مدرسي فجعلوني بدءا من صفي الرابع في المدرسة ألفا الطابور الذي يهتف و يهتف وراءه تلاميذ المدرسة الأصغر منه سنا و الأكبر بتحية العلم و يقرأ كلمة الصباح ثم يدير الطابور ليذهب كل تلاميذ فصل إلى فصلهم ، و ذات مرة وقف ناظر المدرسة الأستاذ حسن عبد الفتاح دسوقي بحذائه ذي اللون الأسود و الأبيض ليسأل هذا السؤال : من منكم يا أولاد يعرف اسم ضيف مصر الكبير في هذه الأيام ؟ فوجم الجميع و لم ينبس أحد ببنت شفة و رفعت إصبعي فرآني أحد مدرسي فشدني من يدي و أوقفني أمام الناظر قائلا : ياحضرة الناظر : الولد دا بيعرف الكفت ( و لكني حتى الآن لا أعرف ماهو الكفت ) ، فأعاد علي الناظر السؤال فقلت له : الأسقف مكاريوس رئيس قبرص فصفق لي حضرة الناظر و أمر كل تلاميذ المدرسة و المدرسين ( المتطربشين و المتبنطلين ) أن يفعلوا ذلك ، و في أحد احتفلات المدرسة بعيد الأم و كنت في الصف الثالث وضعوا لي كرسيا فوق منضدة و أصعدوني على الكرسي لكي أخطب في زملائي خطبة حول موضوع قرأته كقصة في مكتبة الوحدة المجمعة عن ضرورة البر بالوالدين حتى إن كانوا كفارا ، و مرة أخرى في أحد الأعياد القومية و كنت في الصف الخامس و بعد طواف طوابير المدارس بالقرية وقفت الطوابير أمام نقطة البوليس حيث يعمل أبي و ورفعوني على كرسي فوق منصدة ليراني الجميع فقد كنت طفلا صغيرا لم أتجاوز العاشرة من عمري لألقي كلمة مقتبسة من الميثاق الوطني الذي حفظني مدرس التربية الوطنية نصفه تقريبا خلال عدة أشهر من أجل أن استخدم فقراته ذات الأسلوب المميز في كلمات الصباح ( و لا غرو فإن لجنة ذات مستوى رفيع علما و ثقافة هم من قاموا بوضعه ، أما لمسات الصياغة الأسلوببة النهائية فكانت لهيكل و هيكل أديب في زي صحفي ) كانت الكلمة التي ما زلت أحفظها حتى الآن و غيرها من فقرات و عبارات الميثاق فهي كما يلي :
" إن قطعة من الأرض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة أو التاريخ لحركة عنصرية عدوانية أرادها المستعمر سوطا في يده يلهب به ظهر النضال العربي إذا استطاع يوما أن يتخلص من المهانة " .
حكى أبي لأمي ما حدث أمام محل عمله و كان فخورا بي و إن لم يبد ذلك لي صراحة فقد كان صعيديا قحا كما سبق أن ذكرت و من سمات الصعيدي القح - و هذا عيب فيه - أنه لا يفصح كثيرا عن مشاعره بالرغم من أن وجدانه يجيش بها ، في تلك الليلة أشعلت أمي قليلا من الحطب في طبق فخار و وضعت على النار بعد أن هدأت حفنةمن الشيح و المستكة و حبة البركة و اللبان الدكر و بخرتني ببخورها لوقايتي من الحسد وكانت تتلو المعوذتين و تردد بعض الدعوات في أثناء عملية التبخير .
***
6 - الصحة و المستشفيات في القرى
كنت بعد أن أخرج من مكتبة الوحدة المجمعة مع نهاية فترتها الصباحية و في جيب جلابيتي القصة التي استعرتها كي أقرأها بالبيت بعد الغداء أتخذ طريقي إلى حيث يلعب صاحبي رمضان جاد كي نعود معا إلى البيت و لكن بسبب فضولي الطفولي الشديد أحرص دائما على المرور بصيدلية الوحدة لا لشيء إلا للفرجة من خارج الصيدليةعلى مسوخ الأجنة المغمورة في الفورمالين داخل برطامانات كبيرة و المرصوصة على أرفف خشبية عالية بامتداد حوائط الصيدلية الداخلية ، و حين أتيح لي دخول المستشفى بجوار الصيدلية نزيلا لمدة ثلاثة عشر يوما في بداية صيف عام 1964 و كنت حينها تلميذا بالصف الرابع الابتدائي سألت كبيرة الممرضات بالمستشفى عن مسوخ الأجنة تلك فأخبرتني أنها أطفال ولدت ميتة و قد استكملت معلوماتي بشأنها بعد ذلك من عدة مصادر فعرفت أنها خدائج أجنة أي أجنة ولدت غير مكتملة النمو بعد أن أصيبت داخل بطون الأمهات بما ألحق بها تشوهات شتى ، و لأنها حالات جديرة بالدراسة الطبية فقد وضعت هكذا في مواد حافظة داخل البرطمانات و لكن ما لم أتمكن من الوصول إلى إجابة شافية عنه هو لماذا هي موجودة في الصيدلية ؟ و لماذا هي معروضة بهذا الشكل بحيث يراها رواد الصيدلية و كل من يمر أمامها مثلي ؟ .
تتبع تلك الصيدلية مستشفى الوحدة المجمعة و تعمل مصاحبة لعمل المستشفى ، فبعد أن يقطع المريض تذكرة الكشف التي لم يكن يزيد ثمنها آنذاك على قرشين صاغ تقريبا، ينتظر المريض على إحدى الدكك خارج حجرة الكشف حتى يحين دوره ف
يدخل ليكشف عليه الطبيب ثم يكتب له روشتة العلاج فيذهب بعد ذلك إلى الصيدلية كي يصرفها مجانا ، و. كنت ألاحظ أن معظم زبائن المستشفى و الصيدلية يوميا من النساء و الأطفال ما قبل سن المدرسة ، و كلما مررت قدام الصيدلية صباحا وجدت طابورا من السواد : الجلابيب السود و الشقق ( جمع شقة و هي نوع من الطرح الكبيرة ) و الطرح ، و ما زالت ذاكرتي تحتفظ باسم أشهر الأدوية التي كانت تصرف للمرضى في ذلك الزمان : الراوند و شربة الملح الإنجليزي و المزيج ( و لا أدري ماهو المزيج و لكن اسمه يدل على أنه خلطة من عدة مواد طبية ) و اليزول و الميكروكروم للجروح .
و مادمت جئت على سيرة دخول المستشفى فلا بأس من أحكي عنها حكايتين : الأولى حين تورم باطن ذراعي و كان يؤلمني و شرد ألمه النوم من عيني عدة ليال و لم تفلح فيه لبخات أمي البلدية فذهب بي أبي إلى المستشفى و كنت حينها بالصف الثالث الابتدائي ، كشفت الطبيبة على ذراعي فقالت لأبي : لما يستوي الورم ، تعال به بعد يومين أو ثلاثة ، و قبل أن يسألها أبي عن معنى ( يستوي ) قالت له عندما يتحول لون الورم إلى اللون الأحمر ، و بعد ثلاثة أيام كنا في حجرة الكشف و كشفت على ذراعي و رشت على الورم مخدرا موضعيا ( إتير ) ثم خاطبتني قائلة : راجل و تستحمل و الا عيل ؟ فقلت لها : راجل طبعا ، فابتسمت و هي تضع المشرط في بطن الورم و تحركه إلى أعلى و إلى أسفل و هي تضغط لكي تفرغ كل ما به من الصديد و كان ألما هائلا لا يطاق و وددت لو أستطيع البكاء ، و لكن كيف يبكي من أقر بأنه ر جل و ليس عيلا ؟ ، و ضمدت الطبيبة الجرح بعد أن وضعت بداخله فتيلا قائلة لوالدي : بعد ثلاثة أو أربعة أيام جئ به لنفك الضمادة ، و حين خرجت مع أبي كانت قد زال الكثير الوجع الذي عانيته مدة أسبوعين منذ ظهر بذراعي الورم و لم يتبق سوى وجع الجراحة الذي سرعان ما انتهى .
الحكاية الثانية أنني دخلت المستشفى أو بتعبير أدق احتجزت به بعد اصابتي بحمى روماتيزنية جعلت رجلي لا تقويان على حملي و كنت حينها كما أسلفت في الصف الرابع ، وضعوني حين احتجزت في عنبر كبير به أكثر من خمسة أسرة و لم يكن بالعنبر نزيل سواي و كان هناك أكثر من عنبر آخر و كلها بالدور الثاني من المستشفى ، حين دخلت المستشفى كان بالعنبر المجاور لعنبري ثلاثة رجال كهول ينتظرون موعد إجراء عملية البواسير فقد كانت المستشفى مزودة بغرفة عمليات كما أن الجراحة كانت تخصص مديرة المستشفى ، أحد الكهول الثلاثة كان خفيف الظل صاحب دعابة فبينما رفيقه يتعب الممرضة و يرهقها من أمرها عسرا في تناول حصته المقررة ثلاث مرات باليوم من زيت الخروع ، و هذا من أجل تنظيف بطنه تماما من فضلات الطعام حتى يصبح جاهزا لإجراء العملية كان هو يلحس بإصبعه جدران الكوب من الداخل و كأن ما به عسل نحل و ليس زيت الخروع الذي تجزع أنفس كثير من الناس و أنا منهم من مجرد رؤيته ، ثالثهم كان شديد السمرة و يحفظ أجزاء كثيرة من السيرة الهلالية أسمعني بعضها و حببني فيها كما كان يحفظ قدرا غير قليل من المواويل أذكر منها موالا سمعته لأول مرة في حياتي منه يقول : " الخسيس قال للأصيل : تعالى اعمل عندنا خدام ، تاكل و تشرب و تبقى من زمرة الخدام ، قال الأصيل عجبي عليك يا زمان ، دا أنا أسكن الجبال مع الحدادي و الغربان ، تاكلني الوحوشة و الغيلان ، و لا يقولوا الأصيل عند الخسيس خدام " ، هكذا حفظته منه و هو يختلف عن صيغته المتداولة بعض الاختلافات الطفيفة .
لليلتين عقب إجراء الكهول الثلاثة للعملية لم أكن أستطيع النوم بسبب أنينهم و توجعهم المستمر بعد انتهاء مفعول المخدر ( البنج ) أما حين أزيل من كل منهم ( الخابور ) الذي يضمد الجروح محل العملية و يمتص ما تنزفه من دماء فقد كان شيئا لا يمكن وصفه ، و قد ظللت طول عمري بعد ذلك أتحسب من الإصابة بالبواسير و يتلبسني رعب هائل إن ألمت بي أعراض كأعراضها .
نسيت أن أقول إن المستشفى كان في غاية النظافة ، يوميا تمسح أرضياته بالمنظفات و المعقمات فتبدو كأنها أرضيات فندق من فنادق الدرجة الممتازة و هذا في قرية لا تعد في الأرض و لا يوجد ما يماثل تلك المستشفى الآن في كثير من المدن .
عقب الحقنة الثانية تقريبا انفك عقال الروماتيزم عن رجلي و لكنهم أبقوني ثلاثة عشر يوما محتجزا بالمستشفى لاستكمال العلاج ، كان طعام الإفطار صباحا بيضتين مسلوقتين و كوب حليب ساخن ، و في الغداء خضار و أرز و لحمة و في العشاء قطعة جبن أبيض و قطعة حلاوة طحينية و زبادي و كل ذلك مجانا بالكامل : العلاج و الغذاء ، و مع ذلك أتذكر أن أمي - رحمة الله عليها - أرسلت إلي مع أبي طعاما مخصوصا مرتين أو ثلاثة و لا غرو فهكذا قلب الأم ، و لأني لم أكن أحب الحلاوة الطحينية فقد كنت أضع ما أعطاه منها داخل درج الكوميدينو بجوار السرير حتى إذا تجمعت عدة قطع يأتيني بعض أصدقائي من الأطفال و يقفون في الحديقة أسفل العنبر الذي أقيم فيه و قد استعار كل منهم قصة من المكتبة باسمه و يقذفون إلي بها من أسفل فأتلقفها أنا من أحد شبابيك العنبر الكبيرة و في مقابل ذلك ألقي إليهم بقطع الحلاوة فيتلقفونها في حجور جلابياتهم ، حدث ذلك مرتين أو ثلاث مرات خلال تواجدي بالمستشفى ، و من عجائب الذاكرة اني اتذكر اسم قصة قراتها بسريري في المستشفى و كان ( سميحة و مديحة ) و هي إحدى قصص المكتبة المدرسية لمحمد سعيد العريان و آخرين .
حين خرجت من المستشفى إلى البيت و لزمت البيت لأسبوعين آخرين لا أستطيع الخروج للعب مع أطفال الحي و لا يمكنني الذهاب إلى المكتبة لأقرأ فيها و أستعير منها و لكن الله عوضني خيرا فقد منحتني بنت جيراننا الطالبة أنذاك بالسنة الخامسة ( النهائية ) في مدرسة دار المعلمات روايتي ( واسلاماه ) و ( سيرة شجاع ) لعلي أحمد باكثير و يبدو أنهما كانا مقررتين للدراسة على طلاب و طالبات دور المعلمين و المعلمات فأجهزت عليهما في عدة أيام و لما لم أجد بعدهما ما أقرؤه فقد لجأت إلى الاجترار ، و أعني هنا بالاجترار إعادة قراءة ما قرأته من قبل مرة أخرى ، فكنت كل حين أنزل إلى الدور الأرضي من البيت لأفتح دولابا مثبتا في الحائط الذي يعلو المصطبة بمدخل البيت ألصقت بأحد مصراعيه من الخارج ورقة كتبت عليها بحبر أحمر ( المكتبة) و هي أول مكتبة أكونها في حياتي و إن كان ما بها من مقتنيات لا يزيد على خمس أو ست قصص و ثلاثة أو أربعة أعداد من مجلة سندباد لا أدري الآن من أين جاءتني ؟ كيف ؟ لكنها أصبحت بشكل أو آخر ملكي ، فأستخرج منها ما قرأته من قبل لأقرأه مرة ثانية و مرة ثالثة ، و كان هذا مفيدا فقد كنت مع كل قراءة أكتشف شيئا خفي علي في القراءات السابقة ، و الآن أتذكر عبارة للمفكر العلامة عباس محمود العقاد أشهر قارئ عربي في القرن العشرين يقول فيها : " أن تقرأ كتابا ثلاث مرات خير لك من أن تقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة".
***
7 - العيد في القرى
قبل أن ينتهي شهر رمضان أي قبل مجيء العيد بعشرة أيام تقريبا أو أسبوع على الأقل كان يأخذني أبي إلى محل بالقرية لبيع الأقمشة فأختار لون الجلابية أو البيجامة التي ستكون زي العيد ، لم نكن في القرى نعرف أن البيجامة ملبس مخصص للنوم فقط و كأطفال كنا نفضل أن يفصل القماش الجديد كبيجامة لأنها أشبه بالبدلة من ناحية و من ناحية أخرى تعطي فرصة كبيرة للحركة في أثناء اللعب ، و نوع القماش بحسب وقت مجيء عيد رمضان في الصيف أو الشتاء ، و كما سبق أن ذكرت كان وقت رمضان طوال الستينيات هو فصل الشتاء و لذلك كان الكستور هو القماش المناسب لكسوة عيد رمضان و كان الكستور نوعين : كستور بفروة و كستور مبرد ( أي بدون فروة ) .
و يصحبني أبي بعد شراء القماش الذي اخترته إلى دكان الخياط الذي يأخذ مقاساتي بعد أن يسألني : جلابية و الا بيجامة ؟ ، و قبل العيد بيوم أو اثنين أذهب مع أبي إلى الخياط لاستلام الجلابية أو البيجامة الجديدة .
أما بالنسبة لأمي رحمة الله عليها فهي تنشغل مع نساء الجيران في عمل كعك العيد و البسكويت فيجهزون " صواني الصاج " التي ترص فيها المخبوزات ( الكعك و القرص أو البسكويت أو الكعك أبو سكر ) و أتذكر أنهم كانوا يرسلونني إلى مكان معين قريبا من سويقة القرية لأشتري لهن لوازم عجينة الكعك من الخميرة و البيكنبودر و الكركم و الأخير هو ما يعطي الكعك لونه الأصفر أو المائل للصفرة بحسب مقدار ما يضاف منه إلى العجينة .
كانت عملية " خبز الكعك " تستمر لعدة أيام و كلها لدينا في البيت و ينضج كل الكعك سواء كعكنا أو كعك الجيران في فرننا فأمي كما سبق أن ذكرت لا تخرج من البيت و لو حتى إلى بيت الجيران الملاصق لناو لا الذي أمامنا ، و لكل بيت من بيوت الجيران يوم كامل و يعمل النساء جميعا كفريق واحد كل منهن تتولى جانبا من جوانب عملية " الخبز " تكون فيها أمهر و أكثر خبرة .
بالنسبة لعمل البسكويت كانت تثبت الماكينة ( ماكينة عمل البسكويت و هي غالبا مفرمة اللحمة مع تغيير الوجه أي منفذ خروج العجين ) بحافة الطبلية و توضع العجينة في فتحتها العليا و عندما تدار يد الماكينة يخرج العجين من فم الماكينة في شكل متصل فيقطع في أشكال مختلفة و يرص في صواني الصاج ، و قد كنت أساعد أمي و هي تصنع " الكعك أبو سكر " فقد كانت تستعين بي لنقش ذلك النوع من الكعك و فائدة النقوش أن السكر المطحون عندما يرش فوق الكعكة يستقر في الخدوش الغائرة التي أحدثتها أداة النقش ( المنقاش) ، و لم نكن في الأرياف نعرف السكر المطحون الذي نراه في مخابز الحلويات الآن ، كان السكر في القرى آنذاك يباع في شكلين : سكر المكنة " و هو عبارة عن مكعبات صغيرة و يستخدم أساسا في تحلية الشاي بحسب حجم كوب الشاي و عادة الشارب في تحليته ، و سكر القمع و يعرف بهذا الاسم لأنه قطعة واحدة كبيرة في شكل قمع ، و قمع السكر كان يكسر بالشاكوش و القطع المكسرة يتم طحنها في " الهون " طحنا جيدا و السكر الطحين أو المطحون هو ما يرش على الكعك المنقوش .
قليل من الكعك و القرص ( تنطق بضمة ففتحة ) بعد إنضاجه في الفرن يترك ليأكل طريا وحده أو يأكل بعد غمسه في الحليب الساخن أو الشاي الممزوج بالحليب أو بالشاي فقط ، أما معظم الكعك و القرص فيتم تشريكها أي تقطيعها في شكل شرائح و إعادتها إلى الفرن مرة أخرى لتحميصها ( يسمى فايش في كثير من المناطق و لكنه في جنوب سوهاج و شمال قنا يسمى شريك ) و هذا ما يجعلها تستخدم لفترة أطول بكثير مما لو تركت بدون تحميص.
ليلة العيد ليلة عظيمة بالنسبة للأطفال و بخاصة الأطفال في القرى ، كنت أكاد لا أستطيع النوم هذه الليلةمن شدة الانفعال ، ففي الصباح سألبس كسوة العيد الجديدة و غالبا ما يكون مع الكسوة الجديدة حذاء جديد و أذهب مع أبي إلى الجامع للمشاركة في تكبيرات و تهليلات العيد ثم صلاة ركعتي العيد و سماع الخطبة ثم أعود معه بعد ذلك إلى البيت لنفطر ثم أنطلق بعد أن أحصل على العيدية من أبي و أمي مع أترابي من أطفال الحي للاستماع بمباهج العيد المختلفة ، كان أبي يحرص قبل العيد على أن يفك بضعة جنيهات إلى فئات أصغر : شلنات (الشلن خمسة قروش ) و أنصاف ريالات ( نصف الريال عشرة قروش ) لكي يوزعها كعيديات على و على أمي و على أطفال الجيران و أصدقائي المقربين عندما يأتون معي إلى البيت ، و هكذا يفعل معي آباء أطفال الجيران و آباء أصدقائي عندما ننتقل من بيت إلى بيت كجزء من طقوس العيد ، فلوس العيد تصرف على شراء البلالين ( النفاخات أو النفافيخ كما كنا نسميها في الريف ) و على شراء الحلويات المختلفة كحلاوة خد الجميل و غزل البنات و براغيت الست و العسلية و شراء قصب خد الجميل ( و هو نوع غض من القصب ، لونه إما أحمر أو مموه من الأحمر و الأصفر ) غيرها ، و على البمب و الزمارات ذات الأصوات العالية و غالبا ما كان استخدامها هي و البمب يعرضنا لسماع عبارات التوبيخ و كلمات الزجر من كبار السن في الحي و غالبا ما ينتهي الأمر بسبب عدم توقفنا عن النفخ في الزمارات المزعجة و فرقعة البمب بالطرد من المكان ، و أكثر ما يكسبه أصحاب الدكاكين في القرية أيام العيد يكون من الأطفال ، كما كنا نذهب إلى المراجيح ( في اللعة الفصيحة أراجيح و مفردها أرجوحة) حيث نصبها الموالدية في جانب من القرية و المراجيح التي كنا نعرفها ليست كالمراجيح التي يعرفها أطفال المدن آنذاك و لا كما يعرفها أطفال القرى الآن ، هي مراجيح بدائية للغاية فهي مجرد قطعة عريضة و سميكة من الخشب معلقة بحبلين غليظين بين نخلتين أو شجرتين لا أكثر ( في قرى جنوب سوهاج و شمال قنا يسمون المرجيجة طلطيحة ) ، و بالمشاركة بين أكثر من طفل كنا نشتري أحيانا كرة جلدية نلعب بها في الأماكن الرحبة بالحي و كانت نتيجة لعب الكرة التعرض لما تعرضنا له بسبب الزمارات و البمب فاللعب لا يتم في صمت و كيف يصمت الأطفال و هم يلعبون ؟! و إنما يصحب اللعب دائما الكثير من المشاجرات الطفولية و الصياح ، لم نكن نشعر طول يوم العيد بأي تعب بالرغم من كثرة الحركة و التنقل كما لا تساورنا رغبة في العودة إلى البيوت مما يضطر الأمهات لإرسال الآباء أو صبيان أكبر سنا لإعادتنا إلى البيوت و غالبا ما تخفق هذه المحاولات و تقابل بالرفض الصريح ثم الروغان ( الزوغان ) منهم لاستكمال اللعب و الاستمتاع بمباهج العيد ، و إذا حدث و لم أجد بدا من العودة إلى البيت فإنني أكون مكدرا للغاية و لا يفلح ما تضعه أمي أمامي على الطبلية من طعام مميز في هذا اليوم يكون اللحم (الزفر ) قوامه الأساسي في التخفيف من كدري ( أهم شيء لدى الطفل هو اللعب ) حتى أنفلت مرة أخرى إلى الشارع و لم يكن شيء يحول دون ذلك إلا وجود أبي في البيت و استعانة أمي به على كبح جماحي و إجباري على المكوث بالبيت على الأقل فترة القيلولة لا سيما إذا كان الجو حارا.
تعرضت ذات عيد في يومه الثاني أو الثالث لعلقة ساخنة من أبي لأن طفلا سأله أبي عني و هو يمر أمام نقطة البوليس حيث يعمل ليعود بي إلى البيت فأخبره الطفل كذبا لا أدري لماذا ؟ أنه رآني مع طفلين آخرين نركب الأوتوبيس الذاهب إلى مدينة أسيوط ، و لما تأخرت في اللعب مع أترابي فلم أرجع إلى البيت إلا بعد أن نفدت معظم طاقتي الحيوية و قرصني بمقارصه الجوع الذي لم أكن أشعر به طوال اندماجي في اللعب ، لم أفلح في إقناع والدي أني لم أذهب إلى أي مكان خارج القرية و استشهدت بطفلي الجيران اللذين كان معي طوال النهار ، و لم يقتنع بكلامي الذي كان مختلطا بالبكاء و النشيج إلا بعد تأكيدهما صدق كلامي ، حينئذ هدأت ثائرته ( كان رحمة الله عصبيا و شديدا في معاملتي بالرغم من كوني طفله الوحيد ) و راح يربت على كتفي و يمسح رأسي بيده مبررا ضربه لي بخوفه علي و كان بالطبع صادقا و عندما أقرأ بيت الشاعر الذي يقول :
فقسا ليزدجروا ، و من يك حازما .. فليقس أحيانا على من يرحم .
أتذكر هذه الواقعة و واقعات أخرى شبيهة بها .
***
8 - الصيف في القرى " أ "
لا أتذكر الصيف في السنوات الأولى من حياتي إلا من خلال الماء فقد ارتبط الماء و الصيف في ذاكرتي ارتباطا وثيقا ، و أبعد المشاهد التي أتذكرها حين كنت في الثالثة من عمري تقريبا هو مشهد المياه و هي تتدفق على الأرض و تنداح فتملأ الشقوق و الأماكن المنخفضة ، و جحافل الحشرات كالنمل و الصراصير و بعض الفئران هي تجري أمام أطراف المياه المتدفقة باحثة عن منجى من الغرق ، كان المشهد مثيرا و غريبا بالنسبة لطفل في تلك السن الصغيرة ، كانت القرى قبل تحويل مجرى النيل و بناء السد العالي حين يأتي الفيضان و يجتاح أراضي الحياض حول المدن و القرى تتحول القرى على وجه التحديد إلى جزر وسط المياه و يكون التنقل حينئذ ما بينها في أغلب الأحوال بالمراكب الصغيرة ( الفلوكة ) ، و كانت مياه الفيضان حين تصل إلى " نجع سبع " حيث ولدت تحيط بها و تكون على بعد عشرات الأمتار فقط من البيت الذي نسكن فيه ، و أتذكر أنه ذات يوم أغراني بعض الأطفال الصغار من أترابي بخلع ملابسي و النزول معهم في تلك المياه ، و لا أدري كيف عرف والدي بالأمر ؟ كان عائدا من لدن البقال و يحمل بين يديه بضعة أكياس ملح ( كان وزن الكيس كيلو و ثمنه قرش صاغ إن لم تخني الذاكرة ) حين وجدني على الحالة التي وصفتها فشدني من يدي و جررني وراءه و أنا أبكي حتى مدخل البيت ، و عندما رأى أمي شتمها و قذفها بأكياس الملح التي تمزقت فوق رأسها ( كانت أكياس الملح ورقية ) متهما إياها بالإهمال في ملاحظتي ، و يمكنكم أن تتفهموا طبيعة ما حدث في ضوء معرفتكم أني كنت الطفل الوحيد لوالدي فكل ما أنجباه قبلي من أطفال - مع الأسف - لم يقدر لهم الاستمرار في الحياة فكانوا يموتون لأسباب شتى قبل أن يتجاوزوا الخامسة من أعمارهم ، و المشهد الثاني أو الثالث و هو مشهد مأساوي رويته في قصة قصيرة بعنوان " المأساة " نشرتها عام 2007 تقريبا بمجلة القصة التي كان يصدرها نادي القصة ، و خلاصة المشهد الذي ظل محفورا في ذاكرتي بشكل غريب أن جروا صغيرا سقط في لجة من مياه الفيضان لا أدري كيف ، أمن تلقاء نفسه أم بفعل فاعل ؟ و كان الجرو حين رأيته يحاول الوصول إلى حافة اللجة ليخرج و لكن شرذمة من الأطفال الأكبر مني قليلا ( أطفال و لكنهم شريرون ) كانوا يرشقونه بالأحجار و قطع الطوب و الزلط كلما اقترب من الحافة فيغطس في اللجة ثانية ثم يكرر محاولاته للخروج و لكن هيهات فقد ظل الأطفال الأشرار يصوبون قذائفهم إلى رأسه حتى فاضت روحه ، عندئذ فقط تفرقوا و هم يتصايحون و يتضاحكون .
خوف والدي علي من الغرق جعلهما يخوفانني من الماء و النتيجة أني كبرت دون أن أن أتعلم السباحة ، و قد ظللت سنوات طويلة حين أذهب مع زوجتي و أولادي إلى المصيف أكتفي بالجلوس على الشاطئ و قصارى ما كنت أفعله أن أغمس رجلي في مياه المد التي أعرف أنها سرعان ما تنحسر عنها مرة أخرى ، و لكنني رويدا رويدا و شيئا فشيئا بدأت أتجرأ و أنزل إلى الماء ، ثم تجاسرت حتى قدرت أن أقف هناك أو أتمدد على ظهري فوق سطح المياه لبضع دقائق قليلة و أنا ممسك بالحبل الحاجز الذي تبدأ بعده المنطقة التي لا يصلح أمثالي للوجود فيها .
حين انتقلنا من قرية نجع سبع التي ولدت فيها عام 1954 إلى قرية " موشا " و كان ذلك عام 1958 تقريبا أتذكر أن ذلك كان في الصيف ، و قد حملتنا و كل محتويات بيتنا من أثاث و مفروشات و آنية نحاسية و فخارية و ما إلى ذلك سيارة نقل جلس أبي بجوار سائقها و لذت أنا بحضن أمي في الجزء الخلفي من السيارة وراء كابينة القيادة مباشرة ، و أقمنا الليلتين الأوليين بموشا في ضيافة أسرة أحد زملاء والدي بنقطة البوليس ثم انتقلنا إلى بيت الست فهيمة و أتذكر أنها كانت سيدة مسيحية كفيفة تعيش في الدور الارضي قريبا من باب البيت الذي استأجرناه و يأتي إليها بطعامها و شرابها يوميا أولاد ابنها أو بنتها الذين يسكنون في شارع قريب من البيت ، لم نمكث كثيرا في هذا البيت و انتقلنا منه إلى بيت أفضل و أوسع في شارع النقطة ( نقطة البوليس ) ملك رجل يلقب بأبي فهيم و كان رجلا كبيرا في السن و يسكن في الدور الأرضي من البيت وحيدا بعد أن ماتت زوجته و لم يكن له أولاد منها ، حظيت أمي خلال الفترة القصيرة التي سكناها في بيت الست فهيمة بأول صديقة لها في " موشا " هي الست " أم شعبان " و كانت سيدة فقيرة مات زوجها من سنوات و لم يتيسر لها الزواج ثانية ( يطلقون على من في مثل حالتها تلك لقب : هجالة ) ، و كان لها بنت وحيدة زوجتها مبكرا و تعيش في قرية قريبة ، و لما سألتها ذات مرة لماذا تلقب بأم شعبان و أين هو شعبان ؟ أخبرتني أن أول مواليدها كان طفلا أسمته شعبان و لكنه مات صغيرا و اعتاد الناس منذ ذلك الزمان أن ينادوها بأم شعبان ، كانت أم شعبان ترتزق من التردد على البيوت لتبيع احتياجات النساء من الحرد ( و لوازم تفصيل الحردة كالترتر و الخرز و غيره ) و الفلايات و الدبابيس و الكباسين و الإبر و بنسات الشعر و الفازلين و زجاجات الريحة ( العطور ) و ما إلى ذلك و ظلت تلك السيدة تترد على أمي إلى أن انتقلنا عام 1970 إلى مدينة أسيوط و أظن أنها زارتنا في بيتنا بأسيوط عدة مرات قبل أن تقعدها الشيخوخة و المرض ( رحمة الله عليها ) ، و ظل أبي يبحث عن مكان أفضل و المكان الأفضل في عرف الناس في ذلك الوقت هو " بيت من بابه " أي مكان مستقل للسكنى لا يشاركنا فيه أحد كالبيتين السابقين ، و بعد عدة شهور وجد أبي بيتا في حي الشهابية بالطرف الجنوبي من القرية في ذلك الوقت ، كان البيت يتكون من دورين : بالأرضي غرفة مبلطة كان أبي يضع بها بضعة أشولة القمح و زكايب الدقيق مؤونة البيت لمدة 6 أشهر على الأقل و في جانب منها كانت هناك منضدة مستديرة و كرسيان ؛ و قد كانت المنضدة مكان مذاكرتي المفضل أوقات الامتحانات أما في غير ذلك من الأوقات فالمذاكرة على الطبلية ، و خارج الغرفة خلف باب البيت مباشرة تقع باحة البيت الأمامية وكان الجزء الأكبر منها مسقوفا و الجزء الآخر مفتوحا على السماء ، أما خلف الباحة و الغرفة فيقع الجزء الداخلي من البيت الذي يبدأ بالركن الذي يقبع فيه الزير مصدر مياه الشرب و الطبخ و ما إلى ذلك ثم إذا انحرفت يسارا تجد باحة البيت الخلفية حيث تقبع الفرن في المنطقة غير المسقوفة منها أما المنطقة المسقوفة ففيها صومعة تخزن فيها الحبوب و غريفة صغيرة كانت أمي تضع فيها زروية السمن و بلاص الجبنة القديمة و المش كما كان في تلك الغريفة قطرة الأرنبة الوالدة ( القطرة جحر طويل يخص الأرانب ) ؛ و قدرة مليئة بالنخالة ( تسمى النخالة أيضا في القرية باسم آخر هو الدشيش ) كانت أمي تدفن فيها بيض الدجاج الذي تربيه في المساحات خارج الغرف سواء بالدور الأرضي أو الدور الأول.
و في الدور الأول كان هناك غرفتان إحداهما صغيرة و الأخرى كبيرة ( الكبيرةكانت بمثابة غرفة النوم لأسرتنا الصغيرة و في الأيام الأولى لنا بالبيت قامت أمي بتلييس حوائطها بالكامل ، و التلييس هو تغطية الحائط بالطين المخلوط بالتبن ( حطام سيقان القمح أو القش ) فلا تكون هناك أية شقوق مفتوحة يخشى خروج حشرات مؤذية منها كالعقارب و غيرها ) و الصغيرة يدخل إليها من الكبيرة و لكل منهما شبابيك على الشارع الذي يفصل بيننا و بين جيراننا " بيت مهران الخطيب " كان شيخا شحيما لحيما و تختلف عنه زوجته لبيبة فهي نحيفة نحيلة ( جلد على عظم ) يجدها الداخل إلى بيتهم على الداوم تفترش جزة ( فروة كبش ) على " شلتة " و مسندة ظهرها إلى الحائط بجوار الباب الذي كان في أغلب الأوقات مفتوحا على مصراعيه و يتقاسم غرف البيت أسفل و أعلى أولاده الثلاثة : مصطفى و عبد الصبور و فتحي ، خارج الغرفتين صالة تفصل بين الغرفتين و بقية سطح المنزل الذي لم يكن ينقصه سوى السقف ليشكل غرفة كبيرة و لكن صاحب البيت تركه دون سقف و في هذا المكان الذي كانت الشمس تغمره بضوئها و حرارتها صيفا و شتاء كانت أمي تربي بعض الدجاج والبط وأحيانا جديا أو معزة ، أما في الغرفة الصغيرة المسقوفة التي أشرت إليها من قبل فكانت تربي حماما و أرانب .
حين انتقلنا إلى موشا و في الفترة القصيرة التي سكنا في أثنائها ببيت أبو فهيم كان ماء الدميرة " أي الفيضان " بدأ ينحسر و في هذا الوقت بالذات يبدأ الأهالي المزارعون في إصلاح أراضيهم و إعدادها للزراعة فيخرجون بألواح اللوق لتسوية أراضيهم التي ما تزال أوشال المياه المنحسرة راكدة في أجزائها المنخفضة ، و مما تحتفظ به ذاكرتي من تلك الأيام حادثة مقتل " إبراهيم بهنساوي " زين شباب عائلة بهنساوي برصاص عائلة بيت عسقلاني و هما من كبار عائلات القرية و كان بينهما ثأر و دماء لسنوات طويلة ( حتى منتصف الستينيات تقريبا ) إلى أن أفلحت السلطات و رجال المصالحات العائلية و حكماء العائلتين في تسوية و إنهاء ما كان بينهما من مشاكل حتى إنهما فيما أعلم قد ارتبطا بعد ذلك بعلاقات نسب و مصاهرة و انطوت صفحة كئيبة و بغيضة من حياة العائلتين و حياة القرية بالكامل .
و مما تحتفظ به ذاكرتي من تلك الأيام أيضا - و إن كنت غير متأكد من ذلك - أغنية لليلى مراد كانت فيما يبدو من أغنياتها الجديدة في أواخر الخمسينيات لأنها كانت تذاع كثيرا في الراديو لذلك و تتردد على ألسنة الناس و هي : " آنا زي مانا و انت بتتغير " من كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد و تلحين أخيها موسيقار الأغاني الخفيفة و الظريفة منير مراد ، و قريبا منها في الزمن إن لم تخني الذاكرة أغنية : " يا اما القمر على الباب " لفايزة أحمد كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز و تلحين الموسيقار محمد الموجي .
في أشهر الصيف لا يجد الأطفال في القرية سوى اللعب في الشوارع و الأزقة و الحارات لتزجية الوقت حتى تنتهي الإجازة المدرسية فيعود جزء كبير منهم إلى المدرسة ، و لكن أبي في أيام الإجازة كان حريصا على أن يلحقني بالكتاب لأحفظ ما تيسر لي من القرآن الكريم ، في البداية التحقت بكتاب الشيخ شعيب ( كان معي في ذلك الكتاب أطفال مسيحيون يتعلمون القراءة و الكتابة ) و لكن ذلك الكتاب لم يستمر طويلا فألحقني بكتاب الشيخ علي الجبود و كنت يوميا أذهب إلى الكتاب و معي لوحي ( من الصفيح و يكون وقت شرائه جديدا براقا لامعا جدا فلا يثبت عليه الحبر عند الكتابة سواء كانت أداة الكتابة الريشة أو قلم الغاب لذلك كان تعالج تلك المشكلة بأن نسكب عليه كمية من الحبر و نتركه حتى يجف فيغدو بعدها صالحا للكتابة عليه ) و رواد الكتاب منهم تلاميذ بالمدارس و منهم أطفال يلحقهم أهلوهم بالكتاب كي يتأهلوا لدخول المدرسة و منهم من لم يلتحقوا من قبل بالتعليم و التحقوا بالكتاب كي يتأهلوا لدخول الأزهر و هؤلاء هم الفئة التي تحظى بأغلب اهتمام شيخ الكتاب و يبدو أنه كان يحصل على مكافأة نظير كل صبي يتأهل من كتابه لدخول الأزهر ، كل طفل حين يدخل الكتاب صباحا يكتب الشيخ له في لوحه حصته من آيات القرآن ، و إن كان من الصغار الذين لم يدخلوا المدرسة بعد يكتب لهم حصتهم من حروف الأبجدية كل حرف بتشكيلاته الثلاثة الضمة و الكسرة و الفتحة فيظل الطفل الصغير طوال اليوم يقرأ مثلا ( باء فتحة با ، باء ضمة بو ، باء كسرة بي و هكذا ) ، كتاب الشيخ علي الجبود عبارة عن صالة كبيرة تتوسطه بعض دكك للأطفال الصغار الذين يتعلمون مبادئ القراءة و الكتابة و مصطبة بارتفاع نصف متر مفروشة بالحصر ( جمع حصير ) ملاصقة لثلاثة حوائط عدا الحائط التي يفتح فيه الباب و بجواره مصطبة الشيخ التي يجلس عليها و هي أعلى قليلا من مصطبة التلاميذ ، و هناك مدخل من داخل الكتاب يفتح على بيت الشيخ و في بداية المدخل وضع زير المياه الذي يعلوه غطاء خشبي فوقه كوب من الصفيح مربوط بدوبارة طويلة في أحد أرجل الحامل .
كل من رواد الكتاب كبارا و صغارا يقرأ حصته التي حددها له الشيخ من وقت دخوله الكتاب في الصباح حتى موعد الخروج قبل أذان العصر و بيد الشيخ دائما جريدة طويلة يصيب بها دون أن يتحرك من مكانه رأس من يجده توقف عن القراءة أو انشغل بالحديث مع جاره و تتداخل الأصوات في القراءة بشكل كلما أتذكره لا أعرف كيف كان الشيخ يميز الأخطاء في قراءة كل هؤلاء ، و في حالة عدم حفظ أحدهم الحصة المقررة أو إحداث بعض الصغار شغبا شديدا فهنا لا يكون ثمة مفر من التعليق من الرجلين في الفلقة ( و ينطقها بعضهم الفلكة ) التي يحملها من طرفيها صبيان كبيران و ينال المقصر أو المشاغب على بطني قدميه بضع ضربات بعصا قصيرة و صلبة من الجريد و أحيانا يصاحب الضرب تجريسة بالضرورة بين تلاميذ الكتاب و ذلك عندما يكون المعاقب بدون سروال داخلي ، و غير قليل من أطفال و صبيان القرية في ذلك الزمان كانوا هكذا .
***
9 - الصيف في القرى " ب"
لم أكن في الكتاب أحظى باهتمام كبير من الشيخ فهو يعرف أن أبي يرسلني إلى الكتاب لا لحفظ القرآن كله كغيري و لا حتى نصفه بل كان غرضه الأساسي ألا تضيع الإجازة كلها في ما لا جدوى من ورائه من وجهة نظره في اللعب ، و مع ذلك فقد حفظت بضعة أجزاء منه و ما زلت أحفظها ، و في الكتاب فضلا عن حفظي ما تيسر لي من القرآن الكريم استفدت بضع خبرات منها مثلا معرفة الكثير من أحكام التلاوة ، و منها أيضا معرفة كيفية صنع المداد ( الحبر ) السائل في البيت من بودرة الحبر الجاف ، و أن أجعل الحبر السائل غليظ القوام بعض الشيء ليعلق باللوح عند الكتابة عليه و ذلك بإضافة قليل من الصمغ إليه ( كنت أجمع الصمغ في شكل فصوص من شجر السنط و هو كثير بالقرية) ، و لكي لا ينسكب الحبر من الدواة أضع بداخلها قطعة من الإسفنج أو القطن ( تسمى ليقة ) لتمتص الحبر فلا تسمح بانسكابه عندما تميل الدواة ( المحبرة ) على جانبها لسبب أو آخر ، و بالطبع هذا أرخص كثيرا من شراء الحبر السائل في دويان ( جمع دواة ) معلبة ، و بالمناسبة فقد لحقت إبان دراستي الابتدائية المرحلة الأخيرة من استخدام الحبر السائل في الكتابة ، و أدراج التلاميذ ( كانت تسمى تخت بضم ففتح و مفردها تختة ) حين كانت تصنع فمن أهم ما يميزها تلك الفجوة التي تستقر فيها دواة الحبر التي كان التلميذ يغمس فيها ريشته التي يكتب بها في الكراسة أو يملأ منها خزان القلم ( قلم بجلدة أو قلم بكباس ) و بجوار فجوة الدواة كان هناك مجرى طويل محفور قرب حافة التختة ليكون مستقرا للريشة في حالة عدم استخدامها ، و تعلمت أيضا كيف أصنع بنفسي قلم البسط أو قلم البوص أو القصب ( في فقه اللغة للثعالبي نقرأ : كل نبات كانت ساقه أنابيب و كعوبا فهو قصب ) و يصنع هذا النوع من الأقلام من أنابيب نبات الغاب (كعوبه) ، فكنت أقطع رأس الكعب بميل معين بأداة قطع حادة كالسكين و غيرها ثم أشق طرفه الدقيق قليلا ليمتص بعضا من الحبر عندما يغمس في الدواة ، و لكنني كنت أفضل الريشة في الكتابة على لوحي ، و الريشة تتكون من جزئين : جسم الريشة ( في طول قلم الرصاص تقريبا ) الذي تقبض عليه اليد عند الكتابة و جسم الريشة يصنع في الغالب من الخشب و ينتهي في أعلاه بدائرة معدنية صغيرة يثبت فيها سن معدني مشقوق ( يسمى سن الريشة ) و هو الذي يغمس في الدواة عند الرغبة في الكتابة .
كان الطلاب الأساسيون في الكتاب هم أولئك الذين يؤهلهم الشيخ لدخول الأزهر ( معهد فؤاد الأول الديني بمدينة أسيوط ) ، لذلك عندما ينتهي أحدهم من حفظ القرآن كاملا كان أهله يفرحون و يحتفلون بذلك الإنجاز فيرسلون مثلا إلى الشيخ زجاجة شربات و قمعين من السكر و أشياء أخرى لا تمر على الكتاب بل تذهب مباشرة إلى بيت الشيخ و هي غالبا من لحوم الذبائح و الطيور و العيش الشمسي و ما إلى ذلك ، و في أحيان قليلة كان يصيب كل تلميذ في الكتاب من حلوى الفرح بختم القرآن قطعة طوفي أو ملبسة أو مكعب صغير من السكر .
كانت هناك إعانات رسمية للكتاتيب من وزارة الأقاف فيما أعلم و لكنها قليلة لا تكفي ، لذلك فبالإضافة إلى الإعانة يحصل الشيخ من الأهالي إبان مواسم الحصاد المختلفة نصيبا من المحصول ، و صباح الخميس يذهب كل تلميذ إلى الكتاب و معه قرشان صاغ يسلمهما للشيخ عند دخوله و تسمى هذه الجعالة الأسبوعية باسم " الصرافة " ، و يطرد الشيخ التلميذ الذي نسي أن يحضر معه الصرافة في هذا اليوم .
بخلاف التردد اليومي على الكتاب الذي ينتهي كل يوم عند الساعة الواحدة بالنسبة لتلميذ غير أساسي بالكتاب مثلي كنت كشأن الأطفال في كل زمان و مكان أكمل بقية اليوم في اللعب مع أترابي و كثيرة هي ألعاب الأطفال في الريف ، كنا مثلا نجمع أغطية زجاجات الكوكاكولا و زجاجات سيكو الليمون و سيكو البرتقال و عندما يصل العدد إلى 33 غطاء نقوم بثقبها جميعا في المنتصف و ندخل فيها خيط أستك نعقده في نهايته فتصبح الأغطية المنظومة في خيط الأستك كأنها سوار ، حينئذ نضع في وسط سوار الأغطية بكرة خيط خشبية ( كانت الخيوط آنذاك تلف على بكرة من الخشب و ليس الورق كما يحدث الآن ) فيصبح لدينا عجلة و نصنع عجلة أخرى بنفس الطريقة ، و في طرفي قطعة سميكة من الخشب لايزيد طولها عن 40 سم إلا قليلا نثبت العجلتين ، و في وسط تلك القطعة السميكة نثبت قطعة خشب طويلة ( متر و نصف تقريبا ) نستخدمها في تحريك العجلتين ، و إن لم يكن لدينا رغبة في صناعة العجل فيمكننا استخدام الأغطية في لعبة أخرى وتكون بين متنافسين اثنين في الغالب يضع أحدهما غطاء جديدا على الأرض و يحاول اللاعب الآخر عن طريق الضغط على سطح الغطاء الموضوع على الأرض بطرف أحد الأغطية التي تخصه فإذا أسفر الضغط بطريقة معينة عن انقلاب الغطاء على ظهره فإنه يصبح ملكا له ، و إذا فشل في ذلك فعليه أن يضع غطاء من عنده على الأرض ليأتي دور خصمه الذي يجرب حظه في محاولة قلب الغطاء و هكذا ، و الفائز في نهاية اللعبة هو من استطاع كسب أكبر عدد من أغطية خصمه .
ومن ألعاب الطفولة التي أفلتت من عمليات جمع التراث الشعبي على كثرة القائمين به ربما لأنها اختفت منذ فترة زمنية طويلة لعبة تسمى " النكيتة " بكسر و تشديد النون و الكاف و اسم اللعبة من الفعل " نكت " بمعنى غرس أو غرز و اللعبة كانت مرتبطة بانحسار مياه الفيضان حيث تكون الارض لينة بعض الشيء قبل أن تجففها تماما حرارة الشمس فتتشقق ، يجتمع حول قطعة الارض اللينة مجموعة من الأطفال كل منهم في يده قطعة قصيرة صلبة ذات رأس مسنون من الخشب أو الحطب ( سيقان نبات القطن ) و تسمى أداة اللعب أيا كانت خامتها ( الدكم ) بضم الدال و سكون الكاف ( يشبه الأهالي الشخص الربعة متين البنيان بالدكم ) و يرفع الطفل يده بالدكم ثم ينزل بها و قبل الاقتراب من الأرض يفلت من يده الدكم الذي ينغرس في الأرض بمقدار قوة يد الطفل و خبرته في اللعبة و تمتلئ قطعة الأرض الصغيرة بالدكوم أو الأدكم التي انغرزت في الأرض ، و تعاد الكرة بنفس الترتيب الذي بدأت به و إذا نزل دكم أحد اللاعبين فخلع دكما من الأرض للاعب آخر و حل محله يكون الدكم المخلوع من حقه .
ومن الألعاب التي أفلتت أيضا من عمليات جمع الموروث الشعبي لعبة نسيت اسمها و لكنها كانت تلعب بنوى البلح و يسمى نوى البلح في القرية باسم ( الفصا ) و تبدأ اللعبة بأن يكون لكل لاعب في حجره كمية من النوى و تحفر بينهما في الأرض حفرة صغيرة و عميقة بعض الشيء ، يمسك اللعب الأول بنواتين بأصابعه الثلاث الإبهام و السبابة و الإبهام ثم يقربهما من شفتيه فينفث فيهما ثم يلقي بهما في الحفرة فإذا سقطت النواتان داخل الحفرة فله أن يحاول مرة أخرى أما إذا سقطت النواتان خارج الحفرة فهنا يبدأ دور اللاعب الآخر أما إن ظلت إحداهما في قعر الحفرة و قفزت الأخرى إلى خارجها فعلى اللاعب الخصم حينئذ أن يملأ المسافة ما بين النواة خارج الحفرة و الحفرة بنوى من عنده .
و من ألعاب الأطفال و الكبار في القرية لعبة السيجة و لست في حاجة إلى وصفها فهي معروفة لأغلب الناس و هي تشبه في بعض جوانبها لعبة الشطرنج و لكنها أفضل منها و قد وصفها وصفا لا استزادة عندها لمستزيد المفكر القومي عصمت سيف الدولة في الجزء الأول من سيرته الذاتية التي نشرها على جزئين في كتاب الهلال بعنوان " مذكرات قرية ، مشايخ جبل البداري " و ما أثار إعجابي أكثر من وصفه اللعبة تلك الموازنة التي عقدها بين السيجة و الشطرنج و انتصر فيها للسيجة على الشطرنج من خلال رصده عدة فوارق لكل منها دلالته الفكرية و الاجتماعية ، فالسيجة مثلا كل قطعها متساوية في القيمة و في مجال الحركة ؛ لا فضل و لا ميزة لقطعة منها على الأخرى ، بينما قطع الشطرنج تراتبية فهناك الملك و بعده الوزير و الفارس و الطابية و الفيل و أخيرا البيادق ، و امتيازات قطعة الشطرنج في الحركة بحسب مكانتها ، لذلك فلعبة السيجة لعبة ديمقراطية و مران عليها بينما لعبة الشطرنج أرستقراطية و ممارسة لها بحسب تعبيره ، و مما يؤكد ذلك أن قطع اللعب في السيجة من الأحجار أو الطوب الصغير ( يطلق عليها كلاب السيجة ) و تنقر مواقع صف القطع ( العيون ) في التراب و يمارسها لاعبوها و هم يجلسون على الأرض لكن في الشطرنج فإن قطع اللعب تصنع من الخشب الثمين أو من العاج و يجلس لاعبوها على كراسي أو مقاعد مريحة ، و كل القوى في لعبة الشطرنج مسخرة لحماية الملك ( الشاه ) و لا يجوز قتل الملك إلا بعد تحذيره بقول اللاعب ( كش ) و لكن في السيجة القطعة التي تسقط تسقط فداء لقطعة أخرى و الهزيمة هزيمة جماعية ، و يسهب عصمت سيف الدولة في بيان عدم صحة القول بأن السيجة أبسط من الشطرنج و أقل اقتصادا فيما يبذل فيها من جهد ذهني .
و لأن الصيف في القرى يكون دائما مصحوبا بانتشار الحشرات من كل نوع لاسيما الذباب و الناموس و و المن و الهاموش و يكون فيه الهواء ثقيلا و مشبعا بالروائح ( الزخم ) المنبعثة من الزرائب التي لا يخلو بيت منها حيث تربى الحيوانات المختلفة كالجاموس و الأبقار و الغنم و الضأن و الحمير و غيرها و كذلك الطيور الداجنة كالدجاج و الإوز و البط ، و تكون الأرض ملتهبة من شدة الحرارة فالشمس لا تفتأ تصليها بأشعتها الملتهبة طوال النهار فإن الأطفال هم أكثر الفئات اتساخا و تعرضا للأمراض فهم يلعبون في كل مكان ، ربما يلوذون بالأماكن الظليلة أحيانا و لكن في أغلب الأحيان يضطرهم الاندماج في اللعب إلى اللعب تحت أي ظرف فهم لا يأبهون لأية أمور ما عدا لوازم اللعب و مقتضياته ، و قد تميزت عن أترابي في الحي بشيء أساسي بسبب أني طفل وحيد والديه هو أن أمي كانت تحميني ( تسبحني في لغة أهل القرية) مرتين و ربما ثلاثة خلال الأسبوع بينما الأطفال الآخرون لا تحميهم أمهاتهم إلا مرة واحدة في الأسبوع و موعد ذلك هو صباح الجمعة ، و لكنه تميز بضريبة أو بثمن هو تعرض كامل جسدي ثلاث مرات لا مرة واحدة لخشونة ليفة النخل التي كانت تستخدمها أمي في تحميمي و تعرض عيني ثلاث مرات لحرقة الصابون قبل أن تستجيب أمي لتوسلاتي فتسكب الماء على رأسي للتخفيف من معاناتي ، كانت أمي تفعل ذلك مع الضرب ( التسكيع ) أحيانا لأتوقف عن البكاء و كان محل الاستحمام هو الطست ( الطشت ) تضعه قريبا من الكانون أو وابور الجاز الذي تسخن عليه الماء و تخلط الماء الساخن بماء آخر بارد و تزداد الآلام ألما ثالثا عندما تكون كمية الماء الساخن أكثر فأصرخ و أتقافز داخل الطست متوجعا .
عندما كانت تمر عربة الرش التابعة للبلدية لتثبيت التربة و التخفيف قليلا من سخونتها - و هي عبارة عن صهريج كبير مملوء بالمياه و محمول على عجلتين كبيرتين من الخشب يجرها بغل أو حصان أعجف - يجري الأطفال وراء العربة و هم يتصايحون و يضحكون ( أغلبهم حفاة لا بسبب الفقر بل عادة و سلوكا ) و قد شمروا جلابيهم من الأمام ليتلقوا على بطونهم و أرجلهم المياه المندفعة من ثقوب ماسورتي الرش الخلفيتين ، و بالرغم من رغبتي الطفولية العارمة في مشاركتهم هذا الأمر إلا أنني لم أكن أستطيع لأن معنى ذلك التعرض لتجربة التحميم القاسية في الطست مرة رابعة .
نشاط الأطفال الحقيقي بشكل عام نشاط نهاري يقل عندما يأتي الليل و أغلب الأطفال في القرى ينامون بعد تناول وجبة العشاء و قليلا ما كان يسهر الأطفال في ذلك الزمان و إذا سهر بعضهم بجوار الراديو في البيت فمن النادر و يكون ذلك مرتبطا بسماع مادة مشوقة هي في الأغلب تمثيلية كتمثيليات : أدهم الشرقاوي أو عابد المداح أو أيوب و غيرها ، و لم يكن يعرف الأطفال السهر حتى منتصف الليل إلا بعد دخول التليفزيون إلى القرية في الوحدة المجمعة ، و قبل ذلك كنت و بعض أترابي من أطفال الحي نتحلق على الأرض في بقعة الضوء التي يلقيها كلوب المقهى خارج الباب و نتبادل الحكايات التي يختلط في كثير منها الواقع بالخيال ، و تمثل خرافات و أساطير القرى جزءا أساسيا من تلك الحكايات و يستحضر مناخ الليل دائما حكايات العفاريت و الجن و الغيلان ، بعض الأطفال يحكون ما يحكونه عن تلك الكائنات الخيالية وكأنها واقع لا يقبل الجدال بل إن منهم من يؤكد و هو يحكي أنه رأى ذلك بأم عينيه و منهم من يؤكد أن هذا حدث معه شخصيا ، و أتذكر أنه عندما أحدثنا ضجيجا و نحن جلوس أمام المقهى طردنا صاحبها و كان القمر مكتملا فلجأنا إلى جذر نخلة ضخم استخرج من باطن الأرض في أثناء حفرها لبناء جدار ، كان جذر النخلة اشبه بجثة فيل صغير ، اتخذناه متكأ في الليالي المقمرة نمارس و نحن جلوس فوقه - كمجموعة من القردة الصغار - طقوسنا الليلية في تبادل الحكايات ، و عندما أتذكر بعض تلك الحكايات أجد أن بعضا منها عابر لحدود الجغرافيا و الجنسية و بعضها قرأته أو قرأت ما يشبهه ضمن أقاصيص هانز كريستيان أندرسون أو خرافات إيسوب أو أمثولات لافونتين أو حكايات كلية و دمنة ، من الحكايات التي كنا نتداولها و نحن أطفال صغار في القرية حكاية خلاصتها أن ثعبانا كبيرا كان كل ليلة يخرج من جحره ليبحث عن شيء يقتات به و لكن الظلام دامس - هكذا تقول الحكاية – لذلك فهو يخرج من جوفه جوهرة ذات بريق وهاج يبحث على ضوئها عما يقتات به فإذا ما انتهى من ذلك عاد فابتلعها مرة أخرى ، و قد رآه ذات ليلة رجل يركب حصانا و يلبس طربوشا فطمع في الجوهرة و نزل الرجل عن حصانه ثم ألقى بطربوشه فوق الجوهرة فحجب بريقها مما تسبب في موت الثعبان كمدا و حزنا ( نص الحكاية أنه طق مات )على جوهرته ، و قد أثرى الرجل ثراء عريضا عندما باع الجوهرة ، هذه الحكاية سمعتها في الإمارات حين كنت أعمل هناك إبان عقد الثمانينيات من القرن الماضي و إن كنت لا أتذكر بالضبط هل سمعتها من مواطن إماراتي أم من وافد عربي مثلي ؟ و لكنه غير مصري ، الفارق الوحيد بين الحكاية كما سمعتها و أنا طفل في القرية و الحكاية كما سمعتها و أنا شاب في الإمارات أن الرجل لم يكن يلبس طربوشا بل يضع على رأسه عمامة و سائر تفاصيل الحكاية الخيالية كما هي .
***
10 - و مازلنا في الابتدائي
قضيت في مدرستي التي هي أقدم مدرسة ابتدائية بالقرية سنتين بالإضافة إلى السنة التي دخلت فيها مستمعا فقط أي ثلاث سنوات ثم نقلت مع فصلي بالكامل إلى ملحق للمدرسة في نفس المنطقة و لكن على بعد 200 متر تقريبا منها ، و كان الأهالي يسمون ذلك الملحق " مدرسة الجمعية " ربما لأنها كانت فيما يبدو جمعية زراعية قبل تحويلها إلى ملحق للمدرسة ، ما أتذكره أن الفصل الذي وضعنا فيه كان واسعا رحبا على خلاف بقية فصول الملحق و له عدة شبابيك على الشارع الجانبي تدخل منه الشمس و يمرق الهواء كتيار عندما يكون الباب مفتوحا ، و فوق السبورة صورة للرئيس جمال عبد الناصر و على بعد منها صورة مرسومة لطفل يمسك في يده اليمنى بمنديل و أسفل الصورة كتبت هذه الجملة : " المنديل للتلميذ النظيف " ، و كان مدرس التربية الفنية ( الرسم ) في بداية العام الدراسي يكلف أحد التلاميذ بأن يجمع من كل تلميذ بالفصل تعريفة ( خمس مليمات ) و عند الانتهاء من عملية الجمع يعطي المبلغ لزميلين أو ثلاثة من زملائنا لشراء ورق القص و اللزق الملون و ورق الزينة ( الكريشة ) و صمغ و دبابيس و بالونات ( نفاخات ) و غيرها لتجميل الفصل كجزء من النشاط الفني ، و لكني لم أكن أشارك في تلك الأعمال إلا بدفع التعريفة فقط فلم يكن لي حظ البتة من المهارات المطلوبة لفعل ذلك .
و مازلت أحتفظ في ذاكرتي ببعض محفوظات المرحلة الابتدائية ، إليكم مثلا من نشيد " يا ربنا " من مقررات الصف الأول هذا الجزء الصغير : " يا ربنا يا ذا الكرم / يا واهبا كل النعم / هذا أبي ، نعم الأب / و أمنا كم تتعب / باركهما يا ربنا / و احفظهما دوما لنا " و من محفوظات الصف الثاني الابتدائي إليكم هذه الفقرات من نشيد " ما أجمل الضياء " : " تشقشق الطيور / فرحانة بالنور / تقول في سرور / ما أجمل الضياء // و الرجل الكبير و الولد الصغير / يقول في سرور / ما أجمل الضياء // و الحقل و الزهور / و النهر و الغدير / يقول في سرور / ما أجمل الضياء " ، و ما زلت أيضا أتذكر الجملة التي كان يقولها الأرنب المتبطر على طعامه لأمه في درس القراءة " الأرنب الغضبان " و هي : " كل يوم خس وجزر ، كل يوم خس و جزر .. أنا خارج لأبحث عن طعام " ، و أتذكر كذلك عدة جمل من أنشودة كنا نغنيها في حصة الموسيقى بالصف الثاني تقريبا تقول : " قطتي صغيرة و اسمها نميرة / شعرها طويل / و ذيلها قصير / لعبها يسلي / و هي لي كظلي / عندها المهارة / كي تصيد فارة " و قد كنت بالرغم من صغر سني أستسخف تلك الأنشودة و قد ظللت عدة سنوات بعد ذلك لا أفهم ماذا تعني هذه الكتلة من الحروف ( كظلي ) ؟ ، لم أميز في ذلك الوقت كاف التشبيه التي تسبق ( ظلي ) فتعاملت مع ( كظلي ) على أنها كلمة واحدة ، و لا أدري لماذا لم أطلب من المدرس أن يفسرها لي ؟ ، و على أية حال فهذا من عيوب التعليم المزمنة في مدارسنا فما زال الطفل حتى الآن يخشى التصريح لمدرسه أنه لم يفهم الدرس أو بعضه ، و المدرس حتى الآن أيضا يرفض أن يناقشه التلاميذ فيما يقول ، و من محفوظات الصف الثالث كان هناك نشيد بعنوان " الفلاح " أو " يحيا العمل " و منه هذه الفقرات : " احمل الفأس و هيا / نزرع الأرض سويا // سوف أجني بيديا / ثمرا منها شهيا / فاحمل الفأس و هيا // في غد تزهو الحقول / ذاك قمح ذاك فول / كل ما فيها جميل / سوف ينمو و يطول / فاحمل الفأس وهيا " ، و من محفوظات الصف السادس أتذكر نصين لأمير الشعراء أحمد شوقي أحدهما عن العمال يقول في بدايته : " أيها العمال أفنوا العمر كدا و اكتسابا / و اعمروا الأرض فلولا سعيكم كانت خرابا " و آخر رمزي أوله : " برز الثعلب يوما .. في ثياب الواعظينا " .
كنا نحصل على رغيف مصري يوميا كما كنا نحصل على قطعة جبنة مثلثة ( نستو ) و أحيانا قطعة من الجبنة الفلمنك و أحيانا كيس فول سوداني أو قطعة حلاوة طحينية ، و لعدة مرات وزع على كل تلميذ منا في المدرسة علبة سمنة و كيس لبن جاف كبير و على كليهما وضع شعار المعونة الأمريكية ( يدان متصافحتان ) و ذلك بالرغم من تناقض توجهات مصر بعد ثورة 52 مع سياسات الإدارة الأمريكية التي كانت تسعى إلى السيطرة و الهيمنة على المنطقة العربية تطبيقا لسياسة تبنتها أصطلح على تسميتها في الأدبيات السياسية و الصحفية بـ " سياسة ملء الفراغ " و يقصد بالفراغ الحالة التي حدثت في الشرق العربي على وجه التحديد بعد انسحاب بريطانيا عقب هزيمتها في معركة السويس عام 1956 ، و كأن دول تلك المنطقة لا يجوز أن تكون حرة بالكامل من أية سيطرة أو هيمنة استعمارية مباشرة أو غير مباشرة ، و قبل خروجي من البيت صباحا للذهاب إلى المدرسة كان أبي رحمة الله عليه ينفحني تعريفة ( خمسة مليمات ) كمصروف جيب ارتفع إلى قرش صاغ في الصف السادس تقريبا ، و كنت في الغالب أشتري بالتعريفة ثم القرش من البقالة المجاورة للمدرسة إداما ( غموسا ) للرغيف الذي يوزع علينا بالمدرسة ( حلاوة طحينية أو جبنة بيضاء ) فالجبنة النستو المثلثة لم يكن طعمها مستساغا لنا نحن أطفال الأرياف في ذلك الزمان كما ذكرت من قبل ، و أحيانا أشتري بالتعريفة حلاوة عسلية من بياعها بجوار المدرسة ، و كثيرا ما كان بعض الأطفال يأتون في خرائطهم ( الخريطة حقيبة مصنوعة من القماش يضع التلميذ فيها كتبه و كراساته و أدواته الكتابية و يحملها في كتفه ) بكسر من خبز البتاو بسطت عليها مسحة من جبنة قديمة أو جبنة قريش يأكلونها في الفسحة الكبيرة أما التلاميذ الذين تقع بيوتهم بالقرب من المدرسة فهؤلاء محظوظون لأنه يمكنهم الذهاب إلى بيوتهم حيث يأكلون ما أتيح لهم أن يأكلوا ثم يعودون قبل موعد انتهاء الفسحة .
على باب المدرسة كان يجلس دائما العم حسين و هو رجل أسمر نحيف ذو عين كريمة ( تعبير يطلقه الأهالي على من فقد إحدى عينيه لتجنب الإشارة إلى عاهته) يرتزق من إصلاح الأحذية ( إسكافي ، صرماتي ، و بلغة أهل سوهاج : نقاقلي ) و أدواته البسيطة عبارة عن جردل به كمية من المياه و سندان مغروس في الأرض و شاكوش و صندوق خشبي به كمية مسامير صغيرة و قطع جلدية مختلفة الأنواع و الألوان منها قطع من جلود الأبقارأو الجاموس المجففة و سكين حادة يقطع به الجلد و يسويه ، و معظم القرويين كانوا في ذلك الزمان يلبسون الأحذية لغرض أساسي هو حماية أقدامهم من الأذى ( حشرات و زواحف مؤذية كالعقارب و الثعابين أو قطع زجاج مكسور أو أشواك ) و ليس للوجاهة ، لذلك فعندما يحتاج حذاء قروي إلى رقعة فليس من المهم أن تكون من نفس لون الحذاء و إن كان يفضل ذلك ، و تسمى الرقعة إذا كانت في جانب الحذاء من الأمام " لوزة " و تتم خياطة الرقعة بإبرة طويلة تسمى ( المخراز ) و إذا كان الحذاء قد بلي من أسفل فلابد من تركيب نعل له أو نصف نعل بحسب الحاجة و غالبا ما يكون النعل من جلد الجاموس أو البقر لأنه سميك لا يبلى سريعا ، يغمر العم حسين قطعة الجلد الجافة التي تكون أحيانا بشعرها في ماء الجردل حتى تلين ثم يثبتها أسفل الحذاء بالمسامير و يقص الزيادات بمقص كبير و يهذب جوانب النعل بالسكين و في بعض الأحيان يتم تثبيت النعل بالخيط المشمع عن طريق المخراز و لكن لكل من المسامير و الخيط مزاياه و عيوبه ، كنا كأطفال في أثناء الفسحة الكبيرة بعد أن نأكل و يصيبنا الإرهاق من اللعب هنا و هناك حول المدرسة نتحلق أحيانا حول العم حسين ، يتسلى هو بالحديث معنا و هو يعمل في إصلاح الأحذية و المداسات القديمة و نتسلى نحن بالفرجة عليه قبل أن يدعونا جرس المدرسة للعودة إلى الفصول .
كان عدد طلاب فصلي 33 تلميذا تقريبا و ما زلت حتى الآن أتذكر أسماء كثيرين منهم و لكن مع الأسف لا يتواصل أحد منهم الآن معي سوى صديقي عبد الفتاح عبد العليم عبد المطلب ( طبيب تخرج في طب الأزهر هو الآن على المعاش و يقيم بمدينة أسوان ) ، مات أبوه حين كنا بالصف الثالث الابتدائي تقريبا ثم أمه بعد ذلك بسنوات قليلة و لم يكن له من أهل يلوذ بهم سوى جدته المسنة و أخيه حسن الطالب بدار المعلمين ، كان عبد الفتاح من أصدقائي المقربين و يسكن في حارة متفرعة من شارع النقطة ( نقطة البوليس ) و كثيرا ما كنا نذهب كل ليلة في الإجازات إلى الوحدة المجمعة لمشاهدة التليفزيون و كان يمثل لنا في تلك السن الصغيرة متعة بصرية لا حدود لها ثم نعود معا إلى البيت عند منتصف الليل أو قبله بقليل ، كما أنه عندما انتقل فصلنا و نحن في الصف الخامس من ملحق المدرسة إلى المدرسة الأساسية كان عبد الفتاح يشاركني الدرج الذي أجلس عليه و بالرغم من ظروفه الاجتماعية و الاقتصادية المضطربة فقد كان نشيطا و مجتهدا دراسيا و ساعده في اجتهاده تمتعه بذكاء فطري ، و عقب انتهاء سنة الصف الخامس أخذه أخوه و نزحا معا إلى مدينة السويس ليعيشا فيها و لكنهما عادا ثانية إلى القرية بعد حدوث نكسة 1967 .
بدءا من الصف الخامس كان زي التلميذ يتغير فبدلا من المريلة يكون زي التلميذ البنطلون و القميص و يشغل تلاميذ الصف الخامس أول فصل على يمين بوابة المدرسة و يقابله أول فصل على يسار المدخل و يشغله طلاب الصف السادس ، و تغيير زينا المدرسي إلى البنطلون و القميص معناه أننا لم نعد أطفالا ، و تزداد عناية إدارة المدرسة بالصفين الخامس و السادس فيخصص لهم أفضل المدرسين و أكثرهم خبرة فمجال التنافس بين مدارس القرية هو امتحانات القبول ( نهاية المرحلة الابتدائية ) و تلك يتم شحن التلاميذ و تحفيزهم على التفوق فيها بدءا من الصف الخامس ، و كل مدرسة تسعى أن يكون نصيبها من الطلاب المتفوقين في امتحانات القبول أكبر من زميلاتها و من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مواد الامتحانات و هي مواد أربع : اللغة العربية و الحساب و التربية الوطنية و العلوم .
على الرغم من حرصي على التفوق في مواد الدراسة إلا أن إدماني للقراءة الحرة ( خارج المنهج ) لم يتوقف بل تطور حين تعرفت و أنا في السنة السادسة الابتدائية إلى الأدب المترجم البسيط من خلال وقوع بعض الروايات العالمية في يدي و أتذكر منها ماجدولين لألفونس كار ( و لم تكن الترجمة للمنفلوطي ) و راسبوتين لوليم ليكيه و روايتين بوليسيتين إحداهما من سلسلة مغامرت شرلوك هولمز لآرثر كونان دويل و الثانية من سلسلة مغامرات أرسين لوبين لموريس لبلان ، و لأول مرة في حياتي اشتريت ذات يوم من بياع الجرائد قصة من قصص أرسين لوبين و دفعت فيها حينئذ قرشين صاغ تقريبا و كانا بالنسبة لي مبلغا ضخما كلفني مصروف جيب أربعة أيام تخليت فيها عن شراء إدام ( غموس ) لرغيفي و اضطررت لأكله بقطعة الجبنة النستو التي لم أكن أستسيغ طعمها كما سبق أن ذكرت ، كان كل يوم صباحا يأتي في أول أوتوبيس من مدينة أسيوط العم مختار بياع الجرائد ( الأهرام و الأخبار و الجمهورية و بعض المجلات الأسبوعية و الشهرية ) ، كان دائما يلبس جاكتا كاكي فاتح اللون على جلابية و يضح تحت إبطه المطبوعات وسط غلاف كبير من ورق الكرتون ، يمر على المدارس حيث ينتظره بعض المدرسين ممن اعتادوا قراءة الجرائد فيشتري كل منهم ما يفضله منها كما يمر على بعض البيوت في القرية و بعض زبائنه كانوا يشترون منه مجلات أطفال لأولادهم مثل مجلتي سمير و ميكي و مجلات ثقافية عامة مثل الهلال و العربي الكويتية و كانت مجلة ملونة فخمة تزخر بالصور الزاهية الجذابة ، و كان بعض المدرسين يستخدمون صورها في عمل مجلات حائط يزينون بها جدران فصول التلاميذ بالصفين الخامس و السادس على وجه الخصوص .
جاء موعد امتحانات القبول و جمعوا كل طلاب الصف السادس بالمدارس الأربع بالقرية ليمتحنوا في مكان واحد يسع جميع الطلاب في الوحدة المجمعة و كل طالب يجلس بحسب رقم جلوسه ‘ و قد تعرضت في أثناء امتحان إحد ى المواد الأربع لمشكلة فقد سقط قلم الحبر الذي كنت أكتب به و لم يكن معي سواه فأصيب بشرخ تسرب منه الحبر فملأ أصابع يدي اليمنى و لم أستطع التعامل معه في الكتابة خشية أن ينسكب الحبر على ورقة الإجابة فتوقفت متحيرا و تعطلت لمدة تزيد عن ربع الساعة أصابني خلاله توتر شديد حتى أسعفتني تلميذة لا أعرفها كان موقعها أمامي في لجنة الامتحانات ، تفضلت علي بناء على طلب أحد المراقبين فأعطتني قلمها الاحتياطي و قد أديت الامتحان في حالة لا أحسد عليها ، و عدت إلى البيت مع والدي الذي كان ينتظرني خارج اللجنة و قد علم بما حدث معي من أحد زملائي الذين خرجوا قبلي فاكتئب و ظل متوجسا من النتيجة في تلك المادة حتى ظهرت و كانت مشرفة فقد حصلت على الدرجة النهائية في مادتي الحساب و التربية الوطنية و قد حصل مدرسي في المادتين على مكافأة عن ذلك ، و كان ترتيبي الثالث على جميع طلاب القبول بمدارس القرية الاربعة ، و كما كان يأتي عقب نهاية كل سنة العم سيد فراش المدرسة ليسلم أبي شهادة السنة الخضراء جاء هذه المرة ليخبرأبوي بالنتيجة الباهرة و يحصل على حلاوته و كانت هذه المرة أكثر من أي مرة سابقة .
كنا و نحن طلاب في الصفين الخامس و السادس نتطلع إلى اليوم الذي نصبح فيه طلابا بالمدرسة الإعدادية فقد كنا نشاهد طلابها و هم يلعبون كرة القدم في ملعب المدرسة و يتنافسون في مهرجانات الألعاب الرياضية النهارية التي تقيمها المدرسة و في حفلات العروض الفنية المسائية التي يدعى إليها أولياء أمور التلاميذ و أهالي القرية بشكل عام ، و كان كثيرا ما تشد انتباهنا فلاشات الكاميرات التي يصور بها بعضهم أقاربهم المشاركين من التلاميذ في فقرات التمثيل و الغناء على خشبة المسرح ، كان بيتنا قريبا من حي الشهابية الذي نسكن فيها و كنت أحيانا أذهب و أنا طفل صغير مع بعض أترابي لننبش في كومة المهملات الملقاة على بعد من المدرسة فنجد فيها قطعا من الطباشير الملونة و بعض بقايا أقلام الرصاص و ألوان الشمع و الأخشاب و أشياء أخرى نستخدمها في ألعابنا بالحي ، كما كنا في الإجازات نذهب إلى ملعب المدرسة حيث نلعب كرة القدم و كانت كرتنا عبارة عن جورب قديم محشو بكمية من قطع الإسفنج الملفوفة جيدا بالخيوط ( تسمى كورة الشراب ) ، لم يكن يزعجنا و نحن نفعل ذلك إلا الخوف من التعرض لهجمات كلاب عائلة عسقلاني الشرسة فالمدرسة الإعدادية بجوار بيوتهم بل إن المبنى ملكهم و مؤجر للتربية و التعليم ، و أتذكر الآن كيف أن الشدة الأكثر من اللازم في تعامل الآباء مع الأبناء بحجة ضرورة تنشئتهم تنشئة خشنة تؤهلهم لتحمل ظروف الحياة القاسية قد تفضي إلى أمور لا تحمد عقباها ‘ فقد عقرني ذات يوم أحد كلاب عائلة عسقلاني و ظلت آثار أنيابه التي انغرست في باطن ساقي من الخلف تؤلمني عدة أيام و لكني لم أجرؤ على مصارحة أبي و لا حتى أمي بما حدث خشية التعرض لعقابهما على عدم تنفيذ تحذيراتهما بعدم الذهاب ناحية المدرسة الإعدادية ، و لو كان الكلب الذي هاجمني حينذاك مسعورا لما قدر لي أن أكتب هذه السطور و لما قدر لكم أن تقرؤوها الآن .
***