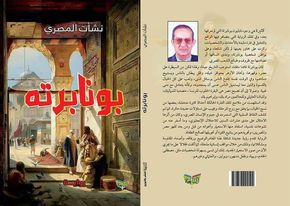يقولُ الشاعرُ في مقدمة كتابه " أحلام الجندي" أن قصائد مجموعته الآنفة الذكر، لا يجمعها التجانس، وأنها لا يكاد يجمعها جامع سوى كاتب القصائد نفسه، وما قرأته في مجموعتيه، كان مغايراً، فقد تشكل عندي بعد الانتهاء من القراءة جسدٌ أنهكته الحرب، جسدٌ معبأٌ بالرصاص ورائحة البارود، في أول قصيدة من ديوانه "قصف" إلى آخر كلمة في ديوانه الآخر " أحلام الجندي"
*****
عرفتُ الشاعرَ الكعبي مقلاً في كتابة الشعر، وتأكدت منه بعد اطلاعي على تجربته، والشعراء المقلون لا يكتبون الرديء من الشعر، إذ تكون القصيدة قطعة من أرواحهم، خلاصة أنين، وتمخض عسير عن عالم متخم بالموت والجثث والأشلاء .
****
لا يمكن أن نغض النظر عن الظروف التي عاشها الشاعر، ففي قصيدته "وظائف الفم" ص١٦ ، في زمن الدكتاتور، كان الفمُ له وظائف محددة، منها الأكل وليس كل الأكل طبعاً ف"بعدما أصبحَ الذئب أدرد حرم أكل الشياه، ومن ثم أختيار الكلمات التي لا تخدش مسامع حارسه الشخصي"فمٌ مقفلات خزائنه وحارسه لا ينام"، إضافة إلى أن القبلة تحتاج إلى أكثر من فم "لصنع قبلة واحدة لابد من فمين" لا وقت للحب في ذلك الزمن، ولا مجال للزوايا، إذ في كل بقعة ثمة مخبر سري، ناهيك عن الجدران ...
****
بماذا يحلمُ الجندي عندما يموت ؟
حقيقة هنا لا يسعني إلا أن أضع القصيدة كاملة، وأترك الجندي يتحدث بنفسه، فهو ليس بحاجة أن أتحدث نيابة عنه
"أحلامُ الجنديِّ القتيل ص٩
مات الجندي
ماتت عيناه وتخَثَّرَ فيهما الضوء
وماتت شفتاه وتوقفتا عن الدعاء
وماتت يداه وتخلتا عن صور أطفاله
وامتدتْ قنطرة جسدِه
بين خوذتِهِ وجزمتيه
وشَرَعَ الدودُ يتسلقه
والغبارُ يلوّن أهدابه
وكفَّ حَسَكُ لحيتِهِ عن النمو
لكنَّ مرآة حلاقته
ما زالت تلتقط الشعاع
كبحيرةٍ بحَجْمِ الدِّرهم
وَسَطَ أَبَدٍ من اللامبالاة
وحملت الريح عطر دمه
فجاء الليل ووخزه بعصاه المدبَّبة
ففتح الجنديُّ القتيل عينيه
ورأى معسكر السماء يتهيَّأ للمعركة
والنجوم فوهات بنادق ساخنة
والظلامَ يتكوَّر في أحشاء خوذته
ثم رأى الرعود تتشاجر
والأمطار تهطل مثل إنزالٍ مظلي
فنطَّ قلبُه إلى الماء كضفدعة مرعوبة.
وأخيراً أقبل الصباح بجناحيه الأبيضين
فهزه من كتفيه
وأخذت الشمس تزرِّر أكمامَه
وطيورُ الطيطوى تنقر الصلواتِ التي تَخْرُج من فمه
وأصابعُه تبحث عن القرص المعدني الذي يحمل اسمه
وخَطَفَتْ ظلالُ جنودٍ مسرعين
فلَمَسَتْ حواشيَ جسدِه
مثل أرديةٍ كهنوتية
سمع نكاتِهم تَتساقط كالتمر اليابس
وحدَّقت عيناه في أصابعه الشبيهة بالأشواك
وهي تحاول أن تستوقفَهُم.
وحين انحدرتْ عربةُ الظهيرة بأجراسها الصفراء
رَشَقَتْهُ آلافُ الدبابيس
فشَعَرَ بثِقَلٍ في أجفانه
ورأى في المنام سُلَّماً من أشعة الشمس
يخترق السماء كنصلٍ فضِّيّ
ورتلاً طويلاً من الجنود
يرتقون درجاته
برؤوس مثقوبة وخطواتٍ مُوَقَّعة
محفوفين بطيور الطيطوى
فقال الجندي القتيل لنفسه
ما أطولَ الطريقَ إلى البيت!
وليس ثمة من شاحنة
أو سيارة إسعاف
ومازالت الحرب ممتدة
بين مسقط الخرطوشة ومسقط الرصاصة
ومازالت القذائف تحفر أنفاقاً
بين نقطة انطلاقها ومحطتها النهائية
حاملة هداياها المشؤومة إلى الأعداء
رغم غيوم البعوض
ومداد المطر
ووحل الظنون.
وهكذا واصَلَ الموت
فرأى ناراً تضيء الأعداء
وهم يأكلون مع الأصدقاء
فقال الجندي القتيل لنفسه
ما لهم يغادرون الخنادق مثل قيامةٍ مفاجئة؟
وبدلَ الشتائم يتبادلون الضباب؟
ما لعيونِهم تشبه حراشفَ السمك؟
ما للنار مستيقظة تحت بيرية الليل؟
وما الذي حوَّل النخيل إلى مداخن؟
ما للشاحنات تطلق الزفرات وهي ترتقي السفوح الزلقة؟
وأين ذَهَبَ الهواء الموبوء بالإشاعات والهوام؟
أين ذهبت الطوابير ذات الخطى المدويّة السائرة فوق مسطرة الفجر؟
أين جحافل البيانات؟ أين أنهار الصهيل؟
أين أفواج القوافي المطهَّمة التي اكتسحت الأعداء وهزَمَتْهم؟
وماذا حلَّ بالأدعية المرفرفة في سماء الخوف؟
أين الدمامل المتبخترة ذات النياشين والأشرطة والشوارب المُمْتَشَقة من أغمادها؟
أين العربات المدلَّاة من رقبة الجبل؟
أين الزمزميات-المباول؟ أين العلب-القَصَعات؟ أين الوسائد-الخوذات؟
أين الدبابات المُسَمَّنة في حظيرة المجد؟
لكنه فوجىء بفصيلِ إعدام يضرم النار في أهرام من الملابس العسكرية
ثم يَنْخسها بالحديد فتتقافز حِمْلانٌ مشوية
كشظايا من ثغاءٍ ودخان.
وما زال القتلى في انتظار الرب
كي يشق بصولجانه
نفقاً من الضياء
ليمر موكبهم المُجَلْجِل
بقرقعة تجهيزاتهم، وبساطيلهم المطيَّنة
إلى حدائق السماء
جيشاً عرمرماً من الجثث المترنحة
فقال الجندي القتيل لنفسه
إذنْ لأنتظرْ قطعةَ اللُبَان الهائلة
التي سينفخها الله في الفضاء
ويضيؤها بألوان الطيف
وهي تحمل رقمي العسكري
وكنيتي وإضبارة ميتاتي القديمة
ولأواصلِ الموت وفياً لشرف الجندية
كالماء المراق في الزمزميات المثقَّبة.
مات الجندي
ماتت عيناه، وماتت شفتاه، وماتت يداه
ولكن أما زالَ الزلزال الذي تحته مؤجلاً؟
وهل سيدوم موته طويلاً؟
هل سيتبخر الماء من الدمع
مخلفاً الملح وحده؟
هل سيتدفأ المقرورون بلهاثهم قرب جثته
بينما تحلق عيناه في حوصلة الطير
وتتأملان الشمس وهي تتدحرج
ككرة الثلج على بساط الرمل؟
أم تراه سيموت ميتاتٍ عديدةً أخرى
قبل أن يستيقظ في النهاية
على بوق التعداد الصباحي؟"
إجابة شافية أليس كذلك؟ لقد استطاع الشاعرُ في هذه القصيدة أن يضع أصابعه في عين الزمن، نعم، لقد مات الجندي-وماتت شفتاه- وكفت لحيته عن النمو- ورأى الظلام يتكور في أحشاء خوذته لكنه بقي يتساءل متعجباً على الرغم من موته -ما أطولَ الطريقَ إلى البيت وليس ثمة من شاحنة أو سيارة إسعاف ! - وعلى الرغم من كل ما يحصل للجندي فهو يظل يواصلِ الموت وفاءً لشرف الجندية، وليس لشرف الجندي فقط إنما لكي يبقى يقظاً لبوق التعداد الصباحي ..
***
أتمنى أن أكون قد قدمت شيئاً بسيطاً لهذه التجربة التي تستحق الكثير من الدراسات والتنقيب الحذر، إنها تجربة مفخخة بالشعر ...
*****
عرفتُ الشاعرَ الكعبي مقلاً في كتابة الشعر، وتأكدت منه بعد اطلاعي على تجربته، والشعراء المقلون لا يكتبون الرديء من الشعر، إذ تكون القصيدة قطعة من أرواحهم، خلاصة أنين، وتمخض عسير عن عالم متخم بالموت والجثث والأشلاء .
****
لا يمكن أن نغض النظر عن الظروف التي عاشها الشاعر، ففي قصيدته "وظائف الفم" ص١٦ ، في زمن الدكتاتور، كان الفمُ له وظائف محددة، منها الأكل وليس كل الأكل طبعاً ف"بعدما أصبحَ الذئب أدرد حرم أكل الشياه، ومن ثم أختيار الكلمات التي لا تخدش مسامع حارسه الشخصي"فمٌ مقفلات خزائنه وحارسه لا ينام"، إضافة إلى أن القبلة تحتاج إلى أكثر من فم "لصنع قبلة واحدة لابد من فمين" لا وقت للحب في ذلك الزمن، ولا مجال للزوايا، إذ في كل بقعة ثمة مخبر سري، ناهيك عن الجدران ...
****
بماذا يحلمُ الجندي عندما يموت ؟
حقيقة هنا لا يسعني إلا أن أضع القصيدة كاملة، وأترك الجندي يتحدث بنفسه، فهو ليس بحاجة أن أتحدث نيابة عنه
"أحلامُ الجنديِّ القتيل ص٩
مات الجندي
ماتت عيناه وتخَثَّرَ فيهما الضوء
وماتت شفتاه وتوقفتا عن الدعاء
وماتت يداه وتخلتا عن صور أطفاله
وامتدتْ قنطرة جسدِه
بين خوذتِهِ وجزمتيه
وشَرَعَ الدودُ يتسلقه
والغبارُ يلوّن أهدابه
وكفَّ حَسَكُ لحيتِهِ عن النمو
لكنَّ مرآة حلاقته
ما زالت تلتقط الشعاع
كبحيرةٍ بحَجْمِ الدِّرهم
وَسَطَ أَبَدٍ من اللامبالاة
وحملت الريح عطر دمه
فجاء الليل ووخزه بعصاه المدبَّبة
ففتح الجنديُّ القتيل عينيه
ورأى معسكر السماء يتهيَّأ للمعركة
والنجوم فوهات بنادق ساخنة
والظلامَ يتكوَّر في أحشاء خوذته
ثم رأى الرعود تتشاجر
والأمطار تهطل مثل إنزالٍ مظلي
فنطَّ قلبُه إلى الماء كضفدعة مرعوبة.
وأخيراً أقبل الصباح بجناحيه الأبيضين
فهزه من كتفيه
وأخذت الشمس تزرِّر أكمامَه
وطيورُ الطيطوى تنقر الصلواتِ التي تَخْرُج من فمه
وأصابعُه تبحث عن القرص المعدني الذي يحمل اسمه
وخَطَفَتْ ظلالُ جنودٍ مسرعين
فلَمَسَتْ حواشيَ جسدِه
مثل أرديةٍ كهنوتية
سمع نكاتِهم تَتساقط كالتمر اليابس
وحدَّقت عيناه في أصابعه الشبيهة بالأشواك
وهي تحاول أن تستوقفَهُم.
وحين انحدرتْ عربةُ الظهيرة بأجراسها الصفراء
رَشَقَتْهُ آلافُ الدبابيس
فشَعَرَ بثِقَلٍ في أجفانه
ورأى في المنام سُلَّماً من أشعة الشمس
يخترق السماء كنصلٍ فضِّيّ
ورتلاً طويلاً من الجنود
يرتقون درجاته
برؤوس مثقوبة وخطواتٍ مُوَقَّعة
محفوفين بطيور الطيطوى
فقال الجندي القتيل لنفسه
ما أطولَ الطريقَ إلى البيت!
وليس ثمة من شاحنة
أو سيارة إسعاف
ومازالت الحرب ممتدة
بين مسقط الخرطوشة ومسقط الرصاصة
ومازالت القذائف تحفر أنفاقاً
بين نقطة انطلاقها ومحطتها النهائية
حاملة هداياها المشؤومة إلى الأعداء
رغم غيوم البعوض
ومداد المطر
ووحل الظنون.
وهكذا واصَلَ الموت
فرأى ناراً تضيء الأعداء
وهم يأكلون مع الأصدقاء
فقال الجندي القتيل لنفسه
ما لهم يغادرون الخنادق مثل قيامةٍ مفاجئة؟
وبدلَ الشتائم يتبادلون الضباب؟
ما لعيونِهم تشبه حراشفَ السمك؟
ما للنار مستيقظة تحت بيرية الليل؟
وما الذي حوَّل النخيل إلى مداخن؟
ما للشاحنات تطلق الزفرات وهي ترتقي السفوح الزلقة؟
وأين ذَهَبَ الهواء الموبوء بالإشاعات والهوام؟
أين ذهبت الطوابير ذات الخطى المدويّة السائرة فوق مسطرة الفجر؟
أين جحافل البيانات؟ أين أنهار الصهيل؟
أين أفواج القوافي المطهَّمة التي اكتسحت الأعداء وهزَمَتْهم؟
وماذا حلَّ بالأدعية المرفرفة في سماء الخوف؟
أين الدمامل المتبخترة ذات النياشين والأشرطة والشوارب المُمْتَشَقة من أغمادها؟
أين العربات المدلَّاة من رقبة الجبل؟
أين الزمزميات-المباول؟ أين العلب-القَصَعات؟ أين الوسائد-الخوذات؟
أين الدبابات المُسَمَّنة في حظيرة المجد؟
لكنه فوجىء بفصيلِ إعدام يضرم النار في أهرام من الملابس العسكرية
ثم يَنْخسها بالحديد فتتقافز حِمْلانٌ مشوية
كشظايا من ثغاءٍ ودخان.
وما زال القتلى في انتظار الرب
كي يشق بصولجانه
نفقاً من الضياء
ليمر موكبهم المُجَلْجِل
بقرقعة تجهيزاتهم، وبساطيلهم المطيَّنة
إلى حدائق السماء
جيشاً عرمرماً من الجثث المترنحة
فقال الجندي القتيل لنفسه
إذنْ لأنتظرْ قطعةَ اللُبَان الهائلة
التي سينفخها الله في الفضاء
ويضيؤها بألوان الطيف
وهي تحمل رقمي العسكري
وكنيتي وإضبارة ميتاتي القديمة
ولأواصلِ الموت وفياً لشرف الجندية
كالماء المراق في الزمزميات المثقَّبة.
مات الجندي
ماتت عيناه، وماتت شفتاه، وماتت يداه
ولكن أما زالَ الزلزال الذي تحته مؤجلاً؟
وهل سيدوم موته طويلاً؟
هل سيتبخر الماء من الدمع
مخلفاً الملح وحده؟
هل سيتدفأ المقرورون بلهاثهم قرب جثته
بينما تحلق عيناه في حوصلة الطير
وتتأملان الشمس وهي تتدحرج
ككرة الثلج على بساط الرمل؟
أم تراه سيموت ميتاتٍ عديدةً أخرى
قبل أن يستيقظ في النهاية
على بوق التعداد الصباحي؟"
إجابة شافية أليس كذلك؟ لقد استطاع الشاعرُ في هذه القصيدة أن يضع أصابعه في عين الزمن، نعم، لقد مات الجندي-وماتت شفتاه- وكفت لحيته عن النمو- ورأى الظلام يتكور في أحشاء خوذته لكنه بقي يتساءل متعجباً على الرغم من موته -ما أطولَ الطريقَ إلى البيت وليس ثمة من شاحنة أو سيارة إسعاف ! - وعلى الرغم من كل ما يحصل للجندي فهو يظل يواصلِ الموت وفاءً لشرف الجندية، وليس لشرف الجندي فقط إنما لكي يبقى يقظاً لبوق التعداد الصباحي ..
***
أتمنى أن أكون قد قدمت شيئاً بسيطاً لهذه التجربة التي تستحق الكثير من الدراسات والتنقيب الحذر، إنها تجربة مفخخة بالشعر ...