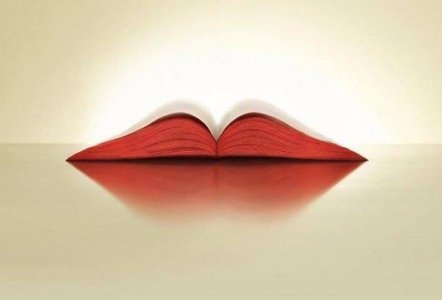1
عندما المكان يتعدد. يختلف. يتفرع. يدور. يستطيل، يصبح مكاناً للسفر. تلك تجربة الجسد مع المكان. هي العين التي ترى المكان. أو الأذن التي تسمعه. وبالحواس نحدد طبيعة المكان. كما بالمعرفة. نفس يعيد نشء الحواس. على الدوام. ولا أعود في ذلك الى مقولات فلسفية. هي الحواس والمكان. قبل كل شيء. وبينهما هذا النفس. من ثم لدينا أمكنة ملقاة خارج مكاننا. بعيداً أو قرىباً. حسب الحواس التي بها نتقدم نحو المكان. الأمكنة. وبها أيضاً أوعز لنفسي ان المكان الذي ليس بمكاني. محتمل ان أطّل عليه. من كلمةٍ. من كتاب. من صورة. ولكن من المحتمل في الوقت. ذاته. ان استنشق هواءه. بحرية. ذات صباح.
يتهيأ أني كنت طيلة أيامي على سفر. العالم كان يتطلب مني ذلك. هو المكان الأول الذي لم يهبني هيئة الاستقرار. كما كانت تبدو لي القاهرة، أو بيروت. أو حتى دمشق. من دون الحديث عن جهات اخرى. لها حضور الأمكنة المعجبة. باريس. لندن. موسكو. نيويورك. طوكيو. هيئة الاستقرار ربما ليست من صفات المغربي الباحث عن المعرفة. كان دائماً يجعل السفر شرطاً للمعرفة. نحو الاندلس أو الشرق. ولكن نموذج القرن التاسع عشر في فاس يوحي لي بالنقيض. حيث أصبحت النخبة الفاشية متوحدة بالمدينة. المطبعة أخذت في طبع الكتب المقررة في جامعة القرويين. وهي نهاية المعرفة.
لم يكن ثمة سؤال عن العالم الخارجي. مكان للمعرفة. مكان مسوّر. سماء تحرس الجنة. وهي فوق المدينة. كما كان المقدسي يعتقد ذلك. ان كانت الجنة فوق الأرض فستكون في أرض فاس. وإن كانت في السماء فستكون سماء فاس. هكذا وضع الخيال للعالم خريطة الدنيا والآخرة. رسم حدود العالم التي أحاط بها نفسه. وفي شبه أنين ألقى بنفسه. حروب تطوان أو وجدة كلها أصبحت تدل على ان هناك ما يهدد. أجنبي يريد الاستيلاء على مدن ومنها الى سائر البلد. تلك قصة مراحل التغلغل الاستعماري في المغرب القرن التاسع عشر.
هذا العالم الخارجي، الغازي، لم يكن مطروحاً كسؤال معرفي. كانت هناك علامات الانفتاح عليه. بأساليب التعليم ولكنها ظلت حبيسة البنية الذهنية التقليدية. والأوضاع المناقضة للانفتاح. وللسفر. خطوات لم تؤصل نموذجاً تحديثياً للمكان. كي تستقر فيه. بل هو مكان يحثك على السفر، خارج أسوار من جير وتراب. لها تاريخ من التدمير، وتاريخ من الدم لا ينسى. بين الزمنين، زمن القرن التاسع عشر وزمني، أعطاني المكان وضعاً متوتراً بأقسى مستويات التوتر. لا وجود لمعرفة إلا بالسفر في الاتجاهين. ما يسافر اليك وما تسافر اليه. أما القاهري فبإمكانه ان يرى عالماً ثقافياً بكامله يولد في حيه، أمام بيته. أو بين أفراد العائلة. وهذا ما لم يكن لك ان تظفر به شاباً يبحث عن معرفة. ما هي المعرفة.
2
على سفر. ولي إحساس كنت أتقاسمه مع أبناء بلاد أخرى في العالم. سفر الثقافة اليك أو سفرك من أجل الثقافة، بالتدقيق، من أجل تحديث الثقافة. ولربما كان من الافضل اختصار حياتي في سفر كهذا الذي هو مصيري. حيث الجغرافيات الثقافية متبدلة. من عهد الى عهد، ومن زمن الى زمن. وذلك الشرق الذي كان وجهة المغربي، المتعلم بالعربية، في سفره من أجل الثقافة. أو ذلك الكتاب الذي كان يصلني من الشرق. هما الآن خارج ما كانا عليه. تبدل الزمن. وأول ما علي ان استوعبه هو الزمن الثقافي الذي به ألج الأزمنة المحايثة، المجاورة.
إن سفري هو الحقيقة والمجاز. في آن. رغبة في التعلم. ربما كان قول كهذا لا يعني ما يفيد عربياً حيث أصبحنا نلاحظ دلالة السفر. نتخلى عن بعدها المعرفي والانطولوجي. سفر يتنكر للسفر. انه يعوض السفر بالامتياز. أو بالخضوع. وهكذا افتقدت شهوة مثل هذا السفر الذي لا يعلمني شيئاً. مناسبات هي الثقافة. ونحن راضون بذلك. بل نتزاحم. حتى لا تضيع منا فرصة الغنيمة. فبأي غنيمة يتناجون وهم يسافرون. لا أفهم. وليس ذلك من شأني. فالسفر عندها يتخلى عن السفر. من اجل المعرفة. وفي المعرفة. هذه المفتوحة على سلم اللانهائي، يصبح باطلاًَ.
ولعلي أحاول ان أنفرد بهذه الخلوة، التي تزيدني تشبثاً بالابتعاد عن المراسيم، كيفما كان نوعها. مراسيم المؤسسة المقتدرة على إلغاء السفر. ومن خلاله على إلغاء الثقافة. سؤال لا يتوانى عن مراجعة المسلمات. وعن إدراك العوائق في رحاب القلق المتزايد أمام الانسان في هذا الزمن. بين اختيارات تكاد تعصف بالنماذج التي تعودنا عليها. لا في النصف الأول من القرن العشرين، بل بهذا النصف الثاني الذي كان عاصفة. أشد تأججاً من عواصف السابق عليها. وهي لا تتأخر في تقويض البدايات كلما اطمأنت النفس أو توهمت أنها تطمئن.
إن هناك ما يغير وجهة سفري، وما يؤكد لي أنني لا أوجد من دون سفر. إنهما معاً يتمازجان وفيهما أظل وفياً للتعلم، حينما أختنق في العموميات. والجمل المضادة للمعنى. والكلام الذي يتكرر رغبة في المحافظة على العادة. سُنة ان نتكلم. بصوت جهوري. نبرة تعلو السماوات. وهي تنشأ في جبة الكلام. هياكل ننشئها لمجرد ان يرتفع الصوت. بالعلم. والحقيقة. والمجد. فيما نحن لا ندري لمن نتوجه بهذا الكلام. ولا نأخذ الزمن كمعيار لما نلهج به بين أقراننا أو بين وافدين علينا ينصتون بخشوع لهذا الصوت الفارع، الممتد في علياء السماوات. التي تدركها أصواتنا المحشوة بالكلمات المبتذلة. اقتناعاً منا أنها هي التي تُرضي الوافدين علينا. وهم في خشوعهم يتكاثرون.
لا أحسن موقعاً كهذا. فكيف لي أن أندم على ذلك، إنني المسفر. سفر يخلصني من الاطمئنان الذي يتسرب احياناً الى النفس. خِفية. من دون همس بأبجدية الاطمئنان. يشتغل رغماً عنا في وسط لا يترجى غير الاطمئنان. والنزول عند رغبة من يتكاثرون في الخشوع. حتى ولو كانوا لا يمثلون ما كان المثقف العربي الحديث يصبو اليه. في نوعية المخاطب. أو في ثورته على ما تعلمه في الكراريس المدرسية التي هي هي، لا تتبدل، نفس الاستشهادات، نفس القصائد، نفس الأقوال. والمجد للصوت يرتفع الى علياء السماوات. يستجمع قوة ان تنصت ولا تسأل عما ننصت اليه، أو ليكن العبث هو ملتقى الكلام. عبث بدون عبث. يؤرق.
3
ولا تناقض بين العزلة المطلوبة في الكتابة وبين السفر من أجل التعلم، تعودنا على خطاطة هذا الترافق بين الكلمتين. في تاريخ ثقافة انسانية، لها صيغ متقاربة في الصين. في الهند. في فارس. في العالم العربي. في أوروبا. في أميركا. وافريقيا. العالم كله اتبع قانون الترافق هذا. ولا نفلت منه. في أي زمن. ولو أن ما نعيشه اليوم يحثنا على إعادة النظر في الوسائل التي علينا بها أن نتقدم في تحقيق ترافق كهذا. هي مسألة ذات أهمية. في الإفادة من الانصات للزمن. ثقافياً. وهو يدعونا إلى المزيد من القلق حتى لا وهن في العظم، بارداً، يتلقى الأسئلة المتجددة.
وعليّ، هنا، أن أوضح قليلاً، عندما أتأمل تاريخ سفري، أسفاري، اكتشف ما يفصلني عن تلك اللحظة الأولى التي أخذت فيها أقرأ. كان القرآن كتاباً مسافراً إلي. وصل إلى المغرب. في العهد الأول للإسلام، مع هذا العهد ابتدأت عملية التعلم. في الجامع. وعند الانتقال إلى المدرسة الابتدائية كانت الكتب المقررة كلها مسافرة إليّ من الشرق. علوم. نصوص. ثم لم يتوقف سفر الكتاب، إليّ، فيما كنت أسافر في هذه الكتب. الجيل الأسبق. في بداية القرن لم يكن الكتاب الذي يقرأه هو بالضرورة كل ما يسافر إليه من خارج المغرب. كانت مؤلفات مغربية تطبع في المطبعة الحجرية بفاس. ومن هذه الكتب استمد المغربي علومه ومعارفه. في القرويين. لكنني أنا عشت زمناً آخر، مختلفاً، فيه أصبح المكان متعدداً. للثقافة. ولكن ما الذي حدث منذ تلك اللحظة الثانية حتى الآن؟ قد يبدو السؤال فاقداً لكل أهمية. مع ذلك أتفرّس فيه. أناوشه. أصب عليه قطرات من عطش الروح. وفي عملية المؤالفة يتبدى لي المكان المتعدد مجسّداً لمصير بكامله، حتى أقول لا وجود لي بدون سفر، مدركاً أن ما أقصده من السفر، على سفر. هو التعلم. في عالم احتاج فيه إلى المزيد من التعلم. انه مُجسّد لمصير بكامله، وبدلالة جديدة.
4
انها دلالة استيعاب الزمن، لا شك، ذلك الموقف من التعلم في بداية القرن بالنسبة الى كل عربي. كان يطرح على ذاته الجماعية: كيف أتعلم. من عالم يكتسب معرفة تفصلني عن زمني، هو الآن موقف معقد بصيغة أكبر. فالتعلم الآن يؤدي الى كيف يمكنني أن أقول كلمتي. أنا. جماعية. بعد أن تعلمت كيف أخرج من زمني القديم من دون أن أحقق ذلك. حتماً. أو في حالتنا المهيمنة، حيث ارتدّ كل شيء على نفسه. وهو يتنكر للمعرفة الحديثة. راغباً عنها. شاحذاً أظافره ليفترس كل ما تعلمناه. لي ان استمر في الانفصال. وهو اختيار التعلم. بالدلالة الجديدة.
هذا هو معنى الزمن الذي يعيد قراءة المكان. الأمكنة. دون كلل، فيما هو يواجه. بضربة واحدة ثقافة المراسيم، وثقافة الارتداد عن التعلم. وضع صعب، ممض. في جميع الاحوال. ولا نجاة من السفر. على سفر. بين حدين يتوازيان ويضيقان. لم تعد القاهرة ولا بيروت مكانين للتعليم. هذا أكيد. والاستمرار في إلغاء السؤال الشخصي مناف لزمن التعلم أيضاً، بينهما تقيم. وكيف تقوم. مسافراً. خارجاً من أزمنة لك ان تنغرس فيها حتى الجذر. راضياً بما تخفيه عنك من مفاجأة الاخطاء. والحوادث، الملازمة لكل سفر. فيها جميعها تبحث عن سؤالك الشخصي. دامياً. مبعثراً. غباراً بين الغبار.
5
بمثل هذا السفر أتعرف على جانب من قلقٍ لا يفارقني، وأنا أنظر الى الجسد. يشيخ. تلك الطاقة القديمة على تحمّل التنقل. والسهر. حتى آخر الليل لم تعد في حوزتي. انها تتضاءل. ولا يبقى غير نَفَس. به أهيّئ الجسد للسفر. في تعلم صعب. يحتد سؤاله. مع مرور الوقت. بسرعة. وأنت تشم رائحة الموت فيك. برودة ما أخذت تسكن العظم. ولا فزع مطلقاً. لكن التعلم اصبح يتعارض مع المراسيم. التي تبعدني عن التعلم. في زمن منه أطل على حياة غريبة. أحاول ان اقترب منها فلا أعثر إلا على القصيدة. نافرة من المعلوم. المسطر في كتاب. على رقعة هيكل عظمي لأنفاس بها أقيس إقامتي في الأمكنة.

عندما المكان يتعدد. يختلف. يتفرع. يدور. يستطيل، يصبح مكاناً للسفر. تلك تجربة الجسد مع المكان. هي العين التي ترى المكان. أو الأذن التي تسمعه. وبالحواس نحدد طبيعة المكان. كما بالمعرفة. نفس يعيد نشء الحواس. على الدوام. ولا أعود في ذلك الى مقولات فلسفية. هي الحواس والمكان. قبل كل شيء. وبينهما هذا النفس. من ثم لدينا أمكنة ملقاة خارج مكاننا. بعيداً أو قرىباً. حسب الحواس التي بها نتقدم نحو المكان. الأمكنة. وبها أيضاً أوعز لنفسي ان المكان الذي ليس بمكاني. محتمل ان أطّل عليه. من كلمةٍ. من كتاب. من صورة. ولكن من المحتمل في الوقت. ذاته. ان استنشق هواءه. بحرية. ذات صباح.
يتهيأ أني كنت طيلة أيامي على سفر. العالم كان يتطلب مني ذلك. هو المكان الأول الذي لم يهبني هيئة الاستقرار. كما كانت تبدو لي القاهرة، أو بيروت. أو حتى دمشق. من دون الحديث عن جهات اخرى. لها حضور الأمكنة المعجبة. باريس. لندن. موسكو. نيويورك. طوكيو. هيئة الاستقرار ربما ليست من صفات المغربي الباحث عن المعرفة. كان دائماً يجعل السفر شرطاً للمعرفة. نحو الاندلس أو الشرق. ولكن نموذج القرن التاسع عشر في فاس يوحي لي بالنقيض. حيث أصبحت النخبة الفاشية متوحدة بالمدينة. المطبعة أخذت في طبع الكتب المقررة في جامعة القرويين. وهي نهاية المعرفة.
لم يكن ثمة سؤال عن العالم الخارجي. مكان للمعرفة. مكان مسوّر. سماء تحرس الجنة. وهي فوق المدينة. كما كان المقدسي يعتقد ذلك. ان كانت الجنة فوق الأرض فستكون في أرض فاس. وإن كانت في السماء فستكون سماء فاس. هكذا وضع الخيال للعالم خريطة الدنيا والآخرة. رسم حدود العالم التي أحاط بها نفسه. وفي شبه أنين ألقى بنفسه. حروب تطوان أو وجدة كلها أصبحت تدل على ان هناك ما يهدد. أجنبي يريد الاستيلاء على مدن ومنها الى سائر البلد. تلك قصة مراحل التغلغل الاستعماري في المغرب القرن التاسع عشر.
هذا العالم الخارجي، الغازي، لم يكن مطروحاً كسؤال معرفي. كانت هناك علامات الانفتاح عليه. بأساليب التعليم ولكنها ظلت حبيسة البنية الذهنية التقليدية. والأوضاع المناقضة للانفتاح. وللسفر. خطوات لم تؤصل نموذجاً تحديثياً للمكان. كي تستقر فيه. بل هو مكان يحثك على السفر، خارج أسوار من جير وتراب. لها تاريخ من التدمير، وتاريخ من الدم لا ينسى. بين الزمنين، زمن القرن التاسع عشر وزمني، أعطاني المكان وضعاً متوتراً بأقسى مستويات التوتر. لا وجود لمعرفة إلا بالسفر في الاتجاهين. ما يسافر اليك وما تسافر اليه. أما القاهري فبإمكانه ان يرى عالماً ثقافياً بكامله يولد في حيه، أمام بيته. أو بين أفراد العائلة. وهذا ما لم يكن لك ان تظفر به شاباً يبحث عن معرفة. ما هي المعرفة.
2
على سفر. ولي إحساس كنت أتقاسمه مع أبناء بلاد أخرى في العالم. سفر الثقافة اليك أو سفرك من أجل الثقافة، بالتدقيق، من أجل تحديث الثقافة. ولربما كان من الافضل اختصار حياتي في سفر كهذا الذي هو مصيري. حيث الجغرافيات الثقافية متبدلة. من عهد الى عهد، ومن زمن الى زمن. وذلك الشرق الذي كان وجهة المغربي، المتعلم بالعربية، في سفره من أجل الثقافة. أو ذلك الكتاب الذي كان يصلني من الشرق. هما الآن خارج ما كانا عليه. تبدل الزمن. وأول ما علي ان استوعبه هو الزمن الثقافي الذي به ألج الأزمنة المحايثة، المجاورة.
إن سفري هو الحقيقة والمجاز. في آن. رغبة في التعلم. ربما كان قول كهذا لا يعني ما يفيد عربياً حيث أصبحنا نلاحظ دلالة السفر. نتخلى عن بعدها المعرفي والانطولوجي. سفر يتنكر للسفر. انه يعوض السفر بالامتياز. أو بالخضوع. وهكذا افتقدت شهوة مثل هذا السفر الذي لا يعلمني شيئاً. مناسبات هي الثقافة. ونحن راضون بذلك. بل نتزاحم. حتى لا تضيع منا فرصة الغنيمة. فبأي غنيمة يتناجون وهم يسافرون. لا أفهم. وليس ذلك من شأني. فالسفر عندها يتخلى عن السفر. من اجل المعرفة. وفي المعرفة. هذه المفتوحة على سلم اللانهائي، يصبح باطلاًَ.
ولعلي أحاول ان أنفرد بهذه الخلوة، التي تزيدني تشبثاً بالابتعاد عن المراسيم، كيفما كان نوعها. مراسيم المؤسسة المقتدرة على إلغاء السفر. ومن خلاله على إلغاء الثقافة. سؤال لا يتوانى عن مراجعة المسلمات. وعن إدراك العوائق في رحاب القلق المتزايد أمام الانسان في هذا الزمن. بين اختيارات تكاد تعصف بالنماذج التي تعودنا عليها. لا في النصف الأول من القرن العشرين، بل بهذا النصف الثاني الذي كان عاصفة. أشد تأججاً من عواصف السابق عليها. وهي لا تتأخر في تقويض البدايات كلما اطمأنت النفس أو توهمت أنها تطمئن.
إن هناك ما يغير وجهة سفري، وما يؤكد لي أنني لا أوجد من دون سفر. إنهما معاً يتمازجان وفيهما أظل وفياً للتعلم، حينما أختنق في العموميات. والجمل المضادة للمعنى. والكلام الذي يتكرر رغبة في المحافظة على العادة. سُنة ان نتكلم. بصوت جهوري. نبرة تعلو السماوات. وهي تنشأ في جبة الكلام. هياكل ننشئها لمجرد ان يرتفع الصوت. بالعلم. والحقيقة. والمجد. فيما نحن لا ندري لمن نتوجه بهذا الكلام. ولا نأخذ الزمن كمعيار لما نلهج به بين أقراننا أو بين وافدين علينا ينصتون بخشوع لهذا الصوت الفارع، الممتد في علياء السماوات. التي تدركها أصواتنا المحشوة بالكلمات المبتذلة. اقتناعاً منا أنها هي التي تُرضي الوافدين علينا. وهم في خشوعهم يتكاثرون.
لا أحسن موقعاً كهذا. فكيف لي أن أندم على ذلك، إنني المسفر. سفر يخلصني من الاطمئنان الذي يتسرب احياناً الى النفس. خِفية. من دون همس بأبجدية الاطمئنان. يشتغل رغماً عنا في وسط لا يترجى غير الاطمئنان. والنزول عند رغبة من يتكاثرون في الخشوع. حتى ولو كانوا لا يمثلون ما كان المثقف العربي الحديث يصبو اليه. في نوعية المخاطب. أو في ثورته على ما تعلمه في الكراريس المدرسية التي هي هي، لا تتبدل، نفس الاستشهادات، نفس القصائد، نفس الأقوال. والمجد للصوت يرتفع الى علياء السماوات. يستجمع قوة ان تنصت ولا تسأل عما ننصت اليه، أو ليكن العبث هو ملتقى الكلام. عبث بدون عبث. يؤرق.
3
ولا تناقض بين العزلة المطلوبة في الكتابة وبين السفر من أجل التعلم، تعودنا على خطاطة هذا الترافق بين الكلمتين. في تاريخ ثقافة انسانية، لها صيغ متقاربة في الصين. في الهند. في فارس. في العالم العربي. في أوروبا. في أميركا. وافريقيا. العالم كله اتبع قانون الترافق هذا. ولا نفلت منه. في أي زمن. ولو أن ما نعيشه اليوم يحثنا على إعادة النظر في الوسائل التي علينا بها أن نتقدم في تحقيق ترافق كهذا. هي مسألة ذات أهمية. في الإفادة من الانصات للزمن. ثقافياً. وهو يدعونا إلى المزيد من القلق حتى لا وهن في العظم، بارداً، يتلقى الأسئلة المتجددة.
وعليّ، هنا، أن أوضح قليلاً، عندما أتأمل تاريخ سفري، أسفاري، اكتشف ما يفصلني عن تلك اللحظة الأولى التي أخذت فيها أقرأ. كان القرآن كتاباً مسافراً إلي. وصل إلى المغرب. في العهد الأول للإسلام، مع هذا العهد ابتدأت عملية التعلم. في الجامع. وعند الانتقال إلى المدرسة الابتدائية كانت الكتب المقررة كلها مسافرة إليّ من الشرق. علوم. نصوص. ثم لم يتوقف سفر الكتاب، إليّ، فيما كنت أسافر في هذه الكتب. الجيل الأسبق. في بداية القرن لم يكن الكتاب الذي يقرأه هو بالضرورة كل ما يسافر إليه من خارج المغرب. كانت مؤلفات مغربية تطبع في المطبعة الحجرية بفاس. ومن هذه الكتب استمد المغربي علومه ومعارفه. في القرويين. لكنني أنا عشت زمناً آخر، مختلفاً، فيه أصبح المكان متعدداً. للثقافة. ولكن ما الذي حدث منذ تلك اللحظة الثانية حتى الآن؟ قد يبدو السؤال فاقداً لكل أهمية. مع ذلك أتفرّس فيه. أناوشه. أصب عليه قطرات من عطش الروح. وفي عملية المؤالفة يتبدى لي المكان المتعدد مجسّداً لمصير بكامله، حتى أقول لا وجود لي بدون سفر، مدركاً أن ما أقصده من السفر، على سفر. هو التعلم. في عالم احتاج فيه إلى المزيد من التعلم. انه مُجسّد لمصير بكامله، وبدلالة جديدة.
4
انها دلالة استيعاب الزمن، لا شك، ذلك الموقف من التعلم في بداية القرن بالنسبة الى كل عربي. كان يطرح على ذاته الجماعية: كيف أتعلم. من عالم يكتسب معرفة تفصلني عن زمني، هو الآن موقف معقد بصيغة أكبر. فالتعلم الآن يؤدي الى كيف يمكنني أن أقول كلمتي. أنا. جماعية. بعد أن تعلمت كيف أخرج من زمني القديم من دون أن أحقق ذلك. حتماً. أو في حالتنا المهيمنة، حيث ارتدّ كل شيء على نفسه. وهو يتنكر للمعرفة الحديثة. راغباً عنها. شاحذاً أظافره ليفترس كل ما تعلمناه. لي ان استمر في الانفصال. وهو اختيار التعلم. بالدلالة الجديدة.
هذا هو معنى الزمن الذي يعيد قراءة المكان. الأمكنة. دون كلل، فيما هو يواجه. بضربة واحدة ثقافة المراسيم، وثقافة الارتداد عن التعلم. وضع صعب، ممض. في جميع الاحوال. ولا نجاة من السفر. على سفر. بين حدين يتوازيان ويضيقان. لم تعد القاهرة ولا بيروت مكانين للتعليم. هذا أكيد. والاستمرار في إلغاء السؤال الشخصي مناف لزمن التعلم أيضاً، بينهما تقيم. وكيف تقوم. مسافراً. خارجاً من أزمنة لك ان تنغرس فيها حتى الجذر. راضياً بما تخفيه عنك من مفاجأة الاخطاء. والحوادث، الملازمة لكل سفر. فيها جميعها تبحث عن سؤالك الشخصي. دامياً. مبعثراً. غباراً بين الغبار.
5
بمثل هذا السفر أتعرف على جانب من قلقٍ لا يفارقني، وأنا أنظر الى الجسد. يشيخ. تلك الطاقة القديمة على تحمّل التنقل. والسهر. حتى آخر الليل لم تعد في حوزتي. انها تتضاءل. ولا يبقى غير نَفَس. به أهيّئ الجسد للسفر. في تعلم صعب. يحتد سؤاله. مع مرور الوقت. بسرعة. وأنت تشم رائحة الموت فيك. برودة ما أخذت تسكن العظم. ولا فزع مطلقاً. لكن التعلم اصبح يتعارض مع المراسيم. التي تبعدني عن التعلم. في زمن منه أطل على حياة غريبة. أحاول ان اقترب منها فلا أعثر إلا على القصيدة. نافرة من المعلوم. المسطر في كتاب. على رقعة هيكل عظمي لأنفاس بها أقيس إقامتي في الأمكنة.