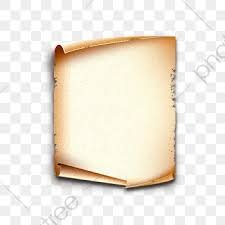حين صدرت روايتي “باردة كأنثى” عن منشورات الاختلاف وضفاف ومكتبة كلّ شيء، كان ذلك بالتّزامن مع روايتي المتوّجة “وصيّة المعتوه، كتاب الموتى ضدّ الأحياء”، لم أكن أفكّر في نشرها، لكنّ الكاتب والصّديق بشير مفتي اتّصل بي، وطلب الرّواية المتوّجة بجائزة الطيّب صالح العالميّة للإبداع الكتابي، ولالتزامٍ مع دار نشر أخرى لم أمنح “وصيّة المعتوه” لعدد من النّاشرين، واقترحتُ عليه “باردة كأنثى”، في الحقيقة هي كانت لديه قبل ذلك بسنوات، لكنّه همّ في نشر رواية أخرى لي هي “ياموندا، ملائكة لافران”، ثمّ اختطفها منه ناشر حكوميّ وأساء لها دون موافقتي ودون عقد بيننا، هكذا تداخلت صدف النّشر، وعوض أن تصدر “باردة كأنثى” روايتي الأولى صدرت الرّواية التي لا تشبه البقيّة “ياموندا، ملائكة لافران” أوّلا، والوصيّة ثانيا ثمّ “باردة كأنثى”.
هكذا كتبتُ روايتي الأولى؟
كنتُ أمرّ بخيبة وجوديّة، وقفتُ على خرابٍ أو توهّمته بما كان بين يديّ آنذاك، كنتُ شابّا في المنتصف الأوّل من العشرين، خرّيج جامعة، أقود مشروعا فاشلا، وتجربة صحفيّة أفشل، ليس بين يديّ غير شهادتي الجامعيّة التي لا تجدي، وتجربة قرائيّة تمتدّ لسنوات، ومعها مخطوطات شعريّة أُعدم أغلبها لاحقاً، كانت الإقامة في العاصمة قاسية؛ لهذا فقد قرّرت الانكفاء والاكتفاء عقب الخيبات والعودة إلى مدينتي الأمّ، إلى مدينة الجلفة التي تنتمي إلى الشّتاء والخريف وتجاملُ قليلا فصلي الصّيف والرّبيع، حملت كتبي القليلة ومخطوطاتي وخيبتي وعدتُ، وقد أزحتُ من ذاكرتي الكثير من الأشياء، بما فيها نصّ كتبته في غابة بحيّ بن عكنون بمدينة الجزائر، هذا النّصّ الذي أطعمتُ البحر بعض أجزائه التي لم ترقني، ورميت ببعضه في مخبئ سريّ في غابة ببن عكنون.
في مدينتي بدأت أتعلّم التعوّد على التيه، أجري بسرعةٍ نحو المجهول كي لا تلاحقني أحلامي، كنتُ فتى مثاليّا، لا أستطيع تسلّق بناءات المشهد الأدبيّ غير المنسجمة، أفقيّا لا أفهم العموديّ، لهذا فقد توقّفت عن كتابة القصيدة العموديّة واتّجهت باكرا إلى التفعيلة، كان هناك صوت يدعوني أن أتمسّك وأواصل مسعى الأدب الذي عشت من أجله وله لسنوات، وكان من حظّي أن وجدت أصدقائي الرّوائيّ عبد القادر برغوث والشّاعر والرّوائيّ الشيخ شعثان في مدينة الجلفة، والرّوائيّة أمينة شيخ عبر التراسل والهاتف في تلك المرحلة، وكانوا قادرين على الإصغاء إلى أحلامي وهذياني، ربّما لم أمنحهم شيئا غير قراءة نصوصي ومناقشتهم، وبناء مواقف أدبيّة من خلال ذلك، فجأة حملتني إلى مدينة الجزائر، التقطتُ أنفاسي ودخلت غابتي أفتّش عن النصّ الذي أهملته لأشهر، لم أعثر عليه كاملا ولا على نصفه، فقط بعض الأوراق التي تحوّلت إلى خرائط من طين وتدفّقت أحرفها من أغلب كلماتها، حملت تلك الأوراق، والتقيتُ أمينة شيخ ذلك اليوم، حكينا قليلا وتألّمنا قليلا وضحكنا ما استطعنا، وحين افترقنا كنت أتمدّد في مقعدين خلفيين في سيارة الأجرة نحو مدينة الجلفة، وكانت هي تمضي إلى بيت أهلها.
في رحلتي تلك عدتُ أحمل بقايا النصّ الذي سأعيد ترميمه في أيّام قليلة، اعتزلت العائلة والأصدقاء وجلستُ إلى الكمبيوتر لأوّل مرّة، ومن يومها لم أكتب على الورق إلا الشّعر، وخلال أيّام قليلة فرغتُ من النّص، وصار مقروءا من قبل مجموعة من الأصدقاء، ثمّ طالهُ الإهمال، وكتبتُ إثره مجموعات شعريّة ورواية “ياموندا، ملائكة لافران” وعدتُ إلى الحياةِ تدريجيّا، ثمّ صرتُ أتصوّرني أفضل وأنا أكتب، ولم أفكّر في النّشر، كان النّشر – وما يزال – أمرا مرعباً بالنّسبة لي، وشاركتُ برواية “باردة كأنثى” في جائزة مالك حداد التي دعمتها أحلام مستغانمي ونظّمتها جمعيّة الاختلاف الجزائريّة، ولم أذكر أنّ لي رواية بعد ذلك، وقد أخبرني بشير مفتي أنّ الجمعيّة ستنشر الرّواية، ولم يكن أفضل منّي فنسيناها، إلى غاية أن حان وقت نشرها، لكن لماذا كتبتُ رواية “باردة كأنثى”؟
لقد كانت الرّواية بمثابة مانيفستو التائه عن الحياة، كانت رؤيتي للعالم، وكُنت أضعُ فيها مسار شابّ جزائريّ اكتوى بنار سنوات القتل والعذاب أو ما صار يعرف بالعشريّة الحمراء، قرأتُ بعض الأعمال التي تناولت عذابات المثقّف والصّحفيّ المستهدف، وكنت أعرفُ أنّ المواطن البسيطَ أكثر رعبا، وأقلّ حيلة، وهو لا يملكُ الأدوات الكافيّة لتفسير ما يدورُ حولهُ، بوسع المثقّف أن يموت وهو يعرفُ شيئا ممّا يُدار حوله، أمّا البسطاء، فقد كانوا يموتون غير مرّة في كلّ مرّة تتحرّك فيها آلة القتل، ورغم أنّنا كنّا نستعدّ لنخرج من عنق الزّجاجة، إلا أنّي كنت واحدا من الذين سقطوا أثناء التدافع للخروج من الزجاجة إلى قاعها البارد، هؤلاء يمثّلون جيلا كاملا أنتمي إليه، نحن الذين عَبَرنا التّاريخُ ولم نعبرُه، تأخّرت طفولتنا وشبابنا، وصرنا مُدانين من الجيل الذي سبقنا كوننا فشلنا والذي لحقنا كوننا نزاحمهُ، مثل طفل في العاشرة نسيه أهله في الحضانة، تأخّر كلّ شيء، ولم تُتح لنا الكثير من الفرص، وحين جاء “الرّئيس القصير” كما تصفه الرّواية جدّد مجدَ جيله وأمعن في إذلال جيلنا، ولم يحتفِ بنا قطّ، إنّنا جيلٌ فتح وعيه على النّار والرّصاص، ولم يتوقّف الأمر إلى غاية مرور سنوات عمرنا الجميلة.
تدور أحداث “باردة كأنثى” بين مدينتي الجلفة والجزائر العاصمة، والبرودة ليست في علاقات الحبّ الفاشلة التي عاشها البطل إدريس نعيم فحسب، بل في المدينتين اللّتين لم تنكّرتا له ولم تمنحانه شيئا من الدّفء، وفي تجمّده وسط عاصفة التّطرّف والإرهاب، وفي مساراته كلّها، هو نموذج لجيلي، لهذا تكون هذه الرّواية أقرب إلى المانيفستو أو الصّرخة بالنّسبة لي.
نشر جيّد مبتور؟
حين نشرت روايتي الأولى “باردة كأنثى” وجدتني في قلب عمليّة طبع سريعة ومتقنة، سريعًا حصلت على الغلاف واطّلعت على النّصّ مُصفّفا، ثمّ استقبلته في معرض الكتاب اللّاحق، وبعدها بسنواتٍ صار مُجرّد ذكرى، تصلني الكثير من الأصداء الجيّدة بخصوصه، لكنّهُ لا يعني شيئا في عالم النّشر، لم يطلب منّي ناشري إعادة طبعه، وهذا يعني أنّه مكتف منه، رغم ذلك سألتقي بالنّاشر والمكتبيّ الفلسطينيّ صالح عباسي صاحب مكتبة كلّ شيء، وسيبدي فرحهُ بالنّص الذي وزّعَ منه خمسمائة نسخةٍ بفلسطين وطلبهُ من منشورات ضفاف بلبنان ولم تستجب له، وسأكتشفُ أنّ طبعةً مزوّرة بغلاف مختلف وزّعت في فلسطين وأخرى في مصر، ولكنّ أهمّ شيء بالنّسبة لي أنّ الرّواية ربطتني بقراء من العالم العربيّ، أغلبهم من الشّباب، كما كتبَ عنها بعض النقّاد والكتاب العرب قبل أن ألتقيهم وأعرفهم، وتناولتها الكثير من الدّراسات الجامعيّة في الماجستير والدّكتوراه وعدد مهمّ من المقالات العلميّة، كلّ هذا يؤكّد لي أنّ نشرها كان جيّدا، لكنّه مبتور، فبعد سنوات لم تعد متوفّرة، ويوجدُ بعض الطّلب عليها، على الأقلّ من خلال الرّسائل التي تصلني، ومن غرائبها أنّها الرّواية الوحيدة من رواياتي التي لم تطبع ثانيّة إلا مقرصنة.
هل هي رواية أولى؟
كلّما قرأتُ مقالات أو دراسات تخصّني إلا ووجدتهم يتكلّمون عن روايتي الثّالثة “باردة كأنثى” وهو في الحقيقة أمر لا يتعارضُ مع مسار طبعها، لكنّهُ يتعارض مع مسار كتابتها، فهي الأولى كتابةً إلى حدّ ما، والثّالثة نشرا، وإذا كان على القارئ أن يطّلع على تجربتي؛ فإنّ قراءة “باردة كأنثى” تسبقُ “وصيّة المعتوه” و”مولى الحيرة” كونها أولى الثلاثيّة غير المعلنة، أمّا البقيّة فتقرأ منفصلة، رغم ذلك فإنّ نصّ “باردة كأنثى” هو النصّ الذي عقد رابطا بيني وبين الحلم، وأعادني إلى الإصرار، ربّما أكون قد فعلت ذلك على ظهر إدريس نعيم الذي حمل عنّي الخراب، ولقد التقطتُ اسمه من تفصيل حصل معي أثناء دراستي الجامعيّة، فإدريس نعيم قد أخذ منّي علامتي في الجامعة، وحمّلته بعض ألمي في الرّواية، كان هذا عندما وجدتني بعلامة أقلّ من علامتي، بينما حظي المجهول إدريس نعيم بعلامة مماثلة لعلامتيْ زميلتيّ في البحث الجامعيّ، وحين فتّشنا لم نعثر على إدريس نعيم الذي لا أثر له في الجامعة ولا في الحياة، كان اختلاقا من ذهن الأستاذ الذي لم يسمع اسمي جيّدا، وعوض أن يذوّنَ إسماعيل يبرير، دوّنَ إدريس نعيم، واستعدت نقطتي من إدريس ولم أفكّر في استعادة ألمي منه، هذا لأنّ الألم يولد في أوطاننا بكثرة.
لقد قلتُ أنّها كانت الرّواية الأولى نوعاً ما، أو إلى حدّ ما، وهذا حقيقة، فقد كتبتُ ما يشبهُ الرّواية في الثّانويّة، نصّ أرفع مستوى من بعض النّصوص التي يُحتفى بها اليوم، ورحتُ أُباهي بها رفاقي، وحين اطّلع عليها أحدهم صرخ بوجهي مستاء، إذ كيف أتجرّأ وأكتبُ رواية في سنّي هذه! وهكذا مزّقتها وأطعمتها النّار حتّى لا يتأذّي الأدبّ وصديقي ذاك.
قبل أشهر ذهبتُ في جولة مع زوجتي الرّوائيّة أمينة شيخ وأطفالي إلى غابة بن عكنون بمدينة الجزائر العاصمة، وقد صارت بعد تلك السّنوات حديقة ترتادها العائلات، ولعب أطفالي فوق الرّكن السريّ الذي ضمّني واستضاف جنوني وهوسي، وعرف روايتي الأولى ونشوتي الأولى.

 samaward.net
samaward.net
هكذا كتبتُ روايتي الأولى؟
كنتُ أمرّ بخيبة وجوديّة، وقفتُ على خرابٍ أو توهّمته بما كان بين يديّ آنذاك، كنتُ شابّا في المنتصف الأوّل من العشرين، خرّيج جامعة، أقود مشروعا فاشلا، وتجربة صحفيّة أفشل، ليس بين يديّ غير شهادتي الجامعيّة التي لا تجدي، وتجربة قرائيّة تمتدّ لسنوات، ومعها مخطوطات شعريّة أُعدم أغلبها لاحقاً، كانت الإقامة في العاصمة قاسية؛ لهذا فقد قرّرت الانكفاء والاكتفاء عقب الخيبات والعودة إلى مدينتي الأمّ، إلى مدينة الجلفة التي تنتمي إلى الشّتاء والخريف وتجاملُ قليلا فصلي الصّيف والرّبيع، حملت كتبي القليلة ومخطوطاتي وخيبتي وعدتُ، وقد أزحتُ من ذاكرتي الكثير من الأشياء، بما فيها نصّ كتبته في غابة بحيّ بن عكنون بمدينة الجزائر، هذا النّصّ الذي أطعمتُ البحر بعض أجزائه التي لم ترقني، ورميت ببعضه في مخبئ سريّ في غابة ببن عكنون.
في مدينتي بدأت أتعلّم التعوّد على التيه، أجري بسرعةٍ نحو المجهول كي لا تلاحقني أحلامي، كنتُ فتى مثاليّا، لا أستطيع تسلّق بناءات المشهد الأدبيّ غير المنسجمة، أفقيّا لا أفهم العموديّ، لهذا فقد توقّفت عن كتابة القصيدة العموديّة واتّجهت باكرا إلى التفعيلة، كان هناك صوت يدعوني أن أتمسّك وأواصل مسعى الأدب الذي عشت من أجله وله لسنوات، وكان من حظّي أن وجدت أصدقائي الرّوائيّ عبد القادر برغوث والشّاعر والرّوائيّ الشيخ شعثان في مدينة الجلفة، والرّوائيّة أمينة شيخ عبر التراسل والهاتف في تلك المرحلة، وكانوا قادرين على الإصغاء إلى أحلامي وهذياني، ربّما لم أمنحهم شيئا غير قراءة نصوصي ومناقشتهم، وبناء مواقف أدبيّة من خلال ذلك، فجأة حملتني إلى مدينة الجزائر، التقطتُ أنفاسي ودخلت غابتي أفتّش عن النصّ الذي أهملته لأشهر، لم أعثر عليه كاملا ولا على نصفه، فقط بعض الأوراق التي تحوّلت إلى خرائط من طين وتدفّقت أحرفها من أغلب كلماتها، حملت تلك الأوراق، والتقيتُ أمينة شيخ ذلك اليوم، حكينا قليلا وتألّمنا قليلا وضحكنا ما استطعنا، وحين افترقنا كنت أتمدّد في مقعدين خلفيين في سيارة الأجرة نحو مدينة الجلفة، وكانت هي تمضي إلى بيت أهلها.
في رحلتي تلك عدتُ أحمل بقايا النصّ الذي سأعيد ترميمه في أيّام قليلة، اعتزلت العائلة والأصدقاء وجلستُ إلى الكمبيوتر لأوّل مرّة، ومن يومها لم أكتب على الورق إلا الشّعر، وخلال أيّام قليلة فرغتُ من النّص، وصار مقروءا من قبل مجموعة من الأصدقاء، ثمّ طالهُ الإهمال، وكتبتُ إثره مجموعات شعريّة ورواية “ياموندا، ملائكة لافران” وعدتُ إلى الحياةِ تدريجيّا، ثمّ صرتُ أتصوّرني أفضل وأنا أكتب، ولم أفكّر في النّشر، كان النّشر – وما يزال – أمرا مرعباً بالنّسبة لي، وشاركتُ برواية “باردة كأنثى” في جائزة مالك حداد التي دعمتها أحلام مستغانمي ونظّمتها جمعيّة الاختلاف الجزائريّة، ولم أذكر أنّ لي رواية بعد ذلك، وقد أخبرني بشير مفتي أنّ الجمعيّة ستنشر الرّواية، ولم يكن أفضل منّي فنسيناها، إلى غاية أن حان وقت نشرها، لكن لماذا كتبتُ رواية “باردة كأنثى”؟
لقد كانت الرّواية بمثابة مانيفستو التائه عن الحياة، كانت رؤيتي للعالم، وكُنت أضعُ فيها مسار شابّ جزائريّ اكتوى بنار سنوات القتل والعذاب أو ما صار يعرف بالعشريّة الحمراء، قرأتُ بعض الأعمال التي تناولت عذابات المثقّف والصّحفيّ المستهدف، وكنت أعرفُ أنّ المواطن البسيطَ أكثر رعبا، وأقلّ حيلة، وهو لا يملكُ الأدوات الكافيّة لتفسير ما يدورُ حولهُ، بوسع المثقّف أن يموت وهو يعرفُ شيئا ممّا يُدار حوله، أمّا البسطاء، فقد كانوا يموتون غير مرّة في كلّ مرّة تتحرّك فيها آلة القتل، ورغم أنّنا كنّا نستعدّ لنخرج من عنق الزّجاجة، إلا أنّي كنت واحدا من الذين سقطوا أثناء التدافع للخروج من الزجاجة إلى قاعها البارد، هؤلاء يمثّلون جيلا كاملا أنتمي إليه، نحن الذين عَبَرنا التّاريخُ ولم نعبرُه، تأخّرت طفولتنا وشبابنا، وصرنا مُدانين من الجيل الذي سبقنا كوننا فشلنا والذي لحقنا كوننا نزاحمهُ، مثل طفل في العاشرة نسيه أهله في الحضانة، تأخّر كلّ شيء، ولم تُتح لنا الكثير من الفرص، وحين جاء “الرّئيس القصير” كما تصفه الرّواية جدّد مجدَ جيله وأمعن في إذلال جيلنا، ولم يحتفِ بنا قطّ، إنّنا جيلٌ فتح وعيه على النّار والرّصاص، ولم يتوقّف الأمر إلى غاية مرور سنوات عمرنا الجميلة.
تدور أحداث “باردة كأنثى” بين مدينتي الجلفة والجزائر العاصمة، والبرودة ليست في علاقات الحبّ الفاشلة التي عاشها البطل إدريس نعيم فحسب، بل في المدينتين اللّتين لم تنكّرتا له ولم تمنحانه شيئا من الدّفء، وفي تجمّده وسط عاصفة التّطرّف والإرهاب، وفي مساراته كلّها، هو نموذج لجيلي، لهذا تكون هذه الرّواية أقرب إلى المانيفستو أو الصّرخة بالنّسبة لي.
نشر جيّد مبتور؟
حين نشرت روايتي الأولى “باردة كأنثى” وجدتني في قلب عمليّة طبع سريعة ومتقنة، سريعًا حصلت على الغلاف واطّلعت على النّصّ مُصفّفا، ثمّ استقبلته في معرض الكتاب اللّاحق، وبعدها بسنواتٍ صار مُجرّد ذكرى، تصلني الكثير من الأصداء الجيّدة بخصوصه، لكنّهُ لا يعني شيئا في عالم النّشر، لم يطلب منّي ناشري إعادة طبعه، وهذا يعني أنّه مكتف منه، رغم ذلك سألتقي بالنّاشر والمكتبيّ الفلسطينيّ صالح عباسي صاحب مكتبة كلّ شيء، وسيبدي فرحهُ بالنّص الذي وزّعَ منه خمسمائة نسخةٍ بفلسطين وطلبهُ من منشورات ضفاف بلبنان ولم تستجب له، وسأكتشفُ أنّ طبعةً مزوّرة بغلاف مختلف وزّعت في فلسطين وأخرى في مصر، ولكنّ أهمّ شيء بالنّسبة لي أنّ الرّواية ربطتني بقراء من العالم العربيّ، أغلبهم من الشّباب، كما كتبَ عنها بعض النقّاد والكتاب العرب قبل أن ألتقيهم وأعرفهم، وتناولتها الكثير من الدّراسات الجامعيّة في الماجستير والدّكتوراه وعدد مهمّ من المقالات العلميّة، كلّ هذا يؤكّد لي أنّ نشرها كان جيّدا، لكنّه مبتور، فبعد سنوات لم تعد متوفّرة، ويوجدُ بعض الطّلب عليها، على الأقلّ من خلال الرّسائل التي تصلني، ومن غرائبها أنّها الرّواية الوحيدة من رواياتي التي لم تطبع ثانيّة إلا مقرصنة.
هل هي رواية أولى؟
كلّما قرأتُ مقالات أو دراسات تخصّني إلا ووجدتهم يتكلّمون عن روايتي الثّالثة “باردة كأنثى” وهو في الحقيقة أمر لا يتعارضُ مع مسار طبعها، لكنّهُ يتعارض مع مسار كتابتها، فهي الأولى كتابةً إلى حدّ ما، والثّالثة نشرا، وإذا كان على القارئ أن يطّلع على تجربتي؛ فإنّ قراءة “باردة كأنثى” تسبقُ “وصيّة المعتوه” و”مولى الحيرة” كونها أولى الثلاثيّة غير المعلنة، أمّا البقيّة فتقرأ منفصلة، رغم ذلك فإنّ نصّ “باردة كأنثى” هو النصّ الذي عقد رابطا بيني وبين الحلم، وأعادني إلى الإصرار، ربّما أكون قد فعلت ذلك على ظهر إدريس نعيم الذي حمل عنّي الخراب، ولقد التقطتُ اسمه من تفصيل حصل معي أثناء دراستي الجامعيّة، فإدريس نعيم قد أخذ منّي علامتي في الجامعة، وحمّلته بعض ألمي في الرّواية، كان هذا عندما وجدتني بعلامة أقلّ من علامتي، بينما حظي المجهول إدريس نعيم بعلامة مماثلة لعلامتيْ زميلتيّ في البحث الجامعيّ، وحين فتّشنا لم نعثر على إدريس نعيم الذي لا أثر له في الجامعة ولا في الحياة، كان اختلاقا من ذهن الأستاذ الذي لم يسمع اسمي جيّدا، وعوض أن يذوّنَ إسماعيل يبرير، دوّنَ إدريس نعيم، واستعدت نقطتي من إدريس ولم أفكّر في استعادة ألمي منه، هذا لأنّ الألم يولد في أوطاننا بكثرة.
لقد قلتُ أنّها كانت الرّواية الأولى نوعاً ما، أو إلى حدّ ما، وهذا حقيقة، فقد كتبتُ ما يشبهُ الرّواية في الثّانويّة، نصّ أرفع مستوى من بعض النّصوص التي يُحتفى بها اليوم، ورحتُ أُباهي بها رفاقي، وحين اطّلع عليها أحدهم صرخ بوجهي مستاء، إذ كيف أتجرّأ وأكتبُ رواية في سنّي هذه! وهكذا مزّقتها وأطعمتها النّار حتّى لا يتأذّي الأدبّ وصديقي ذاك.
قبل أشهر ذهبتُ في جولة مع زوجتي الرّوائيّة أمينة شيخ وأطفالي إلى غابة بن عكنون بمدينة الجزائر العاصمة، وقد صارت بعد تلك السّنوات حديقة ترتادها العائلات، ولعب أطفالي فوق الرّكن السريّ الذي ضمّني واستضاف جنوني وهوسي، وعرف روايتي الأولى ونشوتي الأولى.

حين صارت الرّواية الأولى ثالثةً.."باردة كأنثى" مانيفستو التّيه – مجلة سماورد
إسماعيل يبرير – الجزائر:حين صدرت روايتي "باردة كأنثى" عن منشورات الاختلاف وضفاف ومكتبة كلّ شيء، كان ذلك بالتّزامن مع روايتي المتوّجة "وصيّة المعتوه، كتاب الموتى ضدّ الأحياء"، لم أكن أفكّر في نشرها، لكنّ الكاتب والصّديق بشير مفتي اتّصل بي، وطلب الرّواية المتوّجة بجائزة الطيّب صالح العالميّة...
 samaward.net
samaward.net