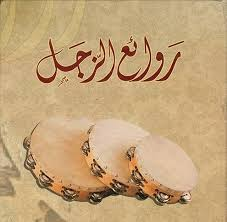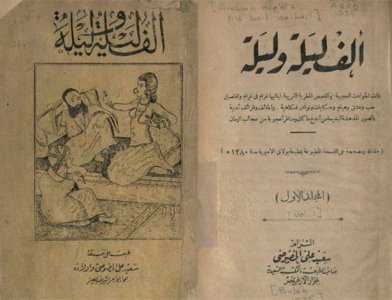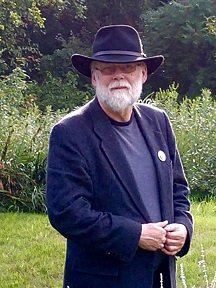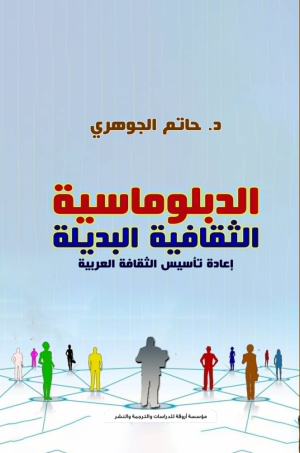في كتابنا الأول (جرح الذات وعنف الموضوع في القصيدة الزجلية المغربية المعاصرة) ؛ .تكلمنا عن أشكال الصرخات المبحوحة؛ التي جعلت من الذات الجريحة ؛ أهم خاصية في محور كل تجليات الكتابة الزجلية المعاصرة ؛ فأنتجت لنا موضوعا عنيفا حًٓوَّلٓ القبح جمالا مغشوشا؛ أو ماكرا؛ لأن أساس الحكاية الزجلية هي الخروج أو الهروب من الواقع؛ لإعادة صياغته برؤية يراها الزجال مخرجا مقبولا في تبنيه كل ما وجده قربه مسعفا فحوّٓله حسب الظن الذي يهمه. مرة نجده يعاتب عقله لأنه كان سبب شقائه؛و مرة أخرى يحاسبه لأنه هو الذي أدخله في كل مسالك الحياة؛ الصعبة فجاءت الحسابات مغلوطة؛ و مرة ثالثة كان. سبب تعبه وشقائه؛ لهذا لم يعد يرغب أن يتجاوب مع هذا العقل؛ هذا ما وجدناه عند حنيف نورالدين يقول:
ياك اعقلي..
هو عتاب صريح؛ ومرة أخرى وجدنا احميدة بلبالي يناديه صراحة عندما قال له:
بسلامة عليك اعقلي..
وهي دعوة صريحة لاستغناء الشاعر عن عقله. لم تتوقف الحكاية هنا بل زادت رائحتها في التسرب عندما ذهب بعض الزجالين الى نفي وجودهم وعدم الاعتراف به؛ منهم الشدادي عزالدين الذي سمى ديوانه الأول ب :
موحال انكون انا..
وهي صرخة صريحة بنفي نهائي لتجليات الذات في واقع لا تعترف به اساسا. ثم احمد لمسيح الذي وصل به الحد( ان توحش راسو)؛ وهي خاصية تحدد لنا طبيعة الغربة التي يعيشها الانسان الشاعر الذي اختار الزجل شكلا تعبيريا ؛ به يحدد طبيعة علاقته بذاته؛ بمحيطه وبالآخرين؛ الذين يعيشون قربه؛ منهم من وضع لنفسه قبرا كمكان يعيش فيه؛ عبدالمجيد الباهيلي الذي ربط القصيدة بالموت في ديوانه (حبيق الموت؛) وامغار مسناوي الذي نسي ذاته فعاد مطالبا بتذكرها في ديوانه (خلوني نتذكرتي؛)؛. هذه الكتابات المختلفة برؤى متفاوتة؛ كلها تبحث لنفسها عن مخرج تراه ملائما لرغباتها وتطلعاتها. هذا على المستوى الفلسفي وعلاقة الشاعر بذاته وبوجوده؛ أما على مستوى بحث عن متنفس؛ فيه يدمج ذاته؛ وبها يعيد النظر في كل المحتويات التي يتنفسها ويستنشقها ؛ على أساس أنها المخرج من مجال المتاهة ليلبس ثوب اللامعقول وجد الزجال في رحلة الكناوي متعة تتجاوب وطبيعة نظرته الى ما يجده قربه ليصبح استعارة يتنفسها ويتعايش فيها؛ فيصبح هو نفسه الذات الاخرى التي تتقارب مع ذاته؛ إلى درجة ان استنكر ذاته ولبس ذاتا أخرى؛ ذاك ما وجدناه في تناص نفسي ووجودي وفلسفي وفني؛ فوجد المبدع نفسه منصهرا؛ بشكل لا إرادي؛ في تواصل عميق مع نصوص أخرى؛ منها ماحدث بين النص الزجلي والفن الكناوي؛ هنا وجد الزجال ضالته؛ وهناك تحول همه ليصبح المكنوي المتعب المرهق والمعذب. هذا ماسنراه في قصيدة جاءنا بها محمد الحبيب العسالي في اختياراته الواعية؛ ليصبح صوتا زجليا يبحث عن مخارج ومتنفسات فنية؛ تجعله مؤهلا ان يكتب القصيدة من داخل معاناة الإنسان الأسود الذي عانق السنتير؛ ليحمل من كتاباته مشعلا فلسفيا داخل العمق الزجلي المغربي المعاصر. وقوقنا عند قصيدة العسالي ستكون بهدفين:
الأول لنبين ان استعارات الألم من الفن الكناوي ليست محصورة على مجموعة من الزجالة؛ منهم شعراء الاتحاد المغربي للزجل ؛ الذين ساهموا في إنتاج ديوان جماعي سموه(دردبة على محلات الكتبة). بل هي إشكال حاضر عند مجموعة كبيرة من شعراء الزجل؛ و العسالي أحدهم.
الهدف الثاني. سنسعى للبحث في التميز بين هؤلاء الشعراء لمعرفة أشكال الإختلاف والتنوع في نفس الموضوع ؛ الذي اشتغل فيه شعراء مختلفون. السؤال المحوري هنا كيف تحول الزجال محمد الحبيب العسالي الى فنان مكنوي؛ لبس حمق العبد؛ صفق بقراقب ليام وبسنير لعمر؛ يجتر رائحة العشق الأبدي لسراب زمن هارب من ذاكرة مجروحة؛ كلها سلاسل من نار؛ وسوط ترك وشمه على جسد منخور؛ رفض الظلم؛ وصاح بصوت هائج؛ يكلم. فراق الاحبة والوطن؛ ليصبح أسير إنسان ابيض قاهر ومستغل؟ كما سنطرح معه سؤالا إشكاليا يناقش قيمة الألم كفلسفة في الكتابة تتقاسمها الانفس فتتحول من حقل إلى حقل آخر؛ وكان للزجل نصيبا آمن به الزجال؛ فجعله يركب شراع الفن الكناوي عامة وطقوسه بشكل خاص؟.. اسئلة سنبحث في محتواها من خلال قصيدة :
........اشفع يا ڭـواد.....
عنوان يتميز بخاصيتين:
خاصية الشفاعة وخاصية الكواد.
الشفاعة هي طلب و ترجي؛ مرفوقة بالرحمة؛ وكأن الذات هنا تتقرب اكثر من شخص آخر مترجية منه ان يكون رحيما بها . والكواد هو من يسوق القافلة؛ هو القائد بشكل عام؛ الذي آسندت إليه مهمة القيادة. فنصبح امام معطين يعيشهما قطبان في درجات متفاوتة من الهرم الاجتماعي؛ طبعا على المستوى السوسيوثقافي . قطب القوة التي تميز القائد؛ بصفته جبارا؛ مادام يطلب منه الشفاعة والرحمة؛ وقطب الضعف التي تدل عليه الذات المنهكة؛ التي تخاطب القوي بأن يكون شفيعا و رحيما بها . فنجد انفسنا امام برنامجين من المنظور السيميائي:
البرنامح اول : فيه نجد الذات المتكلمة في حالة ضعف.
والبرنامج الثاني نجد فيه المخاطب بصفته القائد في حالة قوة.
فتتحدد لنا اول ثنائية أساسها مبني على التضاد والتناقض : القوة والضعف.؛ التبعية والقيادة؛ الانا والاخر؛ هي كلها عناصر تشكل الدلالة من خلال عنوان قصيدة الحبيب العسالي؛ بصفتها تشكل عتبة اولى؛ تتلازم في ثنائية العلاقات الازدراجية؛ التي تتحكم فيها إثنانيات متماسكة ومترابطة؛ سواء على مستوى القصيدة؛ او من خلال بناء تشكلاتها في الهرم الطبقي الاجتماعي المتناحر؛ مما جعل منها عنوانا محوريا لقصديته الماتلة امامنا. فتبدأ معالم هذه القيادة بسنات معجمية واضحة:
حراااام حزام اللجام ادمانا
اللجام هنا هو الاداة التي يكبل بها الشخص المقيود؛ فجعل من التبعية تشبه الشكل الذي به يكبل الحيوان؛ هكذا لم يفرق الكائن بين الكائن البشري المكبل باللجام بحيوان سائب غير نطيع لصاحبه؛ زاد من عمق هذه الاهانة؛ كما عمق موضوع الالم عندما قال (ادمانا) ؛ فيصبح الألم محددا بشملين من الاساليب:
اسلوب مادي: الاثر/ادمانا.
واسلوب نفسي: الوقع والجرح الداخلي.
مكتفيا بإدانة وصرخة ذات بعد أخلاقي واجتماعي؛ بل ديني أحيانا؛ ذلك ما نلمسه عندما قال:
احرااام.
هذه الأخيرة جاءت مرفقة بثلاثة الفات؛ تعني. صرخة طويلة الصوت؛ والعبد غالبا ماكان يخفي آلمه وعذابه؛ فحكم عليه حتى في ألمه ان يبقى أسير نفسه بصوت غير مسموع؛ أما صرخة الشاعر فهي احتجاج على الألم الداخلي الذي حكم عليه في عصر العبيد أن يبقى مقموعا ومحكوما عليه ان يعيشه وحده بلا كلام ولا صوت. .
على ڭـد شوفتو ڭـوادنا رمانا
اڭـلب ل طَرْحة طريڭـنا المجاج
تبقى المفارقات حاضرة بقوة بين القوي والضعيف؛ الحاكم والمحكوم؛ القائد و التابع؛ علاقات تتحكم فيها المفارقات التالية؛:
كوادنا-----رمانا.
كوادنا----- كلب ل طرحة طريكنا لمجاج.
فيصبح (المجاج) ورمانا ودمانا ؛ كمعجم تحدد طبيعة العلاقة المبنية على التنافر بين قطبين؛ في موضعين متمايزين:
الأول /قوي(قائد)؛ والثاني /ضعيف(المتبوع). فوضعنا الشاعر امام قيادة سالبة؛ غير مقبولة مما جعل منه ان يحتج بكلمة (حرااام)؛ وبعبارة لجام دمانا؛ كإحالة على التعذيب الجسدي والنفسي. يحدد الشاعر جغرافية المحن؛ ابتدأ من اجزاء الذات/ركابينا؛ ليمتد الى المكان الصغير/عكابينا؛ ثم الارض الشاسعة/الوطن؛ فيحدد بوصف دقيق كل أشكال المحن؛ مرة قال عنها :
ب ركابينا ساوى.
عڭـابينا ب اوْطانا
وَطانا عطانا بطانة
ومرة اخرى يتحول الى أماكن صغيرة؛ لكنها مهمة لا تخلو اهمية في استقرار نفسي؛. ليصفها باوصاف تعمق الضربة؛ وتزيد من الرداءات . منها:
لفراشنا و غطانا
اعْرانا عْرانا و رعانا
والنتيجة أصبح الجسد منهارا في وجود منكسر: ليصبح هذا القائد؛ الذي؛ سبق أن طالبه بطرح صحيح؛ عندما قال؛ مناديا؛ مستنكرا ومحتجا:
احراااام
بصفتها صيحة رافضة؛ متمردة؛ غير قابلة هذا الشكل من العيش في واقع تحولت فيه الذات إلى؛ كما قال الزجال:
يوم عْزانا نعاج
وهي صفات تعري عن وقاحات هذا/الكواد؛ المتعجرف؛ الطاغية؛ المتسم بصفات غير رحبمة. وهي إشارات ذات دلالة واضحة؛ جعلت الحياة وكل مافيها في وضع لا يطلق؛ منها :
الكبل اذبل
اهبل فكعابنا
نببل ب حر
الڭـياد جنابنا
حتى مال الحال
ؤ بنا عواج..
صيحة وصرخة وغضبة قوية؛ حاول محمد الحبيب العسالي؛ بأسلوب مشفر أن يحدد مستويات المسؤولية؛ كما عمق كل القضايا التي اثارتها قيادة معطوبة؛ بصفتها/كواد ؛ لم ينتج سوى ماسماه بمعجم عنيف( اللجام ادمانا) وهي دلالة تفيد ان الإتجاه لا يتحكم فيه سوى هذا السائق الأبله؛ لأنه الخارق المتمكن من الللجام؛ كإشارة أن الممرات كلها محددة بقيادة معطوبة؛ كما ناداه بخطاب رمزي تتديدي عندما قال(حرااام)؛
قسّْم بالسم مانا
ف سمانا ڭـُرعة
رقّْع الترعة
بمخيط المرعى
ؤ عادت المنذبة
فينا تفجاج
على ضوء هذا المقطع الشعري يمكننا تحديد مواصفات كل طرف في عملية بناء الدلالة على الشكل التالي:
الفاعل : هو /القائد _____قسم بالسم مانا
رقع الترعة
عن طريقه عادت المنذبة المفعول/الذات الجمعية--- تسمم ماؤها.
انكسر خاطرها
النتيجة:
عادت المنذبة فيها تفجاج.
على ضوء هذه الخطاطة يمكننا فهم طبيعة العلاقات بين الهو/الكواد(القائد)؛ والانا الجمعية(نا)؛ علاقات تحكمها روابط التنافر والتناحر؛ بين قطبين في موقع غير متساوي وعادل. والنتيجة أن الأمانة التي أسندت لهذا القائد لن يقم بواجبه المطلوب؛ مما جعله ينحرف؛ لتقوم بالمهمة النقيض. لم يكتف بالاشارات الدالة. بمعجم قوي ؛ بل اعتمد أساليب بلاغية لا تخلو من اهمية؛ منها تكرار بعض الكلمات؛ والتكرار في اللغة الكناوية هي صرخة وصوت احتجاجي؛ وفي اللغة العربية هي تأكيد الكلام؛ لهذا عندما اعتمد الشاعر خاصية التكرار لتاكيد الجرح وتعميق الألم؛ لهذا وجدناه هنا اعتمد على كلمة دالة بخاصيتين؛ في ذاتها تعني الجرح وفي تكرارها تفيد الألم وهي كلمة دم؛ يقول:
و الدم الدم
ذااااك الدم يا راسي
كرر كلمة دم؛ كما رفع من صوت ذاااك؛ لتخصيص الموقع الذي منه يتكلم؛ وهي نفس مجروحة؛ تناشد وتطلب من كواد غير رحيم ان يعيد النظر في حمقه وفي أساليب جنونه؛ لان الحال اصبح لا يطاق؛ وهو ماعبر عنه بهذه الصورة السعرية البليغة:
الڭـاسي فيك
يا كاسي احمى
تكبدت ف عروقو
الرحمة اتّْعمى
رفرف زفزف قبحو
وسطنا عجاج
كرر كلمة كاسي كما صاحب رفرف بزفزف؛ وهما معجمين يفيدان الحركية والهيجان الناتجان عن تعب طويل تعدى كل المقاييس. ماببن الكأس الحامي والقبح الذي رفرف ثم زفزف تشتت العروق وتكبدت دماؤها؛ والنتيجة( الكاس حمى والروح قربات تزهق)؛ والموت اصبح نتيجة حتمية بعد حال اصبح يمهد لنتائج غير محمودة؛ والسبب دائما هو قائد عنيد بليذ وطائش.
نفس العمل نجده في هذا المقطع؛ يعتمد أسلوب التكرار إما بنفس الكلمات او اعتماد معجم يتقارب في الأصوات؛ منه مثلا : يتهامى/ يترامى/ يتعامى؛ أو بكمة /حكمة/الكلمة/وهي كلها مصطلحات تلتقي في عمق دلالي واحد يفيد ماقال عنه الحبيب العسالي بصريح الكلام:، (عادت شوفات لامان فينا تعواج) او (كحال شغل لعمى)؛ لأن المسالة ببساطة أساسها كواد يتهامى وفي نفس الوقت يترامى ثم يتعامى وفي الأخير كل شيء؛ كما قال: فينا تعواج. يقول :
طاح بيننا يتهامى يترامى
يتعامى بكمة بلا حكمة
لاط عين الكلمة
كحال شغل العمى
عادت شوفات الأمان
فينا تعواج
الجميل في خطاب محمد الحبيب العسالي هو أنه تكلم عن الألم الجمعي؛ لم يحاسب ذاته؛ كما لم يغازلها؛ لم يسقط ضحية عتاب ذاتي محوره ألم شخصي؛ بل اخرج ذاته من أنانيتها ليتكلم باسم المقهور المتعب والمغلوب عامة؛ يحاسب الكواد الذي يقود الجماعة؛ فأدمج ذاته في ذوات المقهورين؛ ليتحول إلى شاعر جمعي؛ له القدرة أن يصرخ بصراخ الجماعة؛ ويتألم بلسانها و يصيح و يتكلم بما تخفيه في عمقها الجريح. في الأول تكلم بلسان الضمير المتكلم الجماعي؛ بعدها يعود ليتكلم عن الآخر؛ في معزل عن ذاته؛ كما فعل في هذا المقطع الصغير :
ونزل الضيف ثقلة
حر من الصيف
بنادم بن خادم
عادم ما نادم
جايف حايف
ما خايف ما عايف
المونة جيفة
و العولة خماج
الضيف هنا هو العبد القادم من بعيد (بنادم بن خادم)؛ حدد صفاته بتفصيل عندما قال: عادم مانادم؛ وهي صفات الانسان المنخور إجتماعيا؛ ينتمي الى أسفل الهرم الطبقي الفقير؛ ؛لأنه كما قال عنه: المونة جيفة/ والعولة خماج؛ وهي مواصفات تنطبق على اسفل انواع البشر في المجتمع المسحوق. هي كلها مواصفات تحدد طبيعة الانسان المعني في خطاب شاعرنا الذي يعني به الانسان الاسود القادم من الاذغال الافريقية بحثا عن مخرج وعن حل؛ ليجعل منه إنسانا شبيها لاخيه الابيض الذي يعيش في وضع مريح.
سلالة عبد ڭـناوي
ب هجهوج خاوي
ؤ دردبة بلا جاوي
ؤ لا ڭـول هرڭـاوي
من ملوك عائشة
و لا رضيع هايشة
الضيف الذي يتحدث عنه الشاعر هو من سلالة العبد الكناوي؛ الذي رمته الأرض الافريقية ليصبح اسير أخيه الابيض؛ في تاريخ مليء بالجراح؛ وبالصياح والصراخ والألم؛ فتحول في الفن الكناوي إلى لغة موسيقية يستنطقها الهجهوج والقراقب؛ في طقوس دردبة بكل محلاتها ؛ تستحضر الملوك السبع؛ وبالثوب المتنوع والبخور الذي يصاحب كل قطع موسيقية يتغنى المكنوي الليل ويعاشر سكونه ؛ لتتعالى الأصوات وتتهايج؛ تتكلم عن زمن الظلام؛ والقهر الذي عاشه الأسود في عهد غير رحيم.
الحبيب العسالي في هذه القصيدة تكلم عن ثلاثة شرائح مقهورة؛ كلها يجمعها صوت الغضب والتمرد والصراخ الرافض: يتكلم عن نفسه في علاقته بجماعة تنتمي إليه؛ يسوقها كواد غير عادل؛ لم يحسن فن القيادة؛ كما تكلم عن عبد؛ اعتبره ضيفا في أرض غير رحيمة؛ هو ذاك الضيف القادم من ارض العبد القديم؛ وتكلم عن سلالة الانسان الكناوي وسنتيره وطقوسه وشعائره المعروفة؛ عمق هذه العلاقة تتحكم فيها جراح مشتركة؛ والم موحد؛ كلها خصائص جعلت من هذه الشرائح الثلاث يجمع بينها خيط واحد؛ وهم واحد؛ كله يتكلم عن الألم المشترك والقهر الموحد
فيعود الي الكواد لينعته بصفات محددة؛ جعله اساس كل المشاكل؛ مخاطبا طيشه قائلا :
ذاااك الهادف
اللي ما ساوي
دافڭـ على مڭـازي
هاج امواج
غَرّْقني ف نيتي
كيف كان ناوي
هذه الرموز الشعرية تحدد موطن الداء ؛ كما تحدد اساس القضية التي تدافع عنها القصيدة؛ فيموقعنا الشاعر في الكتابة الهادفة التي تحمل رسالة وتدافع عنها بكل قوتها الشعرية التي تستند على أساس شعري واضح.
لْبْس خيري
ترّْكني شرّْڭـني
شرّْدني شرّْكني
الحق مع هداوي
لبّْسني على هواه
الحڭـرة تاج
هنا الذات تتحول؛ لتصيح بضمير المتكلم؛ على مستوى الظاهر هي ذات الشاعر اما على مستوى العمق فالموضوع اكبر من فرد واحد؛ لانها ستصبح قضية و صوت يعني الجميع؛ نبدأ بالشاعر؛ بصفته المعني الاول؛ ثم العبد بكونه انسان تنطبق عليه صيحة الحبيب العسالي؛ كما يتحول إلى خطاب الإنسان الأسود الضيف القادم من ارض الكناوي الهداوي.
يمكننا تحديد ذلك على ضوء الخطاطة التالية:
هو____ الآخر /السائق.
الانا----الشاعر+العبد الضيف+الكناوي.
الموضوع المشترك بين الانا والآخر تكمن فيما يلي:
البس خيري+ تركني شركي+ شدني+شركني.
الحل او المطلوب هو:
الحق مع هداوي ----- رمز الصفاء والنقاء والعدل. فيتحول إلى حسرة وقلق؛ مناشدا بلاده؛ لأن العودة الى الوطن تعني التمسك بالجذور وبالأصول؛ يقول:
و يا حسرة ف بلادي
محزم باولادي
ما نفعني عنادي
و لا اللي عليه ننادي
و لا شفع اللي بالشرع
بصبح موضوع كل المعادلات تسمية الاسماء بمسمياتها؛ ابتدأ بالبلد؛ ثم تحول إلى ابناء البلد؛ فعاتب عناده وتعصبه؛ كما استنكر في نفس الوقت ذاك الذي كان يترجاه ويناديه؛ ليخرج بنتيجة واحدة اساسها؛. كما قال محمود درويش(كل شيء على حاله)؛: فيعود إلى السؤال المحوري :
من هو ڭـوادي
ولا من فات حسبتو
لباب الحمية رتاج .
النتيجة لا شيء تغير؛ فقط صمته وسكاته كل ماتبقى له لعله يستطيع أن يعالج لغز ألمه وجرحه؛ لكن الهم وصل اقصاه؛ والضر تعدى مداه؛ والحال لم بعد يطمئن؛ فلم امامه إلا ثلاث مطالب حددها في العتاصر التالية: الدعاء+ الهيجان والصراخ+الثورة والتمرد؛ هي الحلول الوحيدة الممكنة في واقع قائده يسوق الذات والوطن والحياة نحو السراب والجنون: يقول:
ب سكاتي داوي آش يداوي
لمن نشكي و اش ف الجاَّيات مانداوي
ياك الهم ف الكم
تلم كاوي
لدعوتكم لغوثثكم لثورتكم هو محتاج .
خلاصة نهائية:
على ضوء ماسبق يمكننا ان نخلص الى عدة نتائج نحصرها في النقاط التالية:.
.اعتمد الشاعر مجموعة من الخصائص الأسلوبية لكتابة قصيدة شعرية تتحول وتتحرر في نفس الوقت من كل ضيق. شاعر يكتب محترما عدة قواعد أساسبة؛ أولها اختيار الموضوع؛ لهذا جاءت كتابة قوية وعنيفة؛ باحترام مجموعة من البناءات الضرورية؛ منها القدرة على الانتقال من مجال إلى آخر ؛ موضفا تقنية حسن التخلص. كما انه شاعر قادر على تجزيء الذوات لإلباسها في جوهر الذات الواحدة؛ لذلك انطلق بالذات الجمعية ثم تحول إلى الضيف العبد؛ وبعدها عاد الى الكناوي ليشاطره أحزانه وألمه؛ وأخيرا عاد إلى الذات الفردية؛ لكنه يقصد الجماعة المتقاربة والمشتركة في هم واحد؛ فوضعنا امام كلية متلازمة متداخلة؛ حية وحركية؛ فيها يجعل الشاعر من موضوع قصيدته مجالا ينطبق على مجموعة تشاركه وجعه وتعبه. كما لن نغيل استعارة القصيدة الكناوية لبتحول الشاعر إلى مكنوي صغير؛ يعيش ماعاشه؛ كما يواكذ تعبه؛ بل جعل من الضيف القادم من ارض الحوع والعطش رافدا من روافد الزمن القديم ؛ الذي مازال يشهد على حمق الاستيلاب والطيش الذي مارسه الأبيض في حق الأسود؛ السبب هو أن العبد ادى الفاتورة بثمن باهض نتيجة وضحية لونه.؛كما استعان بلون موسيقي كناوي؛ فوضفه الشاعر للتعبير عن عدة قضايا تعني الإنسان عامة والشاعر خاصة.
 www.facebook.com
www.facebook.com
ياك اعقلي..
هو عتاب صريح؛ ومرة أخرى وجدنا احميدة بلبالي يناديه صراحة عندما قال له:
بسلامة عليك اعقلي..
وهي دعوة صريحة لاستغناء الشاعر عن عقله. لم تتوقف الحكاية هنا بل زادت رائحتها في التسرب عندما ذهب بعض الزجالين الى نفي وجودهم وعدم الاعتراف به؛ منهم الشدادي عزالدين الذي سمى ديوانه الأول ب :
موحال انكون انا..
وهي صرخة صريحة بنفي نهائي لتجليات الذات في واقع لا تعترف به اساسا. ثم احمد لمسيح الذي وصل به الحد( ان توحش راسو)؛ وهي خاصية تحدد لنا طبيعة الغربة التي يعيشها الانسان الشاعر الذي اختار الزجل شكلا تعبيريا ؛ به يحدد طبيعة علاقته بذاته؛ بمحيطه وبالآخرين؛ الذين يعيشون قربه؛ منهم من وضع لنفسه قبرا كمكان يعيش فيه؛ عبدالمجيد الباهيلي الذي ربط القصيدة بالموت في ديوانه (حبيق الموت؛) وامغار مسناوي الذي نسي ذاته فعاد مطالبا بتذكرها في ديوانه (خلوني نتذكرتي؛)؛. هذه الكتابات المختلفة برؤى متفاوتة؛ كلها تبحث لنفسها عن مخرج تراه ملائما لرغباتها وتطلعاتها. هذا على المستوى الفلسفي وعلاقة الشاعر بذاته وبوجوده؛ أما على مستوى بحث عن متنفس؛ فيه يدمج ذاته؛ وبها يعيد النظر في كل المحتويات التي يتنفسها ويستنشقها ؛ على أساس أنها المخرج من مجال المتاهة ليلبس ثوب اللامعقول وجد الزجال في رحلة الكناوي متعة تتجاوب وطبيعة نظرته الى ما يجده قربه ليصبح استعارة يتنفسها ويتعايش فيها؛ فيصبح هو نفسه الذات الاخرى التي تتقارب مع ذاته؛ إلى درجة ان استنكر ذاته ولبس ذاتا أخرى؛ ذاك ما وجدناه في تناص نفسي ووجودي وفلسفي وفني؛ فوجد المبدع نفسه منصهرا؛ بشكل لا إرادي؛ في تواصل عميق مع نصوص أخرى؛ منها ماحدث بين النص الزجلي والفن الكناوي؛ هنا وجد الزجال ضالته؛ وهناك تحول همه ليصبح المكنوي المتعب المرهق والمعذب. هذا ماسنراه في قصيدة جاءنا بها محمد الحبيب العسالي في اختياراته الواعية؛ ليصبح صوتا زجليا يبحث عن مخارج ومتنفسات فنية؛ تجعله مؤهلا ان يكتب القصيدة من داخل معاناة الإنسان الأسود الذي عانق السنتير؛ ليحمل من كتاباته مشعلا فلسفيا داخل العمق الزجلي المغربي المعاصر. وقوقنا عند قصيدة العسالي ستكون بهدفين:
الأول لنبين ان استعارات الألم من الفن الكناوي ليست محصورة على مجموعة من الزجالة؛ منهم شعراء الاتحاد المغربي للزجل ؛ الذين ساهموا في إنتاج ديوان جماعي سموه(دردبة على محلات الكتبة). بل هي إشكال حاضر عند مجموعة كبيرة من شعراء الزجل؛ و العسالي أحدهم.
الهدف الثاني. سنسعى للبحث في التميز بين هؤلاء الشعراء لمعرفة أشكال الإختلاف والتنوع في نفس الموضوع ؛ الذي اشتغل فيه شعراء مختلفون. السؤال المحوري هنا كيف تحول الزجال محمد الحبيب العسالي الى فنان مكنوي؛ لبس حمق العبد؛ صفق بقراقب ليام وبسنير لعمر؛ يجتر رائحة العشق الأبدي لسراب زمن هارب من ذاكرة مجروحة؛ كلها سلاسل من نار؛ وسوط ترك وشمه على جسد منخور؛ رفض الظلم؛ وصاح بصوت هائج؛ يكلم. فراق الاحبة والوطن؛ ليصبح أسير إنسان ابيض قاهر ومستغل؟ كما سنطرح معه سؤالا إشكاليا يناقش قيمة الألم كفلسفة في الكتابة تتقاسمها الانفس فتتحول من حقل إلى حقل آخر؛ وكان للزجل نصيبا آمن به الزجال؛ فجعله يركب شراع الفن الكناوي عامة وطقوسه بشكل خاص؟.. اسئلة سنبحث في محتواها من خلال قصيدة :
........اشفع يا ڭـواد.....
عنوان يتميز بخاصيتين:
خاصية الشفاعة وخاصية الكواد.
الشفاعة هي طلب و ترجي؛ مرفوقة بالرحمة؛ وكأن الذات هنا تتقرب اكثر من شخص آخر مترجية منه ان يكون رحيما بها . والكواد هو من يسوق القافلة؛ هو القائد بشكل عام؛ الذي آسندت إليه مهمة القيادة. فنصبح امام معطين يعيشهما قطبان في درجات متفاوتة من الهرم الاجتماعي؛ طبعا على المستوى السوسيوثقافي . قطب القوة التي تميز القائد؛ بصفته جبارا؛ مادام يطلب منه الشفاعة والرحمة؛ وقطب الضعف التي تدل عليه الذات المنهكة؛ التي تخاطب القوي بأن يكون شفيعا و رحيما بها . فنجد انفسنا امام برنامجين من المنظور السيميائي:
البرنامح اول : فيه نجد الذات المتكلمة في حالة ضعف.
والبرنامج الثاني نجد فيه المخاطب بصفته القائد في حالة قوة.
فتتحدد لنا اول ثنائية أساسها مبني على التضاد والتناقض : القوة والضعف.؛ التبعية والقيادة؛ الانا والاخر؛ هي كلها عناصر تشكل الدلالة من خلال عنوان قصيدة الحبيب العسالي؛ بصفتها تشكل عتبة اولى؛ تتلازم في ثنائية العلاقات الازدراجية؛ التي تتحكم فيها إثنانيات متماسكة ومترابطة؛ سواء على مستوى القصيدة؛ او من خلال بناء تشكلاتها في الهرم الطبقي الاجتماعي المتناحر؛ مما جعل منها عنوانا محوريا لقصديته الماتلة امامنا. فتبدأ معالم هذه القيادة بسنات معجمية واضحة:
حراااام حزام اللجام ادمانا
اللجام هنا هو الاداة التي يكبل بها الشخص المقيود؛ فجعل من التبعية تشبه الشكل الذي به يكبل الحيوان؛ هكذا لم يفرق الكائن بين الكائن البشري المكبل باللجام بحيوان سائب غير نطيع لصاحبه؛ زاد من عمق هذه الاهانة؛ كما عمق موضوع الالم عندما قال (ادمانا) ؛ فيصبح الألم محددا بشملين من الاساليب:
اسلوب مادي: الاثر/ادمانا.
واسلوب نفسي: الوقع والجرح الداخلي.
مكتفيا بإدانة وصرخة ذات بعد أخلاقي واجتماعي؛ بل ديني أحيانا؛ ذلك ما نلمسه عندما قال:
احرااام.
هذه الأخيرة جاءت مرفقة بثلاثة الفات؛ تعني. صرخة طويلة الصوت؛ والعبد غالبا ماكان يخفي آلمه وعذابه؛ فحكم عليه حتى في ألمه ان يبقى أسير نفسه بصوت غير مسموع؛ أما صرخة الشاعر فهي احتجاج على الألم الداخلي الذي حكم عليه في عصر العبيد أن يبقى مقموعا ومحكوما عليه ان يعيشه وحده بلا كلام ولا صوت. .
على ڭـد شوفتو ڭـوادنا رمانا
اڭـلب ل طَرْحة طريڭـنا المجاج
تبقى المفارقات حاضرة بقوة بين القوي والضعيف؛ الحاكم والمحكوم؛ القائد و التابع؛ علاقات تتحكم فيها المفارقات التالية؛:
كوادنا-----رمانا.
كوادنا----- كلب ل طرحة طريكنا لمجاج.
فيصبح (المجاج) ورمانا ودمانا ؛ كمعجم تحدد طبيعة العلاقة المبنية على التنافر بين قطبين؛ في موضعين متمايزين:
الأول /قوي(قائد)؛ والثاني /ضعيف(المتبوع). فوضعنا الشاعر امام قيادة سالبة؛ غير مقبولة مما جعل منه ان يحتج بكلمة (حرااام)؛ وبعبارة لجام دمانا؛ كإحالة على التعذيب الجسدي والنفسي. يحدد الشاعر جغرافية المحن؛ ابتدأ من اجزاء الذات/ركابينا؛ ليمتد الى المكان الصغير/عكابينا؛ ثم الارض الشاسعة/الوطن؛ فيحدد بوصف دقيق كل أشكال المحن؛ مرة قال عنها :
ب ركابينا ساوى.
عڭـابينا ب اوْطانا
وَطانا عطانا بطانة
ومرة اخرى يتحول الى أماكن صغيرة؛ لكنها مهمة لا تخلو اهمية في استقرار نفسي؛. ليصفها باوصاف تعمق الضربة؛ وتزيد من الرداءات . منها:
لفراشنا و غطانا
اعْرانا عْرانا و رعانا
والنتيجة أصبح الجسد منهارا في وجود منكسر: ليصبح هذا القائد؛ الذي؛ سبق أن طالبه بطرح صحيح؛ عندما قال؛ مناديا؛ مستنكرا ومحتجا:
احراااام
بصفتها صيحة رافضة؛ متمردة؛ غير قابلة هذا الشكل من العيش في واقع تحولت فيه الذات إلى؛ كما قال الزجال:
يوم عْزانا نعاج
وهي صفات تعري عن وقاحات هذا/الكواد؛ المتعجرف؛ الطاغية؛ المتسم بصفات غير رحبمة. وهي إشارات ذات دلالة واضحة؛ جعلت الحياة وكل مافيها في وضع لا يطلق؛ منها :
الكبل اذبل
اهبل فكعابنا
نببل ب حر
الڭـياد جنابنا
حتى مال الحال
ؤ بنا عواج..
صيحة وصرخة وغضبة قوية؛ حاول محمد الحبيب العسالي؛ بأسلوب مشفر أن يحدد مستويات المسؤولية؛ كما عمق كل القضايا التي اثارتها قيادة معطوبة؛ بصفتها/كواد ؛ لم ينتج سوى ماسماه بمعجم عنيف( اللجام ادمانا) وهي دلالة تفيد ان الإتجاه لا يتحكم فيه سوى هذا السائق الأبله؛ لأنه الخارق المتمكن من الللجام؛ كإشارة أن الممرات كلها محددة بقيادة معطوبة؛ كما ناداه بخطاب رمزي تتديدي عندما قال(حرااام)؛
قسّْم بالسم مانا
ف سمانا ڭـُرعة
رقّْع الترعة
بمخيط المرعى
ؤ عادت المنذبة
فينا تفجاج
على ضوء هذا المقطع الشعري يمكننا تحديد مواصفات كل طرف في عملية بناء الدلالة على الشكل التالي:
الفاعل : هو /القائد _____قسم بالسم مانا
رقع الترعة
عن طريقه عادت المنذبة المفعول/الذات الجمعية--- تسمم ماؤها.
انكسر خاطرها
النتيجة:
عادت المنذبة فيها تفجاج.
على ضوء هذه الخطاطة يمكننا فهم طبيعة العلاقات بين الهو/الكواد(القائد)؛ والانا الجمعية(نا)؛ علاقات تحكمها روابط التنافر والتناحر؛ بين قطبين في موقع غير متساوي وعادل. والنتيجة أن الأمانة التي أسندت لهذا القائد لن يقم بواجبه المطلوب؛ مما جعله ينحرف؛ لتقوم بالمهمة النقيض. لم يكتف بالاشارات الدالة. بمعجم قوي ؛ بل اعتمد أساليب بلاغية لا تخلو من اهمية؛ منها تكرار بعض الكلمات؛ والتكرار في اللغة الكناوية هي صرخة وصوت احتجاجي؛ وفي اللغة العربية هي تأكيد الكلام؛ لهذا عندما اعتمد الشاعر خاصية التكرار لتاكيد الجرح وتعميق الألم؛ لهذا وجدناه هنا اعتمد على كلمة دالة بخاصيتين؛ في ذاتها تعني الجرح وفي تكرارها تفيد الألم وهي كلمة دم؛ يقول:
و الدم الدم
ذااااك الدم يا راسي
كرر كلمة دم؛ كما رفع من صوت ذاااك؛ لتخصيص الموقع الذي منه يتكلم؛ وهي نفس مجروحة؛ تناشد وتطلب من كواد غير رحيم ان يعيد النظر في حمقه وفي أساليب جنونه؛ لان الحال اصبح لا يطاق؛ وهو ماعبر عنه بهذه الصورة السعرية البليغة:
الڭـاسي فيك
يا كاسي احمى
تكبدت ف عروقو
الرحمة اتّْعمى
رفرف زفزف قبحو
وسطنا عجاج
كرر كلمة كاسي كما صاحب رفرف بزفزف؛ وهما معجمين يفيدان الحركية والهيجان الناتجان عن تعب طويل تعدى كل المقاييس. ماببن الكأس الحامي والقبح الذي رفرف ثم زفزف تشتت العروق وتكبدت دماؤها؛ والنتيجة( الكاس حمى والروح قربات تزهق)؛ والموت اصبح نتيجة حتمية بعد حال اصبح يمهد لنتائج غير محمودة؛ والسبب دائما هو قائد عنيد بليذ وطائش.
نفس العمل نجده في هذا المقطع؛ يعتمد أسلوب التكرار إما بنفس الكلمات او اعتماد معجم يتقارب في الأصوات؛ منه مثلا : يتهامى/ يترامى/ يتعامى؛ أو بكمة /حكمة/الكلمة/وهي كلها مصطلحات تلتقي في عمق دلالي واحد يفيد ماقال عنه الحبيب العسالي بصريح الكلام:، (عادت شوفات لامان فينا تعواج) او (كحال شغل لعمى)؛ لأن المسالة ببساطة أساسها كواد يتهامى وفي نفس الوقت يترامى ثم يتعامى وفي الأخير كل شيء؛ كما قال: فينا تعواج. يقول :
طاح بيننا يتهامى يترامى
يتعامى بكمة بلا حكمة
لاط عين الكلمة
كحال شغل العمى
عادت شوفات الأمان
فينا تعواج
الجميل في خطاب محمد الحبيب العسالي هو أنه تكلم عن الألم الجمعي؛ لم يحاسب ذاته؛ كما لم يغازلها؛ لم يسقط ضحية عتاب ذاتي محوره ألم شخصي؛ بل اخرج ذاته من أنانيتها ليتكلم باسم المقهور المتعب والمغلوب عامة؛ يحاسب الكواد الذي يقود الجماعة؛ فأدمج ذاته في ذوات المقهورين؛ ليتحول إلى شاعر جمعي؛ له القدرة أن يصرخ بصراخ الجماعة؛ ويتألم بلسانها و يصيح و يتكلم بما تخفيه في عمقها الجريح. في الأول تكلم بلسان الضمير المتكلم الجماعي؛ بعدها يعود ليتكلم عن الآخر؛ في معزل عن ذاته؛ كما فعل في هذا المقطع الصغير :
ونزل الضيف ثقلة
حر من الصيف
بنادم بن خادم
عادم ما نادم
جايف حايف
ما خايف ما عايف
المونة جيفة
و العولة خماج
الضيف هنا هو العبد القادم من بعيد (بنادم بن خادم)؛ حدد صفاته بتفصيل عندما قال: عادم مانادم؛ وهي صفات الانسان المنخور إجتماعيا؛ ينتمي الى أسفل الهرم الطبقي الفقير؛ ؛لأنه كما قال عنه: المونة جيفة/ والعولة خماج؛ وهي مواصفات تنطبق على اسفل انواع البشر في المجتمع المسحوق. هي كلها مواصفات تحدد طبيعة الانسان المعني في خطاب شاعرنا الذي يعني به الانسان الاسود القادم من الاذغال الافريقية بحثا عن مخرج وعن حل؛ ليجعل منه إنسانا شبيها لاخيه الابيض الذي يعيش في وضع مريح.
سلالة عبد ڭـناوي
ب هجهوج خاوي
ؤ دردبة بلا جاوي
ؤ لا ڭـول هرڭـاوي
من ملوك عائشة
و لا رضيع هايشة
الضيف الذي يتحدث عنه الشاعر هو من سلالة العبد الكناوي؛ الذي رمته الأرض الافريقية ليصبح اسير أخيه الابيض؛ في تاريخ مليء بالجراح؛ وبالصياح والصراخ والألم؛ فتحول في الفن الكناوي إلى لغة موسيقية يستنطقها الهجهوج والقراقب؛ في طقوس دردبة بكل محلاتها ؛ تستحضر الملوك السبع؛ وبالثوب المتنوع والبخور الذي يصاحب كل قطع موسيقية يتغنى المكنوي الليل ويعاشر سكونه ؛ لتتعالى الأصوات وتتهايج؛ تتكلم عن زمن الظلام؛ والقهر الذي عاشه الأسود في عهد غير رحيم.
الحبيب العسالي في هذه القصيدة تكلم عن ثلاثة شرائح مقهورة؛ كلها يجمعها صوت الغضب والتمرد والصراخ الرافض: يتكلم عن نفسه في علاقته بجماعة تنتمي إليه؛ يسوقها كواد غير عادل؛ لم يحسن فن القيادة؛ كما تكلم عن عبد؛ اعتبره ضيفا في أرض غير رحيمة؛ هو ذاك الضيف القادم من ارض العبد القديم؛ وتكلم عن سلالة الانسان الكناوي وسنتيره وطقوسه وشعائره المعروفة؛ عمق هذه العلاقة تتحكم فيها جراح مشتركة؛ والم موحد؛ كلها خصائص جعلت من هذه الشرائح الثلاث يجمع بينها خيط واحد؛ وهم واحد؛ كله يتكلم عن الألم المشترك والقهر الموحد
فيعود الي الكواد لينعته بصفات محددة؛ جعله اساس كل المشاكل؛ مخاطبا طيشه قائلا :
ذاااك الهادف
اللي ما ساوي
دافڭـ على مڭـازي
هاج امواج
غَرّْقني ف نيتي
كيف كان ناوي
هذه الرموز الشعرية تحدد موطن الداء ؛ كما تحدد اساس القضية التي تدافع عنها القصيدة؛ فيموقعنا الشاعر في الكتابة الهادفة التي تحمل رسالة وتدافع عنها بكل قوتها الشعرية التي تستند على أساس شعري واضح.
لْبْس خيري
ترّْكني شرّْڭـني
شرّْدني شرّْكني
الحق مع هداوي
لبّْسني على هواه
الحڭـرة تاج
هنا الذات تتحول؛ لتصيح بضمير المتكلم؛ على مستوى الظاهر هي ذات الشاعر اما على مستوى العمق فالموضوع اكبر من فرد واحد؛ لانها ستصبح قضية و صوت يعني الجميع؛ نبدأ بالشاعر؛ بصفته المعني الاول؛ ثم العبد بكونه انسان تنطبق عليه صيحة الحبيب العسالي؛ كما يتحول إلى خطاب الإنسان الأسود الضيف القادم من ارض الكناوي الهداوي.
يمكننا تحديد ذلك على ضوء الخطاطة التالية:
هو____ الآخر /السائق.
الانا----الشاعر+العبد الضيف+الكناوي.
الموضوع المشترك بين الانا والآخر تكمن فيما يلي:
البس خيري+ تركني شركي+ شدني+شركني.
الحل او المطلوب هو:
الحق مع هداوي ----- رمز الصفاء والنقاء والعدل. فيتحول إلى حسرة وقلق؛ مناشدا بلاده؛ لأن العودة الى الوطن تعني التمسك بالجذور وبالأصول؛ يقول:
و يا حسرة ف بلادي
محزم باولادي
ما نفعني عنادي
و لا اللي عليه ننادي
و لا شفع اللي بالشرع
بصبح موضوع كل المعادلات تسمية الاسماء بمسمياتها؛ ابتدأ بالبلد؛ ثم تحول إلى ابناء البلد؛ فعاتب عناده وتعصبه؛ كما استنكر في نفس الوقت ذاك الذي كان يترجاه ويناديه؛ ليخرج بنتيجة واحدة اساسها؛. كما قال محمود درويش(كل شيء على حاله)؛: فيعود إلى السؤال المحوري :
من هو ڭـوادي
ولا من فات حسبتو
لباب الحمية رتاج .
النتيجة لا شيء تغير؛ فقط صمته وسكاته كل ماتبقى له لعله يستطيع أن يعالج لغز ألمه وجرحه؛ لكن الهم وصل اقصاه؛ والضر تعدى مداه؛ والحال لم بعد يطمئن؛ فلم امامه إلا ثلاث مطالب حددها في العتاصر التالية: الدعاء+ الهيجان والصراخ+الثورة والتمرد؛ هي الحلول الوحيدة الممكنة في واقع قائده يسوق الذات والوطن والحياة نحو السراب والجنون: يقول:
ب سكاتي داوي آش يداوي
لمن نشكي و اش ف الجاَّيات مانداوي
ياك الهم ف الكم
تلم كاوي
لدعوتكم لغوثثكم لثورتكم هو محتاج .
خلاصة نهائية:
على ضوء ماسبق يمكننا ان نخلص الى عدة نتائج نحصرها في النقاط التالية:.
.اعتمد الشاعر مجموعة من الخصائص الأسلوبية لكتابة قصيدة شعرية تتحول وتتحرر في نفس الوقت من كل ضيق. شاعر يكتب محترما عدة قواعد أساسبة؛ أولها اختيار الموضوع؛ لهذا جاءت كتابة قوية وعنيفة؛ باحترام مجموعة من البناءات الضرورية؛ منها القدرة على الانتقال من مجال إلى آخر ؛ موضفا تقنية حسن التخلص. كما انه شاعر قادر على تجزيء الذوات لإلباسها في جوهر الذات الواحدة؛ لذلك انطلق بالذات الجمعية ثم تحول إلى الضيف العبد؛ وبعدها عاد الى الكناوي ليشاطره أحزانه وألمه؛ وأخيرا عاد إلى الذات الفردية؛ لكنه يقصد الجماعة المتقاربة والمشتركة في هم واحد؛ فوضعنا امام كلية متلازمة متداخلة؛ حية وحركية؛ فيها يجعل الشاعر من موضوع قصيدته مجالا ينطبق على مجموعة تشاركه وجعه وتعبه. كما لن نغيل استعارة القصيدة الكناوية لبتحول الشاعر إلى مكنوي صغير؛ يعيش ماعاشه؛ كما يواكذ تعبه؛ بل جعل من الضيف القادم من ارض الحوع والعطش رافدا من روافد الزمن القديم ؛ الذي مازال يشهد على حمق الاستيلاب والطيش الذي مارسه الأبيض في حق الأسود؛ السبب هو أن العبد ادى الفاتورة بثمن باهض نتيجة وضحية لونه.؛كما استعان بلون موسيقي كناوي؛ فوضفه الشاعر للتعبير عن عدة قضايا تعني الإنسان عامة والشاعر خاصة.
Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
 www.facebook.com
www.facebook.com