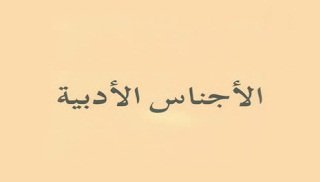القصة القصيرة جنس سردي عصي في نظامه الاختزالي الذي به تتكثف فاعلية عناصره، متشكلة في سرد يوصف بالقصر والاكتمال وبمسرود واحد يوصف بالمركزية في الأغلب.
وقد تبدو القصة القصيرة عصية بسبب سماتها التي تتضاد فيما بينهما حيث الاختزال يقابله التمثيل والتكثيف يقابله الإيفاء والقصر يقابله الاكتمال. وهو ما يجعل كثيراً من كتّابنا يهابون هذا الجنس ويسترهبون الخوض فيه مفضلين عليه الرواية التي تتوضح ظاهرة طغيانها على الأجناس السردية الأخرى في أوقات الشحة الإبداعية وأزمات الواقع الحياتية الطارئة وغير الاعتيادية. وهو ما يحصل بالضبط في ظل المرحلة الراهنة التي يعيشها السرد العراقي الذي يغزوه الانتاج الروائي باستمرار بينما ينحسر إنتاج القصة القصيرة فلا يشكل إلا استثناء من ظاهرة. على خلاف ما كانت عليه القصة القصيرة في النصف الثاني من القرن الماضي حين شكلت ظاهرة لافتة للنظر في المشهد الثقافي وكانت الرواية هي الاستثناء.
وللأمر بالطبع علاقة بالمتغيرات الحياتية وما يطرأ على الواقع من تقدم أو تراجع فالعراق من النصف الثاني للقرن الماضي إلى نهاياته يشهد صعودا حياتيا بغض النظر عن سلبياته أو ايجابياته، لكنه في العقدين الاولين من القرن الحادي والعشرين وإلى الآن يشهد تحولات دراماتيكية في كل المجالات من دون استثناء، فأصبحت القصة بتكثيفها واختزالها غير قادرة على استيعاب مظاهر هذه التحولات جميعها.
وإذا كان الأمر بين السرد والحياة بهذه الصورة وهذا التوافق إيجابا وسلبا، فما حال القصة القصيرة وهي تتخذ من التاريخ ثيمة هي بمثابة وسيلة فنية، القصد منها التمثيل السردي للوقائع والأحداث ؟ وقد يكون السؤال أكثر تعقيدا إذا اضفنا إلى التمثيل السردي استيعاب التحديد المفهوماتي ما بعد الحداثي للتاريخ ؟
لا خلاف أنّ تعامل القاص مع التاريخ يتجاوز النظرة التقليدية، فالتاريخ لم يعد سجلاً نصياً لأحداث الماضي؛ بل التاريخ اليوم هو عبارة عن تواريخ، فيها تتم محاكاة الوقائع التي حصلت فعلياً ثم تناقلتها الألسن شفاهياً لتوثقها الأيدي بعد ذلك كتابياً في نصوص مدونة هيستوغرافية Historiography كسرود لقصص وحكايات لا تمثل التاريخ بكليته الممتدة وغير النهائية وإنما تمثل جزءاً يسيراً منه. والسبب وجود جانب شفاهي لم يدون ووجود جانب مستقبلي لم يقع بعد، مما يسميه هايدن وايت الميتاتاريخية meta-history بوصف التاريخ تركيباً عقلياً لكنه مؤد وظيفياً إلى غايات شعرية.
والقصة الميتاتاريخية ـ التي هي نوع سردي ينضوي في جنس القصة القصيرة ـ تعني سرد لحظة زمنية من لحظات التاريخ أو شخصية من شخصياته ضمن مكان وسياق لا يفصلان الماضي عن الحاضر، بل يزحزحان التاريخ الرسمي العام بتاريخ خاص يصنعه القاص تخييلياً. وبالاستقلال الكلي مساءلة وتناصات وخطابات تقوّض القصة الميتاتاريخية مركزية التاريخ لا الهيستوغرافية فقط، مرجئة صدقيتها.
والطريقة التي بها تزحزح هذه القصة التاريخ هي حفرها في جينالوجيته التي بها تتجلى كليته الزمنية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وبما يمكِّن القاص من القبض على التاريخ كخطاب سردي ميتاـ تاريخي فيه ما هو متعدد في المنظور ومتفاوت في الوعي.
ولو اقتصر القاص على الهيستوغرافية لما أنتج قصة ميتاتاريخية لأنه حينها سيتعامل مع نصوص مدونة عن واقعة حصلت فعلا وتمت محاكاتها كتابياً، وليس مع الواقعة نفسها من قبل أن تدون ومن بعد تدوينها ليكون عمله إعادة تمثيلها قصصيا عبر التخييل السردي لها في ماضيها وما قد يكون عليه حاضرها من دون إهمال لما قد يسفر عنه مستقبلها.
وطبيعي أن يكون الاختلاف كبيراً بين قصة يريد كاتبها التاريخ نفسه وقصة يتحرى كاتبها فيها الكتابة التاريخية حسب، ذلك أن القصة الأولى ستكون ميتاتاريخية أما الأخرى فستكون ميتاخرافة تأريخية وفيها الواقعة fact التي هي اللاخرافة يقابلها حدث event هو خرافة ما بعد حداثية. وهذه الخرافة يمكن أن تكون صادقة وكاذبة مثلما يمكن أن تكون وقائع (كتابة) التاريخ كذلك. بيد أننا نرى أنّ وقائع التاريخ نفسها لا صدق فيها ولا كذب، فالتاريخ واقتناعا بنظرية هايدن وايت يظل هو المحرك للفعلي للتخييل السردي.
ومن ثم تغدو القصة الميتاتاريخية مفتوحة المساحات حرة المديات وهي تعارض التاريخ وتفككه، متضادة مع كليته، قالبة أساساته، بانية على أنقاضها سرداً ميتاـتاريخي هو بمثابة تاريخ خاص.
ولو كانت الكتابة التأريخية هي الأهم عند القاص لما استطاع مشاكسة المؤرخين لأن عمله حينئذ سيدور في حدود ما كتبه المؤرخون غير ناظر إلى التاريخ الشفوي ولا مهملات التاريخ الرسمي التي هي مصدر مهم للتخييل التاريخي بسبب ما تمنحه من الخصب والثراء.
والقصة الميتاتاريخية لا تأخذ بيد كاتبها ما لم يكن الكاتب نفسه ذا ملكة ناضجة لتحلِّق به خارج أسوار التاريخ العام بحثاً عن مناطق تخييلية جديدة مبتكرة وأصيلة.
كأن ينساق وراء رؤية واقعية أو ما بعد واقعية أو يهتم بالبعد الكرونتوبي للحدث أو يوجه القصة توجيها يتعدى السرد إلى ما بعده، اهتماما بتصوير اللحظة السردية التي فيها يتلاقي الفعلان الواقعي والتاريخي، ليتم قلبهما والاقتصاص منهما معاً.
وتشبه براندا مارشال عملية كتابة القصة الميتاتاريخية كمن يكتب على جدران التاريخ واضعاً المؤرخين خلفه متحصلاً على التاريخ الذي لم نقم بكتابته قط، كتاريخ خاص صنعه القاص بنفسه، هو وحده الذي يتحكم به. ولو أن وعي القاص بالتاريخ اقتصر على الكتابة التأريخية لما استطاع تقديم تاريخ جديد هو نسخة بديلة عن التاريخ الرسمي المدون.
وهذه هي انطولوجية التخييل التاريخي التي هي مختلفة تماما عن إيديولوجية القص التاريخي التي ترى أن التاريخ هو الماضي نفسه بلا حاضر أو مستقبل.
وهذا هو التورط الذي فيه لن نجد في القصة ما به تخبرنا عن الكيفية التي نفكر بها في حدث معين بينما في القصة الميتاـتاريخية يكون القاص على بينة من وجهة النظر التاريخية التي بها سينحرف عن خط التاريخ العام برؤية ما بعد حداثية تمنحه خطاً خاصاً، منه يشرع بقصدية نحو جعل التاريخ محركاً لمخيلته وهي ترسم دورة الزمان على مستويين تجاوري سايكروني وتجاوزي دياكروني مركزاً وهامشاً، مذكراً ومؤنثاً، تشابهاً واختلافاً، انتصاراً وخسارةً.
كأن تكشف القصة عن غياب الصوت النسوي والثقافة الأمومية في التاريخ البشري لاكثر من 7000سنة مضت أو تؤشر على مناطق النقص التاريخي في واقعة ما، أهملها المجتمع البطريركي أو نظر إليها بأصولية عرقية أو بطوباوية ميتافزيقية أو بسحرية تهويمية.
من هنا يصبح ممكناً لكاتب القصة الميتاتاريخية أن يأتي بشخصية مخترعة تمثل هامشاً أهمله التاريخ واجداً في كوجيتو صناعتها ما يمكنه من ردم نقص وإضافة جديد إلى هذا التاريخ. وهو ما لا يتاح لكاتب القصة التاريخية لأنه ينشد إلى شخصيات اهتم بها التاريخ. ولو حاول أن يتغلغل فيها مفتشاً عما يقوله عنها فلن يستطيع أن يكشف لنا مستوراً لأن قصته مكتملة في الأصل لا تحتاج إلى استرداد كما أن أية إضافة عليها ستكون فائضة أو غير ضرورية.
وإذا كان هدف القصة التاريخية كتابة نص إبداعي عن نص موجود في بطون التاريخ العام؛ فإن الكتابة الميتاتاريخية تسعى إلى رصد ما هو بريء، مما يمكن البحث عنه في التاريخ العام عبر توظيف ذاكرة مضادة تمشكله، واستعمال لغة مقوِّضة تمخيله.
وإذا وضع الكاتب هذا كله في باله فسينتج قصة ميتاتاريخية لا يقف في وجهها تاريخ عريق ولا ارث تليد كما لن يستعصى عليه استنفار الذاكرة الجماعية التي هي حية بما تحفل به من حكايات ومرويات شفاهية. وما ذلك إلا لأن التمثيل يتحدى الواقعة تاريخياً محاولاً إعادة إنتاج معطياتها الخام سردياً، على أساس أنّ التاريخ هو في الأساس أحداث صارت وقائع وكلاهما يحتفظان بوضعيتهما خارج اللغة وداخلها.
والتمثيل التاريخي لواقعة ما هو تجريب يتخذه القاص طريقا لبلوغ ما هو غير متوقع فيها ميتاتاريخيا. وشتان ما بين تمثيل تاريخي يبني على ما وصل إلينا من الوقائع التاريخية وبين تمثيل تاريخي يهدم المبني ويقيم على أنقاضه تاريخاً خاصاً للوقائع.
ومثل ذلك يقال مع التمثيل التاريخي للشخصيات التاريخية فالقاص الذي يبني قصته على شخصية من شخصيات التاريخ هو غير ذلك الذي يخترع شخصيته التاريخية. فالأول مهما حاول أن يعمل مخيلته يبقى سائراً في ركب التاريخ العام بينما يبتدع الثاني الشخصية من مخياله الذاتي مضفياً عليها ملامح شخصية تاريخية هنا أو ناسباً إليها أعمال شخصية أخرى هناك، معيداً بنائها من جديد ظافراً بجديد لم يقله التاريخ. وقد يحوّر اسم الشخصية الأصل ليضعه على شخصية من مكان وزمان آخر غير الذي ثبّته التاريخ لها.
وقد تعاملت القصة العراقية منذ بواكيرها مع التاريخ بالنهج نفسه الذي به تعاملت الرواية من ناحية الامتثال لمركزيته وتبجيل رسميته، بيد أن قليلا من القصص اختارت طريق التجريب التاريخي ولاسيما في عقد الستينيات الذي فيه كان التجريب المنشدُّ إلى الواقع هو الخط العام عند أكثر القصاصين.. فما الذي دفع القاص إلى هذا اللون من التجريب التاريخي ؟ أ هي رغبة ذاتية خالصة في مخالفة الخط العام الواقعي ومنافاة أعرافه أم هي ضرورة اقتضاها وعيه بواقعه ومآلات هذا الواقع المستقبلية أيضا ؟!!
وقد تبدو القصة القصيرة عصية بسبب سماتها التي تتضاد فيما بينهما حيث الاختزال يقابله التمثيل والتكثيف يقابله الإيفاء والقصر يقابله الاكتمال. وهو ما يجعل كثيراً من كتّابنا يهابون هذا الجنس ويسترهبون الخوض فيه مفضلين عليه الرواية التي تتوضح ظاهرة طغيانها على الأجناس السردية الأخرى في أوقات الشحة الإبداعية وأزمات الواقع الحياتية الطارئة وغير الاعتيادية. وهو ما يحصل بالضبط في ظل المرحلة الراهنة التي يعيشها السرد العراقي الذي يغزوه الانتاج الروائي باستمرار بينما ينحسر إنتاج القصة القصيرة فلا يشكل إلا استثناء من ظاهرة. على خلاف ما كانت عليه القصة القصيرة في النصف الثاني من القرن الماضي حين شكلت ظاهرة لافتة للنظر في المشهد الثقافي وكانت الرواية هي الاستثناء.
وللأمر بالطبع علاقة بالمتغيرات الحياتية وما يطرأ على الواقع من تقدم أو تراجع فالعراق من النصف الثاني للقرن الماضي إلى نهاياته يشهد صعودا حياتيا بغض النظر عن سلبياته أو ايجابياته، لكنه في العقدين الاولين من القرن الحادي والعشرين وإلى الآن يشهد تحولات دراماتيكية في كل المجالات من دون استثناء، فأصبحت القصة بتكثيفها واختزالها غير قادرة على استيعاب مظاهر هذه التحولات جميعها.
وإذا كان الأمر بين السرد والحياة بهذه الصورة وهذا التوافق إيجابا وسلبا، فما حال القصة القصيرة وهي تتخذ من التاريخ ثيمة هي بمثابة وسيلة فنية، القصد منها التمثيل السردي للوقائع والأحداث ؟ وقد يكون السؤال أكثر تعقيدا إذا اضفنا إلى التمثيل السردي استيعاب التحديد المفهوماتي ما بعد الحداثي للتاريخ ؟
لا خلاف أنّ تعامل القاص مع التاريخ يتجاوز النظرة التقليدية، فالتاريخ لم يعد سجلاً نصياً لأحداث الماضي؛ بل التاريخ اليوم هو عبارة عن تواريخ، فيها تتم محاكاة الوقائع التي حصلت فعلياً ثم تناقلتها الألسن شفاهياً لتوثقها الأيدي بعد ذلك كتابياً في نصوص مدونة هيستوغرافية Historiography كسرود لقصص وحكايات لا تمثل التاريخ بكليته الممتدة وغير النهائية وإنما تمثل جزءاً يسيراً منه. والسبب وجود جانب شفاهي لم يدون ووجود جانب مستقبلي لم يقع بعد، مما يسميه هايدن وايت الميتاتاريخية meta-history بوصف التاريخ تركيباً عقلياً لكنه مؤد وظيفياً إلى غايات شعرية.
والقصة الميتاتاريخية ـ التي هي نوع سردي ينضوي في جنس القصة القصيرة ـ تعني سرد لحظة زمنية من لحظات التاريخ أو شخصية من شخصياته ضمن مكان وسياق لا يفصلان الماضي عن الحاضر، بل يزحزحان التاريخ الرسمي العام بتاريخ خاص يصنعه القاص تخييلياً. وبالاستقلال الكلي مساءلة وتناصات وخطابات تقوّض القصة الميتاتاريخية مركزية التاريخ لا الهيستوغرافية فقط، مرجئة صدقيتها.
والطريقة التي بها تزحزح هذه القصة التاريخ هي حفرها في جينالوجيته التي بها تتجلى كليته الزمنية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وبما يمكِّن القاص من القبض على التاريخ كخطاب سردي ميتاـ تاريخي فيه ما هو متعدد في المنظور ومتفاوت في الوعي.
ولو اقتصر القاص على الهيستوغرافية لما أنتج قصة ميتاتاريخية لأنه حينها سيتعامل مع نصوص مدونة عن واقعة حصلت فعلا وتمت محاكاتها كتابياً، وليس مع الواقعة نفسها من قبل أن تدون ومن بعد تدوينها ليكون عمله إعادة تمثيلها قصصيا عبر التخييل السردي لها في ماضيها وما قد يكون عليه حاضرها من دون إهمال لما قد يسفر عنه مستقبلها.
وطبيعي أن يكون الاختلاف كبيراً بين قصة يريد كاتبها التاريخ نفسه وقصة يتحرى كاتبها فيها الكتابة التاريخية حسب، ذلك أن القصة الأولى ستكون ميتاتاريخية أما الأخرى فستكون ميتاخرافة تأريخية وفيها الواقعة fact التي هي اللاخرافة يقابلها حدث event هو خرافة ما بعد حداثية. وهذه الخرافة يمكن أن تكون صادقة وكاذبة مثلما يمكن أن تكون وقائع (كتابة) التاريخ كذلك. بيد أننا نرى أنّ وقائع التاريخ نفسها لا صدق فيها ولا كذب، فالتاريخ واقتناعا بنظرية هايدن وايت يظل هو المحرك للفعلي للتخييل السردي.
ومن ثم تغدو القصة الميتاتاريخية مفتوحة المساحات حرة المديات وهي تعارض التاريخ وتفككه، متضادة مع كليته، قالبة أساساته، بانية على أنقاضها سرداً ميتاـتاريخي هو بمثابة تاريخ خاص.
ولو كانت الكتابة التأريخية هي الأهم عند القاص لما استطاع مشاكسة المؤرخين لأن عمله حينئذ سيدور في حدود ما كتبه المؤرخون غير ناظر إلى التاريخ الشفوي ولا مهملات التاريخ الرسمي التي هي مصدر مهم للتخييل التاريخي بسبب ما تمنحه من الخصب والثراء.
والقصة الميتاتاريخية لا تأخذ بيد كاتبها ما لم يكن الكاتب نفسه ذا ملكة ناضجة لتحلِّق به خارج أسوار التاريخ العام بحثاً عن مناطق تخييلية جديدة مبتكرة وأصيلة.
كأن ينساق وراء رؤية واقعية أو ما بعد واقعية أو يهتم بالبعد الكرونتوبي للحدث أو يوجه القصة توجيها يتعدى السرد إلى ما بعده، اهتماما بتصوير اللحظة السردية التي فيها يتلاقي الفعلان الواقعي والتاريخي، ليتم قلبهما والاقتصاص منهما معاً.
وتشبه براندا مارشال عملية كتابة القصة الميتاتاريخية كمن يكتب على جدران التاريخ واضعاً المؤرخين خلفه متحصلاً على التاريخ الذي لم نقم بكتابته قط، كتاريخ خاص صنعه القاص بنفسه، هو وحده الذي يتحكم به. ولو أن وعي القاص بالتاريخ اقتصر على الكتابة التأريخية لما استطاع تقديم تاريخ جديد هو نسخة بديلة عن التاريخ الرسمي المدون.
وهذه هي انطولوجية التخييل التاريخي التي هي مختلفة تماما عن إيديولوجية القص التاريخي التي ترى أن التاريخ هو الماضي نفسه بلا حاضر أو مستقبل.
وهذا هو التورط الذي فيه لن نجد في القصة ما به تخبرنا عن الكيفية التي نفكر بها في حدث معين بينما في القصة الميتاـتاريخية يكون القاص على بينة من وجهة النظر التاريخية التي بها سينحرف عن خط التاريخ العام برؤية ما بعد حداثية تمنحه خطاً خاصاً، منه يشرع بقصدية نحو جعل التاريخ محركاً لمخيلته وهي ترسم دورة الزمان على مستويين تجاوري سايكروني وتجاوزي دياكروني مركزاً وهامشاً، مذكراً ومؤنثاً، تشابهاً واختلافاً، انتصاراً وخسارةً.
كأن تكشف القصة عن غياب الصوت النسوي والثقافة الأمومية في التاريخ البشري لاكثر من 7000سنة مضت أو تؤشر على مناطق النقص التاريخي في واقعة ما، أهملها المجتمع البطريركي أو نظر إليها بأصولية عرقية أو بطوباوية ميتافزيقية أو بسحرية تهويمية.
من هنا يصبح ممكناً لكاتب القصة الميتاتاريخية أن يأتي بشخصية مخترعة تمثل هامشاً أهمله التاريخ واجداً في كوجيتو صناعتها ما يمكنه من ردم نقص وإضافة جديد إلى هذا التاريخ. وهو ما لا يتاح لكاتب القصة التاريخية لأنه ينشد إلى شخصيات اهتم بها التاريخ. ولو حاول أن يتغلغل فيها مفتشاً عما يقوله عنها فلن يستطيع أن يكشف لنا مستوراً لأن قصته مكتملة في الأصل لا تحتاج إلى استرداد كما أن أية إضافة عليها ستكون فائضة أو غير ضرورية.
وإذا كان هدف القصة التاريخية كتابة نص إبداعي عن نص موجود في بطون التاريخ العام؛ فإن الكتابة الميتاتاريخية تسعى إلى رصد ما هو بريء، مما يمكن البحث عنه في التاريخ العام عبر توظيف ذاكرة مضادة تمشكله، واستعمال لغة مقوِّضة تمخيله.
وإذا وضع الكاتب هذا كله في باله فسينتج قصة ميتاتاريخية لا يقف في وجهها تاريخ عريق ولا ارث تليد كما لن يستعصى عليه استنفار الذاكرة الجماعية التي هي حية بما تحفل به من حكايات ومرويات شفاهية. وما ذلك إلا لأن التمثيل يتحدى الواقعة تاريخياً محاولاً إعادة إنتاج معطياتها الخام سردياً، على أساس أنّ التاريخ هو في الأساس أحداث صارت وقائع وكلاهما يحتفظان بوضعيتهما خارج اللغة وداخلها.
والتمثيل التاريخي لواقعة ما هو تجريب يتخذه القاص طريقا لبلوغ ما هو غير متوقع فيها ميتاتاريخيا. وشتان ما بين تمثيل تاريخي يبني على ما وصل إلينا من الوقائع التاريخية وبين تمثيل تاريخي يهدم المبني ويقيم على أنقاضه تاريخاً خاصاً للوقائع.
ومثل ذلك يقال مع التمثيل التاريخي للشخصيات التاريخية فالقاص الذي يبني قصته على شخصية من شخصيات التاريخ هو غير ذلك الذي يخترع شخصيته التاريخية. فالأول مهما حاول أن يعمل مخيلته يبقى سائراً في ركب التاريخ العام بينما يبتدع الثاني الشخصية من مخياله الذاتي مضفياً عليها ملامح شخصية تاريخية هنا أو ناسباً إليها أعمال شخصية أخرى هناك، معيداً بنائها من جديد ظافراً بجديد لم يقله التاريخ. وقد يحوّر اسم الشخصية الأصل ليضعه على شخصية من مكان وزمان آخر غير الذي ثبّته التاريخ لها.
وقد تعاملت القصة العراقية منذ بواكيرها مع التاريخ بالنهج نفسه الذي به تعاملت الرواية من ناحية الامتثال لمركزيته وتبجيل رسميته، بيد أن قليلا من القصص اختارت طريق التجريب التاريخي ولاسيما في عقد الستينيات الذي فيه كان التجريب المنشدُّ إلى الواقع هو الخط العام عند أكثر القصاصين.. فما الذي دفع القاص إلى هذا اللون من التجريب التاريخي ؟ أ هي رغبة ذاتية خالصة في مخالفة الخط العام الواقعي ومنافاة أعرافه أم هي ضرورة اقتضاها وعيه بواقعه ومآلات هذا الواقع المستقبلية أيضا ؟!!