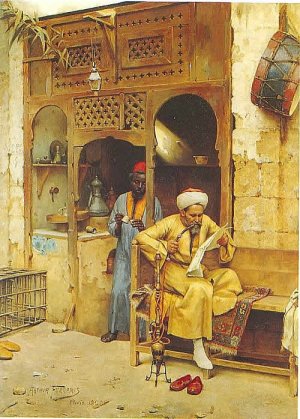(1)
كان أول عهدي بشهر رمضان وأنا طفل في المدرسة. لا أذكر في أي سنة على وجه الدقة، فكل ما أذكره أن الفصل كان خريفا وأن الطقس كان يراوح بين الحر والقر وأن العودة من المدرسة كانت تستغرق منا أزيد من ساعة نمضيها في المشي واللعب أحيانا. أعود من المدرسة فأجد أمي رحمها الله قد أعدّت الإفطار ولم يكن شيئا أكثر من برمة الحساء شربة أحيانا وأحيانا حلالم أو حتى محمّمصة ومعها الخبز رقاقا أو جرادق. وليس لهذا التنويع من معنى سوى أنه اجتهاد لكسر الرتابة ودفع التكرار وما ينشأ عنه من الإملال. كنا وقتها سبعة من أصل تسعة. فأختي الكبرى حليمة رحمها الله كانت قد تزوجت وأنا لم أدخل المدرسة بعد وأختي الصغرى سارة حفظها الله لم تولد بعد. فإذا حان موعد الإفطار ننقسم قسمين. مائدة للرجال أجلس إليها أنا وأبي رحمه الله وأخرى للنساء تجلس إليها أمي رفقة أخواتي أم هانئ وخديجة حفظهما الله و المرحومة زينة. أما أخي صالح حفظه الله فكان ما يزال في الثالثة من عمره وكان حرا يجلس حيث يشاء. تلك هي العادة عند كل إفطار ويحدث أن نكسر هذه العادة فنبعثر هذا النظام ونعبث به فلا نلتزم بما التزمنا به ليلتين أو أكثر الأمر الذي دعا أبي رحمه الله إلى التنازل نهائيا عن حقه القديم في الاستقلال بمائدة لا يشاركه فيها أحد سوايا. وبهذا التنازل صرنا جميعا على مائدة واحدة وحول قصعة واحدة نغرف منها كما نشاء. وكان لليوم الأول من شهر رمضان علامة بارزة فلم أر أبي رحمه الله يصلي إلا في شهر رمضان فإذا رأيناه يتوضأ ويصلي علمنا أننا في شهر الصيام. أما أمي فكانت تصلي في كل فصل من فصول السنة. وكان لصلاة أبي معنى غير معانيها الشائعة فلم يكن يحفظ من القرآن غير الفاتحة وشيئا من سورة الناس يتلوها على غير نظام فإذا أشرت عليه بتصويب التلاوة يكتفي بأن يقول إن الله غفور رحيم.
* * *
(2)
لم يكن في بيتنا ولا في أغلب البيوت في القرية شيء يساعد على معرفة الوقت بالدقيق. فلا ساعة يدوية ولا ساعة حائطية ولا تلك التي تسمّى فياقة أو رفّايا. وكان الكبار منا يستعينون على قياس الوقت بصياح الديكة أو بقيس الظل. وهذا ممكن في سائر الأيام ولكن لرمضان أوقات دقيقة فالإمساك في وقت مضبوط وكذلك الإفطار. وكان لابد إذن من حل لهذه المعضلة فتطوع الرزڨي بن محمد بن سماعين وكان وقتها في العشرين من عمره أو دون ذلك بقليل ليرصد وقت المغرب فيصعد عند كل مساء الجبل قبيل الغروب ومعه؛ شيء من القش أو الحطب ويظل واقفا موليا وجهه صوب مدينة الكاف التي تتراءى لنا بناءاتها عن أكثر من عشرين كيلومترا تقريبا فإذا لمح ومضة المدفع أو أي ومضة أخرى أشعل كومة القش ونادى بأعلى صوته (الله أكبر) ثلاث مرات و لا يتبعها شيء من نص الآذان المعروف. ثم ينحدر مسرعا. وبينما كان الرزڨي يرصد وميض الكاف كنا نحن الأطفال نرصد ناره وتكبيرته فإذا رأيناه يشعل النار تعالت أصواتنا تكرر آذانه المبتور. وأما خيرة زوجة عمي الطاهر حفظهما الله فكانت تقف معنا أمام الحوش تراقب هي الأخرى آذان الرزڨي وبين يديها قادوس ماء فإذا سمعت تكبيرته أو رأت ناره شربت القادوس كله حتى تكاد يغمى عليها. ثم يدخل الجميع فلا يخرج أحد إلا بعد ساعة أو أقل من ذلك.
* * *
(3)
فرحات شحيمة من أصدقاء أبي فضلا عن كونه ابن خالته. كان بائعا متجولا يطوف جميع القرى والمداشر على حماره المحمل بكل ما يستحقه القرويون من خضرواوات وغلال وشاي وسكر وحلويات. وكان لذلك أوسع معرفة بكل جديد وأكثر اطلاعا على ما جد من أخبار وتقنيات. وكان يزورنا بعد كل إفطار تقريبا ليقضي السهرة مع ابن خالته ويروي له من الأخبار ما التقطه في جولته اليومية. ومما رواه لنا ذات ليلة حكاية من حكايات عم حروكة وحين سألناه من يكون عم حروكة هذا وكيف علم بقصته قال حكاية تمثيلية سمعتها في الراديو ومضى يحدثنا عما في الراديو من تمثيليات طريفة تُعرض كل ليلة بعد الإفطار مباشرة فازداد شوقنا لذلك وطالبنا أبي بشراء راديو لنسمتع بهذه الحكايات فاعترض متعللا بقلة ذات اليد حينا وبما لديه من حكايات تغنينا عن حكايات العم حروكة أحيانا. ولكننا تمسكنا بمطلبنا وساندنا في ذلك العم فرحات ويسّر الأمر على أبي فوعده بأن يأتيه بجهاز الراديو بعد ليلة أو ليلتين مقابل ستة دنانير فقط. كان المبلغ كبيرا لا يقل عن ثمن خروف من خرفان أبي فقد رأيته يبيع خروفا بتسعة دنانير ورأيته يبيع بقرة عجفاء بأقل من ثلاثين دينارا وثورا سمينا بأربعين دينارا. ومع ذلك استجاب أبي لمطلبنا. وجاء الراديو. كان مثل علبة صغيرة فيها مفتاحان وإبرة تتنقل يمينا وشمالا لتحط على أرقام وكلما أدرت مفتاحا سمعت صوتا مختلفا عن بقية الأصوات. وبحضور الراديو صار للمفتاح معنى جديد غير معناه القديم فلم نكن نعرف للمفتاح من صورة غير تلك التي رأيناها في مفتاح الصندوق الأخضر الذي يحتفظ فيه أبي بجملة من الوثائق وصار للإبرة معنى جديد أيضا غير إبرة الخياطة وإبرة الوابور نخزه بها لتشتعل ناره وتقوى. جاء الراديو فاجتمعنا حوله وتسابقنا لتسغيله وإدارة مفاتيحه وكان أبي ينهرنا ويأمرنا بالابتعاد عنه ويحذرنا من مغبة العبث به وخصص له مكانا عليا فوضعه في طاقة في أعلى الحائط وكان لا يفتحه ولا يعلقه أحد سواه في وقت معلوم. جاء الراديو وبمجيئه تحول أبي من حكواتي يروي لنا الحكايات إلى مدير تكنولوجي يتحكم في تلك الآلة العجيبة يفتحها ويغلقها وبتعهدها بالصيانة كلما طرأ عليها طارئ ولم تكن الصيانة تعني في الحقيقة شيئا سوى نفض الغبار عنها وتغيير البطارية إذا فرغت وكان يقول كل هذا بسبب منكم لقد . صار لي مصروف زائد.
* * *
( 4)
دخل الراديو بيتنا فبعثر نظامه القديم وتغيرت عادات كثيرة واتسعت آفاق العالم في أذهاننا. كنا قبل ذلك نعتقد أن العالم هو تونس وفرنسا والجزائر. بل إن تونس هي الكاف وتاجروين فإذا هي أوسع من ذلك. أما فرنسا فلم نكن نحسبها أرضا وكنا نتخيلها في صورة جندي مدجج بالسلاح وأما الجزائر فكانت تبدو لنا بعض قراها ومدنها من بعيد عند كل غروب حين تتلألأ أنوارها. وكنا لذلك نحسبها جزءا منا أو نحسب أنفسنا جزءا منها. لا فرق. واكتشفنا بالراديو أننا مختلفون. فهم يتكلمون بلهجة مختلفة عنا بعض اختلاف وفيهم رجل يعظمونه كما كنا نعظم بورقيبة. وكان بورقيبة أعظم من أن يتسع له خيالنا فإذا هو رجل مثل بقية الرجال يتكلم عاميتنا ويقول (فهمت الحاصل معناها) كما يقول الرجال في بلدتنا ثم تقلصت صورته وتضاءلت حين سمعنا أحدهم يقول (ما جابهاش بن بلة خلّي الحبيب الفرطاس). ومن يكون بن بلة هذا؟ لابد أنه أعظم من بورقيبة ولكنه حسب نص المثل فاشل مثله. و لعل أعظم اكتشاف جنيناه بدخول الراديو هو تلك الفاتحة التي يفتتح بها عبد المجيد بوديدح نشرة الأخبار باللسان الدارج حين يقول في مفتتحها (صحة شريبتكم) لم نكن قبل ذلك نقول هذه الكلمة وكنا نقول (بالشفاء). بدت لنا هذه الكلمة أول الأمر غريبة فالشريبة تصغير شربة الماء ثم علمنا بعد ذلك أنها تصغير الشوربة. نحن أيضا لم نكن نسمي الشوربة شربة وكنا نسميها دشيشة. سقطت أسماء وعلت في المقابل أسماء أخرى وصار اسم بورقيبة من الماضي تماما كالدشيشة ولم يعد للديك أو الظل من معنى إذ صار الوقت يعرف بدقات الجرس على أمواج الإذاعة الجزائرية. وكانت أمي تقول توقيت الجزائر أقرب إلينا من توقيت تونس ثم تبين لنا أنها قد أخطأت فعدنا إلى التوقيت التونسي دون مراعاة الفارق. مضى زمن طويل جدا على زيارة فرحات شحيمة التي جلبت لنا الراديو وها هو يزورنا مرة أخرى بعد غيبة طويلة. كان قد ترك البلدة وانتقل إلى العاصمة. جاء ليجد في بيتنا تلفزة بالألوان. كنا ننتظر آذان المغرب على أمواج إذاعة الكاف وإذا بالمؤذن يرفع صوته في التلفزة فبادر العم فرحات رحمه الله إلى الطعام فقلت له هذا آذان المغرب في العاصمة. قال (نحن نفطر على هذا الآذان وأنتم أحرار). أما أبي فقد وجد له فتوى وقال ( افطر على روحك أنت جاي من تونس وصمت قبلنا)
***
(5)
فاتني أن أقول لكم إن العم فرحات قد عرف بين الناس بكنيته شحيمة لما رأوه فيه أيام الطفولة من بياض ناصع ولكن هذا البياض تحول شيئا فشيئا إلى حمرة مشوبة بسمرة من أثر التجوال في كل الأوقات. وكان له أخ شقيق اسمه يوسف وكنيته الروج إذ كان كأخيه تماما أشقر اللون أصفر الشعر أزرق العينين. ولعل شقرة الرجلين قد ورثاها من والدتهما أم الزين خالة أبي. وكانت اسما على مسمى. وليوسف الروج فضل علينا كفضل فرحات شحيمة أو أكثر فقد كان من القلائل الذين هاجروا إلى فرنسا فزادته الهجرة شقرة على شقرة وعاد إلينا بعد سنوات وبين يديه ماكينة وليست هذه الماكينة آلة حصاد كما قد يظن بعضكم ولا آلة حلاقة فالماكينات كثيرة ومعانيها شتى. إنها ماكينة الغناء المسمّاة تورنديسك والديسكات كانوا يسمونها صحونا. ولا أدري ما العلاقة بين الديسك والصحن فالصحن عندنا وعاء للطعام جاء بعد المعجنة وإذا هو مع الروج دائرة سوداء رقيقة إتودع في قلب الماكينة وتحط عليها إبرة أخرى غير الإبر السابقة فينطلق صوت المغني بأعذب الألحان. كان يوسف الروج يطوف على الديار فيسهر في كل دار سهرة ليطلع الناس على أغان شعبية يغنيها فنانون جزائريون مثل أبي رقعة وبڨار حدة وحدة الخنشة والڨصاب إبراهيم بن دباش وغيرهم. أتساءل الآن كيف عاد الروج من فرنسا بكل هذه الأغاني الشعبيّة ولم يصحب معه صحنا واحدا من صحون الفنانين الفرنسيين. لابد أنه مثلي تماما لا يجد لذة الغناء إلا في أغانينا الشعبية على أني تعلمت لاحقا أن أتذوق أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفهد بلان وفيروز وكل ذلك بفضل الراديو. ومن طرائفنا مع الروج أنه كان ذات ليلة من ليالي رمضان عائدا من عبيدة حيث يقيم بعض أهالينا وكان في زيارة من زياراته الليلية المعتادة لاستعراض ماكينته وعرض موسيقاه على الناس وكنا جماعة من الفتيان حديثي العهد بالتدخين نخرج بعيدا عن منازلنا لنتقاسم سيجارة أو سيجارتين فلما لمحناه يحث حماره على السير خطر لنا أن نعترض سبيله متنكرين وهجمنا عليه دفعة واحدة وأحطنا بالحمار من كل ناحية وظللنا نتراقص دون أن ننبس بكلمة وإذا بعمنا يوسف يرفع صوته مرددا المعوذتين فلما خفنا عليه انسحبنا ولذنا بقمة الجبل. ومن الغد راح الروج يحدث أهل البلدة بالأرواح التي عرضت له وسألوه كيف نجا منها قال : لولا المعوذتان لكنت في خبر كان فيقول له الناس ما جلب لك الأرواح إلا ڨصبة إبراهيم بن دباش وصوت حدة الخنشة
***
(6)
لم يكن على مائدة الإفطار شيء سوى الشوربة والخبز فلا مفتحات ولا محليات. هي أكلة واحدة تتكرر والمتغير الوحيد هو نوع الشوربة إن كان دشيشة أو حلالم أو لسان عصفور. وبتقدم الأوقات دخلت على المائدة أطعمة أخرى لم نكن نعهدها. فالملسوقة مثلا أتتنا من تجربة حليمة أختي رحمها الله وكذلك الطاجين. أذكر أن أبي ظل يسأل عن اسم هاتين الأكلتين ولا يقتنع بالجواب. قال : كيف يسمون هذا طاجينا والطاجين كناية عن كل قبيح وكيف يسمون هذه ملسوقة ولا شيء فيها يدال على الإلصاق ولا على السلق؟ لابد أنه وجد فيهما مذاقا غير معهود ولابد أنه استطاب ذلك وإلا فما سبب حيرته. أما المقرونة فلم تكن ذات شأن عندنا لسبب بسيط وهو أن معجناتنا التقليدية أنفع منها وأطيب ولكن هذه المقرونة لما صارت بالصلصة غير مرمية فقد فعلت ما فعله الطاجين والملسوقة خصوصا إذا كانت فلا بخلاف تلك التي تكون في شكل أعواد طويلة ونحتاج لتناولها إلى الشوكة عوض الملعقة وضعت زينة أختي رحمها الله طبق المقرونة هذا أمام أبي وظل ينظر إليه فتش عن الملعقة فلم يجدها ووجد عوضا عنها شيئا آخر بثلاثة أصابع طويلة. قال: ما هذا؟ هاتوا الغنجاية. فقيل له: الغنجاية لا تنفع في مثل هذه الحالة. خذ الشوكة اغرسها في الطبق واستمر في تدويرها لتلتقط المقرونة. حاول ذلك َمرة ومرتين وثلاث مرات. لم يفلح. رمى الشوكة بعيدا وهو يزمجر غاضبا (هزوا علي الكازي. ما عادش نحب نشوفها. هاتوا لي الكسكسي) كان المسكين صائما ينتظر لذه الإفطار فإذا بهذه المقرونة الأعواد المنثنية تفسد عليه مزاجه.
***
(7)
كان أبي رحمه الله شديد الافتخار بأبناء خالاته وأخواله وأعمامه لا لما بينهم من قرابة بل لما كانوا يتقنونه من حرف متنوعة فقد كان منهم البائع المتجول واابنّاء والحانوتي وكان لذلك يلجأ إليهم كلما هم بإنجاز عمل فإذا عرض له أن يبيع شاة أو بقرة استشار محمدا الأخضر ابن عمه إبراهيم وإذا خطر له أن يفلح حقلا من حقوله الصغيرة المشتتة نادى ابن خاله أحمد الغريسي الملقب بالفلاح دون أهل البلدة كلهم وإذ همّ بترميم الحوش أو المنزل كله لجأ إلى ابن خاله الهادي المعروف بالهاي فقاع لا لعيب في خلقته أو في أخلاقه بل لقدرته الفائقة على اصطناع الحديث في كل شيء تقريبا دون أن يكون لذلك أثر في الناس فشبهوا أسلوبه في الحديث بالفقاقيع سرعان ما تنطفئ. أما أبي فكان لا يكاد يتقن شيئا سوى سرد الحكايات في ليالي الشتاء وفي سهرات رمضان ومعالجة بعض ما يصيب الحمير والبغال دون غيرها من الحيوانات من أمراض. لذلك كان الناس يقصدونه لتزجية الوقت والاستمتاع بخرافاته أو لعلاج حميرهم وبغالهم.. وبينما كان ذات سهرة من سهرات رمضان الصيفية يتصدر مجلس الحكي أمام حوشنا وكان المنصتون إليه جموعا من الرجال والنساء والأطفال إذ اقبل وفد من بني شارن يسوقون قافلة حمير وبغال يقولون إنها أصيبت كلها بأعطاب في أرجلها الأمامية. وطلبوا من أبي أن يعالجها كلها قبل موعد السحور فاعتذر بما كان منشغلا به من الحكي ووعدهم أن يكون لهم ذلك في الليلة المقبلة ثم دعاهم إلى الانضمام إلى مجلسه وكانت الحكاية حكاية أبي جلد صاحب الحمار وكيف صنع لنفسه من جلد حمار له فوزا عظيما إذ كان يلبس ذلك الجلد ويقصد الغابة فإذا بلغ شجرة بعينها نزع الجلد وأوقد النار وتمتم ببضع كلمات سحرية صار جلد الحمار فرسا بجناحين يركبه أبو جلد ويطير في الأجواء قاصدا مملكة الجن في أقصى الأرض حيث ينبت نوع من التفاح يفوح ويرد الروح كما يقال. كان الحاضرون منشدين إلى عالم الحكاية وإذا برجل من وفد شارن يقفز داعيا رفاقه إلى الانسحاب فورا وهو يقول ألم تفهموا الحكاية بعد؟ عمكم رمضان يقول لكم اذبحوا هذه الحمير والبغال واسلخوا جلودها عنها تفوزوا بخيول مجنحة. هيا يا جماعة إلى الغابة قبل أن ينسلخ الليل. قال أبي ما أطيب بني شارن، أيكون ذلك مما جعل البايات يعولون عليهم في أمور دولتهم في هذه الربوع؟
***
/ 8
لأيّام رمضان ولياليه في الصيف صور لا تكاد تكون في مواسم أخرى. يبدأ الإمساك في بلدتنا كما في سائر البلدات باكرا جدّا ولا يكون الإفطار حتّى تنقضي عشرون ساعة إلاّ ثلاثا تقريبا. ومدّة صوم طويلة كهذه في فصل حرّه شديد وأعماله كثيرة تستوجب صبرا جميلا وعزيمة من حديد أو تسامحا كثيرا وتفريطا في العديد من طقوس الصوم للمتدرّبين عليه من الصبيان إناثا وذكورا. وقد كان أبي رحمه الله يدعونا إلى التدرّب على الصوم ونحن لم نبلغ الرشد بعد ولم يكن مع ذلك شديدا بخلاف أمّي رحمها الله فقد كانت تغضب إذا رأتنا لا نطيق صبرا على العطش والجوع فنتناول شربة ماء أو لقمة خبز إذا عدنا من المرعى عند الضحى بعد حوالي ستّ ساعات قضيناها تحت الشمس نلاحق شياهنا في مراعيها البعيدة. وكانت تقول عنّا أمثالكم لا يكون منهم رجال ولا نساء فنندم على ما أتيناه ونستأنف الصوم إلى المغرب وكان أبي لا يغضب من ذلك أبدا ويجتهد في فتاويه وشعاره في ذلك ( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها). لم يكن يحفظ الآية وكان مع ذلك يتمثّل معناها ويعمل به. فتعترض عليه أمّي وتتّهمه بتحريضنا على ترك الصوم ليستفيد من أعمالنا معه في الحقل صباحا ومساء وفي البيدر عند الظهر فيقول: نعم. أليس هذا أحبّ عند الله من تعذيب هؤلاء الأطفال وحملهم على ما لا يقدرون عليه، ومن ترك هذه المحاصيل التي نعتاش عليها تذهب سدى؟ ومثل هذه الفتوى لم تكن تُعجب أمّي حتّى أفقنا ذات فجر فوجدنا موعد الإمساك قد فات عليه وقت قليل. كان الفجر قد طلع تماما وكانت النجوم قد اختفت ولم يلحق أحد منّا السحور وكنت أنا وأختاي خديجة وزينة رحمها الله من المعنيين بالتدرّب على الصيام. أمّا أمّي فقد اعتذرت لنا وتأسّفت لفوات وقت السحور ودعتنا إلى الصوم إن شئنا، وأمّا أبي فقد دعانا إلى تناول السحور في ذلك الوقت إن شئنا الصيام. فاعترضت عليه أمّي قائلة: ألا ترى ضوء النهار قد انتشر في الآفاق؟ فقال: لا بأس، سأغلق الباب وأحجب الضوء عن البيت، تعالوا، خذوا ما شئتم من الطعام والشراب إن كنتم تنوون الصيام. فإن لم تنووا ذلك فهذا فطور صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نوارة، دعي الأطفال يكبروا. وكبرنا، وصار الصوم واجبا علينا ولا حجّة لنا عند أبي وظللنا على تلك العادة حتّى ظهرت فتنة رؤيا الهلال وتفرّق الناس بين مذهب الدولة القاضي باعتماد اليومية لتحديد أول رمضان وآخره ومذهب الإسلاميين القاضي باعتماد الرؤية. وكان من الناس مفطرون وصائمون وانتقلت الفتنة إلى بيتنا ولكنّها سرعان ما انطفأت فقد كان أبي على تسامحه في الدين لا يقبل الخروج عن مذهب الدولة فيه وكانت أمي على تشدّدها في الدين لا تقبل هي أيضا مثل هذا الخروج.
***
9/
تقع بلدتنا جزة جنوب مدينة الكاف وهي من أكثر بلدات هذا الجنوب اتساعا وارتفاعا وعمرانا. وهي شطران بينهما الوادي المعروف بوادي طلحة أحدهما نسميه الظهارة لأنه يقع في ظهر الوادي أي غربه والآخر القبالة أي شرقه. وكانت مع ذلك أبعد البلدات عن عيون الدولة فلم يحظ أهلها منذ الاستقلال إلا بمدرسة واحدة تقع ظهرة الوادي فيها درست ومنها ارتقيت إلى الثانوية. أما قبلة الوادي حيث كنا نقيم فلم تأتها المدرسة إلا في أواخر العهد البورڨيبي. وصادف أن كان ذلك في شهر رمضان فقال الناس رمضان هذا العام أكثر الرماضين بركة علينا. مدرسة صغيرة تتوسط الدوار تتألف من قاعتين ودورة مياه ومعلم وحيد، بلا سياج ولا ساحة مهيئة للأطفال إن شاؤوا اللعب. وكان هذا المعلم الضيف في عيون أهل البلدة القبلية معلما يختلف عن كل المعلمين الذين رأوهم من قبل فهو مثلهم تماما في كل شيء تقريبا بإستثناء الشهادة العلمية التي يفوقهم بها. فقد كان اسمه يونس وهذا الاسم شائع بينهم بل إن دار العم يونس كانت قريبة جدا من المدرسة الجديدة ولم يكن من المعلمين القادمين من جهة الساحل أو الوطن القبلي فهو من بني شارن وبنو شارن أجوار وأصهار. ولم يكن يملك سيارة أو دراجة نارية ولا حتى عادية وكان مع ذلك يفكر في التنقل يوميا بين محل سكناه في عقلة شارن ومقر عمله ولكن أهل بلدتنا الكرام خلصوه من هذه المشقة فقد تبرع له زوج أختي حليمة رحمها الله بحوشه ليسكنه بلا مقابل بعد أن انتقل للإقامة في تاجروين وترك عمل الزراعة واحترف التجارة بدلا منها. وكان هذا الحوش من أكثر الأحواش اتساعا وكان له باب من حديد بأقفال محكمة ومن حوله جنان التين والزيتون والمشمش. فلما اطمأن القوم على سكن المعلم التفتوا إلى مأكله فعقدوا اجتماعا أسفر على برنامج لإطعام المعلم يونس على امتداد العام وأعلموه بذلك فكان لكل عائلة من العائلات المقيمة حول المدرسة يوم في الأسبوع تتكفل فيه بتقديم الغداء والعشاء للمعلم. وتنافست العائلات في ذلك أيما تنافس وزاد رمضان في حدة التنافس فكانت كل ربة بيت تجتهد في إخراج طعامها في أحسن صورة وألذ مذاق وكان ذلك يستوجب ثقافة جديدة في الطبخ اكتسبها نساء البلدة من برامج يذيعها الراديو فتعلمن إعداد الكثير من الأطباق الجديدة ليأكلها يونس هنيئا مريئا. وانتهى ذلك العام الدراسي وغادر المعلم يونس القرية مشكورا على جهده ولكنه لم يعد إليها في العام الدراسي الموالي. هل ترك البلدة لأنه لم يعجبه فيها شيء لا المسكن ولا المأكل ولا الصحبة التي كانت تجمعه ببعض شبان البلدة المتعلمين مثله أو أكثر بقليل؟ ربما.
***
10/
كان لي عمتان اثنتان لا يكاد الناس يفرقون بينهما إذ كانت الواحدة منهما تشبه الأخرى في كل شيء تقريبا. لقد كانتا امرأة واحدة في نسختين متطابقتين فالعينان غامضتان لا تدري إن كانتا خضراوين أو زرقاوين أو مزيجا بين الأخضر والأزرق والوجه أشقر مشوب بحمرة طبيعية لم تلحقه تلك السمرة التي لحقت وجه أبي والأنف ينحدر في انحناءة خفيفة تمنعه من أن يكون منقارا والشعر ينسدل أحمر قانيا َمن أثر الحناء. وكنت إذا رأيتهما َمعا ينتابني شعور غريب وأقول في نفسي لابد أن إحداهما انعكاس للأخرى وأنظر حولي لعلي أرى مرآة عاكسة فلا أظفر بشيء. ولم أتخلص من هذا الشعور إلا بعد أن رأيت عمتي مباركة مستقيمة الظل ورأيت عمتي فجرية منحنية الظهر لا تقوى على الوقوف باستقامة وسألت أمي عن سر هذه الانحناءة الغريبة التي لحقت بها فذهبت بحسن قوامها فقالت : عمتك مباركة أنعم الله عليها بالبنين والبنات من زوج يكرمها وينفق عليها بلا حساب. ألا تعرف الشاوش محمود؟ كان من خدام جدنا وسيدنا طلحة وكان إلى ذلك رقيقا لطيفا من أثر ما تعلمه في الجامع من الأذكار والمدائح. أما عمتك فجرية فقد شاء الله أن يحرمها من ابنها الوحيد. قلت : أمات ابنها الطيب؟ قالت: بل اسمه الحقيقي العيد وضعته يوم عيد الفطر، وهو اليوم حي يرزق ولكنه لم يعش معها إلا سنوات. لقد فر من أمه وأبيه ولم يبلغ الرشد بعد جراء ما لحقه من الضرب والإهانة لأتفه الأسباب. أرأيت كل هذه الرقة في عمتك فجرية؟ هي لا تعدل ما كانت عليه قبل ذلك بأعوام طوال والسبب في ذلك غلظة زوجها أبي جمعة وقسوته عليها . لم أستسغ حديث أمي عن عمتي ولعلها لمحت ذلك في قسمات وجهي فقالت : عمتك هذه إمرأة من حديد ولو أن الذي أصابها أصاب غيرها لماتت ولكنها صمدت وتلقت المصيبة فلم تنل منها إلا لماما. قلت : وما قصتها؟ قالت تزوجها أبو جمعة صغيرة وحجزها في حوش عال لا تخرج منه إلا نادرا من فرط حبه لها وغيرته عليها من العيون وكان قاسي القلب غليظا شديدا عليها. وضعت ابنها العيد في سنتها الثانية من الزواج ولم تضع بعده أبدا. أو تدري لماذا؟ لأنها كانت ترى ابنها يضرب ويرفس فتثور على أبيه دفاعا عنه. فيضربها أبو جمعة بعصاه ويرفسها بقدميه. قلت : ومن أين جاءه الاسم الثاني؟ قالت: فر العيد ولم يعلم الناس له وجهة. فتشوا عنه في البلدات المجاورة وسألوا عنه الناس في تاجروين والدهماني والكاف فلم يفدهم أحد بخبر عنه. وسافر أبو جمعة إلى العاصمة وعاد بعد أسبوع أو أكثر بخفي حنين كما يقال. أما عمتك فجرية فدخلت في حداد أسود قاس وهامت على وجهها شهورا وظل أبو جمعة يلهث خلفها فلم يهدأ لها بال حتى جاء رجال الحرس الوطني ذات يوم فأخذوا أبا جمعة واقتادوه إلى المركز فلما عاد سأله الناس عن سبب هذه الدعوة فقال: فر العيد منذ سنوات وعييت في البحث عنه حتى يئست منه ولكن رجال الحرس قالوا لقد قبض عليه مع جملة المعتقلين من عناصر الفتنة اليوسفية في ناحية من نواحي بنزرت وقد أفاد في التحقيق أنه ابن أبي جمعة وابن فجرية من جزة. فهل هو ابنك؟ قلت نعم. فقدته منذ سنوات. ثم قالوا: هو الآن محكوم عليه بالسجن واسمه المدني الطيب اليعقوبي ولك أن تزوره. قالت أمي: وأمضى العيد الطيب في السجن ثلاث سنوات ثم نفي إلى سوسة حيث يقيم اليوم وهو لا يزور البلدة إلا نادارا. وشاءت الأقدار بعد أربعين سنة من فرار العيد الطيب أن أكون طالبا في دار المعلمين العليا بسوسة وأن أزور ابن عمتي في منزله وأن أسمع منه ما لم تروه أمي ولم يروه أبو جمعة
***
/11
سألت العيد عرفا الطيب شرعا عن قصة فراره من أمه وأبيه فقال: كان الفصل وقتئذ صيفا حارا وكان الشهر شهر رمضان وأذكر أني كنت أقصد حانوت الهريسي بعد كل إفطار للعب الورق. كان اللعب قمارا وكنت أختلس كل غروب بيضة أو بيضتين من بيض الدجاج الكثير الذي كانت تربيه أمي. وأنحدر نحو الحانوت مسرعا خشية. أن تفوتني حصة القمار وخوفا من تفطن أحدهم إلي وأنا في قن الدجاج. وأذكر أني جمعت من القمار بعد نصف شهر تقريبا مبلغا كنت أعتقد أنه يكفيني لاقتطاع تذكرة السفر إلى العاصمة على متن القطار. ولكن مصاريف التدخين أخلت بهذه الموازنة وأيقنت أن الهروب مستحيل إن استمر الوضع على هذه الوتيرة فخطر لي أن أبيع خروفا من خرفان أبي كنت أرعاها كل يوم. وكان الأمر كذلك. كنا وقتها نرعى القطعان في الموضع المعروف بالتلة بعيدا عن منازلنا. وكانت التلة في طريق الخضارين من عبيدة يمرون عليها كل يوم اثنين ليبيعوا خضراواتهم في سوق تاجروين. وأذكر أني عرضت على أحدهم خروفا اخترته فابتاعه مني بثمن بخس ولكنه يكفي لشراء تذكرة. ثم تركت الشويهات وقصدت محطة القطار في موضع نسميه المسخية. كانت المسافة بعيدة ولكن الخوف والرغبة في الخلاص من القهر جعلني أطويها طي السحاب. وأدركت قطار القلعة الجرداء. كانت الرحلة طويلة حتى أكلتني الوساوس. في عربة القطار فكرت في الوجهة التي أنا موليها. أين سأنزل ؟ وأين سأقيم؟ وماذا سأصنع؟ أسئلة لم تطرأ على بالي قبل ذلك. كنت قبلها منشغلا بخطة الفرار وهاهي الآن تهجم علي دفعة واحدة. ومع ذلك لم أفكر لحظة في الرجوع. في العاصمة وجدت نفسي في الزحام فزاحمت مع المزاحمين. لا أدري علام كان الزحام ولكني زاحمت حتى وجدت نفسي في عربة قطار آخر قيل لي بعد ذلك إنه قطار بنزرت. لم أسمع بهذا الاسم من قبل. وجاء مراقب التذاكر فطلب مني التذكرة. كنت في الزحام ولم أقتطعها. قال أين تقصد ؟ قلت لا أدري ولكن أريد تذكرة بأقل سعر ممكن. وتقود إلى أبعد نقطة عن العاصمة قال: يمكنك أن تقصد ماطر. رأى في عيني حيرة فقال هي في الوسط بين العاصمة وبنزرت وأظن أنها تليق بك. لابد أنه لاحظ هيأتي الريفية فاختار لي هذا السبيل. وقد أحسن الاختيار حقا. أدركت ذلك حين وجدت نفسي في بلد كثير البساتين والمزارع وسهل علي الانخراط فيه. عملت شهورا عدة في الزراعة وتيسر لي ما كان عسيرا على.،فقد انضممت إلى قوم علموني القراءة والكتابة ودربوني على القتال وقالوا حين أخبرتهم بأصلي وفصلي: لا عدو لك اليوم إلا هذا المحتل الأجنبي وهذا الذي يفاوضه على استقلال داخلي. قلت أنقاتل بورقيبة ؟ قالوا : نحذره ولا نقاتله حتى يقاتلنا. وكان الأمر على هذا النحو ولكن بورقيبة كان الأقوى. حوصرنا في مخيم على أطراف مدينة ماطر فمات من مات واعتقل الباقون. وكنت من الباقين.
***
12
بدا للكثير منكم أن أبا جمعة زوج عمتي رجل فظ غليظ قلبه قاس أو هو بلا قلب. أنا أيضا كنت أقول عنه ما تقولون بل كنت حين أراه بعمامته البيضاء ولحيته البيضاء وعصاه البيضاء أيضا أحسبه ملك الموت فأحيد عن طريقه خشية أن يقبض علي. من أين جاءت هذه الصورة وكيف سكنت رأسي وأوحت لي بما أوحت؟ لابد أنها صنيعة تلك الأحاديث التي ترويها عمتي عنه أو ربما من حرصه الدائم على حماية بستانه وما فيه من أشجار التين و المشمش واللوز من عبث العابثين. فقد كنا نحن الأطفال لا نبقي من ثمار الأشجار شيئا لأصحابها بل كنا لا ندعها تنضج في أغصانها فنقطفها وهي في أول الظهور وكان بستان العم أبي جمعة البستان الوحيد الذي يمتنع علينا ولكن ثماره الناضجة كانت تصلنا فنأكلها من يدي عمتي. كنت كما أسلفت أنظر إلى أبي جمعة من هذا المنظار ولكني رأيت فيه بعد ذلك صورة رجل آخر إذ تبين لي وأنا تلميذ أستعد لامتحان الباكالوريا أنه لم يكن يكره الأطفال بل كان يكره أن يكونوا أشرارا مفسدين فإذا كفوا عن ذلك كف عنهم غضبه. وكان لما رآني أنضج وأتزن يدعوني لمساعدته في أمر من الأمور كأن أقرأ له رسالة وصلت من ابنه الطيب أو أكتب له رسالة ترد عليها. وآذكر أنه دعاني يوما لأنظر في حزمة من الأوراق النقدية لم يعرفها كان يعرف أنها ليست من الدنانير التونسية ولكنه لا يعرف إن كانت دنانير جزائرية أو فرنكات فرنسية وكان يتمنّى أن تكون فرنسية فلما علم أنها ليست كذلك ضحك من نفسه ضحكة لم أرها من قبل وقال (الطماع يبات ساري). أبو جمعة يضحك إذن ويضاحك أيضا بل هو أرق من ذلك. فقد قرر ابنه الطيب ذات صيف أن ينقل أباه وأمه للإقامة معه لما بدأ يظهر عليهما من العجز فاستجابا له وظلا عنده في سوسة الصيف والخريف وبعضا من الشتاء. كنت وقتها طالبا بدار المعلمين العليا وكان أبي يحثني على زيارة عمتي والاطمئنان عليها. فلما اقترب موعد العطلة زرتها لأنقل أخبارها إلى أبي ولكن ابا جمعة دعاني إلى المقهى ليخبرني بخطة رسمها مع عمتي للعودة إلى جزة والخلاص من هذا السجن الذي وضعا فيه كما قال. وملخص الخطة أن تقول لي عمتي بحضور ابنها أنها ترغب في العودة معي إلى الكاف لزيارة الأهل فإذا انقضت العطلة عادت معي.، وأن أضمن أنا عودتها إذا شك الطيب في ذلك وأن أعود بعد العطلة دونها فإذا حصل ذلك لحق بها. قلت ضاحكا: ولكن العيش هنا أفضل لكما فقال: ألا تفهم؟ أنت تفهم فلا تلعب دور الناصح. وكان الأمر كذلك.
***
13
تمكين النساء من حقهن فى الإرث المنصوص عليه شرعا وقانونا أمر غير معمول به في بلدة أغلب سكانها من الفقراء إذا لا يجد الناس ما يمكن تقاسمه بينهم وجرت العادة على أن يؤول الميراث لمن ظل مقيما في بيت من رحل من الآباء. حتّى الرجال الذين تركوا البلدة ونزحوا عنها لم يلتفتوا في الغالب إلى ما تركه الآباء ولكن العمتين مباركة وفجرية قررتا ذات يوم المطالبة بحقهن في ما ترك أبوهما عمار. لا أدري كيف طرأت الفكرة عليهما ولا كيف خططتا لتنفيذها. ما أعلمه أنهما حلتا علينا ضيفتين في إحدى ليالي رمضان وكان الفصل صيفا وأن العمة فجرية دعت أبي بعد الإفطار إلى الحديث معها في أمر خاص. ظن الجميع أن الموضوع خلاف بينها وبين زوجها كالعادة ولكنها أتت بجديد هذه المرة. قالت تخاطب أبي: يا ابن أمي، سأقول كلمات قد لا تعجبك ولكنها حق. نحن نريد منابنا مما ترك الوالد. قال أبي: ولكن منابكما ليس عندي وحدي. هو مفرق بيني وبين أبناء إخوتكم. مات أخوكم عمر وترك رجلين وامرأتين ومات أخوكم الزين وترك رجلين وثلاث نساء. وها أنا حي أرزق وعلى استعداد تام لتأخذا هذا الحق. فقالت العمة مباركة: أنا في الحقيقة لا أحتاج إليه ولكن يحلو لي أن آخذه. وظللنا طيلة السهرة نسمع حديثا من هذا القبيل بأساليب شتى حتى تم الاتفاق على دعوة المعنيين بالأمر كلهم إلى اجتماع للنظر في هذه القضية الطارئة وأن يكون ذلك في أيام عيد الفطر. كان اثنان من أبناء عمي عمر يقيمان في العاصمة أحدهما وهو أحمد لا يكاد يزورالبلدة آبدا وكنت أعرفه سماعا لا عيانا. والثاني وهو السايح ودود كثير التردد على البلدة رغم طول المدة التي قضاها مهاجرا في فرنسا. وتولى أبي التنسيق مع أبناء عمي الزين وهما المختار الديمقراطي والطاهر المعروف بالدبوس وإعلام أحمد والسايح للحضور في اليوم الثاني من أيام العيد والنظر في طلب العمتين. وحضر المعنيون كلهم وكان الاجتماع في منزل الدبوس وسمح لنا نحن الأطفال بحضور الجلسة كما سمح للنساء كلهم. ودار النقاش. كانت العمة فجرية هي الأجرأ والأوضح وكانت عمتي مباركة تكتفي بالمصادقة على ما تقول أختها أو بتوضيح ما بدا غامضا أو غير مفهوم أو بتعديله تعديلا طفيفا ليناسب المقام ويحافظ على هدوء الحال. وأسفر الاجتماع على اعتراف الكل بحق العمتين وعلى استعدادهم لتمكين الطالبتين منه. ولم يبق شيء سوى التنفيذ. قالت العمة فجرية؛ ليكن ذلك قبل عيد الأضحى. قال السايح : فكرة جيدة. وستكون مناسبة للاحتفال بعيد الأضحى هنا. ثم جاء العيد وحضر الجميع وجيء برجل قيل إنه يفهم في المواريث وعرضوا عليه القضية فاستعصت عليه لتشتت الأرض وقدم المسألة وسقوط الكثير من عناصر الميراث فلما أدركت العمة فجرية ذلك اقترحت فكرة فاجأت الجميع. قالت: نترك حقنا في رقابكم فلا نأخذه منكم شرط أن تزورونا كلكم مرة كل صيف. كانت تعني أحمد والسايح فالباقون قريبون منها تزورهم ويزورونها باستمرار. وكان الأمر كذلك.
***
/ 14
كان أبي يكاد يختصّ دون رجال البلدة كلها باسمه وهو رمضان ولعلّ ذلك ممّا جعله ينجو من الألقاب الملحقة بمن كانت أسماؤهم متكرّرة مثل محمّد وعلي وعبد الله وإبراهيم وغيرها من الأسماء الشائعة. وهي في الغالب ألقاب وكنى تشير إلى صفات بارزة في أصحابها ألحقوها بهم ليميّزوا محمّدا من محمّد أو عليّا من عليّ أو غير ذلك من الأسماء. فمن المحمّدين من سُمّي الطيّور لخفّته ومنهم من سمّي الأنديشي لمشاركته في حرب الهند الصينية. ومن العلويّين من سمّي بازوكا لإدمانه لعب الورق واحترافه فيه وربّما لمشاركته في الحرب العالمية الثانية ووقوعه أسيرا لدى الألمان، ومنهم من سمّي البوهالي ربّما لما رأوه فيه من السذاجة ولم يكن كذلك أبدا، ومنهم من سمّي البكّوش وقيل إنّه لم ينطلق لسانه إلاّ في الخامسة من عمره. أمّا أبي فلم أعرف له كنية شائعة سوى أنّ بعض الأباعد كان يسمّيه الداني وسألته عن ذلك فقال: لم أكن في طفولتي الأولى أتقن النطق باسمي وكنت أقول عن رمضان دان فاستعذب بعضهم ذلك لما رآه في الدال المفخّمة من اجتهاد في نطق الضاد وصار يناديني الداني. والسبب في تسميته رمضان أنّه ولد في شهر رمضان ومن المصادفات أنّه مات في رمضان أيضا. لم تشهد عائلتنا موتا منذ أكثر من عشر سنوات، وها أن الموت يتردد على أبوابها. في رمضان الذي سبق رمضان ذلك العام مات عثمان ابن عمّتي في حادث مرور فظيع، كان قادما من العاصمة لزيارة أمّه ولكنه مات. وها أنّ أبي يموت بعده بسنة. صار لنا مع رمضان قصّة موت تروح وتغدو. مات أبي. كان ذلك في مثل هذا اليوم من شهر الصيام أي ليلة النصف. مات ولم يمض على مرضه أكثر من أسبوع. زارني قبل مرضه رفقة أمّي ليباركا لي الحصول على مسكن خاص بعد معاناة الكراء. وكان في زيارته تلك سليما معافى لا يشكو من شيء. سمعته ليلة زارني يقول لقد آن لي أن أنام. حسبته يريد النوم حقيقة ولكنه كان يشير إلى نهاية القصّة. في الليلة السابعة من رمضان ذلك العام انتابني شعور بالضيق لا عهد لي به. تركت مائدة الإفطار وجلست في شرفة المنزل وتنهّدت تنهيدة عميقة لم أكد أنهيها حتى رنّ الهاتف. هذا أخي صالح على الخط. لم يسلّم ولم يقل صحة شريبتك. قال بنبرة المستعجل: الحق أباك، فقد وعيه منذ دقائق. نصحونا في مستشفى تاجروين بنقله إلى مستشفى الكاف. وهناك قيل لنا إنّ جلطة في الدماغ تسببت له في شلل نصفي. لم تتعدّ مدة إقامته بذلك المستشفى ثلاث ليال، وكانت أمّي هي من يرعاه هناك. سألت الطبيب عنه فقال بلغة فرنسية باردة: لديّ أربعة شيوخ لابدّ من التخلّص منهم وأبوك منهم. لم أستسغ حديثه فتركته، كان يريد أن يقول إن حالتهم مستعصية وإن الإبقاء عليهم في المستشفى يضرّهم ولا ينفعهم والأفضل إذن أن يغادروا ليموتوا بين أهلهم. عدت إلى أبي في فراشه. هاهو مستلق على ظهره لا يقوى على الحراك. عيناه مغمضتان. كنا حوله جميعا. وكان يسمع بكاء أخواتي خاصّة ويشعر بنا. مددت يدي إليه فأمسك بها وأشار بسبّابته اليمنى نحو الجنوب. كان يريد أن يقول عد بي إلى البيت. وعدنا به. كان الناس قبل مرضه يجلسون إليه ليسمعوا حكاياته، وها هم اليوم يجلسون إليه وهو صامت لا يقوى على شيء وهم يتحدّثون عنه وعن أيامهم معه. لم يخل بيتنا من الزوار طيلة مرضه، لابدّ أنه يسمعهم. بل هو يسمعهم. ثم مات أبي في ليلة النصف تماما قُبيل آذان المغرب بدقائق معدودات. قالت أمّي: قبل ذلك بقليل تناول تفّاحة من يدها وحاول أكلها ولكنه لم يقدر، لم يكن يرغب في شيء قبل ذلك. مات أبي. وجاء الناس ليشهدوا موته. رأيت رجالا لم أرهم منذ عشرين عاما أو يزيد. بعضهم قال لي: كن أنت بدلا منه في كل شيء. وها أنا أحاول منذ أكثر من عشرين سنة أن أخلفه. أما أخي صالح فقد خلفه حقا وصار الناس ينادونه الداني.
***
15 /
لا معنى لرمضان في بلدتنا دون تلك الحوانيت الصغيرة التي يقصدها الشباب والكهول بعد كل إفطار للعب الورق ولا يعودون منها إلى بيوتهم إلاّ قبل موعد الإمساك بساعة أو أقلّ. وكانت هذه الحوانيت في البدء من اختصاص بني عريس مثل حانوت الهريسي وحانوت إبراهيم زرتوتة وحانوت ابن زينة ثم نافسهم في ذلك بنو براشن فافتتح غومة حانوتا وكذلك فعل أخوه الهادي فقاع. والفارق بين حانوت وحانوت لا يكاد يتعدّى اسم صاحبه. فقد كانت كلّها ضيّقة وكانت أبوابها زرقاء ولا تتعدى مساحة الواحد منها العشرين مترا مربّعا. وكانت مع ذلك تتّسع للوافدين عليها فتتشكّل فيها حلقات تبدأ عادة بتبادل الأخبار والخوض في أحاديث شتّى ثم يأتي دور اللعب. وكان حانوت غومة من أكثر الحوانيت جذبا للشبّان لما عُرف به صاحبه دون أصحاب الحوانيت الأخرى من انفتاح على الشباب قد يعود إلى إقامته الطويلة في العاصمة قبل أن يقرّر العودة إلى البلدة والاستقرار بها. وكان حانوته على قارعة الطريق خلافا لسائر الحوانيت التي خيّر أصحابها أن تكون في زاوية من الزوايا كأنّهم يريدون إخفاءها عن الأنظار لما قد يحتمله الحانوت من معان سلبية. نأتي بعد الإفطار مباشرة فنجد العمّ غومة قد هيّأ المكان ورتّبه أحسن ترتيب. زجاجات الفانتا والكوكا الكبيرة والصغيرة ترقد في حوض ماء بارد أو في حوض رمل مبلّل، وعلب السجائر مرصوفة في طاقة في الجدار وبجانبها صناديق صغيرة لشتّى أنواع الحلوى، والحصير الأزرق مفروش تتوسّطه مائدة صغيرة زرقاء ومن حولها الوسائد وأمام الباب المفتوح أبدا كانون ينتصب فيه برّاد الشاي الأحمر والعم غومة متكّئ في ناحية من الحانوت على فراش مصنوع من بقايا القماش نسمّيه كليم الشوالق. فإذا دخلنا وألقينا عليه التحية هزّ رأسه وأشار علينا بالجلوس وشرع في سرد بعض مغامراته في العاصمة ريثما يكتمل النصاب، فإذا اكتمل جاءنا بالورق ووزّع علينا قوارير الكوكا والفانتا وكؤوس الشاي. وكنّا كثيرا ما نُضرب عن اللعب لما نجده في أقاصيصه من عذب الكلام و غريب الوقائع. ومن طريف ما حدّثنا به أنّه كان في أوّل عهده بالعاصمة يعمل أجيرا في حظيرة بناء في شارع الحرّية غير بعيد عن مبنى الإذاعة وأنّه دُعي ذات يوم لشراء وجبة الغداء فلما كان يصعد السلم محمّلا بكيس فيه خبز وجبن وسردين وزجاجة فانتا اعترض سبيله شابّان اثنان وسخرا من هيئته وحاولا افتكاك ما بين يديه. قال: تخلّصت منهما بلباقة حتّى سلّمت سلّة الغداء لرفاقي ثمّ أخذت من الحظيرة قضيبا من حديد ونزلت السلّم مسرعا. ناداني رفاقي أين تقصد فقلت دقيقتان وأعود. في الطابق الأرضي وجدت الشابين ورأيتهما يهمّان بالخروج فناديتهما أن تعاليا إليّ وانهلت عليهما ضربا بذلك القضيب حتّى علا صياحهما وسمع الرفاق الصياح فجاؤوا مسرعين وأنقذوا الشابين من موت محقّق. قالوا: لم كلّ هذا العنف يا غومة؟ قلت: أبلهان يسخران منّي وكادا يأخذان سلّة الغداء. فقالوا: اهدأ يا غومة. ما هكذا تجري الحياة. ثمّ مات غومة بعد تسعين سنة. ولم يكن موته غريبا. مات كما يموت أغلب سكّان البلدة، إمّا لإفراط في العيش، أو لعدم اعتراف بالطبيب، أو لانحناء ضروريّ أمام الأقدار. غومة عاش سبعين عاما بلا أمّ ولا أب ولا زوجة ولا أبناء. حتّى أهل بلدتنا الأقربين والأبعدين لم يكونوا على صلة به، فقد عاش بعيدا عنهم في حيّ عتيق من أحياء العاصمة. ولكنه عاد إليهم بعد السبعين وتزوّج منهم وأنجب أطفالا ثم رحل فرحل أطفاله وتركوا البلدة كما تركها هو من قبل. ولم يبق من غومة شيء سوى قبر بين سائر القبور، وبعض الأحاديث منها أنّ الحياة الدنيا كلعبة الورق تماما. يلتقط اللاعب أوراقه عشوائيّا، والحاذق هو من يحسن التصرّف في ما بين يديه من أوراق لتحقيق كسب أو تفادي خسارة أو الحدّ من آثارها.
***
/ 16
كان عامر رحمه الله صامتا أبد الدهر لا نكاد نعرف له صوتا. سوى صوت مهراس ضخم يهرس به الحلفاء ليصنع منها قفة أو بردعة أو حصيرا. وكان حوشه بخلاف جميع الأحواش في البلدة عبارة عن سلسلة من الصخور العظيمة استند إليها العم عامر فبنى بيتين صغيرين أحدهما للنوم والآخر يصلح أن يكون مخزنا لخزن الحبوب أو مطبخا لإعداد الطعام أو حتى مبيتا لضيف طارئ. وكان فضلا عن صمته الدائم يديم الجلوس فوق صخرة من تلك الصخور عليها يهرس الحلفاء ويجلس إليه كل من لا شغل له حتى تحولت سلسلة الصخور إلى مجلس عام يجذب إليه الرجال و الشبان في كل الأوقات. وكان من أبناء عامر شاب يسميه الناس عنترة ولم يكن ذلك اسما له في الحقيقة بل كان اسما ألصقناه به نحن لما رأيناه فيه من غلظة وتمرد. فقد تسبب يوما في تحطيم سن واحد من توأمين لم نكن نفرق بينهما وهما عمر وأبو بكر من أبناء إبراهيم بن إسماعيل. وبانشطار سن عمر إثر صفعة عفوية من عنترة صار بإمكان كل أهل البلدة تمييز عمر من أبي بكر وكانوا يدعون لعنترة بالخير رغم ما في فعلته من الأذى. حدث ذلك ذات قيلولة حين كنا نستعد للعب مباراة في كرة القدم بعد أن عدنا من مراعينا وأودعنا أغنامنا في زرائبها. كنا قد انقسمنا فريقين وكان عنترة حارس مرمى لا لأنه يجيد الحراسة بل لأنه لا يحسن ترويض الكرة بقدميه ولا يعرف إلا أن يمسكها بيديه. انطلقت المباراة وإذا بعمر قد لحق بنا وكان يريد الانضمام إلى أحد الفريقين فرفضنا لكنه أصر على ذلك وتوقفت المباراة ودار نقاش أزعج عنترة فترك مرماه وااقتحم كوكبة المتجادلين بدفعة من يديه كان مآلها في وجه عمر فشطر سنا من أسنانه. ولم ينشأ عن تلك الحادثة شيء مما يجب أن ينشأ في العادة فلا عمر استاء ولا شقيقه أبو بكر ولا دارت معركة وغرقنا كلنا في موجة ضحك جنوني أنسانا المباراة. ومن طرائف عنترة أيضا أن اجتمعنا ذات ليلة من ليالي رمضان في حانوت محمد الأخضر المعروف بالقريد لقصر قامته ولما في مشيته من قفز يشبه قفز القردة. ولم يكن هذا الحانوت فضاء للعب الورق كحانوت غومة الواقع قبالته بل كان حانوتا لبيع الغلال والخضروات وسائر المواد الغذائية وخطر لنا أن نلعب لعبة فكتب أحدناالأسماء وطويت الأوراق وبدأ الفرز وكان لا يظهر في كل فرز الا اسم واحد هو عنترة فدفع مرة ومرتين وثلاثا ثم انفجر غاضبا:. إلا يظهر غير اسمي؟ فضحكنا حتى كاد يغمى علينا ولكن عنترة تمسك بمعرفة السر ففتحت الأوراق كلها فإذا فيها اسم واحد هو عنترة. من فعل ذلك؟ فعلها الكاتب طبعا وهو من يروي لكم القصة الآن.
***
/ 17
كل ما في بلدتنا مقسوم موزع بين النساء والرجال لا يكاد طرف يجتاز حدوده ليلعب دور الطرف الثاني. وهذا قانون سار في كل مقام هزلا كان أم جدا. ويحدث أن يخترق الناس هذا القانون ويعبثوا به ولا يعترض على ذلك أحد. فالغناء والرقص في الأعراس عمل من أعمال النساء خاصة وللرجال في هذه الحفلات الطبل والمزمار وركوب الخيل والأذكار والأشعار. وكان من رواة الشعر في بلدتنا رجال منهم محمد التيتش ومَحا بن زينة ومن الشبان أبو القاسم الخراط والمنصف جاب الله. وصار أبو القاسم هذا يعرف بين الناس بكنيته فقد سمّوه نكّارة لتردد هذا اللفظ في قصيدة كان يلقيها في كل حفل. وكان ذلك سببا في انقطاعه عن إنشاد الشعر في الأعراس ودعاه الناس إلى العدول عن قراره والعودة إلى تنشيط السهرات كما كان يفعل وكان جوابه في كل مرة أن يقول لهم: لكم في المنصف جاب الله ما يغنيكم عني فيقال له ولكن هذا المنصف شاب لا يراعي الأذواق ويأتي في ما ينشد بصور وألفاظ لا تليق. ألم تسمع قوله في عرس:
الشعير المقلي
عند الزراع ما ينبتش
وكلام الطحان ما يثبتش.
ولكن نكّارة ظل يرفض هذه الدعوات ويعد الناس بما هو خير من الشعر وإنشاده. فإذا سألوه عن ذلك قال سترونه قريبا. وظل الناس ينتظرون حتى طلع عليهم نكارة ذات ليلة متنكرا في لباس إمرأة تضع خلخالين في الساقين وقرطين في الأذنين وتعصب الجبين بعصابة حمراء وتشد الوسط بحزام من حرير ثم جلس حيث يجلس النساء فلما جاء الدور على الرقص قفز نكارة من مكانه واندفع إلى الساحة في رقص أبهر الناس وهم يتساءلون عن الراقصة من تكون. خُتمت الرقصة وانتظر الناس عودة الراقصة إلى مجلسها ولكن نكارة اندس بلباسه النسوي في صف الرجال وطفق ينزع عنه الخلخال والحزام والقرطين والعصابة حتى أدركوا حقيقته. وتعالت في الأجواء هتافات تردد اسمه يا نكارة يا متنكر. كم كان بائس الحظ لقد فر من نكارة فوقع في التنكر. وبتطاول الأوقات رضي أبو القاسم بتلك الكنية وصار في كل حفل ينشد الشعر في صورة الرجال ويرقص في صورة النساء.
***
18 /
لم يكن في البلدة كُتاب واحد لا قبل ظهور المدرسة ولا بعد ذلك أيضا رغم وجود عدد ممن يصلح لأن يكون مؤدب صبيان مثل سي رحيم وسي محمد جنيور وسي على. فهؤلاء الثلاثة ألصق بهم حرف السين مكسورا دلالة عما كان في صدورهم من القرآن ومع ذلك لم يتقدم واحد َمنهم لافتتاح كُتّاب. أما سي رحيم فكان مختصا في وصف الأعشاب لعلاج ما يصيب النساء والأطفال من أمراض وأما سي محمد جنيور فلا أدري من أين جاءه هذا اللقب فالبعض يقول الجنيور تعني المهندس ولا شيء في الرجل يوحي بالهندسة والبعض يقول اسم يعنى في الفرنسيّة الصغير أو الثاني وهذا ممكن ولكنه مستبعد فقد كان أخوه الأكبر يحمل اللقب نفسه وهو علي جنيور فلم يبق للقب معنى سوى أنه تحريف لحق بلفظ الجنرال إذ كان الأخوان علي ومحمد في صفوف الجيش الفرنسي. وكان سي محمد جنيور هذا قد حاول أن يكون مؤدبا ولكن ظهور المدرسة قريبا من مسكنه حرمه من ذلك فلم يلتفت إليه الناس. وأما سي علي فكأن أشهر الثلاثة وكان يجمع بين وصف العلاج بالأعشاب والقرآن وكان مقصد الناس من كل الآفاق يكتب لهم الحجب والتعاويذ لا للوقاية من كيد الشياطين ومس الجن فحسب بل لجلب الحظ وفك العقد واستخراج الكنوز من باطن الأرض أيضا. هكذا قيل عنه ولعل ذلك مما جعله مهابا في أعين الناس يخشونه كما يخشون لقاء ربهم وأكثر. ولم يكن يفعل ذلك مع أهل البلدة أبدا إذ كان حرفاؤه يأتونه من أماكن بعيدة جدا لذلك كان كثير الغياب عن البلدة ولم يتسن لي أن أتحدث إليه إلا مرة واحدة. كان ذلك أيام كنت تلميذا بالثانوية. كان اليوم يوم سبت وكنت عائدا من المبيت إلى دارنا كعادتي في نهاية كل أسبوع سيرا على القدمين وفي الطريق أدركني سي علي علي بغلته الشهباء. في جبة بيضاء وعمامة صفراء ناسبت ما في شاربه من صفرة دائمة من أثر نفة يستنشقها باستمرار. وظل على امتداد المسافة يسألني عما أفدته في الثانوية من معارف في النحو والصرف والبلاغة والشعر وكنت أعرض عليه ذلك فيناقشني في بعض المسائل وعلمت بعد ذلك أنه كان يحفظ ألفية إبن مالك والأجرومية أيضا. ورأيت نسخا من هاتين المدونتين ومن كتب أخرى مثل شمس المعارف الكبرى للبوني وتفسير الأحلام لابن سيرين والرحمة في الطب والحكمة لجلال الدين السيوطي وهي كتب ورثها عنه ابنه إبراهيم واستفاد منها في وصف الأدوية وتحرير الحجب للأطفال والنساء. أما ابنه الآخر وهو محمد الزاهي فلم يرث عنه شيئا واكتفى في حياة أبيه بخدمة مقام الولي طلحة بن عادل فلما مات أبوه بنى له قبرا وشيد عليه صرحا كأنه يريد له أن يكون وليا من أولياء الله ولكن أهل البلدة كرهوا ذلك منه وعابوه فهدم الصرح وجعل الأرض التي كان فيها مقبرة للجميع وهي إلى اليوم في وسط الدوار خلافا لكل المقابر. ثم إن الزاهي انقلب فجأة من زاهد في الدنيا مقبل على خدمة الأولياء ينشد الأذكار في الحضرة إلى مغن في الأعراس واكتشف الناس فيه مهارة أخرى غير الإنشاد الديني والغناء فقد كان إلى ذلك يتقن النقر على الطبل والنفخ في المزامير ولكن ذلك لم يساعده كثيرا على الانخراط في حياة الناس اليومية فقد ظل الزاهي بلا زواج حتى مات وكان يسكن كوخا صغيرا بعيدا عن منزل أبيه وسط بستان له سياجه من التين الشوكي المسمى عندنا الهندي. وقد أوحت هذه القصة لعمه محمد المعروف بالسفير بتأليف أحجية عرضها على الناس فقال ( دلوني على أحمر بلندي يسكن الهندي تنالوا كل ما عندي) وكان يعني الزاهي فقد كان أشقر وذلك هو معنى الحمرة وكان طويل القامة وهو معنى البلندي.
***
/ 19
كانت مدرستنا في أول تأسيسها تتألف من ثلاث قاعات يحيط بها سياج قصير وخارج السياج مسكن ملحق بها يقيم فيه مدير المدرسة إن كان متزوجا فإن لم تكن له زوجة أو جاء إلى المدرسة دونها يكون المسكن متاحا للمعلمين كلهم ولم يكن عددهم يتجاوز الثلاثة أو الأربعة. وكان هؤلاء المعلمون إذا كان المدير متزوجا يلجؤون إلى الإقامة في أحد الأحواش التي تركها أصحابها ونزحوا عنها إلى المدينة مثل حوش الكمباطية وهي سيدة شهرت بهذا الاسم لأن زوجها كان ضابطا في صفوف المقاومة. وإذا لم يتسن لهم ذلك أقاموا في بناية محاذية للمدرسة كنا نسميها النادي الصغير وهو ناد مخصص في العادة لإعداد وجبات الإطعام المدرسي وكان القيم عليها رجل من جيران المدرسة اسمه عمار فلما توفي خلفته أرملته السيدة حرمية. وكنا في أيام الشتاء نصل إلى المدرسة في حدود السابعة صباحا بعد أن نكون قد قطعنا أميالا عدة واجتزنا أودية وسلكنا مسالك وعرة موحلة فنجد السيدة حرمية وزوجها قد أعدا الحليب المجفف والقهوة ومأكولات أخرى لا نعرف لها اسما وكانت مع ذلك تستهوينا لما نجده فيها من الدفء واللذاذة. ثم ندخل قاعات الدرس في انتظار لمجة الساعة العاشرة وهي في الغالب عبارة عن ربع خبزة من الخبز الطلياني الطويل المحشو بالسردين والمخللات. وكان المعلمون يشرفون على توزيع هذه اللمجة ويراقبون الصفوف الطويلة كي لا يفكر أحد منا في تناول وجبتين. في قاعة الدرس يبادر كل معلم بتفقد تلامذته فيأمرهم ببسط أيديهم على الطاولات للنظر في أظافرهم والويل لمن كانت أظافره طويلة إذ يلقى من الضرب ما يدمي أصابعه. ثم ينظر في رؤوسهم ويقلب شعورهم لعل فيها من القذارة ما يستوجب حلقها أو غسلها. وكنا أثناء تلك الحملات اليومية كمن يقف في عرصات يوم القيامة ينتظر حسابه. فإذا فرغ المعلم من ذلك مر إلى الدرس والويل لمن أخطأ في قراءة جملة أو في نسخ كلمة أو في حل مسألة . كنا نمر في اليوم الواحد بأكثر من حساب ونلقى أكثر من عقاب. ولا أدري لماذا كنا مع ذلك نأنس للمعلمين ونرضى بما نلقاه في المدرسة من الضرب يصل أحيانا إلى حد لا يطاق. فقد أشبعني ذات يوم معلم العربية السيد حسن ضربا على قدميّ لأني كتبت عند خروجه من القاعة كلمة على الطاولة بدل أن أكتبها على اللوحة. وأذكر أني عدت إلى دارنا و بالقدمين أورام من أثر الضرب. شكوت ذلك إلى أمي وأبي ولكنهما قالا لي تستحق ذلك وأكثر. ومع حبّنا للمدرسة ومعلّميها كنّا نشعر بالخوف منها، وكان الخوف في الكثير من الأحيان سببا في انقطاع عدد منّا عن الدراسة والهروب من المدرسة والرضى برعي الأغنام على ما في ذلك من الرهق. ولم يكن الخوف مانعا من الاحتجاج أحيانا على ذلك العنف وإن كان احتجاجا سرّيا بيننا وبين أنفسنا ولكنّه نما شيئا فشيئا حتّى ظهر إلى العلن. كنا وقتها في السنة الثالثة ولم تتعد أعمارنا التاسعة في الغالب ولكننا قررنا يوما أن نشكو المعلم حسن إلى العمدة بعد أن انهال بعصاه الغليظة على صديقنا الهادي الروز وأصابه في ذراعه اليمنى فلم يقدر على تحريكها. والهادي الروز سمّيناه بهذا الاسم لأنّه كان ينطق الراء الفرنسية ثاء، وكان يقول عن الوردة باللسان الفرنسي الروث. غادرنا القاعة في الساعة العاشرة وبدل أن نتوجه لتناول اللمجة كما جرت العادة اجتمعنا خلف سور المدرسة لننظر في ذراع صديقنا فإذا هي مشلولة أو تكاد. بكينا معه بكاء مرّا وشتمنا معلّمنا شتما وقلنا عنه ما أمكن أن يقول الضحية عن جلاّده سرّا لا علنا. كنّا أربعة من أصدقاء الروز المقرّبين، أنا وعبد الباري صالح والطاهر الشريف ومحمد عبد الله. ولا أدري كيف قفزت إلى أذهاننا فكرة اللجوء إلى مكتب العمدة الشيخ العيدي لنبلغه استياءنا مما أصاب صديقنا. واستقبلنا الشيخ العيدي واستمع إلينا وهو يتعجب ولم نعرف إن كان يتعجب مما أتاه المعلم أو مما أقدمنا عليه ولكنه رضي بمرافقتنا إلى المدرسة والحديث إلى المعلم في هذه القضية. كانت فرحتنا عارمة. ها نحن ننتصر أخيرا ونجد من يقف معنا لحمايتنا من التعذيب. ثم رأينا الشيخ العيدي يحدّث المعلم حسن. لابد أنه كان يوصيه بنا رفقا أو لعلّه كان يحذّره من مغبّة العودة إلى هذه المعاملة القاسية. كلّ ذلك ممكن، وما يعنينا نحن الأربعة خصوصا أن السيد حسن قد بات أخيرا في موقف المتّهم وأنّ الشيخ العيدي يلومه وربّما يحذّره أو يهدّده. هل ينفع ذلك؟ للأسف لم يكن نافعا فقد استمرّ السيد حسن في قسوته وإن كانت قد خفّت قليلا إذ لم يعد يستعمل عصاه لضربنا وكان يكتفي بقرص آذاننا ولطم وجوهنا وصفعنا صفعا شديدا.
***
/ 20
لم تكن نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى التعليم الثانوي بمدرستنا مرضية أبدا خلافا لمدارس أخرى تشترك معها في الكثير من الخصائص. رغم حرص المعلمين على تأمين الدروس كاملة وإضافة ما يجب أن يضاف من حصص الدعم ورغم حث الأولياء أطفالهم على الاستعداد الأمثل للامتحان و كانوا في نهاية كل موسم دراسي ينتظرون ما ستسفر عليه نتائج ذلك الامتحان سواء في ذلك من كان له ابن أو بنت يجتاز المناظرة أو من لم يكن له. وقد خلفت النتائج الهزيلة طيلة السنوات الأولى في نفوس الأولياء والتلاميذ على السواء عقدة يصعب التخلص منها وكان الناس ينظرون إلى الفائزين في تلك المناظرة على أنهم أبطال وربما صاروا مثالا يحتذى به. ومن هؤلاء الفائزين الأوائل القلائل محمد الصالح بن فرحات شحيمة رحمهما الله وحسن والأزهر من أبناء رابح الأرمش وكان الكثير من أهل البلدة يضيفون إلى أسمائهم حرف السين مكسورا فيقولون سي محمد الصالح وسي الأزهر وسي حسن وهم ما يزالون في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بل إنهم أوكلوا إليهم تدريس أطفالهم في شهر من شهور العطلة الصيفية الثلاثة مقابل دينار واحد عن كل طفل. وكان هؤلاء الثلاثة قد اقتسموا المجال في ما بينهم فتولى كلّ واحد منهم مهمّته في حدود ما يسمح به الاتفاق بينهم . وأذكر أن دروس سي محمد الصالح كانت في الهواء الطلق وسط جنان التين الشوكي إذ لم يكن منزلهم يتّسع لاحتضان سبعة أو ثمانية أطفال وكنا نفترش حصيرا في مكان ظليل وننصت إليه ونتابع دروسه باهتمام فإذا فرغ من ذلك أسقط الحاجز البيداغوجي بيننا وبينه وصار يلعب معنا. وأما الأخوان الأزهر وحسن فكانا يؤديان دروسهما في منزل مهجور من منازل أحد الجيران الذين رحلوا إلى العاصمة منذ بداية الستينات وكانا في غاية الصرامة ويتعاملان معنا كما لو كانا معلمين حقا وكثيرا ما كانا يلجآن إلى الضرب لمعاقبة من أخطأ أو نسي واجبا من واجباته. وكان لهذا التقليد في بلدتنا فضل في تحسين النتائج في مدرستنا. كان ذلك في السنة التي تهيأت فيها لاجتياز تلك المناظرة. وكان علينا أن نعدّ لها العدّة. والعدّة في تلك الأيام لا تعني شيئا سوى أن نواظب على الحضور وأن ننصت إلى المعلمين وأن نسأل عمّا بدا لنا غير واضح. أما آباؤنا فالعدّة عندهم لا تتجاوز استخراج بعض الوثائق الإدارية من مكتب العمدة أو مكتب المعتمد مثل شهادة المكاسب لمن كان لهم كسب أو شهادة الفقر وهي الأشهر. وفي ليلة الامتحان كان علينا أن ننام باكرا وأن ننهض قبل الخامسة صباحا كي يتسنّى لنا الوصول إلى مركز الامتحان في السابعة والنصف. وكان على الآباء أن يجهّزوا رواحلهم قبل الغروب. في الخامسة صباحا كانت قافلة الحمير جاهزة وكان على ظهر كل حمار والد وولده. وانطلقنا على بركة الله. الوالدون يحثّون الحمير على السير والأولاد يتطلّعون إلى المدينة وعالمها الغريب. أودعونا مركز الامتحان ومضوا. قالوا لنا نلتقي عند منتصف النهار. والتقينا فساقونا إلى السوق واشتروا لنا طعاما مازالت رائحته في أنفي إلى اليوم علبةَ تنّ وشيئا من الفلفل الأحمر المخلل وقطع خيار مغمس وزيتونات خضر وسود. وخبز طلياني. جلسنا في ظل شجرة على قارعة الطريق. أما نحن فتناولنا غداءنا بفرحة عارمة. وأما آباؤنا فظلوا يراقبوننا وهم يخوضون في حديث لا يعنينا. وعدنا بعد الغداء إلى الامتحان من جديد ولا شيء في رؤوسنا غير علبة التن والفلفل الأحمر المخلل والخيار المغمس والخبز الطلياني. ولكننا اجتزنا الامتحان فنجح منا من نجح وأخفق من أخفق. وأذكر أنّ يوم نجاحي في ذلك الامتحان العسير كان يوما قائظا، وكنت أرعى شويهات أبي غير بعيد عن منزلنا ورأيت أبي رحمه الله قادما إليّ على ظهر حماره. ظننته جاء لينوب عنّي في رعي الشويهات ولكنه ناداني بأعلى صوته: هيّا يا محمّد، المعلّمان سي حسن وسي محمّد بوقيلة ينتظرانك في المدرسة. قلت: خيرا إن شاء الله. فقال: لقد نجحت يا بُنيّ. اركب الحمار وخذ من أمّك الديك فهي تنتظرك وأسرع إلى المدرسة. ركبت الحمار وأخذت الديك من أمّي وهي تمطرني بقبلاتها وتردّد كلمات غير واضحات. لابد أنها كانت تمجّد الله وتشكر أولياء الله الذين نذرت لهم النذور، ودعتني إلى زيارتهم يومين قبل موعد الامتحان فزرت سيدي طلحة وسيدي أحمد الذيب وسيدي أبا القاسم، حتّي سيدي مبروك زرته ولم يكن له مقام مثل غيره من الأولياء وكذلك للاّ خدّوم. في الطريق إلى المدرسة كان الديك الأحمر ينتفض بين يديّ يريد الخلاص منّي وكنت أحثّ الحمار على الركض بقدميّ وأضغط بيدي اليسرى على الديك فما كدت أصل المدرسة حتّى كان الديك بين الحياة والموت. لقيني سي محمّد بوقيلة بوجه ضاحك فهنّأني بالنجاح أخذ الديك منّي وهو يقول: كدت تقتله يا محمّد. مبارك عليك يا محمّد.
***
/ 21
كان لذلك النجاح وقع كبير في منزلنا وفي سائر أنحاء البلدة وربما في أماكن أخرى لا أعرف منها غير أسمائها. فقد عمد أبي إلى كبش له كان قد نذره لسيدي عبد القادر الجيلاني فذبحه وأولمت أمي الوليمة وجاء الأعمام والعمات والأخوال والخالات مهنئين وبين أيديهم سلال فيها البسكويت والمشروبات الغازية وكذا جاء سائر أهل البلدة. وكنت أرى في عيون أمي وأخواتي كلهن وهن يستقبلن الزوار كل معاني الفخر والاعتزاز و سمعت أختي حليمة رحمها الله تحدث عني جمعا من النساء فتقول ذاك من بركات سيدي عبد القادر فلولاه ما نجا من الموت في الأشهر الأولى من ولادته. أصابته عين كادت تودي به فتقرحت حنجرته وانقطعت أنفاسه مرات حتى حسبناه يموت ولم تترك أمي طبيبا إلا زارته. أتصدقنني إن قلت لكن إن أخي هذا قد وخزوه في المستشفيات بمائة إبرة أو يزيد. ولكنه لم يسلم من تلك العين التي أصابته حتى نذر أبي نذره لسيدي عبد القادر. وقالت أمي رحمها الله كنت وأنا أجري به من طبيب إلى طبيب أرى سحابة خفيفة في السماء تتبعني. كان الفصل خريفا وما جاء الربيع حتى انقشعت تلك السحابة فذهب عنه الأذى ثم جاء الصيف فقالت لي العرّافة كلاما كثيرا أحفظ منه قولها (محمد هذا قلبه مفتوح للكتاب واللوح). وقد صدقت.
أما أبي فكنت أراه يستقبل وفود المهنئين وينصت باهتمام إلى توصيات بعض الذين سبق لهم أن ذاقوا طعم النجاح وعواقبه. قال العم فرحات شحيمة يحيطه علما بما هو آت : سترى يا ابن الخالة عاقبة هذا النجاح. ستبيع نعاجك لتدفع بين السبعة دنانير والأربعة عشر دينارا. كل ثلاثة أشهر قال أبي: ولم ندفعها؟ فقال : ذاك معلوم الإقامة بالمبيت، ويطلبون منك فوق ذلك توفير طاقم الملابس، فمن كل لباس اثنان أو ثلاثة ومعجون الأسنان وصابونة فواحة ومناشف ولابد من حذاءين اثنين أحدهما للرياضة ولابد أيضا من كسوة للخروج يوم السبت، وأشياء أخرى كثيرة ستجدها مكتوبة في ورقة الترسيم بالمبيت. كان أبي يلتقط هذه المعلومات من أفواه رجال سبقوه إلى مكابدة تكاليف الدراسة في الثانوية ويبثها إلينا بعد خلو الدار من الزوار. فلما انقضت أيام التهاني بدأت العائلة كلها تستعد لتوفير نفقات الدراسة والمبيت فباعت أمي بعضا من منسوجاتها وباع أبي بعضا من نعاجه وباع بقرة هي أم بقراته الثلاث. كانت عجفاء قرناء. ساقها إلى سوق الاثنين فلم يتعد ثمنها العشرين دينارا فعاد يلعنها ويلعن قرنها المعقوف الذي أفزع التجار منها ثم ساقها مرة أخرى إلى سوق الثلاثاء فزادوه على العشرين خمسة دنانير فتخلص منها واشترى لي بثمنها أهم ما يجب أن يشترى. كان يجب لطفل مثلي أن يسعد بالنجاح وأن يسعد بعد ذلك بكل هذه الملابس الجديدة التي يراها لأول مرة ولكن ذلك لم يحصل إلا لماما. لحظات عابرة سرعان ما تمضي ليحلّ محلها شعور عميق بالذنب. لقد رأيت في كل ذلك حملا ثقيلا على أمي وأبي وسطوا على حقوق أخواتي. وظل هذا الشعور يتضاعف سنة بعد أخرى حتى خلصتني منه رسالة خططتها بيدي وأنا في أول سنة من سنوات المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. رسالة شكوت فيها حالي وحال أمي وأبي ودفعتها إلى مدير المعهد السيد عبد الحميد السماري قبل عطلة الشتاء بيومين. وانقضت العطلة فسلمني أبي معلوم الإقامة في المبيت لأدفعه صباح يوم الإثنين. دخلت مكتب المقتصد وتلوت عليه الاسم واللقب ورقم المبيت. تصفح السجل مليا ثم رفع رأسه وقال : الرقم 873 معفي من دفع المعلوم. لم أصدق الخبر. لاحظ المقتصد ذلك فسألني: ألم تتقدم بمطلب للحصول على منحة إقامة كاملة.؟ قلت : نعم. قال: والسيد المدير وافق على ذلك. خرجت من مكتبه قابضا على الأربعة عشر دينار. أين سأحتفظ بها؟ وكيف لي أن أمنع نفسي من التصرف فيها. لابد أن أحفظها وخير حافظ لها السيد الأمين المرايحي القيم المسؤول عنا في قاعة المراجعة. قصصت عليه القصة وسلمته المبلغ ورجوته أن يحفظه لي حتى يأتي السبت لأعود به إلى أمي وأبي. كنت وقتها أتدرب على التدخين وعلى ارتياد المقاهي ولعب الورق وكان سي الأمين يعلم ذلك ويكرهه. أخذ المبلغ مني ثم قال لي : عدني أن لا تأخذ منه شيئا. أعرف أنك تدخن وتلعب الورق وأخشى عليك أن تنفقه على سجائرك. قلت : أعدك بذلك. ووفيت بالوعد الذي قطعته على نفسي وعدت في آخر الأسبوع وحدثت أبي وأمي بكل ما جرى فكأن بابا من أبواب السماء قد فتح لهما. مازلت أذكر تلك الرسالة وأقول كلما ذكرتها لولاك يا قلمي ما كنت أحسبني أنجو من النكد.
***
22 /
لا أذكر متى تخيّلت لنفسي صورة في المستقبل البعيد، وكلّ ما أذكره أنّ معلّم الفرنسية السيد محمّد بوقيلة ذلك الذي فاز بديك من ديكة أمّي طرح علينا سؤالا أثناء الدرس ونحن في السنة الخامسة، ونص السؤال مترجما هو (أيّ مهنة تريد أن تشغلها في المستقبل). انكبّ كلّ واحد منّا على كرّاسه ومضينا نفكّر في ما عسانا نكون إذا صرنا رجالا. ثم دعانا بعد مهلة التفكير إلى قراءة الأجوبة. كانت أغلب الأحلام الصغيرة متعلّقة بالمعلّم والممرّض وسائق السيارة والبستاني والراعي والفلاّح والميكانيكي، وكان المعلّم يثني على تلك الأجوبة لا من حيث هي أحلام وآمال بل من حيث هي دليل على تمثّل الأطفال للتعليمة التي عُرضت عليهم واستيعابهم لمضامين الدرس وأهدافه. وحين سمع جوابي رأيته ينظر إلي نظرة اشمئزاز. تساءلت بيني وبين نفسي أأكون قد أخطأت الجواب وأنّ المهنة التي اخترتها لا تكون من المهن أصلا؟ كيف ذلك وقد تعرّضنا إليها أثناء الدرس ورأينا بأمّ أعيننا صورة الدكتور وهو يفحص مريضه؟ ها أنا اليوم بعد حوالي أربعين عاما في مهنة التدريس أعيد السؤال مرّة أخرى ولكن من زاوية مختلفة. هل كان جوابي خطأ بمقاييس بيداغوجية ومعرفية؟ أم كان جوابا غير مطابق للواقع. بيداغوجيا ومعرفيا هو جواب سليم تماما. لابدّ أن سي محمد بوقيلة رأى فيه حلما بعيد المنال قد يعصف بشخصيّتي ويفصلني عن واقعي لذلك لم يستسغه ونظر إلي تلك النظرة الغريبة وهو يقول بالفرنسية طبعا (ولكن هذا من المستحيل) ثم وهو يشير بيديه إشارة معناها كن عاقلا يا هذا. كان جوابي في تقديره ضربا من الجنون وكان تعليقه عليه ضربة أعادتني إلى الواقع أو الممكن. جميل أن يحلم صبيّ منّا وقتها بأن يصبح معلّما أو ممرّضا أو سائق سيّارة أو حتّى راعيا، أمّا أن يتخيّل نفسه وهو من هو طبيبا فهذا غير معقول. واليوم وأنا أسترجع تلك الحادثة وأجتهد في أن أعثر على العقل الذي به قيّم سي محمّد بوقيلة جوابي أجد معلّمي ذاك على صواب تماما. كان يدرّس تلامذته ويقيّم أعمالهم وفي دماغه عقل يقول له درّب أطفالك على أن يمدّوا أرجلهم على قدر كسائهم كي لا يصابوا بخيبة الأمل إن هم أفرطوا في الخيال. ولعلّ ذلك العقل الذي لم أقف عليه وقتها قد اخترقني اختراقا وقادني حيث شاء لي المعلّم وإلاّ فبماذا أفسّر مشاركتي في مناظرة الدخول إلى مدارس ترشيح المعلّمين مرّتين على التوالي ولم أفلح فيهما معا؟ ولماذا فكّرت بعد حصولي على شهادة الباكالوريا في الترشّح إلى مناظرة انتداب المعلّمين لولا أنّ أبي شجّعني على الذهاب بعيدا. أذكر أنّه سألني بعد الباكالوريا عمّا أنوي عمله فقلت دون تفكير طويل: سأكون معلّما. ولكنّه قال: أليس ثمّة ما هو أفضل من المعلّم؟ فقلت: نعم، أن أدرس بالجامعة أربع سنوات لأصبح أستاذا مثل هؤلاء الذين درّسوني بالمعهد. فقال: كن أستاذا إذن، ولا تشغل بالك بما نحن فيه. أسعدتني فكرته. بل قادتني من حيث لا يشعر هو إلى إعادة ترتيب الحلم الذي سكنني بعد تعليق المعلّم على تلك الإجابة المجنونة، فالأستاذ في نهاية الأمر معلّم خصوصا إذا كُتب له أن يتخرّج من دار المعلّمين العليا.
***
/ 23
لكل أرض من أراضي بلدتنا غير المأهولة قصة اختلقها الناس وصدقوها وهي في الغالب قصص أقرب إلى الغريب والعجيب منها إلى الأكاذيب. فقد قالوا عن أرض التلة إنها مسكن الرهبان. وليس الرهبان في الحكاية رجل الدين المسيحي بل هو مخلوق يشبه البشر في صورتهم ولا يختلف عنهم في شيء سوى أنه لا يظهر إلا ليلا وأن له إصبعا سادسا فإن كان في يده اليسرى فهو من الأشرار وإن كان في اليمنى فهو من الأخيار. وعلى من ظفر به من الناس أن يبادر إلى القبض على ذلك الإصبع السادس ففيه تكمن قوة الرهبان وبالقبض عليه يدخل أبو ستة في طوع الممسك به. أما من خافه وولى هاربا منه فسيلقى حتفه لا محالة. ولهؤلاء الرهبان سر ثان فهم يسكون المغاور والكهوف ولهم في باطن الأرض كنوز مخفية يسهرون على حمايتها ولا يفرطون في شيء منها إلا إذا صادف لبشري أن يمسك بذلك الإصبع السادس وصادف أن يكون صاحبه من الأخيار. شروط اقتضتها الحكاية ليظل الناس في خوف دائم من هؤلاء الرهبان ومن الأرض التي فيها يقيمون. كنا نسمع قصصا كثيرة عن أناس من قديم الزمان غامروا واقتحموا أرض التلة ليلا لعلهم يظفرون بأحد هؤلاء الرهبان ولكنهم وقعوا في شراكهم. فمنهم من فُقد ومنهم عُثر عليه ملقى في سفح جبل أو في قعر بئر ومنهم من عاد بلا صواب. وأكثر من كان يحدث الناس بمثل هذا الحديث الهادي فقاقيع . وهو كما قلنا في موضع سابق من أقارب أبي والفقاقيع لقب ألحقه به الناس لا لعيب في خلقته بل لما وجدوا في أحاديثه من تكاثر وتعاظم ولكنها سرعان ما تخبو تماما كما تتعاظم الفقاقبع وتخبو في لمح البصر. ومن أغرب ما سمعت عن العم الهادي فقاقيع قصة رواها لنا في ليلة من ليالي الشتاء فقال: قفلت راجعا منذ أسبوع من جولة يومية بدأتها من جزة وقادتني إلى عبيدة ثم الحوض. كانت الشمس تميل إلى الغروب وأنا أصعد جبل الصفا من الجهة الشرقية. وكان حماري مثقلا بزنبيل ملأته قمحا وشعيرا لقاء ما بعت من الشاي والقهوة والسكر والحلوى. وكنت أسوقه بالجهد وأحثه على الصعود في الجبل لعلي أنجو من أرض التلة قبل أن يحط الظلام ولكني لم أفلح فقد وقع عليّ الليل بظلمته الكثيفة وأنا في أرض التلة واستأنست بالحمار فأمسكت بذيله ولكنه كان يكره ذلك مني ويعمد إلى صكي. توغلت في أرض التلة حتى بلغت الموضع المعروف بالدخيلة وهو كما تعلمون بين الصفا وكدية الضبع وإذا بضوء يلوح لي ثم ينتشر ويتسع مداه لتنكشف صورة مدينة وخُيل لي أني ضللت الطريق ووصلت إبة قصور ثم إني رأيت جمعا من النساء كأنهن يحتفلن ورأيت كوكبة من الرجال يجهزون الخيول كأنهم فرسان. حتّى نسيت أني في التلة وانطلت عليّ فكرة الضلال فقلت أقيم في الفندق ريثما ينجلي الليل ولكن نهيق الحمار المفاجئ أيقظني من سكرتي ونظرت فلم أر شيئا مما كان وإذا بنباح كلاب يملأ الفضاء فأيقنت أني نجوت من رهبان الدخيلة وأني بلغت منازل أولاد أبي ركبة.
كان العم الهادي فقاقيع يروي قصته ونحن نتابع حركاته وسكناته ونتخيل المشهد بتفاصيله فينتابنا الرعب مما وصفه ثم ننفجر ضاحكين حين نعلم أنه نجا من الرهبان. بلغت قصته منتهاها فسألناه ولماذا لم تمسك بالإصبع السادس يا عم الهادي.؟ فقال ضاحكا: الحقيقة يا جماعة أني كنت ممسكا بذيل الحمار خشية أن أموت. فلما هم بالخروج يريد العودة إلى منزله وقف برهة أمام باب الحوش ثم سمعناه يسأل أبي أن يرافقه في الطريق فالظلمة شديدة والخنڨة تسكنها الأرواح فيستجيب أبي لطلبه وهو يقول :أتخاف الخنڨة وأرواحها وقد نجوت من التلة ورهبانها؟ فيقول: الرهبان شيء والأرواح شيء. فيقول أبي : كلها فقاقيع.
***
24 /
ومن الأحاديث الفقاقيع أيضا حديث الأرواح التي تسكن الأودية والفجاج. ولا يكاد واحد من كبار البلدة ينكر ذلك والكثير منهم يروون قصصا عن أرواح ظهرت لهم وهم يقطعون واديا أو يعبرون فجأ. . فقد حدثتنا أمي عن روح ظهرت لها وهي عائدة من حقل لنا يبعد عنا أميالا كثيرة. قالت: تأخرت في الحقل ولم أنتبه إلى ذلك حتى أوشكت الشمس على الغروب. كنت منشغلة بجمع ما حصدته خشية أن تظل الأغمار مفرقة وأمضيت في ذلك وقتا لم أنتبه إليه فلما انتبهت حزمت أمري وغادرت الحقل. في الطريق حاصرتني وساوس وأوهام كثيرة. تذكرت أن وادي الصلصال قد جرف ثلاث نساء منذ أعوام. وتذكرت أحاديث الناس من قبل ومن بعد عما عرض لهم في الوادي عند عبوره بعد غروب الشمس أو عند القيلولة. عبرت الوادي وأنا ألتفت يمنة ويسرة فما سمعت ولا رأيت شيئا فارتحت لذلك وقلت في نفسي لقد كذبوا. ولكن هذه الطمأنينة لم تدم سوى لحظات. والغريب أن ما طرأ علي من الأوهام والوساوس قبل عبور وادي الصلصال عاد ليسكنني لما بلغت الموضع المعروف بالغدران وهو كما تعلمون موضع يلتقي فيه واديان اثنان أحدهما ينحدر من ناحية الجبل الأبيض والآخر من جبل الصحراوي . لم أسمع من قبل أحدا يتحدث عن روح تسكن هذا الموضع ولكني أحسست عند عبوره بخوف شديد فلعنت الشيطان وتلوت المعوذتين وواصلت سيري. لم أكد أقطع ملتقى الواديين حتى شعرت بيد تمتد إلي تريد أن تلمس كتفي اليمني. انتابني ذعر شديد وظللت أركض واليد تلاحقني فلا تدركني وما يئست مني حتى بلغت الدوار. كنا ننصت إلى حديثها والخوف يملأ قلوبنا لكن أبي أذهب عنا ذلك الخوف وطمأننا بتعقيبه على حديث أمي فقال : ليس في الغدران روح كما توهمت يا نوارة إنما هو خوفك الشديد عند هبوط الليل أوحى إليك بذلك لتحثي الخطى ولتطوي المسافة البعيدة دون إحساس بالتعب والإرهاق. ألم تسمعي قولهم (الخوف يعلّم السبق) ومعناه أن الجسم المنهك يميل إلى الاسترخاء ويكسل ولتحريك هذا الجسم واستنفار طاقته الكامنة لا بد من حافز والخوف حافز قوي يستنهض الجسد ويدفعه إلى النشاط.. لم تقتنع أمي بهذا التأويل فروت حديثا آخر. قالت: وماذا تقول في ما رأيت هنا في هذا المنزل تحديدا؟ قلنا جميعا: وماذا رأيت يا دادة؟ قالت: لم أشأ أن أحدثكَم بما رأيت وظللت أكتمه عنكم جميعا حتى أنت يا رمضان لم أحدثك به. وها أنا أرويه اليوم ليكون دليلا على بطلان ما أتيت به من التأويل. قال : هات حديثك. قالت: مات ابننا عمار وهو صبي لم يتجاوز العامين. مات ولم يصبه مرض قط. ولكنه مات فجأة. وعكة خفيفة لم تدم أكثر من ليلة ولكنها أخذته منا. ظللت أبكي فراقه سرا وعلانية حتّى كنت يوما أجلس هنا وحيدة أغزل الصوف وذكرته فانخرطت في موجة بكاء حار وإذا هو بلحمه وشحمه يقفز أمامي ويعبث بالصوف كما كان يفعل في حياته. قال أبي: لابد أنك حضنته وقبلت رأسه كما كنت تفعلين. قالت؛ بل فررت منه. قفزت من مجلسي هاربة ولم أنتبه إلا وأنا خارج الحوش. والغريب يا جماعة أني لم أبكه بعد ذلك أبدا. قال أبي: هذا حديث يثبت تأويلي ولا يبطله. سألناه وكيف ذلك؟ فقال : لم تر أمكم ما رأته إلا من فرط تفكيرها في المرحوم ولم تهرب منه حين خيل إليها أنها تراه إلا بسبب الخوف منه. الخوف يا جماعة سلاح المرء لتحريره من التعب والإرهاق سواء في ذلك تعب الجسم وتعب النفس وأمكم أتعبها الحزن وذهب بطاقتها حتى كاد يقتلها ولم تنج من ذلك حتى خافت. الخوف يعلّم السبق.
***
25
للديمقراطية في بلدتنا تاريخ يكاد يساوي تاريخ الديمقراطية في الوطن كله. فقد تسربت إلينا الديمقراطية في مطلع الثمانينات حين سطع نجم الورقة الخضراء وخبا نجم الورقة الحمراء. ولم ينجذب الديمقراطيون الأوائل في بلدتنا إلى الورقة الخضراء لما تشير إليه من أفكار وأعلام بل انجذبوا إليها لما في اللون الأخضر في ذاته من دلالة على الخصب والحياة وهروبا من اللون الأحمر لما بدا لهم فيه من معاني الموت والقسوة. وليس الأخضر عندهم إلا ضد اليابس فإذا يبس العود مثلا صار أحمر والخضراء من النساء المفعمة حبا ورغبة وكذلك الأرض وسائر الحيوان والخيل خصوصا. وأول المبشرين بالديمقراطية والداعين إليها في البلدة محمد بن رابح وهو في الأصل عسكري متقاعد شهد معركة ڨفصة حين حاول عدد من الضباط التمرد على بورڨيبة ونظامه وربما طرأت عليه فكرة الخروج عن الورقة الحمراء لما رآه في الضباط المتمردين من اخضرار واضح وانتصار للكتاب الأخضر. واستغرب الناس في البدء ذلك وتساءلوا كيف يخرج عسكري عن الخط ويسلك خطا غير مأمون ثم ذهبت عنهم الحيرة بانضمام عمي المختار إلى دعوة ابن رابح وصار الرجلان يوصفان بالديمقراطية فيقولون محمد الديمقراطي والمختار الديمقراطي ثم اختص المختار بتلك الصفة حتى سقطت عن ابن رابح تماما. وقد وجد الناس في أول عهدهم بالديمقراطية صعوبة في نطقها فكانوا يحرفون الكلمة ويغيرون نظام حروفها ويقدمون ويؤخرون واشتد عليهم ذلك حين لقبوا المختار بالديمقراطي فكان منهم من أسقط الميم وقلب الدال تاء فيقول التقراطي ومنهم من ذهب مذهبا آخر فأبقى على الدال وأسقط الميم وحركتها الطويلة ليقول الدقراطي وقال آخرون المقاطي. والأغرب من ذلك أن فيهم من مزج المنعوت بالنعت فجاء بلفظ غريب لكنه سرعان ما انتشر لما فيه من اقتصاد فقد اختزلوا عبارة المختار الديمقراطي في لفظ واحد فقالوا المخراطي ثم قالوا المخراطية. وكان المختار يجد في هذه التقليبات متعة ويقول خطأ مشهور خير من صواب مهجور وحجته في ذلك أن الهدف الأسمى في أول مراحل الديمقراطية هو أن يشيع اللفظ بين الناس فإذا لاكوه ولووا به ألسنتهم واعتادت على وقعه آذانهم أنسوا إليه.. وظل الناس منشغلين باللفظ دون المعنى ردحا من الزمن ولم يتسن لأحد منهم أن يسأل عما تحت هذا اللفظ من المعاني وأقصى ما بلغوه من الفهم أن الديمقراطية تعني الخروج عن المعتاد وأن تكون مخراطيا هو أن تكون مختلفا في كل شيء تقريبا. فإذا شرّق الناس فعليك أن تغرّب والعكس بالعكس. ولم يستقر هذا المعنى في أفهامهم إلا بما رأوه في سيرة المختار الديمقراطي فقد كان يسمى القليل من كل شيء تشيشة في صيغة التصغير وكان الناس في المقابل يسمونه شويّة. وكان يقسم باسم الرب ويقسم الناس برؤوس أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم. وكان يضحي بخروف والناس يضحون بالنعاج والدجاج أحيانا وكان لا يضع على رأسه شيئا لا صيفا ولا شتاء أما سائر الناس فيغطون رؤوسهم اتقاء الحر والقر. ورأس المختار الديمقراطي أصلع لا يحجبه شعر ولا شاشية ولا أي شيء آخر وكان يواجه تقلبات الجو عاريا بلا واق فصار مثالا على التحدي والعناد. وظهر ذلك واضحا في يوم الاقتراع فقد كان الوحيد من بين الناخبين الرجال كلهم من دخل الخلوة وأخذ معه الورقتين الحمراء والخضراء واكتفى الآخرون بانتقاء الورقة الحمراء ووضعها في الصندوق أمام الجميع. وقد جذبت سيرة المختار الديمقراطي بعضا من الرجال ولكنهم لم يكونوا في حجمه تحديا وخروجا عن المعتاد. وأما من النساء فلم تنجذب إليه غير خديجة أختي فسارت سيرته وكانت أول فتاة في البلدة تلبس الشانال وتعقص شعرها ولا تضع عليه شيئا يحجبه وأول إمرأة على ما أعلم رفضت زوجا وافقت العائلة عليه واختارت زوجا قالت إنها تحبه ورسمت الحرفين الأولين من اسمه واسمها على لباس من الصوف صنعته بيديها وكانت أول فكر في تأسيس ورشة للنسيج وقدمت طلبا في الغرض للحصول على تمويل. ودخلت خلوة الناخبين مثله. فأما المختار الديمقراطي فلم يترتب على خروجه عن الخط شيء وأما خديجة أختي فقد عوقبت أشد عقاب فحرمت من تمويل مشروعها الصغير لأنها اختارت أن تكون ديمقراطية مثل عمها. وأما أبي فلم أره منشغلا بشيء من هذا وكان لا يعنيه من الأوراق غير أوراق الأشجار. حتّى تلك الأوراق التي تثبت زواجه من أمي وتثبت ملكيتها لهذه الأرض أو تلك كان لا يحفل بها كثيرا. وسئل في ذروة الصراع بين الورقتين الحمراء والخضراء أيهما أقرب إليك فقال : كلها فقاقيع.
***
26
كان عمّي المختار مثلا في التحدّي والجرأة على كل صعب. وسألته: ألا تخشى على نفسك أن يلحقك من هذه السيرة ما يؤذيك فقال: تعرف يا ولدي أني لا أخشى على نفسي شيئا لا إنسا ولا جانا ولا حيوانا ولم يحدث أن سكن الخوف قلبي إلاّ مرّة واحدة ولا أظن أن رجلا غيري قد عاشها. وسألته عن ذلك فقال: اعتراني فى أول أيام الشبيبة شعور بدنوّ الأجل فقلت أصلي كما يصلي الكبار لعلّي ألقى الله مؤمنا وكانت صلاتي صلاة خائف أبدا، وحدث أن عزمت في جمعة من جمعات رمضان والفصل صيف حار على صلاة الجمعة والمسافة بيني وبين المسجد الجامع كما تعلم بعيدة. كنت أقطع الطريق وحدي وحمّارة القيظ تكاد تذهب بأنفاسي وأعصابي وظللت أقاوم حرّ الشمس وطول المسافة ووطأة العطش بأفكار غريبة تلهيني عمّا أنا فيه. وخطر لي في منتصف المسافة هنالك في الموضع المعروف بالوادي الواعر أن فكرت في ثواب هذه الجمعة التي أسعى إليها وماذا عساه يكون وقفز إلى رأسي سؤال هو أشبه ما يكون بالاحتجاج إذ سألت الله بأعلى صوتي وناديته (لمَ أنت تؤجل ثواب العمل الصالح؟ إن كنت تثيب حقا فأنا كما تراني الآن أحوج من يكون إلى دينار لشراء ما يشتهيه الصائم) قلت ذلك بنبرة يمتزج فيها الذل بالغضب ولا أدري إن كنت بكيت أم لا ولكني ما خطوت خطوتين أو ثلاثا حتى لمحت في التراب دينارا. تسمرت في مكاني وظللت ألتفت يمنة ويسرة لعلي أرى طيفا أو شبحا وخيّل إلي إن الله قاب قوسين أو أدنى أو أن شيطان المقيل قد حفّ بي. وسرعان ما ولّت صور الله والشيطان وحلّت محلها صور الغيلان والعبابيث التي حدثني عنها جدك رحمه الله أيام الطفولة فكدت أموت من هول ما ألمّ بي. وكان ذلك أقسى ما رأيت من الهلع. فقلت وماذا فعلت بالدينار؟ فضحك وقال وهل كنت تخالني أدعه وأمضي؟ لقد انحنيت بخفة الخائف فالتقطه واستدرت وأطلقت ساقي للريح وما هي إلا لحظات حتى عدت إلى الدار وفي قبضتي الدينار. ولم يمض رمضان ذلك العام حتى تركت الصلاة لما كان لي معها مما رويت لك.
ومن أخباره أيضا أنّ أهل بلدتنا لم يكونوا يعرفون للعجّة لا طعما ولا لونا ولا رائحة ولا أي معنى من المعاني. وكان كل طعامهم الشكوكة نهارا والكسكسي أو المحمصة ليلا حتى جاء المختار الديمقراطي بالعجة فرأى فيها الناس بدعة من البدع إذ البيض عندهم للبيع غالبا وإن أُكل يؤكل مسلوقا أو مقليا. وسئل عن ذلك فقال: هذا طعام من لا طعام له وطعام من لا وقت لديه ليصرفه في الطبخ وطعام من لا يملك زمام أموره. وطعام من لا أهل له. فقال الناس: أوَ تأكله وهو كما وصفت؟ فقال: وجدته على كل ما فيه من العيوب أمضى في العروق وأجرى في الحلوق تماما كما قال عيسى بن هشام عن طعام السوق. وجرب الناس ذلك فلم يستسغه أحد منهم. قال المختار الديمقراطي: لم يستسيغوا العجة لا لعيب فيها بل لاعتقادهم أنها من عادات الديمقراطيين وهم في ذلك معذورون فقد قاسوا بدعة العجة على بدعة الديمقراطية. فلما صارت الديمقراطية شائعة شاعت العجة معها وشاعت بعدها أمور أخرى.
***
27
كانت خالتي حفصيّة رحمها الله تعاني منذ سنوات طويلة آلاما حادّة في المفاصل جعلتها تزور كلّ الأطبّاء تقريبا دون أن تظفر بعلاج يبرئ سُقمها. وأشار عليها بعض أهل بلدتنا المجرّبين أن تترك الطب وتتستعيض عن ذلك بااسباحة في حوض من أحواض حمّام معدني، ونصحوها بحمّام ملاّق وهو غرب مدينة الكاف على مسافة ثلاثين كيلومترا من بلدتنا تقريبا . لم أزره من قبل ولكنّي سمعت عنه حكايات كثيرة أغلب أبطالها رجال ونساء مصابون بشتّى الأمراض المزمنة جاؤوه من مسافات بعيدة وهم على شفير الموت وغادروه سالمين. حكايات قصّها عليّ الكثير من كبار البلدة مذ علموا بتطوّعي لمرافقة الخالة حفصيّة إلى هناك، ومنهم من روى لي حكايات أخرى عن بعض سكّان هذا الحمّام من غير الإنس، مثل الجنّيات اللاتي يظهرن كلّ ليلة بعد غياب القمر في صور شتّى وينزلن في أحواض السباحة. ومنهم من حذّرني من دخول حوض السباحة في ذلك الوقت من الليل كي لا تصيبني جنّية بأذى، ومنهم من كان ينهي حديثه بضحكات غريبة أفهم منها أنّه يحرّضني على دخول حمّام السباحة في تلك الأوقات الممنوعة لعلّ الله يفتح لي فتحا عظيما. لم يكن الحمّام حين دخلته أوّل مرّة شيئا ذا بال. حوضان اثنان للسباحة لا يتّسعان لأكثر من أربعة أشخاص، يتدفق فيهما ماء معدنيّ حار من فوهتين صغيرتين محفورتين في الجبل، وبين الحوضين ستار خفيف من القصب يجدّده القيّمون على الحمّام مرّة كلّ سنة كما قالت لي السيدة منّانة المشرفة على إدارة هذا المنتجع. وحول الحوضين بضعة غرف صغيرة بنيت حديثا ممّا تناثر من المعلم الأثري القديم من أحجار ضخمة. وكان الوافدون إلى الحمّام يأتون بخيامهم فيصنعون منها بيوتا لهم يأوون إليها. أمّا نحن فلا أدري لِمَ جئنا إلى هنا دون أن نصحب معنا خيمة، لذلك كان علينا أن نستأجر من السيدة منّانة غرفة من تلك الغرف الصغيرة. كانت لغرفتنا نافذة صغيرة تطلّ على نهر ملاّق ومن خلف النهر تتراءى للناظر منها غابة صنوبر حلبيّ ممتدّة، ولم يكن للنافذة شبّاك لا من زجاج ولا من خشب ولا من حديد، كانت كما تقول الخالة حفصيّة مجرّد "طاقة" أي كوّة في الجدار. قالت لي السيدة منّانة لابدّ أن تترك هذه النافذة مفتوحة ليلا نهارا، وإيّاك أن تسدّها بشيء. ولمّا سألتها عن سبب ذلك قالت ستتلقّى منها في ساعات القيلولة نسمات لطيفة تصدر من الغابة وتمرّ على النهر فتتشبّع برطوبة الماء لتصلك نديّة منعشة، فإذا جاء الليل يأتيك منها ضوء القمر الممزوج بظلال الأشجار المرتعشة، فإذا غاب القمر تتدفّق من النافذة الصغيرة ظلمة شديدة سرعان ما تقودك إلى النوم. هممت بسؤالها عن أشياء كثيرة ولكنّها تركتني وهي تقول بنبرة حازمة: لا تنس ذلك. تركتني الخالة حفصيّة أنظر إلى تلك النافذة وسارعت إلى حوض السباحة. تخيّلت أشياء كثيرة تصلني عبر النافذة غير النسمات اللطيفة وضوء القمر والظلمة الشديدة ولكنّ شيئا من ذلك لم يصلني طيلة الأسبوع الأول من الأسابيع الثلاثة التي قضّيتها هنالك. وحين أطلّ الأسبوع الثاني، ورأيت الخالة حفصيّة تتماثل إلى الشفاء شيئا فشيئا قلت في نفسي لعلّ هذه النافذة المفتوحة أبدا لا ترسل شيئا سوى ما ذكرت منّانة لأنّها مفتوحة أبدا، وخطرت لي فكرة سدّها بعد غياب القمر بقطعة من قماش. وجاء الليل وظللت أنتظر غياب القمر ثم قمت إلى النافذة وسددتها وظللت أنتظر. مرت ساعة أو بضع ساعة وإذا بصوت خفيف من وراء النافذة، كان الصوت ضعيفا متقطّعا، تخيّلته في البداية حفيف أشجار ثم استبعدت ذلك حين تذكّرت أنّ الجوّ هادئ ولا رياح فيه تحرّك الأشجار، ثمّ تخيّلته حشرجة وقلت في نفسي لعلّ أحدهم يموت الآن خلف النافذة فاقشعرّ جلدي وكدت أرفع صوتي مستغيثا لولا أنّي خشيت إزعاج الخالة حفصيّة وهي تغطّ في نومها. نظرت إليها في تلك الظلمة الشديدة فلم أتبيّن شيئا سوى شخيرها المتقطّع. الله يهديك يا خالة. كدت أموت من الخوف. وظلّ الأمر يتكرّر بحذافيره كلّ ليلة، وكنت في كلّ ليلة أتخيّل الصور نفسها على الترتيب نفسه وأنهي تخيّلاتي بالجملة نفسها إلى أن جاء الأسبوع الثالث فتبدّل كلّ شيء. تنام الخالة حفصيّة كعادتها بعد صلاة العشاء بقليل وأظل أنا أقرأ شيئا ممّا كان معي من الكتب على ضوء شمعة، فإذا غاب ضوء القمر وحلّت الظلمة وغلبني النعاس أقوم إلى تلك النافذة فأسدّها بقطعة القماش التي جعلتها لها. وما أن أعود إلى فراشي وأستلقي على ظهري مستسلما للنوم حتّى يظهر ذلك الصوت الخفيف المتقطّع فأقول في نفسي إنه شخير الخالة حفصيّة ولكنّ قطعة القماش تسقط من مكانها. أسمع وقوعها على سطح الأرض فأنهض إلى النافذة أتطلّع إلى ما وراءها فلا أجد شيئا فأعيد قطعة القماش إلى مكانها ولكنّها تسقط من جديد. فأظلّ أفكّر لبرهة وإذا بيد تمتدّ إليّ من النافذة فتلامس وجهي، إنّي أتحسّس أصابعها الطويلة الرقيقة وهي تداعبني بلطف أوّلا ثم بشيء من العنف ثانيا ثم بعنف شديد ثالثا فإذا هممت بالصياح أحسست بتلك اليد تبتعد عنّي فأقول في نفسي هذه اليد الغريبة تأبى غلق النافذة وتأبى أن أستغيث إذا اشتدّت عليّ فلمن تكون يا ترى؟ أهي يد إحدى الجنّيات تمتدّ إليّ؟ ولكنّ الجنّيات حسب ما حدّثوني به لا يأتين على هذا النحو. وظلّ الأمر يتكرّر كل ليلة، حتّى أنّي صرت أنتظر تلك الساعة البعيدة من الليل على أحرّ من الجمر. وجاءت الليلة الأخيرة من مدّة إقامتنا بتلك الغرفة وأنا لم أدرك سرّ النافذة فأصابني شعور غريب بالخيبة ودعوت الله في سرّي أن يكشف لي سرّها ولكنّ الله لم يستجب لدعائي. فلمّا طلع النهار وجمعنا أمتعتنا استعدادا للرحيل جاءت السيّدة منّانة لتوديعنا ومعها نساء أخريات لا أعرفهنّ ولكنّ الخالة حفصيّة تعرفهنّ، وعلمت من حديثهن إليّ أنّ الخالة حفصيّة حدّثتهن عنّي طويلا، وأنّ واحدة من بنات السيّدة منّانة تطوّعت بتدبير منهنّ جميعا لتلعب معي لعبة الجنّية ولكنّها لم تنجح. قالت: ما أكبر قلبك يا رجل، تعني ما أقساك يا رجل. لم أكن في الحقيقة قاسي القلب، فقد كنت في غاية الخوف ولكن شيئا من الحياء منعني من التعبير عنه وشيئا آخر من التلهّف إلى عالم الجنّيات ألزمني بالصمت والاستمرار في اللعبة.
***
28
لكلّ رجل من أهل بلدتنا قصّة مع الحمير أو أكثر. ولا غرابة في ذلك أبدا فالحمير وسيلتهم الوحيدة في النقل والحرث والدرس. وسأروي لكم نتفا من هذه القصص مازلت أذكر بعض تفاصيلها. قصص ثلاث هي قصّة أبي وقصّة المختار الديمقراطي وقصّة أخيه المعروف عند البعض بالدبّوس. أمّا أبي فقد كانت له حِمارة شرّيرة ترفض أن يمتطيها أحد وكل من يحاول ذلك بالقوة سرعان ما يجد نفسه طريح الأرض، والغريب أنّ أبي كان يمتطيها بسهولة وكان يحذّرنا من محاولة ركوبها إلاّ بحضوره. وصادف أن جاء العمّ الشريف بن حواء يطلب من أبي أن يعيره الحمارة ليجلب زنبيل الخضروات من عبيدة فنبّهه أبي وحذّره ولكنّه أصرّ على ذلك وهو يقول " والله ما لأحملنّها على الصواب رغم أنفها". ساعده ابي على امتطائها ونصحه إذا سار أن يلتزم الصمت وهو على ظهرها وأن لا يخزها أو يضربها كي لا توقعه أرضا فقبل النصيحة ومضى. وما هي إلاّ بضع ساعة حتّى عادت الحمارة إلى الحوش. أين هو عمّي الشريف؟ وخرجنا جميعا نسأل عنه فلم نعثر عليه. وظللنا ننتظر عودته فلم يعد إلاّ بعد ساعة أو أكثر وهو يعرج ويرغي ويزبد قائلا : أيُعقل يا رمضان؟ أهذه حمارة ؟ كيف تربّي حمارة كهذه؟ ثم روى لنا قصّته معها قال: ما إن تجاوزت الجبل الصغير، وهو جبل يقف حاجزا بين حوشنا وأرض الهمّاجة الخالية، حتّى بدأت الحمارة في التلكّؤِ ولكنّي التزمت الصمت عملا بنصيحتك، فلما أضربتْ عن السير واستدارت تريد العودة منعتها من ذلك وهمست في أذنيها ( إر يهديك) وما إن سمعت صوتي حتّى بدأت تقفز قفزا غريبا، كانت تغرس رأسها في الأرض وترفع ساقيها الخلفيّيتن إلى السماء. حاولت أن أتماسك ولكنّها رمتني على الأرض فوقعت، وأين وقعت؟ اختارت الخبيثة شفا جرف هار ورمتني ولم أنج منه إلاّ بشقّ الأنفس. ضحك أبي وضحكنا جميعا بأصوات عالية، حتّى عمي الشريف كان يروي مغامرته مع الحمارة وهو يضحك ويتوجّع من آثار وقوعه ويلعن الحمارة ويشرب الشاي ويدخّن ويضرب الأرض بعصاه.
وأمّا المختار الديمقراطي فقد شوهد يوما يربط حماره إلى أصل الشجرة قبالة الدار وينهال عليه بالسوط يجلده. قيل له: لِمَ تفعل به كلّ هذا؟ قال: لو رأيتم ما فعله بي لقتلتموه. قيل: وكيف ذلك؟ قال: ركبت صباح اليوم هذا الملعون وسرت به إلى الحقل. كان في الطريق حرونا، حثثته على السير فأبى ومضى ينكص حتّى أوقعنى أرضا ورفسني بحافره، فكتمت غيضي وعاودت الركوب وحثثته على السير فسار بي خطوات ثمّ انطلق يعدو عدو الخيول فدعوته إلى التمهّل فأبى فتمسّكتُ به خشية السقوط وظل يعدو عدوا لا عهد لي به وكان في عدوه يمرّ حذو شجيرات الصبّار على الطريق ويتعمّد ملامستها كأنه يريد لأشواكها أن تصيبني وكنت أتفاداها بجهد جهيد، أو يمرّ ببركة ماء فلا يجانبها ويتعمّد الخوض فيها كأنّه يريد أن يلحقني منها أذى، وما وصلت إلى الحقل حتّى ذهب عنّي رشدي ولكنّي حمدت الله على السلامة، فنزلت وأوثقته ومضيت أجمع المحصول حتّى سوّيته في حزمة عريضة وجئت به فرفعتها ووضعتها على ظهره وقصدت طريق العودة خلفه أمسك الحزمة بكلتا يديّ. كان الملعون كلّما تراءت له شجرة على حافة الطريق تعمّد الاقتراب منها يريد إزاحة الحمل عن ظهره وكنت أقاوم سقوط الحمل حتّى كلّ متني وفتّ عضدي والأغرب من ذلك أنّه مرّ بي على حافة الوادي وطفق يقفز حتّى وقع الحمل ووقعت معه في الوادي ومضى هو في حال سبيله، ولا تسألوا عن حالي وأنا في قعر الوادي فما خرجت منه إلاّ بشقّ الأنفس. قيل له: وكيف ظفرت به بعد الذي وقع؟ قال: وأنا في الطريق إلى الدار بعد الخروج من قعر الوادي قلت في نفسي: هذا الحمار في غاية الذكاء، ألم تر كيف عزم على التمرّد وظلّ يعبّر عن استيائه من إذلالي له بالخدمة يوما بعد يوم؟ ألم تر كيف ثار عليك وكيف تحيّن الفرصة بعد الفرصة ليسقطك؟ ثم قلت في نفسي: لابدّ أنّه يسعد بانتصاره عليّ وأنّه يسعد بالحرّية بعد العبودية، وتخيّلت نفسي مكانه فلم أر عملا أحسن من عمله. قيل له: لقد علّمك درسا في الثورة والحريّة يا ديمقراطي فما بالك تجلده كلّ هذا الجلد؟ قال: الملعون ابن الملعون، فعل بي ما فعل ولكنّي عدت إلى الدار فوجدته في الاسطبل حيث يقيم من زمان، فقلت: أيُعقل أن تتمرّد عليّ وتوقع بي ثم تعود إلى سجنك القديم يا ابن الملعونة. أنت حقّا حمار وابن حمار ولا يجوز البتة أن تكون ذكيّا كما حسبتك أو ثائرا كما تخيّلتك فتعال إذن لتنال الجزاء الأوفى. وأمّا الدّبوس فكنية لصقت بعمّي الطاهر شقيق الديمقراطي، وأعتقد أنها تليق به ظاهرا وباطنا. فقد عرفناه غليظ اليدين عريض لمنكبين واسع الصدر ثقيل الخطوات، وكان إلى ذلك كثير الصمت، وكنّا لا نعرف له ضحكة أبدا وكان إذا أراد أن يضحك يكتفي بابتسامة تصحبها نحنحة خفيفة. وكان مع ذلك مسالما أبدا. وملخّص حكايته أنّه جرّب في أوّل أيام الشبيبة الهجرة إلى ليبيا ولكنّه عاد بعد أقلّ من أسبوع منهكا، ولم تسمح طباعه للناس أن يعرفوا سرّ عودته السريعة رغم نجاح آخرين أقلّ منه حجما ومنزلة في العبور إلى طرابلس وجني أموال كثيرة. عاد وصنع لنفسه سيرة أخرى، فقد برع في صنائع كثيرة لا يتقنها الناس عندنا كالحلاقة وإصلاح أجهزة الراديو والدراجات الناريّة. لا تتصوّروا أنه فتح دكانا لهذه الصناعة أو تلك، فهذا مستحيل، ولكنّه كان يحلق رؤوس الأطفال في نهاية كل عطلة مدرسية أمام باب منزله وبلا مقابل، وكان يرمّم ما تداعى من أحواش المزارعين لقاء دينارين أو ثلاثة، وكان يصلح ما يلحق بمذياع أحدهم من أعطاب مكتفيا بكلمات الشكر. ومع ذلك كان الدبوس قاسيا عنيفا لا يرحم حيوانا أبدا فلم يُعرف عنه أنّه ربّى كلبا أو قطا أبدا، وكان يقول لا حاجة لي بكلب يأكل من زادي وينبح خوفا على نفسه، ولا إلى قطّ ذليل لا يتردّد في سرقتي، وكان يصطاد الفئران بيده فيمسكها من ذيولها ويرمي بها على الأرض فتموت لحينها. أمّا الحمارة التي كان يركبها ويستعين بها في كل عمل من أعمال المزارعين فقد حرمها من أن يكون لها جحش كبنات جنسها، وكان إذا حلّ موسم تزاوج الحمير يخيط على دُبُرها ما يشبه الواقي المطاطي ليمنعها من التزاوج، فإذا حدث أن حملت الحمارة وأنجبت جحشا فمصيره ليلة ميلاده أن يموت مخنوقا إمّا بقبضة العصا الغليظة أو بحبل يقطع أنفاسه. وكان يعلّل ذلك بعلل شتّى منها أن الحمارة إذا حملت لم تعد صالحة للخدمة، وأن جحشها إذا عاش سيدهور صحّتها، فإذا قيل له خذ حمارا بدل الحمارة قال ذكور الحمير عنيدة وأنا لا صبر لي على عنادها. والحقّ أنّ الدبوس قد أصاب في هذا فلو كان له حمار بدل الحمارة لقتله وكيف لا يقتله وقد كاد يقتل ذات يوم رجلا من أولاد سعد جاء يلاحقنا لأننا عبرنا زرعه، فلمّا رآه يلاحقنا مضى نحوه متثاقلا فسلّم عليه وسأله ما ذنب هؤلاء؟ فقال الرجل: أفسدوا الزرع، فقال الدبوس: كيف أفسدوه؟ هل أطلقوا عليه غنما تأكله؟ قال: لا. قال: فهل رأيتهم يقتلعون شيئا منه؟ قال: لا. قال: فما الجريمة إذن؟ قال: مشوا فيه. فما كان من الدبّوس إلاّ أن أمسك بعنقه وظلّ يضغط عليه حتى كاد يكتم أنفاسه، فلمّا أطلقه ولّى مذعورا وتعالت أصواتنا فرحا بالخلاص وإعجابا بالدبوس. وقلنا: الدبوس حقّ. أي لابدّ من دبّوس.
***
رمضانيات ريفية 29
أيكون العيد غدا أو بعد غد؟ وغدا أو بعد غد سأعود. سأقطع بلدتنا من الغرب إلى الشرق. سأمرّ على مدرستي الأولى وسأعبر أودية ومسالك تعرفني. سأعود، لكنّي لن ألقى أحدا. فأبي قد مات وحليمة ماتت وكذلك زينة ماتت، والخالة حفصية ماتت، وآخر من مات المختار. سأظلّ أمام الدار، وسأسأل عن أمّي. الحوش مليء بالأخبار وبالأحزان. سأعود، لكنّي لن ألقى أحدا. لم يبق أحد إلاّ اثنان، الطاهر عمّي والثاني أخي الداني. رجلان اختارا الصبر وينتظران. سأعود، لكنّي لن ألعب كرة أو ورقا، فعنترة ما عاد هناك، وكذلك كلّ الأقران. سأعود، لكنّي لن أرقب آذان المغرب، فالرزقي تخلّى عن الآذان، وسجائر غومة ضاعت وأحاديث الهادي فقاقيع. سأعود. سأقلّب نظري في كل مكان، في الجبل الرابض منذ زمان، في شجر التين الباسق والرمّان. سأعود، وأسأل كل الجيران. أين الجيران؟ أحواش يملؤها الموت، ولا شيء هنالك إلاّ الأشجان. أين الأرواح إذن؟ وأين هم الرهبان ؟ سأعود. وسأجلس في قلب الحوش الفارغ منهم وسأنصت للحيطان. في الحائط صورة أمّي ترقبني، عيناها ملؤهما الحبّ ويداها تمتدان إليّ. أصافحها؟ أمدّ يديّ، لا شيء هنالك إلاّ الأوهام. وأبي كالعادة يروي قصصا وعصاه بين يديه وكؤوس الشاي تروح وتغدو، يشرب منها ويحكي. كان هنا، والقصّة كان يرويها ويثير بسردها دهشتنا. واليوم صار هو القصة. سأعود غدا أو بعد غد. سنعود. يا رمضان.
***
30
لولاكم سيداتي سادتي ما كان للحكاية أن تنمو. كانت في البدء لعبة لتزجية الوقت. واللعب في رمضان أشهى وأبهى من كل لعب في كل شهر. ثم صارت اللعبة شغلا يشغلنا جميعا فانشغلناعما حولنا. تنشأ الحكاية أحيانا من ومضة خاطفة فإذا بالومضة تصبح ضوءا والضوء يستحيل إلى نور يملأ الكون والكيان معا. هناك حيث تنام الذكريات البعيدة يكمن السر. تنشأ الحكاية أحيانا من لا شيء، من كلمة مهموسة أو صورة مطموسة أو نتفة من فكرة محبوسة. ينفك القيد على الكلمات وينجلي الغبار على الصور فتكون حياة أخرى وينشأ كون آخر. ننسى دنيانا وتنسون. تأخذنا اللعبة. نمضي فيها أو هي تمضي فينا. لا ندري أين نسير ومع ذلك نحن نسير. الحكي حبل نجاة أو حبل وثاق أو توثيق أو حبل آخر. مشنقة. أو أرجوحة أو أنشوطة لكنه حبل والقصة حبلى لا يدري أحد متى تضع؟ أو أين؟ وكيف؟ وماذا عساها قد تضع؟ والحبل حرير، ملمسه مغر ولذيذ. من منا ينفر من هذا وإن قيل له إنه من صنع الدودة؟ القصة دودة ونحن جميعا تسكننا الدودة.
كان أول عهدي بشهر رمضان وأنا طفل في المدرسة. لا أذكر في أي سنة على وجه الدقة، فكل ما أذكره أن الفصل كان خريفا وأن الطقس كان يراوح بين الحر والقر وأن العودة من المدرسة كانت تستغرق منا أزيد من ساعة نمضيها في المشي واللعب أحيانا. أعود من المدرسة فأجد أمي رحمها الله قد أعدّت الإفطار ولم يكن شيئا أكثر من برمة الحساء شربة أحيانا وأحيانا حلالم أو حتى محمّمصة ومعها الخبز رقاقا أو جرادق. وليس لهذا التنويع من معنى سوى أنه اجتهاد لكسر الرتابة ودفع التكرار وما ينشأ عنه من الإملال. كنا وقتها سبعة من أصل تسعة. فأختي الكبرى حليمة رحمها الله كانت قد تزوجت وأنا لم أدخل المدرسة بعد وأختي الصغرى سارة حفظها الله لم تولد بعد. فإذا حان موعد الإفطار ننقسم قسمين. مائدة للرجال أجلس إليها أنا وأبي رحمه الله وأخرى للنساء تجلس إليها أمي رفقة أخواتي أم هانئ وخديجة حفظهما الله و المرحومة زينة. أما أخي صالح حفظه الله فكان ما يزال في الثالثة من عمره وكان حرا يجلس حيث يشاء. تلك هي العادة عند كل إفطار ويحدث أن نكسر هذه العادة فنبعثر هذا النظام ونعبث به فلا نلتزم بما التزمنا به ليلتين أو أكثر الأمر الذي دعا أبي رحمه الله إلى التنازل نهائيا عن حقه القديم في الاستقلال بمائدة لا يشاركه فيها أحد سوايا. وبهذا التنازل صرنا جميعا على مائدة واحدة وحول قصعة واحدة نغرف منها كما نشاء. وكان لليوم الأول من شهر رمضان علامة بارزة فلم أر أبي رحمه الله يصلي إلا في شهر رمضان فإذا رأيناه يتوضأ ويصلي علمنا أننا في شهر الصيام. أما أمي فكانت تصلي في كل فصل من فصول السنة. وكان لصلاة أبي معنى غير معانيها الشائعة فلم يكن يحفظ من القرآن غير الفاتحة وشيئا من سورة الناس يتلوها على غير نظام فإذا أشرت عليه بتصويب التلاوة يكتفي بأن يقول إن الله غفور رحيم.
* * *
(2)
لم يكن في بيتنا ولا في أغلب البيوت في القرية شيء يساعد على معرفة الوقت بالدقيق. فلا ساعة يدوية ولا ساعة حائطية ولا تلك التي تسمّى فياقة أو رفّايا. وكان الكبار منا يستعينون على قياس الوقت بصياح الديكة أو بقيس الظل. وهذا ممكن في سائر الأيام ولكن لرمضان أوقات دقيقة فالإمساك في وقت مضبوط وكذلك الإفطار. وكان لابد إذن من حل لهذه المعضلة فتطوع الرزڨي بن محمد بن سماعين وكان وقتها في العشرين من عمره أو دون ذلك بقليل ليرصد وقت المغرب فيصعد عند كل مساء الجبل قبيل الغروب ومعه؛ شيء من القش أو الحطب ويظل واقفا موليا وجهه صوب مدينة الكاف التي تتراءى لنا بناءاتها عن أكثر من عشرين كيلومترا تقريبا فإذا لمح ومضة المدفع أو أي ومضة أخرى أشعل كومة القش ونادى بأعلى صوته (الله أكبر) ثلاث مرات و لا يتبعها شيء من نص الآذان المعروف. ثم ينحدر مسرعا. وبينما كان الرزڨي يرصد وميض الكاف كنا نحن الأطفال نرصد ناره وتكبيرته فإذا رأيناه يشعل النار تعالت أصواتنا تكرر آذانه المبتور. وأما خيرة زوجة عمي الطاهر حفظهما الله فكانت تقف معنا أمام الحوش تراقب هي الأخرى آذان الرزڨي وبين يديها قادوس ماء فإذا سمعت تكبيرته أو رأت ناره شربت القادوس كله حتى تكاد يغمى عليها. ثم يدخل الجميع فلا يخرج أحد إلا بعد ساعة أو أقل من ذلك.
* * *
(3)
فرحات شحيمة من أصدقاء أبي فضلا عن كونه ابن خالته. كان بائعا متجولا يطوف جميع القرى والمداشر على حماره المحمل بكل ما يستحقه القرويون من خضرواوات وغلال وشاي وسكر وحلويات. وكان لذلك أوسع معرفة بكل جديد وأكثر اطلاعا على ما جد من أخبار وتقنيات. وكان يزورنا بعد كل إفطار تقريبا ليقضي السهرة مع ابن خالته ويروي له من الأخبار ما التقطه في جولته اليومية. ومما رواه لنا ذات ليلة حكاية من حكايات عم حروكة وحين سألناه من يكون عم حروكة هذا وكيف علم بقصته قال حكاية تمثيلية سمعتها في الراديو ومضى يحدثنا عما في الراديو من تمثيليات طريفة تُعرض كل ليلة بعد الإفطار مباشرة فازداد شوقنا لذلك وطالبنا أبي بشراء راديو لنسمتع بهذه الحكايات فاعترض متعللا بقلة ذات اليد حينا وبما لديه من حكايات تغنينا عن حكايات العم حروكة أحيانا. ولكننا تمسكنا بمطلبنا وساندنا في ذلك العم فرحات ويسّر الأمر على أبي فوعده بأن يأتيه بجهاز الراديو بعد ليلة أو ليلتين مقابل ستة دنانير فقط. كان المبلغ كبيرا لا يقل عن ثمن خروف من خرفان أبي فقد رأيته يبيع خروفا بتسعة دنانير ورأيته يبيع بقرة عجفاء بأقل من ثلاثين دينارا وثورا سمينا بأربعين دينارا. ومع ذلك استجاب أبي لمطلبنا. وجاء الراديو. كان مثل علبة صغيرة فيها مفتاحان وإبرة تتنقل يمينا وشمالا لتحط على أرقام وكلما أدرت مفتاحا سمعت صوتا مختلفا عن بقية الأصوات. وبحضور الراديو صار للمفتاح معنى جديد غير معناه القديم فلم نكن نعرف للمفتاح من صورة غير تلك التي رأيناها في مفتاح الصندوق الأخضر الذي يحتفظ فيه أبي بجملة من الوثائق وصار للإبرة معنى جديد أيضا غير إبرة الخياطة وإبرة الوابور نخزه بها لتشتعل ناره وتقوى. جاء الراديو فاجتمعنا حوله وتسابقنا لتسغيله وإدارة مفاتيحه وكان أبي ينهرنا ويأمرنا بالابتعاد عنه ويحذرنا من مغبة العبث به وخصص له مكانا عليا فوضعه في طاقة في أعلى الحائط وكان لا يفتحه ولا يعلقه أحد سواه في وقت معلوم. جاء الراديو وبمجيئه تحول أبي من حكواتي يروي لنا الحكايات إلى مدير تكنولوجي يتحكم في تلك الآلة العجيبة يفتحها ويغلقها وبتعهدها بالصيانة كلما طرأ عليها طارئ ولم تكن الصيانة تعني في الحقيقة شيئا سوى نفض الغبار عنها وتغيير البطارية إذا فرغت وكان يقول كل هذا بسبب منكم لقد . صار لي مصروف زائد.
* * *
( 4)
دخل الراديو بيتنا فبعثر نظامه القديم وتغيرت عادات كثيرة واتسعت آفاق العالم في أذهاننا. كنا قبل ذلك نعتقد أن العالم هو تونس وفرنسا والجزائر. بل إن تونس هي الكاف وتاجروين فإذا هي أوسع من ذلك. أما فرنسا فلم نكن نحسبها أرضا وكنا نتخيلها في صورة جندي مدجج بالسلاح وأما الجزائر فكانت تبدو لنا بعض قراها ومدنها من بعيد عند كل غروب حين تتلألأ أنوارها. وكنا لذلك نحسبها جزءا منا أو نحسب أنفسنا جزءا منها. لا فرق. واكتشفنا بالراديو أننا مختلفون. فهم يتكلمون بلهجة مختلفة عنا بعض اختلاف وفيهم رجل يعظمونه كما كنا نعظم بورقيبة. وكان بورقيبة أعظم من أن يتسع له خيالنا فإذا هو رجل مثل بقية الرجال يتكلم عاميتنا ويقول (فهمت الحاصل معناها) كما يقول الرجال في بلدتنا ثم تقلصت صورته وتضاءلت حين سمعنا أحدهم يقول (ما جابهاش بن بلة خلّي الحبيب الفرطاس). ومن يكون بن بلة هذا؟ لابد أنه أعظم من بورقيبة ولكنه حسب نص المثل فاشل مثله. و لعل أعظم اكتشاف جنيناه بدخول الراديو هو تلك الفاتحة التي يفتتح بها عبد المجيد بوديدح نشرة الأخبار باللسان الدارج حين يقول في مفتتحها (صحة شريبتكم) لم نكن قبل ذلك نقول هذه الكلمة وكنا نقول (بالشفاء). بدت لنا هذه الكلمة أول الأمر غريبة فالشريبة تصغير شربة الماء ثم علمنا بعد ذلك أنها تصغير الشوربة. نحن أيضا لم نكن نسمي الشوربة شربة وكنا نسميها دشيشة. سقطت أسماء وعلت في المقابل أسماء أخرى وصار اسم بورقيبة من الماضي تماما كالدشيشة ولم يعد للديك أو الظل من معنى إذ صار الوقت يعرف بدقات الجرس على أمواج الإذاعة الجزائرية. وكانت أمي تقول توقيت الجزائر أقرب إلينا من توقيت تونس ثم تبين لنا أنها قد أخطأت فعدنا إلى التوقيت التونسي دون مراعاة الفارق. مضى زمن طويل جدا على زيارة فرحات شحيمة التي جلبت لنا الراديو وها هو يزورنا مرة أخرى بعد غيبة طويلة. كان قد ترك البلدة وانتقل إلى العاصمة. جاء ليجد في بيتنا تلفزة بالألوان. كنا ننتظر آذان المغرب على أمواج إذاعة الكاف وإذا بالمؤذن يرفع صوته في التلفزة فبادر العم فرحات رحمه الله إلى الطعام فقلت له هذا آذان المغرب في العاصمة. قال (نحن نفطر على هذا الآذان وأنتم أحرار). أما أبي فقد وجد له فتوى وقال ( افطر على روحك أنت جاي من تونس وصمت قبلنا)
***
(5)
فاتني أن أقول لكم إن العم فرحات قد عرف بين الناس بكنيته شحيمة لما رأوه فيه أيام الطفولة من بياض ناصع ولكن هذا البياض تحول شيئا فشيئا إلى حمرة مشوبة بسمرة من أثر التجوال في كل الأوقات. وكان له أخ شقيق اسمه يوسف وكنيته الروج إذ كان كأخيه تماما أشقر اللون أصفر الشعر أزرق العينين. ولعل شقرة الرجلين قد ورثاها من والدتهما أم الزين خالة أبي. وكانت اسما على مسمى. وليوسف الروج فضل علينا كفضل فرحات شحيمة أو أكثر فقد كان من القلائل الذين هاجروا إلى فرنسا فزادته الهجرة شقرة على شقرة وعاد إلينا بعد سنوات وبين يديه ماكينة وليست هذه الماكينة آلة حصاد كما قد يظن بعضكم ولا آلة حلاقة فالماكينات كثيرة ومعانيها شتى. إنها ماكينة الغناء المسمّاة تورنديسك والديسكات كانوا يسمونها صحونا. ولا أدري ما العلاقة بين الديسك والصحن فالصحن عندنا وعاء للطعام جاء بعد المعجنة وإذا هو مع الروج دائرة سوداء رقيقة إتودع في قلب الماكينة وتحط عليها إبرة أخرى غير الإبر السابقة فينطلق صوت المغني بأعذب الألحان. كان يوسف الروج يطوف على الديار فيسهر في كل دار سهرة ليطلع الناس على أغان شعبية يغنيها فنانون جزائريون مثل أبي رقعة وبڨار حدة وحدة الخنشة والڨصاب إبراهيم بن دباش وغيرهم. أتساءل الآن كيف عاد الروج من فرنسا بكل هذه الأغاني الشعبيّة ولم يصحب معه صحنا واحدا من صحون الفنانين الفرنسيين. لابد أنه مثلي تماما لا يجد لذة الغناء إلا في أغانينا الشعبية على أني تعلمت لاحقا أن أتذوق أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفهد بلان وفيروز وكل ذلك بفضل الراديو. ومن طرائفنا مع الروج أنه كان ذات ليلة من ليالي رمضان عائدا من عبيدة حيث يقيم بعض أهالينا وكان في زيارة من زياراته الليلية المعتادة لاستعراض ماكينته وعرض موسيقاه على الناس وكنا جماعة من الفتيان حديثي العهد بالتدخين نخرج بعيدا عن منازلنا لنتقاسم سيجارة أو سيجارتين فلما لمحناه يحث حماره على السير خطر لنا أن نعترض سبيله متنكرين وهجمنا عليه دفعة واحدة وأحطنا بالحمار من كل ناحية وظللنا نتراقص دون أن ننبس بكلمة وإذا بعمنا يوسف يرفع صوته مرددا المعوذتين فلما خفنا عليه انسحبنا ولذنا بقمة الجبل. ومن الغد راح الروج يحدث أهل البلدة بالأرواح التي عرضت له وسألوه كيف نجا منها قال : لولا المعوذتان لكنت في خبر كان فيقول له الناس ما جلب لك الأرواح إلا ڨصبة إبراهيم بن دباش وصوت حدة الخنشة
***
(6)
لم يكن على مائدة الإفطار شيء سوى الشوربة والخبز فلا مفتحات ولا محليات. هي أكلة واحدة تتكرر والمتغير الوحيد هو نوع الشوربة إن كان دشيشة أو حلالم أو لسان عصفور. وبتقدم الأوقات دخلت على المائدة أطعمة أخرى لم نكن نعهدها. فالملسوقة مثلا أتتنا من تجربة حليمة أختي رحمها الله وكذلك الطاجين. أذكر أن أبي ظل يسأل عن اسم هاتين الأكلتين ولا يقتنع بالجواب. قال : كيف يسمون هذا طاجينا والطاجين كناية عن كل قبيح وكيف يسمون هذه ملسوقة ولا شيء فيها يدال على الإلصاق ولا على السلق؟ لابد أنه وجد فيهما مذاقا غير معهود ولابد أنه استطاب ذلك وإلا فما سبب حيرته. أما المقرونة فلم تكن ذات شأن عندنا لسبب بسيط وهو أن معجناتنا التقليدية أنفع منها وأطيب ولكن هذه المقرونة لما صارت بالصلصة غير مرمية فقد فعلت ما فعله الطاجين والملسوقة خصوصا إذا كانت فلا بخلاف تلك التي تكون في شكل أعواد طويلة ونحتاج لتناولها إلى الشوكة عوض الملعقة وضعت زينة أختي رحمها الله طبق المقرونة هذا أمام أبي وظل ينظر إليه فتش عن الملعقة فلم يجدها ووجد عوضا عنها شيئا آخر بثلاثة أصابع طويلة. قال: ما هذا؟ هاتوا الغنجاية. فقيل له: الغنجاية لا تنفع في مثل هذه الحالة. خذ الشوكة اغرسها في الطبق واستمر في تدويرها لتلتقط المقرونة. حاول ذلك َمرة ومرتين وثلاث مرات. لم يفلح. رمى الشوكة بعيدا وهو يزمجر غاضبا (هزوا علي الكازي. ما عادش نحب نشوفها. هاتوا لي الكسكسي) كان المسكين صائما ينتظر لذه الإفطار فإذا بهذه المقرونة الأعواد المنثنية تفسد عليه مزاجه.
***
(7)
كان أبي رحمه الله شديد الافتخار بأبناء خالاته وأخواله وأعمامه لا لما بينهم من قرابة بل لما كانوا يتقنونه من حرف متنوعة فقد كان منهم البائع المتجول واابنّاء والحانوتي وكان لذلك يلجأ إليهم كلما هم بإنجاز عمل فإذا عرض له أن يبيع شاة أو بقرة استشار محمدا الأخضر ابن عمه إبراهيم وإذا خطر له أن يفلح حقلا من حقوله الصغيرة المشتتة نادى ابن خاله أحمد الغريسي الملقب بالفلاح دون أهل البلدة كلهم وإذ همّ بترميم الحوش أو المنزل كله لجأ إلى ابن خاله الهادي المعروف بالهاي فقاع لا لعيب في خلقته أو في أخلاقه بل لقدرته الفائقة على اصطناع الحديث في كل شيء تقريبا دون أن يكون لذلك أثر في الناس فشبهوا أسلوبه في الحديث بالفقاقيع سرعان ما تنطفئ. أما أبي فكان لا يكاد يتقن شيئا سوى سرد الحكايات في ليالي الشتاء وفي سهرات رمضان ومعالجة بعض ما يصيب الحمير والبغال دون غيرها من الحيوانات من أمراض. لذلك كان الناس يقصدونه لتزجية الوقت والاستمتاع بخرافاته أو لعلاج حميرهم وبغالهم.. وبينما كان ذات سهرة من سهرات رمضان الصيفية يتصدر مجلس الحكي أمام حوشنا وكان المنصتون إليه جموعا من الرجال والنساء والأطفال إذ اقبل وفد من بني شارن يسوقون قافلة حمير وبغال يقولون إنها أصيبت كلها بأعطاب في أرجلها الأمامية. وطلبوا من أبي أن يعالجها كلها قبل موعد السحور فاعتذر بما كان منشغلا به من الحكي ووعدهم أن يكون لهم ذلك في الليلة المقبلة ثم دعاهم إلى الانضمام إلى مجلسه وكانت الحكاية حكاية أبي جلد صاحب الحمار وكيف صنع لنفسه من جلد حمار له فوزا عظيما إذ كان يلبس ذلك الجلد ويقصد الغابة فإذا بلغ شجرة بعينها نزع الجلد وأوقد النار وتمتم ببضع كلمات سحرية صار جلد الحمار فرسا بجناحين يركبه أبو جلد ويطير في الأجواء قاصدا مملكة الجن في أقصى الأرض حيث ينبت نوع من التفاح يفوح ويرد الروح كما يقال. كان الحاضرون منشدين إلى عالم الحكاية وإذا برجل من وفد شارن يقفز داعيا رفاقه إلى الانسحاب فورا وهو يقول ألم تفهموا الحكاية بعد؟ عمكم رمضان يقول لكم اذبحوا هذه الحمير والبغال واسلخوا جلودها عنها تفوزوا بخيول مجنحة. هيا يا جماعة إلى الغابة قبل أن ينسلخ الليل. قال أبي ما أطيب بني شارن، أيكون ذلك مما جعل البايات يعولون عليهم في أمور دولتهم في هذه الربوع؟
***
/ 8
لأيّام رمضان ولياليه في الصيف صور لا تكاد تكون في مواسم أخرى. يبدأ الإمساك في بلدتنا كما في سائر البلدات باكرا جدّا ولا يكون الإفطار حتّى تنقضي عشرون ساعة إلاّ ثلاثا تقريبا. ومدّة صوم طويلة كهذه في فصل حرّه شديد وأعماله كثيرة تستوجب صبرا جميلا وعزيمة من حديد أو تسامحا كثيرا وتفريطا في العديد من طقوس الصوم للمتدرّبين عليه من الصبيان إناثا وذكورا. وقد كان أبي رحمه الله يدعونا إلى التدرّب على الصوم ونحن لم نبلغ الرشد بعد ولم يكن مع ذلك شديدا بخلاف أمّي رحمها الله فقد كانت تغضب إذا رأتنا لا نطيق صبرا على العطش والجوع فنتناول شربة ماء أو لقمة خبز إذا عدنا من المرعى عند الضحى بعد حوالي ستّ ساعات قضيناها تحت الشمس نلاحق شياهنا في مراعيها البعيدة. وكانت تقول عنّا أمثالكم لا يكون منهم رجال ولا نساء فنندم على ما أتيناه ونستأنف الصوم إلى المغرب وكان أبي لا يغضب من ذلك أبدا ويجتهد في فتاويه وشعاره في ذلك ( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها). لم يكن يحفظ الآية وكان مع ذلك يتمثّل معناها ويعمل به. فتعترض عليه أمّي وتتّهمه بتحريضنا على ترك الصوم ليستفيد من أعمالنا معه في الحقل صباحا ومساء وفي البيدر عند الظهر فيقول: نعم. أليس هذا أحبّ عند الله من تعذيب هؤلاء الأطفال وحملهم على ما لا يقدرون عليه، ومن ترك هذه المحاصيل التي نعتاش عليها تذهب سدى؟ ومثل هذه الفتوى لم تكن تُعجب أمّي حتّى أفقنا ذات فجر فوجدنا موعد الإمساك قد فات عليه وقت قليل. كان الفجر قد طلع تماما وكانت النجوم قد اختفت ولم يلحق أحد منّا السحور وكنت أنا وأختاي خديجة وزينة رحمها الله من المعنيين بالتدرّب على الصيام. أمّا أمّي فقد اعتذرت لنا وتأسّفت لفوات وقت السحور ودعتنا إلى الصوم إن شئنا، وأمّا أبي فقد دعانا إلى تناول السحور في ذلك الوقت إن شئنا الصيام. فاعترضت عليه أمّي قائلة: ألا ترى ضوء النهار قد انتشر في الآفاق؟ فقال: لا بأس، سأغلق الباب وأحجب الضوء عن البيت، تعالوا، خذوا ما شئتم من الطعام والشراب إن كنتم تنوون الصيام. فإن لم تنووا ذلك فهذا فطور صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا نوارة، دعي الأطفال يكبروا. وكبرنا، وصار الصوم واجبا علينا ولا حجّة لنا عند أبي وظللنا على تلك العادة حتّى ظهرت فتنة رؤيا الهلال وتفرّق الناس بين مذهب الدولة القاضي باعتماد اليومية لتحديد أول رمضان وآخره ومذهب الإسلاميين القاضي باعتماد الرؤية. وكان من الناس مفطرون وصائمون وانتقلت الفتنة إلى بيتنا ولكنّها سرعان ما انطفأت فقد كان أبي على تسامحه في الدين لا يقبل الخروج عن مذهب الدولة فيه وكانت أمي على تشدّدها في الدين لا تقبل هي أيضا مثل هذا الخروج.
***
9/
تقع بلدتنا جزة جنوب مدينة الكاف وهي من أكثر بلدات هذا الجنوب اتساعا وارتفاعا وعمرانا. وهي شطران بينهما الوادي المعروف بوادي طلحة أحدهما نسميه الظهارة لأنه يقع في ظهر الوادي أي غربه والآخر القبالة أي شرقه. وكانت مع ذلك أبعد البلدات عن عيون الدولة فلم يحظ أهلها منذ الاستقلال إلا بمدرسة واحدة تقع ظهرة الوادي فيها درست ومنها ارتقيت إلى الثانوية. أما قبلة الوادي حيث كنا نقيم فلم تأتها المدرسة إلا في أواخر العهد البورڨيبي. وصادف أن كان ذلك في شهر رمضان فقال الناس رمضان هذا العام أكثر الرماضين بركة علينا. مدرسة صغيرة تتوسط الدوار تتألف من قاعتين ودورة مياه ومعلم وحيد، بلا سياج ولا ساحة مهيئة للأطفال إن شاؤوا اللعب. وكان هذا المعلم الضيف في عيون أهل البلدة القبلية معلما يختلف عن كل المعلمين الذين رأوهم من قبل فهو مثلهم تماما في كل شيء تقريبا بإستثناء الشهادة العلمية التي يفوقهم بها. فقد كان اسمه يونس وهذا الاسم شائع بينهم بل إن دار العم يونس كانت قريبة جدا من المدرسة الجديدة ولم يكن من المعلمين القادمين من جهة الساحل أو الوطن القبلي فهو من بني شارن وبنو شارن أجوار وأصهار. ولم يكن يملك سيارة أو دراجة نارية ولا حتى عادية وكان مع ذلك يفكر في التنقل يوميا بين محل سكناه في عقلة شارن ومقر عمله ولكن أهل بلدتنا الكرام خلصوه من هذه المشقة فقد تبرع له زوج أختي حليمة رحمها الله بحوشه ليسكنه بلا مقابل بعد أن انتقل للإقامة في تاجروين وترك عمل الزراعة واحترف التجارة بدلا منها. وكان هذا الحوش من أكثر الأحواش اتساعا وكان له باب من حديد بأقفال محكمة ومن حوله جنان التين والزيتون والمشمش. فلما اطمأن القوم على سكن المعلم التفتوا إلى مأكله فعقدوا اجتماعا أسفر على برنامج لإطعام المعلم يونس على امتداد العام وأعلموه بذلك فكان لكل عائلة من العائلات المقيمة حول المدرسة يوم في الأسبوع تتكفل فيه بتقديم الغداء والعشاء للمعلم. وتنافست العائلات في ذلك أيما تنافس وزاد رمضان في حدة التنافس فكانت كل ربة بيت تجتهد في إخراج طعامها في أحسن صورة وألذ مذاق وكان ذلك يستوجب ثقافة جديدة في الطبخ اكتسبها نساء البلدة من برامج يذيعها الراديو فتعلمن إعداد الكثير من الأطباق الجديدة ليأكلها يونس هنيئا مريئا. وانتهى ذلك العام الدراسي وغادر المعلم يونس القرية مشكورا على جهده ولكنه لم يعد إليها في العام الدراسي الموالي. هل ترك البلدة لأنه لم يعجبه فيها شيء لا المسكن ولا المأكل ولا الصحبة التي كانت تجمعه ببعض شبان البلدة المتعلمين مثله أو أكثر بقليل؟ ربما.
***
10/
كان لي عمتان اثنتان لا يكاد الناس يفرقون بينهما إذ كانت الواحدة منهما تشبه الأخرى في كل شيء تقريبا. لقد كانتا امرأة واحدة في نسختين متطابقتين فالعينان غامضتان لا تدري إن كانتا خضراوين أو زرقاوين أو مزيجا بين الأخضر والأزرق والوجه أشقر مشوب بحمرة طبيعية لم تلحقه تلك السمرة التي لحقت وجه أبي والأنف ينحدر في انحناءة خفيفة تمنعه من أن يكون منقارا والشعر ينسدل أحمر قانيا َمن أثر الحناء. وكنت إذا رأيتهما َمعا ينتابني شعور غريب وأقول في نفسي لابد أن إحداهما انعكاس للأخرى وأنظر حولي لعلي أرى مرآة عاكسة فلا أظفر بشيء. ولم أتخلص من هذا الشعور إلا بعد أن رأيت عمتي مباركة مستقيمة الظل ورأيت عمتي فجرية منحنية الظهر لا تقوى على الوقوف باستقامة وسألت أمي عن سر هذه الانحناءة الغريبة التي لحقت بها فذهبت بحسن قوامها فقالت : عمتك مباركة أنعم الله عليها بالبنين والبنات من زوج يكرمها وينفق عليها بلا حساب. ألا تعرف الشاوش محمود؟ كان من خدام جدنا وسيدنا طلحة وكان إلى ذلك رقيقا لطيفا من أثر ما تعلمه في الجامع من الأذكار والمدائح. أما عمتك فجرية فقد شاء الله أن يحرمها من ابنها الوحيد. قلت : أمات ابنها الطيب؟ قالت: بل اسمه الحقيقي العيد وضعته يوم عيد الفطر، وهو اليوم حي يرزق ولكنه لم يعش معها إلا سنوات. لقد فر من أمه وأبيه ولم يبلغ الرشد بعد جراء ما لحقه من الضرب والإهانة لأتفه الأسباب. أرأيت كل هذه الرقة في عمتك فجرية؟ هي لا تعدل ما كانت عليه قبل ذلك بأعوام طوال والسبب في ذلك غلظة زوجها أبي جمعة وقسوته عليها . لم أستسغ حديث أمي عن عمتي ولعلها لمحت ذلك في قسمات وجهي فقالت : عمتك هذه إمرأة من حديد ولو أن الذي أصابها أصاب غيرها لماتت ولكنها صمدت وتلقت المصيبة فلم تنل منها إلا لماما. قلت : وما قصتها؟ قالت تزوجها أبو جمعة صغيرة وحجزها في حوش عال لا تخرج منه إلا نادرا من فرط حبه لها وغيرته عليها من العيون وكان قاسي القلب غليظا شديدا عليها. وضعت ابنها العيد في سنتها الثانية من الزواج ولم تضع بعده أبدا. أو تدري لماذا؟ لأنها كانت ترى ابنها يضرب ويرفس فتثور على أبيه دفاعا عنه. فيضربها أبو جمعة بعصاه ويرفسها بقدميه. قلت : ومن أين جاءه الاسم الثاني؟ قالت: فر العيد ولم يعلم الناس له وجهة. فتشوا عنه في البلدات المجاورة وسألوا عنه الناس في تاجروين والدهماني والكاف فلم يفدهم أحد بخبر عنه. وسافر أبو جمعة إلى العاصمة وعاد بعد أسبوع أو أكثر بخفي حنين كما يقال. أما عمتك فجرية فدخلت في حداد أسود قاس وهامت على وجهها شهورا وظل أبو جمعة يلهث خلفها فلم يهدأ لها بال حتى جاء رجال الحرس الوطني ذات يوم فأخذوا أبا جمعة واقتادوه إلى المركز فلما عاد سأله الناس عن سبب هذه الدعوة فقال: فر العيد منذ سنوات وعييت في البحث عنه حتى يئست منه ولكن رجال الحرس قالوا لقد قبض عليه مع جملة المعتقلين من عناصر الفتنة اليوسفية في ناحية من نواحي بنزرت وقد أفاد في التحقيق أنه ابن أبي جمعة وابن فجرية من جزة. فهل هو ابنك؟ قلت نعم. فقدته منذ سنوات. ثم قالوا: هو الآن محكوم عليه بالسجن واسمه المدني الطيب اليعقوبي ولك أن تزوره. قالت أمي: وأمضى العيد الطيب في السجن ثلاث سنوات ثم نفي إلى سوسة حيث يقيم اليوم وهو لا يزور البلدة إلا نادارا. وشاءت الأقدار بعد أربعين سنة من فرار العيد الطيب أن أكون طالبا في دار المعلمين العليا بسوسة وأن أزور ابن عمتي في منزله وأن أسمع منه ما لم تروه أمي ولم يروه أبو جمعة
***
/11
سألت العيد عرفا الطيب شرعا عن قصة فراره من أمه وأبيه فقال: كان الفصل وقتئذ صيفا حارا وكان الشهر شهر رمضان وأذكر أني كنت أقصد حانوت الهريسي بعد كل إفطار للعب الورق. كان اللعب قمارا وكنت أختلس كل غروب بيضة أو بيضتين من بيض الدجاج الكثير الذي كانت تربيه أمي. وأنحدر نحو الحانوت مسرعا خشية. أن تفوتني حصة القمار وخوفا من تفطن أحدهم إلي وأنا في قن الدجاج. وأذكر أني جمعت من القمار بعد نصف شهر تقريبا مبلغا كنت أعتقد أنه يكفيني لاقتطاع تذكرة السفر إلى العاصمة على متن القطار. ولكن مصاريف التدخين أخلت بهذه الموازنة وأيقنت أن الهروب مستحيل إن استمر الوضع على هذه الوتيرة فخطر لي أن أبيع خروفا من خرفان أبي كنت أرعاها كل يوم. وكان الأمر كذلك. كنا وقتها نرعى القطعان في الموضع المعروف بالتلة بعيدا عن منازلنا. وكانت التلة في طريق الخضارين من عبيدة يمرون عليها كل يوم اثنين ليبيعوا خضراواتهم في سوق تاجروين. وأذكر أني عرضت على أحدهم خروفا اخترته فابتاعه مني بثمن بخس ولكنه يكفي لشراء تذكرة. ثم تركت الشويهات وقصدت محطة القطار في موضع نسميه المسخية. كانت المسافة بعيدة ولكن الخوف والرغبة في الخلاص من القهر جعلني أطويها طي السحاب. وأدركت قطار القلعة الجرداء. كانت الرحلة طويلة حتى أكلتني الوساوس. في عربة القطار فكرت في الوجهة التي أنا موليها. أين سأنزل ؟ وأين سأقيم؟ وماذا سأصنع؟ أسئلة لم تطرأ على بالي قبل ذلك. كنت قبلها منشغلا بخطة الفرار وهاهي الآن تهجم علي دفعة واحدة. ومع ذلك لم أفكر لحظة في الرجوع. في العاصمة وجدت نفسي في الزحام فزاحمت مع المزاحمين. لا أدري علام كان الزحام ولكني زاحمت حتى وجدت نفسي في عربة قطار آخر قيل لي بعد ذلك إنه قطار بنزرت. لم أسمع بهذا الاسم من قبل. وجاء مراقب التذاكر فطلب مني التذكرة. كنت في الزحام ولم أقتطعها. قال أين تقصد ؟ قلت لا أدري ولكن أريد تذكرة بأقل سعر ممكن. وتقود إلى أبعد نقطة عن العاصمة قال: يمكنك أن تقصد ماطر. رأى في عيني حيرة فقال هي في الوسط بين العاصمة وبنزرت وأظن أنها تليق بك. لابد أنه لاحظ هيأتي الريفية فاختار لي هذا السبيل. وقد أحسن الاختيار حقا. أدركت ذلك حين وجدت نفسي في بلد كثير البساتين والمزارع وسهل علي الانخراط فيه. عملت شهورا عدة في الزراعة وتيسر لي ما كان عسيرا على.،فقد انضممت إلى قوم علموني القراءة والكتابة ودربوني على القتال وقالوا حين أخبرتهم بأصلي وفصلي: لا عدو لك اليوم إلا هذا المحتل الأجنبي وهذا الذي يفاوضه على استقلال داخلي. قلت أنقاتل بورقيبة ؟ قالوا : نحذره ولا نقاتله حتى يقاتلنا. وكان الأمر على هذا النحو ولكن بورقيبة كان الأقوى. حوصرنا في مخيم على أطراف مدينة ماطر فمات من مات واعتقل الباقون. وكنت من الباقين.
***
12
بدا للكثير منكم أن أبا جمعة زوج عمتي رجل فظ غليظ قلبه قاس أو هو بلا قلب. أنا أيضا كنت أقول عنه ما تقولون بل كنت حين أراه بعمامته البيضاء ولحيته البيضاء وعصاه البيضاء أيضا أحسبه ملك الموت فأحيد عن طريقه خشية أن يقبض علي. من أين جاءت هذه الصورة وكيف سكنت رأسي وأوحت لي بما أوحت؟ لابد أنها صنيعة تلك الأحاديث التي ترويها عمتي عنه أو ربما من حرصه الدائم على حماية بستانه وما فيه من أشجار التين و المشمش واللوز من عبث العابثين. فقد كنا نحن الأطفال لا نبقي من ثمار الأشجار شيئا لأصحابها بل كنا لا ندعها تنضج في أغصانها فنقطفها وهي في أول الظهور وكان بستان العم أبي جمعة البستان الوحيد الذي يمتنع علينا ولكن ثماره الناضجة كانت تصلنا فنأكلها من يدي عمتي. كنت كما أسلفت أنظر إلى أبي جمعة من هذا المنظار ولكني رأيت فيه بعد ذلك صورة رجل آخر إذ تبين لي وأنا تلميذ أستعد لامتحان الباكالوريا أنه لم يكن يكره الأطفال بل كان يكره أن يكونوا أشرارا مفسدين فإذا كفوا عن ذلك كف عنهم غضبه. وكان لما رآني أنضج وأتزن يدعوني لمساعدته في أمر من الأمور كأن أقرأ له رسالة وصلت من ابنه الطيب أو أكتب له رسالة ترد عليها. وآذكر أنه دعاني يوما لأنظر في حزمة من الأوراق النقدية لم يعرفها كان يعرف أنها ليست من الدنانير التونسية ولكنه لا يعرف إن كانت دنانير جزائرية أو فرنكات فرنسية وكان يتمنّى أن تكون فرنسية فلما علم أنها ليست كذلك ضحك من نفسه ضحكة لم أرها من قبل وقال (الطماع يبات ساري). أبو جمعة يضحك إذن ويضاحك أيضا بل هو أرق من ذلك. فقد قرر ابنه الطيب ذات صيف أن ينقل أباه وأمه للإقامة معه لما بدأ يظهر عليهما من العجز فاستجابا له وظلا عنده في سوسة الصيف والخريف وبعضا من الشتاء. كنت وقتها طالبا بدار المعلمين العليا وكان أبي يحثني على زيارة عمتي والاطمئنان عليها. فلما اقترب موعد العطلة زرتها لأنقل أخبارها إلى أبي ولكن ابا جمعة دعاني إلى المقهى ليخبرني بخطة رسمها مع عمتي للعودة إلى جزة والخلاص من هذا السجن الذي وضعا فيه كما قال. وملخص الخطة أن تقول لي عمتي بحضور ابنها أنها ترغب في العودة معي إلى الكاف لزيارة الأهل فإذا انقضت العطلة عادت معي.، وأن أضمن أنا عودتها إذا شك الطيب في ذلك وأن أعود بعد العطلة دونها فإذا حصل ذلك لحق بها. قلت ضاحكا: ولكن العيش هنا أفضل لكما فقال: ألا تفهم؟ أنت تفهم فلا تلعب دور الناصح. وكان الأمر كذلك.
***
13
تمكين النساء من حقهن فى الإرث المنصوص عليه شرعا وقانونا أمر غير معمول به في بلدة أغلب سكانها من الفقراء إذا لا يجد الناس ما يمكن تقاسمه بينهم وجرت العادة على أن يؤول الميراث لمن ظل مقيما في بيت من رحل من الآباء. حتّى الرجال الذين تركوا البلدة ونزحوا عنها لم يلتفتوا في الغالب إلى ما تركه الآباء ولكن العمتين مباركة وفجرية قررتا ذات يوم المطالبة بحقهن في ما ترك أبوهما عمار. لا أدري كيف طرأت الفكرة عليهما ولا كيف خططتا لتنفيذها. ما أعلمه أنهما حلتا علينا ضيفتين في إحدى ليالي رمضان وكان الفصل صيفا وأن العمة فجرية دعت أبي بعد الإفطار إلى الحديث معها في أمر خاص. ظن الجميع أن الموضوع خلاف بينها وبين زوجها كالعادة ولكنها أتت بجديد هذه المرة. قالت تخاطب أبي: يا ابن أمي، سأقول كلمات قد لا تعجبك ولكنها حق. نحن نريد منابنا مما ترك الوالد. قال أبي: ولكن منابكما ليس عندي وحدي. هو مفرق بيني وبين أبناء إخوتكم. مات أخوكم عمر وترك رجلين وامرأتين ومات أخوكم الزين وترك رجلين وثلاث نساء. وها أنا حي أرزق وعلى استعداد تام لتأخذا هذا الحق. فقالت العمة مباركة: أنا في الحقيقة لا أحتاج إليه ولكن يحلو لي أن آخذه. وظللنا طيلة السهرة نسمع حديثا من هذا القبيل بأساليب شتى حتى تم الاتفاق على دعوة المعنيين بالأمر كلهم إلى اجتماع للنظر في هذه القضية الطارئة وأن يكون ذلك في أيام عيد الفطر. كان اثنان من أبناء عمي عمر يقيمان في العاصمة أحدهما وهو أحمد لا يكاد يزورالبلدة آبدا وكنت أعرفه سماعا لا عيانا. والثاني وهو السايح ودود كثير التردد على البلدة رغم طول المدة التي قضاها مهاجرا في فرنسا. وتولى أبي التنسيق مع أبناء عمي الزين وهما المختار الديمقراطي والطاهر المعروف بالدبوس وإعلام أحمد والسايح للحضور في اليوم الثاني من أيام العيد والنظر في طلب العمتين. وحضر المعنيون كلهم وكان الاجتماع في منزل الدبوس وسمح لنا نحن الأطفال بحضور الجلسة كما سمح للنساء كلهم. ودار النقاش. كانت العمة فجرية هي الأجرأ والأوضح وكانت عمتي مباركة تكتفي بالمصادقة على ما تقول أختها أو بتوضيح ما بدا غامضا أو غير مفهوم أو بتعديله تعديلا طفيفا ليناسب المقام ويحافظ على هدوء الحال. وأسفر الاجتماع على اعتراف الكل بحق العمتين وعلى استعدادهم لتمكين الطالبتين منه. ولم يبق شيء سوى التنفيذ. قالت العمة فجرية؛ ليكن ذلك قبل عيد الأضحى. قال السايح : فكرة جيدة. وستكون مناسبة للاحتفال بعيد الأضحى هنا. ثم جاء العيد وحضر الجميع وجيء برجل قيل إنه يفهم في المواريث وعرضوا عليه القضية فاستعصت عليه لتشتت الأرض وقدم المسألة وسقوط الكثير من عناصر الميراث فلما أدركت العمة فجرية ذلك اقترحت فكرة فاجأت الجميع. قالت: نترك حقنا في رقابكم فلا نأخذه منكم شرط أن تزورونا كلكم مرة كل صيف. كانت تعني أحمد والسايح فالباقون قريبون منها تزورهم ويزورونها باستمرار. وكان الأمر كذلك.
***
/ 14
كان أبي يكاد يختصّ دون رجال البلدة كلها باسمه وهو رمضان ولعلّ ذلك ممّا جعله ينجو من الألقاب الملحقة بمن كانت أسماؤهم متكرّرة مثل محمّد وعلي وعبد الله وإبراهيم وغيرها من الأسماء الشائعة. وهي في الغالب ألقاب وكنى تشير إلى صفات بارزة في أصحابها ألحقوها بهم ليميّزوا محمّدا من محمّد أو عليّا من عليّ أو غير ذلك من الأسماء. فمن المحمّدين من سُمّي الطيّور لخفّته ومنهم من سمّي الأنديشي لمشاركته في حرب الهند الصينية. ومن العلويّين من سمّي بازوكا لإدمانه لعب الورق واحترافه فيه وربّما لمشاركته في الحرب العالمية الثانية ووقوعه أسيرا لدى الألمان، ومنهم من سمّي البوهالي ربّما لما رأوه فيه من السذاجة ولم يكن كذلك أبدا، ومنهم من سمّي البكّوش وقيل إنّه لم ينطلق لسانه إلاّ في الخامسة من عمره. أمّا أبي فلم أعرف له كنية شائعة سوى أنّ بعض الأباعد كان يسمّيه الداني وسألته عن ذلك فقال: لم أكن في طفولتي الأولى أتقن النطق باسمي وكنت أقول عن رمضان دان فاستعذب بعضهم ذلك لما رآه في الدال المفخّمة من اجتهاد في نطق الضاد وصار يناديني الداني. والسبب في تسميته رمضان أنّه ولد في شهر رمضان ومن المصادفات أنّه مات في رمضان أيضا. لم تشهد عائلتنا موتا منذ أكثر من عشر سنوات، وها أن الموت يتردد على أبوابها. في رمضان الذي سبق رمضان ذلك العام مات عثمان ابن عمّتي في حادث مرور فظيع، كان قادما من العاصمة لزيارة أمّه ولكنه مات. وها أنّ أبي يموت بعده بسنة. صار لنا مع رمضان قصّة موت تروح وتغدو. مات أبي. كان ذلك في مثل هذا اليوم من شهر الصيام أي ليلة النصف. مات ولم يمض على مرضه أكثر من أسبوع. زارني قبل مرضه رفقة أمّي ليباركا لي الحصول على مسكن خاص بعد معاناة الكراء. وكان في زيارته تلك سليما معافى لا يشكو من شيء. سمعته ليلة زارني يقول لقد آن لي أن أنام. حسبته يريد النوم حقيقة ولكنه كان يشير إلى نهاية القصّة. في الليلة السابعة من رمضان ذلك العام انتابني شعور بالضيق لا عهد لي به. تركت مائدة الإفطار وجلست في شرفة المنزل وتنهّدت تنهيدة عميقة لم أكد أنهيها حتى رنّ الهاتف. هذا أخي صالح على الخط. لم يسلّم ولم يقل صحة شريبتك. قال بنبرة المستعجل: الحق أباك، فقد وعيه منذ دقائق. نصحونا في مستشفى تاجروين بنقله إلى مستشفى الكاف. وهناك قيل لنا إنّ جلطة في الدماغ تسببت له في شلل نصفي. لم تتعدّ مدة إقامته بذلك المستشفى ثلاث ليال، وكانت أمّي هي من يرعاه هناك. سألت الطبيب عنه فقال بلغة فرنسية باردة: لديّ أربعة شيوخ لابدّ من التخلّص منهم وأبوك منهم. لم أستسغ حديثه فتركته، كان يريد أن يقول إن حالتهم مستعصية وإن الإبقاء عليهم في المستشفى يضرّهم ولا ينفعهم والأفضل إذن أن يغادروا ليموتوا بين أهلهم. عدت إلى أبي في فراشه. هاهو مستلق على ظهره لا يقوى على الحراك. عيناه مغمضتان. كنا حوله جميعا. وكان يسمع بكاء أخواتي خاصّة ويشعر بنا. مددت يدي إليه فأمسك بها وأشار بسبّابته اليمنى نحو الجنوب. كان يريد أن يقول عد بي إلى البيت. وعدنا به. كان الناس قبل مرضه يجلسون إليه ليسمعوا حكاياته، وها هم اليوم يجلسون إليه وهو صامت لا يقوى على شيء وهم يتحدّثون عنه وعن أيامهم معه. لم يخل بيتنا من الزوار طيلة مرضه، لابدّ أنه يسمعهم. بل هو يسمعهم. ثم مات أبي في ليلة النصف تماما قُبيل آذان المغرب بدقائق معدودات. قالت أمّي: قبل ذلك بقليل تناول تفّاحة من يدها وحاول أكلها ولكنه لم يقدر، لم يكن يرغب في شيء قبل ذلك. مات أبي. وجاء الناس ليشهدوا موته. رأيت رجالا لم أرهم منذ عشرين عاما أو يزيد. بعضهم قال لي: كن أنت بدلا منه في كل شيء. وها أنا أحاول منذ أكثر من عشرين سنة أن أخلفه. أما أخي صالح فقد خلفه حقا وصار الناس ينادونه الداني.
***
15 /
لا معنى لرمضان في بلدتنا دون تلك الحوانيت الصغيرة التي يقصدها الشباب والكهول بعد كل إفطار للعب الورق ولا يعودون منها إلى بيوتهم إلاّ قبل موعد الإمساك بساعة أو أقلّ. وكانت هذه الحوانيت في البدء من اختصاص بني عريس مثل حانوت الهريسي وحانوت إبراهيم زرتوتة وحانوت ابن زينة ثم نافسهم في ذلك بنو براشن فافتتح غومة حانوتا وكذلك فعل أخوه الهادي فقاع. والفارق بين حانوت وحانوت لا يكاد يتعدّى اسم صاحبه. فقد كانت كلّها ضيّقة وكانت أبوابها زرقاء ولا تتعدى مساحة الواحد منها العشرين مترا مربّعا. وكانت مع ذلك تتّسع للوافدين عليها فتتشكّل فيها حلقات تبدأ عادة بتبادل الأخبار والخوض في أحاديث شتّى ثم يأتي دور اللعب. وكان حانوت غومة من أكثر الحوانيت جذبا للشبّان لما عُرف به صاحبه دون أصحاب الحوانيت الأخرى من انفتاح على الشباب قد يعود إلى إقامته الطويلة في العاصمة قبل أن يقرّر العودة إلى البلدة والاستقرار بها. وكان حانوته على قارعة الطريق خلافا لسائر الحوانيت التي خيّر أصحابها أن تكون في زاوية من الزوايا كأنّهم يريدون إخفاءها عن الأنظار لما قد يحتمله الحانوت من معان سلبية. نأتي بعد الإفطار مباشرة فنجد العمّ غومة قد هيّأ المكان ورتّبه أحسن ترتيب. زجاجات الفانتا والكوكا الكبيرة والصغيرة ترقد في حوض ماء بارد أو في حوض رمل مبلّل، وعلب السجائر مرصوفة في طاقة في الجدار وبجانبها صناديق صغيرة لشتّى أنواع الحلوى، والحصير الأزرق مفروش تتوسّطه مائدة صغيرة زرقاء ومن حولها الوسائد وأمام الباب المفتوح أبدا كانون ينتصب فيه برّاد الشاي الأحمر والعم غومة متكّئ في ناحية من الحانوت على فراش مصنوع من بقايا القماش نسمّيه كليم الشوالق. فإذا دخلنا وألقينا عليه التحية هزّ رأسه وأشار علينا بالجلوس وشرع في سرد بعض مغامراته في العاصمة ريثما يكتمل النصاب، فإذا اكتمل جاءنا بالورق ووزّع علينا قوارير الكوكا والفانتا وكؤوس الشاي. وكنّا كثيرا ما نُضرب عن اللعب لما نجده في أقاصيصه من عذب الكلام و غريب الوقائع. ومن طريف ما حدّثنا به أنّه كان في أوّل عهده بالعاصمة يعمل أجيرا في حظيرة بناء في شارع الحرّية غير بعيد عن مبنى الإذاعة وأنّه دُعي ذات يوم لشراء وجبة الغداء فلما كان يصعد السلم محمّلا بكيس فيه خبز وجبن وسردين وزجاجة فانتا اعترض سبيله شابّان اثنان وسخرا من هيئته وحاولا افتكاك ما بين يديه. قال: تخلّصت منهما بلباقة حتّى سلّمت سلّة الغداء لرفاقي ثمّ أخذت من الحظيرة قضيبا من حديد ونزلت السلّم مسرعا. ناداني رفاقي أين تقصد فقلت دقيقتان وأعود. في الطابق الأرضي وجدت الشابين ورأيتهما يهمّان بالخروج فناديتهما أن تعاليا إليّ وانهلت عليهما ضربا بذلك القضيب حتّى علا صياحهما وسمع الرفاق الصياح فجاؤوا مسرعين وأنقذوا الشابين من موت محقّق. قالوا: لم كلّ هذا العنف يا غومة؟ قلت: أبلهان يسخران منّي وكادا يأخذان سلّة الغداء. فقالوا: اهدأ يا غومة. ما هكذا تجري الحياة. ثمّ مات غومة بعد تسعين سنة. ولم يكن موته غريبا. مات كما يموت أغلب سكّان البلدة، إمّا لإفراط في العيش، أو لعدم اعتراف بالطبيب، أو لانحناء ضروريّ أمام الأقدار. غومة عاش سبعين عاما بلا أمّ ولا أب ولا زوجة ولا أبناء. حتّى أهل بلدتنا الأقربين والأبعدين لم يكونوا على صلة به، فقد عاش بعيدا عنهم في حيّ عتيق من أحياء العاصمة. ولكنه عاد إليهم بعد السبعين وتزوّج منهم وأنجب أطفالا ثم رحل فرحل أطفاله وتركوا البلدة كما تركها هو من قبل. ولم يبق من غومة شيء سوى قبر بين سائر القبور، وبعض الأحاديث منها أنّ الحياة الدنيا كلعبة الورق تماما. يلتقط اللاعب أوراقه عشوائيّا، والحاذق هو من يحسن التصرّف في ما بين يديه من أوراق لتحقيق كسب أو تفادي خسارة أو الحدّ من آثارها.
***
/ 16
كان عامر رحمه الله صامتا أبد الدهر لا نكاد نعرف له صوتا. سوى صوت مهراس ضخم يهرس به الحلفاء ليصنع منها قفة أو بردعة أو حصيرا. وكان حوشه بخلاف جميع الأحواش في البلدة عبارة عن سلسلة من الصخور العظيمة استند إليها العم عامر فبنى بيتين صغيرين أحدهما للنوم والآخر يصلح أن يكون مخزنا لخزن الحبوب أو مطبخا لإعداد الطعام أو حتى مبيتا لضيف طارئ. وكان فضلا عن صمته الدائم يديم الجلوس فوق صخرة من تلك الصخور عليها يهرس الحلفاء ويجلس إليه كل من لا شغل له حتى تحولت سلسلة الصخور إلى مجلس عام يجذب إليه الرجال و الشبان في كل الأوقات. وكان من أبناء عامر شاب يسميه الناس عنترة ولم يكن ذلك اسما له في الحقيقة بل كان اسما ألصقناه به نحن لما رأيناه فيه من غلظة وتمرد. فقد تسبب يوما في تحطيم سن واحد من توأمين لم نكن نفرق بينهما وهما عمر وأبو بكر من أبناء إبراهيم بن إسماعيل. وبانشطار سن عمر إثر صفعة عفوية من عنترة صار بإمكان كل أهل البلدة تمييز عمر من أبي بكر وكانوا يدعون لعنترة بالخير رغم ما في فعلته من الأذى. حدث ذلك ذات قيلولة حين كنا نستعد للعب مباراة في كرة القدم بعد أن عدنا من مراعينا وأودعنا أغنامنا في زرائبها. كنا قد انقسمنا فريقين وكان عنترة حارس مرمى لا لأنه يجيد الحراسة بل لأنه لا يحسن ترويض الكرة بقدميه ولا يعرف إلا أن يمسكها بيديه. انطلقت المباراة وإذا بعمر قد لحق بنا وكان يريد الانضمام إلى أحد الفريقين فرفضنا لكنه أصر على ذلك وتوقفت المباراة ودار نقاش أزعج عنترة فترك مرماه وااقتحم كوكبة المتجادلين بدفعة من يديه كان مآلها في وجه عمر فشطر سنا من أسنانه. ولم ينشأ عن تلك الحادثة شيء مما يجب أن ينشأ في العادة فلا عمر استاء ولا شقيقه أبو بكر ولا دارت معركة وغرقنا كلنا في موجة ضحك جنوني أنسانا المباراة. ومن طرائف عنترة أيضا أن اجتمعنا ذات ليلة من ليالي رمضان في حانوت محمد الأخضر المعروف بالقريد لقصر قامته ولما في مشيته من قفز يشبه قفز القردة. ولم يكن هذا الحانوت فضاء للعب الورق كحانوت غومة الواقع قبالته بل كان حانوتا لبيع الغلال والخضروات وسائر المواد الغذائية وخطر لنا أن نلعب لعبة فكتب أحدناالأسماء وطويت الأوراق وبدأ الفرز وكان لا يظهر في كل فرز الا اسم واحد هو عنترة فدفع مرة ومرتين وثلاثا ثم انفجر غاضبا:. إلا يظهر غير اسمي؟ فضحكنا حتى كاد يغمى علينا ولكن عنترة تمسك بمعرفة السر ففتحت الأوراق كلها فإذا فيها اسم واحد هو عنترة. من فعل ذلك؟ فعلها الكاتب طبعا وهو من يروي لكم القصة الآن.
***
/ 17
كل ما في بلدتنا مقسوم موزع بين النساء والرجال لا يكاد طرف يجتاز حدوده ليلعب دور الطرف الثاني. وهذا قانون سار في كل مقام هزلا كان أم جدا. ويحدث أن يخترق الناس هذا القانون ويعبثوا به ولا يعترض على ذلك أحد. فالغناء والرقص في الأعراس عمل من أعمال النساء خاصة وللرجال في هذه الحفلات الطبل والمزمار وركوب الخيل والأذكار والأشعار. وكان من رواة الشعر في بلدتنا رجال منهم محمد التيتش ومَحا بن زينة ومن الشبان أبو القاسم الخراط والمنصف جاب الله. وصار أبو القاسم هذا يعرف بين الناس بكنيته فقد سمّوه نكّارة لتردد هذا اللفظ في قصيدة كان يلقيها في كل حفل. وكان ذلك سببا في انقطاعه عن إنشاد الشعر في الأعراس ودعاه الناس إلى العدول عن قراره والعودة إلى تنشيط السهرات كما كان يفعل وكان جوابه في كل مرة أن يقول لهم: لكم في المنصف جاب الله ما يغنيكم عني فيقال له ولكن هذا المنصف شاب لا يراعي الأذواق ويأتي في ما ينشد بصور وألفاظ لا تليق. ألم تسمع قوله في عرس:
الشعير المقلي
عند الزراع ما ينبتش
وكلام الطحان ما يثبتش.
ولكن نكّارة ظل يرفض هذه الدعوات ويعد الناس بما هو خير من الشعر وإنشاده. فإذا سألوه عن ذلك قال سترونه قريبا. وظل الناس ينتظرون حتى طلع عليهم نكارة ذات ليلة متنكرا في لباس إمرأة تضع خلخالين في الساقين وقرطين في الأذنين وتعصب الجبين بعصابة حمراء وتشد الوسط بحزام من حرير ثم جلس حيث يجلس النساء فلما جاء الدور على الرقص قفز نكارة من مكانه واندفع إلى الساحة في رقص أبهر الناس وهم يتساءلون عن الراقصة من تكون. خُتمت الرقصة وانتظر الناس عودة الراقصة إلى مجلسها ولكن نكارة اندس بلباسه النسوي في صف الرجال وطفق ينزع عنه الخلخال والحزام والقرطين والعصابة حتى أدركوا حقيقته. وتعالت في الأجواء هتافات تردد اسمه يا نكارة يا متنكر. كم كان بائس الحظ لقد فر من نكارة فوقع في التنكر. وبتطاول الأوقات رضي أبو القاسم بتلك الكنية وصار في كل حفل ينشد الشعر في صورة الرجال ويرقص في صورة النساء.
***
18 /
لم يكن في البلدة كُتاب واحد لا قبل ظهور المدرسة ولا بعد ذلك أيضا رغم وجود عدد ممن يصلح لأن يكون مؤدب صبيان مثل سي رحيم وسي محمد جنيور وسي على. فهؤلاء الثلاثة ألصق بهم حرف السين مكسورا دلالة عما كان في صدورهم من القرآن ومع ذلك لم يتقدم واحد َمنهم لافتتاح كُتّاب. أما سي رحيم فكان مختصا في وصف الأعشاب لعلاج ما يصيب النساء والأطفال من أمراض وأما سي محمد جنيور فلا أدري من أين جاءه هذا اللقب فالبعض يقول الجنيور تعني المهندس ولا شيء في الرجل يوحي بالهندسة والبعض يقول اسم يعنى في الفرنسيّة الصغير أو الثاني وهذا ممكن ولكنه مستبعد فقد كان أخوه الأكبر يحمل اللقب نفسه وهو علي جنيور فلم يبق للقب معنى سوى أنه تحريف لحق بلفظ الجنرال إذ كان الأخوان علي ومحمد في صفوف الجيش الفرنسي. وكان سي محمد جنيور هذا قد حاول أن يكون مؤدبا ولكن ظهور المدرسة قريبا من مسكنه حرمه من ذلك فلم يلتفت إليه الناس. وأما سي علي فكأن أشهر الثلاثة وكان يجمع بين وصف العلاج بالأعشاب والقرآن وكان مقصد الناس من كل الآفاق يكتب لهم الحجب والتعاويذ لا للوقاية من كيد الشياطين ومس الجن فحسب بل لجلب الحظ وفك العقد واستخراج الكنوز من باطن الأرض أيضا. هكذا قيل عنه ولعل ذلك مما جعله مهابا في أعين الناس يخشونه كما يخشون لقاء ربهم وأكثر. ولم يكن يفعل ذلك مع أهل البلدة أبدا إذ كان حرفاؤه يأتونه من أماكن بعيدة جدا لذلك كان كثير الغياب عن البلدة ولم يتسن لي أن أتحدث إليه إلا مرة واحدة. كان ذلك أيام كنت تلميذا بالثانوية. كان اليوم يوم سبت وكنت عائدا من المبيت إلى دارنا كعادتي في نهاية كل أسبوع سيرا على القدمين وفي الطريق أدركني سي علي علي بغلته الشهباء. في جبة بيضاء وعمامة صفراء ناسبت ما في شاربه من صفرة دائمة من أثر نفة يستنشقها باستمرار. وظل على امتداد المسافة يسألني عما أفدته في الثانوية من معارف في النحو والصرف والبلاغة والشعر وكنت أعرض عليه ذلك فيناقشني في بعض المسائل وعلمت بعد ذلك أنه كان يحفظ ألفية إبن مالك والأجرومية أيضا. ورأيت نسخا من هاتين المدونتين ومن كتب أخرى مثل شمس المعارف الكبرى للبوني وتفسير الأحلام لابن سيرين والرحمة في الطب والحكمة لجلال الدين السيوطي وهي كتب ورثها عنه ابنه إبراهيم واستفاد منها في وصف الأدوية وتحرير الحجب للأطفال والنساء. أما ابنه الآخر وهو محمد الزاهي فلم يرث عنه شيئا واكتفى في حياة أبيه بخدمة مقام الولي طلحة بن عادل فلما مات أبوه بنى له قبرا وشيد عليه صرحا كأنه يريد له أن يكون وليا من أولياء الله ولكن أهل البلدة كرهوا ذلك منه وعابوه فهدم الصرح وجعل الأرض التي كان فيها مقبرة للجميع وهي إلى اليوم في وسط الدوار خلافا لكل المقابر. ثم إن الزاهي انقلب فجأة من زاهد في الدنيا مقبل على خدمة الأولياء ينشد الأذكار في الحضرة إلى مغن في الأعراس واكتشف الناس فيه مهارة أخرى غير الإنشاد الديني والغناء فقد كان إلى ذلك يتقن النقر على الطبل والنفخ في المزامير ولكن ذلك لم يساعده كثيرا على الانخراط في حياة الناس اليومية فقد ظل الزاهي بلا زواج حتى مات وكان يسكن كوخا صغيرا بعيدا عن منزل أبيه وسط بستان له سياجه من التين الشوكي المسمى عندنا الهندي. وقد أوحت هذه القصة لعمه محمد المعروف بالسفير بتأليف أحجية عرضها على الناس فقال ( دلوني على أحمر بلندي يسكن الهندي تنالوا كل ما عندي) وكان يعني الزاهي فقد كان أشقر وذلك هو معنى الحمرة وكان طويل القامة وهو معنى البلندي.
***
/ 19
كانت مدرستنا في أول تأسيسها تتألف من ثلاث قاعات يحيط بها سياج قصير وخارج السياج مسكن ملحق بها يقيم فيه مدير المدرسة إن كان متزوجا فإن لم تكن له زوجة أو جاء إلى المدرسة دونها يكون المسكن متاحا للمعلمين كلهم ولم يكن عددهم يتجاوز الثلاثة أو الأربعة. وكان هؤلاء المعلمون إذا كان المدير متزوجا يلجؤون إلى الإقامة في أحد الأحواش التي تركها أصحابها ونزحوا عنها إلى المدينة مثل حوش الكمباطية وهي سيدة شهرت بهذا الاسم لأن زوجها كان ضابطا في صفوف المقاومة. وإذا لم يتسن لهم ذلك أقاموا في بناية محاذية للمدرسة كنا نسميها النادي الصغير وهو ناد مخصص في العادة لإعداد وجبات الإطعام المدرسي وكان القيم عليها رجل من جيران المدرسة اسمه عمار فلما توفي خلفته أرملته السيدة حرمية. وكنا في أيام الشتاء نصل إلى المدرسة في حدود السابعة صباحا بعد أن نكون قد قطعنا أميالا عدة واجتزنا أودية وسلكنا مسالك وعرة موحلة فنجد السيدة حرمية وزوجها قد أعدا الحليب المجفف والقهوة ومأكولات أخرى لا نعرف لها اسما وكانت مع ذلك تستهوينا لما نجده فيها من الدفء واللذاذة. ثم ندخل قاعات الدرس في انتظار لمجة الساعة العاشرة وهي في الغالب عبارة عن ربع خبزة من الخبز الطلياني الطويل المحشو بالسردين والمخللات. وكان المعلمون يشرفون على توزيع هذه اللمجة ويراقبون الصفوف الطويلة كي لا يفكر أحد منا في تناول وجبتين. في قاعة الدرس يبادر كل معلم بتفقد تلامذته فيأمرهم ببسط أيديهم على الطاولات للنظر في أظافرهم والويل لمن كانت أظافره طويلة إذ يلقى من الضرب ما يدمي أصابعه. ثم ينظر في رؤوسهم ويقلب شعورهم لعل فيها من القذارة ما يستوجب حلقها أو غسلها. وكنا أثناء تلك الحملات اليومية كمن يقف في عرصات يوم القيامة ينتظر حسابه. فإذا فرغ المعلم من ذلك مر إلى الدرس والويل لمن أخطأ في قراءة جملة أو في نسخ كلمة أو في حل مسألة . كنا نمر في اليوم الواحد بأكثر من حساب ونلقى أكثر من عقاب. ولا أدري لماذا كنا مع ذلك نأنس للمعلمين ونرضى بما نلقاه في المدرسة من الضرب يصل أحيانا إلى حد لا يطاق. فقد أشبعني ذات يوم معلم العربية السيد حسن ضربا على قدميّ لأني كتبت عند خروجه من القاعة كلمة على الطاولة بدل أن أكتبها على اللوحة. وأذكر أني عدت إلى دارنا و بالقدمين أورام من أثر الضرب. شكوت ذلك إلى أمي وأبي ولكنهما قالا لي تستحق ذلك وأكثر. ومع حبّنا للمدرسة ومعلّميها كنّا نشعر بالخوف منها، وكان الخوف في الكثير من الأحيان سببا في انقطاع عدد منّا عن الدراسة والهروب من المدرسة والرضى برعي الأغنام على ما في ذلك من الرهق. ولم يكن الخوف مانعا من الاحتجاج أحيانا على ذلك العنف وإن كان احتجاجا سرّيا بيننا وبين أنفسنا ولكنّه نما شيئا فشيئا حتّى ظهر إلى العلن. كنا وقتها في السنة الثالثة ولم تتعد أعمارنا التاسعة في الغالب ولكننا قررنا يوما أن نشكو المعلم حسن إلى العمدة بعد أن انهال بعصاه الغليظة على صديقنا الهادي الروز وأصابه في ذراعه اليمنى فلم يقدر على تحريكها. والهادي الروز سمّيناه بهذا الاسم لأنّه كان ينطق الراء الفرنسية ثاء، وكان يقول عن الوردة باللسان الفرنسي الروث. غادرنا القاعة في الساعة العاشرة وبدل أن نتوجه لتناول اللمجة كما جرت العادة اجتمعنا خلف سور المدرسة لننظر في ذراع صديقنا فإذا هي مشلولة أو تكاد. بكينا معه بكاء مرّا وشتمنا معلّمنا شتما وقلنا عنه ما أمكن أن يقول الضحية عن جلاّده سرّا لا علنا. كنّا أربعة من أصدقاء الروز المقرّبين، أنا وعبد الباري صالح والطاهر الشريف ومحمد عبد الله. ولا أدري كيف قفزت إلى أذهاننا فكرة اللجوء إلى مكتب العمدة الشيخ العيدي لنبلغه استياءنا مما أصاب صديقنا. واستقبلنا الشيخ العيدي واستمع إلينا وهو يتعجب ولم نعرف إن كان يتعجب مما أتاه المعلم أو مما أقدمنا عليه ولكنه رضي بمرافقتنا إلى المدرسة والحديث إلى المعلم في هذه القضية. كانت فرحتنا عارمة. ها نحن ننتصر أخيرا ونجد من يقف معنا لحمايتنا من التعذيب. ثم رأينا الشيخ العيدي يحدّث المعلم حسن. لابد أنه كان يوصيه بنا رفقا أو لعلّه كان يحذّره من مغبّة العودة إلى هذه المعاملة القاسية. كلّ ذلك ممكن، وما يعنينا نحن الأربعة خصوصا أن السيد حسن قد بات أخيرا في موقف المتّهم وأنّ الشيخ العيدي يلومه وربّما يحذّره أو يهدّده. هل ينفع ذلك؟ للأسف لم يكن نافعا فقد استمرّ السيد حسن في قسوته وإن كانت قد خفّت قليلا إذ لم يعد يستعمل عصاه لضربنا وكان يكتفي بقرص آذاننا ولطم وجوهنا وصفعنا صفعا شديدا.
***
/ 20
لم تكن نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى التعليم الثانوي بمدرستنا مرضية أبدا خلافا لمدارس أخرى تشترك معها في الكثير من الخصائص. رغم حرص المعلمين على تأمين الدروس كاملة وإضافة ما يجب أن يضاف من حصص الدعم ورغم حث الأولياء أطفالهم على الاستعداد الأمثل للامتحان و كانوا في نهاية كل موسم دراسي ينتظرون ما ستسفر عليه نتائج ذلك الامتحان سواء في ذلك من كان له ابن أو بنت يجتاز المناظرة أو من لم يكن له. وقد خلفت النتائج الهزيلة طيلة السنوات الأولى في نفوس الأولياء والتلاميذ على السواء عقدة يصعب التخلص منها وكان الناس ينظرون إلى الفائزين في تلك المناظرة على أنهم أبطال وربما صاروا مثالا يحتذى به. ومن هؤلاء الفائزين الأوائل القلائل محمد الصالح بن فرحات شحيمة رحمهما الله وحسن والأزهر من أبناء رابح الأرمش وكان الكثير من أهل البلدة يضيفون إلى أسمائهم حرف السين مكسورا فيقولون سي محمد الصالح وسي الأزهر وسي حسن وهم ما يزالون في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بل إنهم أوكلوا إليهم تدريس أطفالهم في شهر من شهور العطلة الصيفية الثلاثة مقابل دينار واحد عن كل طفل. وكان هؤلاء الثلاثة قد اقتسموا المجال في ما بينهم فتولى كلّ واحد منهم مهمّته في حدود ما يسمح به الاتفاق بينهم . وأذكر أن دروس سي محمد الصالح كانت في الهواء الطلق وسط جنان التين الشوكي إذ لم يكن منزلهم يتّسع لاحتضان سبعة أو ثمانية أطفال وكنا نفترش حصيرا في مكان ظليل وننصت إليه ونتابع دروسه باهتمام فإذا فرغ من ذلك أسقط الحاجز البيداغوجي بيننا وبينه وصار يلعب معنا. وأما الأخوان الأزهر وحسن فكانا يؤديان دروسهما في منزل مهجور من منازل أحد الجيران الذين رحلوا إلى العاصمة منذ بداية الستينات وكانا في غاية الصرامة ويتعاملان معنا كما لو كانا معلمين حقا وكثيرا ما كانا يلجآن إلى الضرب لمعاقبة من أخطأ أو نسي واجبا من واجباته. وكان لهذا التقليد في بلدتنا فضل في تحسين النتائج في مدرستنا. كان ذلك في السنة التي تهيأت فيها لاجتياز تلك المناظرة. وكان علينا أن نعدّ لها العدّة. والعدّة في تلك الأيام لا تعني شيئا سوى أن نواظب على الحضور وأن ننصت إلى المعلمين وأن نسأل عمّا بدا لنا غير واضح. أما آباؤنا فالعدّة عندهم لا تتجاوز استخراج بعض الوثائق الإدارية من مكتب العمدة أو مكتب المعتمد مثل شهادة المكاسب لمن كان لهم كسب أو شهادة الفقر وهي الأشهر. وفي ليلة الامتحان كان علينا أن ننام باكرا وأن ننهض قبل الخامسة صباحا كي يتسنّى لنا الوصول إلى مركز الامتحان في السابعة والنصف. وكان على الآباء أن يجهّزوا رواحلهم قبل الغروب. في الخامسة صباحا كانت قافلة الحمير جاهزة وكان على ظهر كل حمار والد وولده. وانطلقنا على بركة الله. الوالدون يحثّون الحمير على السير والأولاد يتطلّعون إلى المدينة وعالمها الغريب. أودعونا مركز الامتحان ومضوا. قالوا لنا نلتقي عند منتصف النهار. والتقينا فساقونا إلى السوق واشتروا لنا طعاما مازالت رائحته في أنفي إلى اليوم علبةَ تنّ وشيئا من الفلفل الأحمر المخلل وقطع خيار مغمس وزيتونات خضر وسود. وخبز طلياني. جلسنا في ظل شجرة على قارعة الطريق. أما نحن فتناولنا غداءنا بفرحة عارمة. وأما آباؤنا فظلوا يراقبوننا وهم يخوضون في حديث لا يعنينا. وعدنا بعد الغداء إلى الامتحان من جديد ولا شيء في رؤوسنا غير علبة التن والفلفل الأحمر المخلل والخيار المغمس والخبز الطلياني. ولكننا اجتزنا الامتحان فنجح منا من نجح وأخفق من أخفق. وأذكر أنّ يوم نجاحي في ذلك الامتحان العسير كان يوما قائظا، وكنت أرعى شويهات أبي غير بعيد عن منزلنا ورأيت أبي رحمه الله قادما إليّ على ظهر حماره. ظننته جاء لينوب عنّي في رعي الشويهات ولكنه ناداني بأعلى صوته: هيّا يا محمّد، المعلّمان سي حسن وسي محمّد بوقيلة ينتظرانك في المدرسة. قلت: خيرا إن شاء الله. فقال: لقد نجحت يا بُنيّ. اركب الحمار وخذ من أمّك الديك فهي تنتظرك وأسرع إلى المدرسة. ركبت الحمار وأخذت الديك من أمّي وهي تمطرني بقبلاتها وتردّد كلمات غير واضحات. لابد أنها كانت تمجّد الله وتشكر أولياء الله الذين نذرت لهم النذور، ودعتني إلى زيارتهم يومين قبل موعد الامتحان فزرت سيدي طلحة وسيدي أحمد الذيب وسيدي أبا القاسم، حتّي سيدي مبروك زرته ولم يكن له مقام مثل غيره من الأولياء وكذلك للاّ خدّوم. في الطريق إلى المدرسة كان الديك الأحمر ينتفض بين يديّ يريد الخلاص منّي وكنت أحثّ الحمار على الركض بقدميّ وأضغط بيدي اليسرى على الديك فما كدت أصل المدرسة حتّى كان الديك بين الحياة والموت. لقيني سي محمّد بوقيلة بوجه ضاحك فهنّأني بالنجاح أخذ الديك منّي وهو يقول: كدت تقتله يا محمّد. مبارك عليك يا محمّد.
***
/ 21
كان لذلك النجاح وقع كبير في منزلنا وفي سائر أنحاء البلدة وربما في أماكن أخرى لا أعرف منها غير أسمائها. فقد عمد أبي إلى كبش له كان قد نذره لسيدي عبد القادر الجيلاني فذبحه وأولمت أمي الوليمة وجاء الأعمام والعمات والأخوال والخالات مهنئين وبين أيديهم سلال فيها البسكويت والمشروبات الغازية وكذا جاء سائر أهل البلدة. وكنت أرى في عيون أمي وأخواتي كلهن وهن يستقبلن الزوار كل معاني الفخر والاعتزاز و سمعت أختي حليمة رحمها الله تحدث عني جمعا من النساء فتقول ذاك من بركات سيدي عبد القادر فلولاه ما نجا من الموت في الأشهر الأولى من ولادته. أصابته عين كادت تودي به فتقرحت حنجرته وانقطعت أنفاسه مرات حتى حسبناه يموت ولم تترك أمي طبيبا إلا زارته. أتصدقنني إن قلت لكن إن أخي هذا قد وخزوه في المستشفيات بمائة إبرة أو يزيد. ولكنه لم يسلم من تلك العين التي أصابته حتى نذر أبي نذره لسيدي عبد القادر. وقالت أمي رحمها الله كنت وأنا أجري به من طبيب إلى طبيب أرى سحابة خفيفة في السماء تتبعني. كان الفصل خريفا وما جاء الربيع حتى انقشعت تلك السحابة فذهب عنه الأذى ثم جاء الصيف فقالت لي العرّافة كلاما كثيرا أحفظ منه قولها (محمد هذا قلبه مفتوح للكتاب واللوح). وقد صدقت.
أما أبي فكنت أراه يستقبل وفود المهنئين وينصت باهتمام إلى توصيات بعض الذين سبق لهم أن ذاقوا طعم النجاح وعواقبه. قال العم فرحات شحيمة يحيطه علما بما هو آت : سترى يا ابن الخالة عاقبة هذا النجاح. ستبيع نعاجك لتدفع بين السبعة دنانير والأربعة عشر دينارا. كل ثلاثة أشهر قال أبي: ولم ندفعها؟ فقال : ذاك معلوم الإقامة بالمبيت، ويطلبون منك فوق ذلك توفير طاقم الملابس، فمن كل لباس اثنان أو ثلاثة ومعجون الأسنان وصابونة فواحة ومناشف ولابد من حذاءين اثنين أحدهما للرياضة ولابد أيضا من كسوة للخروج يوم السبت، وأشياء أخرى كثيرة ستجدها مكتوبة في ورقة الترسيم بالمبيت. كان أبي يلتقط هذه المعلومات من أفواه رجال سبقوه إلى مكابدة تكاليف الدراسة في الثانوية ويبثها إلينا بعد خلو الدار من الزوار. فلما انقضت أيام التهاني بدأت العائلة كلها تستعد لتوفير نفقات الدراسة والمبيت فباعت أمي بعضا من منسوجاتها وباع أبي بعضا من نعاجه وباع بقرة هي أم بقراته الثلاث. كانت عجفاء قرناء. ساقها إلى سوق الاثنين فلم يتعد ثمنها العشرين دينارا فعاد يلعنها ويلعن قرنها المعقوف الذي أفزع التجار منها ثم ساقها مرة أخرى إلى سوق الثلاثاء فزادوه على العشرين خمسة دنانير فتخلص منها واشترى لي بثمنها أهم ما يجب أن يشترى. كان يجب لطفل مثلي أن يسعد بالنجاح وأن يسعد بعد ذلك بكل هذه الملابس الجديدة التي يراها لأول مرة ولكن ذلك لم يحصل إلا لماما. لحظات عابرة سرعان ما تمضي ليحلّ محلها شعور عميق بالذنب. لقد رأيت في كل ذلك حملا ثقيلا على أمي وأبي وسطوا على حقوق أخواتي. وظل هذا الشعور يتضاعف سنة بعد أخرى حتى خلصتني منه رسالة خططتها بيدي وأنا في أول سنة من سنوات المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. رسالة شكوت فيها حالي وحال أمي وأبي ودفعتها إلى مدير المعهد السيد عبد الحميد السماري قبل عطلة الشتاء بيومين. وانقضت العطلة فسلمني أبي معلوم الإقامة في المبيت لأدفعه صباح يوم الإثنين. دخلت مكتب المقتصد وتلوت عليه الاسم واللقب ورقم المبيت. تصفح السجل مليا ثم رفع رأسه وقال : الرقم 873 معفي من دفع المعلوم. لم أصدق الخبر. لاحظ المقتصد ذلك فسألني: ألم تتقدم بمطلب للحصول على منحة إقامة كاملة.؟ قلت : نعم. قال: والسيد المدير وافق على ذلك. خرجت من مكتبه قابضا على الأربعة عشر دينار. أين سأحتفظ بها؟ وكيف لي أن أمنع نفسي من التصرف فيها. لابد أن أحفظها وخير حافظ لها السيد الأمين المرايحي القيم المسؤول عنا في قاعة المراجعة. قصصت عليه القصة وسلمته المبلغ ورجوته أن يحفظه لي حتى يأتي السبت لأعود به إلى أمي وأبي. كنت وقتها أتدرب على التدخين وعلى ارتياد المقاهي ولعب الورق وكان سي الأمين يعلم ذلك ويكرهه. أخذ المبلغ مني ثم قال لي : عدني أن لا تأخذ منه شيئا. أعرف أنك تدخن وتلعب الورق وأخشى عليك أن تنفقه على سجائرك. قلت : أعدك بذلك. ووفيت بالوعد الذي قطعته على نفسي وعدت في آخر الأسبوع وحدثت أبي وأمي بكل ما جرى فكأن بابا من أبواب السماء قد فتح لهما. مازلت أذكر تلك الرسالة وأقول كلما ذكرتها لولاك يا قلمي ما كنت أحسبني أنجو من النكد.
***
22 /
لا أذكر متى تخيّلت لنفسي صورة في المستقبل البعيد، وكلّ ما أذكره أنّ معلّم الفرنسية السيد محمّد بوقيلة ذلك الذي فاز بديك من ديكة أمّي طرح علينا سؤالا أثناء الدرس ونحن في السنة الخامسة، ونص السؤال مترجما هو (أيّ مهنة تريد أن تشغلها في المستقبل). انكبّ كلّ واحد منّا على كرّاسه ومضينا نفكّر في ما عسانا نكون إذا صرنا رجالا. ثم دعانا بعد مهلة التفكير إلى قراءة الأجوبة. كانت أغلب الأحلام الصغيرة متعلّقة بالمعلّم والممرّض وسائق السيارة والبستاني والراعي والفلاّح والميكانيكي، وكان المعلّم يثني على تلك الأجوبة لا من حيث هي أحلام وآمال بل من حيث هي دليل على تمثّل الأطفال للتعليمة التي عُرضت عليهم واستيعابهم لمضامين الدرس وأهدافه. وحين سمع جوابي رأيته ينظر إلي نظرة اشمئزاز. تساءلت بيني وبين نفسي أأكون قد أخطأت الجواب وأنّ المهنة التي اخترتها لا تكون من المهن أصلا؟ كيف ذلك وقد تعرّضنا إليها أثناء الدرس ورأينا بأمّ أعيننا صورة الدكتور وهو يفحص مريضه؟ ها أنا اليوم بعد حوالي أربعين عاما في مهنة التدريس أعيد السؤال مرّة أخرى ولكن من زاوية مختلفة. هل كان جوابي خطأ بمقاييس بيداغوجية ومعرفية؟ أم كان جوابا غير مطابق للواقع. بيداغوجيا ومعرفيا هو جواب سليم تماما. لابدّ أن سي محمد بوقيلة رأى فيه حلما بعيد المنال قد يعصف بشخصيّتي ويفصلني عن واقعي لذلك لم يستسغه ونظر إلي تلك النظرة الغريبة وهو يقول بالفرنسية طبعا (ولكن هذا من المستحيل) ثم وهو يشير بيديه إشارة معناها كن عاقلا يا هذا. كان جوابي في تقديره ضربا من الجنون وكان تعليقه عليه ضربة أعادتني إلى الواقع أو الممكن. جميل أن يحلم صبيّ منّا وقتها بأن يصبح معلّما أو ممرّضا أو سائق سيّارة أو حتّى راعيا، أمّا أن يتخيّل نفسه وهو من هو طبيبا فهذا غير معقول. واليوم وأنا أسترجع تلك الحادثة وأجتهد في أن أعثر على العقل الذي به قيّم سي محمّد بوقيلة جوابي أجد معلّمي ذاك على صواب تماما. كان يدرّس تلامذته ويقيّم أعمالهم وفي دماغه عقل يقول له درّب أطفالك على أن يمدّوا أرجلهم على قدر كسائهم كي لا يصابوا بخيبة الأمل إن هم أفرطوا في الخيال. ولعلّ ذلك العقل الذي لم أقف عليه وقتها قد اخترقني اختراقا وقادني حيث شاء لي المعلّم وإلاّ فبماذا أفسّر مشاركتي في مناظرة الدخول إلى مدارس ترشيح المعلّمين مرّتين على التوالي ولم أفلح فيهما معا؟ ولماذا فكّرت بعد حصولي على شهادة الباكالوريا في الترشّح إلى مناظرة انتداب المعلّمين لولا أنّ أبي شجّعني على الذهاب بعيدا. أذكر أنّه سألني بعد الباكالوريا عمّا أنوي عمله فقلت دون تفكير طويل: سأكون معلّما. ولكنّه قال: أليس ثمّة ما هو أفضل من المعلّم؟ فقلت: نعم، أن أدرس بالجامعة أربع سنوات لأصبح أستاذا مثل هؤلاء الذين درّسوني بالمعهد. فقال: كن أستاذا إذن، ولا تشغل بالك بما نحن فيه. أسعدتني فكرته. بل قادتني من حيث لا يشعر هو إلى إعادة ترتيب الحلم الذي سكنني بعد تعليق المعلّم على تلك الإجابة المجنونة، فالأستاذ في نهاية الأمر معلّم خصوصا إذا كُتب له أن يتخرّج من دار المعلّمين العليا.
***
/ 23
لكل أرض من أراضي بلدتنا غير المأهولة قصة اختلقها الناس وصدقوها وهي في الغالب قصص أقرب إلى الغريب والعجيب منها إلى الأكاذيب. فقد قالوا عن أرض التلة إنها مسكن الرهبان. وليس الرهبان في الحكاية رجل الدين المسيحي بل هو مخلوق يشبه البشر في صورتهم ولا يختلف عنهم في شيء سوى أنه لا يظهر إلا ليلا وأن له إصبعا سادسا فإن كان في يده اليسرى فهو من الأشرار وإن كان في اليمنى فهو من الأخيار. وعلى من ظفر به من الناس أن يبادر إلى القبض على ذلك الإصبع السادس ففيه تكمن قوة الرهبان وبالقبض عليه يدخل أبو ستة في طوع الممسك به. أما من خافه وولى هاربا منه فسيلقى حتفه لا محالة. ولهؤلاء الرهبان سر ثان فهم يسكون المغاور والكهوف ولهم في باطن الأرض كنوز مخفية يسهرون على حمايتها ولا يفرطون في شيء منها إلا إذا صادف لبشري أن يمسك بذلك الإصبع السادس وصادف أن يكون صاحبه من الأخيار. شروط اقتضتها الحكاية ليظل الناس في خوف دائم من هؤلاء الرهبان ومن الأرض التي فيها يقيمون. كنا نسمع قصصا كثيرة عن أناس من قديم الزمان غامروا واقتحموا أرض التلة ليلا لعلهم يظفرون بأحد هؤلاء الرهبان ولكنهم وقعوا في شراكهم. فمنهم من فُقد ومنهم عُثر عليه ملقى في سفح جبل أو في قعر بئر ومنهم من عاد بلا صواب. وأكثر من كان يحدث الناس بمثل هذا الحديث الهادي فقاقيع . وهو كما قلنا في موضع سابق من أقارب أبي والفقاقيع لقب ألحقه به الناس لا لعيب في خلقته بل لما وجدوا في أحاديثه من تكاثر وتعاظم ولكنها سرعان ما تخبو تماما كما تتعاظم الفقاقبع وتخبو في لمح البصر. ومن أغرب ما سمعت عن العم الهادي فقاقيع قصة رواها لنا في ليلة من ليالي الشتاء فقال: قفلت راجعا منذ أسبوع من جولة يومية بدأتها من جزة وقادتني إلى عبيدة ثم الحوض. كانت الشمس تميل إلى الغروب وأنا أصعد جبل الصفا من الجهة الشرقية. وكان حماري مثقلا بزنبيل ملأته قمحا وشعيرا لقاء ما بعت من الشاي والقهوة والسكر والحلوى. وكنت أسوقه بالجهد وأحثه على الصعود في الجبل لعلي أنجو من أرض التلة قبل أن يحط الظلام ولكني لم أفلح فقد وقع عليّ الليل بظلمته الكثيفة وأنا في أرض التلة واستأنست بالحمار فأمسكت بذيله ولكنه كان يكره ذلك مني ويعمد إلى صكي. توغلت في أرض التلة حتى بلغت الموضع المعروف بالدخيلة وهو كما تعلمون بين الصفا وكدية الضبع وإذا بضوء يلوح لي ثم ينتشر ويتسع مداه لتنكشف صورة مدينة وخُيل لي أني ضللت الطريق ووصلت إبة قصور ثم إني رأيت جمعا من النساء كأنهن يحتفلن ورأيت كوكبة من الرجال يجهزون الخيول كأنهم فرسان. حتّى نسيت أني في التلة وانطلت عليّ فكرة الضلال فقلت أقيم في الفندق ريثما ينجلي الليل ولكن نهيق الحمار المفاجئ أيقظني من سكرتي ونظرت فلم أر شيئا مما كان وإذا بنباح كلاب يملأ الفضاء فأيقنت أني نجوت من رهبان الدخيلة وأني بلغت منازل أولاد أبي ركبة.
كان العم الهادي فقاقيع يروي قصته ونحن نتابع حركاته وسكناته ونتخيل المشهد بتفاصيله فينتابنا الرعب مما وصفه ثم ننفجر ضاحكين حين نعلم أنه نجا من الرهبان. بلغت قصته منتهاها فسألناه ولماذا لم تمسك بالإصبع السادس يا عم الهادي.؟ فقال ضاحكا: الحقيقة يا جماعة أني كنت ممسكا بذيل الحمار خشية أن أموت. فلما هم بالخروج يريد العودة إلى منزله وقف برهة أمام باب الحوش ثم سمعناه يسأل أبي أن يرافقه في الطريق فالظلمة شديدة والخنڨة تسكنها الأرواح فيستجيب أبي لطلبه وهو يقول :أتخاف الخنڨة وأرواحها وقد نجوت من التلة ورهبانها؟ فيقول: الرهبان شيء والأرواح شيء. فيقول أبي : كلها فقاقيع.
***
24 /
ومن الأحاديث الفقاقيع أيضا حديث الأرواح التي تسكن الأودية والفجاج. ولا يكاد واحد من كبار البلدة ينكر ذلك والكثير منهم يروون قصصا عن أرواح ظهرت لهم وهم يقطعون واديا أو يعبرون فجأ. . فقد حدثتنا أمي عن روح ظهرت لها وهي عائدة من حقل لنا يبعد عنا أميالا كثيرة. قالت: تأخرت في الحقل ولم أنتبه إلى ذلك حتى أوشكت الشمس على الغروب. كنت منشغلة بجمع ما حصدته خشية أن تظل الأغمار مفرقة وأمضيت في ذلك وقتا لم أنتبه إليه فلما انتبهت حزمت أمري وغادرت الحقل. في الطريق حاصرتني وساوس وأوهام كثيرة. تذكرت أن وادي الصلصال قد جرف ثلاث نساء منذ أعوام. وتذكرت أحاديث الناس من قبل ومن بعد عما عرض لهم في الوادي عند عبوره بعد غروب الشمس أو عند القيلولة. عبرت الوادي وأنا ألتفت يمنة ويسرة فما سمعت ولا رأيت شيئا فارتحت لذلك وقلت في نفسي لقد كذبوا. ولكن هذه الطمأنينة لم تدم سوى لحظات. والغريب أن ما طرأ علي من الأوهام والوساوس قبل عبور وادي الصلصال عاد ليسكنني لما بلغت الموضع المعروف بالغدران وهو كما تعلمون موضع يلتقي فيه واديان اثنان أحدهما ينحدر من ناحية الجبل الأبيض والآخر من جبل الصحراوي . لم أسمع من قبل أحدا يتحدث عن روح تسكن هذا الموضع ولكني أحسست عند عبوره بخوف شديد فلعنت الشيطان وتلوت المعوذتين وواصلت سيري. لم أكد أقطع ملتقى الواديين حتى شعرت بيد تمتد إلي تريد أن تلمس كتفي اليمني. انتابني ذعر شديد وظللت أركض واليد تلاحقني فلا تدركني وما يئست مني حتى بلغت الدوار. كنا ننصت إلى حديثها والخوف يملأ قلوبنا لكن أبي أذهب عنا ذلك الخوف وطمأننا بتعقيبه على حديث أمي فقال : ليس في الغدران روح كما توهمت يا نوارة إنما هو خوفك الشديد عند هبوط الليل أوحى إليك بذلك لتحثي الخطى ولتطوي المسافة البعيدة دون إحساس بالتعب والإرهاق. ألم تسمعي قولهم (الخوف يعلّم السبق) ومعناه أن الجسم المنهك يميل إلى الاسترخاء ويكسل ولتحريك هذا الجسم واستنفار طاقته الكامنة لا بد من حافز والخوف حافز قوي يستنهض الجسد ويدفعه إلى النشاط.. لم تقتنع أمي بهذا التأويل فروت حديثا آخر. قالت: وماذا تقول في ما رأيت هنا في هذا المنزل تحديدا؟ قلنا جميعا: وماذا رأيت يا دادة؟ قالت: لم أشأ أن أحدثكَم بما رأيت وظللت أكتمه عنكم جميعا حتى أنت يا رمضان لم أحدثك به. وها أنا أرويه اليوم ليكون دليلا على بطلان ما أتيت به من التأويل. قال : هات حديثك. قالت: مات ابننا عمار وهو صبي لم يتجاوز العامين. مات ولم يصبه مرض قط. ولكنه مات فجأة. وعكة خفيفة لم تدم أكثر من ليلة ولكنها أخذته منا. ظللت أبكي فراقه سرا وعلانية حتّى كنت يوما أجلس هنا وحيدة أغزل الصوف وذكرته فانخرطت في موجة بكاء حار وإذا هو بلحمه وشحمه يقفز أمامي ويعبث بالصوف كما كان يفعل في حياته. قال أبي: لابد أنك حضنته وقبلت رأسه كما كنت تفعلين. قالت؛ بل فررت منه. قفزت من مجلسي هاربة ولم أنتبه إلا وأنا خارج الحوش. والغريب يا جماعة أني لم أبكه بعد ذلك أبدا. قال أبي: هذا حديث يثبت تأويلي ولا يبطله. سألناه وكيف ذلك؟ فقال : لم تر أمكم ما رأته إلا من فرط تفكيرها في المرحوم ولم تهرب منه حين خيل إليها أنها تراه إلا بسبب الخوف منه. الخوف يا جماعة سلاح المرء لتحريره من التعب والإرهاق سواء في ذلك تعب الجسم وتعب النفس وأمكم أتعبها الحزن وذهب بطاقتها حتى كاد يقتلها ولم تنج من ذلك حتى خافت. الخوف يعلّم السبق.
***
25
للديمقراطية في بلدتنا تاريخ يكاد يساوي تاريخ الديمقراطية في الوطن كله. فقد تسربت إلينا الديمقراطية في مطلع الثمانينات حين سطع نجم الورقة الخضراء وخبا نجم الورقة الحمراء. ولم ينجذب الديمقراطيون الأوائل في بلدتنا إلى الورقة الخضراء لما تشير إليه من أفكار وأعلام بل انجذبوا إليها لما في اللون الأخضر في ذاته من دلالة على الخصب والحياة وهروبا من اللون الأحمر لما بدا لهم فيه من معاني الموت والقسوة. وليس الأخضر عندهم إلا ضد اليابس فإذا يبس العود مثلا صار أحمر والخضراء من النساء المفعمة حبا ورغبة وكذلك الأرض وسائر الحيوان والخيل خصوصا. وأول المبشرين بالديمقراطية والداعين إليها في البلدة محمد بن رابح وهو في الأصل عسكري متقاعد شهد معركة ڨفصة حين حاول عدد من الضباط التمرد على بورڨيبة ونظامه وربما طرأت عليه فكرة الخروج عن الورقة الحمراء لما رآه في الضباط المتمردين من اخضرار واضح وانتصار للكتاب الأخضر. واستغرب الناس في البدء ذلك وتساءلوا كيف يخرج عسكري عن الخط ويسلك خطا غير مأمون ثم ذهبت عنهم الحيرة بانضمام عمي المختار إلى دعوة ابن رابح وصار الرجلان يوصفان بالديمقراطية فيقولون محمد الديمقراطي والمختار الديمقراطي ثم اختص المختار بتلك الصفة حتى سقطت عن ابن رابح تماما. وقد وجد الناس في أول عهدهم بالديمقراطية صعوبة في نطقها فكانوا يحرفون الكلمة ويغيرون نظام حروفها ويقدمون ويؤخرون واشتد عليهم ذلك حين لقبوا المختار بالديمقراطي فكان منهم من أسقط الميم وقلب الدال تاء فيقول التقراطي ومنهم من ذهب مذهبا آخر فأبقى على الدال وأسقط الميم وحركتها الطويلة ليقول الدقراطي وقال آخرون المقاطي. والأغرب من ذلك أن فيهم من مزج المنعوت بالنعت فجاء بلفظ غريب لكنه سرعان ما انتشر لما فيه من اقتصاد فقد اختزلوا عبارة المختار الديمقراطي في لفظ واحد فقالوا المخراطي ثم قالوا المخراطية. وكان المختار يجد في هذه التقليبات متعة ويقول خطأ مشهور خير من صواب مهجور وحجته في ذلك أن الهدف الأسمى في أول مراحل الديمقراطية هو أن يشيع اللفظ بين الناس فإذا لاكوه ولووا به ألسنتهم واعتادت على وقعه آذانهم أنسوا إليه.. وظل الناس منشغلين باللفظ دون المعنى ردحا من الزمن ولم يتسن لأحد منهم أن يسأل عما تحت هذا اللفظ من المعاني وأقصى ما بلغوه من الفهم أن الديمقراطية تعني الخروج عن المعتاد وأن تكون مخراطيا هو أن تكون مختلفا في كل شيء تقريبا. فإذا شرّق الناس فعليك أن تغرّب والعكس بالعكس. ولم يستقر هذا المعنى في أفهامهم إلا بما رأوه في سيرة المختار الديمقراطي فقد كان يسمى القليل من كل شيء تشيشة في صيغة التصغير وكان الناس في المقابل يسمونه شويّة. وكان يقسم باسم الرب ويقسم الناس برؤوس أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم. وكان يضحي بخروف والناس يضحون بالنعاج والدجاج أحيانا وكان لا يضع على رأسه شيئا لا صيفا ولا شتاء أما سائر الناس فيغطون رؤوسهم اتقاء الحر والقر. ورأس المختار الديمقراطي أصلع لا يحجبه شعر ولا شاشية ولا أي شيء آخر وكان يواجه تقلبات الجو عاريا بلا واق فصار مثالا على التحدي والعناد. وظهر ذلك واضحا في يوم الاقتراع فقد كان الوحيد من بين الناخبين الرجال كلهم من دخل الخلوة وأخذ معه الورقتين الحمراء والخضراء واكتفى الآخرون بانتقاء الورقة الحمراء ووضعها في الصندوق أمام الجميع. وقد جذبت سيرة المختار الديمقراطي بعضا من الرجال ولكنهم لم يكونوا في حجمه تحديا وخروجا عن المعتاد. وأما من النساء فلم تنجذب إليه غير خديجة أختي فسارت سيرته وكانت أول فتاة في البلدة تلبس الشانال وتعقص شعرها ولا تضع عليه شيئا يحجبه وأول إمرأة على ما أعلم رفضت زوجا وافقت العائلة عليه واختارت زوجا قالت إنها تحبه ورسمت الحرفين الأولين من اسمه واسمها على لباس من الصوف صنعته بيديها وكانت أول فكر في تأسيس ورشة للنسيج وقدمت طلبا في الغرض للحصول على تمويل. ودخلت خلوة الناخبين مثله. فأما المختار الديمقراطي فلم يترتب على خروجه عن الخط شيء وأما خديجة أختي فقد عوقبت أشد عقاب فحرمت من تمويل مشروعها الصغير لأنها اختارت أن تكون ديمقراطية مثل عمها. وأما أبي فلم أره منشغلا بشيء من هذا وكان لا يعنيه من الأوراق غير أوراق الأشجار. حتّى تلك الأوراق التي تثبت زواجه من أمي وتثبت ملكيتها لهذه الأرض أو تلك كان لا يحفل بها كثيرا. وسئل في ذروة الصراع بين الورقتين الحمراء والخضراء أيهما أقرب إليك فقال : كلها فقاقيع.
***
26
كان عمّي المختار مثلا في التحدّي والجرأة على كل صعب. وسألته: ألا تخشى على نفسك أن يلحقك من هذه السيرة ما يؤذيك فقال: تعرف يا ولدي أني لا أخشى على نفسي شيئا لا إنسا ولا جانا ولا حيوانا ولم يحدث أن سكن الخوف قلبي إلاّ مرّة واحدة ولا أظن أن رجلا غيري قد عاشها. وسألته عن ذلك فقال: اعتراني فى أول أيام الشبيبة شعور بدنوّ الأجل فقلت أصلي كما يصلي الكبار لعلّي ألقى الله مؤمنا وكانت صلاتي صلاة خائف أبدا، وحدث أن عزمت في جمعة من جمعات رمضان والفصل صيف حار على صلاة الجمعة والمسافة بيني وبين المسجد الجامع كما تعلم بعيدة. كنت أقطع الطريق وحدي وحمّارة القيظ تكاد تذهب بأنفاسي وأعصابي وظللت أقاوم حرّ الشمس وطول المسافة ووطأة العطش بأفكار غريبة تلهيني عمّا أنا فيه. وخطر لي في منتصف المسافة هنالك في الموضع المعروف بالوادي الواعر أن فكرت في ثواب هذه الجمعة التي أسعى إليها وماذا عساه يكون وقفز إلى رأسي سؤال هو أشبه ما يكون بالاحتجاج إذ سألت الله بأعلى صوتي وناديته (لمَ أنت تؤجل ثواب العمل الصالح؟ إن كنت تثيب حقا فأنا كما تراني الآن أحوج من يكون إلى دينار لشراء ما يشتهيه الصائم) قلت ذلك بنبرة يمتزج فيها الذل بالغضب ولا أدري إن كنت بكيت أم لا ولكني ما خطوت خطوتين أو ثلاثا حتى لمحت في التراب دينارا. تسمرت في مكاني وظللت ألتفت يمنة ويسرة لعلي أرى طيفا أو شبحا وخيّل إلي إن الله قاب قوسين أو أدنى أو أن شيطان المقيل قد حفّ بي. وسرعان ما ولّت صور الله والشيطان وحلّت محلها صور الغيلان والعبابيث التي حدثني عنها جدك رحمه الله أيام الطفولة فكدت أموت من هول ما ألمّ بي. وكان ذلك أقسى ما رأيت من الهلع. فقلت وماذا فعلت بالدينار؟ فضحك وقال وهل كنت تخالني أدعه وأمضي؟ لقد انحنيت بخفة الخائف فالتقطه واستدرت وأطلقت ساقي للريح وما هي إلا لحظات حتى عدت إلى الدار وفي قبضتي الدينار. ولم يمض رمضان ذلك العام حتى تركت الصلاة لما كان لي معها مما رويت لك.
ومن أخباره أيضا أنّ أهل بلدتنا لم يكونوا يعرفون للعجّة لا طعما ولا لونا ولا رائحة ولا أي معنى من المعاني. وكان كل طعامهم الشكوكة نهارا والكسكسي أو المحمصة ليلا حتى جاء المختار الديمقراطي بالعجة فرأى فيها الناس بدعة من البدع إذ البيض عندهم للبيع غالبا وإن أُكل يؤكل مسلوقا أو مقليا. وسئل عن ذلك فقال: هذا طعام من لا طعام له وطعام من لا وقت لديه ليصرفه في الطبخ وطعام من لا يملك زمام أموره. وطعام من لا أهل له. فقال الناس: أوَ تأكله وهو كما وصفت؟ فقال: وجدته على كل ما فيه من العيوب أمضى في العروق وأجرى في الحلوق تماما كما قال عيسى بن هشام عن طعام السوق. وجرب الناس ذلك فلم يستسغه أحد منهم. قال المختار الديمقراطي: لم يستسيغوا العجة لا لعيب فيها بل لاعتقادهم أنها من عادات الديمقراطيين وهم في ذلك معذورون فقد قاسوا بدعة العجة على بدعة الديمقراطية. فلما صارت الديمقراطية شائعة شاعت العجة معها وشاعت بعدها أمور أخرى.
***
27
كانت خالتي حفصيّة رحمها الله تعاني منذ سنوات طويلة آلاما حادّة في المفاصل جعلتها تزور كلّ الأطبّاء تقريبا دون أن تظفر بعلاج يبرئ سُقمها. وأشار عليها بعض أهل بلدتنا المجرّبين أن تترك الطب وتتستعيض عن ذلك بااسباحة في حوض من أحواض حمّام معدني، ونصحوها بحمّام ملاّق وهو غرب مدينة الكاف على مسافة ثلاثين كيلومترا من بلدتنا تقريبا . لم أزره من قبل ولكنّي سمعت عنه حكايات كثيرة أغلب أبطالها رجال ونساء مصابون بشتّى الأمراض المزمنة جاؤوه من مسافات بعيدة وهم على شفير الموت وغادروه سالمين. حكايات قصّها عليّ الكثير من كبار البلدة مذ علموا بتطوّعي لمرافقة الخالة حفصيّة إلى هناك، ومنهم من روى لي حكايات أخرى عن بعض سكّان هذا الحمّام من غير الإنس، مثل الجنّيات اللاتي يظهرن كلّ ليلة بعد غياب القمر في صور شتّى وينزلن في أحواض السباحة. ومنهم من حذّرني من دخول حوض السباحة في ذلك الوقت من الليل كي لا تصيبني جنّية بأذى، ومنهم من كان ينهي حديثه بضحكات غريبة أفهم منها أنّه يحرّضني على دخول حمّام السباحة في تلك الأوقات الممنوعة لعلّ الله يفتح لي فتحا عظيما. لم يكن الحمّام حين دخلته أوّل مرّة شيئا ذا بال. حوضان اثنان للسباحة لا يتّسعان لأكثر من أربعة أشخاص، يتدفق فيهما ماء معدنيّ حار من فوهتين صغيرتين محفورتين في الجبل، وبين الحوضين ستار خفيف من القصب يجدّده القيّمون على الحمّام مرّة كلّ سنة كما قالت لي السيدة منّانة المشرفة على إدارة هذا المنتجع. وحول الحوضين بضعة غرف صغيرة بنيت حديثا ممّا تناثر من المعلم الأثري القديم من أحجار ضخمة. وكان الوافدون إلى الحمّام يأتون بخيامهم فيصنعون منها بيوتا لهم يأوون إليها. أمّا نحن فلا أدري لِمَ جئنا إلى هنا دون أن نصحب معنا خيمة، لذلك كان علينا أن نستأجر من السيدة منّانة غرفة من تلك الغرف الصغيرة. كانت لغرفتنا نافذة صغيرة تطلّ على نهر ملاّق ومن خلف النهر تتراءى للناظر منها غابة صنوبر حلبيّ ممتدّة، ولم يكن للنافذة شبّاك لا من زجاج ولا من خشب ولا من حديد، كانت كما تقول الخالة حفصيّة مجرّد "طاقة" أي كوّة في الجدار. قالت لي السيدة منّانة لابدّ أن تترك هذه النافذة مفتوحة ليلا نهارا، وإيّاك أن تسدّها بشيء. ولمّا سألتها عن سبب ذلك قالت ستتلقّى منها في ساعات القيلولة نسمات لطيفة تصدر من الغابة وتمرّ على النهر فتتشبّع برطوبة الماء لتصلك نديّة منعشة، فإذا جاء الليل يأتيك منها ضوء القمر الممزوج بظلال الأشجار المرتعشة، فإذا غاب القمر تتدفّق من النافذة الصغيرة ظلمة شديدة سرعان ما تقودك إلى النوم. هممت بسؤالها عن أشياء كثيرة ولكنّها تركتني وهي تقول بنبرة حازمة: لا تنس ذلك. تركتني الخالة حفصيّة أنظر إلى تلك النافذة وسارعت إلى حوض السباحة. تخيّلت أشياء كثيرة تصلني عبر النافذة غير النسمات اللطيفة وضوء القمر والظلمة الشديدة ولكنّ شيئا من ذلك لم يصلني طيلة الأسبوع الأول من الأسابيع الثلاثة التي قضّيتها هنالك. وحين أطلّ الأسبوع الثاني، ورأيت الخالة حفصيّة تتماثل إلى الشفاء شيئا فشيئا قلت في نفسي لعلّ هذه النافذة المفتوحة أبدا لا ترسل شيئا سوى ما ذكرت منّانة لأنّها مفتوحة أبدا، وخطرت لي فكرة سدّها بعد غياب القمر بقطعة من قماش. وجاء الليل وظللت أنتظر غياب القمر ثم قمت إلى النافذة وسددتها وظللت أنتظر. مرت ساعة أو بضع ساعة وإذا بصوت خفيف من وراء النافذة، كان الصوت ضعيفا متقطّعا، تخيّلته في البداية حفيف أشجار ثم استبعدت ذلك حين تذكّرت أنّ الجوّ هادئ ولا رياح فيه تحرّك الأشجار، ثمّ تخيّلته حشرجة وقلت في نفسي لعلّ أحدهم يموت الآن خلف النافذة فاقشعرّ جلدي وكدت أرفع صوتي مستغيثا لولا أنّي خشيت إزعاج الخالة حفصيّة وهي تغطّ في نومها. نظرت إليها في تلك الظلمة الشديدة فلم أتبيّن شيئا سوى شخيرها المتقطّع. الله يهديك يا خالة. كدت أموت من الخوف. وظلّ الأمر يتكرّر بحذافيره كلّ ليلة، وكنت في كلّ ليلة أتخيّل الصور نفسها على الترتيب نفسه وأنهي تخيّلاتي بالجملة نفسها إلى أن جاء الأسبوع الثالث فتبدّل كلّ شيء. تنام الخالة حفصيّة كعادتها بعد صلاة العشاء بقليل وأظل أنا أقرأ شيئا ممّا كان معي من الكتب على ضوء شمعة، فإذا غاب ضوء القمر وحلّت الظلمة وغلبني النعاس أقوم إلى تلك النافذة فأسدّها بقطعة القماش التي جعلتها لها. وما أن أعود إلى فراشي وأستلقي على ظهري مستسلما للنوم حتّى يظهر ذلك الصوت الخفيف المتقطّع فأقول في نفسي إنه شخير الخالة حفصيّة ولكنّ قطعة القماش تسقط من مكانها. أسمع وقوعها على سطح الأرض فأنهض إلى النافذة أتطلّع إلى ما وراءها فلا أجد شيئا فأعيد قطعة القماش إلى مكانها ولكنّها تسقط من جديد. فأظلّ أفكّر لبرهة وإذا بيد تمتدّ إليّ من النافذة فتلامس وجهي، إنّي أتحسّس أصابعها الطويلة الرقيقة وهي تداعبني بلطف أوّلا ثم بشيء من العنف ثانيا ثم بعنف شديد ثالثا فإذا هممت بالصياح أحسست بتلك اليد تبتعد عنّي فأقول في نفسي هذه اليد الغريبة تأبى غلق النافذة وتأبى أن أستغيث إذا اشتدّت عليّ فلمن تكون يا ترى؟ أهي يد إحدى الجنّيات تمتدّ إليّ؟ ولكنّ الجنّيات حسب ما حدّثوني به لا يأتين على هذا النحو. وظلّ الأمر يتكرّر كل ليلة، حتّى أنّي صرت أنتظر تلك الساعة البعيدة من الليل على أحرّ من الجمر. وجاءت الليلة الأخيرة من مدّة إقامتنا بتلك الغرفة وأنا لم أدرك سرّ النافذة فأصابني شعور غريب بالخيبة ودعوت الله في سرّي أن يكشف لي سرّها ولكنّ الله لم يستجب لدعائي. فلمّا طلع النهار وجمعنا أمتعتنا استعدادا للرحيل جاءت السيّدة منّانة لتوديعنا ومعها نساء أخريات لا أعرفهنّ ولكنّ الخالة حفصيّة تعرفهنّ، وعلمت من حديثهن إليّ أنّ الخالة حفصيّة حدّثتهن عنّي طويلا، وأنّ واحدة من بنات السيّدة منّانة تطوّعت بتدبير منهنّ جميعا لتلعب معي لعبة الجنّية ولكنّها لم تنجح. قالت: ما أكبر قلبك يا رجل، تعني ما أقساك يا رجل. لم أكن في الحقيقة قاسي القلب، فقد كنت في غاية الخوف ولكن شيئا من الحياء منعني من التعبير عنه وشيئا آخر من التلهّف إلى عالم الجنّيات ألزمني بالصمت والاستمرار في اللعبة.
***
28
لكلّ رجل من أهل بلدتنا قصّة مع الحمير أو أكثر. ولا غرابة في ذلك أبدا فالحمير وسيلتهم الوحيدة في النقل والحرث والدرس. وسأروي لكم نتفا من هذه القصص مازلت أذكر بعض تفاصيلها. قصص ثلاث هي قصّة أبي وقصّة المختار الديمقراطي وقصّة أخيه المعروف عند البعض بالدبّوس. أمّا أبي فقد كانت له حِمارة شرّيرة ترفض أن يمتطيها أحد وكل من يحاول ذلك بالقوة سرعان ما يجد نفسه طريح الأرض، والغريب أنّ أبي كان يمتطيها بسهولة وكان يحذّرنا من محاولة ركوبها إلاّ بحضوره. وصادف أن جاء العمّ الشريف بن حواء يطلب من أبي أن يعيره الحمارة ليجلب زنبيل الخضروات من عبيدة فنبّهه أبي وحذّره ولكنّه أصرّ على ذلك وهو يقول " والله ما لأحملنّها على الصواب رغم أنفها". ساعده ابي على امتطائها ونصحه إذا سار أن يلتزم الصمت وهو على ظهرها وأن لا يخزها أو يضربها كي لا توقعه أرضا فقبل النصيحة ومضى. وما هي إلاّ بضع ساعة حتّى عادت الحمارة إلى الحوش. أين هو عمّي الشريف؟ وخرجنا جميعا نسأل عنه فلم نعثر عليه. وظللنا ننتظر عودته فلم يعد إلاّ بعد ساعة أو أكثر وهو يعرج ويرغي ويزبد قائلا : أيُعقل يا رمضان؟ أهذه حمارة ؟ كيف تربّي حمارة كهذه؟ ثم روى لنا قصّته معها قال: ما إن تجاوزت الجبل الصغير، وهو جبل يقف حاجزا بين حوشنا وأرض الهمّاجة الخالية، حتّى بدأت الحمارة في التلكّؤِ ولكنّي التزمت الصمت عملا بنصيحتك، فلما أضربتْ عن السير واستدارت تريد العودة منعتها من ذلك وهمست في أذنيها ( إر يهديك) وما إن سمعت صوتي حتّى بدأت تقفز قفزا غريبا، كانت تغرس رأسها في الأرض وترفع ساقيها الخلفيّيتن إلى السماء. حاولت أن أتماسك ولكنّها رمتني على الأرض فوقعت، وأين وقعت؟ اختارت الخبيثة شفا جرف هار ورمتني ولم أنج منه إلاّ بشقّ الأنفس. ضحك أبي وضحكنا جميعا بأصوات عالية، حتّى عمي الشريف كان يروي مغامرته مع الحمارة وهو يضحك ويتوجّع من آثار وقوعه ويلعن الحمارة ويشرب الشاي ويدخّن ويضرب الأرض بعصاه.
وأمّا المختار الديمقراطي فقد شوهد يوما يربط حماره إلى أصل الشجرة قبالة الدار وينهال عليه بالسوط يجلده. قيل له: لِمَ تفعل به كلّ هذا؟ قال: لو رأيتم ما فعله بي لقتلتموه. قيل: وكيف ذلك؟ قال: ركبت صباح اليوم هذا الملعون وسرت به إلى الحقل. كان في الطريق حرونا، حثثته على السير فأبى ومضى ينكص حتّى أوقعنى أرضا ورفسني بحافره، فكتمت غيضي وعاودت الركوب وحثثته على السير فسار بي خطوات ثمّ انطلق يعدو عدو الخيول فدعوته إلى التمهّل فأبى فتمسّكتُ به خشية السقوط وظل يعدو عدوا لا عهد لي به وكان في عدوه يمرّ حذو شجيرات الصبّار على الطريق ويتعمّد ملامستها كأنه يريد لأشواكها أن تصيبني وكنت أتفاداها بجهد جهيد، أو يمرّ ببركة ماء فلا يجانبها ويتعمّد الخوض فيها كأنّه يريد أن يلحقني منها أذى، وما وصلت إلى الحقل حتّى ذهب عنّي رشدي ولكنّي حمدت الله على السلامة، فنزلت وأوثقته ومضيت أجمع المحصول حتّى سوّيته في حزمة عريضة وجئت به فرفعتها ووضعتها على ظهره وقصدت طريق العودة خلفه أمسك الحزمة بكلتا يديّ. كان الملعون كلّما تراءت له شجرة على حافة الطريق تعمّد الاقتراب منها يريد إزاحة الحمل عن ظهره وكنت أقاوم سقوط الحمل حتّى كلّ متني وفتّ عضدي والأغرب من ذلك أنّه مرّ بي على حافة الوادي وطفق يقفز حتّى وقع الحمل ووقعت معه في الوادي ومضى هو في حال سبيله، ولا تسألوا عن حالي وأنا في قعر الوادي فما خرجت منه إلاّ بشقّ الأنفس. قيل له: وكيف ظفرت به بعد الذي وقع؟ قال: وأنا في الطريق إلى الدار بعد الخروج من قعر الوادي قلت في نفسي: هذا الحمار في غاية الذكاء، ألم تر كيف عزم على التمرّد وظلّ يعبّر عن استيائه من إذلالي له بالخدمة يوما بعد يوم؟ ألم تر كيف ثار عليك وكيف تحيّن الفرصة بعد الفرصة ليسقطك؟ ثم قلت في نفسي: لابدّ أنّه يسعد بانتصاره عليّ وأنّه يسعد بالحرّية بعد العبودية، وتخيّلت نفسي مكانه فلم أر عملا أحسن من عمله. قيل له: لقد علّمك درسا في الثورة والحريّة يا ديمقراطي فما بالك تجلده كلّ هذا الجلد؟ قال: الملعون ابن الملعون، فعل بي ما فعل ولكنّي عدت إلى الدار فوجدته في الاسطبل حيث يقيم من زمان، فقلت: أيُعقل أن تتمرّد عليّ وتوقع بي ثم تعود إلى سجنك القديم يا ابن الملعونة. أنت حقّا حمار وابن حمار ولا يجوز البتة أن تكون ذكيّا كما حسبتك أو ثائرا كما تخيّلتك فتعال إذن لتنال الجزاء الأوفى. وأمّا الدّبوس فكنية لصقت بعمّي الطاهر شقيق الديمقراطي، وأعتقد أنها تليق به ظاهرا وباطنا. فقد عرفناه غليظ اليدين عريض لمنكبين واسع الصدر ثقيل الخطوات، وكان إلى ذلك كثير الصمت، وكنّا لا نعرف له ضحكة أبدا وكان إذا أراد أن يضحك يكتفي بابتسامة تصحبها نحنحة خفيفة. وكان مع ذلك مسالما أبدا. وملخّص حكايته أنّه جرّب في أوّل أيام الشبيبة الهجرة إلى ليبيا ولكنّه عاد بعد أقلّ من أسبوع منهكا، ولم تسمح طباعه للناس أن يعرفوا سرّ عودته السريعة رغم نجاح آخرين أقلّ منه حجما ومنزلة في العبور إلى طرابلس وجني أموال كثيرة. عاد وصنع لنفسه سيرة أخرى، فقد برع في صنائع كثيرة لا يتقنها الناس عندنا كالحلاقة وإصلاح أجهزة الراديو والدراجات الناريّة. لا تتصوّروا أنه فتح دكانا لهذه الصناعة أو تلك، فهذا مستحيل، ولكنّه كان يحلق رؤوس الأطفال في نهاية كل عطلة مدرسية أمام باب منزله وبلا مقابل، وكان يرمّم ما تداعى من أحواش المزارعين لقاء دينارين أو ثلاثة، وكان يصلح ما يلحق بمذياع أحدهم من أعطاب مكتفيا بكلمات الشكر. ومع ذلك كان الدبوس قاسيا عنيفا لا يرحم حيوانا أبدا فلم يُعرف عنه أنّه ربّى كلبا أو قطا أبدا، وكان يقول لا حاجة لي بكلب يأكل من زادي وينبح خوفا على نفسه، ولا إلى قطّ ذليل لا يتردّد في سرقتي، وكان يصطاد الفئران بيده فيمسكها من ذيولها ويرمي بها على الأرض فتموت لحينها. أمّا الحمارة التي كان يركبها ويستعين بها في كل عمل من أعمال المزارعين فقد حرمها من أن يكون لها جحش كبنات جنسها، وكان إذا حلّ موسم تزاوج الحمير يخيط على دُبُرها ما يشبه الواقي المطاطي ليمنعها من التزاوج، فإذا حدث أن حملت الحمارة وأنجبت جحشا فمصيره ليلة ميلاده أن يموت مخنوقا إمّا بقبضة العصا الغليظة أو بحبل يقطع أنفاسه. وكان يعلّل ذلك بعلل شتّى منها أن الحمارة إذا حملت لم تعد صالحة للخدمة، وأن جحشها إذا عاش سيدهور صحّتها، فإذا قيل له خذ حمارا بدل الحمارة قال ذكور الحمير عنيدة وأنا لا صبر لي على عنادها. والحقّ أنّ الدبوس قد أصاب في هذا فلو كان له حمار بدل الحمارة لقتله وكيف لا يقتله وقد كاد يقتل ذات يوم رجلا من أولاد سعد جاء يلاحقنا لأننا عبرنا زرعه، فلمّا رآه يلاحقنا مضى نحوه متثاقلا فسلّم عليه وسأله ما ذنب هؤلاء؟ فقال الرجل: أفسدوا الزرع، فقال الدبوس: كيف أفسدوه؟ هل أطلقوا عليه غنما تأكله؟ قال: لا. قال: فهل رأيتهم يقتلعون شيئا منه؟ قال: لا. قال: فما الجريمة إذن؟ قال: مشوا فيه. فما كان من الدبّوس إلاّ أن أمسك بعنقه وظلّ يضغط عليه حتى كاد يكتم أنفاسه، فلمّا أطلقه ولّى مذعورا وتعالت أصواتنا فرحا بالخلاص وإعجابا بالدبوس. وقلنا: الدبوس حقّ. أي لابدّ من دبّوس.
***
رمضانيات ريفية 29
أيكون العيد غدا أو بعد غد؟ وغدا أو بعد غد سأعود. سأقطع بلدتنا من الغرب إلى الشرق. سأمرّ على مدرستي الأولى وسأعبر أودية ومسالك تعرفني. سأعود، لكنّي لن ألقى أحدا. فأبي قد مات وحليمة ماتت وكذلك زينة ماتت، والخالة حفصية ماتت، وآخر من مات المختار. سأظلّ أمام الدار، وسأسأل عن أمّي. الحوش مليء بالأخبار وبالأحزان. سأعود، لكنّي لن ألقى أحدا. لم يبق أحد إلاّ اثنان، الطاهر عمّي والثاني أخي الداني. رجلان اختارا الصبر وينتظران. سأعود، لكنّي لن ألعب كرة أو ورقا، فعنترة ما عاد هناك، وكذلك كلّ الأقران. سأعود، لكنّي لن أرقب آذان المغرب، فالرزقي تخلّى عن الآذان، وسجائر غومة ضاعت وأحاديث الهادي فقاقيع. سأعود. سأقلّب نظري في كل مكان، في الجبل الرابض منذ زمان، في شجر التين الباسق والرمّان. سأعود، وأسأل كل الجيران. أين الجيران؟ أحواش يملؤها الموت، ولا شيء هنالك إلاّ الأشجان. أين الأرواح إذن؟ وأين هم الرهبان ؟ سأعود. وسأجلس في قلب الحوش الفارغ منهم وسأنصت للحيطان. في الحائط صورة أمّي ترقبني، عيناها ملؤهما الحبّ ويداها تمتدان إليّ. أصافحها؟ أمدّ يديّ، لا شيء هنالك إلاّ الأوهام. وأبي كالعادة يروي قصصا وعصاه بين يديه وكؤوس الشاي تروح وتغدو، يشرب منها ويحكي. كان هنا، والقصّة كان يرويها ويثير بسردها دهشتنا. واليوم صار هو القصة. سأعود غدا أو بعد غد. سنعود. يا رمضان.
***
30
لولاكم سيداتي سادتي ما كان للحكاية أن تنمو. كانت في البدء لعبة لتزجية الوقت. واللعب في رمضان أشهى وأبهى من كل لعب في كل شهر. ثم صارت اللعبة شغلا يشغلنا جميعا فانشغلناعما حولنا. تنشأ الحكاية أحيانا من ومضة خاطفة فإذا بالومضة تصبح ضوءا والضوء يستحيل إلى نور يملأ الكون والكيان معا. هناك حيث تنام الذكريات البعيدة يكمن السر. تنشأ الحكاية أحيانا من لا شيء، من كلمة مهموسة أو صورة مطموسة أو نتفة من فكرة محبوسة. ينفك القيد على الكلمات وينجلي الغبار على الصور فتكون حياة أخرى وينشأ كون آخر. ننسى دنيانا وتنسون. تأخذنا اللعبة. نمضي فيها أو هي تمضي فينا. لا ندري أين نسير ومع ذلك نحن نسير. الحكي حبل نجاة أو حبل وثاق أو توثيق أو حبل آخر. مشنقة. أو أرجوحة أو أنشوطة لكنه حبل والقصة حبلى لا يدري أحد متى تضع؟ أو أين؟ وكيف؟ وماذا عساها قد تضع؟ والحبل حرير، ملمسه مغر ولذيذ. من منا ينفر من هذا وإن قيل له إنه من صنع الدودة؟ القصة دودة ونحن جميعا تسكننا الدودة.