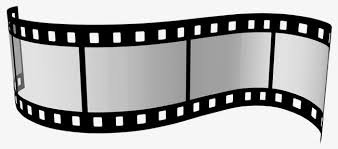أضحت سلطة الصورة في عصرنا تتجاوز كل السُّلط ، وتفرض لسانها كخطاب بصري بمجازه الخاص في علاقته الأفقية والعمودية والسطحية والعميقة بالمتلقي؛ سواء في بعدها التشكيلي أو الأيقوني...وكلما تم استعراض تطور الصورة تقنيا وجماليا ووظيفيا، نلفي المسألة تتعقد أكثر لتحديد قِيَمِها المتعددة في علاقتها بالواقع، من خلال عمليات أساس أهمها : المعرفة، الاتفاق، الوهم أو القيمة التمثيلية الحسية والصورة الرمزية المجردة، والقيمة الإشارية التي تعكس مضمونا ظاهرا للعيان وآخر مخفي لا يفكُّ شفرات سَنَنَه إلا من تزوَّد بآليات ومناهج القراءة والتأويل الحديثة .
ويبرز جليا هذا التعقيد خصوصا مع مختلف أنماط الصورة، لجهة الانتقال من المرئي البصري إلى الخيالي ثم الإدراكي قبل الولوج إلى مطبخ المعنى .
وأيًا تكن هيبة الصورة أو تفاهتها، بجِدّيتها وسخريتها، فهي كنتاج بشري تصويري يحشد كفاءات نفسية، وثقافية متعددة وإيديولوجية متفاوتة الأهمية والأولويات، تستدرج لدى المتلقي حالات ذهنية وانفعالية وعاطفية قد تختلف من زوايا عديدة ذات أبعاد أنطولوجية..
ويقبع المتلقي أمام (الصورة) في مقام أوَّلي ،صافي الذهن، يرتبط بوجوده الاستثنائي تلك اللحظة وتواجُدِها أمامه، في تجربة المرئي البصري ، تختلف عن أي تجربة عادية؛ لكن هل يستوعب حقا هذا المتلقي ماهية الصورة ؟ وما درجة وعيه برؤيته وإدراكه لها على المستوى السطحي قبل أن يلج بنياتها العميقة ؟
هل الثقافة البصرية للمتلقي المغربي تخوّلُ له تفكيك رمزيتها وتحليلها للقبض على المعنى وأثره ؟
تساؤلات وطروحات كانت من ضمن أخرى طرقنا باب الفنان التشكيلي المغربي عبدالنبي الصروخ للإجابة عنها في حوار جماعي ؛ انطلاقا من تجربته الفنية المتميزة ومساره المهني كأستاذ للفنون التشكيلية بمدينة القصر الكبير .
قبل أن يفتح لنا بابه البرَّاني على مِصراعَيه برحابة صدر وعفوية قَلَّ نظيرها في هذا الزمان ، عَجِلَ إلينا من كوّته بروح مبدع شفّافة وصدق وأمانة في كشف الحجاب عن عالمه الجَوّاني كذات محترقة قلقة بالبحث عن مَكامِن الاستيتيقا أينما وقع بصره لينفذ منه ببصيرة العارف إلى روح الأشياء والفضاءات الزمانية والأمكنة الشامخة في الذاكرة الفردية والجماعية ؛ فاتحا المجال لريشته وألوانه المبهرة جمالا لإعادة تشكيل العالم من حوله إلى علامات وأيقونات بصرية كثيفة الرمزية ومتعددة الدلالات، كخطاب بصري، تُغري المتلقي المتخصص للبحث في مستوياتها العميقة عن معنى المعنى ، وتشُدُّ إليها المتلقي العادي منذ الوهلة الأولى بروعتها ورونقها وألوانها المتوهجة ومواضيعها المُغتَرَفة من معين الثقافة الشعبية المغربية .
وقبل محاورته يوم 30 أبريل 2022، قدّم لنا نبذة مختزلة عن تجربته الفنية هذا نص ما جاء فيها :
على العموم، انا من مواليد سنة 1961 بمدينة طنجة، درست بها التعليم الأولي بالمدرسة العمومية إلى غاية سن العاشرة ، وانقطعت عن الدراسة لمدة ثلاث سنوات لأمتهن ،وأنا في هذه السن المبكرة جدا، بعد الحرف التجارية والصناعات التقليدية، بعدها عدت أدراجي إلى التمدرس بالتعليم الخصوصي بلهفة وعزيمة على الجد والمثابرة بعد ندمي على ما فرطت في جنب التعلّم .فحصلت على نتائج جيدة إلا أنني انقطعت للمرة الثانية عن الدراسة حين كنت بالمستوى الرابع إعدادي بسبب تهاوني وانشغالي بموهبتي التي افتتنت بها لمّا اكتشفت أني رسام ماهر ورافق هذا الانتشاء نوع من الغرور الزائف ، بالإضافة إلى عامل خارجي زكّى هذا التيه وهو تزامن تلك الفترة مع الأفكار الثورية وظهور ظاهرة Le hippisme زاد من حدة سخطي على المدرسة بعد رسوبي بالمستوى الإعدادي لسنتين متتاليتين؛ لولا تشجيعات ودعم بعض أساتذتي لمواصلة التمدرس والتحصيل ، واذكر منهم أستاذي للغة العربية وهو الفنان التشكيلي العالمي خليل غريب .
بعدما حصلت على الباكالوريا درست بالجامعة الأدب الإنجليزي لمدة سنتين ثم ولجت أكاديمية الفنون الجميلة بتطوان، بعدها التحقت بالمركز التربوي الجهوي بمدينة طنجة لأزاول مهنة أستاذ للتربية التشكيلية لاحقا بمدينة القصر الكبير سنة 1988 لأستقر بها إلى يومنا هذا.
إن الطفل الشغوف بالرسم الذي كنته ما زال هنا يشغلني بأحاسيسه الفنية المرهفة ، وانتباهه إلى الاشياء البسيطة التي لا تثير انتباه كل الناس وقد يعتبرونها أشياء تافهة لا قيمة لها ؛ لكن بالنسبة لي ، هي مادة خام للبحث وهذا ما يخلق لدي نوعا من الطمأنينة والراحة النفسية .
أما فيما يخص مساري الفني فقد شاركت في عدة معارض فردية وجماعية داخل المغرب وخارجه ببعض الدول الاوروبية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وطبعا هذه التجارب ساهمت في تكوين قناعاتي بأسلوبي الخاص وتجربتي التشكيلية حيث انطلقت في البدايات ، مع البحث المستمر في الميدان، من التشخيص ؛ بمعنى كل المدارس التي تلتقي في تشخيص او محاكاة الواقع، ليس تركيبيا وإنما تحليليا، فمثلا حين نشير إلى تشخيص السريالية فهي هنا تشخيصية ، والمدرسة الواقعية تشخيصية ، كذلك الكلاسيكية تشخيصية وحتى التعبيرية في أصل ذاتها تشخيصية.
ومن هنا سلكت مسارا للبحث عن ذاتي المبدعة داخل اللوحة وعن ألواني التي أعيشها في منطقة الشمال بالخصوص، وأيضا في المناطق الجنوبية من بلدي المغرب الذي أراه كلوحة فنية لما يزخر به من تنوع في تربته التي يتغير لونها من شماله إلى جنوبه ؛ فنجد مثلا التربة السوداء إلى الزرقاء عبر الحمرية والرمال والجبال...وكلها ألوان ترابية تختلف فيما بينها، وهذه خاصية يمتاز بها المغرب مقارنة مع بلدان أخرى .
أما فيما يخص اللوحة الأكاديمية فاخترت البحث فيها نسبيا بنوع من العصامية بطريقتي وألواني الخاصة دون اللجوء إلى آليات المدرسة الكلاسيكية ، ووجدت نفسي فعلا في هذا التوجه، وهذا كان دَيْدَني منذ سنواتي الأولى ويحضرني الآن وجه أبي رحمه الله وهو يأتيني ببطاقات تذكارية لأرسمها ويشجعني بشراء كل مواد الرسم التي أحتاجها ويدعمني ببيع لوحاتي ، كما كان لاحتكاكي في سِنّ مبكرة بفنانين كبار مثل خليل غريب و De La Croix بالخصوص والقاسمي رحمه الله ومحمد شبعة أثر إيجابي على مساري الفني حتى صار الرسم يجري مجرى الدم من عروقي ولم أفارقه إلى هذا الحين.
بالنسبة لبصمتي الفنية لم تتغير من حيث التقنية إلا ان الاسلوب قد تغير من الواقعية إلى الرمزية او الرومانسية في بعض أعمالي التشكيلية - وأحتفظ دوما بألواني الخاصة التي أعشقها ،فهي مني طبعا – واستمدها من واقعي ومن الطبيعة المغربية والجدران والملابس...فلا مفر بالنسبة لي من ذلك ...وتلك فلسفتي في الحياة.
ومن الأعمال التشكيلية التي أثارت انتباهي أثناء زيارتي لبعض المتاحف الأوروبية خاصة ببلجيكا والتي تعود إلى القرن الخامس عشر، من حيث كيفية مزج ألوانها – الواضح في الظلام أو ما يسمى Le clair obscureولاحظت أنهم كانوا يبجلون نظرتهم للإنجيل، فهم يقولون " يولج الليل في النهار" أي أن كل الأشياء في هذا الفضاء يخرج منها النور وليس ذلك ناتج عن انعكاس أشعة الشمس على الأجسام ، بل هذه الأجسام هي التي تعكس نورها وألوانها.
لكن في دين الإسلام شيء آخر، عندنا في القرءان الكريم " يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل" ومن هذا المنطلق صححت نظرتي وفي مرحلة لاحقة بعد الرومانسية والواقعية وحتى الانطباعية اصبحت للرسام الجرأة على رسم الاشياء القبيحة وكان يرى فيها جمالية، وحتى فانغوغ كان لا يرسم الطبيعة كأنها طبيعة ساحرة بل كأنها قوة حركية . وقد تأثرتُ بدراسته وخصوصا في جانب تحليل اللوحات التي قد تجد لها مرجعيات تاريخية وإبستمولوجية وإيديولوجية، ففانغوغ كان يُمنع من العرض ليس بسبب خربشته للوحات او تلطيخها، بل لأنه كان يتعمد رسم بعض المواضيع الدينية لأنه قبل أن يكون رساما كان قِسّا ورجل دين، وله لوحة " مقهى الصداقة" تعكس لوحة " العشاء الأخير لعيسى" والتي رسمها ليوناردو دي فانشي.
أما قديما، فكان التلميذ يتعلم اولا كيفية الرسم، مثل تعلم La perspective وكيفية رسم أعضاء الإنسان؛ الوجه، اليد ... وبعد ذلك بالأهداف يأتي التعرف على مفاهيم الألوان ومفاهيم الخط ومفاهيم النقطة وكذلك المادة ومفاهيم الفضاء ومفاهيم التركيب ... أي سلسلة من المفاهيم التي يتلقّاها دون أن يُلِمَّ بدور تعلُّم هذه المفاهيم حتى ظهور بيداغوجيا الكفايات، حيث أصبح التلميذ اليوم له عالمه الخاص وله رؤية جديدة للفن لأنه يتلقى عبر وسائل التواصل العالمية إشعاعا فنيا ؛ إلا أن الإشكال المطروح ،وهو مُهمّشٌ نوعا ما لدينا، مفهوم الأجيال وكيفية إزاحة الحواجز بين الجيل القديم والجديد من أجل تحقيق تواصل فعّال تحت إطار العملية التعلمية التعليمية داخل المؤسسات التربوية من المستوى الأولي إلى غاية الطور الجامعي.
كما أن اليوم لم تعد المؤسسات الثانوية تكون خريجين في التربية التشكيلية إلا من بعض أكاديميات الفنون الجميلة، الشيء الذي أصبح يدعو إلى التفكير في خلق أوراش تشكيلية لتأطير هذه المادة ضمن الخوصصة، وفي نفس الوقت يتم تأطيرها بتقنيات رقمية ووسائل التواصل الجديدة المتاحة ، لكني أراها سلاحا ذو حدين، من جهة أخرى يشكل عامل العادات والتقاليد والثقافة الشعبية داخل المجتمع المغربي عائقا أمام توجيه التلميذ للبحث مثلا في المدرسة الكلاسيكية والفن الاوروبي بصفة عامة حيث قد يصطدم التلميذ ببعض لوحاتها التي تتنافى وتقاليد و ثقافة وأخلاق مجتمعه الإسلامي ، وهذا ما ينبغي للمدرس الانتباه إلين والتعامل معه بذكاء وحكمة.
تسعى البيداغوجيات الحالية إلى تكوين تلميذ موسوعي، لأن الفنان لا يمكن حصره ضمن خانة عازف العود أو الرسام...وإنما الفنان ينتبه إلى جميع مكونات الحياة بما في ذلك الفنون المكانية كالمسرح والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي... أو الفنون الزمنية كالشعر والموسيقى والرواية ... وهذا التعدد ما يجعل من الشخص فنانا؛ لأن الفنون في تداخلها وتفاعلها تشكل جسما واحدا. والفنان الذي له عين جرّيئة عليه أن تكون له أذن جرٍيئة أيضا على مستوى الإحساس، ويفهم اللوحة انطلاقا من تركيبها وألوانها وموضوعها...وكل هذا يحيل على الأسلوب الذي هو جمع بين التقنية والنسقية والنفسية التي يُكَوّنُ ويسهم في معالجة اللوحة ككل للوصول إلى توقيعها بُغية إقناع المتلقي بها.
وشكرا جزيلا .
أما فيما يخص تجربتي، فقد انطلقت من المنظر لأتعلم الألوان وكيفية تفاعلها فيما بينها والطريقة الصحيحة للتعامل معها، ورسمت بمواد مختلفة؛ منها طبيعية وعقاقيرية ومكتبية وأبحث دوما في مواد مختلفة.
ومعنى انطلاقي من المنظر إلى المشهد أي أن أضيف إلى حدث ما عن طريق التذكار أو مفهوم من المفاهيم قد استقيه من رواية او من الطفولة أو شيء من هذا القبيل، كما أخذت من الخط العربي واعتبره فنا عربيا تجريديا لما له من قوة وخصائص فنية وجمالية لا نجدها في ثقافات أخرى. وقد قال بيكاسو بصدده " إن أعلى درجات البلاغة التشكيلية التي كنت أبحث عنها وجدتها في الخط العربي " فعلا، لقد الهمني الخط العربي.
وفي لوحاتي بعد ذلك وجدت نفسي لا أرسم الأجسام التشكيلية ، بل ايقونات مثل الحي القديم، الذي سرعان ما يتغير إلى التجريد، كيف ؟! أي حين أراه من بعيد فهو منظر أو مشهد حي، لكن حين أقترب من الجدران فهو عالم آخر؛ به خدوش وألوان متراكمة تحيل على الزمان والمكان وحتى الساكن الذي يقطنه، فأخذت ضالتي من هذه الأيقونات ومن الملابس التقليدية .
وأرى أنه على الفنان أن ينطلق من هويته، من مركزه ، ليعطي إشعاعا نحو العالم وليس العكس، لا نأخذ من الغرب ونقول أن الفنان أصبح فنانا عالميا، ولذلك أجدني أكتب او أدون هذه الأشكال بالألوان ولا أرسمها.
ووقفت في النهاية ما بين الشعور واللاشعور، بمعنى رسمت وأنا في الشعور وكانت اللوحة تشخيصية دقيقة لها حركيتها ومتطلباتها، واللاشعور هو ذلك اللعب بالألوان واللمسات دون إعطاء قيمة للتفكير ؛ وحاليا أعمل بإرادتي بين النسيان والتذكر La Subconscience
وتبقى السلطة في الأخير للمتلقي في الحكم على الأعمال الفنية وللناقد التشكيلي الذي يمتلك آليات التصنيف حسب المدارس وأدوات التأويل .
والفن هو أعلى درجات التعامل مع الأشياء والأشخاص والمؤسسات والحياة برمّتها؛ سواء على المستوي النفسي الإنساني أو على المستوى العملي أو على المستوى العقلي والعلمي لمَ لا ! ؟
لكن قديما في المغرب مثلا في سنة 1975م كانت ساكنة مدينة طنجة حوالي 350 ألف نسمة، أي ما يعادل عدد المتطوعين بالمسيرة الخضراء، وكان آنذاك بالمدينة رواق واحد للفرنسيين وكانوا ينشرون من خلاله أعمالهم وثقافتهم ، وبما أن مدينة طنجة كانت مدينة دولية كان يتواجد بها حتى المركز الثقافي الالماني ، وفعلا، هؤلاء هم من كانوا يهتمون بالفنون وفتح الأروقة؛ أما نحن كمغاربة لم يكن لدينا اهتمام باللوحة وخصوصا أن " اللوحة" كانت " محرّمة" وهذا سبب من أسباب تهميشها من وجهة مقاربة تاريخية . كما يرجع ذلك أيضا إلى انعدام آليات السلطة الحديثة للفن التي تقتضي أولا توفر متاحف ، أكاديميات للفنون الجميلة، أروقة... والفنان يبقى فنانا، سواء ازداد بالمغرب او بأي بقعة أخرى بهذا العالم.
هناك من الرسامين الذين لم يسبق لهم ان أبدعوا قط ! لماذا ؟! إما لأنه يعتبر ان الرسم حرام ! إما لعدم قدرته على ذلك، لكن الرسم يبقى موهبة من الله يمنحها لمن يشاء . وسبق لأحد الفرنسيين ان طرح علي هذا السؤال : " هل كان بالمغرب رسامون قبل الاستعمار ؟" قلت له : " أكيد ..." لكن الثقافة المغربية او العربية عموما لم تهتم بالرسم بقدر ما اهتمت بالكتابة، فكان الرسم في فكر العديد يمس بالمقدَّس، في حين كانت أوروبا تشتغل على الفن برمّته.
لكن إذا ما قارنا اليوم بين العهد القديم والجديد ، نجد أن اليوم اصبح هناك اهتمام من طرف وزارة الثقافة يتجسد في فتح بعض المراكز الثقافية ، وإن كان يجب أجرأتها وتفعيل أدوارها مع تيسير وتبسيط إمكانيات إقامة وتنظيم المعارض الفنية. ويمكن القول انه اليوم إلى جانب النخبة المهتمة بالفن وزيارة المعارض والاروقة التشكيلية أصبح المتلقي العادي يهتم بمثل هذه الانشطة الثقافية ويستمتع بحضوره بها وهذا راجع دون شك إلى ما تخلِّفه في نفسيته من آثار إيجابية وقيم جمالية وإن كان لا يفقه أبعاد اللوحة ودلالاتها العميقة كخطاب بصري له مستويات وشفرات وسنَنَن وجب تشفيرها ليتوصل إلى مغزى رسالة الفنان المبدع .
أتذكر أني بأحد المعارض الذي سبق ان نظمته بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، حضره بعض الطلبة وكتب لي أحدهم في الدفتر الذهبي : " شكرا جزيلا ، أنا طالب موجز وعاطل ووضعيتي الاجتماعية جد مزرية ، واليوم توفيت والدتي، ولكن هذا المعرض فعلا أنساني بعض أحزاني " ومن ثمة فالفضاء والإنسان في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأنشطة من أجل تنمية وتكريس ثقافة التربية الفنية داخل المجتمع.
وكما ترون أن الإشهار له سلطته على المتلقي /المستهلك في المجتمع، فالفن التشكيلي له دور أرقى في السمو بهذا المتلقي / الإنسان إلى مكامن الجمال ...
ولمَ لا نُمكّن هذا التلميذ من التوجه والتخصص في مسار موهبته منذ الإعدادي ؟ أكيد أنه سيبدع ويتفوق في توجهه، وحتى في مجال الرياضيات مثلا، هناك من لهم مواهب خارقة في فهم المنطق او حل المسائل الرياضية. واذكر اني طرحت يوما ما اقتراحا على أحد مفتشي مادة علوم الحياة والأرض ؛ بأن يبرمجوا مادة La zoologie ضمن المقررات التربوية التعليمية ، ما دام الطفل الصغير يحب الحيوانات فحتما سيكون شغوفا بدراسة ومعرفة كل ما يتعلق بهذا الحيوان، وهي مادة أرى أنها سهلة، لكن هناك في الواقع أشياء لا أعلم إن كان تهميشها يكون مقصودا أو عن جهل ؟!
نحن الآن في حاجة ماسة إلى النهضة التربوية والنهضة الفنية ... أما الثورة فما زلنا لم نصلها، كيف السبيل إلى النهوض عن تقاعسنا وخمولنا؟! والحال اليوم لا يبشر بالخير البتة ، كثرة المقاهي المزدحمة والناس لا قيمة للوقت لديهم، فكيف ستُبنى الأسر ؟ وكيف ستنجح المنظومة التربوية التعليمية في ظل تفشي الجهل والأمية وفق ما تنص عليه المناهج الجديدة ؟
فيما يخص مسألة الدين قديما كان تقليديا؛ اما اليوم فالدين هو دين العلم والثقافة والفن والحضارة والجمال، والحضارة الأندلسية المغربية خير شاهد على ذلك، والإنسان يتعلم عن طريق البصر والفضاء من حيث لا يدري، فمفهوم المدينة مثلا ليست هي المنازل الإسمنتية فحسب، بل هي فضاء به العديد من المرافق الفنية والجمالية من متاحف وأروقة ودور لتعلم الموسيقى والمسرح والسينما، لأن السينما لا يقتصر دورها على مشاهدة الأفلام والفرجة وحسب، بل لها انشطة أخرى . وأرى أن مغربنا يتوجه في طريقه نحو هذا المسار لكن بوتيرة بطيئة جدا، والتمية البشرية لا تبنى على البنية التحتية فحسب، بل بالاهتمام بالإنسان من حيث هو فنان، وكل إنسان هو فنان، ويمكن أن يبدع ويتميز في مجال موهبته إذا ما وفرنا له آليات وأسباب النجاح وتطوير الذات .
كيف يمكن تحقيق التلاقح بين الفن والأدب ؟ ألا يمكن للنقد الأدبي والسيميولوجي توسيع آفاق فهم اللوحة الفنية وبالتالي خدمة الخطاب الفني ؟ وشكرا.
ففترة الانطباعية هي تقاطع ما بين القديم والحديث، أي أن تخرج من المرسم ومن القصور إلى رسم الطبيعة بكل محتوياتها ؛ تبحث عن الضوء والحركية وتعبيرية اللون في الطبيعة، وهناك مجموعة من الفنانين الانطباعيين اختار منهم المؤرخون ثلاثة فنانين هم فانغوغ وكوغان وبول سيزان الفرنسي، فانغوغ كان رساما حركيا، يعطي للطبيعة حركيتها كحركية الريح والأشجار أما اللون فلا يتعدى ثلاثة او أربعة ألوان بين الاصفر والازرق ...الألوان الرئيسية ، أما كوغان الذي ذهب إلى جزر تاهيتي وتأثر بألوانهم الزاهية وألوان تراثهم القديمة وبدأ يرسم الشيء البعيد كانه قريب دون أن يهتم بالبعد المحسوس، لكنه اهتم باللون وحقيقته سواء كان بعيدا أو قريبا، ولكنه كان يكثر من الألوان وصنف النقاد أعماله ضمن التجريدية اللونية.
ثم هناك بول سيزان الذي اهتم بالشكل واتخذ من الطبيعة مجموعة من الاشكال الهندسية وكان يرسم بالسكين ودون ان يخوض غمار الضوء والظل، وجعل من الشكل وتركيباته عبر تمطيطه فضاء .
فعلا هم لم يذهبوا إلى الطبيعة، لكن هل ابتعدوا عن المجتمع ؟ هناك سؤال وحيرة ، لماذا الرسام في أيام الانطباعيين باستثناء فانغوغ وكوغان أحيانا ، كان يبتعد عن رسم الاشخاص ومعاناتهم ؟ ولكن كل واحد منهم كان يظهر من خلال طريقته سذاجة الفنان وحسن نيته، فالألوان الجلية أو الزاهية لا تكون لون الترياق بل قد تكون لون السم كذلك، مثلما كان يستخدمها فانغوغ في رسمه للسم . ويبقى الإنسان المهموم بالنسبة للفنان هو الفنان في حد ذاته، فغالبا ما كان الرسامون يرسمون الكتّاب والرسامين أنفسهم والمسرحيين في حلّة جديدة ثورية ثائرة على القواعد الكلاسيكية ، بمعنى أن الفن صار للفن ، والفن ينقد من كل الإفرازات السابقة له سواء على مستوى التشكيل او على مستوى الثقافة بصفة عامة.
في حين أن الفنان هو مجموعة من القيم الإنسانية الأخلاقية والجمالية ويسعى دوما إلى تمرير هذه القيم وإيصالها عبر خطابه البصري إلى المتلقي .
وختاما أشكر الأستاذة سناء التي هيأت أسباب وأجواء إجراء هذا الحوار الشيق مع ثلة من الأساتذة الباحثين الذين أشكرهم على تفاعلهم ومداخلاتهم القيمة.
ويبرز جليا هذا التعقيد خصوصا مع مختلف أنماط الصورة، لجهة الانتقال من المرئي البصري إلى الخيالي ثم الإدراكي قبل الولوج إلى مطبخ المعنى .
وأيًا تكن هيبة الصورة أو تفاهتها، بجِدّيتها وسخريتها، فهي كنتاج بشري تصويري يحشد كفاءات نفسية، وثقافية متعددة وإيديولوجية متفاوتة الأهمية والأولويات، تستدرج لدى المتلقي حالات ذهنية وانفعالية وعاطفية قد تختلف من زوايا عديدة ذات أبعاد أنطولوجية..
ويقبع المتلقي أمام (الصورة) في مقام أوَّلي ،صافي الذهن، يرتبط بوجوده الاستثنائي تلك اللحظة وتواجُدِها أمامه، في تجربة المرئي البصري ، تختلف عن أي تجربة عادية؛ لكن هل يستوعب حقا هذا المتلقي ماهية الصورة ؟ وما درجة وعيه برؤيته وإدراكه لها على المستوى السطحي قبل أن يلج بنياتها العميقة ؟
هل الثقافة البصرية للمتلقي المغربي تخوّلُ له تفكيك رمزيتها وتحليلها للقبض على المعنى وأثره ؟
تساؤلات وطروحات كانت من ضمن أخرى طرقنا باب الفنان التشكيلي المغربي عبدالنبي الصروخ للإجابة عنها في حوار جماعي ؛ انطلاقا من تجربته الفنية المتميزة ومساره المهني كأستاذ للفنون التشكيلية بمدينة القصر الكبير .
قبل أن يفتح لنا بابه البرَّاني على مِصراعَيه برحابة صدر وعفوية قَلَّ نظيرها في هذا الزمان ، عَجِلَ إلينا من كوّته بروح مبدع شفّافة وصدق وأمانة في كشف الحجاب عن عالمه الجَوّاني كذات محترقة قلقة بالبحث عن مَكامِن الاستيتيقا أينما وقع بصره لينفذ منه ببصيرة العارف إلى روح الأشياء والفضاءات الزمانية والأمكنة الشامخة في الذاكرة الفردية والجماعية ؛ فاتحا المجال لريشته وألوانه المبهرة جمالا لإعادة تشكيل العالم من حوله إلى علامات وأيقونات بصرية كثيفة الرمزية ومتعددة الدلالات، كخطاب بصري، تُغري المتلقي المتخصص للبحث في مستوياتها العميقة عن معنى المعنى ، وتشُدُّ إليها المتلقي العادي منذ الوهلة الأولى بروعتها ورونقها وألوانها المتوهجة ومواضيعها المُغتَرَفة من معين الثقافة الشعبية المغربية .
وقبل محاورته يوم 30 أبريل 2022، قدّم لنا نبذة مختزلة عن تجربته الفنية هذا نص ما جاء فيها :
- ذ . الفنان التشكيلي عبدالنبي الصروخ :
على العموم، انا من مواليد سنة 1961 بمدينة طنجة، درست بها التعليم الأولي بالمدرسة العمومية إلى غاية سن العاشرة ، وانقطعت عن الدراسة لمدة ثلاث سنوات لأمتهن ،وأنا في هذه السن المبكرة جدا، بعد الحرف التجارية والصناعات التقليدية، بعدها عدت أدراجي إلى التمدرس بالتعليم الخصوصي بلهفة وعزيمة على الجد والمثابرة بعد ندمي على ما فرطت في جنب التعلّم .فحصلت على نتائج جيدة إلا أنني انقطعت للمرة الثانية عن الدراسة حين كنت بالمستوى الرابع إعدادي بسبب تهاوني وانشغالي بموهبتي التي افتتنت بها لمّا اكتشفت أني رسام ماهر ورافق هذا الانتشاء نوع من الغرور الزائف ، بالإضافة إلى عامل خارجي زكّى هذا التيه وهو تزامن تلك الفترة مع الأفكار الثورية وظهور ظاهرة Le hippisme زاد من حدة سخطي على المدرسة بعد رسوبي بالمستوى الإعدادي لسنتين متتاليتين؛ لولا تشجيعات ودعم بعض أساتذتي لمواصلة التمدرس والتحصيل ، واذكر منهم أستاذي للغة العربية وهو الفنان التشكيلي العالمي خليل غريب .
بعدما حصلت على الباكالوريا درست بالجامعة الأدب الإنجليزي لمدة سنتين ثم ولجت أكاديمية الفنون الجميلة بتطوان، بعدها التحقت بالمركز التربوي الجهوي بمدينة طنجة لأزاول مهنة أستاذ للتربية التشكيلية لاحقا بمدينة القصر الكبير سنة 1988 لأستقر بها إلى يومنا هذا.
إن الطفل الشغوف بالرسم الذي كنته ما زال هنا يشغلني بأحاسيسه الفنية المرهفة ، وانتباهه إلى الاشياء البسيطة التي لا تثير انتباه كل الناس وقد يعتبرونها أشياء تافهة لا قيمة لها ؛ لكن بالنسبة لي ، هي مادة خام للبحث وهذا ما يخلق لدي نوعا من الطمأنينة والراحة النفسية .
أما فيما يخص مساري الفني فقد شاركت في عدة معارض فردية وجماعية داخل المغرب وخارجه ببعض الدول الاوروبية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وطبعا هذه التجارب ساهمت في تكوين قناعاتي بأسلوبي الخاص وتجربتي التشكيلية حيث انطلقت في البدايات ، مع البحث المستمر في الميدان، من التشخيص ؛ بمعنى كل المدارس التي تلتقي في تشخيص او محاكاة الواقع، ليس تركيبيا وإنما تحليليا، فمثلا حين نشير إلى تشخيص السريالية فهي هنا تشخيصية ، والمدرسة الواقعية تشخيصية ، كذلك الكلاسيكية تشخيصية وحتى التعبيرية في أصل ذاتها تشخيصية.
ومن هنا سلكت مسارا للبحث عن ذاتي المبدعة داخل اللوحة وعن ألواني التي أعيشها في منطقة الشمال بالخصوص، وأيضا في المناطق الجنوبية من بلدي المغرب الذي أراه كلوحة فنية لما يزخر به من تنوع في تربته التي يتغير لونها من شماله إلى جنوبه ؛ فنجد مثلا التربة السوداء إلى الزرقاء عبر الحمرية والرمال والجبال...وكلها ألوان ترابية تختلف فيما بينها، وهذه خاصية يمتاز بها المغرب مقارنة مع بلدان أخرى .
أما فيما يخص اللوحة الأكاديمية فاخترت البحث فيها نسبيا بنوع من العصامية بطريقتي وألواني الخاصة دون اللجوء إلى آليات المدرسة الكلاسيكية ، ووجدت نفسي فعلا في هذا التوجه، وهذا كان دَيْدَني منذ سنواتي الأولى ويحضرني الآن وجه أبي رحمه الله وهو يأتيني ببطاقات تذكارية لأرسمها ويشجعني بشراء كل مواد الرسم التي أحتاجها ويدعمني ببيع لوحاتي ، كما كان لاحتكاكي في سِنّ مبكرة بفنانين كبار مثل خليل غريب و De La Croix بالخصوص والقاسمي رحمه الله ومحمد شبعة أثر إيجابي على مساري الفني حتى صار الرسم يجري مجرى الدم من عروقي ولم أفارقه إلى هذا الحين.
بالنسبة لبصمتي الفنية لم تتغير من حيث التقنية إلا ان الاسلوب قد تغير من الواقعية إلى الرمزية او الرومانسية في بعض أعمالي التشكيلية - وأحتفظ دوما بألواني الخاصة التي أعشقها ،فهي مني طبعا – واستمدها من واقعي ومن الطبيعة المغربية والجدران والملابس...فلا مفر بالنسبة لي من ذلك ...وتلك فلسفتي في الحياة.
ومن الأعمال التشكيلية التي أثارت انتباهي أثناء زيارتي لبعض المتاحف الأوروبية خاصة ببلجيكا والتي تعود إلى القرن الخامس عشر، من حيث كيفية مزج ألوانها – الواضح في الظلام أو ما يسمى Le clair obscureولاحظت أنهم كانوا يبجلون نظرتهم للإنجيل، فهم يقولون " يولج الليل في النهار" أي أن كل الأشياء في هذا الفضاء يخرج منها النور وليس ذلك ناتج عن انعكاس أشعة الشمس على الأجسام ، بل هذه الأجسام هي التي تعكس نورها وألوانها.
لكن في دين الإسلام شيء آخر، عندنا في القرءان الكريم " يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل" ومن هذا المنطلق صححت نظرتي وفي مرحلة لاحقة بعد الرومانسية والواقعية وحتى الانطباعية اصبحت للرسام الجرأة على رسم الاشياء القبيحة وكان يرى فيها جمالية، وحتى فانغوغ كان لا يرسم الطبيعة كأنها طبيعة ساحرة بل كأنها قوة حركية . وقد تأثرتُ بدراسته وخصوصا في جانب تحليل اللوحات التي قد تجد لها مرجعيات تاريخية وإبستمولوجية وإيديولوجية، ففانغوغ كان يُمنع من العرض ليس بسبب خربشته للوحات او تلطيخها، بل لأنه كان يتعمد رسم بعض المواضيع الدينية لأنه قبل أن يكون رساما كان قِسّا ورجل دين، وله لوحة " مقهى الصداقة" تعكس لوحة " العشاء الأخير لعيسى" والتي رسمها ليوناردو دي فانشي.
- ذ. والكاتب بوسلهام عميمر :
- ذ. الفنان التشكيلي عبدالنبي الصروخ :
أما قديما، فكان التلميذ يتعلم اولا كيفية الرسم، مثل تعلم La perspective وكيفية رسم أعضاء الإنسان؛ الوجه، اليد ... وبعد ذلك بالأهداف يأتي التعرف على مفاهيم الألوان ومفاهيم الخط ومفاهيم النقطة وكذلك المادة ومفاهيم الفضاء ومفاهيم التركيب ... أي سلسلة من المفاهيم التي يتلقّاها دون أن يُلِمَّ بدور تعلُّم هذه المفاهيم حتى ظهور بيداغوجيا الكفايات، حيث أصبح التلميذ اليوم له عالمه الخاص وله رؤية جديدة للفن لأنه يتلقى عبر وسائل التواصل العالمية إشعاعا فنيا ؛ إلا أن الإشكال المطروح ،وهو مُهمّشٌ نوعا ما لدينا، مفهوم الأجيال وكيفية إزاحة الحواجز بين الجيل القديم والجديد من أجل تحقيق تواصل فعّال تحت إطار العملية التعلمية التعليمية داخل المؤسسات التربوية من المستوى الأولي إلى غاية الطور الجامعي.
كما أن اليوم لم تعد المؤسسات الثانوية تكون خريجين في التربية التشكيلية إلا من بعض أكاديميات الفنون الجميلة، الشيء الذي أصبح يدعو إلى التفكير في خلق أوراش تشكيلية لتأطير هذه المادة ضمن الخوصصة، وفي نفس الوقت يتم تأطيرها بتقنيات رقمية ووسائل التواصل الجديدة المتاحة ، لكني أراها سلاحا ذو حدين، من جهة أخرى يشكل عامل العادات والتقاليد والثقافة الشعبية داخل المجتمع المغربي عائقا أمام توجيه التلميذ للبحث مثلا في المدرسة الكلاسيكية والفن الاوروبي بصفة عامة حيث قد يصطدم التلميذ ببعض لوحاتها التي تتنافى وتقاليد و ثقافة وأخلاق مجتمعه الإسلامي ، وهذا ما ينبغي للمدرس الانتباه إلين والتعامل معه بذكاء وحكمة.
تسعى البيداغوجيات الحالية إلى تكوين تلميذ موسوعي، لأن الفنان لا يمكن حصره ضمن خانة عازف العود أو الرسام...وإنما الفنان ينتبه إلى جميع مكونات الحياة بما في ذلك الفنون المكانية كالمسرح والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي... أو الفنون الزمنية كالشعر والموسيقى والرواية ... وهذا التعدد ما يجعل من الشخص فنانا؛ لأن الفنون في تداخلها وتفاعلها تشكل جسما واحدا. والفنان الذي له عين جرّيئة عليه أن تكون له أذن جرٍيئة أيضا على مستوى الإحساس، ويفهم اللوحة انطلاقا من تركيبها وألوانها وموضوعها...وكل هذا يحيل على الأسلوب الذي هو جمع بين التقنية والنسقية والنفسية التي يُكَوّنُ ويسهم في معالجة اللوحة ككل للوصول إلى توقيعها بُغية إقناع المتلقي بها.
- ذ. محمد الصبري باحث في علوم اللغة والدارسات الثقافية :
- كيف تشكلت التجربة الفنية للمبدع عبدالنبي الصاروخ ؟
- أين يظهر الإبداع في هذه التجربة وكيف يمكن استثمارها؟
- الفنان التشكيلي عبدالنبي الصروخ :
أما فيما يخص تجربتي، فقد انطلقت من المنظر لأتعلم الألوان وكيفية تفاعلها فيما بينها والطريقة الصحيحة للتعامل معها، ورسمت بمواد مختلفة؛ منها طبيعية وعقاقيرية ومكتبية وأبحث دوما في مواد مختلفة.
ومعنى انطلاقي من المنظر إلى المشهد أي أن أضيف إلى حدث ما عن طريق التذكار أو مفهوم من المفاهيم قد استقيه من رواية او من الطفولة أو شيء من هذا القبيل، كما أخذت من الخط العربي واعتبره فنا عربيا تجريديا لما له من قوة وخصائص فنية وجمالية لا نجدها في ثقافات أخرى. وقد قال بيكاسو بصدده " إن أعلى درجات البلاغة التشكيلية التي كنت أبحث عنها وجدتها في الخط العربي " فعلا، لقد الهمني الخط العربي.
وفي لوحاتي بعد ذلك وجدت نفسي لا أرسم الأجسام التشكيلية ، بل ايقونات مثل الحي القديم، الذي سرعان ما يتغير إلى التجريد، كيف ؟! أي حين أراه من بعيد فهو منظر أو مشهد حي، لكن حين أقترب من الجدران فهو عالم آخر؛ به خدوش وألوان متراكمة تحيل على الزمان والمكان وحتى الساكن الذي يقطنه، فأخذت ضالتي من هذه الأيقونات ومن الملابس التقليدية .
وأرى أنه على الفنان أن ينطلق من هويته، من مركزه ، ليعطي إشعاعا نحو العالم وليس العكس، لا نأخذ من الغرب ونقول أن الفنان أصبح فنانا عالميا، ولذلك أجدني أكتب او أدون هذه الأشكال بالألوان ولا أرسمها.
ووقفت في النهاية ما بين الشعور واللاشعور، بمعنى رسمت وأنا في الشعور وكانت اللوحة تشخيصية دقيقة لها حركيتها ومتطلباتها، واللاشعور هو ذلك اللعب بالألوان واللمسات دون إعطاء قيمة للتفكير ؛ وحاليا أعمل بإرادتي بين النسيان والتذكر La Subconscience
وتبقى السلطة في الأخير للمتلقي في الحكم على الأعمال الفنية وللناقد التشكيلي الذي يمتلك آليات التصنيف حسب المدارس وأدوات التأويل .
والفن هو أعلى درجات التعامل مع الأشياء والأشخاص والمؤسسات والحياة برمّتها؛ سواء على المستوي النفسي الإنساني أو على المستوى العملي أو على المستوى العقلي والعلمي لمَ لا ! ؟
- ذ. حمادة محمد باحث في النقد والأدب :
- ذ. الفنان التشكيلي عبدالنبي الصروخ :
- ذة . سعاد برعوز باحثة في السيميائيات وتحليل الخطاب :
- ذ. الفنان التشكيلي عبدالنبي الصروخ :
لكن قديما في المغرب مثلا في سنة 1975م كانت ساكنة مدينة طنجة حوالي 350 ألف نسمة، أي ما يعادل عدد المتطوعين بالمسيرة الخضراء، وكان آنذاك بالمدينة رواق واحد للفرنسيين وكانوا ينشرون من خلاله أعمالهم وثقافتهم ، وبما أن مدينة طنجة كانت مدينة دولية كان يتواجد بها حتى المركز الثقافي الالماني ، وفعلا، هؤلاء هم من كانوا يهتمون بالفنون وفتح الأروقة؛ أما نحن كمغاربة لم يكن لدينا اهتمام باللوحة وخصوصا أن " اللوحة" كانت " محرّمة" وهذا سبب من أسباب تهميشها من وجهة مقاربة تاريخية . كما يرجع ذلك أيضا إلى انعدام آليات السلطة الحديثة للفن التي تقتضي أولا توفر متاحف ، أكاديميات للفنون الجميلة، أروقة... والفنان يبقى فنانا، سواء ازداد بالمغرب او بأي بقعة أخرى بهذا العالم.
هناك من الرسامين الذين لم يسبق لهم ان أبدعوا قط ! لماذا ؟! إما لأنه يعتبر ان الرسم حرام ! إما لعدم قدرته على ذلك، لكن الرسم يبقى موهبة من الله يمنحها لمن يشاء . وسبق لأحد الفرنسيين ان طرح علي هذا السؤال : " هل كان بالمغرب رسامون قبل الاستعمار ؟" قلت له : " أكيد ..." لكن الثقافة المغربية او العربية عموما لم تهتم بالرسم بقدر ما اهتمت بالكتابة، فكان الرسم في فكر العديد يمس بالمقدَّس، في حين كانت أوروبا تشتغل على الفن برمّته.
لكن إذا ما قارنا اليوم بين العهد القديم والجديد ، نجد أن اليوم اصبح هناك اهتمام من طرف وزارة الثقافة يتجسد في فتح بعض المراكز الثقافية ، وإن كان يجب أجرأتها وتفعيل أدوارها مع تيسير وتبسيط إمكانيات إقامة وتنظيم المعارض الفنية. ويمكن القول انه اليوم إلى جانب النخبة المهتمة بالفن وزيارة المعارض والاروقة التشكيلية أصبح المتلقي العادي يهتم بمثل هذه الانشطة الثقافية ويستمتع بحضوره بها وهذا راجع دون شك إلى ما تخلِّفه في نفسيته من آثار إيجابية وقيم جمالية وإن كان لا يفقه أبعاد اللوحة ودلالاتها العميقة كخطاب بصري له مستويات وشفرات وسنَنَن وجب تشفيرها ليتوصل إلى مغزى رسالة الفنان المبدع .
أتذكر أني بأحد المعارض الذي سبق ان نظمته بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، حضره بعض الطلبة وكتب لي أحدهم في الدفتر الذهبي : " شكرا جزيلا ، أنا طالب موجز وعاطل ووضعيتي الاجتماعية جد مزرية ، واليوم توفيت والدتي، ولكن هذا المعرض فعلا أنساني بعض أحزاني " ومن ثمة فالفضاء والإنسان في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأنشطة من أجل تنمية وتكريس ثقافة التربية الفنية داخل المجتمع.
وكما ترون أن الإشهار له سلطته على المتلقي /المستهلك في المجتمع، فالفن التشكيلي له دور أرقى في السمو بهذا المتلقي / الإنسان إلى مكامن الجمال ...
- ذة. سناء سقي، فنانة تشكيلية وباحثة في الأنساق السردية والبصرية :
- ذ. الفنان التشكيلي عبد النبي الصروخ :
ولمَ لا نُمكّن هذا التلميذ من التوجه والتخصص في مسار موهبته منذ الإعدادي ؟ أكيد أنه سيبدع ويتفوق في توجهه، وحتى في مجال الرياضيات مثلا، هناك من لهم مواهب خارقة في فهم المنطق او حل المسائل الرياضية. واذكر اني طرحت يوما ما اقتراحا على أحد مفتشي مادة علوم الحياة والأرض ؛ بأن يبرمجوا مادة La zoologie ضمن المقررات التربوية التعليمية ، ما دام الطفل الصغير يحب الحيوانات فحتما سيكون شغوفا بدراسة ومعرفة كل ما يتعلق بهذا الحيوان، وهي مادة أرى أنها سهلة، لكن هناك في الواقع أشياء لا أعلم إن كان تهميشها يكون مقصودا أو عن جهل ؟!
نحن الآن في حاجة ماسة إلى النهضة التربوية والنهضة الفنية ... أما الثورة فما زلنا لم نصلها، كيف السبيل إلى النهوض عن تقاعسنا وخمولنا؟! والحال اليوم لا يبشر بالخير البتة ، كثرة المقاهي المزدحمة والناس لا قيمة للوقت لديهم، فكيف ستُبنى الأسر ؟ وكيف ستنجح المنظومة التربوية التعليمية في ظل تفشي الجهل والأمية وفق ما تنص عليه المناهج الجديدة ؟
فيما يخص مسألة الدين قديما كان تقليديا؛ اما اليوم فالدين هو دين العلم والثقافة والفن والحضارة والجمال، والحضارة الأندلسية المغربية خير شاهد على ذلك، والإنسان يتعلم عن طريق البصر والفضاء من حيث لا يدري، فمفهوم المدينة مثلا ليست هي المنازل الإسمنتية فحسب، بل هي فضاء به العديد من المرافق الفنية والجمالية من متاحف وأروقة ودور لتعلم الموسيقى والمسرح والسينما، لأن السينما لا يقتصر دورها على مشاهدة الأفلام والفرجة وحسب، بل لها انشطة أخرى . وأرى أن مغربنا يتوجه في طريقه نحو هذا المسار لكن بوتيرة بطيئة جدا، والتمية البشرية لا تبنى على البنية التحتية فحسب، بل بالاهتمام بالإنسان من حيث هو فنان، وكل إنسان هو فنان، ويمكن أن يبدع ويتميز في مجال موهبته إذا ما وفرنا له آليات وأسباب النجاح وتطوير الذات .
- ذ. رشيد مليح باحث في الرواية الحديثة :
كيف يمكن تحقيق التلاقح بين الفن والأدب ؟ ألا يمكن للنقد الأدبي والسيميولوجي توسيع آفاق فهم اللوحة الفنية وبالتالي خدمة الخطاب الفني ؟ وشكرا.
- ذ. الفنان التشكيلي عبدالنبي الصروخ :
ففترة الانطباعية هي تقاطع ما بين القديم والحديث، أي أن تخرج من المرسم ومن القصور إلى رسم الطبيعة بكل محتوياتها ؛ تبحث عن الضوء والحركية وتعبيرية اللون في الطبيعة، وهناك مجموعة من الفنانين الانطباعيين اختار منهم المؤرخون ثلاثة فنانين هم فانغوغ وكوغان وبول سيزان الفرنسي، فانغوغ كان رساما حركيا، يعطي للطبيعة حركيتها كحركية الريح والأشجار أما اللون فلا يتعدى ثلاثة او أربعة ألوان بين الاصفر والازرق ...الألوان الرئيسية ، أما كوغان الذي ذهب إلى جزر تاهيتي وتأثر بألوانهم الزاهية وألوان تراثهم القديمة وبدأ يرسم الشيء البعيد كانه قريب دون أن يهتم بالبعد المحسوس، لكنه اهتم باللون وحقيقته سواء كان بعيدا أو قريبا، ولكنه كان يكثر من الألوان وصنف النقاد أعماله ضمن التجريدية اللونية.
ثم هناك بول سيزان الذي اهتم بالشكل واتخذ من الطبيعة مجموعة من الاشكال الهندسية وكان يرسم بالسكين ودون ان يخوض غمار الضوء والظل، وجعل من الشكل وتركيباته عبر تمطيطه فضاء .
فعلا هم لم يذهبوا إلى الطبيعة، لكن هل ابتعدوا عن المجتمع ؟ هناك سؤال وحيرة ، لماذا الرسام في أيام الانطباعيين باستثناء فانغوغ وكوغان أحيانا ، كان يبتعد عن رسم الاشخاص ومعاناتهم ؟ ولكن كل واحد منهم كان يظهر من خلال طريقته سذاجة الفنان وحسن نيته، فالألوان الجلية أو الزاهية لا تكون لون الترياق بل قد تكون لون السم كذلك، مثلما كان يستخدمها فانغوغ في رسمه للسم . ويبقى الإنسان المهموم بالنسبة للفنان هو الفنان في حد ذاته، فغالبا ما كان الرسامون يرسمون الكتّاب والرسامين أنفسهم والمسرحيين في حلّة جديدة ثورية ثائرة على القواعد الكلاسيكية ، بمعنى أن الفن صار للفن ، والفن ينقد من كل الإفرازات السابقة له سواء على مستوى التشكيل او على مستوى الثقافة بصفة عامة.
- ذة. سناء سقي، فنانة تشكيلية وباحثة في الأنساق السردية والبصرية :
- ذ. الفنان التشكيلي عبدالنبي الصروخ :
في حين أن الفنان هو مجموعة من القيم الإنسانية الأخلاقية والجمالية ويسعى دوما إلى تمرير هذه القيم وإيصالها عبر خطابه البصري إلى المتلقي .
وختاما أشكر الأستاذة سناء التي هيأت أسباب وأجواء إجراء هذا الحوار الشيق مع ثلة من الأساتذة الباحثين الذين أشكرهم على تفاعلهم ومداخلاتهم القيمة.
- ذة. سناء سقي، فنانة تشكيلية وباحثة في الأنساق السردية والبصرية :