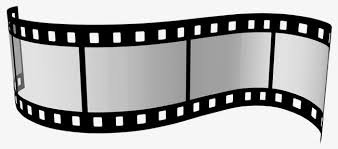فيما مضى- قبل عصر الصورة، الذى صنعته الملتيميديا الجديدة- كان العالم يقيم ويحيا ويتفاعل ويتصارع فوق أرض "اللغة" فى الأساس، لذا كان التراشق يتم بـ "العلامات اللغوية = الكلمات". وببساطة متناهية، كانت الدول تبدى إهتماما فائقا بالأدب والصحافة، وكان الأدباء والصحفيون هم نجوم المجتمع، هذا فضلا عن تماهى الحدود بين الأدب والصحافة؛ فـ "الغالبية العظمى من أدبائنا الكبار كانوا يعملون بالصحافة". وكانت الرقابة على "الكلمة الطبوعة" شديدة الصرامة؛ حتى إن أكثرية المعتقلين السياسيين فى عصر عبد الناصر كانوا من المثقفين...
فى ذلك العصر، كان العالم يقيم فى اللغة، أى أن العلامات اللغوية، فى حد ذاتها، كانت تمثل وجهة النظر الأيديولوجية لمستعمليها فى الوقائع والأحداث.
الفارق بين إستعمال الكلمات، كان هو نفسه الفارق بين أيديولوجيا وأخرى، لذا
كانت الرقابة تقيم بين الإستعمالات المختلفة للكلمات.
سنلاحظ بأن "المعنى" كان هو مشكلة المشاكل كلها فى الماضى، لأن السلطة الحاكمة كانت تمتلك معجما "أيديولوجيا" خاصا بها.
أما الآن، فقد صارت "الصورة" هى الواقع ذاته.
لقد تراجعت "سلطة اللغة"، وكما نلاحظ، فلم يعد هناك اهتمام بالأدب؛ فالشعر تراجع تماما وكذلك القصة القصيرة، والنقد الأدبى "صار أكاديميا"، أما النصوص المسرحية فلم تعد دور النشر تتعاطى معها "نظرا لتراجع المسرح برمته، وإقبال محبى المسرح، على مشاهدة العروض، عوضا عن قراءة النصوص.
وعندما نصل إلى "الرواية"، سنجد أنها قطعت صلتها بالأدب وتحولت إلى "مشروع سيناريو سينمائى"؛ فالحلم الذى يطارد الروائيين الآن هو "تحويل أعمالهم إلى أفلام ومسلسلات".
من هنا تراجع الأدب برمته، أى تراجعت سلطة اللغة، وصارت "الصورة" هى كل شئ، حتى اللغة، لم يعد لها من وظيفة سوى اللحاق بالصورة!.
الصورة ترتكز فى وجودها على "الشئ" وليس على المعنى. ومع ذلك،
فالصورة تُبنَى فى الأساس على الكذب، لأنها تسعى لإنتاج نسخة مطابقة للشئ المصوَّر، هو نفسه، ومع ذلك، فما تنتجه (صورتى الشخصية- مثلا) ليس هو الشئ نفسه، (صورتى ليست أنا نفسى).
ولأن الصورة تتأسس فنيا على "الإيهام بالواقع"، فقد أمكن للتطور التقنى "التكنولوجى" اللعب بها؛ وبذا صار اللعب بالصورة هو اللعب بالواقع.
هكذا أمكن للصورة أن تمتلك سلطة "إيهامنا بأن ما نراه بالعين المجردة هو الواقع نفسه"- تراكم الصور فى حياتنا، جعلنا نفكر ونمارس عمليات الإستدلال، إنطلاقا منها هى، خاصة بعد أن تقلَّصت اللغة وتحولت إلى أحد العناصر الداعمة للصورة ".
// نعم، للصورة سحرها الفائق... لكنها لا تزيد عن مشعوذ أسطورى معاصر.
فى ذلك العصر، كان العالم يقيم فى اللغة، أى أن العلامات اللغوية، فى حد ذاتها، كانت تمثل وجهة النظر الأيديولوجية لمستعمليها فى الوقائع والأحداث.
الفارق بين إستعمال الكلمات، كان هو نفسه الفارق بين أيديولوجيا وأخرى، لذا
كانت الرقابة تقيم بين الإستعمالات المختلفة للكلمات.
سنلاحظ بأن "المعنى" كان هو مشكلة المشاكل كلها فى الماضى، لأن السلطة الحاكمة كانت تمتلك معجما "أيديولوجيا" خاصا بها.
أما الآن، فقد صارت "الصورة" هى الواقع ذاته.
لقد تراجعت "سلطة اللغة"، وكما نلاحظ، فلم يعد هناك اهتمام بالأدب؛ فالشعر تراجع تماما وكذلك القصة القصيرة، والنقد الأدبى "صار أكاديميا"، أما النصوص المسرحية فلم تعد دور النشر تتعاطى معها "نظرا لتراجع المسرح برمته، وإقبال محبى المسرح، على مشاهدة العروض، عوضا عن قراءة النصوص.
وعندما نصل إلى "الرواية"، سنجد أنها قطعت صلتها بالأدب وتحولت إلى "مشروع سيناريو سينمائى"؛ فالحلم الذى يطارد الروائيين الآن هو "تحويل أعمالهم إلى أفلام ومسلسلات".
من هنا تراجع الأدب برمته، أى تراجعت سلطة اللغة، وصارت "الصورة" هى كل شئ، حتى اللغة، لم يعد لها من وظيفة سوى اللحاق بالصورة!.
الصورة ترتكز فى وجودها على "الشئ" وليس على المعنى. ومع ذلك،
فالصورة تُبنَى فى الأساس على الكذب، لأنها تسعى لإنتاج نسخة مطابقة للشئ المصوَّر، هو نفسه، ومع ذلك، فما تنتجه (صورتى الشخصية- مثلا) ليس هو الشئ نفسه، (صورتى ليست أنا نفسى).
ولأن الصورة تتأسس فنيا على "الإيهام بالواقع"، فقد أمكن للتطور التقنى "التكنولوجى" اللعب بها؛ وبذا صار اللعب بالصورة هو اللعب بالواقع.
هكذا أمكن للصورة أن تمتلك سلطة "إيهامنا بأن ما نراه بالعين المجردة هو الواقع نفسه"- تراكم الصور فى حياتنا، جعلنا نفكر ونمارس عمليات الإستدلال، إنطلاقا منها هى، خاصة بعد أن تقلَّصت اللغة وتحولت إلى أحد العناصر الداعمة للصورة ".
// نعم، للصورة سحرها الفائق... لكنها لا تزيد عن مشعوذ أسطورى معاصر.