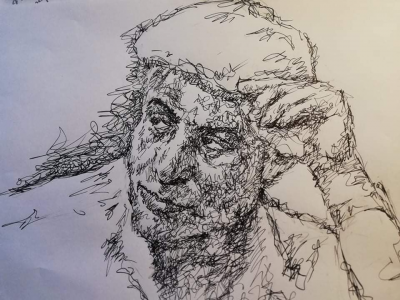المناهج اللسانية وتطبيقاتها في تحليل النص الشعري تحليل ونقد اطروحة تقدم بها الباحث /مجيد مطشر عامر إلى مجلس كلية التربية في جامعة البصرة، وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها بإشراف الأستاذ الدكتور /سامي علي جبار1429هـ 2008م وفيما يلي تعريف بموضوع الدراسة يتم عرضها بنصها كما ذكرها الباحث على النحو التالي:
المحور الأول: مكونات الدراسة:
تكونت الدراسة من مقدمةٍ، وثلاثةِ فصولٍ مسبوقةٍ بتوطئةٍ، وخاتِمةٍ بنتائجِ البحث
ذكر الباحث أنه وقف على أهم المنهجيات اللسانية، وأكثرها تداولا ً لدى الدارس العربي وخاصة على المستوى التطبيقي، وهذه المنهجيات هي المنهج البنائي والمنهج الأسلوبي وهي ما تعرف اليوم بمناهج مرحلة النهضة، والمنهج السيميائي والمنهج التفكيكي وهي ما تعرف بمناهج مرحلة.
واشتملت الدراسة على بابين بخمسة فصول سبقتها مقدمة وتلتها خاتمة عرضت لأهم النتائج، يتم بيانها على النحو التالي كما ذكرها الباحث:
*الباب الأول:
تناول فيه الباحث صورة المنهجيات الأربع في الواقع التحليلي الكلي (تحاليل مستوياتية مختزلة أو مدمجة) فكان الباب إزاء المنهج والنص الفصل الأول:
ضم مرحلة النضج المنهجي النصي ممثلة بالمنهج البنائي والأسلوبي الفصل الثاني:
اشتمل على مرحلة التشظي والانبثاق المرجعي ممثلة بالمنهج السيميائي والتفكيكي .
الباب الثاني:
اشتمل على فصول ثلاثة وتناول أنماطا ً من التحاليل الجزئية وهي التحاليل التي تنطلق من مستوى واحد من مستويات بناء النص، لتتخذه أساسا ً للتحليل المنهجي، فكان الباب إزاء المنهج والمستوى:
الفصل الأول: درس أبرز التحاليل الصوتية ـ الإيقاعية.
الفصل الثاني: درس التحاليل التركيبية (النحوية والبلاغية)
الفصل الثالث: تناول التحاليل الدلالية والمعجمية.
المحور الثاني: نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة لعدة نتائج فيما يلي نذكرها بنصها كما ذكرها الباحث:
*اعتمدت أغلب التحاليل الجزئية ظاهرة التأويل النصي، التي يلاحظ عليها في أغلب الأحيان بعدها عن واقع النص وما يقوله.
*اكتسب التحليل النصي مع انبثاق التوجه الالسني الجديد، أهمية خاصة في المناهج النصية الحديثة، وذلك بسبب الاعتقاد أن النصوص الأدبية تمثل الميدان الحقيقي لاختبار فرضيات هذه المناهج المختلفة. وبناء على ذلك برزت توجهات مختلفة داخل المنهج الواحد، أما بسب السجال المستمر بين منظري هذه المناهج ومحاولة التفرد في طرح المزيد من الأفكار أو الآليات الإجرائية في أثناء تحليل النص الأدبي، أو بسبب التطورات التلقائية التي تصيب الحركة المنهجية وذلك بزيادة أفق المناهج لتطول عناصر تحليلية غير منظوره سابقاً وبذلك أصبح التحليل النصي ثمرة من ثمار الكد المنهجي الحديث، بالاعتماد على الملفوظ الشعري دون سواه، ولكن دون إغفال لما ينبثق منه من علائق سياقية عامة أو علائق مرجعية على سبيل إضاءة النصوص وتنويرها.
*حاولت الدراسة الكشف عن عدة أنماط مورست في ظل التحليل الالسني المنهجي للنصوص الشعرية، منها ما كانت إسقاطا آليا للرؤى والتصورات النظرية، ومنها ما حاولت الاقتراب من الخط العام للمنهج المعلن دون الدخول في تفاصيله، تاركة بحسب زعمها سلطة للنص المحلل بأن يفرض طريقة تحليله، ومنها ما لم تستطيع الخروج عن دائرة التحليل السطحي على الرغم من إعلانها أو تلويحها باعتماد احد المناهج اللسانية الحديثة قيد الدراسة، ومنها ما حاولت المزج بين عدة منهجيات نصية على الرغم من تصادم هذه المنهجيات في رؤاها الفلسفية وبعض آلياتها الإجرائية التي قد لا تصلح لتحليل النص الشعري أصلاً.
*توصلت الدراسة لسيادة الارتجال والذاتية التحليلية وحتى في اختيار النصوص المحللة، دون الرجوع إلى أي من المناهج التحليلية الحديثة، وبذلك فقدت الدراسات المعتمدة على ذلك السند المنهجي الحقيقي في تحليلاتها.
*كشفت الدراسة في بابها الأول بفصيلة عن رؤى منهجية مختلفة حاولت سبر أغوار النصوص الشعرية المختلفة بمجموعة من الآليات أو التقنيات التحليلية، وقد تفاوتت هذه الرؤى في طرق مقاربتها النصوص على الرغم من اعتمادها جميعها الدليل اللساني أولاً وآخراً في عملها.
*كشف الفصل الأول من الباب الأول عن ألوان مختلفة من التحاليل البنائية والأسلوبية، فعلى الصعيد النظري على الرغم من امتثال هذه التحاليل للمقدمات النظرية البنائية والأسلوبية، الا أن أغلبها حاولت الانفلات من الإجراءات المنهجية المستقرة للمنهج البنائي أو الأسلوبي. مما انتهى الحال بتلك التحاليل إلى افتقادها القواعد التحليلية الواضحة، والملموسة، وأحيانا تصاب باضطراب المصطلح التحليلي واستخدمه.
*جاءت أغلب التحاليل البنائية والأسلوبية هجينة من حيث الاستعمال المنهجي وعلى يد أبرز المتحمسين من البنائيين والأسلوبين العرب، أمثال د. كمال أبوديب ود. عبد السلام المسدي ود. محمد عبد المطلب وغيرهم، وبالمقابل نجد عدداً لا يستهان به من الدارسين العرب قد اتسموا بالوضوح المنهجي والاستعمال السليم للكثير من الإجراءات أو الآليات التي اشترطتها الألسنية البنائية أو الأسلوبية
*كان الخروج عن حدود المنهج السيميائي والتفكيكي سمة واضحة في جميع التحاليل التي تعرض لها الباحث بالدراسة والتحليل. فقد كانت الطريقة التركيبية من عدة مناهج نصية سمة واضحة ومعلنة مع تحليلات الدكتور محمد مفتاح السيميائية، وكانت الازدواجية البنائية والتفكيكية سمة واضحة مع تحليلات الدكتور عبد الله الغذامي التفكيكية (التشريحية).
جاءت التحاليل الجزئية على الرغم من منطلقها اللغوي الواضح، ناقصة الامتثال لبعض المسلمات النظرية التي من المفترض ان تتقيد بها تلك التحاليل، إذا ماقررت اقتحام أيٍّ من المستويات بناء النص الشعري، إذ تبين من خلال الاستقراء، ان تلك التحاليل لم تخلو من الانفلات من فرضيات المستوى التحليلي الواحد، لتلامس بذلك قضايا خارج نصية (نفسية واجتماعية وثقافية وتاريخية ..الخ ) . ويعتقد أصحاب تلك النزعة الخارج نصية، أن التجربة الشعرية لابد وأن تترك أثرها على أحد المستويات دون غيرها، وهذا الأثر له صلة بما حول النص فهو المحرك الأساسي أو الوجه الأخر للعالم الأخر (الخارج النصي).
سيطرت تقنية الإحصاء والجداول الاستبيانية على مجمل التحاليل الصوتية والتركيبة و الدلالية. وجعلها مرتكزاً أساسيا يدور حوله التحليل، مهملاً إطلاق العنان للتقنيات الأخرى أن تأخذ دورها في الكشف عن مناطق الإبداع في النص المدروس.
سجلت بعض الدراسات الأسلوبية التحليلية ازدواجية في التعامل مع النصوص المحللة وخاصة على مستوى التركيبي. فقد جاءت مرة ممزوجة بالعوامل النفسية والاجتماعية ( الماحول ) وأخرى بالطرق السيميولوجية والعلامية ... الخ.
لا يزال التحليل الدلالي والمعجمي مفتقداً إلى الكثير من المقومات التحليلية المؤمنة باشتراطات أو فرضيات المناهج الألسنية الحديثة.
سجلت الدراسة ندرة توظيف نظرية الحقول الدلالية في مجمل النصوص التي تعرض الباحث لها.
لم يكن تحليل النصوص المتعددة بمستوى تحليل النص المنفرد بشكل عام، إذ يقترب الأول من الطريقة القديمة في اعتمادها على ظاهرة الشاهد المنفرد، ومن ثم تعميم النتائج علية، دون محاولة الدخول مع النص في صراع تحليلي لغرض استجلاء جميع الإمكانات بصدد الظاهرة المدروسة
المحور الأول: مكونات الدراسة:
تكونت الدراسة من مقدمةٍ، وثلاثةِ فصولٍ مسبوقةٍ بتوطئةٍ، وخاتِمةٍ بنتائجِ البحث
ذكر الباحث أنه وقف على أهم المنهجيات اللسانية، وأكثرها تداولا ً لدى الدارس العربي وخاصة على المستوى التطبيقي، وهذه المنهجيات هي المنهج البنائي والمنهج الأسلوبي وهي ما تعرف اليوم بمناهج مرحلة النهضة، والمنهج السيميائي والمنهج التفكيكي وهي ما تعرف بمناهج مرحلة.
واشتملت الدراسة على بابين بخمسة فصول سبقتها مقدمة وتلتها خاتمة عرضت لأهم النتائج، يتم بيانها على النحو التالي كما ذكرها الباحث:
*الباب الأول:
تناول فيه الباحث صورة المنهجيات الأربع في الواقع التحليلي الكلي (تحاليل مستوياتية مختزلة أو مدمجة) فكان الباب إزاء المنهج والنص الفصل الأول:
ضم مرحلة النضج المنهجي النصي ممثلة بالمنهج البنائي والأسلوبي الفصل الثاني:
اشتمل على مرحلة التشظي والانبثاق المرجعي ممثلة بالمنهج السيميائي والتفكيكي .
الباب الثاني:
اشتمل على فصول ثلاثة وتناول أنماطا ً من التحاليل الجزئية وهي التحاليل التي تنطلق من مستوى واحد من مستويات بناء النص، لتتخذه أساسا ً للتحليل المنهجي، فكان الباب إزاء المنهج والمستوى:
الفصل الأول: درس أبرز التحاليل الصوتية ـ الإيقاعية.
الفصل الثاني: درس التحاليل التركيبية (النحوية والبلاغية)
الفصل الثالث: تناول التحاليل الدلالية والمعجمية.
المحور الثاني: نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة لعدة نتائج فيما يلي نذكرها بنصها كما ذكرها الباحث:
*اعتمدت أغلب التحاليل الجزئية ظاهرة التأويل النصي، التي يلاحظ عليها في أغلب الأحيان بعدها عن واقع النص وما يقوله.
*اكتسب التحليل النصي مع انبثاق التوجه الالسني الجديد، أهمية خاصة في المناهج النصية الحديثة، وذلك بسبب الاعتقاد أن النصوص الأدبية تمثل الميدان الحقيقي لاختبار فرضيات هذه المناهج المختلفة. وبناء على ذلك برزت توجهات مختلفة داخل المنهج الواحد، أما بسب السجال المستمر بين منظري هذه المناهج ومحاولة التفرد في طرح المزيد من الأفكار أو الآليات الإجرائية في أثناء تحليل النص الأدبي، أو بسبب التطورات التلقائية التي تصيب الحركة المنهجية وذلك بزيادة أفق المناهج لتطول عناصر تحليلية غير منظوره سابقاً وبذلك أصبح التحليل النصي ثمرة من ثمار الكد المنهجي الحديث، بالاعتماد على الملفوظ الشعري دون سواه، ولكن دون إغفال لما ينبثق منه من علائق سياقية عامة أو علائق مرجعية على سبيل إضاءة النصوص وتنويرها.
*حاولت الدراسة الكشف عن عدة أنماط مورست في ظل التحليل الالسني المنهجي للنصوص الشعرية، منها ما كانت إسقاطا آليا للرؤى والتصورات النظرية، ومنها ما حاولت الاقتراب من الخط العام للمنهج المعلن دون الدخول في تفاصيله، تاركة بحسب زعمها سلطة للنص المحلل بأن يفرض طريقة تحليله، ومنها ما لم تستطيع الخروج عن دائرة التحليل السطحي على الرغم من إعلانها أو تلويحها باعتماد احد المناهج اللسانية الحديثة قيد الدراسة، ومنها ما حاولت المزج بين عدة منهجيات نصية على الرغم من تصادم هذه المنهجيات في رؤاها الفلسفية وبعض آلياتها الإجرائية التي قد لا تصلح لتحليل النص الشعري أصلاً.
*توصلت الدراسة لسيادة الارتجال والذاتية التحليلية وحتى في اختيار النصوص المحللة، دون الرجوع إلى أي من المناهج التحليلية الحديثة، وبذلك فقدت الدراسات المعتمدة على ذلك السند المنهجي الحقيقي في تحليلاتها.
*كشفت الدراسة في بابها الأول بفصيلة عن رؤى منهجية مختلفة حاولت سبر أغوار النصوص الشعرية المختلفة بمجموعة من الآليات أو التقنيات التحليلية، وقد تفاوتت هذه الرؤى في طرق مقاربتها النصوص على الرغم من اعتمادها جميعها الدليل اللساني أولاً وآخراً في عملها.
*كشف الفصل الأول من الباب الأول عن ألوان مختلفة من التحاليل البنائية والأسلوبية، فعلى الصعيد النظري على الرغم من امتثال هذه التحاليل للمقدمات النظرية البنائية والأسلوبية، الا أن أغلبها حاولت الانفلات من الإجراءات المنهجية المستقرة للمنهج البنائي أو الأسلوبي. مما انتهى الحال بتلك التحاليل إلى افتقادها القواعد التحليلية الواضحة، والملموسة، وأحيانا تصاب باضطراب المصطلح التحليلي واستخدمه.
*جاءت أغلب التحاليل البنائية والأسلوبية هجينة من حيث الاستعمال المنهجي وعلى يد أبرز المتحمسين من البنائيين والأسلوبين العرب، أمثال د. كمال أبوديب ود. عبد السلام المسدي ود. محمد عبد المطلب وغيرهم، وبالمقابل نجد عدداً لا يستهان به من الدارسين العرب قد اتسموا بالوضوح المنهجي والاستعمال السليم للكثير من الإجراءات أو الآليات التي اشترطتها الألسنية البنائية أو الأسلوبية
*كان الخروج عن حدود المنهج السيميائي والتفكيكي سمة واضحة في جميع التحاليل التي تعرض لها الباحث بالدراسة والتحليل. فقد كانت الطريقة التركيبية من عدة مناهج نصية سمة واضحة ومعلنة مع تحليلات الدكتور محمد مفتاح السيميائية، وكانت الازدواجية البنائية والتفكيكية سمة واضحة مع تحليلات الدكتور عبد الله الغذامي التفكيكية (التشريحية).
جاءت التحاليل الجزئية على الرغم من منطلقها اللغوي الواضح، ناقصة الامتثال لبعض المسلمات النظرية التي من المفترض ان تتقيد بها تلك التحاليل، إذا ماقررت اقتحام أيٍّ من المستويات بناء النص الشعري، إذ تبين من خلال الاستقراء، ان تلك التحاليل لم تخلو من الانفلات من فرضيات المستوى التحليلي الواحد، لتلامس بذلك قضايا خارج نصية (نفسية واجتماعية وثقافية وتاريخية ..الخ ) . ويعتقد أصحاب تلك النزعة الخارج نصية، أن التجربة الشعرية لابد وأن تترك أثرها على أحد المستويات دون غيرها، وهذا الأثر له صلة بما حول النص فهو المحرك الأساسي أو الوجه الأخر للعالم الأخر (الخارج النصي).
سيطرت تقنية الإحصاء والجداول الاستبيانية على مجمل التحاليل الصوتية والتركيبة و الدلالية. وجعلها مرتكزاً أساسيا يدور حوله التحليل، مهملاً إطلاق العنان للتقنيات الأخرى أن تأخذ دورها في الكشف عن مناطق الإبداع في النص المدروس.
سجلت بعض الدراسات الأسلوبية التحليلية ازدواجية في التعامل مع النصوص المحللة وخاصة على مستوى التركيبي. فقد جاءت مرة ممزوجة بالعوامل النفسية والاجتماعية ( الماحول ) وأخرى بالطرق السيميولوجية والعلامية ... الخ.
لا يزال التحليل الدلالي والمعجمي مفتقداً إلى الكثير من المقومات التحليلية المؤمنة باشتراطات أو فرضيات المناهج الألسنية الحديثة.
سجلت الدراسة ندرة توظيف نظرية الحقول الدلالية في مجمل النصوص التي تعرض الباحث لها.
لم يكن تحليل النصوص المتعددة بمستوى تحليل النص المنفرد بشكل عام، إذ يقترب الأول من الطريقة القديمة في اعتمادها على ظاهرة الشاهد المنفرد، ومن ثم تعميم النتائج علية، دون محاولة الدخول مع النص في صراع تحليلي لغرض استجلاء جميع الإمكانات بصدد الظاهرة المدروسة