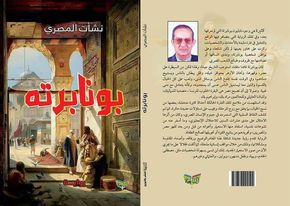عرف الأدب العربي على مر العصور تطورات وازدهارات كثيرة مسته شكلاً ومضموناً، وعرف في المقابل تغييرات طرأت على الأدوات والمواضيع والأغراض وذلك امتثالاً لكل مرحلة من المراحل التي يتطور فيها. لكنه أبدا لم يعرف تغييرا في اجناسه الأدبية، فالشعر ظل شعرا والرواية رواية والنثر نثرا، على الرغم من اختلافات طفيفة في المواضيع والأغراض، فكل شاعر تنوطه في ذلك بيئته التي ينتمي إليها. كما أنه لم يخلط قط بين الشاعر والقاص والروائي..، ولم يكن يمنح هذه المصطلحات والأوصاف مجاملة وامتداحا، وإنما كانت تمنح وفقاً لمعيار الفحولة، ففي الأدب العربي لن تكون شاعراً أو روائيا أو كاتبا بصفة عامة إلا إذا كانت الأجناس الأدبية التي تقدمها تتصف بالجودة والفحولة، أما إن قدمت للأدب الكثير من الأعمال والنصوص باختلاف أنواعها وتوجهاتها، فهنا ستسمى أديبا ومن باب العرفان تردف أيضا بالكبير، فأين أدبنا المعاصر من كل هذا؟
لقد دخل الأدب الجزائري مرحلة جديدة فاقت التوقعات في ما آلت إليه، فبعد أن كان يتطور ويزدهر في شكله ومضمونه، وهذا دليل على نضج التجارب وتطور انفتاحها واحتكاكها بالآداب الأخرى، أصبح اليوم يتغير في بعض أجناسه، التي تداخلت بطريقة لا يحمد عقباها، وأصبحت عباءات مصطلحات الكاتب والشاعر والناقد توضع على ظهر من هب ودب، ولو كان في رصيدهم نص أو كتيب واحد. وهنا توفرت لنا الكمية في كتاب ونصوص كثيرة، لكن الكيفية معدومة من الكفاءة، وينطبق على هذا الأمر ثنائية الوضع والاستعمال التي تحدث عنها دي سوسير في ثنائيته التركيب والاستبدال، ومن بعده تشومسكي مع القدرة والإنجاز ثم عبد الرحمان الحاج صالح، ولكن بصيغة مغايرة تماماً ربما لضرورة أدبية أتى بها جيل اليوم من الكتاب، حيث أنهم يستعملون كل الأفكار والجمل والعبارات التي تجوب خواطرهم، فيوظفونها على شكل روايات وقصائد وقصص دون تنقيح أو تحميص منتجين لنا بذلك جنسا أدبيا يستعصي عليك معرفته أو فهمه، أما اللغة التي تم وضعه بها فقد تكون عامية لا تحاكي واقع تجربة أدبية، وكم هذا كثير.
فاللغة في استعمال الرواية اليوم ضعيفة وناقص باب الفصاحة فيها في كثير من الأعمال التي لا يشتغل عليها أصحابها لغوياً وبلاغيا وأسلوبيا وكذلك دلاليا، فلم ترقى إلى مستوى السرد الذي يعد جوهر الرواية، وبالتالي ظلت هذه النصوص الروائية كلاما يتسم بالاختلاف واللاتجانس في الشكل والمضمون. ونفس الأمر ينطبق على الشعر الذي هزلت لغته وقصرت عن تصوير مجازي وتضميني لصور تكون أكثر جمالية وهي في قالب الشعرية، فما فهمت بعض قصائد المعاصرين أهي خواطر أم أنها قصائد نثر كما يدعي الكثيرون، ولو أنها تخلو من الاسترسال في اللغة والمعنى كما هو النثر المرسل، أما الوزن فغد غابت جمالياته خاصة عندما يكتب الشاعر قصيدته على طريقة التفعيلة، فيتحرر من البحور والقوافي، لكنه في المقابل يجهل أن عليه اشتغال جاد على اللغة من أجل تشكيل إيقاع داخلي لقصيدته، فتحس وأنت تقرأها بثقل في الموسيقى، وهنا لن تستطربها الآذان ولو كان معناها يعجز الكثيرين عن الإتيان بمثله.
لقد غلب على الأدب الجزائري المعاصر نصوص كثيرة تم نقدها وانتقادها لأنها لا تستحق النشر على إعتبار أنها تجربة أدبية لم تنضج بعد، فملأتها أماكن القصور ومواطن النفور. وإن تحدثنا عنها بمصطلحات اللغة قلنا أنها نصوص لا يمكن وصفها بالاستقامة في الكلام وهو الأمر الذي تحدث عنه سيبويه كثيراً، حيث أنها في أحيان كثيرة على سبيل المثال لا الحصر، لا تطابق في شكلها ومعناها مقتضى الحال، ولها أن تكون في باب المحال الكذب أو باب المستقيم القبيح....، لكنها أبدا لن تكون في باب الإستقامة الصحيحة، حتى وإن صنفت في باب الخيال، فالتخييل الأدبي له ضوابط وحدود إن تم تجاوزها أصبحت هذه النصوص الأدبية بتنوعها مغايرة تماماً لمنطق التأليف الأدبي. وإن كان كاتبها يعتز بها، ويشاركها أصحابه وقراءه في المعارض والملتقيات وكذا وسائل الإعلام، فهو لن يتطور ولن يتقدم خطوة إلى الأمام، لأنه انجر وراء الشهرة، فأصبح لا يهتم بالتقييم ولا يعمل على تقويم ما أخطأ فيه، بل إنه لا يراعي لنفسه تحليل الأخطاء التي وقع فيها، فلا يحددها ولا يبررها، وبالتالي لن يكون لها هناك تصويب، وهنا نستدعي مصطلحا من مصطلحات اللسانيات التطبيقية، وهو مصطلح تحليل الأخطاء الذي يعتبر الهفوات والأخطاء على مستوى الشكل والمضمون أموراً مشوهة يجب تجاوزها وتصحيحها، فما أدراك في النصوص الأدبية التي تعتبر الأخطاء فيها سبباً رئيسياً في خلو أي نص من الجماليات الفنية.
إن الكتابة الجادة يلزمها قراءة أجد، فالقراءة هي التي تنمي قدرات الكاتب وتطور مهاراته في التعامل مع النصوص بمختلف أجناسها، وإن كان الحديث عن الرداءة التي طفت فوق سطحنا الأدبي يشخص مرض الأجناس الأدبية عندنا، فإنه لا بد من الوقوف على العيوب وتصحيحها من خلال تطوير تجربة الكتابة وصقلها من كل الجوانب حتى لا تتكرر الأخطاء الفادحة والنصوص البادخة بالنقائص، والتكرار هنا مصطلح مهم من أجل التعلم، والتعلم هو الآخر من مصطلحات اللسانيات الجوهرية، التي تحث على تعلم الشيء، والتعلم هنا يقتصر على تعلم آليات الكتابة وتقنياتها، تكرار العمل على ذلك، فتكرير الشيء يجعلنا نعتاده وبالضرورة نجيده، ولذلك لا بد على كتاب اليوم تكرير القراءات وإعادتها أكثر من مرة لأكثر من نص، ثم تكرير الكتابة وتكرارها من أجل معرفة مواطن القصور وتغييبها. فالتكرار ينبه صاحب النص لأخطائه...، ليستدركها ويقوم بتقويمها.
الحديث عن النص في أصله حديث عن النصية التي يجهلها الكثيرون ممن يكتبون ويحلمون بمسيرة كبيرة في هذا الميدان، فبعض المعاصرين ممن يمارسون فعل الكتابة لا يقرأون الكتب التقنية والأكاديمية، ولذلك فهم يجهلون الكثير من تقنيات النسج والتأليف، ولذلك تجد أغلب نصوصهم مجرد من معايير النصية، فلا اتساق يربط الفقرات، ولا انسجام يضم الموضوع في وحدته الموضوعية. أما القصدية فقد أعيت من يفهمها، لأن الكاتب لا يهتم بهذا الأمر، وهنا يفقد النص مهما كان نوعه أبعاده التداولية، فلا يجهد المتلقي نفسه بقراءة هذا النص الذي لم ينفتح على الآخر، ولم يهتم بوجوده كطرف فاعل في إنتاج النص وتوليده. هذا ويجدر التنبيه إلى أن الإستغناء عن القصدية في الكتابة الأدبية يلغي في المقابل معيار القبول، إذ لا يقبل المتلقي أي نص لم يفهم قصديته والغاية منه.
للنصية وجه آخر وهو التناص الذي عرفه ميخائيل باختين بأنه انفتاح نص على نص آخر، وهذا ما لم يفلح البعض من الجيل الجديد في استخدامه، حيث أنهم يقعون في حفرة التقليد الأعمى وهم ينفتحون على نصوص تأثروا بها، فتجد تلك النصوص في نصوصهم، ولكن بأسلوب أضعف وفي صورة رديئة تجعل التناص المباح، سرقة أدبية للفكرة والمضمون، ولحل هذه المشاكل لا بد على هؤلاء الكتاب التشبع الفكري والنظري من تقنيات الكتابة بكل انواعها، وهو ما يصطلح عليه في اللسانيات بعملية الاكتساب.
إن الحديث عن هذه المقاربة الموضوعية وما عالجته من نقاط، لا يشمل كل كاتب في الساحة الأدبية الجزائرية المعاصرة، وهو لا يقصد شخصا بعينه، إنما هو يشمل فقط أصحاب النصوص ذات المستوى المتدني، ممن تحتاج مهاراتهم الأدبية إلى صقل وتكوين جاد، يتجاوز من خلاله قيود الرتابة في التعبير عن الرأي والوجدان.
لقد دخل الأدب الجزائري مرحلة جديدة فاقت التوقعات في ما آلت إليه، فبعد أن كان يتطور ويزدهر في شكله ومضمونه، وهذا دليل على نضج التجارب وتطور انفتاحها واحتكاكها بالآداب الأخرى، أصبح اليوم يتغير في بعض أجناسه، التي تداخلت بطريقة لا يحمد عقباها، وأصبحت عباءات مصطلحات الكاتب والشاعر والناقد توضع على ظهر من هب ودب، ولو كان في رصيدهم نص أو كتيب واحد. وهنا توفرت لنا الكمية في كتاب ونصوص كثيرة، لكن الكيفية معدومة من الكفاءة، وينطبق على هذا الأمر ثنائية الوضع والاستعمال التي تحدث عنها دي سوسير في ثنائيته التركيب والاستبدال، ومن بعده تشومسكي مع القدرة والإنجاز ثم عبد الرحمان الحاج صالح، ولكن بصيغة مغايرة تماماً ربما لضرورة أدبية أتى بها جيل اليوم من الكتاب، حيث أنهم يستعملون كل الأفكار والجمل والعبارات التي تجوب خواطرهم، فيوظفونها على شكل روايات وقصائد وقصص دون تنقيح أو تحميص منتجين لنا بذلك جنسا أدبيا يستعصي عليك معرفته أو فهمه، أما اللغة التي تم وضعه بها فقد تكون عامية لا تحاكي واقع تجربة أدبية، وكم هذا كثير.
فاللغة في استعمال الرواية اليوم ضعيفة وناقص باب الفصاحة فيها في كثير من الأعمال التي لا يشتغل عليها أصحابها لغوياً وبلاغيا وأسلوبيا وكذلك دلاليا، فلم ترقى إلى مستوى السرد الذي يعد جوهر الرواية، وبالتالي ظلت هذه النصوص الروائية كلاما يتسم بالاختلاف واللاتجانس في الشكل والمضمون. ونفس الأمر ينطبق على الشعر الذي هزلت لغته وقصرت عن تصوير مجازي وتضميني لصور تكون أكثر جمالية وهي في قالب الشعرية، فما فهمت بعض قصائد المعاصرين أهي خواطر أم أنها قصائد نثر كما يدعي الكثيرون، ولو أنها تخلو من الاسترسال في اللغة والمعنى كما هو النثر المرسل، أما الوزن فغد غابت جمالياته خاصة عندما يكتب الشاعر قصيدته على طريقة التفعيلة، فيتحرر من البحور والقوافي، لكنه في المقابل يجهل أن عليه اشتغال جاد على اللغة من أجل تشكيل إيقاع داخلي لقصيدته، فتحس وأنت تقرأها بثقل في الموسيقى، وهنا لن تستطربها الآذان ولو كان معناها يعجز الكثيرين عن الإتيان بمثله.
لقد غلب على الأدب الجزائري المعاصر نصوص كثيرة تم نقدها وانتقادها لأنها لا تستحق النشر على إعتبار أنها تجربة أدبية لم تنضج بعد، فملأتها أماكن القصور ومواطن النفور. وإن تحدثنا عنها بمصطلحات اللغة قلنا أنها نصوص لا يمكن وصفها بالاستقامة في الكلام وهو الأمر الذي تحدث عنه سيبويه كثيراً، حيث أنها في أحيان كثيرة على سبيل المثال لا الحصر، لا تطابق في شكلها ومعناها مقتضى الحال، ولها أن تكون في باب المحال الكذب أو باب المستقيم القبيح....، لكنها أبدا لن تكون في باب الإستقامة الصحيحة، حتى وإن صنفت في باب الخيال، فالتخييل الأدبي له ضوابط وحدود إن تم تجاوزها أصبحت هذه النصوص الأدبية بتنوعها مغايرة تماماً لمنطق التأليف الأدبي. وإن كان كاتبها يعتز بها، ويشاركها أصحابه وقراءه في المعارض والملتقيات وكذا وسائل الإعلام، فهو لن يتطور ولن يتقدم خطوة إلى الأمام، لأنه انجر وراء الشهرة، فأصبح لا يهتم بالتقييم ولا يعمل على تقويم ما أخطأ فيه، بل إنه لا يراعي لنفسه تحليل الأخطاء التي وقع فيها، فلا يحددها ولا يبررها، وبالتالي لن يكون لها هناك تصويب، وهنا نستدعي مصطلحا من مصطلحات اللسانيات التطبيقية، وهو مصطلح تحليل الأخطاء الذي يعتبر الهفوات والأخطاء على مستوى الشكل والمضمون أموراً مشوهة يجب تجاوزها وتصحيحها، فما أدراك في النصوص الأدبية التي تعتبر الأخطاء فيها سبباً رئيسياً في خلو أي نص من الجماليات الفنية.
إن الكتابة الجادة يلزمها قراءة أجد، فالقراءة هي التي تنمي قدرات الكاتب وتطور مهاراته في التعامل مع النصوص بمختلف أجناسها، وإن كان الحديث عن الرداءة التي طفت فوق سطحنا الأدبي يشخص مرض الأجناس الأدبية عندنا، فإنه لا بد من الوقوف على العيوب وتصحيحها من خلال تطوير تجربة الكتابة وصقلها من كل الجوانب حتى لا تتكرر الأخطاء الفادحة والنصوص البادخة بالنقائص، والتكرار هنا مصطلح مهم من أجل التعلم، والتعلم هو الآخر من مصطلحات اللسانيات الجوهرية، التي تحث على تعلم الشيء، والتعلم هنا يقتصر على تعلم آليات الكتابة وتقنياتها، تكرار العمل على ذلك، فتكرير الشيء يجعلنا نعتاده وبالضرورة نجيده، ولذلك لا بد على كتاب اليوم تكرير القراءات وإعادتها أكثر من مرة لأكثر من نص، ثم تكرير الكتابة وتكرارها من أجل معرفة مواطن القصور وتغييبها. فالتكرار ينبه صاحب النص لأخطائه...، ليستدركها ويقوم بتقويمها.
الحديث عن النص في أصله حديث عن النصية التي يجهلها الكثيرون ممن يكتبون ويحلمون بمسيرة كبيرة في هذا الميدان، فبعض المعاصرين ممن يمارسون فعل الكتابة لا يقرأون الكتب التقنية والأكاديمية، ولذلك فهم يجهلون الكثير من تقنيات النسج والتأليف، ولذلك تجد أغلب نصوصهم مجرد من معايير النصية، فلا اتساق يربط الفقرات، ولا انسجام يضم الموضوع في وحدته الموضوعية. أما القصدية فقد أعيت من يفهمها، لأن الكاتب لا يهتم بهذا الأمر، وهنا يفقد النص مهما كان نوعه أبعاده التداولية، فلا يجهد المتلقي نفسه بقراءة هذا النص الذي لم ينفتح على الآخر، ولم يهتم بوجوده كطرف فاعل في إنتاج النص وتوليده. هذا ويجدر التنبيه إلى أن الإستغناء عن القصدية في الكتابة الأدبية يلغي في المقابل معيار القبول، إذ لا يقبل المتلقي أي نص لم يفهم قصديته والغاية منه.
للنصية وجه آخر وهو التناص الذي عرفه ميخائيل باختين بأنه انفتاح نص على نص آخر، وهذا ما لم يفلح البعض من الجيل الجديد في استخدامه، حيث أنهم يقعون في حفرة التقليد الأعمى وهم ينفتحون على نصوص تأثروا بها، فتجد تلك النصوص في نصوصهم، ولكن بأسلوب أضعف وفي صورة رديئة تجعل التناص المباح، سرقة أدبية للفكرة والمضمون، ولحل هذه المشاكل لا بد على هؤلاء الكتاب التشبع الفكري والنظري من تقنيات الكتابة بكل انواعها، وهو ما يصطلح عليه في اللسانيات بعملية الاكتساب.
إن الحديث عن هذه المقاربة الموضوعية وما عالجته من نقاط، لا يشمل كل كاتب في الساحة الأدبية الجزائرية المعاصرة، وهو لا يقصد شخصا بعينه، إنما هو يشمل فقط أصحاب النصوص ذات المستوى المتدني، ممن تحتاج مهاراتهم الأدبية إلى صقل وتكوين جاد، يتجاوز من خلاله قيود الرتابة في التعبير عن الرأي والوجدان.