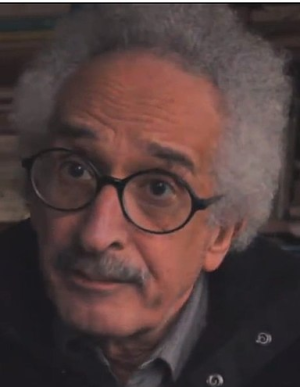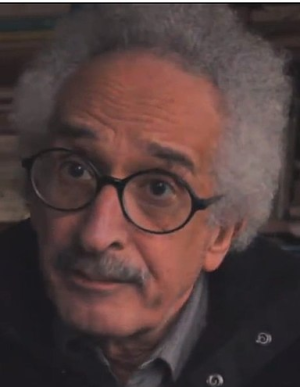اقتربتُ من الدكان في تردَّد. وعندما أصبحتُ أمام الباب اختلستُ النظر إلى الداخل فوجدتُ ما كنتُ أتوقعه. كان الرجل ممددًا على مقعدٍ قديم وقد كشَف جلبابه عن عظمة ساقه المنتفخة، وكان يتنفَّس بصوتٍ مرتفع.
وقفتُ عند الباب لا أدري ماذا أفعل. وأمامي إلى اليسار كان الرفَّان الصغيران اللذان كنتُ أحلُم بهما طوال الأيام الماضية، وفوقهما عشرات من روايات الجيب الرفيعة، بل مئات. كان بيني وبينهما خطوة أو خطوتان. لكن الرجل كان نائمًا، رغم أننا لا زلنا في الصباح. وكنتُ أخاف أن يستيقظ فجأةً ويراني، وفي نفس الوقت لم أكن أستطيع الانصراف؛ لم أكن أستطيع أن أتصوَّر نفسي طول اليوم بدون رواية، وخطَوتُ إلى الداخل.
ناديتُه وأنا أضع يدي في رفق على ساقه المنبعجة، وتوقَّف صوت تنفُّسه على الفور، واهتَز جسمه قليلًا، ثم انفرجَت عينه اليسرى عن دائرةٍ حمراء، وانفرجَت شفتاه عن زمجرة.
قلتُ له وأنا أُشير بإصبعي إلى الروايات: «حادوَّر على رواية.»
انطلقَت زمجرة ثانية من فمه، وخُيِّل لي أنه سينقضُّ عليَّ ويحطمني، لكنه اعتدل جالسًا وهو يتنهَّد، وجعل يمسح رقبته بمنديلٍ متسخ، وتطلَّعت عيناه الحمراوان إليَّ بكل سَعَتهما، فابتعدتُ عنه. وعندما ظل صامتًا، اتجهتُ إلى الرفَّين في بطء ووقفتُ أمامهما أُقلِّب في الروايات.
كانت الروايات قديمة، اختفت أغلفتُها، واسمرَّت صفحاتها وتمزَّقَت. وكان التراب يتصاعد منها ممزوجًا برائحةٍ غريبة كانت تأتي من كل شيءٍ في الدكان، وكنتُ أُحبُّ هذه الرائحة.
استعرضتُ المجموعة في سرعةٍ مكتفيًا بالنظر إلى الصفحة الأولى بحثًا عن سطر من كلماتٍ صغيرة أسفل العنوان. وانتهيتُ من الصف الأول دون أن أعثُر على بغيتي، وشَعرتُ بالضيق، وبدأ العَرق يتصبَّب على وجهي. واختلستُ النظر إلى الرجل وأنا أخشى أن يزمجر أو ينفجر فيَّ، لكنه كان ينظُر إليَّ بعينَيه الحمراوَين في صمت، وقال فجأة: «ما فيش أرسين لوبين.»
توقَّفتْ يداي. كان لا يزال أمامي رفٌّ بأكمله، وخُيِّل إليَّ أنه يودُّ التخلُّص مني، فقرَّرتُ أن أستأنف البحث، وواصلتُ التدوير بسرعةٍ فائقة، لكني لم أجد روايةً واحدة لأرسين لوبين. وغالبتُ شعور الضِّيق الذي تملَّكَني، وعُدتُ أقلِّب الروايات من جديد على مهَل. كنتُ أريد الآن أي روايةٍ بوليسية عادية.
زهرة الموت قرأتُها. الجريمة الكاملة أحضَرها أبي إلى البيت من قبلُ، اللغز الصيني. كانت أول رواية لأرسين لوبين أقرؤها، العيون الثلاثة لموريس لبلان، نفس مؤلِّف أرسين لوبين لكنها ليست عنه، وأخذتُ فيها مقلبًا من قبلُ. لو تكُون هناك رواية لأرسين لوبين فاتت عليَّ في البحث الأول. إعدام في الفجر، تبدو كمأساة وأنا لا أُحب الروايات المفجعة. الحب العظيم، ولا أُحب الروايات الغرامية أيضًا. مدرسة الأسرار، لا يبدو موضوعها من صورة الغلاف. قناع الموت، لغز الألغاز. قرأتُ كل هذا. الحُطام، منظَرها واسمُها لا يُشجِّعان. أنزلتُ يدي في يأس. كان ساعدي قد بدأ يؤلمني، وبدا كأني لن أخرج بشيءٍ من هذه المرة. وزمجَر الرجل من خلفي: «هو أنت موش عاجباك حاجة من كل دول؟»
أجبتُ بسرعة وأنا أستأنف البحث: «لا .. خلاص .. أهوه.»
جريمة بين السحاب، قرأتُها من قبلُ ولا بأس من أخذها مرةً ثانية لو لم أعثُر على شيء، ووضعتُها جانبًا. الرسائل المجهولة، قرأتها. هذه الرواية التي اسمها مدرسة الأسرار، لنُجرِّبها، ربما تكون مفاجئة. المرشد، الأخوات البيض، خبزنا اليومي، يوجيني جرانديه، عناوين لا معنى لها ويمكن أن تكون كلٌّ منها مقلبًا، والأكيد أنها ليست بوليسية. لا يوجد أي شيء لشرلوك هولمز أو حتى شارلي شان الصيني رغم ثقل دمه. كل الروايات صغيرة الحجم، لو أجد واحدة من الروايات الكبيرة القديمة. لو أقع صدفة على الرواية التي كانت في بيتنا وأنا صغير جدًّا وللأسف لم أقرأها؛ لأن ما قرأته منها كان كافيًا لإلقاء الرعب في صدري وجعلَني أُمزِّقها لأتخلَّص منها. ولا زلت أذكُر منها كلامًا عن شاطئ وقصرٍ مهجور تقع به جريمة وناس تجري في الظلام وتتهامس. وهناك أيضًا رواية العين الحمراء، ثم الرواية التي كان أبي يقرأ فيها دائمًا.
ودوَّى صوتٌ مفاجئ، قريبٌ مني بل فوق رأسي تمامًا: «إوعى .. ما فيش روايات .. مش حنبيع روايات.»
كان الرجل قد انتفَض من مَقعدِه غاضبًا وخطَف مني الروايات التي كُنتُ أحتفظ بها في يدي لأختار منها في النهاية عندما أفشل في الحصول على واحدةٍ حلوة، وتطلَّعتُ حولي في يأس. كل هذا البحث وأعود بلا شيء. ولمحتُ كتابًا ذا غلافٍ أسودَ سميكٍ ملقًى على مقربة، فتناولتُه بسرعة وفتحتُه، كان ورقه أصفر خشنًا وطباعتُه رديئة، وحسبتُه من الكتب القديمة التي لا شأن لها بالروايات، ولم يكن له عنوان أو بداية، وقلَّبتُ صفحاته بسرعة، ثم أدركتُ أنه من القصص البوليسية القديمة، وقلتُ في لهفة: «خلاص. حاخده ده».
لكنه خطف الكتاب من يدي ودفعَني في جنبي وهو يزعق: «ما عندناش روايات، مش حنبيع روايات.»
ابتعدتُ في أسًى، ولم يكن أمامي وقت لأذهب إلى دكَّانٍ آخر، وكان يجب أن أعود على الفور؛ فلم يكن أبي يعرف أني خرجتُ.
وعندما دخلتُ الحارة سرت بجوار جدار البيوت محاذرًا كي لا يراني أبي لو كان يقف في البلكونة، وصَعِدتُ السلَّم جريًا حتى لهثتُ وعَرقتُ، ووجدتُ باب الشقَّة مواربًا كما تركتُه، فتسلَّلتُ داخلًا وأنا أتنصَّت لأُحدِّد مكان أبي، وأحسستُ أنه في غرفة النوم، فاتجهتُ إليها. ورأيتُه مُتربعًا على السرير وأمامه المائدة الخشبية، وقد وضَع فوقها علبة الحلاقة التي كانت في الأصل صندوقًا للسجاير من الكرتون، وأسند المرآة إلى كوبٍ من الزجاج مُلئ بالماء، وكان يسنُّ الموسَى على راحة يده.
راقبتُ الموسَى وهو يروح ويجيء فوق لحم كفِّه المتين في بطء وثبات، أدركتُ أنه سيخرج. ولم يبدُ عليه أنه أَحَس بغيابي، فجلستُ على مقعدٍ خشبي بغير مَسندٍ في الركن، وجعلتُ أرقُبه وهو يضع الصابون على ذقنه ويمرُّ عليها بالمكنة ثم ينحني إلى الأمام ليرى وجهه في المرآة، وعندما انتهى دعك ذقنه بقطعةٍ من الشبَّة، فبدَت ناعمةً منتعشة، وأردتُ أن ألمسَها بإصبعي.
التفت إليَّ فجأة قائلًا: «البس هدومك عشان تخرج معايا.»
كان الخروج معه أحسن من عشر روايات، وربما سنحَت الفرصة في الطريق لشراء رواية.
وقبل أن تنتبه أختي للأمر، فتبكي وتصرخ وتُصِر على الخروج معنا، ضحك عليها أبي بأن قال لها إنه سيتركها تلعَب طَوال اليوم في شقة أم زكية المجاورة لنا.
ارتدى أبي ملابسه، ومسح طربوشه بكم سُترته وأحكَم وضعَه فوق رأسه، ثم طوى طرفَي شاربه الأبيض داخل فتحتَي أنفه. وغادَرنا الشقَّة وأغلقنا بابها وراءنا، وانطلَقنا إلى الشارع، ولاحظتُ أننا نتجه إلى محطة الترام.
سألتُه: «إحنا رايحين فين؟»
فأجاب: «الوقت تعرف.»
ركبنا الترام، وقطعنا مسافةً طويلة ثم هبطنا أمام مبنًى كبير مسوَّر ومزدحم بالناس عند بابه وفي فِنائه.
قال أبي: «دي المحكمة.»
دخلنا إلى الفناء، وقال أبي: «الوقت إحنا حنخش جوه، وحنلاقي مامتك قاعدة مع أمها.»
دُهِشتُ: «ماما؟»
– «أيوه. تروح تسلم عليها وتشوف حتقولك إيه.»
– «وانت مش جاي؟»
– «لا، حستناك برَّه في الطرقة.»
وقادني أبي إلى رَدهةٍ كبيرة مظلمة، ومررنا ببابٍ على اليمين فدفعَني ناحيته وهو يقول: «أهي هناك أهيه.» وبالفعل رأيتها.
كانت تجلس ساكنة بجوار جدتي. وكانت الأخيرة أوَّل من أبصَرتْني، فتطلَّعتُ خلفي في اهتمام، ثم ارتسمَت على شفتَيها ابتسامةٌ غريبة لم أَسترِح لها، وجعلَت تنظُر إليَّ في جمود، وكان وجهها محاطًا بطرحةٍ بيضاء باهتة.
اقتربتُ منها وأنا أنظر إلى أمي. كانت ترتدي معطفًا من الحرير الأسود وحول رأسها «بيشة». ولاحظتُ شعرها الأسود الطويل، وخُيِّل إليَّ أنها ازدادت طولًا وعَرضًا عن آخر مرة رأيتُها.
ورأتني أمي، لكن لم يبدُ عليها أنها عرفَتني. وفجأةً خاطبتني في هدوء كأنني لم أفترق عنها أبدًا: «إزيَّك.»
لكنها لم تطلُب مني أن أجلس بجوارها، وانصرفَت عني تتأمل ما يجري في القاعة. وقفتُ حائرًا لا أدري ماذا أفعل. وحانَت مني نظرة إلى الردهة الخارجية، فوجدتُ أبي يستدير برأسه ناحيتي وهو يتمشَّى واضعًا يدَيه خلف ظهره، وأبصرتُ مكانًا خاليًا بجوار أمي فجلستُ فيه.
كنا في آخر القاعة، ولم تكن مزدحمة، وكانت بها دككٌ مستطيلة في نهايتها منصةٌ مرتفعة جلس إليها القاضي، وإلى يساره وقف شيخ بقفطان وعمة ونظَّارة وسيدة بملاءة لف، وكانوا يتناقشون.
كانت هذه أول مرة أرى فيها محكمة. واستغربتُ؛ فلم يكن هناك شيء مما كنت أتصوره، لا مرافعاتٌ ملتهبة، وقاعةٌ مزدحمة، وقاضٍ يرتدي وشاحًا مُلوَّنًا، ومحامٍ يُلوِّح بيديه ويَرِن صوته في أنحاء القاعة.
نهضَت جدتي فجأة ومضت إلى رجلٍ بعمَّة فتحدثَّت معه قليلًا. والتفتُّ إلى اليسار فرأيتُ أبي يتكلم مع بعض الناس. واختلستُ نظرة إلى أمي فوجدتها كما هي تتطلَّع أمامها بغير اكتراث.
وذهبَت جدتي إلى أقصى القاعة وتحدَّثَت قليلًا مع القاضي.
ولاحظتُ أن أبي يشير إليَّ من بعيد، فقمتُ واقفًا، ولم أدر ماذا أقول لأمي، ولم تنظر هي ناحيتي، فمشيتُ دون أن أقول لها شيئًا. وقال لي أبي: «هيه .. قالت لك إيه؟»
– «ما فيش، قالت لي إزيك.»
اتجه أبي إلى الباب وأنا معه، وسرنا في الشارع، وكان ضيقًا وعلى جانبيه دكاكينُ قديمة، وكان أبي يدخِّن. ولمحتُ دكانًا به بعض الكتب، وجذَبتُ أبي من يده وقلتُ له وأنا أستعد لخوض معركة: «بابا .. تعالى نسأل على روايات».
لم يعارض أبي، وصَحبَني إلى الدكان وسأل صاحبه: «عندك روايات يا عم؟» قدَّم لنا الرجل خمس رواياتٍ وجدتُ أني قرأتُها جميعًا عدا واحدة. وكدتُ أقفز من الفرح، أرسين لوبين في قاع البحر. وكانت الرواية جديدةً ذات غلافٍ ملوَّن ناعم يلمع. أخذتُ الرواية ودفع أبي ثمنها وخرجنا إلى الشارع الرئيسي.
وكنتُ أتمنى الآن أن نعود بأقصى سرعة.
ركبنا الترام، ووضعتُ الرواية على ساقي مخفيًا غلافها الأمامي، وجعلتُ أتأمل الغلاف الخلفي. كان أبيضَ مصقولًا، ويحمل إعلانًا عن الرواية التالية. وطوَّح الهواء بالغلاف فظَهرتِ الصفحة الأخيرة وفي نهايتها كلمةٌ لذيذة كبيرة: «تمَّت». وقاومتُ حتى لا أقرأ آخر سطور الرواية، فأدرتها إلى وجهها الأمامي. طالعَني مسدَّسٌ كبير وخلْفه وجهُ رجلٍ يرتدي قبَّعة، لا بد أنه أرسين لوبين شخصيًّا. كان الاسم الساحر مكتوبًا بحروفٍ صغيرة أسفل العنوان، وقرأتُه وأنا أكاد أطير من السعادة.
سجن المحاريق
بالواحات الخارجة
١٩٦٣م

وقفتُ عند الباب لا أدري ماذا أفعل. وأمامي إلى اليسار كان الرفَّان الصغيران اللذان كنتُ أحلُم بهما طوال الأيام الماضية، وفوقهما عشرات من روايات الجيب الرفيعة، بل مئات. كان بيني وبينهما خطوة أو خطوتان. لكن الرجل كان نائمًا، رغم أننا لا زلنا في الصباح. وكنتُ أخاف أن يستيقظ فجأةً ويراني، وفي نفس الوقت لم أكن أستطيع الانصراف؛ لم أكن أستطيع أن أتصوَّر نفسي طول اليوم بدون رواية، وخطَوتُ إلى الداخل.
ناديتُه وأنا أضع يدي في رفق على ساقه المنبعجة، وتوقَّف صوت تنفُّسه على الفور، واهتَز جسمه قليلًا، ثم انفرجَت عينه اليسرى عن دائرةٍ حمراء، وانفرجَت شفتاه عن زمجرة.
قلتُ له وأنا أُشير بإصبعي إلى الروايات: «حادوَّر على رواية.»
انطلقَت زمجرة ثانية من فمه، وخُيِّل لي أنه سينقضُّ عليَّ ويحطمني، لكنه اعتدل جالسًا وهو يتنهَّد، وجعل يمسح رقبته بمنديلٍ متسخ، وتطلَّعت عيناه الحمراوان إليَّ بكل سَعَتهما، فابتعدتُ عنه. وعندما ظل صامتًا، اتجهتُ إلى الرفَّين في بطء ووقفتُ أمامهما أُقلِّب في الروايات.
كانت الروايات قديمة، اختفت أغلفتُها، واسمرَّت صفحاتها وتمزَّقَت. وكان التراب يتصاعد منها ممزوجًا برائحةٍ غريبة كانت تأتي من كل شيءٍ في الدكان، وكنتُ أُحبُّ هذه الرائحة.
استعرضتُ المجموعة في سرعةٍ مكتفيًا بالنظر إلى الصفحة الأولى بحثًا عن سطر من كلماتٍ صغيرة أسفل العنوان. وانتهيتُ من الصف الأول دون أن أعثُر على بغيتي، وشَعرتُ بالضيق، وبدأ العَرق يتصبَّب على وجهي. واختلستُ النظر إلى الرجل وأنا أخشى أن يزمجر أو ينفجر فيَّ، لكنه كان ينظُر إليَّ بعينَيه الحمراوَين في صمت، وقال فجأة: «ما فيش أرسين لوبين.»
توقَّفتْ يداي. كان لا يزال أمامي رفٌّ بأكمله، وخُيِّل إليَّ أنه يودُّ التخلُّص مني، فقرَّرتُ أن أستأنف البحث، وواصلتُ التدوير بسرعةٍ فائقة، لكني لم أجد روايةً واحدة لأرسين لوبين. وغالبتُ شعور الضِّيق الذي تملَّكَني، وعُدتُ أقلِّب الروايات من جديد على مهَل. كنتُ أريد الآن أي روايةٍ بوليسية عادية.
زهرة الموت قرأتُها. الجريمة الكاملة أحضَرها أبي إلى البيت من قبلُ، اللغز الصيني. كانت أول رواية لأرسين لوبين أقرؤها، العيون الثلاثة لموريس لبلان، نفس مؤلِّف أرسين لوبين لكنها ليست عنه، وأخذتُ فيها مقلبًا من قبلُ. لو تكُون هناك رواية لأرسين لوبين فاتت عليَّ في البحث الأول. إعدام في الفجر، تبدو كمأساة وأنا لا أُحب الروايات المفجعة. الحب العظيم، ولا أُحب الروايات الغرامية أيضًا. مدرسة الأسرار، لا يبدو موضوعها من صورة الغلاف. قناع الموت، لغز الألغاز. قرأتُ كل هذا. الحُطام، منظَرها واسمُها لا يُشجِّعان. أنزلتُ يدي في يأس. كان ساعدي قد بدأ يؤلمني، وبدا كأني لن أخرج بشيءٍ من هذه المرة. وزمجَر الرجل من خلفي: «هو أنت موش عاجباك حاجة من كل دول؟»
أجبتُ بسرعة وأنا أستأنف البحث: «لا .. خلاص .. أهوه.»
جريمة بين السحاب، قرأتُها من قبلُ ولا بأس من أخذها مرةً ثانية لو لم أعثُر على شيء، ووضعتُها جانبًا. الرسائل المجهولة، قرأتها. هذه الرواية التي اسمها مدرسة الأسرار، لنُجرِّبها، ربما تكون مفاجئة. المرشد، الأخوات البيض، خبزنا اليومي، يوجيني جرانديه، عناوين لا معنى لها ويمكن أن تكون كلٌّ منها مقلبًا، والأكيد أنها ليست بوليسية. لا يوجد أي شيء لشرلوك هولمز أو حتى شارلي شان الصيني رغم ثقل دمه. كل الروايات صغيرة الحجم، لو أجد واحدة من الروايات الكبيرة القديمة. لو أقع صدفة على الرواية التي كانت في بيتنا وأنا صغير جدًّا وللأسف لم أقرأها؛ لأن ما قرأته منها كان كافيًا لإلقاء الرعب في صدري وجعلَني أُمزِّقها لأتخلَّص منها. ولا زلت أذكُر منها كلامًا عن شاطئ وقصرٍ مهجور تقع به جريمة وناس تجري في الظلام وتتهامس. وهناك أيضًا رواية العين الحمراء، ثم الرواية التي كان أبي يقرأ فيها دائمًا.
ودوَّى صوتٌ مفاجئ، قريبٌ مني بل فوق رأسي تمامًا: «إوعى .. ما فيش روايات .. مش حنبيع روايات.»
كان الرجل قد انتفَض من مَقعدِه غاضبًا وخطَف مني الروايات التي كُنتُ أحتفظ بها في يدي لأختار منها في النهاية عندما أفشل في الحصول على واحدةٍ حلوة، وتطلَّعتُ حولي في يأس. كل هذا البحث وأعود بلا شيء. ولمحتُ كتابًا ذا غلافٍ أسودَ سميكٍ ملقًى على مقربة، فتناولتُه بسرعة وفتحتُه، كان ورقه أصفر خشنًا وطباعتُه رديئة، وحسبتُه من الكتب القديمة التي لا شأن لها بالروايات، ولم يكن له عنوان أو بداية، وقلَّبتُ صفحاته بسرعة، ثم أدركتُ أنه من القصص البوليسية القديمة، وقلتُ في لهفة: «خلاص. حاخده ده».
لكنه خطف الكتاب من يدي ودفعَني في جنبي وهو يزعق: «ما عندناش روايات، مش حنبيع روايات.»
ابتعدتُ في أسًى، ولم يكن أمامي وقت لأذهب إلى دكَّانٍ آخر، وكان يجب أن أعود على الفور؛ فلم يكن أبي يعرف أني خرجتُ.
وعندما دخلتُ الحارة سرت بجوار جدار البيوت محاذرًا كي لا يراني أبي لو كان يقف في البلكونة، وصَعِدتُ السلَّم جريًا حتى لهثتُ وعَرقتُ، ووجدتُ باب الشقَّة مواربًا كما تركتُه، فتسلَّلتُ داخلًا وأنا أتنصَّت لأُحدِّد مكان أبي، وأحسستُ أنه في غرفة النوم، فاتجهتُ إليها. ورأيتُه مُتربعًا على السرير وأمامه المائدة الخشبية، وقد وضَع فوقها علبة الحلاقة التي كانت في الأصل صندوقًا للسجاير من الكرتون، وأسند المرآة إلى كوبٍ من الزجاج مُلئ بالماء، وكان يسنُّ الموسَى على راحة يده.
راقبتُ الموسَى وهو يروح ويجيء فوق لحم كفِّه المتين في بطء وثبات، أدركتُ أنه سيخرج. ولم يبدُ عليه أنه أَحَس بغيابي، فجلستُ على مقعدٍ خشبي بغير مَسندٍ في الركن، وجعلتُ أرقُبه وهو يضع الصابون على ذقنه ويمرُّ عليها بالمكنة ثم ينحني إلى الأمام ليرى وجهه في المرآة، وعندما انتهى دعك ذقنه بقطعةٍ من الشبَّة، فبدَت ناعمةً منتعشة، وأردتُ أن ألمسَها بإصبعي.
التفت إليَّ فجأة قائلًا: «البس هدومك عشان تخرج معايا.»
كان الخروج معه أحسن من عشر روايات، وربما سنحَت الفرصة في الطريق لشراء رواية.
وقبل أن تنتبه أختي للأمر، فتبكي وتصرخ وتُصِر على الخروج معنا، ضحك عليها أبي بأن قال لها إنه سيتركها تلعَب طَوال اليوم في شقة أم زكية المجاورة لنا.
ارتدى أبي ملابسه، ومسح طربوشه بكم سُترته وأحكَم وضعَه فوق رأسه، ثم طوى طرفَي شاربه الأبيض داخل فتحتَي أنفه. وغادَرنا الشقَّة وأغلقنا بابها وراءنا، وانطلَقنا إلى الشارع، ولاحظتُ أننا نتجه إلى محطة الترام.
سألتُه: «إحنا رايحين فين؟»
فأجاب: «الوقت تعرف.»
ركبنا الترام، وقطعنا مسافةً طويلة ثم هبطنا أمام مبنًى كبير مسوَّر ومزدحم بالناس عند بابه وفي فِنائه.
قال أبي: «دي المحكمة.»
دخلنا إلى الفناء، وقال أبي: «الوقت إحنا حنخش جوه، وحنلاقي مامتك قاعدة مع أمها.»
دُهِشتُ: «ماما؟»
– «أيوه. تروح تسلم عليها وتشوف حتقولك إيه.»
– «وانت مش جاي؟»
– «لا، حستناك برَّه في الطرقة.»
وقادني أبي إلى رَدهةٍ كبيرة مظلمة، ومررنا ببابٍ على اليمين فدفعَني ناحيته وهو يقول: «أهي هناك أهيه.» وبالفعل رأيتها.
كانت تجلس ساكنة بجوار جدتي. وكانت الأخيرة أوَّل من أبصَرتْني، فتطلَّعتُ خلفي في اهتمام، ثم ارتسمَت على شفتَيها ابتسامةٌ غريبة لم أَسترِح لها، وجعلَت تنظُر إليَّ في جمود، وكان وجهها محاطًا بطرحةٍ بيضاء باهتة.
اقتربتُ منها وأنا أنظر إلى أمي. كانت ترتدي معطفًا من الحرير الأسود وحول رأسها «بيشة». ولاحظتُ شعرها الأسود الطويل، وخُيِّل إليَّ أنها ازدادت طولًا وعَرضًا عن آخر مرة رأيتُها.
ورأتني أمي، لكن لم يبدُ عليها أنها عرفَتني. وفجأةً خاطبتني في هدوء كأنني لم أفترق عنها أبدًا: «إزيَّك.»
لكنها لم تطلُب مني أن أجلس بجوارها، وانصرفَت عني تتأمل ما يجري في القاعة. وقفتُ حائرًا لا أدري ماذا أفعل. وحانَت مني نظرة إلى الردهة الخارجية، فوجدتُ أبي يستدير برأسه ناحيتي وهو يتمشَّى واضعًا يدَيه خلف ظهره، وأبصرتُ مكانًا خاليًا بجوار أمي فجلستُ فيه.
كنا في آخر القاعة، ولم تكن مزدحمة، وكانت بها دككٌ مستطيلة في نهايتها منصةٌ مرتفعة جلس إليها القاضي، وإلى يساره وقف شيخ بقفطان وعمة ونظَّارة وسيدة بملاءة لف، وكانوا يتناقشون.
كانت هذه أول مرة أرى فيها محكمة. واستغربتُ؛ فلم يكن هناك شيء مما كنت أتصوره، لا مرافعاتٌ ملتهبة، وقاعةٌ مزدحمة، وقاضٍ يرتدي وشاحًا مُلوَّنًا، ومحامٍ يُلوِّح بيديه ويَرِن صوته في أنحاء القاعة.
نهضَت جدتي فجأة ومضت إلى رجلٍ بعمَّة فتحدثَّت معه قليلًا. والتفتُّ إلى اليسار فرأيتُ أبي يتكلم مع بعض الناس. واختلستُ نظرة إلى أمي فوجدتها كما هي تتطلَّع أمامها بغير اكتراث.
وذهبَت جدتي إلى أقصى القاعة وتحدَّثَت قليلًا مع القاضي.
ولاحظتُ أن أبي يشير إليَّ من بعيد، فقمتُ واقفًا، ولم أدر ماذا أقول لأمي، ولم تنظر هي ناحيتي، فمشيتُ دون أن أقول لها شيئًا. وقال لي أبي: «هيه .. قالت لك إيه؟»
– «ما فيش، قالت لي إزيك.»
اتجه أبي إلى الباب وأنا معه، وسرنا في الشارع، وكان ضيقًا وعلى جانبيه دكاكينُ قديمة، وكان أبي يدخِّن. ولمحتُ دكانًا به بعض الكتب، وجذَبتُ أبي من يده وقلتُ له وأنا أستعد لخوض معركة: «بابا .. تعالى نسأل على روايات».
لم يعارض أبي، وصَحبَني إلى الدكان وسأل صاحبه: «عندك روايات يا عم؟» قدَّم لنا الرجل خمس رواياتٍ وجدتُ أني قرأتُها جميعًا عدا واحدة. وكدتُ أقفز من الفرح، أرسين لوبين في قاع البحر. وكانت الرواية جديدةً ذات غلافٍ ملوَّن ناعم يلمع. أخذتُ الرواية ودفع أبي ثمنها وخرجنا إلى الشارع الرئيسي.
وكنتُ أتمنى الآن أن نعود بأقصى سرعة.
ركبنا الترام، ووضعتُ الرواية على ساقي مخفيًا غلافها الأمامي، وجعلتُ أتأمل الغلاف الخلفي. كان أبيضَ مصقولًا، ويحمل إعلانًا عن الرواية التالية. وطوَّح الهواء بالغلاف فظَهرتِ الصفحة الأخيرة وفي نهايتها كلمةٌ لذيذة كبيرة: «تمَّت». وقاومتُ حتى لا أقرأ آخر سطور الرواية، فأدرتها إلى وجهها الأمامي. طالعَني مسدَّسٌ كبير وخلْفه وجهُ رجلٍ يرتدي قبَّعة، لا بد أنه أرسين لوبين شخصيًّا. كان الاسم الساحر مكتوبًا بحروفٍ صغيرة أسفل العنوان، وقرأتُه وأنا أكاد أطير من السعادة.
سجن المحاريق
بالواحات الخارجة
١٩٦٣م