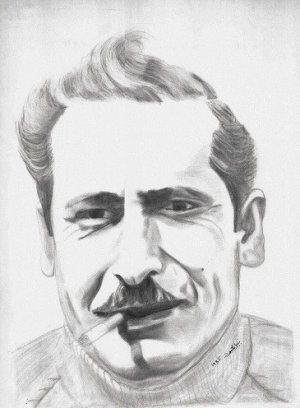عشت ثلاثة وخمسين عاماً، حتى الآن، في دمشق، ولم اكتب ثلاثة وخمسين كلمة عن دمشق، لا أدري لماذا!
يقال ان المجتمع الدمشقي كتيم، وانه منغلق على نفسه، لا سبيل لمن هو غريب عنه، ان يخترق أسوار كتامته، وقد افلحت، أنا الدخيل عليه، ان اخترق هذه الأسوار، ان اتعرف على المجتمع الدمشقي من الداخل، ان أفهم العقلية الدمشقية ظاهراً وباطناً، ان اعيش بيئته وما فيها من أسرار، ان أطوّف في احيائه القديمة، وامشي متمهلاً، متأنياً، ملاحظاً، مراقباً ما في ازقته وزواريبه من بشر وحجر، ان اجلس في مقاهيه، واتحدث مع من فيها من رواد، وحتى مقهى النافورة الشهير، الواقع خلف الجامع الأموي، زرته، قضيت الساعات فيه، شربت ناركيلته كثيراً، صار لي مع أصحابه، مع جلسائه، أحاديث، ورغم ذلك لم اكتب عنه رواية، فقد استعصى علي الأمر، وادركت، بعد طول تفكير، ان معرفة المدن شيء، وكتابة رواية عن هذه المدينة أو تلك، شيء آخر.
إن بعض زملائي الروائيين، من الغرباء عن دمشق، الوافدين إليها للدراسة أو الإقامة، كتبوا روايات مقبولة من وجهة نظرهم، غير مستساغة من وجهة نظري، لأنها تتناول حيوات الطلاب الجامعيين، الذين يعيشون على هامش هذه العاصمة، دون ان تمس قاعها الاجتماعي، ودون ان نستطيع القول: اننا نعرف دمشق من خلالها، أو اننا نزداد معرفة بها، من خلال هذه الرواية أو تلك، لأن حياة الجامعة ليست حياة المدينة، ولن تكون في يوم من الأيام.
هل هذا لأني بحري الهوى؟ وهل هذا لأنني عرفت البحر، ومدن البحر، أكثر مما عرفت دمشق، والمدن الداخلية في وطني سورية؟ ولماذا، ذات يوم، كانت لي، وبعمق هذه الأمنية: ان تنتقل دمشق إلى البحر، أو ينتقل البحر إلى دمشق!؟ وكيف يطاوع قلمي وأنا في اللاذقية، ويحرن وانا في دمشق؟ وهل لنسمة البحر، أو جرعة الرطوبة التي تنعشني جسداً وروحاً وأنا على جوار الساحل، كما يقول أصحابي، علاقة في هذا الاستعصاء الروائي الدمشقي!؟
ظني ان الأمر غير ذلك، وانني، انا الذي لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية، لم أعرف الجامعة، بكلياتها المتعددة، المتنوعة، كي اكتب، كسواي، رواية عن قصص الحب التي تنشأ بين طلابها وطالباتها، وعن لقاءاتهم وسهراتهم وما يدور فيها من أحاديث ونجاوى، ومن ود وجفاء، أو زعل ورضا، أو ما تنتهي إليه علاقات الحب تلك من نهايات سعيدة، بالزواج، وبوضع الرأسين على وسادة واحدة!
المسألة، فيما انتهيت إليه، اعقد من ذلك، كونها تتعلق بالمزاج، أو بشيء غيره، فالأحداث الهاجعة في قاع الذاكرة، لا يكفي ان تستيقظ حتى نكتب عنها، وإلا لكانت التجارب التي تنبت منها الأحداث، كلها صالح لكتابة رواية ما، وهذا يجانف الأصول، فالحدث، حتى مع التجربة، يحتاج إلى تطوير، في السياق وفي نمو الشخصيات، وليس كل حدث يؤاتي بالسهولة التي نريد، مادامت ثمة خشية في الوقوع، مهما احترزنا، في مطب الافتعال، وتالياً في القسر على جعل الخط الرئيسي للرواية، وكذلك الخطوط الثانوية، التي تخدم هذا الخط، فعل إرادة الروائي، لا فعل المنطق الداخلي للرواية، وآليتها الصحيحة، المفضية إلى التكّون الطبيعي لجنين الحدث، وما يتبع ذلك في استواء هذا الجنين قواماً روائياً متكاملاً، صادقاً في تكامله.
بعضهم يقول، اعطني أي مشهد، وانا أجعل منه قصة، وقد كان تشيكوف، في معلميته القصصية البارعة، قادراً على ذلك، وكذلك كان يوسف ادريس، وكتاب القصة الشهيرون في العالم، من موباسان إلى سومرست موم، ومن عبدالله عبد إلى زكريا تامر، ويبقى هذا، في العطاء الفني، وقفاً على القصة وحدها، أما الرواية فإنها تختلف، لأن القصة بنت اللقطة المفردة، والرواية بنت التجربة العريضة، الكافية لخلق حياة متكاملة، ذات أعماق وأبعاد قادرة على ان تجعل هذه الحياة حقيقية، نعيشها بكل جوارحنا، وتبقى في كينونتها، فاعلة في نفس القارئ، حاملة إليه، مع المتعة والفائدة، جوانب مجهولة، يكتشفها في تطور الحدث، وفي استواء شخصياته استواء نستطيع معه أن نقول: نعم انا أعرف هذه الشخصيات، المتخطية محليتها، بيئتها، إلى انسانيتها الشاملة.
يقول ميلان كونديرا حول البناء الروائي: «الرواية هي كتاب الحياة، وروحها هي روح الاستمرار» ويقول الناقد الروائي لا يونغ تريك: «ان الرواية بحث مستمر، وميدان بحثها العالم الاجتماعي، ومادة بحثها، أو تحليلها هي عادات الناس التي تتخذ دليلاً على الاتجاه الذي تسير فيه نفس الإنسان، ويقول دافتي: «يقوم القصد الأول للفاعل، في كل فعل يمارسه، على كشف صورته الخاصة به» وكشف هذه الصورة، أمر معقد، وهو يغدو، في الرواية، أشد تعقيداً، والطابع المعقد للفعل هو، حسب كونديرا، أحد اكتشافات الرواية الكبرى وهذه الرواية هي كتاب الحياة المفتوح، وعلى الروائي ان يجيد فن الحذف، ثم يجيد فن التكثيف، والإنسان يتميز بالعقل، ليصير فنياً، فرداً يتميز عن الأفراد الآخرين.
ان تميز هذا الفرد، عن الآخر وعن الحيوان، ليس سهلاً، لأنه يتطلب ادراكاً في الفروق، وفي كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، رؤية غير مسبوقة في هذا المجال، إذ يقول: «ان اخلاق الحيوان الكثيرة مؤتلفة في نوع الإنسان، ذلك ان الإنسان صفو الجنس الذي هو الحيوان، والحيوان كدر النوع الذي هو الإنسان، وهكذا نرى في بعض الحيوان صفات نجدها في الإنسان، ونرى في بعض الإنسان غدر الذئب، وفي بعضهم ندامة الحمار، وفي بعضهم صبر الجمل، وفي بعضهم وداعة الحمل، وفي بعضهم حرارة الثور، وفي بعضهم استكانة الدجاجة، وفي بعضهم احتمال البغل».
إذن على الروائي أن يعرف طبائع الإنسان، وطبائع الحيوان، وطبائع البشر، والبيئة، والمجتمع، والمدن، والأرياف، قبل ان يتصدى لكتابة الرواية التي هي معقدة، وتصور حياة أكثر تعقيداً، ولأنني لا أعرف دمشق كل هذه المعرفة، فإنني لم اكتب عنها بعد، وكل ما فعلته هو رسم أولي بالقلم، بعنوان: هل تعرف دمشق يا سيدي؟ سأتكلم عليه لاحقاً.
يقال ان المجتمع الدمشقي كتيم، وانه منغلق على نفسه، لا سبيل لمن هو غريب عنه، ان يخترق أسوار كتامته، وقد افلحت، أنا الدخيل عليه، ان اخترق هذه الأسوار، ان اتعرف على المجتمع الدمشقي من الداخل، ان أفهم العقلية الدمشقية ظاهراً وباطناً، ان اعيش بيئته وما فيها من أسرار، ان أطوّف في احيائه القديمة، وامشي متمهلاً، متأنياً، ملاحظاً، مراقباً ما في ازقته وزواريبه من بشر وحجر، ان اجلس في مقاهيه، واتحدث مع من فيها من رواد، وحتى مقهى النافورة الشهير، الواقع خلف الجامع الأموي، زرته، قضيت الساعات فيه، شربت ناركيلته كثيراً، صار لي مع أصحابه، مع جلسائه، أحاديث، ورغم ذلك لم اكتب عنه رواية، فقد استعصى علي الأمر، وادركت، بعد طول تفكير، ان معرفة المدن شيء، وكتابة رواية عن هذه المدينة أو تلك، شيء آخر.
إن بعض زملائي الروائيين، من الغرباء عن دمشق، الوافدين إليها للدراسة أو الإقامة، كتبوا روايات مقبولة من وجهة نظرهم، غير مستساغة من وجهة نظري، لأنها تتناول حيوات الطلاب الجامعيين، الذين يعيشون على هامش هذه العاصمة، دون ان تمس قاعها الاجتماعي، ودون ان نستطيع القول: اننا نعرف دمشق من خلالها، أو اننا نزداد معرفة بها، من خلال هذه الرواية أو تلك، لأن حياة الجامعة ليست حياة المدينة، ولن تكون في يوم من الأيام.
هل هذا لأني بحري الهوى؟ وهل هذا لأنني عرفت البحر، ومدن البحر، أكثر مما عرفت دمشق، والمدن الداخلية في وطني سورية؟ ولماذا، ذات يوم، كانت لي، وبعمق هذه الأمنية: ان تنتقل دمشق إلى البحر، أو ينتقل البحر إلى دمشق!؟ وكيف يطاوع قلمي وأنا في اللاذقية، ويحرن وانا في دمشق؟ وهل لنسمة البحر، أو جرعة الرطوبة التي تنعشني جسداً وروحاً وأنا على جوار الساحل، كما يقول أصحابي، علاقة في هذا الاستعصاء الروائي الدمشقي!؟
ظني ان الأمر غير ذلك، وانني، انا الذي لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية، لم أعرف الجامعة، بكلياتها المتعددة، المتنوعة، كي اكتب، كسواي، رواية عن قصص الحب التي تنشأ بين طلابها وطالباتها، وعن لقاءاتهم وسهراتهم وما يدور فيها من أحاديث ونجاوى، ومن ود وجفاء، أو زعل ورضا، أو ما تنتهي إليه علاقات الحب تلك من نهايات سعيدة، بالزواج، وبوضع الرأسين على وسادة واحدة!
المسألة، فيما انتهيت إليه، اعقد من ذلك، كونها تتعلق بالمزاج، أو بشيء غيره، فالأحداث الهاجعة في قاع الذاكرة، لا يكفي ان تستيقظ حتى نكتب عنها، وإلا لكانت التجارب التي تنبت منها الأحداث، كلها صالح لكتابة رواية ما، وهذا يجانف الأصول، فالحدث، حتى مع التجربة، يحتاج إلى تطوير، في السياق وفي نمو الشخصيات، وليس كل حدث يؤاتي بالسهولة التي نريد، مادامت ثمة خشية في الوقوع، مهما احترزنا، في مطب الافتعال، وتالياً في القسر على جعل الخط الرئيسي للرواية، وكذلك الخطوط الثانوية، التي تخدم هذا الخط، فعل إرادة الروائي، لا فعل المنطق الداخلي للرواية، وآليتها الصحيحة، المفضية إلى التكّون الطبيعي لجنين الحدث، وما يتبع ذلك في استواء هذا الجنين قواماً روائياً متكاملاً، صادقاً في تكامله.
بعضهم يقول، اعطني أي مشهد، وانا أجعل منه قصة، وقد كان تشيكوف، في معلميته القصصية البارعة، قادراً على ذلك، وكذلك كان يوسف ادريس، وكتاب القصة الشهيرون في العالم، من موباسان إلى سومرست موم، ومن عبدالله عبد إلى زكريا تامر، ويبقى هذا، في العطاء الفني، وقفاً على القصة وحدها، أما الرواية فإنها تختلف، لأن القصة بنت اللقطة المفردة، والرواية بنت التجربة العريضة، الكافية لخلق حياة متكاملة، ذات أعماق وأبعاد قادرة على ان تجعل هذه الحياة حقيقية، نعيشها بكل جوارحنا، وتبقى في كينونتها، فاعلة في نفس القارئ، حاملة إليه، مع المتعة والفائدة، جوانب مجهولة، يكتشفها في تطور الحدث، وفي استواء شخصياته استواء نستطيع معه أن نقول: نعم انا أعرف هذه الشخصيات، المتخطية محليتها، بيئتها، إلى انسانيتها الشاملة.
يقول ميلان كونديرا حول البناء الروائي: «الرواية هي كتاب الحياة، وروحها هي روح الاستمرار» ويقول الناقد الروائي لا يونغ تريك: «ان الرواية بحث مستمر، وميدان بحثها العالم الاجتماعي، ومادة بحثها، أو تحليلها هي عادات الناس التي تتخذ دليلاً على الاتجاه الذي تسير فيه نفس الإنسان، ويقول دافتي: «يقوم القصد الأول للفاعل، في كل فعل يمارسه، على كشف صورته الخاصة به» وكشف هذه الصورة، أمر معقد، وهو يغدو، في الرواية، أشد تعقيداً، والطابع المعقد للفعل هو، حسب كونديرا، أحد اكتشافات الرواية الكبرى وهذه الرواية هي كتاب الحياة المفتوح، وعلى الروائي ان يجيد فن الحذف، ثم يجيد فن التكثيف، والإنسان يتميز بالعقل، ليصير فنياً، فرداً يتميز عن الأفراد الآخرين.
ان تميز هذا الفرد، عن الآخر وعن الحيوان، ليس سهلاً، لأنه يتطلب ادراكاً في الفروق، وفي كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، رؤية غير مسبوقة في هذا المجال، إذ يقول: «ان اخلاق الحيوان الكثيرة مؤتلفة في نوع الإنسان، ذلك ان الإنسان صفو الجنس الذي هو الحيوان، والحيوان كدر النوع الذي هو الإنسان، وهكذا نرى في بعض الحيوان صفات نجدها في الإنسان، ونرى في بعض الإنسان غدر الذئب، وفي بعضهم ندامة الحمار، وفي بعضهم صبر الجمل، وفي بعضهم وداعة الحمل، وفي بعضهم حرارة الثور، وفي بعضهم استكانة الدجاجة، وفي بعضهم احتمال البغل».
إذن على الروائي أن يعرف طبائع الإنسان، وطبائع الحيوان، وطبائع البشر، والبيئة، والمجتمع، والمدن، والأرياف، قبل ان يتصدى لكتابة الرواية التي هي معقدة، وتصور حياة أكثر تعقيداً، ولأنني لا أعرف دمشق كل هذه المعرفة، فإنني لم اكتب عنها بعد، وكل ما فعلته هو رسم أولي بالقلم، بعنوان: هل تعرف دمشق يا سيدي؟ سأتكلم عليه لاحقاً.