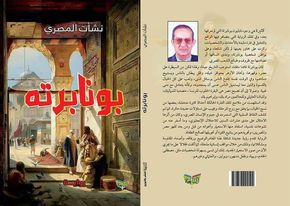تجترح القصيدة المغربية منذ منتصف الستينيات هويتها الشعرية، من خلال التضايف العميق مع كل الشعريات العربية والغربية، ما حتّم على الشاعر المغربي نَحْتَ صوته الإبداعي على مستوى النص الشعري، إذ بدأت التجارب الشعرية المغربية تنفرد بخصوصية إبداعية مغايرة للموجود في الشعرية العربية، ولعلَّ في هذا دعوة أصيلة إلى الإنصات للذات التي تجدّد أساليبها التعبيرية ورؤاها الشعرية للعالم الشيء، ممّا ميّزها بجماليات تمثلت في الاحتفاء بالخط الكاليغرافي، خصوصا في تجارب كل من عبد الله راجع وأحمد بلبداوي ومحمد بنيس، ما أثرى المشهد الشعري العربي، وأيضا بالجِدَّة والإبداع، لتستمر القصيدة المغربية في شقِّ طريق التَّجديد لتجاوز المنجز الشعري، وقد تجلّى ذلك في السبعينيات والثمانينيات التي امتازت بشعرية مختلفة، ليكتمل بهاؤها الخَلقي، مع التسعينيات خالقة نصِّية كسّرت القائم في الشعرية العربية .
والشاعر محمد بشكار من التجارب الشعرية التي تعبّر عن هذا الاختلاف؛ في كتابة نص شعري منبثق من حرارة التجربة الحارقة، والأسئلة المقلقة، والمرجعيات المعرفية المتنوعة، حيث يتميز نصه الشعري بالتجاور الشعري، أي بالارتباط بشعرية الإيقاع المتخلّق من رحم شعر التفعيلة، وبالحفر في أرض الشعر الرحبة الجغرافيات والمنعرجات. وهي تجربة تزاوج بين المعرفة الفكرية والعاطفية، بين الواقعية المدثّرة بالخيال الجانح صوب المجهول، ويتّصف الخطاب الشعري عنده بالحاضن والمتعالق مع التجارب الصوفية والنص القرآني والشعريات الأخرى، كل هذا شحن التجربة بطاقات إبداعية زادت من شعريته. من هنا نحاول، قدر الممكن، أن نفتح حوارا منصتا لتربته الشعرية المكلّلة بديوانين راسخين في الشعر المغربي، يتعلق الأمر بـ«ملائكة في مصحات الجحيم» و«خبط طير».
لا غرو في كون تجربة الشاعر تستلهم وجودها الشعري؛ من رحم الاحتراق في تنّور الحق، للصعود عموديا صوب الدواخل الدفينة المتّقدة بأسئلة العلاقة المنسوجة بين الذات الشاعرة والوجود، هذه الرابطة المُترمّدة والمُسْهدَة والمُتهجِّدة في الملكوت الْحَلَّاجِيِّ، كعربون محبة للحقيقة المبحوث عنها من لدن الكائن، فملفوظ الحق هو استحضار لتاريخ الإشراق المتلبّس للذات المُكتويّة بنار المصائب المتوالية على جسد منذور للشكوك والالتباسات، ويؤكد هذا أن الخطاب الشعري خطاب مفتوح على الألم والمكابدة الوجوديين يقول:
(«أنا الحق» قال الذي حلجته المنايا
على نول جرحي، سجّادة للصّلاة
وقال:
ازفري من دواخلك السندسية
نار البلايا)
فالتجربة الشعرية ذات منحى تأمّلي وجداني عاطفي، تنهل من تجربة المكابدة الحلّاجية (نسبة إلى الحلاج) كعربون على تلاقح وتواشج الذات الشاعرة مع عذابات ومعاناة الصوفي في عالم مُتْرَعٍ بالمصائب والمحن والإحن، ومطوّق بحرائق هذه السُّلَميّة التحولية – إن صح القول – من حالة رمادية إلى حالة سُهْدية وصولا إلى الحالة التَّهجُّدية، وهي حالات تكشف حقيقة النزيف الروحي الصادح بالزفير، كإحالة ضمنية على التصدّعات الداخلية التي تحْيَاها الذات، التي تتخذ الذات صفات ونعوتات ناضحة بالإيحاء والترميز، في عوالم متخيّلة ما دامت الكتابة الشعرية تنحو منحى استعاريا متحوّل الدلالة. فالشعر القادر على ولوج حقول بكر بدون أن يفقد صفاته المتعارف عليها – كما تقول سلمى الجيوسي – شعر يقودك إلى أراضي الجمال والدهشة والانغماس في وجود شعري مُتخلّق من حرارة التجربة، فالتيه والضياع والقلق المضاعف ثيمات منحوتة بإزميل البوح الباطني، حيث البهاء الروحي سيّد الصحو التعبيري بإلماعة تسمو إلى سماوات قريبة من لسان اللهب الكوني يقول:
(فأنت المجين الذي اخترمته وحوش النبوءات
كهفاً لقدّاسها،
يا حبيبي الرخيّ
كثدي اشْتهتْه السحابات منزىً
وجيعا لأدمع أنوائها،
يتموَّجْن بالشَّجو في كبدي
كيف تُجَنُّ؟)
إن الذات تكتب سيرة العذابات بلغة نازفة بحرقة الدواخل، حيث الشجى والجنون سمات معجمية تعبّر عن حجم هذا الهول المتأجّج بسؤال الكينونة في مملكة الصمت، فالريح حمّالة أوجه دلالية غير أنها هنا تحيل إلى المخاتلة والغدر، الشيء الذي وَسِمَ التجربة بسمة التناسخ الروحي بين الذات والآخر يقول:
(صوتكِ الرّيحُ تأتي
مسنّنة !
مثل أغنية من أنين الرّماح: تُخاتِل
بالطعنة البكر في الزهر من أين تأتي
ومملكة الصمت سدّت منافذها السبع بالسيف، سدّت
في الناي أعينه السود كي لا يرى
فوق أوردة الريح، جسمي المعلق في نبضها المطري الرَّقيص على وتر الموت)
بين الصوت والريح مسافة ألم وأنين، طعنات وصمت، حنين وموت إنها كتلة لغوية ضاجّة بهذا الاغتراب الوجودي لذات مصيرها الفرار نحو الأعالي حيث المرأة الملاذ الأسمى المطهّر من دناسة الأرض المتسعة فيافي أي الناطقة بلغة التيه والضياع .والخطاب الشعري قِوامُه التفاعل الوجداني المنصهر في بوتقة الربابة، كترميز على تماهي الذات مع العالم العلوي في تعالق حميم، إذ تغدو مُنْوجِدة في حالة الكشف باحثة عن الكينونة المتحوّلة إلى جسد واحد لإضاءة غابة الروح، إنها تجربة منبثقة من الداخل ترسم ملامح عوالم زاخرة بهذا التّوحّد، كما يشكل رؤية الشاعر للأشياء المحيطة به التي تبقى في حكم الظاهر الفاني، غير مستجيبة لرغبة الذات المبحرة في ملكوت الباطن، ومن هنا نشعر بتلك الرغبة الجموح لها لارتياد الآفاق القصيّة يقول:
(كأنّي المدى
يتنزّه في مقل أبيضّ
في كحلها أرق الموت مثل ثريّا الخريف…
فما عدتُ من وردة فخّخت قلبها
بشراك الشذى
ولا عدتُ من كيف.. أين.. وماذا)
تشكّل اللاعوْدة معادلا موضوعيا يوضّح علاقة الذات بالوجود الكامنة في المنحى التَّساؤلي المُفْصِح عن الحيرة المتملِكة للذات جراء الخواء، غير أن الفناء مع الكون وسيلة للعودة إلى البدايات الأولى يقول:
أنا الكون عدت إلى أجلي الأزلي)
فالذات تَتَكَوْنَنُ (من الكون) لتجسِّد حقيقة هذا الامتداد الوجودي الرَّحْب لموجود مدرِك مُروقَه عن ملائكية اللغة، الذاهب صوب التُّخوم البعيدة للإقامة في محراب النبوءات، وهو الرائي المستبصر الكاشف عن الجانب الحيواني المتواري في كهوف ذات فانية، لكنها تحقق ديمومتها بالفناء والتوحّد يقول:
(ملاك
ولستُ لغير الجحيم أؤولُ
ولستُ بصلصال آدم معجون. كلّي كهوف
وكل محابر هذي النبؤات تسكب فيّ
وأعرف أن بأغواري الجسدية
وحش بعينيه جمر التربّص)
إن اللغة الشعرية، في هذه التجربة، لغة تنضح بالإشارات والرموز تَبْصُمُ الخطاب الشعري بروح التفجير اللغوي – إن صح القول – نظرا لما تحمله من حمولات دلالية ثرية الأبعاد وغنية بالحفر العميق في الأعماق؛ للكشف عن المخفي في الدواخل الملتاعة بالعشق والصبابة الغارقة في الشطحات والصبوات، كل هذا زاد من لوعة الذات وفيوضاتها لمعانقة هذه الشساعة العرائية يقول:
(وأنا كل هذي العراءات مهما
اشتهتك الفصول…..
أنا الظل
والظل ذاكرة الشمس
أنا الميت
والميت كان نواة لثمرة قبره
في شجرات الفناء)
هنا اللغة تفجّر المقول الشعري؛ ليتخذ معاني تصبّ كلّها في نهر المكابدة الوجودية، فالذات تتحوّل إلى العراء والظل والموت، كإشارات على المجابهة الظاهرة وتجاوزها لقَوْلِ الباطن المتواري خلف حجب الضلوع والجوانح والجوارح، من هنا تتخلّق لغة شعرية مجازية انزياحية ترتوي من أساليب مقوّضة للمسكوك البلاغي، وهذا ما يعكسه المستوى المعجمي الصادح بهذه اللغة الاستعارية (أغاصن زيتونة، خلوة أزل، سموق السراب، الأناشيد تنشج، شراك الشذى، قبر الخواء، جمر التربص بلد هارب في الطفولة أفشت الريح، سلاف الزمان، نعش ذراعي) التي منحت للخطاب الشعري رمزية مشحونة برؤية منبثقة من رؤية محتدُها ابتداع لغة جديرة بالحياة. لغة تتلبّس الإشارات والرموز لتضيء «ليل المعنى» ويزول الإبهام واللُّبْس على المستوى الدلالي. فالنسق اللغوي نسق مرتبط بتجسيد الرؤية الشعرية المنبنية على الحلم كمقوم من مقومات جمالية اللغة الشعرية، فالشاعر يختار الغوص في اللغة لشحنها شحنات غنية بقيم جمالية ودلالية تنحو منحى إبداليا سمته التفجير والخرق والانزياح، وأيضا لتعكس رغبة الذات الشاعرة في الكشف عن العشق المفضي إلى الحلول مع المرأة الحبيبة، معبّرا عنه بصور شعرية غنية في تشكيلها المُربِك والمدهش للعين والقلب، فالمرأة المتمثلة في حوّاء لم يجن من شجرتها الشاعر غير عذابات الأرض، لكنها تبقى الكيان الذي بدونه لا تستقيم به الحياة يقول:
(أقوم
وبين يدي
من ضفائرها
غابة أتسلّق نيران
شهوتها)
فالنار عربون دليل على الاحتراق الأبدي، ووسيلة تطهيرية لكينونة تكابد اغترابها الوجودي، إن اللغة لغة وجدانية مقامية، بتعبير آخر لغة المواجد، تحيل إلى ما تستعذبه الذات من مشاق للعناق الروحي مع الأنثى كمصدر لوجود الموجود، من هذا الميسم نستطيع القول إن ثيمة الرغبات الفطرية هي الحاضرة والمهيمنة في المتن الشعري للشاعر يقول:
(أتذوّق من تحت أنهدها، لذّة الوأد: تنفذُ
فيَّ وأنفذ فيها، كما الخيط في سم إبرة دون سلطان)
هكذا تستعير الذات الشهوة كوسيلة من وسائل الحلول والتوالج مع الآخر/الأنثى، وفي هذا دعوة مبطّنة تكمن في كون الأنثى المعادل الوجودي للشاعر، هذا الأخير المتشرّد التّائه، المثقل بأسئلة لاهبة ومضنية تقود الذات إلى المغامرة في عالم كله صحراء وحضارة تلفظ الإنسان إلى الإقامة في الحنين الآسر يقول:
(صحراء
كل السرّة
تنهض أجفانها
بنشيد الجنائز
كل المدائن تنفضني
أنجماً
من نعال السماء)
من نافلة القول إن التجربة الشعرية لدى الشاعر ذات منحى صوفي، جعل الخطاب الشعري يخلق استعاراته المنزاحة عن المألوف، مستمّدة وجودها من لغة المكابدة والاحتراق والحلم كمقَوّم من مقومات جماليته المنتصرة للرؤية الباطنية.
٭ شاعر من المغرب

والشاعر محمد بشكار من التجارب الشعرية التي تعبّر عن هذا الاختلاف؛ في كتابة نص شعري منبثق من حرارة التجربة الحارقة، والأسئلة المقلقة، والمرجعيات المعرفية المتنوعة، حيث يتميز نصه الشعري بالتجاور الشعري، أي بالارتباط بشعرية الإيقاع المتخلّق من رحم شعر التفعيلة، وبالحفر في أرض الشعر الرحبة الجغرافيات والمنعرجات. وهي تجربة تزاوج بين المعرفة الفكرية والعاطفية، بين الواقعية المدثّرة بالخيال الجانح صوب المجهول، ويتّصف الخطاب الشعري عنده بالحاضن والمتعالق مع التجارب الصوفية والنص القرآني والشعريات الأخرى، كل هذا شحن التجربة بطاقات إبداعية زادت من شعريته. من هنا نحاول، قدر الممكن، أن نفتح حوارا منصتا لتربته الشعرية المكلّلة بديوانين راسخين في الشعر المغربي، يتعلق الأمر بـ«ملائكة في مصحات الجحيم» و«خبط طير».
لا غرو في كون تجربة الشاعر تستلهم وجودها الشعري؛ من رحم الاحتراق في تنّور الحق، للصعود عموديا صوب الدواخل الدفينة المتّقدة بأسئلة العلاقة المنسوجة بين الذات الشاعرة والوجود، هذه الرابطة المُترمّدة والمُسْهدَة والمُتهجِّدة في الملكوت الْحَلَّاجِيِّ، كعربون محبة للحقيقة المبحوث عنها من لدن الكائن، فملفوظ الحق هو استحضار لتاريخ الإشراق المتلبّس للذات المُكتويّة بنار المصائب المتوالية على جسد منذور للشكوك والالتباسات، ويؤكد هذا أن الخطاب الشعري خطاب مفتوح على الألم والمكابدة الوجوديين يقول:
(«أنا الحق» قال الذي حلجته المنايا
على نول جرحي، سجّادة للصّلاة
وقال:
ازفري من دواخلك السندسية
نار البلايا)
فالتجربة الشعرية ذات منحى تأمّلي وجداني عاطفي، تنهل من تجربة المكابدة الحلّاجية (نسبة إلى الحلاج) كعربون على تلاقح وتواشج الذات الشاعرة مع عذابات ومعاناة الصوفي في عالم مُتْرَعٍ بالمصائب والمحن والإحن، ومطوّق بحرائق هذه السُّلَميّة التحولية – إن صح القول – من حالة رمادية إلى حالة سُهْدية وصولا إلى الحالة التَّهجُّدية، وهي حالات تكشف حقيقة النزيف الروحي الصادح بالزفير، كإحالة ضمنية على التصدّعات الداخلية التي تحْيَاها الذات، التي تتخذ الذات صفات ونعوتات ناضحة بالإيحاء والترميز، في عوالم متخيّلة ما دامت الكتابة الشعرية تنحو منحى استعاريا متحوّل الدلالة. فالشعر القادر على ولوج حقول بكر بدون أن يفقد صفاته المتعارف عليها – كما تقول سلمى الجيوسي – شعر يقودك إلى أراضي الجمال والدهشة والانغماس في وجود شعري مُتخلّق من حرارة التجربة، فالتيه والضياع والقلق المضاعف ثيمات منحوتة بإزميل البوح الباطني، حيث البهاء الروحي سيّد الصحو التعبيري بإلماعة تسمو إلى سماوات قريبة من لسان اللهب الكوني يقول:
(فأنت المجين الذي اخترمته وحوش النبوءات
كهفاً لقدّاسها،
يا حبيبي الرخيّ
كثدي اشْتهتْه السحابات منزىً
وجيعا لأدمع أنوائها،
يتموَّجْن بالشَّجو في كبدي
كيف تُجَنُّ؟)
إن الذات تكتب سيرة العذابات بلغة نازفة بحرقة الدواخل، حيث الشجى والجنون سمات معجمية تعبّر عن حجم هذا الهول المتأجّج بسؤال الكينونة في مملكة الصمت، فالريح حمّالة أوجه دلالية غير أنها هنا تحيل إلى المخاتلة والغدر، الشيء الذي وَسِمَ التجربة بسمة التناسخ الروحي بين الذات والآخر يقول:
(صوتكِ الرّيحُ تأتي
مسنّنة !
مثل أغنية من أنين الرّماح: تُخاتِل
بالطعنة البكر في الزهر من أين تأتي
ومملكة الصمت سدّت منافذها السبع بالسيف، سدّت
في الناي أعينه السود كي لا يرى
فوق أوردة الريح، جسمي المعلق في نبضها المطري الرَّقيص على وتر الموت)
بين الصوت والريح مسافة ألم وأنين، طعنات وصمت، حنين وموت إنها كتلة لغوية ضاجّة بهذا الاغتراب الوجودي لذات مصيرها الفرار نحو الأعالي حيث المرأة الملاذ الأسمى المطهّر من دناسة الأرض المتسعة فيافي أي الناطقة بلغة التيه والضياع .والخطاب الشعري قِوامُه التفاعل الوجداني المنصهر في بوتقة الربابة، كترميز على تماهي الذات مع العالم العلوي في تعالق حميم، إذ تغدو مُنْوجِدة في حالة الكشف باحثة عن الكينونة المتحوّلة إلى جسد واحد لإضاءة غابة الروح، إنها تجربة منبثقة من الداخل ترسم ملامح عوالم زاخرة بهذا التّوحّد، كما يشكل رؤية الشاعر للأشياء المحيطة به التي تبقى في حكم الظاهر الفاني، غير مستجيبة لرغبة الذات المبحرة في ملكوت الباطن، ومن هنا نشعر بتلك الرغبة الجموح لها لارتياد الآفاق القصيّة يقول:
(كأنّي المدى
يتنزّه في مقل أبيضّ
في كحلها أرق الموت مثل ثريّا الخريف…
فما عدتُ من وردة فخّخت قلبها
بشراك الشذى
ولا عدتُ من كيف.. أين.. وماذا)
تشكّل اللاعوْدة معادلا موضوعيا يوضّح علاقة الذات بالوجود الكامنة في المنحى التَّساؤلي المُفْصِح عن الحيرة المتملِكة للذات جراء الخواء، غير أن الفناء مع الكون وسيلة للعودة إلى البدايات الأولى يقول:
أنا الكون عدت إلى أجلي الأزلي)
فالذات تَتَكَوْنَنُ (من الكون) لتجسِّد حقيقة هذا الامتداد الوجودي الرَّحْب لموجود مدرِك مُروقَه عن ملائكية اللغة، الذاهب صوب التُّخوم البعيدة للإقامة في محراب النبوءات، وهو الرائي المستبصر الكاشف عن الجانب الحيواني المتواري في كهوف ذات فانية، لكنها تحقق ديمومتها بالفناء والتوحّد يقول:
(ملاك
ولستُ لغير الجحيم أؤولُ
ولستُ بصلصال آدم معجون. كلّي كهوف
وكل محابر هذي النبؤات تسكب فيّ
وأعرف أن بأغواري الجسدية
وحش بعينيه جمر التربّص)
إن اللغة الشعرية، في هذه التجربة، لغة تنضح بالإشارات والرموز تَبْصُمُ الخطاب الشعري بروح التفجير اللغوي – إن صح القول – نظرا لما تحمله من حمولات دلالية ثرية الأبعاد وغنية بالحفر العميق في الأعماق؛ للكشف عن المخفي في الدواخل الملتاعة بالعشق والصبابة الغارقة في الشطحات والصبوات، كل هذا زاد من لوعة الذات وفيوضاتها لمعانقة هذه الشساعة العرائية يقول:
(وأنا كل هذي العراءات مهما
اشتهتك الفصول…..
أنا الظل
والظل ذاكرة الشمس
أنا الميت
والميت كان نواة لثمرة قبره
في شجرات الفناء)
هنا اللغة تفجّر المقول الشعري؛ ليتخذ معاني تصبّ كلّها في نهر المكابدة الوجودية، فالذات تتحوّل إلى العراء والظل والموت، كإشارات على المجابهة الظاهرة وتجاوزها لقَوْلِ الباطن المتواري خلف حجب الضلوع والجوانح والجوارح، من هنا تتخلّق لغة شعرية مجازية انزياحية ترتوي من أساليب مقوّضة للمسكوك البلاغي، وهذا ما يعكسه المستوى المعجمي الصادح بهذه اللغة الاستعارية (أغاصن زيتونة، خلوة أزل، سموق السراب، الأناشيد تنشج، شراك الشذى، قبر الخواء، جمر التربص بلد هارب في الطفولة أفشت الريح، سلاف الزمان، نعش ذراعي) التي منحت للخطاب الشعري رمزية مشحونة برؤية منبثقة من رؤية محتدُها ابتداع لغة جديرة بالحياة. لغة تتلبّس الإشارات والرموز لتضيء «ليل المعنى» ويزول الإبهام واللُّبْس على المستوى الدلالي. فالنسق اللغوي نسق مرتبط بتجسيد الرؤية الشعرية المنبنية على الحلم كمقوم من مقومات جمالية اللغة الشعرية، فالشاعر يختار الغوص في اللغة لشحنها شحنات غنية بقيم جمالية ودلالية تنحو منحى إبداليا سمته التفجير والخرق والانزياح، وأيضا لتعكس رغبة الذات الشاعرة في الكشف عن العشق المفضي إلى الحلول مع المرأة الحبيبة، معبّرا عنه بصور شعرية غنية في تشكيلها المُربِك والمدهش للعين والقلب، فالمرأة المتمثلة في حوّاء لم يجن من شجرتها الشاعر غير عذابات الأرض، لكنها تبقى الكيان الذي بدونه لا تستقيم به الحياة يقول:
(أقوم
وبين يدي
من ضفائرها
غابة أتسلّق نيران
شهوتها)
فالنار عربون دليل على الاحتراق الأبدي، ووسيلة تطهيرية لكينونة تكابد اغترابها الوجودي، إن اللغة لغة وجدانية مقامية، بتعبير آخر لغة المواجد، تحيل إلى ما تستعذبه الذات من مشاق للعناق الروحي مع الأنثى كمصدر لوجود الموجود، من هذا الميسم نستطيع القول إن ثيمة الرغبات الفطرية هي الحاضرة والمهيمنة في المتن الشعري للشاعر يقول:
(أتذوّق من تحت أنهدها، لذّة الوأد: تنفذُ
فيَّ وأنفذ فيها، كما الخيط في سم إبرة دون سلطان)
هكذا تستعير الذات الشهوة كوسيلة من وسائل الحلول والتوالج مع الآخر/الأنثى، وفي هذا دعوة مبطّنة تكمن في كون الأنثى المعادل الوجودي للشاعر، هذا الأخير المتشرّد التّائه، المثقل بأسئلة لاهبة ومضنية تقود الذات إلى المغامرة في عالم كله صحراء وحضارة تلفظ الإنسان إلى الإقامة في الحنين الآسر يقول:
(صحراء
كل السرّة
تنهض أجفانها
بنشيد الجنائز
كل المدائن تنفضني
أنجماً
من نعال السماء)
من نافلة القول إن التجربة الشعرية لدى الشاعر ذات منحى صوفي، جعل الخطاب الشعري يخلق استعاراته المنزاحة عن المألوف، مستمّدة وجودها من لغة المكابدة والاحتراق والحلم كمقَوّم من مقومات جماليته المنتصرة للرؤية الباطنية.
٭ شاعر من المغرب

شعرية القصيدة المغربية… قراءة في تجربة محمد بشكار | صالح لبريني
تجترح القصيدة المغربية منذ منتصف الستينيات هويتها الشعرية، من خلال التضايف العميق مع كل الشعريات العربية والغربية، ما حتّم على الشاعر المغربي نَحْتَ صوته الإبداعي على مستوى النص الشعري، إذ بدأت التجار
www.alquds.co.uk