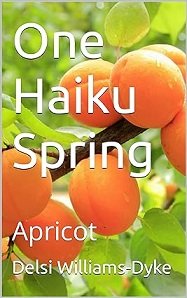لأغنيات الشّيخ إمام، في وعي أبناء جيلنا، وتحديدًا لمن عاش تجربة شبابه مشدودًا إلى اليسار، بتأجّجه ورومانسيّته وأحلامه الكثيرة المُجهضة، ركنٌ حميم يقبع في الوجدان.
ومحظوظ من قادته المصادفة آنذاك، أو الامكانيّة، إلى "حوش قدم" في "سيدنا الحسين" بالقاهرة، ليُعمِّد يساريّته بتلك الزّيارة، حيث يقع هناك ذلك البيت الواسع رغم ضيقه، والذي يتّسع حقيقةً لمئة صديق. بيتٌ متقشِّف، مفتوح للبشر وشتّى الفنون. فقد ظلّ يفيض موسيقى وشعرًا وألوانًا، وكان يقيم فيه "الشّيخ إمام" و"أحمد فؤاد نجم"، ومعهما فنان تشكيلي تلقائي كان اسمه "محمد علي".
كانت الأشعار والأغنيات التي تنهض على خطابٍ تحريضيّ لا يتجنّب المباشرة، في أحيان كثيرة، تمتلك من الجاذبيّة النّضالية، وقوّة العنصر الكاريكاتيري السّاخر فيها، ما يجعلها مطلوبة من جمهور "مولانا" الذي يتردّد على المكان من شتّى البِقاع العربيّة، حيث يستفيض الأخير في هجاء "نيكسون بابا بتاع الووتر غيت"، والرئيس الفرنسي الأسبق "فاليري جيسكار ديستان.. والسِّت بتاعه كمان"، الذي ستملأ "العربيّات" بزيارته لمصر، خزاناتها.. "بدل البنزين بارفان"!؟
غير ان الشّيخ إمام، كان يعود من تحريضه الذي لا يملّ من التّحريض، وسخريته الكامنة في اللّفظة واللّحن والأداء، إلى أغنياتٍ تسكن الأركان الأكثر حميميّة في روحه، والتي غنّاها الفنان بِرِهانٍ على أنّها هي التي ستبقى للزّمان، فيسعدني ويؤجِّج مشاعري عندما يُغني أغنيته الاسكندرانيّة "حلّوا المراكب مع المغرب وفاتوني"، التي ما زالت تثير لديّ أشجانًا معتّقة، وافتقدتها في الألبوم الذي سنتحدّث عنه.
قدرة الشّيخ إمام على الامتداد والبقاء في الزّمان، تبقى أمرًا يحاكي المعجزات. فقد ظلّ ممنوعًا من الغناء في الاذاعات ومحطّات التلفزيون الرّسميّة، في زمن كان فيه الاعلام العربي برمّته.. رسميًا. ومع ذلك فقد استمرّ صوته واستمرّت ألحانه بعد رحيله، وتغلغلت في روح الشّباب الذي لم يعش زمن الشّيخ إمام، خاصّة لدى جيل ثورة يناير 2011 والذي حمل أحلام ربيع عربي، بغضّ النّظر عن مآلاته.
***
لا ينتمي "عبد الحليم أبو حلتم" عُمريًّا إلى الجيل الذي عايش إمام، ومع ذلك، فقد عايشه روحًا عبر محاولة استعادته.
في عمله الغنائي الذي كرّسه بكامله لاستعادة الشيخ إمام، يُطلق أبو حلتم غير عصفورٍ في ألبومٍ غنائيّ واحد.
فهو من جهة، وبلفتة فنيّة تنطوي على درجة كبيرة من الوفاء، يوجِّه تحيّة تقدير لفنان كبير عاش حياته وقدّم فنِّه بعيدًا عن تبنّي المؤسسة الاعلاميّة والثّقافية الرسميّة العربيّة، التي لم تكتفِ بتجاهله، بل انها حاربته بشراسة وفرضت عليه قرارًا سياسيًّا بالحظر، واكتفت بالنّطر إليه فقط عبر رؤيته في أغنيات سياسيّة ترثي "غيفارا" وتسخر من أميركا وأعوانها وتمجِّد فلسطين، من دون أن يمتلك سادة الحظر أدنى درجةٍ من الاحساس والوعي الفنّي، فينتبهوا إلى ما انتبه إليه المغني الشّاب الذي يُحيي ذكراه، ونعني القيمة الفنيّة السّماعية لعددٍ آخر لا يستهان به من أغنيات الشّيخ إمام، التي تنهض على درجةٍ كبيرة من الثّراء الإبداعيّ اللّافت.
من جهة ثانية، فقد حمل الفنان الشّاب عبء احياء أغنيات للشيخ إمام عاشت طويلاً في الظِّل. ولم يكتف بإعادة انتاجها بصوته الصّافي فحسب، وإنما قرَن ذلك باجتهادات توزيعيّة جديدة. وهو إذ يتقدّم باقتراحاته الفنيّة، فإنه يخطو بحذر ظلّ حريصًا على أن لا يخدش روح الأصل بمغامرات توزيعيّة غير مأمونة العواقب. وإذا ما أدخِلتْ على الأغنيّة مؤثِّرات صوتيّة، فإنها تكون في بداية الأغنية وقبل انطلاق الكلام، وتبقى رقيقة، سريعة، لا تُثقل اللّحن ولا تبدو مقحمة على الإيقاع. ففي "البحر بيضحك ليه" (كلمات نجيب سرور)، لا تستغرق أصوات طيور البحر أكثر من ثوانٍ معدودات. وفي "دولا مين ودولا مين".. ثوانٍ أخرى لأصواتٍ عشوائيّة وغامضة لبشرٍ في الزّحام. مؤثرات تهيء للدّخول الإيحائي إلى أجواء الأغنية الإماميّة من دون أن تثقلها أو تعتدي عليها.
وتستحق تجربة أغنية " أنا أتوب عن حبّك أنا"، التفاتة خاصّة في سياق حديثنا عن هذا الألبوم. حيث لا يكتفي الفنان الشّاب فيها باستعادة واحدة من أجمل وأرق أغنيات الشّيخ إمام وأكثرها ثراءً فنيًّا ووجدانيًّا، رغم أنّها من الأغنيات الأقل انتشارًا، وإنما ينحو إلى تقديمها بمغامرة جريئة، وبأسلوب يمكن أن نًطلق عليه "دويتو بالمونتاج"، حيث يتناوب صوت المغني الشّاب مع صوت الشّيخ إمام في تقديم الأغنية، من دون تردُّد من الأوّل أو خشية من أن تُفرض علينا المقارنة بين الصوتين.. صوت الشيخ إمام بقوّته وحدّته وتعدُّد طبقاته المنحدرة من التّجويد القرآني، وصوت عبد الحليم أبو حلتم، بهدوئه وصفائه وتواضعه الجمّ أمام أستاذه (والذي تبدّى في أفضل تجلّياته في أعنية "وهبت عمري للأمل"). لكن مشاركة صوت الشيخ إمام هنا لم تكن شكليّة فحسب، بل ومعرفيّة أيضًا، يتمّ اقتراحها بمستوى جمالي شديد الشّفافيّة والاقناع، خاصّة للجيل الذي جاء بعد زمن الشّيخ إمام، وفي ظِلّ زحامٍ عربيّ هائل من المرئي والمسموع مطروح بدرجات من الابتذال، بقي إمام طويلاً مقصيًّا عنه وغائبًا عن شاشاته وميكروفوناته. وقد ظَلّ صاحب الاقتراح حريصًا على عدم تكرار صوت الشّيخ إمام، إلاّ مرّة أخرى مختزلة، في جملة أخيرة حلّت في مكانها (أغنية "عيون الكلام")، في نهاية الألبوم، فبدت وكأنها تلويحة وداع.. في سياق تجربةٍ تستحق التّقدير.
***
في إحدى مرّات اعتقاله، طرح المحقِّق سؤالاً تقليديًّا بسيطًا على المغني الأعمى، الشيخ إمام عيسى: ماذا تشتغل؟
فأجاب الشّيخ الضّرير على الفور، وبسخريته المعهودة:
ـ ساعاتيّ!
ولأن المكفوفين لا يمكنهم أن يعملوا في مثل تلك المهنة، التي تحتاج إلى دقّة بصريّة عالية، فقد انفجر المحقق في ضحكٍ متواصل.
لو كان المُحقق يدرك أن عمل السّاعاتي، بالمعنى المجازي للكلمة، ليس في حاجة إلى البصر وإنما إلى البصيرة، لما ضحك، ولأدرك أن إصلاح الوقت والزّمان، ليسا في حاجة إلى شعاع العينين، بل إلى شعاع الذّهن والوجدان، وأن ما قاله الشّيخ إمام عن عمله لم يكن هزلاً، وإنما حقيقة.. وفي منتهى الجدّ!
من تطوّع لإيقاظ الشيخ إمام في ذاكرتنا (غفوته الأخيرة كانت في 7 حزيران/ يونيو 1995) ربما يُدرك في قرارة نفسه حقيقة السّاعاتي، أعمى البصر متيقِّظ البصيرة، الذي عاش عمره عاكفًا على تأمُّل النّبض الدّقيق لساعة زمانه ودقائق روحها، فانكبّ الشّاب ليُحيي نماذج غنائيّة من أجمل ما أبدعه شيخُ طريقتها في ذلك الزّمن الجميل، فلم يتوقّف عند استعادة ذكراه، بل أيقظ الوقت نفسه، ساعة زماننا، بكلّ تأجُّجها، وحنينها.. وأحلامها الغزيرة.
ومحظوظ من قادته المصادفة آنذاك، أو الامكانيّة، إلى "حوش قدم" في "سيدنا الحسين" بالقاهرة، ليُعمِّد يساريّته بتلك الزّيارة، حيث يقع هناك ذلك البيت الواسع رغم ضيقه، والذي يتّسع حقيقةً لمئة صديق. بيتٌ متقشِّف، مفتوح للبشر وشتّى الفنون. فقد ظلّ يفيض موسيقى وشعرًا وألوانًا، وكان يقيم فيه "الشّيخ إمام" و"أحمد فؤاد نجم"، ومعهما فنان تشكيلي تلقائي كان اسمه "محمد علي".
كانت الأشعار والأغنيات التي تنهض على خطابٍ تحريضيّ لا يتجنّب المباشرة، في أحيان كثيرة، تمتلك من الجاذبيّة النّضالية، وقوّة العنصر الكاريكاتيري السّاخر فيها، ما يجعلها مطلوبة من جمهور "مولانا" الذي يتردّد على المكان من شتّى البِقاع العربيّة، حيث يستفيض الأخير في هجاء "نيكسون بابا بتاع الووتر غيت"، والرئيس الفرنسي الأسبق "فاليري جيسكار ديستان.. والسِّت بتاعه كمان"، الذي ستملأ "العربيّات" بزيارته لمصر، خزاناتها.. "بدل البنزين بارفان"!؟
غير ان الشّيخ إمام، كان يعود من تحريضه الذي لا يملّ من التّحريض، وسخريته الكامنة في اللّفظة واللّحن والأداء، إلى أغنياتٍ تسكن الأركان الأكثر حميميّة في روحه، والتي غنّاها الفنان بِرِهانٍ على أنّها هي التي ستبقى للزّمان، فيسعدني ويؤجِّج مشاعري عندما يُغني أغنيته الاسكندرانيّة "حلّوا المراكب مع المغرب وفاتوني"، التي ما زالت تثير لديّ أشجانًا معتّقة، وافتقدتها في الألبوم الذي سنتحدّث عنه.
قدرة الشّيخ إمام على الامتداد والبقاء في الزّمان، تبقى أمرًا يحاكي المعجزات. فقد ظلّ ممنوعًا من الغناء في الاذاعات ومحطّات التلفزيون الرّسميّة، في زمن كان فيه الاعلام العربي برمّته.. رسميًا. ومع ذلك فقد استمرّ صوته واستمرّت ألحانه بعد رحيله، وتغلغلت في روح الشّباب الذي لم يعش زمن الشّيخ إمام، خاصّة لدى جيل ثورة يناير 2011 والذي حمل أحلام ربيع عربي، بغضّ النّظر عن مآلاته.
***
لا ينتمي "عبد الحليم أبو حلتم" عُمريًّا إلى الجيل الذي عايش إمام، ومع ذلك، فقد عايشه روحًا عبر محاولة استعادته.
في عمله الغنائي الذي كرّسه بكامله لاستعادة الشيخ إمام، يُطلق أبو حلتم غير عصفورٍ في ألبومٍ غنائيّ واحد.
فهو من جهة، وبلفتة فنيّة تنطوي على درجة كبيرة من الوفاء، يوجِّه تحيّة تقدير لفنان كبير عاش حياته وقدّم فنِّه بعيدًا عن تبنّي المؤسسة الاعلاميّة والثّقافية الرسميّة العربيّة، التي لم تكتفِ بتجاهله، بل انها حاربته بشراسة وفرضت عليه قرارًا سياسيًّا بالحظر، واكتفت بالنّطر إليه فقط عبر رؤيته في أغنيات سياسيّة ترثي "غيفارا" وتسخر من أميركا وأعوانها وتمجِّد فلسطين، من دون أن يمتلك سادة الحظر أدنى درجةٍ من الاحساس والوعي الفنّي، فينتبهوا إلى ما انتبه إليه المغني الشّاب الذي يُحيي ذكراه، ونعني القيمة الفنيّة السّماعية لعددٍ آخر لا يستهان به من أغنيات الشّيخ إمام، التي تنهض على درجةٍ كبيرة من الثّراء الإبداعيّ اللّافت.
من جهة ثانية، فقد حمل الفنان الشّاب عبء احياء أغنيات للشيخ إمام عاشت طويلاً في الظِّل. ولم يكتف بإعادة انتاجها بصوته الصّافي فحسب، وإنما قرَن ذلك باجتهادات توزيعيّة جديدة. وهو إذ يتقدّم باقتراحاته الفنيّة، فإنه يخطو بحذر ظلّ حريصًا على أن لا يخدش روح الأصل بمغامرات توزيعيّة غير مأمونة العواقب. وإذا ما أدخِلتْ على الأغنيّة مؤثِّرات صوتيّة، فإنها تكون في بداية الأغنية وقبل انطلاق الكلام، وتبقى رقيقة، سريعة، لا تُثقل اللّحن ولا تبدو مقحمة على الإيقاع. ففي "البحر بيضحك ليه" (كلمات نجيب سرور)، لا تستغرق أصوات طيور البحر أكثر من ثوانٍ معدودات. وفي "دولا مين ودولا مين".. ثوانٍ أخرى لأصواتٍ عشوائيّة وغامضة لبشرٍ في الزّحام. مؤثرات تهيء للدّخول الإيحائي إلى أجواء الأغنية الإماميّة من دون أن تثقلها أو تعتدي عليها.
وتستحق تجربة أغنية " أنا أتوب عن حبّك أنا"، التفاتة خاصّة في سياق حديثنا عن هذا الألبوم. حيث لا يكتفي الفنان الشّاب فيها باستعادة واحدة من أجمل وأرق أغنيات الشّيخ إمام وأكثرها ثراءً فنيًّا ووجدانيًّا، رغم أنّها من الأغنيات الأقل انتشارًا، وإنما ينحو إلى تقديمها بمغامرة جريئة، وبأسلوب يمكن أن نًطلق عليه "دويتو بالمونتاج"، حيث يتناوب صوت المغني الشّاب مع صوت الشّيخ إمام في تقديم الأغنية، من دون تردُّد من الأوّل أو خشية من أن تُفرض علينا المقارنة بين الصوتين.. صوت الشيخ إمام بقوّته وحدّته وتعدُّد طبقاته المنحدرة من التّجويد القرآني، وصوت عبد الحليم أبو حلتم، بهدوئه وصفائه وتواضعه الجمّ أمام أستاذه (والذي تبدّى في أفضل تجلّياته في أعنية "وهبت عمري للأمل"). لكن مشاركة صوت الشيخ إمام هنا لم تكن شكليّة فحسب، بل ومعرفيّة أيضًا، يتمّ اقتراحها بمستوى جمالي شديد الشّفافيّة والاقناع، خاصّة للجيل الذي جاء بعد زمن الشّيخ إمام، وفي ظِلّ زحامٍ عربيّ هائل من المرئي والمسموع مطروح بدرجات من الابتذال، بقي إمام طويلاً مقصيًّا عنه وغائبًا عن شاشاته وميكروفوناته. وقد ظَلّ صاحب الاقتراح حريصًا على عدم تكرار صوت الشّيخ إمام، إلاّ مرّة أخرى مختزلة، في جملة أخيرة حلّت في مكانها (أغنية "عيون الكلام")، في نهاية الألبوم، فبدت وكأنها تلويحة وداع.. في سياق تجربةٍ تستحق التّقدير.
***
في إحدى مرّات اعتقاله، طرح المحقِّق سؤالاً تقليديًّا بسيطًا على المغني الأعمى، الشيخ إمام عيسى: ماذا تشتغل؟
فأجاب الشّيخ الضّرير على الفور، وبسخريته المعهودة:
ـ ساعاتيّ!
ولأن المكفوفين لا يمكنهم أن يعملوا في مثل تلك المهنة، التي تحتاج إلى دقّة بصريّة عالية، فقد انفجر المحقق في ضحكٍ متواصل.
لو كان المُحقق يدرك أن عمل السّاعاتي، بالمعنى المجازي للكلمة، ليس في حاجة إلى البصر وإنما إلى البصيرة، لما ضحك، ولأدرك أن إصلاح الوقت والزّمان، ليسا في حاجة إلى شعاع العينين، بل إلى شعاع الذّهن والوجدان، وأن ما قاله الشّيخ إمام عن عمله لم يكن هزلاً، وإنما حقيقة.. وفي منتهى الجدّ!
من تطوّع لإيقاظ الشيخ إمام في ذاكرتنا (غفوته الأخيرة كانت في 7 حزيران/ يونيو 1995) ربما يُدرك في قرارة نفسه حقيقة السّاعاتي، أعمى البصر متيقِّظ البصيرة، الذي عاش عمره عاكفًا على تأمُّل النّبض الدّقيق لساعة زمانه ودقائق روحها، فانكبّ الشّاب ليُحيي نماذج غنائيّة من أجمل ما أبدعه شيخُ طريقتها في ذلك الزّمن الجميل، فلم يتوقّف عند استعادة ذكراه، بل أيقظ الوقت نفسه، ساعة زماننا، بكلّ تأجُّجها، وحنينها.. وأحلامها الغزيرة.