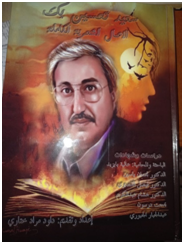" الخروج إلى الحمراء " هو آخر ديوان للمتوكل طه، وقد صدر (أيلول 2002) عن دار الزهراء / بيت الشعر في رام الله. وفيه يعاود الشاعر استلهام الرمز التاريخي، ويواصل ما خطه له من طريقة في كتابة الشـــعر، في ديوانه قبل الأخير " حليب أسود " ( القدس 1999 )، حيث استلهم في الأخير أيضاً الرموز التاريخية. في " الخروج إلى الحمراء " يستلهم المتوكل فترة غروب العرب في الأندلس، وتحديداً فترة سقوط غرناطة وتسليم مفاتيحها من أبي عبد الله الصغير، وفي " حليب أسود " يستلهم خلاف هارون الرشيد مع البرامكة، وليس هناك من شك في أن ثمة إسقاطات معاصرة على الأحداث التاريخية. وهنا يمكن أن نتساءل عن المغزى من وراء ما يقوم به الشاعر، وهنا يمكن أن نبحث عن المدلول الذي يقوله الدال، وليس هناك من شك في أن نصيْ الشاعر هذين، خلافاً لأكثر أشعار المتوكل السابقة، تحتمل تأويلات عديدة، تبدو أحياناً مربكة، وأحياناً خبيثة، يجد فيها المؤيد لما يجري والمعارض، ما يدعم رأيه، ويجد أيضاً فيها – إن أمعن النظر في النصوص – ما يعزز المقطع الشعري التالي الذي كتبه الشاعر، من قبل، وأبدى فيه رأيه في الشاعر:
" نبسط الشعر على ثلج الحكايا،
ونقل في سرّنا ما لم نقل في مشهد الريح
وأضواء المرايا ...
ولهذا، فلنا في فمنا حرف،
وحرف .. للسرايا ". ( ريح النار المقبلة، ص48 )
الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث:
وليس المتوكل طه أول شاعر فلسطيني يستلهم تاريخ العرب في الأندلس – جزئياً – ليربط بين ما يجري في فلسطين وما جرى في الأندلس. لقد أتى شعراءُ فلسطينيون، قبل عام 1948، على فترة غروب شمس العرب في الأندلس، وهم يلاحظون غروب شمس العرب في فلسطين، وانتبه الدارسون إلى هذا، وهم يدرسون الأدب الفلسطيني، ورأى الدكتور عبد الرحمن ياغي، في كتابه " حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة .. حتى النكبة " (ط2/1981) أن الأندلس أصبحت " موضوعاً شعرياً يتناوله الشعراء حتى ولو لم يروا آثار الأندلس. وإنما هم يتمثلونها من واقعهم .. ومن قراءاتهم ومطالعاتهم في رحلة إلى بلاد المجد المفقود " (ص304).
وقد التفت إلى هذه الظاهرة، بتفصيل أكثر، الدكتور محمد عبد الله الجعيدي، فأنجز دراسة مطولة عنوانها " حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث "( عالم الفكر الكويتية، ع4، أبريل 2000) ولاحظ أن حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني تراوح بين " صورة الأندلس الفاتح المتفتح، مدعاة الفخر، متمثلة في عملية الفتح ذاتها (92هـ-711م) وفي بناء صرح الحضارة في قرطبة وإشبيلية وغرناطة ... وما قدمته هذه البلاد في ظل السيادة العربية الإسلامية من علماء ومفكرين وأدباء وساسة وقواد وبين صورة الأندلس المفكك المغلوب على أمره إلى أن تمكنت الممالك الإسبانية النصرانية ومن ورائها أوروبا من الاستيلاء على آخر معقل للعرب والمسلمين بشبه الجزيرة الإيبيرية سنة 897هـ/1492م، وثمة صورة ثالثة لهذا الحضور تمثلت في طبيعة الأندلس الجميلة: " جنة الله على الأرض " في ظل العرب والمسلمين و " الفردوس المفقود " بعد غروب شمس الإسلام والعروبة عنه "(ص7).
وبعد قراءته لكثير من نصوص الأدب الفلسطيني لاحظ الجعيدي " ندرة استدعاء كتاب النثر الفلسطيني للأندلس حيث تكاد تنحصر محاولاتهم فيما قام به خليل بيدس ومحمد نفاع وخضر زهران ونجاتي صدقي وإبراهيم الشنطي، وهي على أي حال إشارات ليس بإمكانها منافسة مثيلاتها عند الشعراء الفلسطينيين، في الكم أو في الكيف "(ص9).
والشخصيات التاريخية التي استحضرها الشعراء الفلسطينيون، كما لاحظ الدارس، هي طارق بن زياد وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر، وثمة شخصيات أخرى لم يكن استحضارها لافتاً حتى يفرد لها الكاتب، على ما يبدو، مساحة خاصة وهو يكتب عن الشخصيات، ومنها شخصية أبي عبد الله الصغير، فقد أتى على ذكرها وهو يكتب عن الأمكنة، وتوقف أمام قصيدة الشاعر فاروق مواسي " قصر الحمراء "(ص40).
ويبدو أن الشخصيات التي استلهمها الشعراء الفلسطينيون هي التي استلهمها أيضاً الشعراء العرب وتوقفوا أمامها، وهذا ما يلحظه المرء وهو يتصفح كتاب الدكتور علي عشري زايد " استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر " ( الكويت، ط2، 1997 )، وكتاب د. خالد الكركي " الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث " ( بيروت وعمان، 1989 ). ولم يتوقف هذان الدارسان، وهما يدرسان الموروث التاريخي في شعرنا المعاصر أمام نصوص استحضر فيها أصحابها شخصية أبي عبد الله الصغير، في حين أنهما توقفا أمام توظيف العرب شخصية عبد الرحمن الداخل ( صقر قريش ).
المعنى والمغزى:
يرى الدكتور زايد أن الشاعر العربي المعاصر " يختار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى القارئ، ومن ثم فقد انعكست طبيعة المرحلة التاريخية والحضارية التي عاشتها أمتنا في الحقبة الأخيرة، وإحباط الكثير من أحلامها، وخيبة أملها في الكثير مما كانت تأمل فيه الخير، وسيطرة بعض القوى الجائرة على بعض مقدراتها، والهزائم المتكررة التي حاقت بها رغم عدالة قضيتها ... انعكس كل ذلك على نوعية الشخصيات التاريخية التي استمدها شاعرنا المعاصر ". (ص120)
ولا شك أن المرء يستحضر هذا الكلام، وهو يكتب أيضاً عن شعرائنا الذين استلهموا التراث، ومنهم الشاعر المتوكل طه. وقد التفت دارسو مجموعته " حليب أسود " إلى المغزى الذي يرمي إليه. وهذا يعني أنه لم يعد كتابة التاريخ، قدر ما أراد أن يكتب الراهن أيضاً.
يذهب أحمد رفيق عوض، وهو يدرس " حليب أسود " إلى أن الديوان " إدانة كاملة ليس للمأساة القديمة رغم حضورها الكامل في الديوان، ولكنها إدانة للأبطال والشخصيات والرموز المتكررة والنتيجة التي يبدو أنها لا تختلف في وقعها المريع في القديم وفي الحديث من الأيام والسنين " ( انظر كتاب صورة الغناء: دراسات في إبداع المتوكل طه، إعداد وتقديم مراد السوداني، رام الله، 2003، ص38 ).
ويشير عباس دويكات إلى هذا وهو يتساءل عن مدى نجاح المتوكل في توظيف الحدث التاريخي " ليبدع نصاً شعرياً ينبض بالدلالة القائمة على الحدث المعيش، ويعرضه بشكل إيمائي بعيداً عن التصريح " ( صورة الغناء، ص71).
ولا يختلف عنهما الدكتور محمد صابر عبيد حين يكتب، وهو يحلل الديوان: " يظهر مُوَجّهٌ مضاف يُعَمِّقُ شبكة الموجات ويرسم لها مساراً آخر، إذ يتضمن إشارة إلى إتاحة فرصة جديدة للقارئ، لكي يعصرن النص ولا يؤخذ بمرجعيته التاريخية على نحو كلي، فضلاً عن أن الإشارة توكيد للعلاقات مبثوثة في مناطق غير قليلة من النص .. " ( صورة الغناء، ص103).
ولا يختلف عن هؤلاء مغير البرغوثي وهادي الربيعي ( انظر صورة الغناء، ص109، وص 124 ).
ويبدو أن المتوكل طه نفسه، في تقديمه للديوان، قد أمد الدارسين بدليل يدعم رأيهم، وذلك حين ذهب إلى ما يلي:
" لم يكن العصر العباسي، قد عرف الاستنساخ الذي تحقق بميلاد ( دوللّي ) بقدر ما عرف، بطريقة ما، التناسخ، حيث تتسلل روح الميت لتدب في جسد مولود جديد، ليكون امتداداً للميت " ( حليب أسود،المقدمة ).
ويعزز هذا ما ورد في التقديم الذي كتبه الشاعر سميح القاسم للديوان، وذلك حين رأى أن المتوكل " يمارس شكلاً حديثاً من أشكال التذويب والتماهي وإعادة صياغة الوقائع والشخوص بما ينخرط بالكامل في التجربة المعاصرة الساخنة، وهكذا فإن هارون الرشيد ويحيى البرمكي وسائر أبطال هذا العمل الشعري يطلون علينا بأزيائنا نحن وسلوكياتنا نحن وبمباشرة فنية متقدمة تجعل التلميح أجمل بكثير وأغنى من التصريح "(حليب اسود، المقدمة).
الخروج إلى الحمراء:
والسؤال الذي يثيره المرء، وهو يقرأ العنوان، هو: لماذا الخروج إلى الحمراء، وليس الخروج من الحمراء؟ وربما يجد المرء تفسيراً لهذا، حتى قبل أن يدلف إلى الديوان. كتب المتوكل ديوانه هذا في فترة انتفاضة الأقصى التي تلت مرحلة مدريد فأوسلو،، ولم يكن أول من يفعل هذا على الصعيد الفلسطيني والعربي، فقد سبقه محمود درويش في " أحد عشر كوكباً "(1993) ورضوى عاشور في " ثلاثية غرناطة "(1995)(ط2/1998). وهؤلاء، في التسعينيات من القرن العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين، استلهموا فترة خروج العرب من الأندلس مهزومين، وفي الفترة هذه ذهب العرب إلى ( مدريد )،ـ وذهابهم هذا هو خروجهم إلى الحمراء، ليوقعوا، هناك، في الأندلس/إسبانيا، معاهدة الصلح، وليسلموا غرناطة المعاصرة – أي فلسطين، وليقروا بدولة إسرائيل. هناك سلم أبو عبد الله الصغير مفاتيح غرناطة، وهناك أيضاً اجتمع العرب والإسرائيليون ليوقعوا اتفاقية السلام.
لم ينكر محمود درويش، في المقابلات التي أجريت معه، أن الراهن تسلل إلى نصه " أحد عشر كوكباً "، ولم يغفل هذا دارسوه الذين تناولوا القصيدة، ومن هؤلاء ادوارد سعيد نفسه. وكنت شخصياً أتيت على هذا بالتفصيل. ( حول ذلك انظر كتابي: أدب المقاومة، غزة، 1998 (ص74-ص97، ودراستي إشكالية الشاعر والسياسي: محمود درويش نموذجاً، كنعان، أيلول 1997 ). وقارئ " ثلاثية غرناطة " لرضوى عاشور يشعر، وهو يقرأ بعض صفحاتها، أنه يقرأ ما يجري الآن، وبخاصة الصفحات التي تصور فيها حياة العرب تحت الحكم الإسباني أيام سقوط غرناطة. كأن رضوى عاشور تسقط الراهن على الماضي، كأنها، وهي تكتب عن تلك الفترة، تكتب عن هذه الفترة. وكأنها وهي تكتب عن حياة العرب في الأندلس، أيام سقوط غرناطة وما تلا ذلك، كأنها تكتب عن العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي.
تجاور الزمنين، تجاور المكانين:
كما لاحظنا، فإن العنوان الرئيس هو " الخروج إلى الحمراء " وليس " الخروج من الحمراء "، والعنوان الفرعي هو: " عن أبي عبد الله الصغير وتسليم غرناطة "، وهذا العنوان يفصح عما يريد المتوكل قوله، وإن بدا العنوان الرئيس، للوهلة الأولى، مضللاً، ولكنه، كما لاحظنا، حين يُقرأ ضمن الزمن الكتابي وما سبقه بسنوات، يبدو غير مضلل، فنحن خرجنا إلى الحمراء، إلى الأندلس، لنخرج من الحمراء، من فلسطين. ولعل ما يدعم هذا أحد العناوين الفرعية للديوان، وتحديداً عنوان " هنا غرناطة "، وإذا كان أنا المتكلم هو أنا الشاعر – أي المتوكل طه – فإن غرناطة تبدو فلسطين. والشكل الشعري في هذا المقطع ينتمي إلى زمننا، لا إلى زمن الشاعر الأندلسي. و "هنا " في قول الشاعر:
" وهنا مرآة الأندلس
وقصر الحمراء
وما ظل من اللهب الليلي " (ص8)
هي فلسطين التي هي مرآة الأندلس، وكما لاحظنا، في أثناء قراءة دراسة الجعيدي، فإن الشعراء الفلسطينيين ربطوا بين الأندلس وفلسطين. بل ولعلنا نذكر قصيدة محمود درويش في رثاء ماجد أبي شرار. يربط درويش بين فلسطين والأندلس حين يسأل:
" أتحسبها الأندلس "؟
وثمة عنوان فرعي آخر يشير إلى تبادل الأمكنة، وهو: " هنا البارحة ... هناك اليوم ". ثمة تبديل عوالم. هنا الأندلس، الأندلس فلسطين – أي ما يجري هنا جرى في الأندلس وما جرى في الأندلس يجري اليوم في فلسطين. وما يدعم هذا ما يرد في النص:
" وأبو عبد الله، الآن، يسمع اليسوع،
وهو يردد على أبواب غرناطة العشرين "(ص52)
وبقي مسجد قرطبة القدسي كنيسة مريم
والمذبح بدل المحراب " (ص53)
ووهنا الزهراء والبيرة وقرطبة وإشبيلية ..
وفي مالقة ( جنين ) المذبحة بعد الألف "(ص53)
وكما يتجاور المكانان يتجاور الزمنان في الديوان أكثره. ثمة في الديوان مفردات وعلامات تعود إلى الزمن الشعري – أقصد زمن تسليم غرناطة – وثمة مفردات وعلامات تعود إلى الزمن الكتابي – أعني الزمن الذي أنجز فيه الديوان، وهو القرن الحادي والعشرون.
وأما العلامات، فبالإضافة إلى اسم الشاعر ودار النشر وتاريخ النشر، هناك الشكل الشعري الذي لم يكن معروفاً زمن الأندلسيين، وأقصد به هنا قصيدة التفعيلة وما شابه، ولكن هذا الشكل الشعري ليس الشكل الشعري الوحيد، فهناك الشكل الكلاسيكي الذي ينتمي إلى ذلك العصر. هكذا يذكر الشكل الشعري بزمن مضى، ولكنه ما زال حاضراً، ويحيلنا إلى زمن حاضر هو زمننا، وتحديداً زمن قصيدة التفعيلة التي عرفت عام 1947.
وأما المفردات فهي شاهد أيضاً على زمنين، وهي شاهد واضح. ثمة مفردات تنتمي إلى عصر سقوط غرناطة، وثمة مفردات لم تكن شائعة في حينه، مفردات شاعت في عصور لاحقة أو في زمننا نحن. والمفردات الأولى، على سبيل المثال، أسماء المدن الأندلسية، والزغل، والزعيبي، وأبو عبد الله، والخيل، الفرسان، الأسل ... الخ والمفردات الثانية كثيرة ومنها: قطار، غولف، سريالية، سيارات الجكوار، دادية، مذيعات الأخبار، جنين غراد، داخاو.
والسؤال هو: هل يكتب المتوكل عن سقوط غرناطة، أم عن فلسطين التي هي، في نظره، في طريقها للضياع؟ أم أنه يكتب عن سقوط هذه وسقوط تلك، ويظن الأندلس فلسطين، وهكذا تجاور الزمنان والمكانان في الديوان؟
وحدة الديوان أم تفككه؟!
يقود ما سبق المرء إلى إثارة سؤال آخر مهم هو: هل خطط الشاعر لكتابة الديوان وأراد أن يكون وحدة واحدة؟ أم أن ذلك لم يخطر على باله إلا في فترة لاحقة، ومن ثم، فقد ضمّ قصائد كتبها في مناسبات معينة، إلى بعض القصائد واختار العنوان الرئيس والفرعي ليكون هو فقط جامع شمل القصائد، وأضاف إلى العنوان الرئيس عناوين فرعية لعناوين القصائد حتى يوهم بأن القصائد كلها تشكل ديواناً متكاملاً؟
هنا يمكن أن أتوقف أمام قصيدتين، على سـبيل المثال لا الحصر، الأولى هي قصيدة " منزلة الياسمين "، والثانية هي قصيدة " يا شام "، وأهدى الأولى إلى المحاصر، وأتبع الثانية بعبارة: " ( ما قاله الزغل، وهو ينظر إلى الغريبة؛ نخلة صقر قريش، وكان قد عزم على زيارة الشام ).
وواضح جداً أن الأولى في مديح ياسر عرفات، وهي على ما يبدو قيلت بمناسبة عيد ميلاد أبو عمار، حين بلغ الثالثة والسبعين، وكان أبو عمار - محاصراً – في رام الله. وأجواء القصيدة كلها أجواء فلسطين، وليس فيها ما يذكر بالأندلس سوى قول الشاعر:
" وفي ردهة الأرض ألف حصار
يطال الرهيب المتوج بالزور
حتى، الذي نزفته على حاجزٍ أمُّه ..
منذ أن زفر الخاسر الأموي،
على أرض غرناطة الدمع،
حتى وصول المواكب في قمة الخاسرين ".(ص73)
وقوله هنا ليس إلا ربط الخسارة الآنية بخسارات سابقة، وتبقى بقية القصيدة التي تتحدث عن عذابات الفلسطينيين في خيامهم، وعن حلمهم بدولتهم، وعن قدسهم، وعن سجن عكا وعتليت وقلقيلية، وتنتهي بخطاب واضح جداً إلى ياسر عرفات، خطاب يتضمن عبارات معروفة يكررها أبو عمار:
" لكن لاءك كانت حصارك
حراً بدأت وحراً ختمت ..
شهيداً .. شهيداً .. شهيداً إلى القدس،
أو طلقة في الجبين ". (ص81)
وأما الثانية " يا شام "، فأظن أن المتوكل كتبها يوم قرر أن يزور الشام، إبان الانتفاضة، وأظن أنه نشرها في جريدة " الانتفاضة ". ولو استبدلنا اسم المتوكل باسم الزغل لما اختلف الأمر. والزغل لا يذهب إلى دمشق من غرناطة، إنه يذهب إليها من القدس:
آتي من القدس مطعونا بصمت آخي
ونازفاً من هزالِ الشجب والخُطَبِ
كـأنـني لا أنـادي أمتي أبــدا
ولم تصوحْها أفعال مغتصبـــي
فمن يصافحهم ضعفا يكن أبـــداً
كلباً ينابح بالتطـبيـع والكلــب (ص84)
وتحفل القصيدة بأسماء المدن الفلسطينية ( القدس، عكا، الخليل، يافا )، وتشير إلى رموز معاصرة في تاريخ فلسطين، وأبرزها الشيخ المجاهد عز الدين القسام:
آتي وفي ناظري القسّام يهتف بي:
قلبي بحيفا ونبضي كان في حلب (ص86)
النص وصلته بالنص السابق:
تؤكد دراسة ديوان " الخروج إلى الحمراء "، حين يربط صاحبها بين هذا الديوان، وديوان " حليب أسود "، تؤكد ما يذهب إليه البنيويون الذين يرون أن دراسة غير قصيدة للشاعر نفسه تظهر أن القصيدتين تعكسان البنية نفسها. لقد خلص إلى هذا (ميخائيل ريفاتيري) وهو يدرس قصيدة " القطط " للشاعر الفرنسي ( بودلير )، وحين درس قصيدة أخرى للشاعر نفسه، لاحظ أن القصيدتين تعكسان البنية نفسها. وخلص إلى الشيء نفسه الناقد كمال أبو ديب في كتابه " جدلية الخفاء والتجلي: دراسات بنيوية في نقد الشعر ". لقد درس ثلاث قصائد للشاعر العباسي أبي نواس، لبرهنة إمكانية المنهج، ولإظهار أن القصائد الثلاثة تعكس البنية نفسها.
إن قارئ " الخروج إلى الحمراء " يلحظ أكثر من وشيجة مع " حليب اسود "، على الرغم من أن الرموز التاريخية المســتلهمة تنتمي إلـى زمانيـن مختلفين ومكانين مختلفين ( العصر العباسي في أوجه، عصر هارون الرشيد، والعصر الأموي في الأندلس في نهايته، عصر أبي عبد الله الصغير )، ويبدو أن المتوكل طه لم يستطع أن يتخلص من الإشكالية التي دفعته لكتابة " حليب أسود "، وهذه هي الصلة الأولى بين الديوانين.
يرد في " حليب أسود "، في التصدير: ] يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودّوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات، إن كنتم تعقلون [ .
ويرد أيضاً: " من فسدت بطانته، أوتي من مأمنه ". وهذا قول لخليفة عباسي.
ويقوم الديوان كله على فكرة الخليفة / البطانة، ويستلهم الشاعر علاقة الرشيد بالبرامكة ليقول من خلالها رأيه في علاقة الحاكم المعاصر بالبطانة المعاصرة، ولا ضرورة لتسمية الأسماء ولكشف الرمز. وتتكرر هذه الفكرة في " الخروج إلى الحمراء " مرتين. نقرأ في قصيدة " حوار في المنفى ( مع أبي عبد الله الصغير في فاس )" نقرأ الأسطر الشعرية التالية:
" قلت:
هذه بطانتك التي أمّرَّتها
وجعلتها الحكامَ دون سداد
أنت الذي اخترت النهاية عندما
اخترت الطريق وثلة الفساد " (ص42)
ونقرأ في قصيدة " منزلة الياسمين " المهداة إلى المحاصر:
" وهل سوف يبقى برامكة العصر
في بهوك الرحب " (ص76)
بل ونقرأ أيضاً، في قصيدة " هنا البارحة .. هناك اليوم "
"وفوق هذا وذاك نعرف الوزراء الخونة والدساسين والتجار...ونعرف غدنا أيضاً "(ص56)
وتحيلنا عبارة " الوزراء الخونة إلى " حليب أسود " وقصيدة " خبر عن صاحب الخبر: بعد أن تناسخت روحه، وحلّت في وزير .. بعد اثني عشر قرناً. هنا ينكشف الرمز ويتضح المدلول، بل لا يعود الرمز رمزاً، لأن الشاعر ما عاد يتحدث عن البرامكة، وإنما أخذ يكتب عن وزير معاصر. والوزير هنا كذوب وزير نساء وفاجر ويتاجر بالقضية ويشرب الويسكي ... الخ. (ص62 وما بعدها). بل وتحيلنا إلى ما يقوله أبو نواس في الأوضاع":
" القائمون على بيوت المال قد سرقوا البلاد، وأصبحوا وزراء أو أمراء، لكن الخليفة لا ينام "(ص49).
وإذا ما غضضنا الطرف عن شكل القصيدة في الديوان -، وثمة تشابه كبير إذ يمزج الشاعر بين أكثر من شكل، - فإننا يمكن أن نصغي إلى أصوات العامة في الديوانين. " في حليب أسود " عنوان هو: رجال من العامة يتسامرون وواحد منهم يروي هذه الحكاية " (ص41 وما بعدها)، وفي الرواية ثمة إدانة للواقع، إذ يفصل الوزراء بين الحاكم والرعية، ولا يصغي الأول إلى الأخيرين. وفي " الخروج إلى الحمراء " عنوان فرعي هو: " الناس في الأسواق "، وهنا نصغي إلى أصوات الناس فيما يقوم به أبو عبد الله:
" – لقد باع الجامع والحارة والأهل وأحلام
البسطاء "(ص37)
رموز تاريخية أدبية أخرى: المتنبي
تحضر في الديوان رموز تاريخية أدبية أخرى غير تلك التي تعود إلى عصر غرناطة في أيامها الإسلامية الأخيرة، وأبرز هذه الرموز العربية هي المتنبي، والمتنبي شخصية تاريخية غلب عليها الطابع الأدبي. وقد لفتت هذه الشخصية أنظار الشعراء والدارسين. وقد توقف أمام توظيفها في الشعر على عشري زايد وخالد الكركي الذي عاد وأنجز كتاباً خاصاً حول استحضار المتنبي في الشعر العربي الحديث، وعنوان الكتاب " الصائح المحكي: صورة المتنبي في الشعر العربي الحديث " ( بيروت، 1999).
والمتنبي شخصية إشكالية وقف منها الأدباء المعاصرون موقفاً غير موحد. مجده شعراء كثيرون مثل أدونيس ودرويش والبردوني، وقللّ من شأنه أدباء آخرون أبرزهم زكريا تامر في بعض قصصه، وتحديداً في قصة " نبوءة كافور الإخشيدي " من مجموعة " نداء نوح "(1994).
ويأتي المتوكل على ذكر المتنبي في قصيدة " منزلة الياسمين " وفيها يقول:
" وما كنت يوماً أنا المتنبي
لأطلب مملكة بالمديح،
وما كان والد أمي طاووس شعري،
فقد كان والدي الضخم
في سجن عكا وعتليت ...
وأمي في حبق الدار تبكي،
على سفح قلقيليا،
كي تعود البلاد إلى قمحها
في العجين ".(ص78).
وكما ذكرت، فإن هذه القصيدة، اعتماداً على قراءتها قراءة داخلية وربطها بالزمن الكتابي، هي موجهة لياسر عرفات. وإذا ذهبنا إلى أن أنا المتكلم هنا هي أنا الشاعر – أي المتوكل طه، فإنه يدافع عن نفسه رافضاً أن يكون مثل المتنبي الذي نشد الملك فمدح الملوك والأمراء والخلفاء. هكذا يرى المتوكل المتنبي: يكتب قصائد المديح حتى يحصل على الملك. وهكذا تبدو صورة المتنبي في نظر المتوكل صورة سلبية. ولعل ما يدعم رأيي هذا أنني كنت، شخصياً، ربطت بين المتنبي والمتوكل. ذهبت في كتابي " أدب المقاومة "(1998) إلى أن المتوكل حين يقول: " إن للشاعر لسانين "، غدا " مثالاً جديداً لسلفه المتنبي "(ص145). ولعله هنا يرد على هذا، وهكذا نلحظ، ثانية، تجاوراً لزمنين: زمن تسليم مفاتيح غرناطة، وزمن الشاعر المتوكل، الزمن الشعري والزمن الكتابي. وهذا يحيلنا من جديد إلى عنوان المعنى والمغزى، وإلى حدود التاريخ وحدود الواقع في الديوان.
يكتب د. الجعيدي في دراسته، حين يأتي على ذكر غرناطة، يكتب:
" وتظل مملكة غرناطة في الشعر الفلسطيني درساً من دروس التاريخ لا ينضب، يتجدد ويقدم العبرة لمن اعتبر. ففي " قصر الحمراء " يقدم الشاعر درساً لمن قصر نظره عن رؤية التاريخ رؤية شمولية، ويحذر من مغبة التمادي في ذلك حتى لا يعبث معاصرونا بمصير الأجيال القادمة "(ص40).
ويقول المتوكل طه:
" غرناطة بعد التسليم
تلد ملايين البلدان على موسيقى سيارات الجكوار
إلى الصحراء المسلوبة زيت الأحياء "ز(ص98)
وكأنها لم تكن عبرة وكأننا لم نعتبر، فخسرنا بلداً تلو آخر. ولعل هناك كلاماً كثيراً يمكن أن يقال في هذا الديوان وفي ديوان " حليب أسود "، ولعل المتوكل هنا حقق ما لم يحققه في مجموعاته السابقة، على صعيد الشعر، وعلى صعيد استلهام التاريخ أيضاً.
ــــــــــــ
- حول الديوان انظر ما كتبه " مغير البرغوثي " وأحمد رفيق عوض. وقد أدرجت المقالتان في كتاب " صورة الغناء: دراسات في إبداع المتوكل طه "، من إعداد مراد السوداني، رام الله 2003. [ص197-ص219] [ص221-227].
نابلس 26/6/2003
" نبسط الشعر على ثلج الحكايا،
ونقل في سرّنا ما لم نقل في مشهد الريح
وأضواء المرايا ...
ولهذا، فلنا في فمنا حرف،
وحرف .. للسرايا ". ( ريح النار المقبلة، ص48 )
الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث:
وليس المتوكل طه أول شاعر فلسطيني يستلهم تاريخ العرب في الأندلس – جزئياً – ليربط بين ما يجري في فلسطين وما جرى في الأندلس. لقد أتى شعراءُ فلسطينيون، قبل عام 1948، على فترة غروب شمس العرب في الأندلس، وهم يلاحظون غروب شمس العرب في فلسطين، وانتبه الدارسون إلى هذا، وهم يدرسون الأدب الفلسطيني، ورأى الدكتور عبد الرحمن ياغي، في كتابه " حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة .. حتى النكبة " (ط2/1981) أن الأندلس أصبحت " موضوعاً شعرياً يتناوله الشعراء حتى ولو لم يروا آثار الأندلس. وإنما هم يتمثلونها من واقعهم .. ومن قراءاتهم ومطالعاتهم في رحلة إلى بلاد المجد المفقود " (ص304).
وقد التفت إلى هذه الظاهرة، بتفصيل أكثر، الدكتور محمد عبد الله الجعيدي، فأنجز دراسة مطولة عنوانها " حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث "( عالم الفكر الكويتية، ع4، أبريل 2000) ولاحظ أن حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني تراوح بين " صورة الأندلس الفاتح المتفتح، مدعاة الفخر، متمثلة في عملية الفتح ذاتها (92هـ-711م) وفي بناء صرح الحضارة في قرطبة وإشبيلية وغرناطة ... وما قدمته هذه البلاد في ظل السيادة العربية الإسلامية من علماء ومفكرين وأدباء وساسة وقواد وبين صورة الأندلس المفكك المغلوب على أمره إلى أن تمكنت الممالك الإسبانية النصرانية ومن ورائها أوروبا من الاستيلاء على آخر معقل للعرب والمسلمين بشبه الجزيرة الإيبيرية سنة 897هـ/1492م، وثمة صورة ثالثة لهذا الحضور تمثلت في طبيعة الأندلس الجميلة: " جنة الله على الأرض " في ظل العرب والمسلمين و " الفردوس المفقود " بعد غروب شمس الإسلام والعروبة عنه "(ص7).
وبعد قراءته لكثير من نصوص الأدب الفلسطيني لاحظ الجعيدي " ندرة استدعاء كتاب النثر الفلسطيني للأندلس حيث تكاد تنحصر محاولاتهم فيما قام به خليل بيدس ومحمد نفاع وخضر زهران ونجاتي صدقي وإبراهيم الشنطي، وهي على أي حال إشارات ليس بإمكانها منافسة مثيلاتها عند الشعراء الفلسطينيين، في الكم أو في الكيف "(ص9).
والشخصيات التاريخية التي استحضرها الشعراء الفلسطينيون، كما لاحظ الدارس، هي طارق بن زياد وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر، وثمة شخصيات أخرى لم يكن استحضارها لافتاً حتى يفرد لها الكاتب، على ما يبدو، مساحة خاصة وهو يكتب عن الشخصيات، ومنها شخصية أبي عبد الله الصغير، فقد أتى على ذكرها وهو يكتب عن الأمكنة، وتوقف أمام قصيدة الشاعر فاروق مواسي " قصر الحمراء "(ص40).
ويبدو أن الشخصيات التي استلهمها الشعراء الفلسطينيون هي التي استلهمها أيضاً الشعراء العرب وتوقفوا أمامها، وهذا ما يلحظه المرء وهو يتصفح كتاب الدكتور علي عشري زايد " استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر " ( الكويت، ط2، 1997 )، وكتاب د. خالد الكركي " الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث " ( بيروت وعمان، 1989 ). ولم يتوقف هذان الدارسان، وهما يدرسان الموروث التاريخي في شعرنا المعاصر أمام نصوص استحضر فيها أصحابها شخصية أبي عبد الله الصغير، في حين أنهما توقفا أمام توظيف العرب شخصية عبد الرحمن الداخل ( صقر قريش ).
المعنى والمغزى:
يرى الدكتور زايد أن الشاعر العربي المعاصر " يختار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى القارئ، ومن ثم فقد انعكست طبيعة المرحلة التاريخية والحضارية التي عاشتها أمتنا في الحقبة الأخيرة، وإحباط الكثير من أحلامها، وخيبة أملها في الكثير مما كانت تأمل فيه الخير، وسيطرة بعض القوى الجائرة على بعض مقدراتها، والهزائم المتكررة التي حاقت بها رغم عدالة قضيتها ... انعكس كل ذلك على نوعية الشخصيات التاريخية التي استمدها شاعرنا المعاصر ". (ص120)
ولا شك أن المرء يستحضر هذا الكلام، وهو يكتب أيضاً عن شعرائنا الذين استلهموا التراث، ومنهم الشاعر المتوكل طه. وقد التفت دارسو مجموعته " حليب أسود " إلى المغزى الذي يرمي إليه. وهذا يعني أنه لم يعد كتابة التاريخ، قدر ما أراد أن يكتب الراهن أيضاً.
يذهب أحمد رفيق عوض، وهو يدرس " حليب أسود " إلى أن الديوان " إدانة كاملة ليس للمأساة القديمة رغم حضورها الكامل في الديوان، ولكنها إدانة للأبطال والشخصيات والرموز المتكررة والنتيجة التي يبدو أنها لا تختلف في وقعها المريع في القديم وفي الحديث من الأيام والسنين " ( انظر كتاب صورة الغناء: دراسات في إبداع المتوكل طه، إعداد وتقديم مراد السوداني، رام الله، 2003، ص38 ).
ويشير عباس دويكات إلى هذا وهو يتساءل عن مدى نجاح المتوكل في توظيف الحدث التاريخي " ليبدع نصاً شعرياً ينبض بالدلالة القائمة على الحدث المعيش، ويعرضه بشكل إيمائي بعيداً عن التصريح " ( صورة الغناء، ص71).
ولا يختلف عنهما الدكتور محمد صابر عبيد حين يكتب، وهو يحلل الديوان: " يظهر مُوَجّهٌ مضاف يُعَمِّقُ شبكة الموجات ويرسم لها مساراً آخر، إذ يتضمن إشارة إلى إتاحة فرصة جديدة للقارئ، لكي يعصرن النص ولا يؤخذ بمرجعيته التاريخية على نحو كلي، فضلاً عن أن الإشارة توكيد للعلاقات مبثوثة في مناطق غير قليلة من النص .. " ( صورة الغناء، ص103).
ولا يختلف عن هؤلاء مغير البرغوثي وهادي الربيعي ( انظر صورة الغناء، ص109، وص 124 ).
ويبدو أن المتوكل طه نفسه، في تقديمه للديوان، قد أمد الدارسين بدليل يدعم رأيهم، وذلك حين ذهب إلى ما يلي:
" لم يكن العصر العباسي، قد عرف الاستنساخ الذي تحقق بميلاد ( دوللّي ) بقدر ما عرف، بطريقة ما، التناسخ، حيث تتسلل روح الميت لتدب في جسد مولود جديد، ليكون امتداداً للميت " ( حليب أسود،المقدمة ).
ويعزز هذا ما ورد في التقديم الذي كتبه الشاعر سميح القاسم للديوان، وذلك حين رأى أن المتوكل " يمارس شكلاً حديثاً من أشكال التذويب والتماهي وإعادة صياغة الوقائع والشخوص بما ينخرط بالكامل في التجربة المعاصرة الساخنة، وهكذا فإن هارون الرشيد ويحيى البرمكي وسائر أبطال هذا العمل الشعري يطلون علينا بأزيائنا نحن وسلوكياتنا نحن وبمباشرة فنية متقدمة تجعل التلميح أجمل بكثير وأغنى من التصريح "(حليب اسود، المقدمة).
الخروج إلى الحمراء:
والسؤال الذي يثيره المرء، وهو يقرأ العنوان، هو: لماذا الخروج إلى الحمراء، وليس الخروج من الحمراء؟ وربما يجد المرء تفسيراً لهذا، حتى قبل أن يدلف إلى الديوان. كتب المتوكل ديوانه هذا في فترة انتفاضة الأقصى التي تلت مرحلة مدريد فأوسلو،، ولم يكن أول من يفعل هذا على الصعيد الفلسطيني والعربي، فقد سبقه محمود درويش في " أحد عشر كوكباً "(1993) ورضوى عاشور في " ثلاثية غرناطة "(1995)(ط2/1998). وهؤلاء، في التسعينيات من القرن العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين، استلهموا فترة خروج العرب من الأندلس مهزومين، وفي الفترة هذه ذهب العرب إلى ( مدريد )،ـ وذهابهم هذا هو خروجهم إلى الحمراء، ليوقعوا، هناك، في الأندلس/إسبانيا، معاهدة الصلح، وليسلموا غرناطة المعاصرة – أي فلسطين، وليقروا بدولة إسرائيل. هناك سلم أبو عبد الله الصغير مفاتيح غرناطة، وهناك أيضاً اجتمع العرب والإسرائيليون ليوقعوا اتفاقية السلام.
لم ينكر محمود درويش، في المقابلات التي أجريت معه، أن الراهن تسلل إلى نصه " أحد عشر كوكباً "، ولم يغفل هذا دارسوه الذين تناولوا القصيدة، ومن هؤلاء ادوارد سعيد نفسه. وكنت شخصياً أتيت على هذا بالتفصيل. ( حول ذلك انظر كتابي: أدب المقاومة، غزة، 1998 (ص74-ص97، ودراستي إشكالية الشاعر والسياسي: محمود درويش نموذجاً، كنعان، أيلول 1997 ). وقارئ " ثلاثية غرناطة " لرضوى عاشور يشعر، وهو يقرأ بعض صفحاتها، أنه يقرأ ما يجري الآن، وبخاصة الصفحات التي تصور فيها حياة العرب تحت الحكم الإسباني أيام سقوط غرناطة. كأن رضوى عاشور تسقط الراهن على الماضي، كأنها، وهي تكتب عن تلك الفترة، تكتب عن هذه الفترة. وكأنها وهي تكتب عن حياة العرب في الأندلس، أيام سقوط غرناطة وما تلا ذلك، كأنها تكتب عن العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي.
تجاور الزمنين، تجاور المكانين:
كما لاحظنا، فإن العنوان الرئيس هو " الخروج إلى الحمراء " وليس " الخروج من الحمراء "، والعنوان الفرعي هو: " عن أبي عبد الله الصغير وتسليم غرناطة "، وهذا العنوان يفصح عما يريد المتوكل قوله، وإن بدا العنوان الرئيس، للوهلة الأولى، مضللاً، ولكنه، كما لاحظنا، حين يُقرأ ضمن الزمن الكتابي وما سبقه بسنوات، يبدو غير مضلل، فنحن خرجنا إلى الحمراء، إلى الأندلس، لنخرج من الحمراء، من فلسطين. ولعل ما يدعم هذا أحد العناوين الفرعية للديوان، وتحديداً عنوان " هنا غرناطة "، وإذا كان أنا المتكلم هو أنا الشاعر – أي المتوكل طه – فإن غرناطة تبدو فلسطين. والشكل الشعري في هذا المقطع ينتمي إلى زمننا، لا إلى زمن الشاعر الأندلسي. و "هنا " في قول الشاعر:
" وهنا مرآة الأندلس
وقصر الحمراء
وما ظل من اللهب الليلي " (ص8)
هي فلسطين التي هي مرآة الأندلس، وكما لاحظنا، في أثناء قراءة دراسة الجعيدي، فإن الشعراء الفلسطينيين ربطوا بين الأندلس وفلسطين. بل ولعلنا نذكر قصيدة محمود درويش في رثاء ماجد أبي شرار. يربط درويش بين فلسطين والأندلس حين يسأل:
" أتحسبها الأندلس "؟
وثمة عنوان فرعي آخر يشير إلى تبادل الأمكنة، وهو: " هنا البارحة ... هناك اليوم ". ثمة تبديل عوالم. هنا الأندلس، الأندلس فلسطين – أي ما يجري هنا جرى في الأندلس وما جرى في الأندلس يجري اليوم في فلسطين. وما يدعم هذا ما يرد في النص:
" وأبو عبد الله، الآن، يسمع اليسوع،
وهو يردد على أبواب غرناطة العشرين "(ص52)
وبقي مسجد قرطبة القدسي كنيسة مريم
والمذبح بدل المحراب " (ص53)
ووهنا الزهراء والبيرة وقرطبة وإشبيلية ..
وفي مالقة ( جنين ) المذبحة بعد الألف "(ص53)
وكما يتجاور المكانان يتجاور الزمنان في الديوان أكثره. ثمة في الديوان مفردات وعلامات تعود إلى الزمن الشعري – أقصد زمن تسليم غرناطة – وثمة مفردات وعلامات تعود إلى الزمن الكتابي – أعني الزمن الذي أنجز فيه الديوان، وهو القرن الحادي والعشرون.
وأما العلامات، فبالإضافة إلى اسم الشاعر ودار النشر وتاريخ النشر، هناك الشكل الشعري الذي لم يكن معروفاً زمن الأندلسيين، وأقصد به هنا قصيدة التفعيلة وما شابه، ولكن هذا الشكل الشعري ليس الشكل الشعري الوحيد، فهناك الشكل الكلاسيكي الذي ينتمي إلى ذلك العصر. هكذا يذكر الشكل الشعري بزمن مضى، ولكنه ما زال حاضراً، ويحيلنا إلى زمن حاضر هو زمننا، وتحديداً زمن قصيدة التفعيلة التي عرفت عام 1947.
وأما المفردات فهي شاهد أيضاً على زمنين، وهي شاهد واضح. ثمة مفردات تنتمي إلى عصر سقوط غرناطة، وثمة مفردات لم تكن شائعة في حينه، مفردات شاعت في عصور لاحقة أو في زمننا نحن. والمفردات الأولى، على سبيل المثال، أسماء المدن الأندلسية، والزغل، والزعيبي، وأبو عبد الله، والخيل، الفرسان، الأسل ... الخ والمفردات الثانية كثيرة ومنها: قطار، غولف، سريالية، سيارات الجكوار، دادية، مذيعات الأخبار، جنين غراد، داخاو.
والسؤال هو: هل يكتب المتوكل عن سقوط غرناطة، أم عن فلسطين التي هي، في نظره، في طريقها للضياع؟ أم أنه يكتب عن سقوط هذه وسقوط تلك، ويظن الأندلس فلسطين، وهكذا تجاور الزمنان والمكانان في الديوان؟
وحدة الديوان أم تفككه؟!
يقود ما سبق المرء إلى إثارة سؤال آخر مهم هو: هل خطط الشاعر لكتابة الديوان وأراد أن يكون وحدة واحدة؟ أم أن ذلك لم يخطر على باله إلا في فترة لاحقة، ومن ثم، فقد ضمّ قصائد كتبها في مناسبات معينة، إلى بعض القصائد واختار العنوان الرئيس والفرعي ليكون هو فقط جامع شمل القصائد، وأضاف إلى العنوان الرئيس عناوين فرعية لعناوين القصائد حتى يوهم بأن القصائد كلها تشكل ديواناً متكاملاً؟
هنا يمكن أن أتوقف أمام قصيدتين، على سـبيل المثال لا الحصر، الأولى هي قصيدة " منزلة الياسمين "، والثانية هي قصيدة " يا شام "، وأهدى الأولى إلى المحاصر، وأتبع الثانية بعبارة: " ( ما قاله الزغل، وهو ينظر إلى الغريبة؛ نخلة صقر قريش، وكان قد عزم على زيارة الشام ).
وواضح جداً أن الأولى في مديح ياسر عرفات، وهي على ما يبدو قيلت بمناسبة عيد ميلاد أبو عمار، حين بلغ الثالثة والسبعين، وكان أبو عمار - محاصراً – في رام الله. وأجواء القصيدة كلها أجواء فلسطين، وليس فيها ما يذكر بالأندلس سوى قول الشاعر:
" وفي ردهة الأرض ألف حصار
يطال الرهيب المتوج بالزور
حتى، الذي نزفته على حاجزٍ أمُّه ..
منذ أن زفر الخاسر الأموي،
على أرض غرناطة الدمع،
حتى وصول المواكب في قمة الخاسرين ".(ص73)
وقوله هنا ليس إلا ربط الخسارة الآنية بخسارات سابقة، وتبقى بقية القصيدة التي تتحدث عن عذابات الفلسطينيين في خيامهم، وعن حلمهم بدولتهم، وعن قدسهم، وعن سجن عكا وعتليت وقلقيلية، وتنتهي بخطاب واضح جداً إلى ياسر عرفات، خطاب يتضمن عبارات معروفة يكررها أبو عمار:
" لكن لاءك كانت حصارك
حراً بدأت وحراً ختمت ..
شهيداً .. شهيداً .. شهيداً إلى القدس،
أو طلقة في الجبين ". (ص81)
وأما الثانية " يا شام "، فأظن أن المتوكل كتبها يوم قرر أن يزور الشام، إبان الانتفاضة، وأظن أنه نشرها في جريدة " الانتفاضة ". ولو استبدلنا اسم المتوكل باسم الزغل لما اختلف الأمر. والزغل لا يذهب إلى دمشق من غرناطة، إنه يذهب إليها من القدس:
آتي من القدس مطعونا بصمت آخي
ونازفاً من هزالِ الشجب والخُطَبِ
كـأنـني لا أنـادي أمتي أبــدا
ولم تصوحْها أفعال مغتصبـــي
فمن يصافحهم ضعفا يكن أبـــداً
كلباً ينابح بالتطـبيـع والكلــب (ص84)
وتحفل القصيدة بأسماء المدن الفلسطينية ( القدس، عكا، الخليل، يافا )، وتشير إلى رموز معاصرة في تاريخ فلسطين، وأبرزها الشيخ المجاهد عز الدين القسام:
آتي وفي ناظري القسّام يهتف بي:
قلبي بحيفا ونبضي كان في حلب (ص86)
النص وصلته بالنص السابق:
تؤكد دراسة ديوان " الخروج إلى الحمراء "، حين يربط صاحبها بين هذا الديوان، وديوان " حليب أسود "، تؤكد ما يذهب إليه البنيويون الذين يرون أن دراسة غير قصيدة للشاعر نفسه تظهر أن القصيدتين تعكسان البنية نفسها. لقد خلص إلى هذا (ميخائيل ريفاتيري) وهو يدرس قصيدة " القطط " للشاعر الفرنسي ( بودلير )، وحين درس قصيدة أخرى للشاعر نفسه، لاحظ أن القصيدتين تعكسان البنية نفسها. وخلص إلى الشيء نفسه الناقد كمال أبو ديب في كتابه " جدلية الخفاء والتجلي: دراسات بنيوية في نقد الشعر ". لقد درس ثلاث قصائد للشاعر العباسي أبي نواس، لبرهنة إمكانية المنهج، ولإظهار أن القصائد الثلاثة تعكس البنية نفسها.
إن قارئ " الخروج إلى الحمراء " يلحظ أكثر من وشيجة مع " حليب اسود "، على الرغم من أن الرموز التاريخية المســتلهمة تنتمي إلـى زمانيـن مختلفين ومكانين مختلفين ( العصر العباسي في أوجه، عصر هارون الرشيد، والعصر الأموي في الأندلس في نهايته، عصر أبي عبد الله الصغير )، ويبدو أن المتوكل طه لم يستطع أن يتخلص من الإشكالية التي دفعته لكتابة " حليب أسود "، وهذه هي الصلة الأولى بين الديوانين.
يرد في " حليب أسود "، في التصدير: ] يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودّوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات، إن كنتم تعقلون [ .
ويرد أيضاً: " من فسدت بطانته، أوتي من مأمنه ". وهذا قول لخليفة عباسي.
ويقوم الديوان كله على فكرة الخليفة / البطانة، ويستلهم الشاعر علاقة الرشيد بالبرامكة ليقول من خلالها رأيه في علاقة الحاكم المعاصر بالبطانة المعاصرة، ولا ضرورة لتسمية الأسماء ولكشف الرمز. وتتكرر هذه الفكرة في " الخروج إلى الحمراء " مرتين. نقرأ في قصيدة " حوار في المنفى ( مع أبي عبد الله الصغير في فاس )" نقرأ الأسطر الشعرية التالية:
" قلت:
هذه بطانتك التي أمّرَّتها
وجعلتها الحكامَ دون سداد
أنت الذي اخترت النهاية عندما
اخترت الطريق وثلة الفساد " (ص42)
ونقرأ في قصيدة " منزلة الياسمين " المهداة إلى المحاصر:
" وهل سوف يبقى برامكة العصر
في بهوك الرحب " (ص76)
بل ونقرأ أيضاً، في قصيدة " هنا البارحة .. هناك اليوم "
"وفوق هذا وذاك نعرف الوزراء الخونة والدساسين والتجار...ونعرف غدنا أيضاً "(ص56)
وتحيلنا عبارة " الوزراء الخونة إلى " حليب أسود " وقصيدة " خبر عن صاحب الخبر: بعد أن تناسخت روحه، وحلّت في وزير .. بعد اثني عشر قرناً. هنا ينكشف الرمز ويتضح المدلول، بل لا يعود الرمز رمزاً، لأن الشاعر ما عاد يتحدث عن البرامكة، وإنما أخذ يكتب عن وزير معاصر. والوزير هنا كذوب وزير نساء وفاجر ويتاجر بالقضية ويشرب الويسكي ... الخ. (ص62 وما بعدها). بل وتحيلنا إلى ما يقوله أبو نواس في الأوضاع":
" القائمون على بيوت المال قد سرقوا البلاد، وأصبحوا وزراء أو أمراء، لكن الخليفة لا ينام "(ص49).
وإذا ما غضضنا الطرف عن شكل القصيدة في الديوان -، وثمة تشابه كبير إذ يمزج الشاعر بين أكثر من شكل، - فإننا يمكن أن نصغي إلى أصوات العامة في الديوانين. " في حليب أسود " عنوان هو: رجال من العامة يتسامرون وواحد منهم يروي هذه الحكاية " (ص41 وما بعدها)، وفي الرواية ثمة إدانة للواقع، إذ يفصل الوزراء بين الحاكم والرعية، ولا يصغي الأول إلى الأخيرين. وفي " الخروج إلى الحمراء " عنوان فرعي هو: " الناس في الأسواق "، وهنا نصغي إلى أصوات الناس فيما يقوم به أبو عبد الله:
" – لقد باع الجامع والحارة والأهل وأحلام
البسطاء "(ص37)
رموز تاريخية أدبية أخرى: المتنبي
تحضر في الديوان رموز تاريخية أدبية أخرى غير تلك التي تعود إلى عصر غرناطة في أيامها الإسلامية الأخيرة، وأبرز هذه الرموز العربية هي المتنبي، والمتنبي شخصية تاريخية غلب عليها الطابع الأدبي. وقد لفتت هذه الشخصية أنظار الشعراء والدارسين. وقد توقف أمام توظيفها في الشعر على عشري زايد وخالد الكركي الذي عاد وأنجز كتاباً خاصاً حول استحضار المتنبي في الشعر العربي الحديث، وعنوان الكتاب " الصائح المحكي: صورة المتنبي في الشعر العربي الحديث " ( بيروت، 1999).
والمتنبي شخصية إشكالية وقف منها الأدباء المعاصرون موقفاً غير موحد. مجده شعراء كثيرون مثل أدونيس ودرويش والبردوني، وقللّ من شأنه أدباء آخرون أبرزهم زكريا تامر في بعض قصصه، وتحديداً في قصة " نبوءة كافور الإخشيدي " من مجموعة " نداء نوح "(1994).
ويأتي المتوكل على ذكر المتنبي في قصيدة " منزلة الياسمين " وفيها يقول:
" وما كنت يوماً أنا المتنبي
لأطلب مملكة بالمديح،
وما كان والد أمي طاووس شعري،
فقد كان والدي الضخم
في سجن عكا وعتليت ...
وأمي في حبق الدار تبكي،
على سفح قلقيليا،
كي تعود البلاد إلى قمحها
في العجين ".(ص78).
وكما ذكرت، فإن هذه القصيدة، اعتماداً على قراءتها قراءة داخلية وربطها بالزمن الكتابي، هي موجهة لياسر عرفات. وإذا ذهبنا إلى أن أنا المتكلم هنا هي أنا الشاعر – أي المتوكل طه، فإنه يدافع عن نفسه رافضاً أن يكون مثل المتنبي الذي نشد الملك فمدح الملوك والأمراء والخلفاء. هكذا يرى المتوكل المتنبي: يكتب قصائد المديح حتى يحصل على الملك. وهكذا تبدو صورة المتنبي في نظر المتوكل صورة سلبية. ولعل ما يدعم رأيي هذا أنني كنت، شخصياً، ربطت بين المتنبي والمتوكل. ذهبت في كتابي " أدب المقاومة "(1998) إلى أن المتوكل حين يقول: " إن للشاعر لسانين "، غدا " مثالاً جديداً لسلفه المتنبي "(ص145). ولعله هنا يرد على هذا، وهكذا نلحظ، ثانية، تجاوراً لزمنين: زمن تسليم مفاتيح غرناطة، وزمن الشاعر المتوكل، الزمن الشعري والزمن الكتابي. وهذا يحيلنا من جديد إلى عنوان المعنى والمغزى، وإلى حدود التاريخ وحدود الواقع في الديوان.
يكتب د. الجعيدي في دراسته، حين يأتي على ذكر غرناطة، يكتب:
" وتظل مملكة غرناطة في الشعر الفلسطيني درساً من دروس التاريخ لا ينضب، يتجدد ويقدم العبرة لمن اعتبر. ففي " قصر الحمراء " يقدم الشاعر درساً لمن قصر نظره عن رؤية التاريخ رؤية شمولية، ويحذر من مغبة التمادي في ذلك حتى لا يعبث معاصرونا بمصير الأجيال القادمة "(ص40).
ويقول المتوكل طه:
" غرناطة بعد التسليم
تلد ملايين البلدان على موسيقى سيارات الجكوار
إلى الصحراء المسلوبة زيت الأحياء "ز(ص98)
وكأنها لم تكن عبرة وكأننا لم نعتبر، فخسرنا بلداً تلو آخر. ولعل هناك كلاماً كثيراً يمكن أن يقال في هذا الديوان وفي ديوان " حليب أسود "، ولعل المتوكل هنا حقق ما لم يحققه في مجموعاته السابقة، على صعيد الشعر، وعلى صعيد استلهام التاريخ أيضاً.
ــــــــــــ
- حول الديوان انظر ما كتبه " مغير البرغوثي " وأحمد رفيق عوض. وقد أدرجت المقالتان في كتاب " صورة الغناء: دراسات في إبداع المتوكل طه "، من إعداد مراد السوداني، رام الله 2003. [ص197-ص219] [ص221-227].
نابلس 26/6/2003
الرمز التاريخي في ديوان المتوكل طه "الخروج إلى الحمراء" - مؤسسة فلسطين للثقافة
" الخروج إلى الحمراء " هو آخر ديوان للمتوكل طه، وقد صدر (أيلول 2002) عن دار الزهراء / بيت الشعر في رام الله. وفيه يعاود الشاعر استلهام الرمز التاريخي، ويواصل
www.thaqafa.org