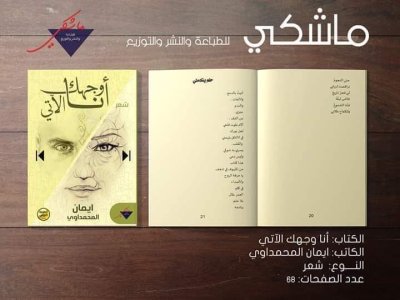اعتدنا رؤيتها كمن اعتاد رؤية تمثال وسط المدينة، أو كحلم من أحلامنا المتكرّرة حين تسطو عليها يد الحقيقة.
اسمها حياة، أو الحجة حياة كما كنا نطلق عليها. في ركنها المعتاد الذي اختارته برويّة؛ كانت تجلس وحيدة على كرسيّ أسود قديم في رصيف مجاور لمدرستنا الابتدائية.
تقيم فيه كعنوان ثابت لها بعد أن بعثرتها الأرصفة، ترقب بعيون شاردة من دخل إلى المدرسة ومن خرج منها، تمنحنا بعض الحلوى من جيب معطفها الأسود وابتسامة طيبة نحملها في جوارحنا حتى تتلقّفنا صفوف المدرسة.
لم تكن تكلم أحداً إلا نادراً، الصمت بعض هيئتها، شغلها التسبيح والتهليل عن لغة ما عادت تتقنها، فإذا أذّن المؤذن كانت أول المنصرفين إلى الصلاة.
ألفها الجوار وأحبها الأطفال، تعلقنا بها وتعاطفت معها معلمات مدرستنا لما رأين من صلاحها ورقيّ كلماتها رغم ندرتها، وبدأن يفتقدنها في الأيام التي كانت فيها تغيب. وحين كنّ يسألنها عن سبب غيابها؛ كانت تطمئنهن عن صحتها بتمتمات خافتة ثم لا تلبث أن تستكين لذلك الصمت الجليل الممزوج مع الكثير من الأحزان.
لم أكن قد تجاوزت عامي السادس وقتها؛ إلا أن شيئاً من الانتماء بدأ يربطني بها، فالحب يستدرجنا منذ الطفولة نحو الحقيقة، وعندما نكبر، يبقى شيء كالضباب فوق رؤانا، حتى إذا حاولنا السقوط فوق أدراج الذاكرة لنتعرّف عليه نجد أننا لم نعد نعيه.
كثيرة هي التفاصيل التي كانت تربطني بها، تفاصيل عمر تحولت إلى ذكريات ثمينة ما زلت ألتقطها حتى اليوم من لحظاتنا معاً. فقد استطاعت احتواءنا بنهر حنانها الجارف، واحتواء انفجاراتنا الجامحة، وأنواء طقوسنا الغرائبية، وسخريتنا في البداية من جلوسها قرب باب المدرسة.. من غموض صمتها.. من الهدايا الرخيصة التي تقدمها لنا بلا مناسبة...من معطفها الأسود الذي مشى عليه شبح الزمن منذ عقود.
كان لصداقتنا معها ذاك المذاق الطفولي يوم كنا صغاراً في تفتّحنا الأول، حيث كنا نلبس الحاضر القليل من الخبرة والكثير من دهشة السؤال. لأننا كنا ندرك كهارب حنانها الخفية، وقلبها الكبير الذي اتّسع لعثراتنا، وحسن مشورتها، وطاقتها على العطاء، بدءا من حلّ مشاكلنا وخصاماتنا وحتى التوسط لنا عند معلماتنا حين كنا ننال عقابا على تقصيرنا.
فكانت تتغاضى عن فوضانا وثرثراتنا،
تطالعنا بابتسامتها المعتادة وكأنها تقول بعينيها المحتشدتين بالنبوءات: صدقوني إن قلت إنني سعيدة بمكاني هذا وأنا أنظر إليكم داخلين وخارجين، سعيدة بكوني تلك اللافتة المرميّة على هامش الطريق.
حاولت مرة أن تبتعد عن ذلك المكان وتختصر قسوة الأسئلة التي تتلقاها، لكنها ما لبثت أن عادت بعد أيام، كأنها اكتشفت أن شيئاً ما يشدّها إليه دائماً، كالضوء الباهت يخنقها بحنان، أو ربما لأنه كان بيننا دوماً وعد باللقاء.
لم نسأل يوماً أين تسكن، وكيف تعيش، ولم اختارت هذا المكان تحديداً. ولم كانت عيناها تشرقان بنور غريب عندما تلقانا، ولم كانت تتجاهل بقية المارّة الذين ينظرون لها بغرابة كمن ارتكبت حماقة التواجد صدفة على حافة الحياة.
لن أنسى ذلك الصباح الذي ذهبت فيه إلى المدرسة لأجد كرسيها خاليا،
كانت الرياح خريفية تنفض عن أوصالها أتربة الدمع لتودعها قلبي وتملأ أوردتي بالكثير من الحنين واللهفة لها، تحسست صلابة خشب الكرسيّ الباهت وعيناي تزحفان فوق مسام اللون الداكن أتلمس فيه دنيا من عطاء، وآفاقا صوفية الأبعاد، وروحا مغادرة لقديسة منسية تقاسمت معها وجع المكان، ورائحة الكثير من الأولياء والصالحين الذين شاركوها ذات الجراح.
تجمعنا في ممرّ المشفى بالقرب من غرفة العناية وقلوبنا تهفو لسماع خبر ما يبشرنا بسلامتها، تناهى إلى سمعي صوت إحدى النساء تهمس للأخرى:
_ رحمها الله، لا أقارب عندها ولا ولد، كانت عاقراً.
كان الممرض ينهرنا بعنف ونحن نتدافع قرب باب غرفتها لرؤيتها، وحين صرخ الطبيب مستفهماً عن سبب الضجيج؛ أجابه بذهول:
_ حشد من الأطفال يدّعون أنهم أولادها، عددهم مئة، أو يزيدون!
إيمان شرباتي/ سورية
اسمها حياة، أو الحجة حياة كما كنا نطلق عليها. في ركنها المعتاد الذي اختارته برويّة؛ كانت تجلس وحيدة على كرسيّ أسود قديم في رصيف مجاور لمدرستنا الابتدائية.
تقيم فيه كعنوان ثابت لها بعد أن بعثرتها الأرصفة، ترقب بعيون شاردة من دخل إلى المدرسة ومن خرج منها، تمنحنا بعض الحلوى من جيب معطفها الأسود وابتسامة طيبة نحملها في جوارحنا حتى تتلقّفنا صفوف المدرسة.
لم تكن تكلم أحداً إلا نادراً، الصمت بعض هيئتها، شغلها التسبيح والتهليل عن لغة ما عادت تتقنها، فإذا أذّن المؤذن كانت أول المنصرفين إلى الصلاة.
ألفها الجوار وأحبها الأطفال، تعلقنا بها وتعاطفت معها معلمات مدرستنا لما رأين من صلاحها ورقيّ كلماتها رغم ندرتها، وبدأن يفتقدنها في الأيام التي كانت فيها تغيب. وحين كنّ يسألنها عن سبب غيابها؛ كانت تطمئنهن عن صحتها بتمتمات خافتة ثم لا تلبث أن تستكين لذلك الصمت الجليل الممزوج مع الكثير من الأحزان.
لم أكن قد تجاوزت عامي السادس وقتها؛ إلا أن شيئاً من الانتماء بدأ يربطني بها، فالحب يستدرجنا منذ الطفولة نحو الحقيقة، وعندما نكبر، يبقى شيء كالضباب فوق رؤانا، حتى إذا حاولنا السقوط فوق أدراج الذاكرة لنتعرّف عليه نجد أننا لم نعد نعيه.
كثيرة هي التفاصيل التي كانت تربطني بها، تفاصيل عمر تحولت إلى ذكريات ثمينة ما زلت ألتقطها حتى اليوم من لحظاتنا معاً. فقد استطاعت احتواءنا بنهر حنانها الجارف، واحتواء انفجاراتنا الجامحة، وأنواء طقوسنا الغرائبية، وسخريتنا في البداية من جلوسها قرب باب المدرسة.. من غموض صمتها.. من الهدايا الرخيصة التي تقدمها لنا بلا مناسبة...من معطفها الأسود الذي مشى عليه شبح الزمن منذ عقود.
كان لصداقتنا معها ذاك المذاق الطفولي يوم كنا صغاراً في تفتّحنا الأول، حيث كنا نلبس الحاضر القليل من الخبرة والكثير من دهشة السؤال. لأننا كنا ندرك كهارب حنانها الخفية، وقلبها الكبير الذي اتّسع لعثراتنا، وحسن مشورتها، وطاقتها على العطاء، بدءا من حلّ مشاكلنا وخصاماتنا وحتى التوسط لنا عند معلماتنا حين كنا ننال عقابا على تقصيرنا.
فكانت تتغاضى عن فوضانا وثرثراتنا،
تطالعنا بابتسامتها المعتادة وكأنها تقول بعينيها المحتشدتين بالنبوءات: صدقوني إن قلت إنني سعيدة بمكاني هذا وأنا أنظر إليكم داخلين وخارجين، سعيدة بكوني تلك اللافتة المرميّة على هامش الطريق.
حاولت مرة أن تبتعد عن ذلك المكان وتختصر قسوة الأسئلة التي تتلقاها، لكنها ما لبثت أن عادت بعد أيام، كأنها اكتشفت أن شيئاً ما يشدّها إليه دائماً، كالضوء الباهت يخنقها بحنان، أو ربما لأنه كان بيننا دوماً وعد باللقاء.
لم نسأل يوماً أين تسكن، وكيف تعيش، ولم اختارت هذا المكان تحديداً. ولم كانت عيناها تشرقان بنور غريب عندما تلقانا، ولم كانت تتجاهل بقية المارّة الذين ينظرون لها بغرابة كمن ارتكبت حماقة التواجد صدفة على حافة الحياة.
لن أنسى ذلك الصباح الذي ذهبت فيه إلى المدرسة لأجد كرسيها خاليا،
كانت الرياح خريفية تنفض عن أوصالها أتربة الدمع لتودعها قلبي وتملأ أوردتي بالكثير من الحنين واللهفة لها، تحسست صلابة خشب الكرسيّ الباهت وعيناي تزحفان فوق مسام اللون الداكن أتلمس فيه دنيا من عطاء، وآفاقا صوفية الأبعاد، وروحا مغادرة لقديسة منسية تقاسمت معها وجع المكان، ورائحة الكثير من الأولياء والصالحين الذين شاركوها ذات الجراح.
تجمعنا في ممرّ المشفى بالقرب من غرفة العناية وقلوبنا تهفو لسماع خبر ما يبشرنا بسلامتها، تناهى إلى سمعي صوت إحدى النساء تهمس للأخرى:
_ رحمها الله، لا أقارب عندها ولا ولد، كانت عاقراً.
كان الممرض ينهرنا بعنف ونحن نتدافع قرب باب غرفتها لرؤيتها، وحين صرخ الطبيب مستفهماً عن سبب الضجيج؛ أجابه بذهول:
_ حشد من الأطفال يدّعون أنهم أولادها، عددهم مئة، أو يزيدون!
إيمان شرباتي/ سورية