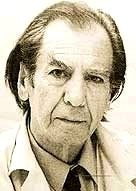تمنّت لو تقوله له: "تعال أنت وأسرتك وعيشوا هنا. بيتي واسع رحب دافئ."
لكنها ظلت صامتة. كانت تعلم أنه لن يتقبل الفكرة بل سيعتبر دعوتها ودّاً مصطنعاً وخبثاً.
حين اعتذر لها عن تأخره بقوله أنه منهمكاً بتركيب المدفأة في البيت لأن البرد غداً قارساً والأطفال يقاسون، تحاشت أن تشهق استغراباً.
لم تكن تدري أن هناك أسراً تعيش في المدينة حتى هذه اللحظة دون مدفأة!
منذ شهرين والدفء يرفرف في أرجاء بيتها الواسع.
وأحست بوخزة في أعماقها.
لا شك في أنّ هناك طبقة تجهل آلام الشعب وهي منها!
لم تقل شيئاً بل اندمجت معه في الحديث:
-وهل اشتغلت المدفأة؟
قال:
-طبعاً.. وقد تركت غرفة الجلوس دافئة.. كالنار.. والأطفال يلعبون سعداء.
الفرح في لهجته جعلها تحسّ في أعماقها بشيء يشبه تأنيب الضمير.
مدفأة صغيرة تسعد أسرة بكاملها. وهي التي لم يخطر في بالها يوماً أن تشكر الحظ بل أن تدرك إنه حظ هذا الذي جعلها تجهل حتى الآن أن هناك أناساً يموتون كل يوم من البرد.
وتلفتت حولها.
وخيل إليها وكأنها قد ارتكبت جريمة بسكناها في هذا البيت الدافئ. هذا البيت الذي عرفته دافئاً منذ فتحت عينيها للنور.
وأرادت أن تغيّر مجرى أفكارها. فتململت في جلستها وسألته في لهجة عادية:
-إذن.... أنت لم تنم بعد الظهر؟
هز رأسه في حسرة:
-أنىّ لي أن أنام؟ بل متى كنت أستطيع أن أنام في البيت خلال النهار؟ الأطفال يزعقون وزوجتي عصبية المزاج تزعق هي الأخرى... والضجيج يملأ البيت..
استمرت في الحديث فقط لتهرب من شعورها بالذنب. فقالت:
-ادخل غرفة النوم واقفل عليك الباب واسترح ساعة.
رمقها معاتباً:
-ما بكِ؟ يجب أن تزورينا لتري بيتنا! غرفة النوم متصلة بغرفة الجلوس. وهي لا تحوي سوى سريرين حديدّين ضيقين. أنام أنا وزوجتي على أحدهما والأطفال على الآخر.. فكيف تريدينني أن أدخل الغرفة وأقفل عليهم الباب؟
لم تعد تدري ما تقول هي تجهل هذا النوع من العيش.
ومع أنها واثقة من أن الذنب ليس ذنبها إلا أن مضايقتها ازدادت. وظلّ هذا الشعور الذي يشبه تأنيب الضمير ينخز أعماقها.
لا! ليس ذنبها أنها نشأت في طبقة ميسورة وأنها ورثت عن أهلها مبلغاً من المال وهذا البيت الدافئ.
مات أهلها. ورحل من رحل. وظلتّ هي وحيدة في هذه المدينة لأنها تكره الاغتراب ولأنها منذ طفولتها كانت تنادي بالثورة.
ومرت سنوات
وتعرفت إليه.
شاب ريفي ملتزم. من أولئك النادرين الذين لم يعتبروا الثورة يوماً طريقاً لمركز أو وسيلة جميل الطلعة. صافي الملامح. يرى العالم من خلال منظار محدود ولكن نقيّ. يريد أن يبني الوطن من جديد وعلى الشكل الأحسن لكنه لم يدرس طرق البناء، مستعد بجدّ أن يموت من أجل المستقبل الأفضل.
وارتاحت لهذا الشاب المؤمن. وأحست بأنها قادرة على أن تقدم إليه صداقة ظلت مكبوتة في نفسها سنوات.
وأحبها هو.
كانت حلوة طيبة مرهفة. والأهم كانت ربيبة طبقة وابنة مدينة. وكانت هاتان الصفتان تثيران كل وافد جديد ينقم على المدينة. يريد إصلاح المدينة. يسكن المدينة. ويرفض أن يتعرف بأنه لا شعورياً يبحث في المدينة له عن جذور.
ونمت بين هذين الإنسانيين المختلفين صداقة متينة.
وصار يزورها كل مساء كل مساء، فيجدها كل مساء كل مساء في انتظاره.
لم يعترف لها بحبه. فقد علموه أن العواطف تقتل الرجولة وبالتالي تسيء إلى القضيّة... وصدّق.
ولم تخبره بارتياحها له. فقد اكتشفت خلال السنوات الفائتة كم أن خبراً كهذا يدع للتبجح وللمتاجرة. وخافت.
كل ما هنالك.. كان يعلم أنها تعيش في مدينتها غريبة. وكانت تعلم.... أنه يعلم.
قصة المدفأة أزعجتها. بل أزعجها شعورها بالذنب فنهضت من مكانها قائلة:
-سأهيئ له فنجاناً من الشاي.
وشعرت وهي تمشي في القاعات الكبيرة متجهة صوب المطبخ بحاجة لأن تقول له:
"بيتي كبير دافئ. ليتكم –أنت وزوجك والأطفال –تقيمون معي. أنا وحدي ووحيدة.
وأنا أكره الوحدة. أخاف الوحدة".
لكنها ظلت صامتة.
هل يستطيع هذا الصديق أن يقدر ما هي الوحدة؟
هل يستطيع أن يصدّق أن هناك صقيعاً نفسياً ذابحاً يجعل الإنسان يتخلى عن كل شيء ويبيع الدنيا بهمسة ودّ؟
لا! عليه أولاً أن يحصل على كل شيء.... ثم يصاب بأمراض الوحدة والملل والفراغ... لذا راحت وهي تقدم له الشاي تحدثه عن أمور عادية. عن بلاده غريبة بلاد باردة بيضاء زارتها في طفولتها.....
ومرّ الوقت.
ونظر إلى ساعته وابتسم قائلاً:
-الوقت معك يمضي بسرعة.
ونهض. فرافقته حتى الباب.
ودّعها. وخرج.
ظلت واقفة تنظر إليه حتى غاب عن عينيها.
دارت في بطء على نفسها ودخلت على مهل.
وبدا لها بيتها الواسع الدافئ موحشاً مخيفاً.
وراحت تدور في الغرف الرحبة، تبحث عبثاً في كل زاوية عن همسة ودّ.
وحين وصلت إلى غرفة نومها الأنيقة المبطّنة بالستائر المخملية والسجاد. وقفت على العتبة.
وسرت قشعريرة باردة في جسدها.
منظر سريرها العريض المغطى بالرياض والفرو أخافها. لقد بدا واسعاً مُوحشاً كالصحراء.
وبسرعة دارت لا شعورياً وعادت إلى حيث كانا جالسين. ووقفت محنية الظهر تحاول استحضار طيف الصديق الذي ذهب منذ لحظات.
وخيل إليها أنها تراه.
هاهو يصل إلى بيته الصغير البارد. إنه يدخل على رؤوس أصابعه. ويتمهل في غرفة الجلوس أمام المدفأة المطفأة. إنه يتحسسها بيديه وهاهو يبتسم وقد يشعر بآثار نيران رقص حولها الأطفال.
إنه يتأكد من أنها مطفأة، ثم يتجه إلى غرفة النوم الخالية من الستائر ومن السجاد ومن مدفأة.
الجميع نيام.
يقترب من الأطفال. يغلفهم بنظرات حنانه. ثم يحمل الغطاء الوحيد الذي تدحرج إلى الأرض ويضعه عليهم في سكون.
وأخيراً هاهو يخلع ثيابه على عجل وينزلق مسرعاً، وهو يرتجف من البرد، تحت اللحاف الرقيق إلى جانب زوجه في السرير الحديدي الضيق... الضيق...
وأحست بنفسها فجأة وحيدة.. وحيدة كالحيوان المريض فحضنت ذراعيها بيديها، ورفعت كتفيها كما لتُغرق بينها رأسها المتعب. وتكوّمت خائفة مرتجفة في زاوية الديوان المريح...
وبصورة غريزية فاضت عيناها بالدمع..
لكنها ظلت صامتة. كانت تعلم أنه لن يتقبل الفكرة بل سيعتبر دعوتها ودّاً مصطنعاً وخبثاً.
حين اعتذر لها عن تأخره بقوله أنه منهمكاً بتركيب المدفأة في البيت لأن البرد غداً قارساً والأطفال يقاسون، تحاشت أن تشهق استغراباً.
لم تكن تدري أن هناك أسراً تعيش في المدينة حتى هذه اللحظة دون مدفأة!
منذ شهرين والدفء يرفرف في أرجاء بيتها الواسع.
وأحست بوخزة في أعماقها.
لا شك في أنّ هناك طبقة تجهل آلام الشعب وهي منها!
لم تقل شيئاً بل اندمجت معه في الحديث:
-وهل اشتغلت المدفأة؟
قال:
-طبعاً.. وقد تركت غرفة الجلوس دافئة.. كالنار.. والأطفال يلعبون سعداء.
الفرح في لهجته جعلها تحسّ في أعماقها بشيء يشبه تأنيب الضمير.
مدفأة صغيرة تسعد أسرة بكاملها. وهي التي لم يخطر في بالها يوماً أن تشكر الحظ بل أن تدرك إنه حظ هذا الذي جعلها تجهل حتى الآن أن هناك أناساً يموتون كل يوم من البرد.
وتلفتت حولها.
وخيل إليها وكأنها قد ارتكبت جريمة بسكناها في هذا البيت الدافئ. هذا البيت الذي عرفته دافئاً منذ فتحت عينيها للنور.
وأرادت أن تغيّر مجرى أفكارها. فتململت في جلستها وسألته في لهجة عادية:
-إذن.... أنت لم تنم بعد الظهر؟
هز رأسه في حسرة:
-أنىّ لي أن أنام؟ بل متى كنت أستطيع أن أنام في البيت خلال النهار؟ الأطفال يزعقون وزوجتي عصبية المزاج تزعق هي الأخرى... والضجيج يملأ البيت..
استمرت في الحديث فقط لتهرب من شعورها بالذنب. فقالت:
-ادخل غرفة النوم واقفل عليك الباب واسترح ساعة.
رمقها معاتباً:
-ما بكِ؟ يجب أن تزورينا لتري بيتنا! غرفة النوم متصلة بغرفة الجلوس. وهي لا تحوي سوى سريرين حديدّين ضيقين. أنام أنا وزوجتي على أحدهما والأطفال على الآخر.. فكيف تريدينني أن أدخل الغرفة وأقفل عليهم الباب؟
لم تعد تدري ما تقول هي تجهل هذا النوع من العيش.
ومع أنها واثقة من أن الذنب ليس ذنبها إلا أن مضايقتها ازدادت. وظلّ هذا الشعور الذي يشبه تأنيب الضمير ينخز أعماقها.
لا! ليس ذنبها أنها نشأت في طبقة ميسورة وأنها ورثت عن أهلها مبلغاً من المال وهذا البيت الدافئ.
مات أهلها. ورحل من رحل. وظلتّ هي وحيدة في هذه المدينة لأنها تكره الاغتراب ولأنها منذ طفولتها كانت تنادي بالثورة.
ومرت سنوات
وتعرفت إليه.
شاب ريفي ملتزم. من أولئك النادرين الذين لم يعتبروا الثورة يوماً طريقاً لمركز أو وسيلة جميل الطلعة. صافي الملامح. يرى العالم من خلال منظار محدود ولكن نقيّ. يريد أن يبني الوطن من جديد وعلى الشكل الأحسن لكنه لم يدرس طرق البناء، مستعد بجدّ أن يموت من أجل المستقبل الأفضل.
وارتاحت لهذا الشاب المؤمن. وأحست بأنها قادرة على أن تقدم إليه صداقة ظلت مكبوتة في نفسها سنوات.
وأحبها هو.
كانت حلوة طيبة مرهفة. والأهم كانت ربيبة طبقة وابنة مدينة. وكانت هاتان الصفتان تثيران كل وافد جديد ينقم على المدينة. يريد إصلاح المدينة. يسكن المدينة. ويرفض أن يتعرف بأنه لا شعورياً يبحث في المدينة له عن جذور.
ونمت بين هذين الإنسانيين المختلفين صداقة متينة.
وصار يزورها كل مساء كل مساء، فيجدها كل مساء كل مساء في انتظاره.
لم يعترف لها بحبه. فقد علموه أن العواطف تقتل الرجولة وبالتالي تسيء إلى القضيّة... وصدّق.
ولم تخبره بارتياحها له. فقد اكتشفت خلال السنوات الفائتة كم أن خبراً كهذا يدع للتبجح وللمتاجرة. وخافت.
كل ما هنالك.. كان يعلم أنها تعيش في مدينتها غريبة. وكانت تعلم.... أنه يعلم.
قصة المدفأة أزعجتها. بل أزعجها شعورها بالذنب فنهضت من مكانها قائلة:
-سأهيئ له فنجاناً من الشاي.
وشعرت وهي تمشي في القاعات الكبيرة متجهة صوب المطبخ بحاجة لأن تقول له:
"بيتي كبير دافئ. ليتكم –أنت وزوجك والأطفال –تقيمون معي. أنا وحدي ووحيدة.
وأنا أكره الوحدة. أخاف الوحدة".
لكنها ظلت صامتة.
هل يستطيع هذا الصديق أن يقدر ما هي الوحدة؟
هل يستطيع أن يصدّق أن هناك صقيعاً نفسياً ذابحاً يجعل الإنسان يتخلى عن كل شيء ويبيع الدنيا بهمسة ودّ؟
لا! عليه أولاً أن يحصل على كل شيء.... ثم يصاب بأمراض الوحدة والملل والفراغ... لذا راحت وهي تقدم له الشاي تحدثه عن أمور عادية. عن بلاده غريبة بلاد باردة بيضاء زارتها في طفولتها.....
ومرّ الوقت.
ونظر إلى ساعته وابتسم قائلاً:
-الوقت معك يمضي بسرعة.
ونهض. فرافقته حتى الباب.
ودّعها. وخرج.
ظلت واقفة تنظر إليه حتى غاب عن عينيها.
دارت في بطء على نفسها ودخلت على مهل.
وبدا لها بيتها الواسع الدافئ موحشاً مخيفاً.
وراحت تدور في الغرف الرحبة، تبحث عبثاً في كل زاوية عن همسة ودّ.
وحين وصلت إلى غرفة نومها الأنيقة المبطّنة بالستائر المخملية والسجاد. وقفت على العتبة.
وسرت قشعريرة باردة في جسدها.
منظر سريرها العريض المغطى بالرياض والفرو أخافها. لقد بدا واسعاً مُوحشاً كالصحراء.
وبسرعة دارت لا شعورياً وعادت إلى حيث كانا جالسين. ووقفت محنية الظهر تحاول استحضار طيف الصديق الذي ذهب منذ لحظات.
وخيل إليها أنها تراه.
هاهو يصل إلى بيته الصغير البارد. إنه يدخل على رؤوس أصابعه. ويتمهل في غرفة الجلوس أمام المدفأة المطفأة. إنه يتحسسها بيديه وهاهو يبتسم وقد يشعر بآثار نيران رقص حولها الأطفال.
إنه يتأكد من أنها مطفأة، ثم يتجه إلى غرفة النوم الخالية من الستائر ومن السجاد ومن مدفأة.
الجميع نيام.
يقترب من الأطفال. يغلفهم بنظرات حنانه. ثم يحمل الغطاء الوحيد الذي تدحرج إلى الأرض ويضعه عليهم في سكون.
وأخيراً هاهو يخلع ثيابه على عجل وينزلق مسرعاً، وهو يرتجف من البرد، تحت اللحاف الرقيق إلى جانب زوجه في السرير الحديدي الضيق... الضيق...
وأحست بنفسها فجأة وحيدة.. وحيدة كالحيوان المريض فحضنت ذراعيها بيديها، ورفعت كتفيها كما لتُغرق بينها رأسها المتعب. وتكوّمت خائفة مرتجفة في زاوية الديوان المريح...
وبصورة غريزية فاضت عيناها بالدمع..