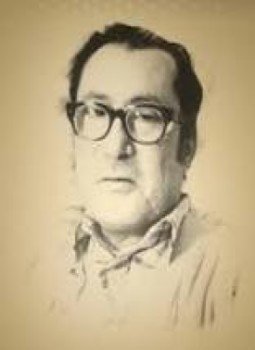خمسة عشرة سنة مرت وهو بعيد عن وطنه؛ يعاني آلام الغربة، ويكافح أعياء الحياة، ويتلمس الطريق إلىمستقبل جميل.
خمسة عشرة سنة لقي فيها أشد العناء، وقاسا ضروباً من الفاقة والعسر وثقلت على عاتقه تكاليف العيش. . . واليوم يرجع إلىوطنه بعد الكفاح المضني، والفراق الطويل، وقد أمحى من عينيه إئتلاق الشباب، وتحولت صباحة وجهه إلىجهامة منكره، وذبول حزين. . . فقد حطم خمسا وثلاثين سلسلة من السلاسل التي تربطه بالوجود، وأخذ يترقب الانحدار إلىالجانب الثاني من تل الحياة ليستقبل السلام الأبدي في قراره الوادي السحيق! فلاح الإجهاد على محياه، وغشيه موج من الحزن عميق.
الآن يرجع إلىوطنه، ويستقبل هذا الشارع الضيق الذي يعرفه حق المعرفة، وتصدمه رائحة العفونة المنبعثة من أكوام الأقذار، وتملأ عيناه منظر الأحجار التي ما زالت قائمة بها يد الإنسان، ولم تنل منها صروف خمس عشرة سنة!
يا للعجب!. . ويا لمرارة الذكرى!. . خمس عشرة سنة ما أحفلها بالأحداث والغير، وما أثرعها بالشجون والغصص، وما أكثر ما غيرت منه، وما جارت على بنيانه الإنساني! ونقلته من حال إلىحال. ولكن الشارع ما زال كما عهده لم يتغير منه أي شيء! إنه ليتذكر كل شيء فيه كأنما غادره أمس. . رحل عند إغفاءة النهار في أحضان الليل، ورجع في يقظة الليل على ترانيم الفجر! فإن صور الليلة التي غادر فيها موطنه ما زالت مرتسمة في صفحة مخيلته، وما زالت ظلالها الحية عالقة في ذهنه. وإنه ليتذكر أمه وهي تتشنج لتعبر عن عاطفتها الحبيسة، وتضطرب شفتاها كورقتين ذابلتين، وتشرق عيناها بالدموع وهو بين ذراعيها مخنوق بالعبرة، ذاهل الفكر، مسلوب الإرادة. وكان الطريق - إذ ذاك - متوشحا رداء الغروب كأنه يحس بلوعة القلوب الواجفة!. .
واليوم يرجع إلىأهله، ونفسه مفعمة بالحزن الكظيم، وبمشاعر لا يتبينها في منظار ضميره، وفي عين وجدانه. ولكنه يضرب برجليه في تراب الطريق الحائل اللون، ويتعثر بحجارته الصغيرة السوداء، وعيناه تحدقان بالبيوت القاتمة على الجانبين كأنها تنتظره!. . .
وامتلأت خياشيمه برائحة كان ينفر منها أشد النفور، ويضيق بها أعظم الضيق، ومع ذلك فقد كان يلقاها مكرها حين يخرج من بيته، ويمر بها - مسوقا إليه ا - حين يعود إليه. ولكن اليوم يحس إحساسا قويا عنيفا بأنها تعطر نفسه التي أفسدتها الغربة، ودمرها الجفاف!
ما أجمل هذا الطريق! وما أبدع ما سطر من ذكريات في سفر السنين، قليلها حلو سائغ، وسائرها مغرق في المرارة! فهو لا يكاد يذكر أنه قطعه مرة وهو خالي النفس من الألم، صافي الفكر من الهواجس والظنون، فكثيراً ما كانت تمتلئ نفسه بالألم ويحس في الضيق يدب في مفاصله، فيهرع إلىبيته يلوذ به من الهجير ويتقي تحت سقفه لوافح الألم وسموم الهواجس والظنون.
وقطع بعضا من الطريق وهو يتلفت. كل شيء كما خلفه قبل خمسة عشر عاماً كأنما السنون تمر على جوانبه مر النسيم! وتمنى لو يدلف إلىبعض البيوت ليرى سكانها أتغيروا مثلما تغير وعضهم الدهر بناجذيه كما عضه هو؟. . ولا شك أنهم سينكرونه أشد الإنكار لما أصابه من شحوب مخيف، وكبر بالغ، حتى كأنه قطع خمسين حجة، وأفضت به السن إلىكهولة واهية!. فالشيب تسلل إلىشعره كما تتسلل الخيوط البيض من الفجر في لمة الليل الفاحم والسنون اللافحة بسمومها أذوت نظارته، وسيلته المرح، وأهدته كآبة لاذعة، ووجوماً ثقيلا.
ووصل إلىبيته، وأطل على باحتة من العتبة العالية، وألقى نظرة واجمة على الداخل. على الجدران المسودة من لفح الدخان، والأرض المهشمة البلاط، وأبواب الغرف الضيقة المظلمة الأغوار؛ ولمح في تطواف عينيه كتلة بشرية جالسة القرفصاء، ساندة رأسها على ذراعيها المتشابكتين.
وعرفها فتحركت في أرجاء نفسه اللواذع. وجاشت لواعج وجدانه فناداها: - أماه!. . أماه!
فارتفع رأس المرأة فجاءة، ونظرت عينان صغيرتان حائرتان، وأرتجفت شفتان ذابلتان، واختلجت أسارير وجه معروق.
أماه! لفظ جميل سرى في جسدها كالتيار الكهربائي. . لقد أطال عهد سماعها به، فلما سمعته ترددت في أعماق نفسها أصداء بعيدة، صادرة من ماضي سحيق، واعترتها رعشة. ودار في خلدها أنها تعرف صاحب هذا الصوت.
وتقدم المغترب خطوات ثقالا، فلمحت الأم شبحا يقبل عليها فنظرت بجهد إلىوجهه، فلاح لها من بين أهداب عينها وجه شاحب هزيل. فتمتمت قائلة وهي لا تصدق ما رأت عيناها.
- عبد الرحمن!؟
وألقى الرجل جسمه في أحضان أمه كالطفل الخائف من الأشباح!، وخضلت الدموع الشفاه المحمومة التي طفقت تعبر عن حنانها بالقبل النهمة، وتفصح عن شوقها بالهمهمات.
وأرادت الأم أن تقول ولكن لسانها خانها، فتلجلجت، وتعثرت الألفاظ على شفتيها المرتجفتين، فأمسكت رأس الرجل بيديها، ونظرت في عينه كأنها تريد أن تستنطقها، ولثمتها لثمات حرار وهي تبكي بصوت خافت.
ولم يستطع الرجل من جانبه أيضا أن يعبر عن إحساسه إلىبشيء واحد وهو: أماه. . . أماه. . . بينما ظلت الأم تحت اللفظة السحرية تسكر وتحس نشوة من عبيرها الذاكي. ولكنها لا تملك إلا اللثمات!
وأخيرا نطقت بصوت تترقرق فيه العبرة:
- أحق أن حلمي قد تحقق، وانك رجعت إلىبيتي بعد غياب طويل!؟
ومسدت بيديها شعره، والتهمته بنظراتها وهو صامت بين يديها كالتمثال. . .
قالت والعبرة لا تزال تقطر من ألفاضها:
- لقد عذبني غيابك، وفرى صبري. لقد كنت أشفق عليك من أغوال الغربة، وأخشى عليك انقطاع الأسباب بك. ويئس أهلك منك إلا أنا فقد كنت موقنة أعظم اليقين أنك سوف ترجع إلي يوما ما.
وضمته إلىصدرها كأنها تريد أن تطرد الوساوس التي تنتابها. ثم قالت: - والآن رجعت. واستجاب الله دعائي وصلواتي. فقد كانت نفسي ممتلئة بك، منتظرة إيابك، تترقبه في كل لحظة، وتتعزى بالأمل عن نكد الدنيا وغصص العيش.
وخنقتها العبرة كالكابوس، وتفرست في وجهه الشاحب المقطب المهيمن عليه الحزن والجمود، وتطلعت إلىالجهامة المرتسمة على صفحاته. فأغمض الرجل عينيه واستسلم إلىارتياح جميل!
وجاء أهله باشين متهللين. يا عجبا! كأنه لم يعرفهم. . إن خمسة عشر عاما كفيله بأن تخلق جيلا جديدا، وتباعد بين المقترب وأهله. وتخلق برزخا واسعا بينه وبينهم!
وطوف ببصره في أرجاء المنزل، منزل الذكريات. . يا الله. ما أصلب هذا الحجر، وما أعظم جبروته! إن الكائن الإنساني تهدمه معاول الدهر، وتزعزعه نكبات الأيام؛ أم الجماد فإن الدهر يترقرق من جوانبه كما يترقرق الماء الزلال من صخرة جلمود!
ووقع بصره على غرفته الخاصة فرأى بابها موصدا، ورأته أمه يحدق فيها فقالت:
- إنها كما تركتها؛ لم تطأ عتبتها قدم، ولم تجل في أرجائها عين. فقد كانت تذكرنا بك، وتجعلك حاضرا معنا، شاهدا على ما تلقاه من جراء غيابك. لقد أوصدت بابها في اليوم الذي سافرت فيه، وظللت كلما تقع عيني على بابها المغلق أتذكرك. ويخيل إلي أنك ما زلت فيها، فتلفني الذكرى، وتتحير في عيني الدموع. . .
وجالت في خاطره فكر، ومرت في مخيلته صور وأشباح. ونهض متثاقلا كأنه يحمل على عاتقه خمسة عشر جبلا من الهموم والأحزان؛ ودفع باب غرفته فسمع لها ضريرا أقشعر له بدنه. وخيل إليهأنه يدلف إلىمقبرة! وطوف ببصره في أرجاء الغرفة المعرشة بخيوط العنكبوت، المغبرة من تراب السنين. وجلس على كرسيه المغطى بطبقة سميكة من التراب، وأسند كوعه على المكتب أمامه، وظل يحدق في سقف الغرفة المختفي وراء طبقة من الظلام، وأخرى من نسيج القدم!
وتدفقت عليه سيول من الأفكار كما تتدفق الأنوار على كهف مظلم مهجور!
ورأى نفسه يلقي على عاتقه خمس عشرة سنة من الزمن، وأكثر منها في عمر العاطفة والشعور. وقال في نفسه:
- هنا. . . وقبل خمس عشرة سنة كان يعيش شاب. . . ابتلي بحمى العاطفة!
وارتسمت على فمه ابتسامة باهتة ساخرة. . . كأنه يسخر من ذلك الشاب الثمل من الأشواق!. . وراح يستطلع ما خبأه في كوة الماضي البعيد. . .
إنه ليتذكر الماضي على أحسن صورة. . . كأنما الأشياء كلها وقعت بالأمس. . . يتذكر ذلك الشاب النزق البعيد الآمال، المجنون بحب المستحيل، الساري في دياجي الأحلام، العبد الذليل لعواطفه! ويتذكر كيف أنه كان يضيق بالحياة، وتمتلئ جوانب نفسه بالثورة على كل شيء، ولأي شيء. . . وإنه ليتذكر ليلة كان القدر يخط سطراً كبيراً في صفحة وجوده. . . سطراً يحسبه كالعنوان لقصة حياته المملة التي فقدت عنصر التشويق. . . تلك الليلة التي لقيها فيها. . إنه ليتذكرها. . فتاة السابعة عشرة غضه لينة، تنطق قسمات وجهها بما يبعث في نفسه الحائرة برد الاطمئنان وقد سحرته عيناها البراقتان، وبثتا سحرهما في قلبه الضعيف الأسوار!. . وألهبتا وجدانه، فكان يهرب إليه امن جحيم واقعة لينظر إلىسواد عينيها. إلىتلك البحيرة التي تعكس أنوار مستقبله.
كانت (سناء) جارة الجنب يراها كل يوم. . . زهرة ندية فياضة بالعطر والندى. . فيتطلع إليه ا، وتصده نظرات من عينيها ذوات معان لم يعرفها وهو ابن العشرين. . . ولكنه كان يحس في قرارة نفسه بأن النظر إليه اشيء جميل جداً ورائع جداً. . وكان سحر العيون أشد من كل سحر قلبه، لا يستطيع أن يرده بإرادة ولا أن يخمده ببرود. . . وكانت عيناها البراقتان كفيلتين بإذكاء النار الخالدة في قلبه!. . . وأي شيء كان أضعف من قلبه؟!
وشعر بأنها هي الأخرى تحبه، فقد انبجس له من افترار شفتيها، وانطلاق روحها، وانبساط محياها أمل حلو في أنها تحبه، وتبادله عاطفة بعاطفة مثلها. . . وإنه لن ينسى تلك الليلة الحلوة الممتعة عندما رجع إلىالبيت فرآها تنتظره بقوامها الرشيق، وتحرك أوتار قلبه بابتسامتها، وتحدثه بعينها الحسنتي التعبير. . . وعندما اقترب منها عبق في وجهه عطر خدّر أوصاله!. . . وعندما دلف إلىبيته كانت شفتاه نديتين!. . . وكان حبه قد أينع عن ثمر حلو المساغ!
وأطلت من شفتي عبد الرحمن ابتسامة وقد وصل إلىهذا الموضع وقال في نفسه:
- هذه القمة السامقة من كل حب. ولكن لا بد للإنسان من الانحدار حين يصل إليه ا.
- لقد صدق الفرنسيون حين قالوا: (الحب يولد بالنظر، وينمو بالقبل، ويموت بالدموع). . فلا بد من الدموع.
وكأنه أحس بمرارة الدموع. . فقد كانت القبل تسكره، وتذهب باتزانه. . . فهام مع أحلامها في واد محرم. . وظل يهوم فيه حتى استفاق على صوت أبيها يزمجر ويقطع كل سبب من أسباب حبه.
هناك أدركه الإعياء، وخارت قواه. . ولاحت له الدنيا مغارة مخيفة!.
وتذكر ليلة الوداع. . حين جاءت إليهتودعه، وتلقي في مسامعه كلمات تزيد لوعة وهي المرأة الضعيفة. . . وقالت له:
- أنها ستحيا من أجله. ومن أجل شيء أعز عليها من نفسها.
واختلجت في صدر عبد الرحمن لواعج وأشجان وهو يسترجع موقفه معها، ويرى في عينيها قصة آمال محطمة، وخيبة مريرة فيقول في سره:
- الحياة رحلة مضنية! أدنى ما ينال المسافر منها التعب، وأقرب ما يطرق باب نفسه فيها الإجهاد والضيق. . ثم السأم المطبق.
وأحس بأن غرفته أصبحت سجناً مظلماً، وذكرياته أشباحا مريعة. فضاق صدره وطلع منها لعل الفضاء والنور والهواء النقي يطرد أشباح الماضي وأطيافه المقيتة!
واستقبله شاب في الخامسة عشرة، منطلق الأسارير، براق العينين، مؤتلق الشباب. فنظر إليهطويلاً كأنه يعرفه. فقالت له أمه:
- هذا جميل. . ابن سناء. . .
وارتجفت شفتاه وهو ينظر إلىوجه الشاب المتسائل وفي أرجاء نفسه سمع صوتاً ينادي:
- ولدي!. .
غائب طعمة فرمان
مجلة الرسالة
28 - 11 - 1949
خمسة عشرة سنة لقي فيها أشد العناء، وقاسا ضروباً من الفاقة والعسر وثقلت على عاتقه تكاليف العيش. . . واليوم يرجع إلىوطنه بعد الكفاح المضني، والفراق الطويل، وقد أمحى من عينيه إئتلاق الشباب، وتحولت صباحة وجهه إلىجهامة منكره، وذبول حزين. . . فقد حطم خمسا وثلاثين سلسلة من السلاسل التي تربطه بالوجود، وأخذ يترقب الانحدار إلىالجانب الثاني من تل الحياة ليستقبل السلام الأبدي في قراره الوادي السحيق! فلاح الإجهاد على محياه، وغشيه موج من الحزن عميق.
الآن يرجع إلىوطنه، ويستقبل هذا الشارع الضيق الذي يعرفه حق المعرفة، وتصدمه رائحة العفونة المنبعثة من أكوام الأقذار، وتملأ عيناه منظر الأحجار التي ما زالت قائمة بها يد الإنسان، ولم تنل منها صروف خمس عشرة سنة!
يا للعجب!. . ويا لمرارة الذكرى!. . خمس عشرة سنة ما أحفلها بالأحداث والغير، وما أثرعها بالشجون والغصص، وما أكثر ما غيرت منه، وما جارت على بنيانه الإنساني! ونقلته من حال إلىحال. ولكن الشارع ما زال كما عهده لم يتغير منه أي شيء! إنه ليتذكر كل شيء فيه كأنما غادره أمس. . رحل عند إغفاءة النهار في أحضان الليل، ورجع في يقظة الليل على ترانيم الفجر! فإن صور الليلة التي غادر فيها موطنه ما زالت مرتسمة في صفحة مخيلته، وما زالت ظلالها الحية عالقة في ذهنه. وإنه ليتذكر أمه وهي تتشنج لتعبر عن عاطفتها الحبيسة، وتضطرب شفتاها كورقتين ذابلتين، وتشرق عيناها بالدموع وهو بين ذراعيها مخنوق بالعبرة، ذاهل الفكر، مسلوب الإرادة. وكان الطريق - إذ ذاك - متوشحا رداء الغروب كأنه يحس بلوعة القلوب الواجفة!. .
واليوم يرجع إلىأهله، ونفسه مفعمة بالحزن الكظيم، وبمشاعر لا يتبينها في منظار ضميره، وفي عين وجدانه. ولكنه يضرب برجليه في تراب الطريق الحائل اللون، ويتعثر بحجارته الصغيرة السوداء، وعيناه تحدقان بالبيوت القاتمة على الجانبين كأنها تنتظره!. . .
وامتلأت خياشيمه برائحة كان ينفر منها أشد النفور، ويضيق بها أعظم الضيق، ومع ذلك فقد كان يلقاها مكرها حين يخرج من بيته، ويمر بها - مسوقا إليه ا - حين يعود إليه. ولكن اليوم يحس إحساسا قويا عنيفا بأنها تعطر نفسه التي أفسدتها الغربة، ودمرها الجفاف!
ما أجمل هذا الطريق! وما أبدع ما سطر من ذكريات في سفر السنين، قليلها حلو سائغ، وسائرها مغرق في المرارة! فهو لا يكاد يذكر أنه قطعه مرة وهو خالي النفس من الألم، صافي الفكر من الهواجس والظنون، فكثيراً ما كانت تمتلئ نفسه بالألم ويحس في الضيق يدب في مفاصله، فيهرع إلىبيته يلوذ به من الهجير ويتقي تحت سقفه لوافح الألم وسموم الهواجس والظنون.
وقطع بعضا من الطريق وهو يتلفت. كل شيء كما خلفه قبل خمسة عشر عاماً كأنما السنون تمر على جوانبه مر النسيم! وتمنى لو يدلف إلىبعض البيوت ليرى سكانها أتغيروا مثلما تغير وعضهم الدهر بناجذيه كما عضه هو؟. . ولا شك أنهم سينكرونه أشد الإنكار لما أصابه من شحوب مخيف، وكبر بالغ، حتى كأنه قطع خمسين حجة، وأفضت به السن إلىكهولة واهية!. فالشيب تسلل إلىشعره كما تتسلل الخيوط البيض من الفجر في لمة الليل الفاحم والسنون اللافحة بسمومها أذوت نظارته، وسيلته المرح، وأهدته كآبة لاذعة، ووجوماً ثقيلا.
ووصل إلىبيته، وأطل على باحتة من العتبة العالية، وألقى نظرة واجمة على الداخل. على الجدران المسودة من لفح الدخان، والأرض المهشمة البلاط، وأبواب الغرف الضيقة المظلمة الأغوار؛ ولمح في تطواف عينيه كتلة بشرية جالسة القرفصاء، ساندة رأسها على ذراعيها المتشابكتين.
وعرفها فتحركت في أرجاء نفسه اللواذع. وجاشت لواعج وجدانه فناداها: - أماه!. . أماه!
فارتفع رأس المرأة فجاءة، ونظرت عينان صغيرتان حائرتان، وأرتجفت شفتان ذابلتان، واختلجت أسارير وجه معروق.
أماه! لفظ جميل سرى في جسدها كالتيار الكهربائي. . لقد أطال عهد سماعها به، فلما سمعته ترددت في أعماق نفسها أصداء بعيدة، صادرة من ماضي سحيق، واعترتها رعشة. ودار في خلدها أنها تعرف صاحب هذا الصوت.
وتقدم المغترب خطوات ثقالا، فلمحت الأم شبحا يقبل عليها فنظرت بجهد إلىوجهه، فلاح لها من بين أهداب عينها وجه شاحب هزيل. فتمتمت قائلة وهي لا تصدق ما رأت عيناها.
- عبد الرحمن!؟
وألقى الرجل جسمه في أحضان أمه كالطفل الخائف من الأشباح!، وخضلت الدموع الشفاه المحمومة التي طفقت تعبر عن حنانها بالقبل النهمة، وتفصح عن شوقها بالهمهمات.
وأرادت الأم أن تقول ولكن لسانها خانها، فتلجلجت، وتعثرت الألفاظ على شفتيها المرتجفتين، فأمسكت رأس الرجل بيديها، ونظرت في عينه كأنها تريد أن تستنطقها، ولثمتها لثمات حرار وهي تبكي بصوت خافت.
ولم يستطع الرجل من جانبه أيضا أن يعبر عن إحساسه إلىبشيء واحد وهو: أماه. . . أماه. . . بينما ظلت الأم تحت اللفظة السحرية تسكر وتحس نشوة من عبيرها الذاكي. ولكنها لا تملك إلا اللثمات!
وأخيرا نطقت بصوت تترقرق فيه العبرة:
- أحق أن حلمي قد تحقق، وانك رجعت إلىبيتي بعد غياب طويل!؟
ومسدت بيديها شعره، والتهمته بنظراتها وهو صامت بين يديها كالتمثال. . .
قالت والعبرة لا تزال تقطر من ألفاضها:
- لقد عذبني غيابك، وفرى صبري. لقد كنت أشفق عليك من أغوال الغربة، وأخشى عليك انقطاع الأسباب بك. ويئس أهلك منك إلا أنا فقد كنت موقنة أعظم اليقين أنك سوف ترجع إلي يوما ما.
وضمته إلىصدرها كأنها تريد أن تطرد الوساوس التي تنتابها. ثم قالت: - والآن رجعت. واستجاب الله دعائي وصلواتي. فقد كانت نفسي ممتلئة بك، منتظرة إيابك، تترقبه في كل لحظة، وتتعزى بالأمل عن نكد الدنيا وغصص العيش.
وخنقتها العبرة كالكابوس، وتفرست في وجهه الشاحب المقطب المهيمن عليه الحزن والجمود، وتطلعت إلىالجهامة المرتسمة على صفحاته. فأغمض الرجل عينيه واستسلم إلىارتياح جميل!
وجاء أهله باشين متهللين. يا عجبا! كأنه لم يعرفهم. . إن خمسة عشر عاما كفيله بأن تخلق جيلا جديدا، وتباعد بين المقترب وأهله. وتخلق برزخا واسعا بينه وبينهم!
وطوف ببصره في أرجاء المنزل، منزل الذكريات. . يا الله. ما أصلب هذا الحجر، وما أعظم جبروته! إن الكائن الإنساني تهدمه معاول الدهر، وتزعزعه نكبات الأيام؛ أم الجماد فإن الدهر يترقرق من جوانبه كما يترقرق الماء الزلال من صخرة جلمود!
ووقع بصره على غرفته الخاصة فرأى بابها موصدا، ورأته أمه يحدق فيها فقالت:
- إنها كما تركتها؛ لم تطأ عتبتها قدم، ولم تجل في أرجائها عين. فقد كانت تذكرنا بك، وتجعلك حاضرا معنا، شاهدا على ما تلقاه من جراء غيابك. لقد أوصدت بابها في اليوم الذي سافرت فيه، وظللت كلما تقع عيني على بابها المغلق أتذكرك. ويخيل إلي أنك ما زلت فيها، فتلفني الذكرى، وتتحير في عيني الدموع. . .
وجالت في خاطره فكر، ومرت في مخيلته صور وأشباح. ونهض متثاقلا كأنه يحمل على عاتقه خمسة عشر جبلا من الهموم والأحزان؛ ودفع باب غرفته فسمع لها ضريرا أقشعر له بدنه. وخيل إليهأنه يدلف إلىمقبرة! وطوف ببصره في أرجاء الغرفة المعرشة بخيوط العنكبوت، المغبرة من تراب السنين. وجلس على كرسيه المغطى بطبقة سميكة من التراب، وأسند كوعه على المكتب أمامه، وظل يحدق في سقف الغرفة المختفي وراء طبقة من الظلام، وأخرى من نسيج القدم!
وتدفقت عليه سيول من الأفكار كما تتدفق الأنوار على كهف مظلم مهجور!
ورأى نفسه يلقي على عاتقه خمس عشرة سنة من الزمن، وأكثر منها في عمر العاطفة والشعور. وقال في نفسه:
- هنا. . . وقبل خمس عشرة سنة كان يعيش شاب. . . ابتلي بحمى العاطفة!
وارتسمت على فمه ابتسامة باهتة ساخرة. . . كأنه يسخر من ذلك الشاب الثمل من الأشواق!. . وراح يستطلع ما خبأه في كوة الماضي البعيد. . .
إنه ليتذكر الماضي على أحسن صورة. . . كأنما الأشياء كلها وقعت بالأمس. . . يتذكر ذلك الشاب النزق البعيد الآمال، المجنون بحب المستحيل، الساري في دياجي الأحلام، العبد الذليل لعواطفه! ويتذكر كيف أنه كان يضيق بالحياة، وتمتلئ جوانب نفسه بالثورة على كل شيء، ولأي شيء. . . وإنه ليتذكر ليلة كان القدر يخط سطراً كبيراً في صفحة وجوده. . . سطراً يحسبه كالعنوان لقصة حياته المملة التي فقدت عنصر التشويق. . . تلك الليلة التي لقيها فيها. . إنه ليتذكرها. . فتاة السابعة عشرة غضه لينة، تنطق قسمات وجهها بما يبعث في نفسه الحائرة برد الاطمئنان وقد سحرته عيناها البراقتان، وبثتا سحرهما في قلبه الضعيف الأسوار!. . وألهبتا وجدانه، فكان يهرب إليه امن جحيم واقعة لينظر إلىسواد عينيها. إلىتلك البحيرة التي تعكس أنوار مستقبله.
كانت (سناء) جارة الجنب يراها كل يوم. . . زهرة ندية فياضة بالعطر والندى. . فيتطلع إليه ا، وتصده نظرات من عينيها ذوات معان لم يعرفها وهو ابن العشرين. . . ولكنه كان يحس في قرارة نفسه بأن النظر إليه اشيء جميل جداً ورائع جداً. . وكان سحر العيون أشد من كل سحر قلبه، لا يستطيع أن يرده بإرادة ولا أن يخمده ببرود. . . وكانت عيناها البراقتان كفيلتين بإذكاء النار الخالدة في قلبه!. . . وأي شيء كان أضعف من قلبه؟!
وشعر بأنها هي الأخرى تحبه، فقد انبجس له من افترار شفتيها، وانطلاق روحها، وانبساط محياها أمل حلو في أنها تحبه، وتبادله عاطفة بعاطفة مثلها. . . وإنه لن ينسى تلك الليلة الحلوة الممتعة عندما رجع إلىالبيت فرآها تنتظره بقوامها الرشيق، وتحرك أوتار قلبه بابتسامتها، وتحدثه بعينها الحسنتي التعبير. . . وعندما اقترب منها عبق في وجهه عطر خدّر أوصاله!. . . وعندما دلف إلىبيته كانت شفتاه نديتين!. . . وكان حبه قد أينع عن ثمر حلو المساغ!
وأطلت من شفتي عبد الرحمن ابتسامة وقد وصل إلىهذا الموضع وقال في نفسه:
- هذه القمة السامقة من كل حب. ولكن لا بد للإنسان من الانحدار حين يصل إليه ا.
- لقد صدق الفرنسيون حين قالوا: (الحب يولد بالنظر، وينمو بالقبل، ويموت بالدموع). . فلا بد من الدموع.
وكأنه أحس بمرارة الدموع. . فقد كانت القبل تسكره، وتذهب باتزانه. . . فهام مع أحلامها في واد محرم. . وظل يهوم فيه حتى استفاق على صوت أبيها يزمجر ويقطع كل سبب من أسباب حبه.
هناك أدركه الإعياء، وخارت قواه. . ولاحت له الدنيا مغارة مخيفة!.
وتذكر ليلة الوداع. . حين جاءت إليهتودعه، وتلقي في مسامعه كلمات تزيد لوعة وهي المرأة الضعيفة. . . وقالت له:
- أنها ستحيا من أجله. ومن أجل شيء أعز عليها من نفسها.
واختلجت في صدر عبد الرحمن لواعج وأشجان وهو يسترجع موقفه معها، ويرى في عينيها قصة آمال محطمة، وخيبة مريرة فيقول في سره:
- الحياة رحلة مضنية! أدنى ما ينال المسافر منها التعب، وأقرب ما يطرق باب نفسه فيها الإجهاد والضيق. . ثم السأم المطبق.
وأحس بأن غرفته أصبحت سجناً مظلماً، وذكرياته أشباحا مريعة. فضاق صدره وطلع منها لعل الفضاء والنور والهواء النقي يطرد أشباح الماضي وأطيافه المقيتة!
واستقبله شاب في الخامسة عشرة، منطلق الأسارير، براق العينين، مؤتلق الشباب. فنظر إليهطويلاً كأنه يعرفه. فقالت له أمه:
- هذا جميل. . ابن سناء. . .
وارتجفت شفتاه وهو ينظر إلىوجه الشاب المتسائل وفي أرجاء نفسه سمع صوتاً ينادي:
- ولدي!. .
غائب طعمة فرمان
مجلة الرسالة
28 - 11 - 1949