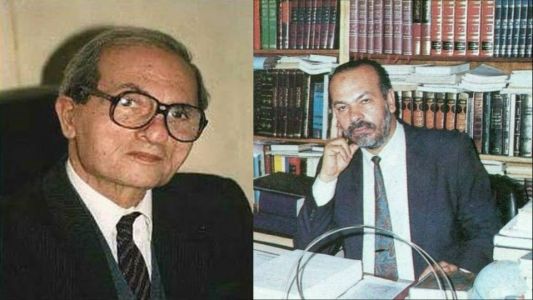هذا الحلبي هو الخواجة فرنسيس، شخص إلى باريس لدراسة الطب سنة 1866 وترك لنا عن رحلته أثراً فذاً: كتاباً طبع في بيروت سنة 1867، عثرت عليه أخيراً في مكتبة المرحوم والدي. والغالب أن الخواجا فرنسيس كان رجلاً رقيق الحال، لا لأن كتابه الذي يقع في سبعين صفحة قد طبع على نفقة غيره فحسب، بل لأن (غيره) هذا نعت نفسه بالعبد الفقير حنا النجار. تصور إذاً ماذا كان المؤلف وهذا ناشره عبد فقير! ومع ذلك عني هذا العبد الفقير بكتاب الخواجا عناية فائقة، فوشى أركان غلافه بنقوش ملتوية ورسوم ورود وأوراق أشجار، وطبع فوق عنوان الكتاب طغراء فرنسية يظهر للمدقق فيها شكل نسر نابليوني واقف على حسام يتطاير منه الشرر (أو هي صواعق جوبيتر؟) وتحيط به قلادة (اللجيون دونير) يتدلى منها الصليب الذي خصصه نابليون لرجاله الشجعان. والعبد الفقير حنا النجار كان رجلا عصرياً محباً للتقدم إذ طبع على ظهر الغلاف قاطرة بخارية ذات مدخنة عالية ترسل عموداً كثيفاً من الدخان، وباخرة ذات مدخنة أعلى تطلق سحباً من الدخان وهي تمخر العباب برفاصات جانبية كالتي لا نزال نراها في بواخر النيل
ورحالتنا يمكن أن يلقب بذي الصناعتين، فهو مالك أعنة النظم والنثر، شاعر حتى في نثره، وناثر حتى في شعره. وسنرى كيف استطاع أن يعهد إلى النظم بوصف نثري لباريس، وكيف عهد إلى النثر بوصف شعري لمدينة النور
أسلوبه صور تتوالى. فهو يرى (الحسد والطمع لابسين أجساماً نارية ذريعة المنظر، وجالسين في ذلك السحاب على مائدة السكر) والسحاب هو الذي رآه الخواجا فرنسيس (على الأفق نارياً كثيفاً ذا لون كأنه من مصبغة الموت، تقشعر منه الأبدان وتزهق الأرواح، ومصنوع من زفرات البشر، وكان الخمر دماء، والأقداح جماجم، وهما يصرخان الخ) ويرى أقواماً (يرضعون الذل من أثداء أمهاتهم وعلى ظهورهم أحمال ثقيلة تحنيهم إلى الأرض، وفي أيديهم حقاق فولاذية مطبوقة على أفكارهم وحريتهم) كما يرى (راية المصائب والأوصاب تخفق على كل هامة، ورياح الآلام والأوجاع تعصف بكل روح. . .) وهو إذا ركب السفن (امتطى ظعن البخار، وأخذ يطوي بيد البحار)
والخواجا فرنسيس كما ترى فيلسوف متشائم، فهو يبدأ كتابه بالقول إنه لما (أدرك رشده، وبلغ أشده، دخل العالم ليتجسسه ويرى كيف يجب اعتباره منه. فعندما تبصره كافياً، وجده سوقاً عظيماً لا حد له، وجميع الخلائق أقامت فيه حوانيتها وكلها تنادي على بضائعها، وكأنما لا يسوغ لأحد مشتري شيء من هذا السوق ما لم يضع على عينيه نظارة تختلف لوناً وقوة. . . فكل يرى هذا السوق على كيفية نظارته وماهية نظره. فالبعض لا يشاهدون فيه معتبراً سوى معدني الذهب والفضة، فيندفعون جماحاً إلى نوالهما على أي أسلوب كان)
ولعلك حذرت أن رحالتنا الخواجا فرنسيس ليس من هؤلاء وليس من البعض الذين (لا يفهمون العالم سوى مقر اللذات والطرب، لأنهم لا يدركون بنظاراتهم سواها، فلا يعتبرون إلاّ ها. فيعيشون ناشرين شراع الليل، وطاوين بساط النهار في الولوع والكر والرقص والخلاعة. هذا إذا لم ينهرهم حارس هذا السوق، أعني به ذلك العفريت الجهنمي المدعو الزمان)
أما هو (المسكين، فقد كانت نظارته لسوء حظه مصنوعة من أشنع الألوان، وأبشع الأشكال) لأنه حين وضعها على عينيه (وجد عالماً ذريعاً ترتعد منه الفرائص، وتميد عمد القلوب وينفي عنه كل ذوق سليم). ولا داعي إلى الاسترسال في نقل الصورة المدلهمة التي يرسمها لنا الخواجا فرنسيس، فهو متشائم فحسب، وقد رأى هذه السوق (المدعو عالماً، فخلا في نفسه ليرى أي بضاعة يبتاعها) فلم يجد (أشرف من انتقاد هذه الحوادث، والبحث عن حركات هذا العالم) فهو يريد أن يكون كاتباً أخلاقياً وكتابه سوف يظهرنا على مبلغ نجاحه في هذا السبيل
إلا أنه، وقد بلغ العشرين، شرع (يمتحن نفسه ليرى ماذا جنى من الثمرات. ولكنه لم يجد في مخيلته سوى كمية وافرة من ألوف مسائل العلم العربي - نحن في سنة 1856 - ولم يعثر في خزانته على غير كتب مطولات ومختصرات في النحو والصرف وما يلحقها). وهو إذ تأمل (الفائدة لم يجدها سوى نظم الشعر) فهو يقول في تواضع مؤثر (فها أنا شاعر إذا أراد شعراء العصر) ولكني لا أحسب شعراء عصره - وأقل منهم شعراء عصرنا - يريدون تضخم الصناعة إلى هذا الحد! ثم هو على كل حال لم يهمل أن يلاحظ (جملة أضرار تقابل هذه الفائدة. وهي أولاً كساد سوق الشعر، ومقت العامة له) - أما نحن الخاصة فسوف نذوب صبابة في شعره بعد لحظة - لذلك أوحيت إليه (كراهته تلك الفائدة المفتداة بأفخر سني حيوته أن يتعكف إلى طلب العلوم العالية واللغات). ثم اتفق له أحد مهرة أطباء الإنكليز (فألقى ثقله على مسايرته، وبدأ يدرس عليه العلوم الطبية وهو في سن الخمسة والعشرين، حتى هضم أربع سنسن كوامل على هذه الدراسة، وصار طبيباً) وعلى رأي المعلم وحده مع الأسف، أما في رأي ما (نقول المدارس فقد كان جهولا)
وشرع (يباشر الأمراض متلاعباً بصناعة إيبوقراط). ثم أوعز إليه ضميره أن يرحل إلى (باريس محط عرش الافرنسيس). وكان لهذا الحادث الهام الفضل في الكتاب الفذ الذي نلخصه لقراء (الرسالة) بعد سبعين سنة من نشره
ففي اليوم (الواقع في 7 أيلول 1866، وهو داخل في دايرة الثلثين) خرج من (أبواب الشهباء صحبة الكروان، ممتطياً ظهر كديش أخي قزل) (ألم أقل إن الخواجا فرنسيس شاعر في نثره؟) فبلغ (الاسكندرونة مينا حلب). وترك لنا وصفاً للطريق يوقف الشعر هلعا. فمن (أوعار ملقاة في الطريق كأنها أمواج البحر الجامد) إلى (جبال صلعاء القمم) إلى (هضاب ممحلة منفردة كاللصوص في درب أبناء السبيل) ومن (عواصف وقواصف تهب من مرابضها الجهنمية على السرى) إلى (أنهار راكدة على فراش الأوصال تعارض سير القوافل). وفي إحدى مراحل هذا الطريق (ينجلي) الخواجا فرنسيس فتتعرف إليه لأول مرة ناظماً، ولا أقول شاعراً فإن شاعريته قد بزغت في نثره كما رأيناه. وقد أسالت (جمرة الفراق جمودة قريحته فهرع إلى القلم ونقش أبياتاً كأنها منشودة من أحد أعراب البادية. . . إلا قليلا). وقد حكم إذ ذاك أن للشعر (علاقة ثابتة مع الموضوعات التي يراها الشاعر). وسأوفر عليك عناء قراءة هذا الشعر البدوي الذي كتب في بادية الشام ما بين حلب والاسكندرونة. ويكفي أن تعلم بما فيه من حداء السرى والخيام والحمى والعيس. وقد لا تمانع في أن تسمع بيتين من جزل شعر الخواجا فرنسيس:
فهل ذكرت تلك المنيعة في الخبا ... شريداً طحاه البين وهو غلامها
وهل علمت أسماء - وهي عليمة - ... صبابة نفس قد تسامى مرامها
نسيم الصبا هل. . . إلى آخر البيت وهو رجل غدا الآن واسع الخبرة بالدنيا إلى حد أن يختتم قصيده قائلاً:
ومن خبر الدنيا وأدرك شرها ... تساوى لديه حربها وسلامها
وقد تأثر عند مشاهدته مدينة الاسكندرونة (حينما أذكر المشكل الدولي حول هذا المرفأ ولوائه!) وكان تأثره (صاعقة لأنه رآها هاوية في أعمق هاوية من القهقرة) أهذا (مينا حلب مدخل تجارة الزوراء وتركستان، ومخرج أنسجة ومحصولات عربستان، صايرة مرسحاً لملاعب الخراب. . حتى تكاد أن لا تعتبر سوى كمبصقة للبحر، أو مداس للدهر؟)
وامتطى (ظعن البخار، وأخذ يطوي بيد البحار، حتى عانق باع اللاذقية) ولكنه لم ينزل إليها (وخفقت به أجنحة البخار إلى مدينة طرابلس، فوجدها ظريفة وعليها أبهة العمار، وكأنها تهم إلى التقدم فتدفعها نحوس الأقدار)
ثم زار بيروت ورأى أن لا بدع في أن (جلست هذه المدينة على المرتبة الأولى ما بين مدن سوريا. وأصبحت مبزغاً لكل نور) وبعد نهاية (أجل المرسى عاود إلى المركب وطار به إلى يافا، فنزل إليها بعد تردد وخوف من مطاردة الأمواج، الدايمة الهياج) ولكنه ما عتم أن عاد آسفاً على الشجاعة التي بذلها في منازلة أحط صعاليك المدن كما يقول
بعد ذلك أخذت (تخفق له أجنحة نسر البحر إلى جانب الإسكندرية) فبلغها بعد ثمانية أيام من مغادرته حلب ورأى فيها مدينة (قايمة على ساق التجدد)، ودعاها تاج المشرق وعنوان المغرب. ووجد فيها وقود (النور الايدروجيني خاصة في الساحة المدعوة عندهم بالمنشية)
ثم (أوحت له شياطين الملل أن يرحل إلى القاهرة. فركب أجنحة عفريت البر، فطار به كالباشق - يقيناً إن الرجل شاعر غير نادم! - حتى أوقعه هذا العفريت بعد خمس ساعات على مدينة الأهرام، أعني الأثر الوحيد الذي أبقته القدمية تميمة على رأس هذه المدينة. وجعل يتفرج على مشتهرات القاهرة مدة ستة أيام، فلم يعثر على ما يستحق الذكر أو يروق الخاطر - حتى ولا النور الايدروجيني؟ - سوى خزانة التحف المصرية وجامع القلعة الذي بناه محمد علي باشا من الحجر الكهربائي - لم أعرف قبلا أن هذه ترجمة - مع السرايا المحاذية له. كما بنى سرايا شبرى ذات الحوض المرمري العظيم الذي أنشأه لكي يتنزه فيه على قارب تجدفه جوار حسان (كذا!) أما الأزبكية الشهيرة فلا عادت تنطوي سوى على بعض أشجار بلح مغروسة بين أمواج الرمال) أما أسواق القاهرة (فلا يوجد أقبح منها لشدة ضيقها وأوخامها، حتى أن البعض لشدة ضناكته يكاد أن يرفض مسير اثنين معاً، ولا يقبل الضوء، ولا يوجد شارع يعتبر بالنسبة إلى البقية سوى الشارع الملقب بالموزكي أو طريق الإفرنج حيثما اختار التجار الحلبيون إقامة حوانيتهم)
ووجد مع ذلك في هذا البلد (كثيراً من الأثارات والبقايا القديمة. . . وعدداً جزيلاً من الجوامع وأخصها جامع الأزهر الذي كان زاهراً بعلوم العرب وفنونهم، وقد تقوض حسب اقتضاء روح العصر بالمدرسة العالية التي جددها حضرة إسماعيل باشا قيل مصر) - لو رأى الخواجا فرنسيس هذا الجامع في أيامنا!
وعاد رحالتنا إلى الإسكندرية (يستنظر المركب الذي سيصحبه إلى أوروبا. وورد الصاحب المستنظر فقلع معه الخواجا فرنسيس في 14 تشرين الأول. وفي صباح العشرين منه انقض به باشق البحار على مدينة مرسيليا، ووجد ذاته حينئذ مرتاحاً في حضن الغرب، متخطراً تحت سماء أوروبا)؛ وبعد إقامته ثمانية أيام في هذه المدينة (المصاغة من عسجد الظرافة، والمطرزة بلؤلؤ الجمال، ركب بخار البر في طريق الحديد وأخذ جهة ليون)
وهنا يصف الرحالة الفذ شعوره في بخار البر وطريق الحديد، وحيال المناظر التي مرّ بها معترفاً (بعجزه عن الشرح، وموجز القول بأن تلك المساحات التي مرّ عليها، فلوات وجبالاً وهضاباً، كانت بستاناً واحداً ومدينة واحدة؛ وما كان يشاهد لون التراب الطبيعي سوى بين اسطوانات طريق الحديد، حيثما تكر العجلات)
ولم يزل الخواجا فرنسيس (مضطجعاً في المركبة الطايرة على أجنحة البخار، مطلاً من كواتها البلورية على نفايس هذه الطبيعة إلى أن حط به طاير النار على مدينة ليون نحو نصف الليل، حينما كانت سابحة في أنوارها العرمرمية)
وهنا تعاود رحالتنا جنة الشعر، فيهرع إلى القلم ليحبس هذه الخيالات المنثورة في بيوت منظومة، ولكنه يبدو في هذه المرة شاعراً حضرياً عصرياً، ألم يحكم بأن للشعر (علاقة ثابتة مع الموضوعات التي يراها الشاعر؟)
إلى جنة الفردوس هل أنا ساير ... ترى أم إلى دنياء أخرى مسافر
وهل أنا مع نسر السما طاير إلى ... سما أم بخار الماء بي هو طاير وعهدي أن الماء يضعف إن غدا ... بخاراً فكيف الآن ذا الضد صاير
ويواصل نظمه ثلاثين بيتاً يتغزل في (عفريت البر وباشق البخار) ويقارن بين راحة السفر على أجنحته وتعب الأسفار على ظهور الإِبل:
ولم يبق من ظعن سوى العجلات في ... حديد تكر الدهر وهي صوابر
أبت غير نيران اللظى علفاً لها ... وهن على خير الهشيم دواير
ولما لمع وجه الصباح، نهض من فراش النعام وطفق يطوف ليون ليتفرج على ما تشتمل عليه من المحاسن واللطايف؛ وهو يذكرنا إذ يتغنى بجمالها وكمالها وما (اجتمع لها من المقومات المدنية والأدوات التمدنية بأن أول من شرع في رفع شأنها أحد أولاد قلويس ملك الغوليين ذي الشهرة العظيمة في غاليا بإدخاله إلى هذه المملكة جملة نظامات وتجديدات لمع بها زمانه، وأهمها إدخاله الديانة المسيحية في الغوليين بعد أن أدخلته فيها امرأته بقصها عليه أخبار قسطنطين الكبير، وبإقناعها له أنه إذا سلك مسلك ذاك الملك المنتصر بالتنصر، إنما يقهر نظيره كل أعدائه)
وركب الخواجا فرنسيس نسر البحار بعد تمضية ثلاثة أيام في ليون، فطار به إلى باريس حيث وصل قرب انفلاق الصباح
ولنا أن نتوقع انفجار - أو ربما قال انفطار؟ - نفس رحالتنا في قلب باريس، وأن نترقب هبوط وحي الشعر عليه. ويظهر أن خواجتنا رجل يحسن (الإِخراج) فهو تاركنا نشتاق إلى شعره بعد أن حببنا إليه ببعض الخطرات، ليمضي في وصف نثري لباريس حتى قبيل آخر الكتاب، ثم هو مطبق علينا بقصيدة مخمسة عددت شطراتها فكانت خمسمائة شطرة والعياذ بالله. وبذلك يكون الخواجا فرنسيس قد أفرغ فينا شعره مرة واحدة
وكان المتوقع أن يترك رحالتنا للشعر مهمة التعبير عن احساساته في باريس، وأن يودعه تفكيره العالي، تاركاً للنثر وصف المتاحف والميادين. ولكن رجلنا شعره منثور ونثره منظوم كما سبق لنا القول، فبينا هو يتغنى نثراً بباريس (مركز مجد العالم، ومصب أنهار العجايب، وموقع أنوار التمدن. . . وها قد أخذت عيناه ترى ما كان يراه ذاك الذي خطفته أرواح الآلهة إلى السماء الثالثة) إذا به يصطحبنا بشعره كأنه (بيديكر) فينصح بأن نترك الدرس لنتمشى في شوارع باريس: يا صاحبي حتى م ترعى الوسوسة ... ها كافة الدراس عافوا المدرسة
وكل نفس قد غدت مستأنسة ... بهدنة في الدرس تطفي قبسه
وتضرم الأشواق ضمن الصدر
هيا بنا نسع إلى البولفار ... إلى مكان الشهب والأقمار
حيث نرى بدايع المعمار ... مقرونة ببدع الأفكار
حيث الغنى حيث افتقار الفقر
كفى فسر بنا إلى فندوم ... حتى نرى تمثال ذي الهجوم
يجلي على عموده المنظوم ... من سلب الحرب مع الخصوم
بطرس نابليون عالي الذكر
ها قد نظرنا أثر الشقاق ... فلننطلق لساحة الوفاق
ذات رنين الصيت في الآفاق ... ذي ساحة تسطو على الأحداق
وتسكر العقل بغير خمر
ولننعطف نحو مقام التوللري ... أعني بلاط العاهل المظفر
هناك بستان عجيب المنظر ... فكله شوارع من شجر
وفسحات زخرفت بالزهر
كلا! لست أنوي أن أسرد عليك كل هذه الخريدة العظيمة، والدرة اليتيمة. إنما أنا أقتطف من شطراتها الخمسمائة هنا وهناك لأجمع لك باقة عاطرة من شعر الخواجا فرنسيس. ثم أي بأس في هذه النزهة الباريسية الفريدة؟ الناس يرتادون باريس في (الأتوكار)، والمعلم فرنسيس يصطحبك بقصيدته الحماسية إلى كثير من أماكنها الهامة. هاهو ذا يناديك من بوقه الشعري:
فلنطلق المسعى لدار اللوفر
ها قد بلغنا الآن دار التحف ... حتى نرى عالم دنيا السلف
نرى حيوة الناس في العهد الخفي ... وهتك ستر الزمن المنصرف
كل له داب بهتك السر
جماعة الأشور والعمالق ... يبدون من ذاك الظلام الغاسق
يجلون في الثياب والقراطق ... طبق لباس الناس في المشارق
فذاك زي الشرق منذ الفطر
كذا نرى جميع أعمال اليد ... منهم وكل الأدوات الشرد
وكل معبود لهم ومعبد ... لكنما المضحك في ذا الصدد
إلههم ثور برأس حبر
وهكذا سكان مصر السالفة ... مع آل أشور لهم محالفة
كانوا على الأرض أجل طايفة ... أجسادهم محنطات واقفة
ولا يرى هذا سوى في مصر
(له بقية)
مجلة الرسالة - العدد 245
بتاريخ: 14 - 03 - 1938
حسين فوزي
ورحالتنا يمكن أن يلقب بذي الصناعتين، فهو مالك أعنة النظم والنثر، شاعر حتى في نثره، وناثر حتى في شعره. وسنرى كيف استطاع أن يعهد إلى النظم بوصف نثري لباريس، وكيف عهد إلى النثر بوصف شعري لمدينة النور
أسلوبه صور تتوالى. فهو يرى (الحسد والطمع لابسين أجساماً نارية ذريعة المنظر، وجالسين في ذلك السحاب على مائدة السكر) والسحاب هو الذي رآه الخواجا فرنسيس (على الأفق نارياً كثيفاً ذا لون كأنه من مصبغة الموت، تقشعر منه الأبدان وتزهق الأرواح، ومصنوع من زفرات البشر، وكان الخمر دماء، والأقداح جماجم، وهما يصرخان الخ) ويرى أقواماً (يرضعون الذل من أثداء أمهاتهم وعلى ظهورهم أحمال ثقيلة تحنيهم إلى الأرض، وفي أيديهم حقاق فولاذية مطبوقة على أفكارهم وحريتهم) كما يرى (راية المصائب والأوصاب تخفق على كل هامة، ورياح الآلام والأوجاع تعصف بكل روح. . .) وهو إذا ركب السفن (امتطى ظعن البخار، وأخذ يطوي بيد البحار)
والخواجا فرنسيس كما ترى فيلسوف متشائم، فهو يبدأ كتابه بالقول إنه لما (أدرك رشده، وبلغ أشده، دخل العالم ليتجسسه ويرى كيف يجب اعتباره منه. فعندما تبصره كافياً، وجده سوقاً عظيماً لا حد له، وجميع الخلائق أقامت فيه حوانيتها وكلها تنادي على بضائعها، وكأنما لا يسوغ لأحد مشتري شيء من هذا السوق ما لم يضع على عينيه نظارة تختلف لوناً وقوة. . . فكل يرى هذا السوق على كيفية نظارته وماهية نظره. فالبعض لا يشاهدون فيه معتبراً سوى معدني الذهب والفضة، فيندفعون جماحاً إلى نوالهما على أي أسلوب كان)
ولعلك حذرت أن رحالتنا الخواجا فرنسيس ليس من هؤلاء وليس من البعض الذين (لا يفهمون العالم سوى مقر اللذات والطرب، لأنهم لا يدركون بنظاراتهم سواها، فلا يعتبرون إلاّ ها. فيعيشون ناشرين شراع الليل، وطاوين بساط النهار في الولوع والكر والرقص والخلاعة. هذا إذا لم ينهرهم حارس هذا السوق، أعني به ذلك العفريت الجهنمي المدعو الزمان)
أما هو (المسكين، فقد كانت نظارته لسوء حظه مصنوعة من أشنع الألوان، وأبشع الأشكال) لأنه حين وضعها على عينيه (وجد عالماً ذريعاً ترتعد منه الفرائص، وتميد عمد القلوب وينفي عنه كل ذوق سليم). ولا داعي إلى الاسترسال في نقل الصورة المدلهمة التي يرسمها لنا الخواجا فرنسيس، فهو متشائم فحسب، وقد رأى هذه السوق (المدعو عالماً، فخلا في نفسه ليرى أي بضاعة يبتاعها) فلم يجد (أشرف من انتقاد هذه الحوادث، والبحث عن حركات هذا العالم) فهو يريد أن يكون كاتباً أخلاقياً وكتابه سوف يظهرنا على مبلغ نجاحه في هذا السبيل
إلا أنه، وقد بلغ العشرين، شرع (يمتحن نفسه ليرى ماذا جنى من الثمرات. ولكنه لم يجد في مخيلته سوى كمية وافرة من ألوف مسائل العلم العربي - نحن في سنة 1856 - ولم يعثر في خزانته على غير كتب مطولات ومختصرات في النحو والصرف وما يلحقها). وهو إذ تأمل (الفائدة لم يجدها سوى نظم الشعر) فهو يقول في تواضع مؤثر (فها أنا شاعر إذا أراد شعراء العصر) ولكني لا أحسب شعراء عصره - وأقل منهم شعراء عصرنا - يريدون تضخم الصناعة إلى هذا الحد! ثم هو على كل حال لم يهمل أن يلاحظ (جملة أضرار تقابل هذه الفائدة. وهي أولاً كساد سوق الشعر، ومقت العامة له) - أما نحن الخاصة فسوف نذوب صبابة في شعره بعد لحظة - لذلك أوحيت إليه (كراهته تلك الفائدة المفتداة بأفخر سني حيوته أن يتعكف إلى طلب العلوم العالية واللغات). ثم اتفق له أحد مهرة أطباء الإنكليز (فألقى ثقله على مسايرته، وبدأ يدرس عليه العلوم الطبية وهو في سن الخمسة والعشرين، حتى هضم أربع سنسن كوامل على هذه الدراسة، وصار طبيباً) وعلى رأي المعلم وحده مع الأسف، أما في رأي ما (نقول المدارس فقد كان جهولا)
وشرع (يباشر الأمراض متلاعباً بصناعة إيبوقراط). ثم أوعز إليه ضميره أن يرحل إلى (باريس محط عرش الافرنسيس). وكان لهذا الحادث الهام الفضل في الكتاب الفذ الذي نلخصه لقراء (الرسالة) بعد سبعين سنة من نشره
ففي اليوم (الواقع في 7 أيلول 1866، وهو داخل في دايرة الثلثين) خرج من (أبواب الشهباء صحبة الكروان، ممتطياً ظهر كديش أخي قزل) (ألم أقل إن الخواجا فرنسيس شاعر في نثره؟) فبلغ (الاسكندرونة مينا حلب). وترك لنا وصفاً للطريق يوقف الشعر هلعا. فمن (أوعار ملقاة في الطريق كأنها أمواج البحر الجامد) إلى (جبال صلعاء القمم) إلى (هضاب ممحلة منفردة كاللصوص في درب أبناء السبيل) ومن (عواصف وقواصف تهب من مرابضها الجهنمية على السرى) إلى (أنهار راكدة على فراش الأوصال تعارض سير القوافل). وفي إحدى مراحل هذا الطريق (ينجلي) الخواجا فرنسيس فتتعرف إليه لأول مرة ناظماً، ولا أقول شاعراً فإن شاعريته قد بزغت في نثره كما رأيناه. وقد أسالت (جمرة الفراق جمودة قريحته فهرع إلى القلم ونقش أبياتاً كأنها منشودة من أحد أعراب البادية. . . إلا قليلا). وقد حكم إذ ذاك أن للشعر (علاقة ثابتة مع الموضوعات التي يراها الشاعر). وسأوفر عليك عناء قراءة هذا الشعر البدوي الذي كتب في بادية الشام ما بين حلب والاسكندرونة. ويكفي أن تعلم بما فيه من حداء السرى والخيام والحمى والعيس. وقد لا تمانع في أن تسمع بيتين من جزل شعر الخواجا فرنسيس:
فهل ذكرت تلك المنيعة في الخبا ... شريداً طحاه البين وهو غلامها
وهل علمت أسماء - وهي عليمة - ... صبابة نفس قد تسامى مرامها
نسيم الصبا هل. . . إلى آخر البيت وهو رجل غدا الآن واسع الخبرة بالدنيا إلى حد أن يختتم قصيده قائلاً:
ومن خبر الدنيا وأدرك شرها ... تساوى لديه حربها وسلامها
وقد تأثر عند مشاهدته مدينة الاسكندرونة (حينما أذكر المشكل الدولي حول هذا المرفأ ولوائه!) وكان تأثره (صاعقة لأنه رآها هاوية في أعمق هاوية من القهقرة) أهذا (مينا حلب مدخل تجارة الزوراء وتركستان، ومخرج أنسجة ومحصولات عربستان، صايرة مرسحاً لملاعب الخراب. . حتى تكاد أن لا تعتبر سوى كمبصقة للبحر، أو مداس للدهر؟)
وامتطى (ظعن البخار، وأخذ يطوي بيد البحار، حتى عانق باع اللاذقية) ولكنه لم ينزل إليها (وخفقت به أجنحة البخار إلى مدينة طرابلس، فوجدها ظريفة وعليها أبهة العمار، وكأنها تهم إلى التقدم فتدفعها نحوس الأقدار)
ثم زار بيروت ورأى أن لا بدع في أن (جلست هذه المدينة على المرتبة الأولى ما بين مدن سوريا. وأصبحت مبزغاً لكل نور) وبعد نهاية (أجل المرسى عاود إلى المركب وطار به إلى يافا، فنزل إليها بعد تردد وخوف من مطاردة الأمواج، الدايمة الهياج) ولكنه ما عتم أن عاد آسفاً على الشجاعة التي بذلها في منازلة أحط صعاليك المدن كما يقول
بعد ذلك أخذت (تخفق له أجنحة نسر البحر إلى جانب الإسكندرية) فبلغها بعد ثمانية أيام من مغادرته حلب ورأى فيها مدينة (قايمة على ساق التجدد)، ودعاها تاج المشرق وعنوان المغرب. ووجد فيها وقود (النور الايدروجيني خاصة في الساحة المدعوة عندهم بالمنشية)
ثم (أوحت له شياطين الملل أن يرحل إلى القاهرة. فركب أجنحة عفريت البر، فطار به كالباشق - يقيناً إن الرجل شاعر غير نادم! - حتى أوقعه هذا العفريت بعد خمس ساعات على مدينة الأهرام، أعني الأثر الوحيد الذي أبقته القدمية تميمة على رأس هذه المدينة. وجعل يتفرج على مشتهرات القاهرة مدة ستة أيام، فلم يعثر على ما يستحق الذكر أو يروق الخاطر - حتى ولا النور الايدروجيني؟ - سوى خزانة التحف المصرية وجامع القلعة الذي بناه محمد علي باشا من الحجر الكهربائي - لم أعرف قبلا أن هذه ترجمة - مع السرايا المحاذية له. كما بنى سرايا شبرى ذات الحوض المرمري العظيم الذي أنشأه لكي يتنزه فيه على قارب تجدفه جوار حسان (كذا!) أما الأزبكية الشهيرة فلا عادت تنطوي سوى على بعض أشجار بلح مغروسة بين أمواج الرمال) أما أسواق القاهرة (فلا يوجد أقبح منها لشدة ضيقها وأوخامها، حتى أن البعض لشدة ضناكته يكاد أن يرفض مسير اثنين معاً، ولا يقبل الضوء، ولا يوجد شارع يعتبر بالنسبة إلى البقية سوى الشارع الملقب بالموزكي أو طريق الإفرنج حيثما اختار التجار الحلبيون إقامة حوانيتهم)
ووجد مع ذلك في هذا البلد (كثيراً من الأثارات والبقايا القديمة. . . وعدداً جزيلاً من الجوامع وأخصها جامع الأزهر الذي كان زاهراً بعلوم العرب وفنونهم، وقد تقوض حسب اقتضاء روح العصر بالمدرسة العالية التي جددها حضرة إسماعيل باشا قيل مصر) - لو رأى الخواجا فرنسيس هذا الجامع في أيامنا!
وعاد رحالتنا إلى الإسكندرية (يستنظر المركب الذي سيصحبه إلى أوروبا. وورد الصاحب المستنظر فقلع معه الخواجا فرنسيس في 14 تشرين الأول. وفي صباح العشرين منه انقض به باشق البحار على مدينة مرسيليا، ووجد ذاته حينئذ مرتاحاً في حضن الغرب، متخطراً تحت سماء أوروبا)؛ وبعد إقامته ثمانية أيام في هذه المدينة (المصاغة من عسجد الظرافة، والمطرزة بلؤلؤ الجمال، ركب بخار البر في طريق الحديد وأخذ جهة ليون)
وهنا يصف الرحالة الفذ شعوره في بخار البر وطريق الحديد، وحيال المناظر التي مرّ بها معترفاً (بعجزه عن الشرح، وموجز القول بأن تلك المساحات التي مرّ عليها، فلوات وجبالاً وهضاباً، كانت بستاناً واحداً ومدينة واحدة؛ وما كان يشاهد لون التراب الطبيعي سوى بين اسطوانات طريق الحديد، حيثما تكر العجلات)
ولم يزل الخواجا فرنسيس (مضطجعاً في المركبة الطايرة على أجنحة البخار، مطلاً من كواتها البلورية على نفايس هذه الطبيعة إلى أن حط به طاير النار على مدينة ليون نحو نصف الليل، حينما كانت سابحة في أنوارها العرمرمية)
وهنا تعاود رحالتنا جنة الشعر، فيهرع إلى القلم ليحبس هذه الخيالات المنثورة في بيوت منظومة، ولكنه يبدو في هذه المرة شاعراً حضرياً عصرياً، ألم يحكم بأن للشعر (علاقة ثابتة مع الموضوعات التي يراها الشاعر؟)
إلى جنة الفردوس هل أنا ساير ... ترى أم إلى دنياء أخرى مسافر
وهل أنا مع نسر السما طاير إلى ... سما أم بخار الماء بي هو طاير وعهدي أن الماء يضعف إن غدا ... بخاراً فكيف الآن ذا الضد صاير
ويواصل نظمه ثلاثين بيتاً يتغزل في (عفريت البر وباشق البخار) ويقارن بين راحة السفر على أجنحته وتعب الأسفار على ظهور الإِبل:
ولم يبق من ظعن سوى العجلات في ... حديد تكر الدهر وهي صوابر
أبت غير نيران اللظى علفاً لها ... وهن على خير الهشيم دواير
ولما لمع وجه الصباح، نهض من فراش النعام وطفق يطوف ليون ليتفرج على ما تشتمل عليه من المحاسن واللطايف؛ وهو يذكرنا إذ يتغنى بجمالها وكمالها وما (اجتمع لها من المقومات المدنية والأدوات التمدنية بأن أول من شرع في رفع شأنها أحد أولاد قلويس ملك الغوليين ذي الشهرة العظيمة في غاليا بإدخاله إلى هذه المملكة جملة نظامات وتجديدات لمع بها زمانه، وأهمها إدخاله الديانة المسيحية في الغوليين بعد أن أدخلته فيها امرأته بقصها عليه أخبار قسطنطين الكبير، وبإقناعها له أنه إذا سلك مسلك ذاك الملك المنتصر بالتنصر، إنما يقهر نظيره كل أعدائه)
وركب الخواجا فرنسيس نسر البحار بعد تمضية ثلاثة أيام في ليون، فطار به إلى باريس حيث وصل قرب انفلاق الصباح
ولنا أن نتوقع انفجار - أو ربما قال انفطار؟ - نفس رحالتنا في قلب باريس، وأن نترقب هبوط وحي الشعر عليه. ويظهر أن خواجتنا رجل يحسن (الإِخراج) فهو تاركنا نشتاق إلى شعره بعد أن حببنا إليه ببعض الخطرات، ليمضي في وصف نثري لباريس حتى قبيل آخر الكتاب، ثم هو مطبق علينا بقصيدة مخمسة عددت شطراتها فكانت خمسمائة شطرة والعياذ بالله. وبذلك يكون الخواجا فرنسيس قد أفرغ فينا شعره مرة واحدة
وكان المتوقع أن يترك رحالتنا للشعر مهمة التعبير عن احساساته في باريس، وأن يودعه تفكيره العالي، تاركاً للنثر وصف المتاحف والميادين. ولكن رجلنا شعره منثور ونثره منظوم كما سبق لنا القول، فبينا هو يتغنى نثراً بباريس (مركز مجد العالم، ومصب أنهار العجايب، وموقع أنوار التمدن. . . وها قد أخذت عيناه ترى ما كان يراه ذاك الذي خطفته أرواح الآلهة إلى السماء الثالثة) إذا به يصطحبنا بشعره كأنه (بيديكر) فينصح بأن نترك الدرس لنتمشى في شوارع باريس: يا صاحبي حتى م ترعى الوسوسة ... ها كافة الدراس عافوا المدرسة
وكل نفس قد غدت مستأنسة ... بهدنة في الدرس تطفي قبسه
وتضرم الأشواق ضمن الصدر
هيا بنا نسع إلى البولفار ... إلى مكان الشهب والأقمار
حيث نرى بدايع المعمار ... مقرونة ببدع الأفكار
حيث الغنى حيث افتقار الفقر
كفى فسر بنا إلى فندوم ... حتى نرى تمثال ذي الهجوم
يجلي على عموده المنظوم ... من سلب الحرب مع الخصوم
بطرس نابليون عالي الذكر
ها قد نظرنا أثر الشقاق ... فلننطلق لساحة الوفاق
ذات رنين الصيت في الآفاق ... ذي ساحة تسطو على الأحداق
وتسكر العقل بغير خمر
ولننعطف نحو مقام التوللري ... أعني بلاط العاهل المظفر
هناك بستان عجيب المنظر ... فكله شوارع من شجر
وفسحات زخرفت بالزهر
كلا! لست أنوي أن أسرد عليك كل هذه الخريدة العظيمة، والدرة اليتيمة. إنما أنا أقتطف من شطراتها الخمسمائة هنا وهناك لأجمع لك باقة عاطرة من شعر الخواجا فرنسيس. ثم أي بأس في هذه النزهة الباريسية الفريدة؟ الناس يرتادون باريس في (الأتوكار)، والمعلم فرنسيس يصطحبك بقصيدته الحماسية إلى كثير من أماكنها الهامة. هاهو ذا يناديك من بوقه الشعري:
فلنطلق المسعى لدار اللوفر
ها قد بلغنا الآن دار التحف ... حتى نرى عالم دنيا السلف
نرى حيوة الناس في العهد الخفي ... وهتك ستر الزمن المنصرف
كل له داب بهتك السر
جماعة الأشور والعمالق ... يبدون من ذاك الظلام الغاسق
يجلون في الثياب والقراطق ... طبق لباس الناس في المشارق
فذاك زي الشرق منذ الفطر
كذا نرى جميع أعمال اليد ... منهم وكل الأدوات الشرد
وكل معبود لهم ومعبد ... لكنما المضحك في ذا الصدد
إلههم ثور برأس حبر
وهكذا سكان مصر السالفة ... مع آل أشور لهم محالفة
كانوا على الأرض أجل طايفة ... أجسادهم محنطات واقفة
ولا يرى هذا سوى في مصر
(له بقية)
مجلة الرسالة - العدد 245
بتاريخ: 14 - 03 - 1938
حسين فوزي