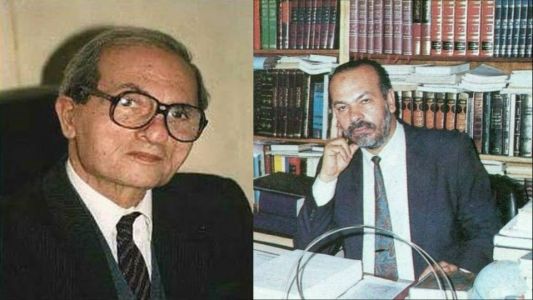وينتقل بنا الخواجا فرنسيس من أشور لمصر ليونان لروما، فيقول في فلاسفة الإغريق:
فذاك أرسطو وذا إقليدس ... ذو منطق هذا وذا مهندس
وهو ذا سقراط ذاك الأنفس ... من كان للآداب دوماً يغرس
ثم يكون من سوء حظ ديوجنيس أن يجئ في الشطرة الخامسة، فتسلبه القافية الرائية مصباحه، ولا يبقى له من فلسفته الكاتبة إلا أن يكون:
وذا ديوجنيس ذو التعرّي!
ورحالتنا رجل حساس بجمال فن التصوير، فهو يأمرنا:
أن نعرج نحو مكان الصور ... حتى نرى أجمل صنع البشر
حيث عينه الفنانة لا تخفي عليها خافية:
فهاك كل بطل مبارز ... يلوح في أعضائه البوارز
وكل خود ذات طرف غامز ... وأجفن عن الهوى روامز
وطلعة تخسف وجه البدر
لا شك أنك تعبت من التجوال - أو من الشعر! - والخواجا فرنسيس يشعر بذلك تواً، فهو يلاحقك بشعره الفلسفي إذ يقول:
تبا لنفس حظها يصرعها ... وكل ما يلزها (كذا!) يلذعه
آفتها تضجر يتبعها ... فأينما سارت أتى يصفعها
وربما يلحقها للقبر
أظن أننا لن ننتهي بسلام من خمسمائية المعلم فرنسيس، وقد تكفي الإشارة إلى أنه ينتقل بك فيها من حديقة (اللوكسمبور) إلى متحف (كلسوني) ومن دار البلدية إلى (بولفار ميخائيل إلى لقا ينبوعه الجميل). ولا ينسى أن يعرج بك على حديقة النبات ومتحف التاريخ الطبيعي حيث يدور شعراً في أقسامه من الجيولوجيا، إلى المعادن، إلى النبات، إلى الحيوان. ثم هو يأخذ بيدك إلى متحف (الفنون والصناعات)، وينتهي بك إلى باريس في الليل حيث يرى (الكل يمشون بها أزواجاً - ويدخلون في الصفا أزواجاً)
والآن وقد اجتزنا محنة شعر الخواجا فرنسيس، يمكننا أن نتمتع دون وجل ببقية نثره. فنعود إليه في أول وصوله إلى باريس عند (انفلاق الصباح) تلك المدينة ذات الشوارع (رحبة العرض، مستقيمة الطول، حسنة التمهيد والتخطيط. . . جامعة لكل شروط النظافة والإتقان. فلا يقوم هناك للجيف الطاعونية انبعاث، ولا للأقزاز (كذا) الوبائية حشر) - لا شك أن صورة عمران العثمانيون لسوريا ماثلة لعين الحلبي المسكين وهو يكتب هذه الفقرة!
ودخل رحالتنا إلى مسارح باريس التمثيلية منها والغنائية، فوجد الفرنسيين فيها (جامعين إلى دست واحد ما تفرقت قطعه في رقاع السنين. وهكذا يحلون هذه الاستحضارات (ليفكرن صاحبنا بالمندل) والاستظهارات بقلايد الآداب، وفصاحة اللغة ويرخمونها بآلات الطرب وحسن الصوت، بحيث أن المشاهد لا يعود يدري بأي حاسة يستقبل وقوع الطرب (بحاسة الشم غالباً!) أبعينه أم بأذنه. فيرحل حاملا في دماغه نهاراً من الأدوار الأدبية، وفي أعينه انبهاراً من الأضواء الطبيعية، وفي قلبه أنهاراً من ينابيع الطرب والحبور)
ولا شك أن ضوضاء باريس في 1867 كانت شديدة على آذان هذا الحلبي - ليت شعري ماذا يقول لو عاد إلى باريس سنة 1938! - (حينما تكون الأعين راتعة في تلك الآفاق الزاهرة، تكون الآذان عرضة لالتطام تموجات الضوضاء الباريسية، واصطدام تلك الرجات التي تبتلع لعلعات الرعود، وتهتضم طلقات الصواعق. فهناك ألوف المركبات مندفعة على الدوام اندفاع الأمواج إزاء مهب العواصف، وألوف صنوف العربات منسحبة وراء خيولها الجامحة (تصور ألوف الخيول الجامحة وسط المدينة العامرة!) انسحاب السحاب بأزمة الرياح)
وعن العمل والعمال والنشاط البادي في كل مظاهر الحياة: (وهناك لا يفتر صياح ربوات أعمال الأيدي مطلوقاً من أفواه الآلات والأجهزة، ولا تكف ألوف المعامل البخارية صافرة بأبواقها النارية لتدعو فرسان العقول - لاحظ اللغة التصويرية! - إلى مواصلة النزال في حومة الإبداع والاختراع، تسديداً لواجبات القرايح، وتشييداً لنظام الجماعة. وهناك الجميع يجرون إلى الامام، الجميع يحركون، الجميع يتسارعون، الجميع يشتغلون، الجميع متعاضدون سوية، منضمون إلى قوة واحدة، للركض إلى اقتحام كل المصاعب، والوصول إلى قمة الكمال والجمال. . . فكم سرور واندهاش للأعين إذا، عندما ترى هذه الأمة الفرنساوية تتموج على بعضها كقصعة واحدة، بدون نزاع في جزئياتها، ولا انقسام في كلياتها، سابحة في بحور الأمن والسلام، بدون خوف من واثب أجنبي أو حسود غادر) ونسى الخواجا فرنسيس سياسياً في برلين اسمه بسمارك يتربص بفرنسا؛ ويرسل (أولان) بروسيا يقتحمون باريس بعد أربع سنوات من كلاعه عن (الواثب الأجنبي، والحسود الغادر)، ويعقدون تاج الإمبراطورية الألمانية على رأس غليوم الأول في قصر فرساي. لذا واصل رحالتنا كلامه عن (عدم خوف الأمة الفرنساوية من وحش مفترس، أو جبار مختلس - بالذات! - رافلة بأذيال الحرية الكاملة) - في عهد الإمبراطور نابليون الثالث تلك الحرية الكاملة!
أما عن أنوار باريس - ويقينا باريس كانت جديرة باسم (مدينة النور) حتى في ذلك الوقت - فالخواجا يحدثنا عن (الأنوار الغازية المندفعة من أفواه ربوات أنابيبها تحت أشكال ألسن نارية تدعو باردي الروح إلى الدخول في كرة التمدن المتوقدة بلهيب الحكمة والآداب)
ورحالتنا الحلبي مدرك تمام الإدراك أن (كل هذا العجيب والكمال الغريب الذي رقت إليه هذه المدينة المعظمة) إنما هو نتيجة ارتقاء (العقل عندهم في طريق التقدم والنجاح، ولم يصعد العقل إلى القمة العالية إلا بدرج المدارس التي لا يفتر تشييدها، ولا يكف نظامها. فيوجد عندهم لكل قسم من العلوم مدرسة تحيط به وتجمع شمله جمعاً لا يقبل التفريق)
ثم هم (أقاموا في كل جانب من المدينة مكتبة عظيمة، معدة لقبول الجمهور مطلقاً. فيدخلون الناس إليها أفواجاً، ويقرءون ما يريدون، وينسخون ما يشتهون بكل راحة وهدوء بال. . .
ولما كان يوجد جانب كبير من العلوم يستلزم كونه عملياً وعيانياً بعد كونه نظرياً، فقد شادوا لذلك محلات مخصوصة يسمونها بالموزيوم، وأشحنوها من كل المواد الضرورية لدراسة موضوعها) وقد وجدها الخواجا فرنسيس مقسمة إلى ما يشتمل على (الاستحضارات التاريخية جيلاً فجيلاً، وأمة فأمة، إن يكن بالنظر إلى أعمال الأيدي، أو إلى الأديان والعقايد، أو إلى العادات. . وما يشتمل على المواد التي يتألف منها جسم الأرض وما يشتمل منها على الأجسام المشرحة مع كل أعضائها وأجهزتها حيث يتأمل الإنسان كل نواميس نموه منذ كونه دودة وليس بإنسان، إلى كونه إنسانا عظيما. . . وما يشتمل على العالم النباتي بكل طوايفه. . . أو العالم الحيواني بكل أجناسه وأنواعه. . . حتى يدرك نظام حيوة كل نوع وفرد، فيعلم أخيراً أن الحيوان كلما انتصب هيكله ارتفع نوعه. حتى إذا ما وقع رأسه عموداً على محور سلسلته كان إنساناً)
وقد رأى أن (هجوم الناس على العلوم والمعارف يشبه انحدارا الغدران من أعالي الجبال. فترى الأباء يسرعون إلى وضع أولادهم في المكاتب حالا بعد فطامهم (أي والله!).)
ومن أدق ما لاحظه المعلم فرنسيس اهتمام الفرنسيين بدراسة لغتهم، إذ يجب (أن يعلم كل منهم قواعد لغته وفهم أصولها. والذي يجهل ذلك يعتبر عندهم كالحيوان العديم النطق، لعدم معرفته صحة النطق. . . وكلما ازداد الشخص معرفة وتعميقاً بلغته، ازداد اعتباراً وكرامة وارتقاء، إلى أن يجعلوه قاضياً في محكمة اللغة أقرأ: '
وكيف يرى الخواجا فرنسيس الحلبي كل ذلك ولا يفكر في ضعة الشرق وانحطاطه، أو لا يقارن بين ما ينال العالم في فرنسا وبينما يصيب من له في الشرق (هوس في العلم، فيعيش مقطوع الخرج، وربما يحتقر ويهان. ولا يحصل على شيء من الجوايز سوى قول الناس عنه: هذا نحوي بارد، أو شاعر مشعر، أو بعرفينو، أو فلفوس. وإذا كان يروي شيئاً من التاريخ يقول عنه: هذا حكاكاتي). وخواجتنا العلامة لا يدعك تتساءل عن أصل هذه الكلمات، فهو يفتح قوساً ليقول لك بأنه (يوجد كثيرون يقبلون شاعر إلى مشعر، وعارف إلى بعرفينو، وفيلسوف إلى فلفوس، وحكاياتي (كذا!) إلى حكاكاتي!)
ولقد لاحظ رحالتنا والألم يحز في فؤاده أن مركز الطلبة غير محترم في باريس. وتفسير ذلك عنده (أنه ما لم يحصل الدارس أولا على شهادة مدرسية، فأنه لا يمكنه الحصول على ثمرة دراسته وجايزة أتعابه. كما أنه بدون رنين هذه الشهادة لا يسمع أحد به، فلا يوجد له اعتبار، وربما كان ساقطاً من أعين الناس لكونه دارساً. سيما إذا كان يدرس الطب أو الشريعة). وسترى أن طلبة الطب والحقوق في عصرنا إنما يحتفظون بسمعة قدمائهم السيئة. واليك تفسير الخواجا فرنسيس، وهو ينطبق في بعضه على العصر الحاضر: (وما ذاك إلا لأن صيت درسة (طلبة) هاتين الصنعتين لا يوجد عندهم اقبح منه. ولا جرم في شيوع هذا الصيت الردى لأنه يوجد حقيقة قسم كبير من هؤلاء الدارسين مطلوق العنان إلى ارتكاب الكباير والجرايم، عوض الانكباب على الدراسة والمطالعة. فترى جماعة هذا القسم تايهين في عالم الشهوات، وضاربين في أودية المعاصي. فهم يطوون النهار ويحيون الليل ما بين الدساكر والخمارات ومحلات الانهماك على الفساد. . . فتراهم هناك مفصومي العرى، محلولي الثياب، مشوشي الشعر. وبرانيطهم مقلوبة إلى الوراء كأنها مجفلة من إماراتهم)
وكان من سوء حظ المعلم فرنسيس أن يشهد جامعياً في داخل قاعة المحاضرات: (وقد شهدت شيئاً من ذلك ضد أعظم معلمي النباتات عندهم. وهو أنني دخلت إلى القاعة المعدة للخطابات، حينما كان المعلم مزمعاً أن يفتح كلامه على النباتات. فرأيت المحفل مضاعف الاحتفال. أي أنني وجدت عدداً وافراً من الدارسين الذين لم أصادفهم قط في محلات الدراسة. فحالما دخل المعلم لابساً ثيابه الرسمية، وصعد على منبر الخطابة، أخذ هؤلاء الدارسون يصيحون ضده، ويصفرون ويزمرون ويدبديون بأرجلهم حتى لم يتركوا له سبيلا للفظ كلمة. وكلما رأوا شفتيه تتحرك أو تهم على الحركة أزادوا الضوضاء والصراخات. وفي أثناء ذلك دخل رئيس المدرسة نفسه ليرجوهم أن يستمعوا لهذا المعلم. فما نجم عن دخوله سوى تضاعف مربع الحركة، ولم يلبثوا أن هبط الخطيب من منبره فانفض المجلس).
لا حاجة إلى وصف الخواجا فرنسيس بأنه رجل ساذج فقد (عرته حينئذ جمودة البهتة وصار مهوى لتيار الاقشعرار، وكان قلبه يقابل ارتجاف المحل بارتجاف الرعدة). ولدى خروجه سأل البعض عن (سبب اندفاع هذا البركان البليغ، فقيل له إن هؤلاء الدرسة يمقتون كل معلم يدقق مسايل الامتحان لكونهم لا يدرسون إلا نادراً وقليلاً. ولذلك يريدون عزل هذا المعلم أو تنكيس أعلامه لشدة تدقيقه عليهم في الامتحان النباتي بحيث لا يمكنهم احتمال ذلك لضعف دراستهم). ويغلب على ظني أن السبب في هذا الـ كان سياسياً. وأقرب الحوادث من نوعه إلى أذهاننا مظاهرة طلبة الحقوق ضد البرفسور جيز أيام كان يدافع عن قضية النجاشى في عصبة الأمم. نعم إن قسوة الأستاذ في الامتحان ربما ساعدت على تظاهر الطلبة، ولكنها لا يمكن أن تكون سبباً بعينها. وما رآه الخواجا فرنسيس يرجع في ظني إلى الشعور الجمهوري الذي كان ينفجر من آن لآخر بعد قلب الجمهورية الثانية وتنصيب البرنس نابليون إمبراطوراً باسم نابليون الثالث
وواضح أن الخواجا فرنسيس رجل قليل التسامح. فهو الدارس - برغم الثلاثين وبلغها - يجاري الرأي العام في الزاوية بالدرسة حتى لينتقد لباسهم. ولا شك أن هذا الحلبي لابس القنباز كان آخر الناس أهلية للحكم على لباس الطلبة في باريس؛ وهذا الشرقي كان آخر من يحق له أن يحجر على حرية الطالب الباريسي؛ ومع ذلك يقول: (والنظر الساذج إلى أولئك الدارسين يوشي بقبح سلوكهم، لأن ملابسهم تعبر عن منافسهم، فهم يلبسون بنطلونات هكذا ضيقة حتى يكاد تتمزق بين أفخاذهم، وسترات هكذا قصيرة حتى لا تخفي شيئاً من الإليتين إلا قليلاً، وشعورهم طويلة منفوشة، وبرانيطهم عريضة كثيرة الانفراج هضيمة الكشح. وكلما كانت البرنيطة تامة في هذا الشكل كان صاحبها أكثر تقدما في ذلك الضرب، حتى تخال البعض من هذه البرانيط نظير غمامة سوداء على رأس حاملها، فمتى لاح هكذا شخص قال الناس: هو ذا الدارس!) فالمعلم فرنسيس يأسف على وجود (هكذا سرب بين دُرس الطب والشريعة أوجب سقوط الجميع من أعين العامة مدة الدراسة مع أن جماعة القسم الأكبر - والذي عليه المعول - لا يسلكون تلك الطريق، بل يسيرون في سبيل مضاد على الخط المستقيم، وعوض أن يطفئوا بمياه الشباب لهبات الشهوات إنما يستقطرونها بأنابيق أدمغتهم المضطرمة بنار الاجتهاد والحمية)
ويستطرق رحالتنا من كلام عن الدرسة المجتهدين إلى ختام وصفه النثري لباريس حيث له حديث طويل عن (بحار التمدن المتدفقة من محابر رجالها، وانهار الأدب جارية من ينابيع أفكارهم) وعن (ممالك الأباطيل والأضاليل، وعروش الحقائق والهدى). ثم يتحدث في لغة سامية عن الفكر (وقوته التي تغلب جميع القوات، ولا تعرف راداً إذا جمحت، ولا صادماً إذا اندفعت). ويضرب لهذه القوة أمثلة أجاد اختيارها حقاً، فهو يقول: (أي قوة أوقفت حركة الأرض بعد ما أدارها غاليلي (جاليلو) على محورها، ودفعها تكر على محيط دايرة البروج. وأي قوة هدمت بناية الإصلاح بعد ما أشادها فكرهوس , وأي قوة أوقعت دوران الدم في أوعيته بعد ما أجراه فكر هارفي مع أن ذلك حبس وذاك حرق (جان هوس احرق على ما أذكر) وذا اضطهد)
(ولما عرف بنو المغرب كونهم محملين بقوة الفكر، أخذوا يهذبونها ويثقفونها، ويستظهرون نتائجها بدون التفات إلى تهديدات المغرضين، أو معارضات المبغضين). وبذلك (بلغوا هذا المبلغ العظيم من الفلاح والنجاح، وتركوا بقية العالم يتقهقر وراءهم، ويتساقط تحت أحمال كبرائه، وأثقال ثقلائه، فاقد التفكير وعديم النطق)
وهذه الإشارة المستترة إلى (تساقط الشرق تحت أحمال كبرائه وأثقال ثقلائه، فاقد الفكر وعديم النطق) تشترى كل كبوات الأسلوب عند الخواجا فرنسيس، فهو رجل سليم التفكير جدير بالتهنئة على كتابه الساذج، ولو أن هذه التهنئة (تشيح بوجهها) أمام شعره، وإذا كان نثره (يصدمنا) بصوره العنيفة المزدحمة، فإن خلوه من التسجيع الذي كان ضرورة من ضرورات الكتابة في عصره، يشهد للخواجا فرنسيس بروح استقلالية مشكورة، كنا نود أن نراها تعمل على إقصائه نهائياً عن الشعر بعد أن عصمته من السجع
ويختتم الرحالة كتابه بفصل إضافي عن معرض باريس العام في سنة 1867. ولكن هذا الفصل لا يمكن أن يزيد معرفتنا بالخواجا فرنسيس. . . حتى ولا بذلك المعرض
حسين فوزي
مجلة الرسالة - العدد 248
بتاريخ: 04 - 04 - 1938
فذاك أرسطو وذا إقليدس ... ذو منطق هذا وذا مهندس
وهو ذا سقراط ذاك الأنفس ... من كان للآداب دوماً يغرس
ثم يكون من سوء حظ ديوجنيس أن يجئ في الشطرة الخامسة، فتسلبه القافية الرائية مصباحه، ولا يبقى له من فلسفته الكاتبة إلا أن يكون:
وذا ديوجنيس ذو التعرّي!
ورحالتنا رجل حساس بجمال فن التصوير، فهو يأمرنا:
أن نعرج نحو مكان الصور ... حتى نرى أجمل صنع البشر
حيث عينه الفنانة لا تخفي عليها خافية:
فهاك كل بطل مبارز ... يلوح في أعضائه البوارز
وكل خود ذات طرف غامز ... وأجفن عن الهوى روامز
وطلعة تخسف وجه البدر
لا شك أنك تعبت من التجوال - أو من الشعر! - والخواجا فرنسيس يشعر بذلك تواً، فهو يلاحقك بشعره الفلسفي إذ يقول:
تبا لنفس حظها يصرعها ... وكل ما يلزها (كذا!) يلذعه
آفتها تضجر يتبعها ... فأينما سارت أتى يصفعها
وربما يلحقها للقبر
أظن أننا لن ننتهي بسلام من خمسمائية المعلم فرنسيس، وقد تكفي الإشارة إلى أنه ينتقل بك فيها من حديقة (اللوكسمبور) إلى متحف (كلسوني) ومن دار البلدية إلى (بولفار ميخائيل إلى لقا ينبوعه الجميل). ولا ينسى أن يعرج بك على حديقة النبات ومتحف التاريخ الطبيعي حيث يدور شعراً في أقسامه من الجيولوجيا، إلى المعادن، إلى النبات، إلى الحيوان. ثم هو يأخذ بيدك إلى متحف (الفنون والصناعات)، وينتهي بك إلى باريس في الليل حيث يرى (الكل يمشون بها أزواجاً - ويدخلون في الصفا أزواجاً)
والآن وقد اجتزنا محنة شعر الخواجا فرنسيس، يمكننا أن نتمتع دون وجل ببقية نثره. فنعود إليه في أول وصوله إلى باريس عند (انفلاق الصباح) تلك المدينة ذات الشوارع (رحبة العرض، مستقيمة الطول، حسنة التمهيد والتخطيط. . . جامعة لكل شروط النظافة والإتقان. فلا يقوم هناك للجيف الطاعونية انبعاث، ولا للأقزاز (كذا) الوبائية حشر) - لا شك أن صورة عمران العثمانيون لسوريا ماثلة لعين الحلبي المسكين وهو يكتب هذه الفقرة!
ودخل رحالتنا إلى مسارح باريس التمثيلية منها والغنائية، فوجد الفرنسيين فيها (جامعين إلى دست واحد ما تفرقت قطعه في رقاع السنين. وهكذا يحلون هذه الاستحضارات (ليفكرن صاحبنا بالمندل) والاستظهارات بقلايد الآداب، وفصاحة اللغة ويرخمونها بآلات الطرب وحسن الصوت، بحيث أن المشاهد لا يعود يدري بأي حاسة يستقبل وقوع الطرب (بحاسة الشم غالباً!) أبعينه أم بأذنه. فيرحل حاملا في دماغه نهاراً من الأدوار الأدبية، وفي أعينه انبهاراً من الأضواء الطبيعية، وفي قلبه أنهاراً من ينابيع الطرب والحبور)
ولا شك أن ضوضاء باريس في 1867 كانت شديدة على آذان هذا الحلبي - ليت شعري ماذا يقول لو عاد إلى باريس سنة 1938! - (حينما تكون الأعين راتعة في تلك الآفاق الزاهرة، تكون الآذان عرضة لالتطام تموجات الضوضاء الباريسية، واصطدام تلك الرجات التي تبتلع لعلعات الرعود، وتهتضم طلقات الصواعق. فهناك ألوف المركبات مندفعة على الدوام اندفاع الأمواج إزاء مهب العواصف، وألوف صنوف العربات منسحبة وراء خيولها الجامحة (تصور ألوف الخيول الجامحة وسط المدينة العامرة!) انسحاب السحاب بأزمة الرياح)
وعن العمل والعمال والنشاط البادي في كل مظاهر الحياة: (وهناك لا يفتر صياح ربوات أعمال الأيدي مطلوقاً من أفواه الآلات والأجهزة، ولا تكف ألوف المعامل البخارية صافرة بأبواقها النارية لتدعو فرسان العقول - لاحظ اللغة التصويرية! - إلى مواصلة النزال في حومة الإبداع والاختراع، تسديداً لواجبات القرايح، وتشييداً لنظام الجماعة. وهناك الجميع يجرون إلى الامام، الجميع يحركون، الجميع يتسارعون، الجميع يشتغلون، الجميع متعاضدون سوية، منضمون إلى قوة واحدة، للركض إلى اقتحام كل المصاعب، والوصول إلى قمة الكمال والجمال. . . فكم سرور واندهاش للأعين إذا، عندما ترى هذه الأمة الفرنساوية تتموج على بعضها كقصعة واحدة، بدون نزاع في جزئياتها، ولا انقسام في كلياتها، سابحة في بحور الأمن والسلام، بدون خوف من واثب أجنبي أو حسود غادر) ونسى الخواجا فرنسيس سياسياً في برلين اسمه بسمارك يتربص بفرنسا؛ ويرسل (أولان) بروسيا يقتحمون باريس بعد أربع سنوات من كلاعه عن (الواثب الأجنبي، والحسود الغادر)، ويعقدون تاج الإمبراطورية الألمانية على رأس غليوم الأول في قصر فرساي. لذا واصل رحالتنا كلامه عن (عدم خوف الأمة الفرنساوية من وحش مفترس، أو جبار مختلس - بالذات! - رافلة بأذيال الحرية الكاملة) - في عهد الإمبراطور نابليون الثالث تلك الحرية الكاملة!
أما عن أنوار باريس - ويقينا باريس كانت جديرة باسم (مدينة النور) حتى في ذلك الوقت - فالخواجا يحدثنا عن (الأنوار الغازية المندفعة من أفواه ربوات أنابيبها تحت أشكال ألسن نارية تدعو باردي الروح إلى الدخول في كرة التمدن المتوقدة بلهيب الحكمة والآداب)
ورحالتنا الحلبي مدرك تمام الإدراك أن (كل هذا العجيب والكمال الغريب الذي رقت إليه هذه المدينة المعظمة) إنما هو نتيجة ارتقاء (العقل عندهم في طريق التقدم والنجاح، ولم يصعد العقل إلى القمة العالية إلا بدرج المدارس التي لا يفتر تشييدها، ولا يكف نظامها. فيوجد عندهم لكل قسم من العلوم مدرسة تحيط به وتجمع شمله جمعاً لا يقبل التفريق)
ثم هم (أقاموا في كل جانب من المدينة مكتبة عظيمة، معدة لقبول الجمهور مطلقاً. فيدخلون الناس إليها أفواجاً، ويقرءون ما يريدون، وينسخون ما يشتهون بكل راحة وهدوء بال. . .
ولما كان يوجد جانب كبير من العلوم يستلزم كونه عملياً وعيانياً بعد كونه نظرياً، فقد شادوا لذلك محلات مخصوصة يسمونها بالموزيوم، وأشحنوها من كل المواد الضرورية لدراسة موضوعها) وقد وجدها الخواجا فرنسيس مقسمة إلى ما يشتمل على (الاستحضارات التاريخية جيلاً فجيلاً، وأمة فأمة، إن يكن بالنظر إلى أعمال الأيدي، أو إلى الأديان والعقايد، أو إلى العادات. . وما يشتمل على المواد التي يتألف منها جسم الأرض وما يشتمل منها على الأجسام المشرحة مع كل أعضائها وأجهزتها حيث يتأمل الإنسان كل نواميس نموه منذ كونه دودة وليس بإنسان، إلى كونه إنسانا عظيما. . . وما يشتمل على العالم النباتي بكل طوايفه. . . أو العالم الحيواني بكل أجناسه وأنواعه. . . حتى يدرك نظام حيوة كل نوع وفرد، فيعلم أخيراً أن الحيوان كلما انتصب هيكله ارتفع نوعه. حتى إذا ما وقع رأسه عموداً على محور سلسلته كان إنساناً)
وقد رأى أن (هجوم الناس على العلوم والمعارف يشبه انحدارا الغدران من أعالي الجبال. فترى الأباء يسرعون إلى وضع أولادهم في المكاتب حالا بعد فطامهم (أي والله!).)
ومن أدق ما لاحظه المعلم فرنسيس اهتمام الفرنسيين بدراسة لغتهم، إذ يجب (أن يعلم كل منهم قواعد لغته وفهم أصولها. والذي يجهل ذلك يعتبر عندهم كالحيوان العديم النطق، لعدم معرفته صحة النطق. . . وكلما ازداد الشخص معرفة وتعميقاً بلغته، ازداد اعتباراً وكرامة وارتقاء، إلى أن يجعلوه قاضياً في محكمة اللغة أقرأ: '
وكيف يرى الخواجا فرنسيس الحلبي كل ذلك ولا يفكر في ضعة الشرق وانحطاطه، أو لا يقارن بين ما ينال العالم في فرنسا وبينما يصيب من له في الشرق (هوس في العلم، فيعيش مقطوع الخرج، وربما يحتقر ويهان. ولا يحصل على شيء من الجوايز سوى قول الناس عنه: هذا نحوي بارد، أو شاعر مشعر، أو بعرفينو، أو فلفوس. وإذا كان يروي شيئاً من التاريخ يقول عنه: هذا حكاكاتي). وخواجتنا العلامة لا يدعك تتساءل عن أصل هذه الكلمات، فهو يفتح قوساً ليقول لك بأنه (يوجد كثيرون يقبلون شاعر إلى مشعر، وعارف إلى بعرفينو، وفيلسوف إلى فلفوس، وحكاياتي (كذا!) إلى حكاكاتي!)
ولقد لاحظ رحالتنا والألم يحز في فؤاده أن مركز الطلبة غير محترم في باريس. وتفسير ذلك عنده (أنه ما لم يحصل الدارس أولا على شهادة مدرسية، فأنه لا يمكنه الحصول على ثمرة دراسته وجايزة أتعابه. كما أنه بدون رنين هذه الشهادة لا يسمع أحد به، فلا يوجد له اعتبار، وربما كان ساقطاً من أعين الناس لكونه دارساً. سيما إذا كان يدرس الطب أو الشريعة). وسترى أن طلبة الطب والحقوق في عصرنا إنما يحتفظون بسمعة قدمائهم السيئة. واليك تفسير الخواجا فرنسيس، وهو ينطبق في بعضه على العصر الحاضر: (وما ذاك إلا لأن صيت درسة (طلبة) هاتين الصنعتين لا يوجد عندهم اقبح منه. ولا جرم في شيوع هذا الصيت الردى لأنه يوجد حقيقة قسم كبير من هؤلاء الدارسين مطلوق العنان إلى ارتكاب الكباير والجرايم، عوض الانكباب على الدراسة والمطالعة. فترى جماعة هذا القسم تايهين في عالم الشهوات، وضاربين في أودية المعاصي. فهم يطوون النهار ويحيون الليل ما بين الدساكر والخمارات ومحلات الانهماك على الفساد. . . فتراهم هناك مفصومي العرى، محلولي الثياب، مشوشي الشعر. وبرانيطهم مقلوبة إلى الوراء كأنها مجفلة من إماراتهم)
وكان من سوء حظ المعلم فرنسيس أن يشهد جامعياً في داخل قاعة المحاضرات: (وقد شهدت شيئاً من ذلك ضد أعظم معلمي النباتات عندهم. وهو أنني دخلت إلى القاعة المعدة للخطابات، حينما كان المعلم مزمعاً أن يفتح كلامه على النباتات. فرأيت المحفل مضاعف الاحتفال. أي أنني وجدت عدداً وافراً من الدارسين الذين لم أصادفهم قط في محلات الدراسة. فحالما دخل المعلم لابساً ثيابه الرسمية، وصعد على منبر الخطابة، أخذ هؤلاء الدارسون يصيحون ضده، ويصفرون ويزمرون ويدبديون بأرجلهم حتى لم يتركوا له سبيلا للفظ كلمة. وكلما رأوا شفتيه تتحرك أو تهم على الحركة أزادوا الضوضاء والصراخات. وفي أثناء ذلك دخل رئيس المدرسة نفسه ليرجوهم أن يستمعوا لهذا المعلم. فما نجم عن دخوله سوى تضاعف مربع الحركة، ولم يلبثوا أن هبط الخطيب من منبره فانفض المجلس).
لا حاجة إلى وصف الخواجا فرنسيس بأنه رجل ساذج فقد (عرته حينئذ جمودة البهتة وصار مهوى لتيار الاقشعرار، وكان قلبه يقابل ارتجاف المحل بارتجاف الرعدة). ولدى خروجه سأل البعض عن (سبب اندفاع هذا البركان البليغ، فقيل له إن هؤلاء الدرسة يمقتون كل معلم يدقق مسايل الامتحان لكونهم لا يدرسون إلا نادراً وقليلاً. ولذلك يريدون عزل هذا المعلم أو تنكيس أعلامه لشدة تدقيقه عليهم في الامتحان النباتي بحيث لا يمكنهم احتمال ذلك لضعف دراستهم). ويغلب على ظني أن السبب في هذا الـ كان سياسياً. وأقرب الحوادث من نوعه إلى أذهاننا مظاهرة طلبة الحقوق ضد البرفسور جيز أيام كان يدافع عن قضية النجاشى في عصبة الأمم. نعم إن قسوة الأستاذ في الامتحان ربما ساعدت على تظاهر الطلبة، ولكنها لا يمكن أن تكون سبباً بعينها. وما رآه الخواجا فرنسيس يرجع في ظني إلى الشعور الجمهوري الذي كان ينفجر من آن لآخر بعد قلب الجمهورية الثانية وتنصيب البرنس نابليون إمبراطوراً باسم نابليون الثالث
وواضح أن الخواجا فرنسيس رجل قليل التسامح. فهو الدارس - برغم الثلاثين وبلغها - يجاري الرأي العام في الزاوية بالدرسة حتى لينتقد لباسهم. ولا شك أن هذا الحلبي لابس القنباز كان آخر الناس أهلية للحكم على لباس الطلبة في باريس؛ وهذا الشرقي كان آخر من يحق له أن يحجر على حرية الطالب الباريسي؛ ومع ذلك يقول: (والنظر الساذج إلى أولئك الدارسين يوشي بقبح سلوكهم، لأن ملابسهم تعبر عن منافسهم، فهم يلبسون بنطلونات هكذا ضيقة حتى يكاد تتمزق بين أفخاذهم، وسترات هكذا قصيرة حتى لا تخفي شيئاً من الإليتين إلا قليلاً، وشعورهم طويلة منفوشة، وبرانيطهم عريضة كثيرة الانفراج هضيمة الكشح. وكلما كانت البرنيطة تامة في هذا الشكل كان صاحبها أكثر تقدما في ذلك الضرب، حتى تخال البعض من هذه البرانيط نظير غمامة سوداء على رأس حاملها، فمتى لاح هكذا شخص قال الناس: هو ذا الدارس!) فالمعلم فرنسيس يأسف على وجود (هكذا سرب بين دُرس الطب والشريعة أوجب سقوط الجميع من أعين العامة مدة الدراسة مع أن جماعة القسم الأكبر - والذي عليه المعول - لا يسلكون تلك الطريق، بل يسيرون في سبيل مضاد على الخط المستقيم، وعوض أن يطفئوا بمياه الشباب لهبات الشهوات إنما يستقطرونها بأنابيق أدمغتهم المضطرمة بنار الاجتهاد والحمية)
ويستطرق رحالتنا من كلام عن الدرسة المجتهدين إلى ختام وصفه النثري لباريس حيث له حديث طويل عن (بحار التمدن المتدفقة من محابر رجالها، وانهار الأدب جارية من ينابيع أفكارهم) وعن (ممالك الأباطيل والأضاليل، وعروش الحقائق والهدى). ثم يتحدث في لغة سامية عن الفكر (وقوته التي تغلب جميع القوات، ولا تعرف راداً إذا جمحت، ولا صادماً إذا اندفعت). ويضرب لهذه القوة أمثلة أجاد اختيارها حقاً، فهو يقول: (أي قوة أوقفت حركة الأرض بعد ما أدارها غاليلي (جاليلو) على محورها، ودفعها تكر على محيط دايرة البروج. وأي قوة هدمت بناية الإصلاح بعد ما أشادها فكرهوس , وأي قوة أوقعت دوران الدم في أوعيته بعد ما أجراه فكر هارفي مع أن ذلك حبس وذاك حرق (جان هوس احرق على ما أذكر) وذا اضطهد)
(ولما عرف بنو المغرب كونهم محملين بقوة الفكر، أخذوا يهذبونها ويثقفونها، ويستظهرون نتائجها بدون التفات إلى تهديدات المغرضين، أو معارضات المبغضين). وبذلك (بلغوا هذا المبلغ العظيم من الفلاح والنجاح، وتركوا بقية العالم يتقهقر وراءهم، ويتساقط تحت أحمال كبرائه، وأثقال ثقلائه، فاقد التفكير وعديم النطق)
وهذه الإشارة المستترة إلى (تساقط الشرق تحت أحمال كبرائه وأثقال ثقلائه، فاقد الفكر وعديم النطق) تشترى كل كبوات الأسلوب عند الخواجا فرنسيس، فهو رجل سليم التفكير جدير بالتهنئة على كتابه الساذج، ولو أن هذه التهنئة (تشيح بوجهها) أمام شعره، وإذا كان نثره (يصدمنا) بصوره العنيفة المزدحمة، فإن خلوه من التسجيع الذي كان ضرورة من ضرورات الكتابة في عصره، يشهد للخواجا فرنسيس بروح استقلالية مشكورة، كنا نود أن نراها تعمل على إقصائه نهائياً عن الشعر بعد أن عصمته من السجع
ويختتم الرحالة كتابه بفصل إضافي عن معرض باريس العام في سنة 1867. ولكن هذا الفصل لا يمكن أن يزيد معرفتنا بالخواجا فرنسيس. . . حتى ولا بذلك المعرض
حسين فوزي
مجلة الرسالة - العدد 248
بتاريخ: 04 - 04 - 1938