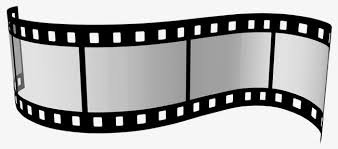تُحب الفنون المُزاملة فيما بينها، ولكنها في الوقت نفسه تحب الانفراد، أو هي على الأقل تحب نوعاً من الانفراد.
فالشعر والموسيقى يتزاملان في الغناء، وقد تتزامل في التمثيل خمسة أو ستة فنون، ومنها الشعر والقصة والموسيقى والرقص والتصوير.
والسينما في هذه الخصلة كالتمثيل، أو هي أوسع قدرة على الجمع بين الفنون المختلفة من خشبة المسرح، لأن الظلال تملك من الحرية ما لا يملكه الأحياء.
ولا شك أن السينما الناطقة أقدر على الجمع بين الفنون من السينما الصامتة التي كنا نشاهدها قبل نيف وعشرين سنة، أو قبل سنة 1927م على وجه التحديد.
ولكن من الخطأ أن نظن أن السينما كانت « فاقدة النطق » قبل تلك السنة، فإنها في الحقيقة لم تفقد النطق في وقت من الأوقات، ولم تفقده حتى في أواخر القرن التاسع عشر حين خرجت من الظلمات إلى النور للمرة الأولى.
لأنها كانت تُعرض دائماً ومعها توقيع موسيقي من فرقة كاملة، أو من معزف منفرد كالبيان والقيثار. وكان عارضو الصور المتحركة يُصاحبون عرضها بأصوات تُحاكي أصوات الموج أو الريح أو البواخر وقاطرات السكك الحديدية، كلما عُرضت هذه المناظر على اللوحة البيضاء.
وكاتب هذه السطور من أوائل من شهدوا الصور المتحركة على هذه الكرة الأرضية، وإن كنتُ لا أكثر التردد على دورها في هذه الأيام.
فقد كانت فنادق أسوان أحفل فنادق العالم في موسم الشتاء. وكان روادها من علية القوم في البلاد الأوربية والأمريكية، فلم تمض فترة قصيرة على عرض الأفلام الأولى في القارة الأمريكية حتى عُرضت على السائحين في أسوان. وأرسلت الدعوة إلى المدرسة الأميرية من قبيل المجاملة ليختار ناظرها طائفة من التلاميذ يشهدون تلك البدعة العجيبة، فكنت من بين هؤلاء التلاميذ المختارين، وسئلتُ أن أُلخِّص ما رأيت، وأن أصف الحفلة كلها في موضوع إنشاء.
رأيتُ الصور المتحركة يومئذ، وسمعتُ أصواتاً كأصوات الأمواج والرياح من وراء الستار، فخُيِّل إليَّ أن الآلة التي تُحرك الصور وتُحدث تلك الأصوات واحدة، ولكنه كان تخيلاً سبق الاختراع الواقعي بأكثر من عشرين سنة!
أما الموسيقى في تلك الحفلة فقد كانت ظاهرة لنا بآلاتها وأشخاص العازفين عليها، قلم نُخدع فيها كما خُدعْنا في أصوات الأمواج والرياح!
ولاحظت شركات الأفلام أن الفرق الموسيقية في دور العرض كثيراً ما تُصاحبها بنغمات لا تُناسبها، فيتفق أحياناً أن تكون القصة مأساة فاجعة، وتعزف الفرقة معها لحناً راقصاً أو لحناً يبعث في السامع شعور المرح والابتهاج!، فعالجت هذا الخطأ بكتابة وصف قصير لموضوع الفيلم يوزع على الموسيقيين قبل عرضه، وكثيراً ما كان هذا الوصف موجزاً غاية الإيجاز، لا يزيد في بعض الأحيان على كلمة واحدة، وهي كلمة «حزين» أو «فَرِحُ» أو «راقص» أو «هادئُ» أو «عنيف» .. ، ثم يترك لمدير الفرقة أن يختار لحناً مُناسباً لهذا الوصف الموجز كائناً ما كان.
ولا تظن أن فيلماً من الأفلام وُضعت له ألحان موسيقية خاصة قبل الفيلم الذي مثلت فيه رواية «مصرع الدوق دي جيز»، وعُرِض في باريس عام 1908م، وكانت موسيقاه من تأليف سان سانس الموسيقار الفرنسي المشهور. ثم تعوّدت الشركات أن تصنع الأفلام وتقترح تأليف الألحان المطولة التي تُناسبها على الموسيقيين المختصين.
كذلك يبدو لنا حب الفنون الجميلة للمزاملة بينها وفي مقدمتها فن الصور المتحركة.
أما حبها للانفراد ـ وإن شئت فقل حبها لنوع من الانفراد ـ فهو يبدو لنا في حالة واحدة تعم جميع هذه المزاملات، وهي أنها في اجتماعها تحب أن يتجه الاهتمام إلى واحد منها دون غيره، ولا تطيق أن تترك لشركائها نصيباً من الاهتمام إلا كنصيب الحاشية في حضرة الأمير.
خذ لذلك مثلاً؛ إنك تذهب إلى حفلات الغناء فيطيب لك أن تسمع الأناشيد والأغاني والألحان الموسيقية من أول الحفلة إلى نهايتها، وقد تستغرق الحفلة ثلاث ساعات أو أكثر من ثلاث ساعات.
ولكنك إذا قصدت أن تذهب إلى رواية تمثيلية على خشبة المسرح أو على اللوحة البيضاء، لا تلبث أن يضيق صدرك بالسماع إذا تجاوز عشر دقائق أو ربع ساعة، لأن الغناء هنا هو الحاشية، والتمثيل هنا هو الأمير الذي لا يُساويه شريك!
ويحدث في بعض الأفلام أن تعرض لك حياة موسيقي تعرفه، أو حياة مغن تُحب سماعه، فتستريح إلى السماع من أول الحفلة إلى نهايتها وتنفر من كل ما يُقاطع هذه الألحان وتطول فيه المقاطعة، وليس هذا شذوذاً عن القاعدة التي قدمناها عن مزاملات الفنون. فإنك في هذه الحالة تقصد السماع ولا تقصد تمثيل الرواية ومشاهدة المناظر، وهي تابعة للغناء والموسيقى لا يُؤتى بها إلا تمهيداً للانتقال وسدا للفراغ.
أما إن كان مقصدك الذي غلب على حياتك أن تُتابع قصة الموسيقار في حياته الخاصة وفي حياته العامة، وفي علاقاته بأصدقائه ومنافسيه ومحبيه ومحباته، فالأمير بين الفنون هنا هو فن القصة، والحاشية هنا هي الألحان والنغمات، وإن كانت في موضع آخر أحب إليك من القصص والتواريخ.
وسر ذلك غير عجيب وغير بعيد.
سره أن النفس الإنسانية حين تُواجه الفنون هي في الواقع آلة فنية حية، تربطها كما تربط الأوتار على نغم مخصوص فيروقك هذا النغم دون غيره، ويأتي كل نغم سواه كأنه ضرب من « النشوز » .
وقد كنا نذهب إلى السينما الصامتة ونحن نتهيّأ لها بزاد واسع من الخيال، لأنها تتطلّب منا أن نتخيّل المعاني والكلمات التي تدل عليها الإشارات والحركات.
أما اليوم، فالصور المتحركة التي تتطلب مثل هذا الخيال تضايق المتفرجين، لأنهم تعوّدوا أن يتوجهوا إليها بملكتي السمع والبصر دون ملكة الخيال.
ولهذا نتساءل: هل من المستحسن أن نهمل السينما الصامتة كل الإهمال؟
لا شك أن السينما الناطقة أقرب إلى التمثيل الطبيعي من السينما التي تعتمد على الحركة والإشارة.
ولكن السينما الصامتة تُحيي الخيال، وتُنشئ فيه لذة الخلق والإبداع، ولا خلاف بين محبي الفنون في قيمة الخيال، فإنه عنصر مهم في كل فن جميل، بل هو في جميع الفنون الجميلة أهم من العيون والآذان!
* [نُشرت في مجلة "الاثنين والدنيا" ـ العدد 761 ـ 10/1/1949م]
فالشعر والموسيقى يتزاملان في الغناء، وقد تتزامل في التمثيل خمسة أو ستة فنون، ومنها الشعر والقصة والموسيقى والرقص والتصوير.
والسينما في هذه الخصلة كالتمثيل، أو هي أوسع قدرة على الجمع بين الفنون المختلفة من خشبة المسرح، لأن الظلال تملك من الحرية ما لا يملكه الأحياء.
ولا شك أن السينما الناطقة أقدر على الجمع بين الفنون من السينما الصامتة التي كنا نشاهدها قبل نيف وعشرين سنة، أو قبل سنة 1927م على وجه التحديد.
ولكن من الخطأ أن نظن أن السينما كانت « فاقدة النطق » قبل تلك السنة، فإنها في الحقيقة لم تفقد النطق في وقت من الأوقات، ولم تفقده حتى في أواخر القرن التاسع عشر حين خرجت من الظلمات إلى النور للمرة الأولى.
لأنها كانت تُعرض دائماً ومعها توقيع موسيقي من فرقة كاملة، أو من معزف منفرد كالبيان والقيثار. وكان عارضو الصور المتحركة يُصاحبون عرضها بأصوات تُحاكي أصوات الموج أو الريح أو البواخر وقاطرات السكك الحديدية، كلما عُرضت هذه المناظر على اللوحة البيضاء.
وكاتب هذه السطور من أوائل من شهدوا الصور المتحركة على هذه الكرة الأرضية، وإن كنتُ لا أكثر التردد على دورها في هذه الأيام.
فقد كانت فنادق أسوان أحفل فنادق العالم في موسم الشتاء. وكان روادها من علية القوم في البلاد الأوربية والأمريكية، فلم تمض فترة قصيرة على عرض الأفلام الأولى في القارة الأمريكية حتى عُرضت على السائحين في أسوان. وأرسلت الدعوة إلى المدرسة الأميرية من قبيل المجاملة ليختار ناظرها طائفة من التلاميذ يشهدون تلك البدعة العجيبة، فكنت من بين هؤلاء التلاميذ المختارين، وسئلتُ أن أُلخِّص ما رأيت، وأن أصف الحفلة كلها في موضوع إنشاء.
رأيتُ الصور المتحركة يومئذ، وسمعتُ أصواتاً كأصوات الأمواج والرياح من وراء الستار، فخُيِّل إليَّ أن الآلة التي تُحرك الصور وتُحدث تلك الأصوات واحدة، ولكنه كان تخيلاً سبق الاختراع الواقعي بأكثر من عشرين سنة!
أما الموسيقى في تلك الحفلة فقد كانت ظاهرة لنا بآلاتها وأشخاص العازفين عليها، قلم نُخدع فيها كما خُدعْنا في أصوات الأمواج والرياح!
ولاحظت شركات الأفلام أن الفرق الموسيقية في دور العرض كثيراً ما تُصاحبها بنغمات لا تُناسبها، فيتفق أحياناً أن تكون القصة مأساة فاجعة، وتعزف الفرقة معها لحناً راقصاً أو لحناً يبعث في السامع شعور المرح والابتهاج!، فعالجت هذا الخطأ بكتابة وصف قصير لموضوع الفيلم يوزع على الموسيقيين قبل عرضه، وكثيراً ما كان هذا الوصف موجزاً غاية الإيجاز، لا يزيد في بعض الأحيان على كلمة واحدة، وهي كلمة «حزين» أو «فَرِحُ» أو «راقص» أو «هادئُ» أو «عنيف» .. ، ثم يترك لمدير الفرقة أن يختار لحناً مُناسباً لهذا الوصف الموجز كائناً ما كان.
ولا تظن أن فيلماً من الأفلام وُضعت له ألحان موسيقية خاصة قبل الفيلم الذي مثلت فيه رواية «مصرع الدوق دي جيز»، وعُرِض في باريس عام 1908م، وكانت موسيقاه من تأليف سان سانس الموسيقار الفرنسي المشهور. ثم تعوّدت الشركات أن تصنع الأفلام وتقترح تأليف الألحان المطولة التي تُناسبها على الموسيقيين المختصين.
كذلك يبدو لنا حب الفنون الجميلة للمزاملة بينها وفي مقدمتها فن الصور المتحركة.
أما حبها للانفراد ـ وإن شئت فقل حبها لنوع من الانفراد ـ فهو يبدو لنا في حالة واحدة تعم جميع هذه المزاملات، وهي أنها في اجتماعها تحب أن يتجه الاهتمام إلى واحد منها دون غيره، ولا تطيق أن تترك لشركائها نصيباً من الاهتمام إلا كنصيب الحاشية في حضرة الأمير.
خذ لذلك مثلاً؛ إنك تذهب إلى حفلات الغناء فيطيب لك أن تسمع الأناشيد والأغاني والألحان الموسيقية من أول الحفلة إلى نهايتها، وقد تستغرق الحفلة ثلاث ساعات أو أكثر من ثلاث ساعات.
ولكنك إذا قصدت أن تذهب إلى رواية تمثيلية على خشبة المسرح أو على اللوحة البيضاء، لا تلبث أن يضيق صدرك بالسماع إذا تجاوز عشر دقائق أو ربع ساعة، لأن الغناء هنا هو الحاشية، والتمثيل هنا هو الأمير الذي لا يُساويه شريك!
ويحدث في بعض الأفلام أن تعرض لك حياة موسيقي تعرفه، أو حياة مغن تُحب سماعه، فتستريح إلى السماع من أول الحفلة إلى نهايتها وتنفر من كل ما يُقاطع هذه الألحان وتطول فيه المقاطعة، وليس هذا شذوذاً عن القاعدة التي قدمناها عن مزاملات الفنون. فإنك في هذه الحالة تقصد السماع ولا تقصد تمثيل الرواية ومشاهدة المناظر، وهي تابعة للغناء والموسيقى لا يُؤتى بها إلا تمهيداً للانتقال وسدا للفراغ.
أما إن كان مقصدك الذي غلب على حياتك أن تُتابع قصة الموسيقار في حياته الخاصة وفي حياته العامة، وفي علاقاته بأصدقائه ومنافسيه ومحبيه ومحباته، فالأمير بين الفنون هنا هو فن القصة، والحاشية هنا هي الألحان والنغمات، وإن كانت في موضع آخر أحب إليك من القصص والتواريخ.
وسر ذلك غير عجيب وغير بعيد.
سره أن النفس الإنسانية حين تُواجه الفنون هي في الواقع آلة فنية حية، تربطها كما تربط الأوتار على نغم مخصوص فيروقك هذا النغم دون غيره، ويأتي كل نغم سواه كأنه ضرب من « النشوز » .
وقد كنا نذهب إلى السينما الصامتة ونحن نتهيّأ لها بزاد واسع من الخيال، لأنها تتطلّب منا أن نتخيّل المعاني والكلمات التي تدل عليها الإشارات والحركات.
أما اليوم، فالصور المتحركة التي تتطلب مثل هذا الخيال تضايق المتفرجين، لأنهم تعوّدوا أن يتوجهوا إليها بملكتي السمع والبصر دون ملكة الخيال.
ولهذا نتساءل: هل من المستحسن أن نهمل السينما الصامتة كل الإهمال؟
لا شك أن السينما الناطقة أقرب إلى التمثيل الطبيعي من السينما التي تعتمد على الحركة والإشارة.
ولكن السينما الصامتة تُحيي الخيال، وتُنشئ فيه لذة الخلق والإبداع، ولا خلاف بين محبي الفنون في قيمة الخيال، فإنه عنصر مهم في كل فن جميل، بل هو في جميع الفنون الجميلة أهم من العيون والآذان!
* [نُشرت في مجلة "الاثنين والدنيا" ـ العدد 761 ـ 10/1/1949م]