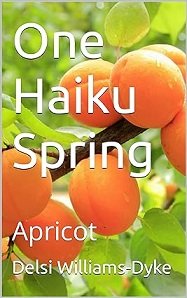ماذا قالت القصائد الشعرية والنصوص عن مدينة العشق والمقاومة والياسمين ؟.
يقول رولان بارت عن الأدب: “ثمة قانون خاص بالأدب يستند إلى مايلي: إنه مصنوع من اللغة، أي من مادة دالة من قبل في الوقت الذي يستولي عليها الأدب: يجب على الأدب أن يتسلل إلى النسق الذي لا يوجد في حوزته، ولكنه يشتغل مثله رغم كل شيء من أجل نفس الأهداف، ومنها: الإبلاغ، وينتج عن ذلك أن صعوبات اللغة والأدب تشكل على نحو ما كينونة الأدب ذاتها”.
وكان الأدب وضمنه اللغة، الوسيلة الأكثر استخداماً في التعبير عن الحرب، عن الألم، عن المآسي التي مرّ بها الإنسان. فمن لم يجرّب الكتابة ذات يوم، جرّبها في الحرب.. ولكن للأديب أسلوبَه ولغتَه اللذين لا يشبههما أسلوب ولغة أخرى، هما بصمة الأديب وروحه، وهما في الوقت نفسه ما يجعلان النصّ أدبياً بحد ذاته!
وفي قراءتنا النقدية السريعة لنصوص تناولت الحرب على سورية، وبخاصة على مدينة حلب، سنتوقف عند هذا الإبلاغ الذي قدّمته عن الحرب..فما الذي أبلغتنا عنه النصوص وأخبرتنا به، وما هي المفردات التي كثر تداولها فيها؟! ما هي الثيمات التي توقفت عندها؟!.
يصعب الخوض في ما كتبه الكتّاب الحلبيون جميعهم منذ بداية الحرب على حلب، فالمهمة هذه تتطلب جمع ماكتبوه وتنسيقه وفرزه، ومن ثم دراسته دراسة نقدية، عدا عن أن هناك نصوصاً مازالت قيد الصدور، وأخرى قيد من يمسك بيدها لإظهارها..وما من ناقد – على حد علمي- أو جهة أكاديمية أو بحثية استطاعت تقديم طابع فارق لوجهة الشعر والنثر اللذين كتبا في أثناء الحرب على حلب، الجنسين الأدبيين اللذين اعتمدناهما في هذا المقال، خلا الرواية والقصة اللتين تتطلبان وقفة نقدية خاصة بهما.
ولا بد هنا من الإشارة إلى قضية مهمة جداً وتتعلق بطبيعة الكتابة، وخاصة الشعرية التي ينبغي أن تتوخى الحذر من السقوط في مطبّات المباشرة أو الخطابية أو التوثيق، مما يمكنه أن يستهلك الروح الشعرية، إن لم يكن هناك معادل إبداعي، ومسافة زمنية، وفضاء مجازي، هذه العناصر التي تقيها من تلك المطبّات، وتظهر قدرة الشعراء على إبداع آليات وأدوات تتمكن من توليد تلك المسافة الزمنية لرؤية الحدث ومن ثمَّ إعادة صياغته بشكل فني إبداعي.
الشعر والحرب
ماذا يمكن للشعر أن يفعل وسط كم هائل من الخراب والدمار، والدم، والموت، هل كان عليه أن يصف المشهد العام للحرب؟! هل كان على الشاعر أن يعود إلى داخله لاستخراج الأنين والألم والقهر تجاه مايحصل حوله؟! أية صور شعرية تلك التي تطالعنا بها القصائد؟!
للقصيدة أن تنتظر، أن تقفز في فضاء مجهول، أن تخشى وتخاف، أن تناجي، أن تتأمل في هذا الركام من اللحم والدم والدمار، أن تقترب وتبتعد في آن، أن تحصي الأرواح المسافرة، أن تشمّ رائحة تراب الأرض، وتبكي إلى آخر حدود البكاء.
يقول الشاعر عباس حيروقة في قصيدته (ألا مِنْ مُجيبٍ يحنُّ عليّ…ألا مِنْ جَوابْ؟!):
وَقَفْتُ ببابِ المدينةِ أبكي/حَمَلْتُ براحة كفّي تُرَاباً /شَمَمْتُ ..شَمَمْتُ/تَفَصَّدَ وجهي وكلِّي دِماءً/ذَرَرْتُ التُّرابَ بوجهِ السَّماءِ/ورحتُ أَخبُّ وأَصْرُخُ/ أسألُ روحي:..أهذا أنا.. أم ..؟؟!!/وأينكِ أَنْت…/وأَينَ الشَّوارعُ../أينَ الحَدائقُ ../أينَ المدارسُ…/أين التُّرابْ../أَصَخْتُ…./طيورٌ تَحُومُ بأُفْقِ المدينةِ/تَنْقُرُ ..تَنْهَشُ/كُلَّ العيونِ/التي قَدْ تَرى ما/وراءَ الحجاااااااابْ/ألا مِنْ مُجيبٍ/يَحنُّ عليَّ /ألا مِنْ جَوابْ..؟؟!!.
هنا يكون السؤال المشروع: أهذا أنا.. أم؟! تضيع الذات تجاه هذا الألم، الجسد يتمزق، الوجه الذي ترى العينان فيه هذا الخراب يتفصّد دماء، وتكثر الأسئلة عن الأمكنة الغائبة وسط هذا الدمار، وليس هناك سوى جثث تنهش عيونها الطيور الجارحة، حتى العقبان حين ترى ما تراه تبكي كطفل يخاف العقاب، فأي مكان هذا يقف فيه الشاعر؟! إنها المدينة، إنها حلب.
هذا الانهماك الذاتي الممزوج بالبكاء، والرغبة الاستشفائية في إظهار الألم الشخصي، ماحاولت القصيدة أن تقوله.
ويعود لمواجهة المدينة بسؤالها عن الباب المؤدي إليها، إلى ذاك الزمن المفعم بالفرح، بالذكريات، بالناس، بالأحبة الذين لم تعد المدينة تراهم، لم تعد هناك خصوصية للمدينة وبيوتها، انفتحت الأشياء على بعضها، فلا وراء، ولا أمام، يقول الشاعر حيروقة:
سألتُكِ شهباءُ أنتِ..:/أنا إِنْ أرَدتُ/الدُّخولَ إليكِ/فَمنْ أيِّ بابٍ ../إلى أيِّ بابْ؟؟!!/هنا في البيوتِ يدبُّ /الخرابْ/نوافذُنا لا وراءَ لها../لا أمامَ /فلا من عيونٍ/تُرَاقبُ دَرْباً../ولا مِنْ حضورٍ/لهذا الحبيبِ/بطاقةِ وردٍ /ولا من سؤالٍ/له أو جوابْ ..
في زمن الحرب، وفي لحظة الدم تصبح القصيدة كاميرا شعرية تصوّر الدمار بعين القصيدة، تصوّر البيوت المحنيّة حزناً على سكانها، تصور التفاصيل التي قد لاتلتقطها كاميرا الخبر العاجل، أأصبح الشعر توثيقياً في هذه اللحظات؟! كثيرة تلك القصائد التي طالعتنا بتلك المشاهد الدموية، وكان البكاء فيها هو العنصر المتجلي الأكثر حضورا!
ولكن ماذا بعد أن تصمت الحرب، إلى أي مكان اتجه الناس فور انتصار المدينة؟! إلى القلعة التي أصبحت مزاراً، محجّاً، ولم القلعة؟! لأنها المكان الوحيد/ المكان الرمز للقوة والذي بقي صامداً، اتجهوا إليها ربما ليتلمّسوا منها معنى القوة والصمود، لتباركهم، أو ليباركوها، ولكن أين محبّوها؟! ماذا حصل لصخر بابها؟! ما الدور الذي قامت به هذه القلعة أثناء الحرب؟! تقول الشاعرة ليلى مقدسي في قصيدتها (غربة قلعة حلب):
نظرت إليكِ ورعشة الحزن تجرح راحة الفجر/أين تغرب أحبتك يا قلعة الوجع؟!/تمزق صخرك بقذائف الشر وتشقشق برد الحجر/تزنر ترابك بنهر لهب الجراح /القلعة وحيدة تعصب جبين جندي جريح بغضن حنانها الممزق!/هنا جثة بطل، هناك صرخة تاريخ، يا فارس الشهامة لا تخف/أنا قلعة حلب/تأملت العشب القتيل على تراب طهرك وعلى شموخك قوس النصر /سوف يسطع/أنا قلعة حلب/زهر وجهي معفر بالشجن والعتب/أيها العشاق أنا لا أرشق بصواريخ الغضب/تاجي الرباب الأبيض وخماري علم الوطن/وعسل الحضارة من بروجي ينساب ويروي عطش حلب.
هنا تتأنسن الأشياء/ القلاع، تصبح يداً حنونة رغم تمزقها ألماً على ماحولها. القلعة تعصب جبين الجندي الجريح، وتمده بالقوة وتسأله ألا يخف! كيف يخاف، وهو في حضرة التاريخ الممتد آلافاً من السنين؟! إنها إذن قلعة حلب التي لا تهزّها ولاتؤثر في صخرها صواريخ من لهب، هي ملكة المدينة التي تاجها وخمارها علم الوطن، هي النحلة التي تهب من روحها رحيق عسلٍ يروي العطش، وأي عطشٍ مرّ على أهل حلب؟!
هذه العلاقة بالأمكنة في الصور الشعرية تنفتح على اللحظة الراهنة؛ لتعيد تشكيلها من زاوية أخرى، زاوية واسعة تحاكي ماورائيات الحدث والصورة، تنفتح على الماضي الموغل في القدم، وهو يمد الحاضر بالكثير من الديمومة، حتى وإن حالت تلك الأمكنة إلى خراب.
حلب مدينة ليست كباقي المدن، هي امرأة ليست كباقي النساء، تتفرّد بكل شيء، هذه الخصوصية هي التي تجعلها مدينة خارجة من عمق الزمن، لهذا يتغزل عشاقها بها، ويصفونها بأروع وأجمل الصفات، وأخال أن الشاعرة غالية خوجة في قصيدتها (حلب مدينة من الندى تجنن العدى) قد أحاطت بكل صفة لازمت حلب وأهلها خلال الحرب، إذ تقول:
شهيدةٌ كما السَّما/ عصيّةٌ على المُدى/ مِدادُها الدِّما/ ومدُّها المَدى/ عظيمةٌ هيَ الكُماةْ/ مدينةٌ منَ الندى/ تُجنّنُ الغزاةْ/ تفيضُ بالهُدى/ رجالُها أُباةْ/ وأطفالُها السَّدى/ نساؤها القلاع حامياتْ/ وحاؤها حُماتُها/ ولامُها لهيبُها/ وباؤها بروقها / رعودُها تطاحنُ العُتاةْ/ مدينةٌ شهيدةٌ وتمنحُ الحياةَ للحياةْ.
كل تلك الصور الشعرية، التي وصفت حلب، جاءت عبر مبتدأ وخبر، وقد فاضت بمعاني القوة والجبروت والعظمة والامتداد وبالصمود، وبتقديمها عبر الخبر صوراً تحمل مشاهد الحرب وأصواتها. إذ كل سطر فيها يحكي قصة من قصص الحرب على حلب. ولكنها حين ستخبرنا بأن هذه المدينة رغم أنها شهيدة، هي مانحة للحياة، تقدم لنا هذه الصورة الرائعة المعبّرة حقيقة عنها، عبر فعل مضارع له صفة الاستمرار والعطاء الدائم، إنها (تمنح الحياة للحياة).
النثر والحرب
لم أستطع في هذه العجالة من كتابة هذا المقال، العثور على نصّ نثري مرره لي كاتب حلبي ما، أو وقعت عيني عليه من قبل. ولهذا وجدت نفسي في حيرة من أمري. ولا أعرف إن كنت محقّة هنا في أن أستشهد بنصّ نثري لي، كتبته ضمن سلسلة من النصوص النثرية التي دوّنتها في الحرب، والتي اتخذت عنوانين، الأول (نافذة في حجرة انفرادية) والثاني (خارج النافذة). وأغلب تلك النصوص كان لحلب النصيب الأكبر فيها، إذ كتبتها بحبر الدم الذي سال في شوارعها.
وسأقف هنا على الحياد؛ لأشير إلى ماتضمنه نصّ منها، ففي النثر قد تمتزج الأنواع الأدبية، وقد تتضمن كلمات أغنية ما، وفي هذا النصّ تمتزج كلمات الشاعر صفوح شغالة في قصيدته (شهبا وش عملوا فيك) والتي غنّاها شادي جميل، تمتزج تلك الكلمات بكلماتي، لتكون افتتاحية النص تعبيراً عن الغياب المجدول بفخر الانتماء إلى هذه المدينة. الوقوف مع الذات وخطابها، وتذكير القارئ بمجد المدينة وبأمكنتها الخالبة للألباب، وقد قلت في هذا النصّ:
ومازلتِ بعد هذا الغياب المنتظر تستمعين لأغنية الشهباء: (من حقي أفتخر بالشهبا واتغنى.. ست الحسن من زارها اتهنى) شهباء الحمام الزاجل الذي طار محلّقاً وقت الغروب.. (شعبا بعدّوا الأيام لو جارت.. عندنا الفرج له باب..ونبعات الصبر عندنا) شهباء القلعة ذات البساط السندسي وأغاني السلاطين. شهباء النوافذ المفتوحة على الأفق.. (شهباء وش عملوا فيك بجنون هدّوا ماضيك) شهباء القرميد الأحمر الذي تسكن في زواياه العصافير..(والله من حرقة قلبي عمرين لو عشت أبكيك) شهباء خان الشونة ذو الإبريق الأسطوري وفتحات السماء، والنحاس الذي يلمع مع كل دغدغة شمس..
(آثار بتحكي ع بلادي.. أسوار بنوها أجدادي) أجراس الجوامع ومآذن الكنائس، والحدائق البابلية الشروق، والشوارع الملتفة نحو الغياب، والأبواب التي حكت التاريخ، والمدينة القديمة التي مشى في أزقتها الياسمين، والقناديل التي أضاءت شوارع العاشقين.. (شهباء يامحلى ديارك, إبراهيم نبينا زارك..ما انضام من يمم يمّك… معزوز ومكرم جارك) والسيّاح الذين جاؤوك من كل الأصقاع لينتشوا برائحتك. شهباء الساعة التي نطقت بالحق، والشوارع العاكسة لحبات المطر، والساحة التي مرّ بها غير عابر.. (مو حرام بلحظة يتهدم تاريخي وفخري وأمجادي) شهباء المقامات التي أرسلتها إلى العالم كله، الصبا والنهوند والراست منك تعلمها من يملك صوتاً إلهياً.. (بالله يا الإخوة تتهدوا.. الجراح ماعادوا ينعدوا..حلب التاريخ أوصيكم من الشهبا حجرة لاتهدوا) وباب القلعة ذو الأسدين، والمسرح الذي غنى فيه الطيور، والسوق الطويل والحبال والغار والصابون، والعرش الذي نام فيه ملك الملوك، شهباء ياحكاية الأنبياء.. (شهباء وش عملوا فيك)..
في هذا النصّ صورة بانورامية لمدينة حلب، أمكنة ومقامات، وقصص عاشقين، وشوارع وساعة ناطقة، وقلعة، وكنائس وجوامع، ومحبين زاروها متنعمين بهوائها ومائها.. إنها مختصر لحكاية، لمدينة، اسمها حلب، صور أدبية مجدولة بكلمات شاعر المدينة وهو يحكي قصة تخريبها ووصيته ألا يهدموا حجرة فيها، ألا يتحاربوا، فلم يعد هناك متسع للجراح، والسؤال الاستنكاري ماذا فعلوا بك يا حلب، يا تاريخ الأجداد، يا مجد الحضارة وفخرها؟!.
سفيربرس – بيانكا ماضيّة -الشهباء
https://www.safirpress.net/2018/09/...ASvmQscU27BOjIQo1FL3EQeVPr9LlydKlsNySd4x54F2U
safirpress.net
حلـــــب وأدب الحـــــرب . بقلم : بيانكا ماضية
ماذا قالت القصائد الشعرية والنصوص عن مدينة العشق والمقاومة والياسمين ؟.
يقول رولان بارت عن الأدب: “ثمة قانون خاص بالأدب يستند إلى مايلي: إنه مصنوع من اللغة، أي من مادة دالة من قبل في الوقت الذي يستولي عليها الأدب: يجب على الأدب أن يتسلل إلى النسق الذي لا يوجد في حوزته، ولكنه يشتغل مثله رغم كل شيء من أجل نفس الأهداف، ومنها: الإبلاغ، وينتج عن ذلك أن صعوبات اللغة والأدب تشكل على نحو ما كينونة الأدب ذاتها”.
وكان الأدب وضمنه اللغة، الوسيلة الأكثر استخداماً في التعبير عن الحرب، عن الألم، عن المآسي التي مرّ بها الإنسان. فمن لم يجرّب الكتابة ذات يوم، جرّبها في الحرب.. ولكن للأديب أسلوبَه ولغتَه اللذين لا يشبههما أسلوب ولغة أخرى، هما بصمة الأديب وروحه، وهما في الوقت نفسه ما يجعلان النصّ أدبياً بحد ذاته!
وفي قراءتنا النقدية السريعة لنصوص تناولت الحرب على سورية، وبخاصة على مدينة حلب، سنتوقف عند هذا الإبلاغ الذي قدّمته عن الحرب..فما الذي أبلغتنا عنه النصوص وأخبرتنا به، وما هي المفردات التي كثر تداولها فيها؟! ما هي الثيمات التي توقفت عندها؟!.
يصعب الخوض في ما كتبه الكتّاب الحلبيون جميعهم منذ بداية الحرب على حلب، فالمهمة هذه تتطلب جمع ماكتبوه وتنسيقه وفرزه، ومن ثم دراسته دراسة نقدية، عدا عن أن هناك نصوصاً مازالت قيد الصدور، وأخرى قيد من يمسك بيدها لإظهارها..وما من ناقد – على حد علمي- أو جهة أكاديمية أو بحثية استطاعت تقديم طابع فارق لوجهة الشعر والنثر اللذين كتبا في أثناء الحرب على حلب، الجنسين الأدبيين اللذين اعتمدناهما في هذا المقال، خلا الرواية والقصة اللتين تتطلبان وقفة نقدية خاصة بهما.
ولا بد هنا من الإشارة إلى قضية مهمة جداً وتتعلق بطبيعة الكتابة، وخاصة الشعرية التي ينبغي أن تتوخى الحذر من السقوط في مطبّات المباشرة أو الخطابية أو التوثيق، مما يمكنه أن يستهلك الروح الشعرية، إن لم يكن هناك معادل إبداعي، ومسافة زمنية، وفضاء مجازي، هذه العناصر التي تقيها من تلك المطبّات، وتظهر قدرة الشعراء على إبداع آليات وأدوات تتمكن من توليد تلك المسافة الزمنية لرؤية الحدث ومن ثمَّ إعادة صياغته بشكل فني إبداعي.
الشعر والحرب
ماذا يمكن للشعر أن يفعل وسط كم هائل من الخراب والدمار، والدم، والموت، هل كان عليه أن يصف المشهد العام للحرب؟! هل كان على الشاعر أن يعود إلى داخله لاستخراج الأنين والألم والقهر تجاه مايحصل حوله؟! أية صور شعرية تلك التي تطالعنا بها القصائد؟!
للقصيدة أن تنتظر، أن تقفز في فضاء مجهول، أن تخشى وتخاف، أن تناجي، أن تتأمل في هذا الركام من اللحم والدم والدمار، أن تقترب وتبتعد في آن، أن تحصي الأرواح المسافرة، أن تشمّ رائحة تراب الأرض، وتبكي إلى آخر حدود البكاء.
يقول الشاعر عباس حيروقة في قصيدته (ألا مِنْ مُجيبٍ يحنُّ عليّ…ألا مِنْ جَوابْ؟!):
وَقَفْتُ ببابِ المدينةِ أبكي/حَمَلْتُ براحة كفّي تُرَاباً /شَمَمْتُ ..شَمَمْتُ/تَفَصَّدَ وجهي وكلِّي دِماءً/ذَرَرْتُ التُّرابَ بوجهِ السَّماءِ/ورحتُ أَخبُّ وأَصْرُخُ/ أسألُ روحي:..أهذا أنا.. أم ..؟؟!!/وأينكِ أَنْت…/وأَينَ الشَّوارعُ../أينَ الحَدائقُ ../أينَ المدارسُ…/أين التُّرابْ../أَصَخْتُ…./طيورٌ تَحُومُ بأُفْقِ المدينةِ/تَنْقُرُ ..تَنْهَشُ/كُلَّ العيونِ/التي قَدْ تَرى ما/وراءَ الحجاااااااابْ/ألا مِنْ مُجيبٍ/يَحنُّ عليَّ /ألا مِنْ جَوابْ..؟؟!!.
هنا يكون السؤال المشروع: أهذا أنا.. أم؟! تضيع الذات تجاه هذا الألم، الجسد يتمزق، الوجه الذي ترى العينان فيه هذا الخراب يتفصّد دماء، وتكثر الأسئلة عن الأمكنة الغائبة وسط هذا الدمار، وليس هناك سوى جثث تنهش عيونها الطيور الجارحة، حتى العقبان حين ترى ما تراه تبكي كطفل يخاف العقاب، فأي مكان هذا يقف فيه الشاعر؟! إنها المدينة، إنها حلب.
هذا الانهماك الذاتي الممزوج بالبكاء، والرغبة الاستشفائية في إظهار الألم الشخصي، ماحاولت القصيدة أن تقوله.
ويعود لمواجهة المدينة بسؤالها عن الباب المؤدي إليها، إلى ذاك الزمن المفعم بالفرح، بالذكريات، بالناس، بالأحبة الذين لم تعد المدينة تراهم، لم تعد هناك خصوصية للمدينة وبيوتها، انفتحت الأشياء على بعضها، فلا وراء، ولا أمام، يقول الشاعر حيروقة:
سألتُكِ شهباءُ أنتِ..:/أنا إِنْ أرَدتُ/الدُّخولَ إليكِ/فَمنْ أيِّ بابٍ ../إلى أيِّ بابْ؟؟!!/هنا في البيوتِ يدبُّ /الخرابْ/نوافذُنا لا وراءَ لها../لا أمامَ /فلا من عيونٍ/تُرَاقبُ دَرْباً../ولا مِنْ حضورٍ/لهذا الحبيبِ/بطاقةِ وردٍ /ولا من سؤالٍ/له أو جوابْ ..
في زمن الحرب، وفي لحظة الدم تصبح القصيدة كاميرا شعرية تصوّر الدمار بعين القصيدة، تصوّر البيوت المحنيّة حزناً على سكانها، تصور التفاصيل التي قد لاتلتقطها كاميرا الخبر العاجل، أأصبح الشعر توثيقياً في هذه اللحظات؟! كثيرة تلك القصائد التي طالعتنا بتلك المشاهد الدموية، وكان البكاء فيها هو العنصر المتجلي الأكثر حضورا!
ولكن ماذا بعد أن تصمت الحرب، إلى أي مكان اتجه الناس فور انتصار المدينة؟! إلى القلعة التي أصبحت مزاراً، محجّاً، ولم القلعة؟! لأنها المكان الوحيد/ المكان الرمز للقوة والذي بقي صامداً، اتجهوا إليها ربما ليتلمّسوا منها معنى القوة والصمود، لتباركهم، أو ليباركوها، ولكن أين محبّوها؟! ماذا حصل لصخر بابها؟! ما الدور الذي قامت به هذه القلعة أثناء الحرب؟! تقول الشاعرة ليلى مقدسي في قصيدتها (غربة قلعة حلب):
نظرت إليكِ ورعشة الحزن تجرح راحة الفجر/أين تغرب أحبتك يا قلعة الوجع؟!/تمزق صخرك بقذائف الشر وتشقشق برد الحجر/تزنر ترابك بنهر لهب الجراح /القلعة وحيدة تعصب جبين جندي جريح بغضن حنانها الممزق!/هنا جثة بطل، هناك صرخة تاريخ، يا فارس الشهامة لا تخف/أنا قلعة حلب/تأملت العشب القتيل على تراب طهرك وعلى شموخك قوس النصر /سوف يسطع/أنا قلعة حلب/زهر وجهي معفر بالشجن والعتب/أيها العشاق أنا لا أرشق بصواريخ الغضب/تاجي الرباب الأبيض وخماري علم الوطن/وعسل الحضارة من بروجي ينساب ويروي عطش حلب.
هنا تتأنسن الأشياء/ القلاع، تصبح يداً حنونة رغم تمزقها ألماً على ماحولها. القلعة تعصب جبين الجندي الجريح، وتمده بالقوة وتسأله ألا يخف! كيف يخاف، وهو في حضرة التاريخ الممتد آلافاً من السنين؟! إنها إذن قلعة حلب التي لا تهزّها ولاتؤثر في صخرها صواريخ من لهب، هي ملكة المدينة التي تاجها وخمارها علم الوطن، هي النحلة التي تهب من روحها رحيق عسلٍ يروي العطش، وأي عطشٍ مرّ على أهل حلب؟!
هذه العلاقة بالأمكنة في الصور الشعرية تنفتح على اللحظة الراهنة؛ لتعيد تشكيلها من زاوية أخرى، زاوية واسعة تحاكي ماورائيات الحدث والصورة، تنفتح على الماضي الموغل في القدم، وهو يمد الحاضر بالكثير من الديمومة، حتى وإن حالت تلك الأمكنة إلى خراب.
حلب مدينة ليست كباقي المدن، هي امرأة ليست كباقي النساء، تتفرّد بكل شيء، هذه الخصوصية هي التي تجعلها مدينة خارجة من عمق الزمن، لهذا يتغزل عشاقها بها، ويصفونها بأروع وأجمل الصفات، وأخال أن الشاعرة غالية خوجة في قصيدتها (حلب مدينة من الندى تجنن العدى) قد أحاطت بكل صفة لازمت حلب وأهلها خلال الحرب، إذ تقول:
شهيدةٌ كما السَّما/ عصيّةٌ على المُدى/ مِدادُها الدِّما/ ومدُّها المَدى/ عظيمةٌ هيَ الكُماةْ/ مدينةٌ منَ الندى/ تُجنّنُ الغزاةْ/ تفيضُ بالهُدى/ رجالُها أُباةْ/ وأطفالُها السَّدى/ نساؤها القلاع حامياتْ/ وحاؤها حُماتُها/ ولامُها لهيبُها/ وباؤها بروقها / رعودُها تطاحنُ العُتاةْ/ مدينةٌ شهيدةٌ وتمنحُ الحياةَ للحياةْ.
كل تلك الصور الشعرية، التي وصفت حلب، جاءت عبر مبتدأ وخبر، وقد فاضت بمعاني القوة والجبروت والعظمة والامتداد وبالصمود، وبتقديمها عبر الخبر صوراً تحمل مشاهد الحرب وأصواتها. إذ كل سطر فيها يحكي قصة من قصص الحرب على حلب. ولكنها حين ستخبرنا بأن هذه المدينة رغم أنها شهيدة، هي مانحة للحياة، تقدم لنا هذه الصورة الرائعة المعبّرة حقيقة عنها، عبر فعل مضارع له صفة الاستمرار والعطاء الدائم، إنها (تمنح الحياة للحياة).
النثر والحرب
لم أستطع في هذه العجالة من كتابة هذا المقال، العثور على نصّ نثري مرره لي كاتب حلبي ما، أو وقعت عيني عليه من قبل. ولهذا وجدت نفسي في حيرة من أمري. ولا أعرف إن كنت محقّة هنا في أن أستشهد بنصّ نثري لي، كتبته ضمن سلسلة من النصوص النثرية التي دوّنتها في الحرب، والتي اتخذت عنوانين، الأول (نافذة في حجرة انفرادية) والثاني (خارج النافذة). وأغلب تلك النصوص كان لحلب النصيب الأكبر فيها، إذ كتبتها بحبر الدم الذي سال في شوارعها.
وسأقف هنا على الحياد؛ لأشير إلى ماتضمنه نصّ منها، ففي النثر قد تمتزج الأنواع الأدبية، وقد تتضمن كلمات أغنية ما، وفي هذا النصّ تمتزج كلمات الشاعر صفوح شغالة في قصيدته (شهبا وش عملوا فيك) والتي غنّاها شادي جميل، تمتزج تلك الكلمات بكلماتي، لتكون افتتاحية النص تعبيراً عن الغياب المجدول بفخر الانتماء إلى هذه المدينة. الوقوف مع الذات وخطابها، وتذكير القارئ بمجد المدينة وبأمكنتها الخالبة للألباب، وقد قلت في هذا النصّ:
ومازلتِ بعد هذا الغياب المنتظر تستمعين لأغنية الشهباء: (من حقي أفتخر بالشهبا واتغنى.. ست الحسن من زارها اتهنى) شهباء الحمام الزاجل الذي طار محلّقاً وقت الغروب.. (شعبا بعدّوا الأيام لو جارت.. عندنا الفرج له باب..ونبعات الصبر عندنا) شهباء القلعة ذات البساط السندسي وأغاني السلاطين. شهباء النوافذ المفتوحة على الأفق.. (شهباء وش عملوا فيك بجنون هدّوا ماضيك) شهباء القرميد الأحمر الذي تسكن في زواياه العصافير..(والله من حرقة قلبي عمرين لو عشت أبكيك) شهباء خان الشونة ذو الإبريق الأسطوري وفتحات السماء، والنحاس الذي يلمع مع كل دغدغة شمس..
(آثار بتحكي ع بلادي.. أسوار بنوها أجدادي) أجراس الجوامع ومآذن الكنائس، والحدائق البابلية الشروق، والشوارع الملتفة نحو الغياب، والأبواب التي حكت التاريخ، والمدينة القديمة التي مشى في أزقتها الياسمين، والقناديل التي أضاءت شوارع العاشقين.. (شهباء يامحلى ديارك, إبراهيم نبينا زارك..ما انضام من يمم يمّك… معزوز ومكرم جارك) والسيّاح الذين جاؤوك من كل الأصقاع لينتشوا برائحتك. شهباء الساعة التي نطقت بالحق، والشوارع العاكسة لحبات المطر، والساحة التي مرّ بها غير عابر.. (مو حرام بلحظة يتهدم تاريخي وفخري وأمجادي) شهباء المقامات التي أرسلتها إلى العالم كله، الصبا والنهوند والراست منك تعلمها من يملك صوتاً إلهياً.. (بالله يا الإخوة تتهدوا.. الجراح ماعادوا ينعدوا..حلب التاريخ أوصيكم من الشهبا حجرة لاتهدوا) وباب القلعة ذو الأسدين، والمسرح الذي غنى فيه الطيور، والسوق الطويل والحبال والغار والصابون، والعرش الذي نام فيه ملك الملوك، شهباء ياحكاية الأنبياء.. (شهباء وش عملوا فيك)..
في هذا النصّ صورة بانورامية لمدينة حلب، أمكنة ومقامات، وقصص عاشقين، وشوارع وساعة ناطقة، وقلعة، وكنائس وجوامع، ومحبين زاروها متنعمين بهوائها ومائها.. إنها مختصر لحكاية، لمدينة، اسمها حلب، صور أدبية مجدولة بكلمات شاعر المدينة وهو يحكي قصة تخريبها ووصيته ألا يهدموا حجرة فيها، ألا يتحاربوا، فلم يعد هناك متسع للجراح، والسؤال الاستنكاري ماذا فعلوا بك يا حلب، يا تاريخ الأجداد، يا مجد الحضارة وفخرها؟!.
سفيربرس – بيانكا ماضيّة -الشهباء
https://www.safirpress.net/2018/09/...ASvmQscU27BOjIQo1FL3EQeVPr9LlydKlsNySd4x54F2U
safirpress.net
حلـــــب وأدب الحـــــرب . بقلم : بيانكا ماضية
ماذا قالت القصائد الشعرية والنصوص عن مدينة العشق والمقاومة والياسمين ؟.