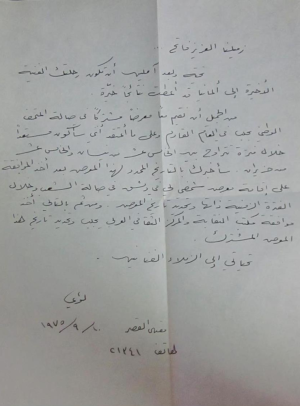تقدمة:
يشتمل هذا البحث على جزء ين: يتعلق أولهما باستعراض للمناهِج والأساليب التي تُطبقها تيارات الترجمة المختلفة بغرض استنطاق النص. سيكون الاستعراض هنا سريعاً ومُقتضباً عند الحديث عن المذاهب غير المؤثرة، أو لنقل الأقل شيوعاً مثل: التراجم الحُرة والموسوعية والتوافقية التي أصبحت تُعرف بترجمة المواءمة. بيد أننا سنتوقف بعض الشيء عند أهم تيارين يشغلان الساحة حالياً ألا وهما: الترجمة الحرفية، والنظرية التفسيرية أو نظرية المعنى. أما الجزء الثاني فسيتناول تحليلاً لبيتين من الشِعر أحدهما من الفرنسية، وثانيهما من العربية نسعى من خلالهما لإيضاح استحالة استنباط مُجمل المعنى بتطبيق منهجية تيار ترجمي بعينه؛ وإنما يتطلب الأمر الاستعانة بالأطُر المنهجية للتيارات جميعها من ناحية، وضرورة تحليل النص المُستهدف من حيث الشكل والمضمون من ناحية أخرى. ذلك أن مثل هذا التحليل كفيل بإظهار عدة معانٍ ما كانت لتخطر للمُترجِم على بال إن هو اكتفى بالمدلول الظاهري للألفاظ.
عن الترجمة:
إن أبسط تعريف مُتفق عليه للترجمة هو: ” قول ذات الشيء كما ورد في أصله”. ولعل أولى إشكالياتها تكمن في تفسير لفظة ” ذات الشيء ” على وجه التحديد. ومعلوم أن عِلم اللغة المُعاصِر، شأنه شأن الترجمة، يواجِه الإشكالية ذاتها في سعيه لتبيان الصِلة بين الإطار اللغوي، والمعنى الذي يحمله.
يدور كل تاريخ الترجمة، في واقع الأمر، حول قضيتين جوهريتين: تتعلق أولاهما بإمكانية الترجمة ذاتها؛ بينما تهتم الثانية بتحديد درجة التقيد والالتزام بما ورد في النص الأصلي. ويبدو أن المسألة الأولى قد حُسِمت بالفعل ولم يعد يثيرها سوى القلائل. إذ طالما كان هنالك مترجمون يزاولون المهنة، نصوص تُترجم، ومؤتمرات تُعقد بمشاركة أناس يتحدثون شتى اللغات ويفهم بعضهم بعضا بفعل عملية الترجمة، فقد أصبحت هذه الأخيرة واقعاً ملموساً لا يطاله الشك. وحتى لو لم تكن كذلك، لجعل منها عالم اليوم بتعقيداته وتشابك مصالحه وتداخل شئونه أمراً مُمكناً، بل لازماً بحكم ضرورة الأشياء. تبقى، إذن، المسألة الأخرى المُتمثلة في درجة الصدق والدِقة في نقل مرامي النص المُراد ترجمته. هنا تتباين آراء المُختصين والباحثين، الأمر الذي أدى لبروز عدة تيارات لكل منها أنصارها ومعارضوها بطبيعة الحال. نذكر من هذه التيارات:
1) الترجمة الحُرة (la traduction libre):
لا يعبأ هذا التيار كثيراً بنقل معاني النص الأصلي. يكون المترجم حراً في تفسير هدف الكاتب ونواياه، ثم يسمح لنفسه بالتمتع بذات القدر من الحرية عند القيام بصياغة النص في اللغة الهدف، وهو ما يجعل علاقة الترجمة بالنص المصدر جد ضعيفة. إذ ينطلِق المترجم من النص الأصلي لصياغة نص جديد.
2) الترجمة الموسوعية (la traduction- Erudition):
يستهدف هذا النوع من التراجم جمهوراً مُتخصصاً يلم بأطراف، وربما بكل جزئيات الموضوع المُراد ترجمته. هنا يستخدم المترجم النص الأصلي كهدف للدراسة فيدخل عليه تعليقات فلسفية، ويصبغ عليه صبغاً نفسية، ويعطيه أبعاداً تاريخية واجتماعية بحيث تكون المحصلة النهائية إظهاراً لسعة علم المترجم، غزارة ثقافته، وتمكنه من شتى ضروب المعرفة، أكثر منها ترجمة النص ذاته.
وكمثال لهاتين الترجمتين، نعني الحرة والموسوعية، نقتبس التعريف التالي للفظة (الكُفر) التي وردت مِراراً في القرآن الكريم. إذ بدل أن يُركز المترجم على ترجمة الكلمة على اعتبار أنها إخفاء وإلغاء لوجود الخالق، يقول بدوافِع دعوية:
” الكُفر ضرب من الجهل، بل هو بالأحرى، الجهل بذاته. إذ أي جهل يفوق عدم المعرفة بالله، الخالق مالك الكون؟ فها هو المرء يشاهد المظاهر المتنوعة للطبيعة ويرى حركة الكون المتناسقة التي لا تتوقف عن الدوران والخلق البديع لجميع الكائنات”
ثم يستعرض المترجم معرفته بمكونات الجسم البشري فيضيف:
” يرى المرء عجائب الكون في جسده، بيد أنه يعجز عن فهم القوة التي أعطته الحياة من خامات مثل: الكربون، الكالسيوم، الصوديوم وما إلى ذلك” (1ص25)
3) الترجمة التوافقية، أو ترجمة المواءمة (la traduction-Adaptation)
يدخل هذا التيار في إطار الترجمة الحرة. ذلك أنه، وإن كان يحافظ على الإشارة للنص الأصلي، إلا أنه يعمل دوماً على تغيير عنصر من عناصره كمستوى اللغة مثلاً، أو الخاصية التي قد يتفرد بها ضرب من ضروب الإبداع الأدبي كالشعر، أو الرواية، أو المسرحية. أو أن يقوم بتغيرات جوهرية في معالم الحِقبة التاريخية للعمل كأن يأخذ ببعض المعطيات التي لم تكن متوفرة لحظة كتابة النص. جل من يلجأ لهذا التيار هم المترجمون في قطاعي السينما والمسرح بهدف عصرنة العمل القديم وتقريبه لعقلية المتلقي المُعاصِر. ويتم التحوير هنا وفقاً لنوعية ومستوى الجمهور المراد مخاطبته، أو الغرض من الخطاب، أو لاعتبارات أخرى ذاتية يقدرها المترجم. نعطي لهذا النوع من الترجمة مثالاً نسوقه من ترجمة لذات الداعية الإسلامي الذي اقتبسنا أجزاء من بعض تراجِمه آنفاً يتحدث فيه عن أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت، منذ يومها الأول، تنادي بحقوق الإنسان. ولشرح هذه الفكرة وتقريبها للقراء يضيف مُقارناً بما يجري في عالمنا المُعاصِر:
” أنظر إلى مسألة اللون، إذ لم يتمكن العالم بعد من إيجاد تواصل منطقي وإنساني من الملونين. فقد قُتِل وعُذِب الآلاف من البشر في الولايات المتحدة بسبب سواد بشرتهم. وُضِعت قوانين مختلفة للبيض والسود. حتى أنهم ما كانوا يستطيعون الدراسة تحت سقف واحد أو في ذات المدرسة أو الكلية. استمر هذا الوضع حتى السابع عشر من مايو من العام 1954م حين أفتت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التفرقة ومن أنها ضد المساواة في الحقوق الإنسانية” (1 ص153)
بيد أن أهم تيارين يشغلان الساحة حالياً هما الترجمة الحرفية (la traduction littérale) والنظرية التفسيرية، أو ما أصبح يُعرف اليوم بترجمة المعنى (la traduction du sens)
وعلى الرغم من الاعتقاد السائد في أوساط من يشتغلون بالترجمة بوجود اختلافات عميقة بين منهجية هذين التيارين وتباين جذري في استراتيجيتهما، إلا أنهما يلتقيان في نقطتين جوهريتين تكمنان في الإجابة على التساؤلين التاليين: هل الترجمة ممكنة أصلاً؟ ولئن كان الرد بالإيجاب، أيهما أفضل: الترجمة الحرفية، أم التفسيرية؟ والمتأمل لهذين التساؤلين يجدهما يبحثان عن إجابة للإشكالية التي تعرضنا إليها في صدر هذا البحث، ألا وهي مسألة تعريف “قول ذات الشيء كما ورد في أصله”. لكن، ونظراً لشيوع هاتين المنهجيتين، كما سبقت الإشارة، فسنتوقف عندهما بشيء من التفصيل، مع التركيز على منهجية كل منهما في ترجمة النص عموماً، والنص الأدبي على وجه الخصوص.
الترجمة الحرفية:
ينبغي التفريق هنا بين الترجمة الحرفية، وترجمة كلمة فكلمة (la traduction mot à mot).
إذ تقوم هذه الأخيرة على الشكل اللغوي والبحث عن المُقابلات في اللغة الهدف دون مراعاة لسياق النص، ثم صياغة الجملة المُترجمة وفقاً لتركيبتها في اللغة المصدر. أما الترجمة الحرفية فهي، وإن كانت تبحث كذلك عن مقابل المفردات في اللغة الهدف دون مراعاة للسياق، بيد أنها تعمل، قدر المستطاع، على أن تكون التركيبة اللغوية للغة المصدر مماثلة لنظيرتها في اللغة الهدف. يوضح بيتر نيو مارك ذلك بقوله عن ترجمة كلمة فكلمة:
” تُوضع مفردات اللغة الهدف تحت مفردات اللغة المصدر مباشرة مع الاحتفاظ على التركيبة اللغوية للغة المصدر. تُترجم كل كلمة بمفردها وتُعطى أكثر المعاني شيوعاً دون مراعاة للسياق. وتُترجم المفردات الثقافية فيها حرفياً ”
وعن الترجمة الحرفية يقول:
” تتحول التراكيب اللغوية للغة المصدر إلى أقرب تراكيب لغوية ممكنة تقابلها في اللغة الهدف، لكن تُترجم الكلمات كل على حِدة دون مراعاة للسياق” (2 صص45ــ46)
ينطلق أنصار هذه الترجمة الحرفية من أمثال بيتر نيو مان، ينطلقون من شعارين إثنين، وهما الحقيقة والدِقة. وينادون باحترام الكلمة الواردة في النص الأصلي والتقيد بها تقيداً مطلقاً، لأننا إنما:
“نترجم الكلمات فقط. إذ لا يوجد شيء يُمكِن ترجمته سوى الكلمات”(2 ص 73)
ولهذا ينتقد دعاة هذا التيار أنصار ترجمة المعنى على وجه الخصوص باعتبار أنهم يعتمدون على تحليل النص بدل التقيد بأفكار كاتبه ونقلها للقراء دون مساس. كما يأخذون عليهم إغفالهم، بل حتى تجاهلهم للصعوبات التي يُمكن أن تطرحها اللغة. يُلخِص بيت نيو مارك هذين المأخذين بقوله:
” يعتقد الكثير من المنظرين أن الترجمة ما هي إلا عملية شرح وتأويل وإعادة صياغة الأفكار. وأن دور اللغة لديهم لجد ثانوي. إذ ينظرون للغة كوعاء حامل للمعنى ما يعني إمكانية ترجمة كل شيء، وأن الصِعاب التي يمكن أن تطرحها هذه اللغة غير موجودة. أولئك هم أتباع المدرسة السلسكوفتشية للمترجمين الفوريين والتحريريين بباريس” (2 ص72)
النظرية التفسيرية، أو نظرية المعنى:
تُمثل هذه النظرية بلا جِدال المنهجية الأكثر شيوعاً في المجالات النظرية لدراسات الترجمة، وفي الممارسة العملية كذلك. إذ فتحت مجالاً جديداً، وآفاق أكثر رحابة لمفهوم التقيد بما ورد في النص الأصلي. ترى هذه النظرية، باديء ذي بدء، تنازع المترجم بين مسئوليتين: الرُغبة في الترجمة بصدق وأمانة ودون حذف أو إضافة من ناحية، وضرورة إقناع قاريء الترجمة من ناحية أخرى، الأمر الذي يُحتم عليه، أحياناً، إضافة بعض المُعطيات في مسعى لإقناع قارئه دون أن تكون تلك الإضافات موجودة في النص الأصلي.
يطرح أنصار النظريتين، أي الحرفية والتفسيرية، يطرحون تساؤلات جوهرية: هل يُمكِن للمترجم التصرف في النص؟ وهل بمقدوره إضافة أبعاد لم يتطرق إليها كاتبه بغرض إقناع القاريء؟ يتفق أتباع النظريتين في خطوة أولى من حيث المبدأ على ضرورة احترام شكل النص وأفكار كاتبه ما أمكن ذلك، لأن المترجم:
” مسئول قبل كل شيء أمام الكاتب الذي ينقل في عمله رسالة يحملها شكل مُعين، وتعابير مُحددة” (2ص 271)
تتم عملية استخلاص المعنى وفقاً للنظرية التفسيرية في ثلاث مراحل:
أولاً: عملية فهم النص. هنا يضع المترجم كافة قدراته المعرفية، لغوية كانت أم غير لغوية، لفهم النص المراد ترجمته. من تلك القدرات التاريخ، العلوم، علم اللغة، علم الاجتماع، الأمثال، الأقوال المأثورة، وما إلى ذلك من معارف مُساعِدة.
ثانياً: تقود عملية الفهم العميق للنص الأصلي لمرحلة وسيطة تُمثل الخطوة النهائية للفهم، والمرحلة الأولى لإعادة صياغة ما فُهِم باللغة الهدف. يُطلق على هذه الخطوة مرحلة تأطير النص.
ثالثاً: تأتي أخيراً مرحلة الصياغة التي تستدعي كذلك استنفار المترجم لكافة معارفه، لغوية كانت أم غير لغوية، لإيجاد المُقابلات اللازمة في اللغة الهدف.
ترى النظرية التفسيرية، إذن، وخِلافاً لرؤية الترجمة الحرفية، ترى أن التقيد بالنص الأصلي إنما يعني التقيد بالمعنى، بالشيء الذي يود الكاتب قوله، لأن الترجمة في منظورها:
” لا تعني إيجاد مقابل لكلمات لغة في لغة أخرى؛ إنما تسعى لإيجاد المعنى الذي ترمز إليه تلك الكلمات” (3ص 66)
أما عند إعادة صياغة المعنى فعلى المترجم:
أولاً: الأخذ بالوسائل التعبيرية المُتاحة في اللغة الهدف.
ثانياً: وضع قراء الترجمة في دائرة اهتمامه. إذ ينبغي عليه التساؤل: هل سيكون بمقدور القاريء الفهم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل سيفهم بنفس القدر الذي يفهم به متلقي الرسالة ممن يتحدثون لغة النص الأصلي كلغة أم؟
إن المُقابِل الترجمي (l’équivalence en traduction) بالنسبة للنظرية التفسيرية، لهو بالضرورة المُقابِل من حيث المعنى. وهو مُقابِل ديناميكي مُتحرِك يُستخلص من خلال الإطار الذي تمت فيه الترجمة، لأن المعنى نفسه متحرك يتغير بتغير الظروف الموضوعية والتاريخية. إذ عندما يذكر أبو الطيب المتنبي ” القنبلة” في شعره؛ إنما يريد بها الكوكبة من أحد عشر فارساً، معنى يختلف جذرياً مع القنبلة التي ألقيت على هيروشيما من حيث قدرتها التدميرية. تنظر النظرية التفسيرية للمعنى، إذن، كخليط من المُعادلات الظرفية (contextuelles) يأخذ في الاعتبار البعد التاريخي، الأمر الذي يزيد من معدلاته. ذلك لأنه، ووفقاً لتغير الحِقبة الزمنية تتبدل المواعين اللغوية والمعطيات الثقافية والوسط الاجتماعي الذي يستهدفه المترجم، وهو ما يُعرف بالصيغ المُتحركة (Dynamiques). وثمة صيغ ثابتة (Transcodages) وهي صيغ صالحة في أية حالة تواصل حقيقي، ولأي نص مهما كان نوعه مثل أسماء الأعلام، الأرقام، صيغ إلقاء التحية، القبول أو الاعتراض، الصيغ الجاهِزة، وما إلى ذلك.
ووفقاً لنظرية المعنى ثمة عوامل كثيرة تدخل في عملية الترجمة، من أهمها النظرة الذاتية للمترجم. ما يهم هو العمل على الترجمة بذكاء ووفقاً لعدة معايير ليس من بينها المُحافظة على سلامة النص كما ينادي بذلك دعاة الترجمة الحرفية. وترى النظرية أنه إن ابتعد المترجم عن الشكل الأصلي للنص؛ فإنما يفعل ذلك لسببين إثنين: أولهما الاقتراب من المعنى المُراد، وثانيهما احترام المواعين اللغوية في اللغة الهدف. ويرى أحد أعمدة هذه النظرية، موريس بيرنيي، (Maurice Bernier) يرى أنه:
” حين يخلص اللغوي، بتفحصه للعناصِر اللغوية للنص، أن الترجمة غير مُطابِقة، يستنتج المترجم الذي يعمل على استخلاص المعنى أنها جد مُطابقة. بمعنى أن عدم التطابق اللغوي قد يكون تطابقاً من حيث المعنى. وأن المترجم المُدرك لأبعاد مهمته، لا بد أن يسعى جاهِداً لاستنباط المعنى غير عابيء بكومة الكلمات” (4)
تصف دينكا سلسكوفيتش، وهي أم النظرية التفسيرية شاركها في تأطيرها والتنظير لها والعمل على ذيوعها زملاؤها وطلابها في المدرسة العليا للمترجمين الفوريين والتحريريين بجامعة السوربون، تصف المعنى بالكيمياء والشكل بالفيزياء، حيث تقول:
” اللغة بمثابة الكيمياء فيما يتعلق بالمعنى، فيزياء فيما يختص بالشكل. كيمياء، لأنه وانطلاقاً من عناصر لغوية محددة، يمكن استنباط كم هائل من المعاني الجديدة دون أن تفقد العناصر اللغوية هويتها الشكلية تماماً كما هو الحال مع العناصر التي تدخل في التجربة الكيميائية” (5 صص 49 ــ50)
ترى نظرية المعنى كذلك وجود تناغم بين المعنى والشكل اللغوي، سيما عندما لا يتوفر المقابل الترجمي في اللغة الهدف. حينها يلجأ المترجم لإعطاء بعض المقابلات التي قد تكون مثيرة للجدل وقد لا توجد في القواميس أصلاً مثل ” العلوج”، ” خارطة الطريق” إلخ. يعمد المترجم هنا لابتداع مقابل ترجمي متأثر بالشكل اللغوي، ونابع من الإطار الظرفي المُعين. بيد أنه ينبغي عدم خلط هذه المقابلات الترجمية المثيرة للجدل على اعتبار أنها استخدامات توليدية، أي استخدامات جديدة لمفردات قديمة (néologisme) ، أو حتى على اعتبار أنها تحديث أسلوبي (innovation stylistique)، ذلك لأن المترجم يجد نفسه مضطراً لإيجاد سياق كلامي عندما يكون المصطلح المراد ترجمته:
أ) لا يُمكن ترجمته ترجمة حرفية بحتة.
ب) لا يوجد في القواميس ثنائية اللغة.
مثال ذلك ترجمة التقارب السياسي بين الصين والولايات المتحد الأمريكية في منتصف السبعينيات بــ ” ديبلوماسية الكرة الطائرة”. إذ اعتمد المترجمون الفعل اللغوي، ذلك أن الانفراج في العلاقات بين البلدين إنما بدأ ظاهِرياً بفعل، ألا وهو إقامة مباراة في الكرة الطائرة.
تأخذ النظرية التفسيرية على الترجمة الحرفية كذلك تقيدها بالتراكيب اللغوية للغة المصدر ما يؤدي إلى:
” وضع العقبات أمام نجاح عملية الترجمة بسبب حصرها، أي الترجمة الحرفية، لجهود التحليل وإعادة الصياغة في الأُطر التي حددتها اللغة المصدر سلفاً، بدل السماح للمترجم بالبحث في كافة الاتجاهات. هذا البحث هو السبيل الوحيد لاكتشاف الصيغ الاسلوبية المُبتكرة في اللغة الهدف” (6)
ويتساءل مناصرو ترجمة المعنى: ما الذي يدفع المترجم للتقيد، عند صياغة النص في اللغة الهدف، ما الذي يدفعه للتقيد بالشكل الوارد في اللغة المصدر؟ أولا يكفي هذه اللغة الهدف أن تكون أصلاً في الموقف الأضعف؟ وهل يجوز إضعافها بصورة أكبر وتشويهها وإفقارها عن طريق التجاهل المستمر لمحسناتها وأساليبها المميزة وصيغها المُبتكرة؟ ويضيفون أنه ينبغي الرجوع في هذا المجال لتصفح تراجم قام بها مترجمون مؤهلون للتثبت من أن باستطاعة اللغة الهدف التحلي بكل المقومات الجمالية، تماماً كما اللغة الأصلية للنص. ذلك أن الترجمة، في نظر المتحمسين لنظرية المعنى، هي تلك التي لا تشبه الترجمة.
لا تكتفي الترجمة الحرفية بإعطاء المدلولات الأكثر شيوعاً للكلمات فحسب؛ إنما تحرم المترجم كذلك، وفقاً لمنتقديها، من فرصة التأمل والتأني لاستنباط مُجمل المعنى. تُشبه النظرية التفسيرية المعنى ببلح البحر (la moule). يقبع هذا البلح داخل الصدف الذي يُمثله الإطار اللغوي. لابدَ،إذن، من كسر هذا الصدف للوصول إلى البلح. ولا يرون أهمية لكيفية الكسر، ولا الطريقة التي يتم بها.
وإذا كانت الترجمة الحرفية ترفض إعطاء المترجم أي قدر من الحرية تُمكنه من الابداع وتبني الاستنتاجات، فإنها بذلك:
” تُنكِر على المترجم ما يُفرِقه عن الآلة، أي تُنكِر عليه الخلق والابتكار وتبني الخيارات الموضوعية. أضف إلى ذلك أن نظرتها لا تتوافق مع ملاحظات علماء اللغة المُعاصرين فيما يتعلق بطبيعة المقابلات الترجمية” (6 ص 71)
نتفق، من جانبنا، مع دعاة نظرية المعني فيما ذهبوا إليه من أن الترجمة الحرفية تحرم المترجم من التأمل اللازم لاستخلاص المرامي الحقيقية للنص. وللدلالة على ذلك نسوق مقطعين شِعريين لشاعر زنجي يتحدى فيهما المُستعمر، ويُهاجِم الاستعمار. يقول:
“Je suis un homme cafre
Je suis le serpent” (7)
تُعطي ترجمة هذين المقطعين حرفياً: ” أنا رجل كافر. أنا الثعبان”
فالمتأمل لهذه الترجمة القاموسية الحرفية، يجد أنها سطحية غير ذات قيمة لأنها تُفرِغ الكلمات من مضمونها وأغراضها الجوهرية. إذ لا يود الشاعر هنا إشهار إلحاده، بقدر ما يود الإشارة إلى أن محاولات المُستعمِر لتنصيره قد باءت بالفشل، ومن أن الاستعمار الذي أتى مُصطحباً للحملات التبشيرية لم يترك أثراً في حياته، إذ لا يزال يعتز بذاته وكينونته. فللفظة ” كافِر” هنا مدلولات عرقية وسياسية، إضافة لبعدها الديني. ثم إن الإشارة للثعبان لا تعدو أن تكون إشارة لقوته التي تُماثل خطر الأفعى في الأحراش الأفريقية. لا يستطيع المترجم معرفة ذلك إلا بالإلمام العميق بسياق النص، والأخذ في الاعتبار المُعطيات اللالغوية كتاريخ الاستعمار وعلاقة المُستعمِر بالمُستَعمر.
أما إذا تناولنا كلمة” كافِر” من منظور لغوي، فستعطينا كذلك بُعداً ما كان ليخطر على بال من يترجِم حرفياً. إذ من حقنا التساؤل: لمً اختار الشاعر هذه اللفظة على وجه التحديد وهي ذات أصل عربي؛ بينما تزخر اللغة الفرنسية بالمفردات التي تدل على الإلحاد بجميع درجاته مثل: (incroyant, irréligieux, mécréant, impie, paÏen, incrédule, infidèle, etc . .)
ونميل للاعتقاد أن الشاعر باستخدامه لكلمة لا تنتمي لأصول لغة المُستعمِر؛ إنما أراد استهجان تلك اللغة التي طالما عقد عليها الغُزاة الآمال في التأثير على مُستعمراتهم فِكرياً وثقافياً.
في نقد النظرية التفسيرية:
إضافة للانتقادات التي ساقها خصومها من أتباع الترجمة الحرفية كما ورد آنفاً، فإن هذه النظرية لم تعط، وهذه إحدى المآخذ التي يأخذها عليها أنصار تيارات تراجم أخرى، لم تعط تعريفاً علمياً دقيقاً للمعنى المُراد نقله. إذ من حقنا التساؤل: هل يتضمن البيت من الشِعر مثلاً معنى واحداً لا يقبل الجدل؟ وهل يجوز تحجيم مرامي الشاعر وقصرها على فهم المترجم فقط؟ وإذا كانت هنالك عُدة معان مُحتملة للبيت، فما الذي يُعطي المترجم الحق في اختيار إحداها واستبعاد الأخرى؟ ثم هل يلتزم المترجم بالإشارة لكل المعاني المُحتملة في سياق ترجمته، أم هل تراه يكتفي بإحداها، واضِعاً البقية في حاشية النص؟ وهل تُعتبر الحاشية أصلاً جزءاً من الترجمة؟ أو لا يُخاطِر المترجم، عندما يورد الكثير من المعاني ويلجأ لاستخدام الحواشي، ألا يُخاطِر بالخروج من دائرة الترجمة والولوج في فرع آخر من فروع المعرفة ألا وهو تحليل النص (analyse textuelle)؟ وإذا فعل ذلك أفلا يُثبت فعلياً مآخذ الترجمة الحرفية القائلة بأن الترجمة التفسيرية تُفسِر ولا تُترجم؟
لإيضاح إشكالية تعدد المعاني تلك سنقوم بتحليل بيت من مُعلقة عمرو بن كلثوم التي يبتدرها بالقول يفتخر بعزة قومه ومنعتهم وشِدة بأسهم وتفردهم بين القبائل:
ألا هُبي بصحنك فاصبحينا = ولا تُبقي خمور الأندرينا
إلى أن يصل في فخره للقول:
ونشربُ إن وردنا الماء صفواً = ويشربُ غيرنا كدراً وطينا
إذا قمنا بترجمة هذا البيت ترجمة حرفية للغة الفرنسية لأعطانا:
“Si nous abordons de l’eau,
Nous la boirons limpide,
Les autres la boiront troublée et boueuse”
لا ريب في أن هذا البيت يطرح أولاً إشكالية حضارية تتمثل في مفهوم” الوِرد”. ذلك أن الجمهور المُستهدف بالترجمة للغة الأجنبية لا يعرف في غالبيته العُظمى عملية السعي للحصول على المياه، إذ تصلهم هذه الأخيرة في دورهم بالأنابيب والصنابير. عليه يتوجب على المترجم شرح مفهوم الورد أولاً. ويزداد الأمر تعقيداً عند العكوف على استنباط المعنى، إذ للبيت معنى ظاهِري سهل تُقدِمه الترجمة الحرفية، ألا وهو الفرق بين صفاء الماء وكدره. معنى سطحي لا يروق لأنصار النظرية التفسيرية، علاوة على أنه لا يخدم الغرض الفخري للقصيدة في شيء، ولا يأتي بسوى مدلول شائع للغة.
قمنا من جانبنا بالتأمل في هذا البيت واستخرجنا منه احتمالية معان عِدة نرى أنها تخدم هدف الشاعر في الافتخار بقبيلته. من تلك المعاني التي جالت بخاطِرنا:
أولاً: نظراً لكثرة عددنا (والبُعد الديمغرافي من دواعي الفخر للقبيلة العربية)، فإننا نحيل الماء حين تغرف منه أكفنا من الصفاء للعكر.
ثانياً: لكثرة أنعامنا (وضخامة الثروة الحيوانية كانت وما تزال تُعطي الثقل الاقتصادي، وبالتالي الوزن الاجتماعي للقبيلة)، كثرتها تُحيل الماء من الصفاء إلى العِكر.
ثالثاً: إننا نصد الآخرين عن الماء عنوة واقتدارا حتى نرتوي وتشرب أنعامنا، وفي ذلك دليل على القوة والمِنعة وشِدة البأس.
رابعاً: إننا من ذوي الهِمم العالية والحيوية والنشاط. ننهض باكِراً حين يغط الآخرون في سُبات عميق. ننهل من الماء وهو في حالة صفاء، حتى إذا الكسالى فاترو الهِمة (يعني القبائل الأخرى)، وجدوه كدراً.
خامساً: إننا نمتلك أفضل البِقاع حيث نقطن في المرتفعات، حتى إذا هطلت الأمطار، حصلنا على ماء صاف. وعندما يسيل هذا الماء إلى الأسفل حيث يقطن الآخرون، يتلوث لاختلاطه بالثرى حيث يتبدل لونه، فيصبح عِكرا.
سادساً: إننا لا نشرب الماء إلا لماما. فنظراً لكثرة أنعامنا وما تجود به علينا من حليب، وما نصنعه بحليبها من ألبان، وبفعل كثرة أشجار أعنابنا ونخيلنا وما نستخرجه من ثمارها من عصائر وشراب، فإننا لا نلجأ لشرب الماء إلا نادراً. نستنبط هذا المعنى إذا ما تأملنا في الفواصل وقرأنا البيت على النحو التالي:
ونشرب، إن شربنا الماء، صفواً
فجملة، إن شربنا الماء، تصبح جملة اعتراضية ترمز لنُدرة الفعل وعدم انتظام واستمرارية الرُغبة في شرب الماء.
سابعاً: إن كلمة” الماء” هنا لا تعني الماء المُتعارف عليه؛ وإنما ترمز لكل مطايب الحياة. فكأنما يود الشاعر القول: إننا نحظى بكل طيب بهيج في شتى مناحي الحياة؛ بينما لا ينال سوانا سوى الغث الهزيل.
ثامناً: إننا من العارِفين الملمين بقواعِد صحة الأبدان، لذا لا نشرب سوى الماء الصافي، أما الآخرون، ولجهلهم بتلك القواعِد، فيشربونه كدراً مُلوثا.
تاسعاً: قد يعني الشاعر كل ما تقدم من معان.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: أي معنى سيختار المترجم المُسترشِد بالنظرية التفسيرية يا تُرى؟
في مسعى للإجابة على التساؤل أعلاه نقول: على المترجم، باديء ذي بدء، حصر كافة المعاني المُحتملة والتركيز عند الترجمة على أكثرها ملاءمة لسياق النص موضوع الترجمة والغرض الذي ينوي الكاتب، أو الشاعر ذيوعه. ولئن حاولنا تطبيق هذا النهج على بيت الشعر الذي قمنا بتحليله للتو، لاتضح لنا بجلاء أن السِمة الغالبة عليه لهي العزة والشجاعة. لذا، فإن أفضل ترجمة له قد تكون في معتقدنا:
“Nous vivons dans l’opulence, parce que nous sommes forts.
Les autres, et à cause de leur faiblesse, vivent la misère et la médiocrité”
ولئن دأب أتباع النظرية التفسيرية على انتقاد أنصار الترجمة الحرفية بسبب عدم اهتمامهم بالمعنى، وتركيزهم على العناصِر اللغوية والتراكيب الاسلوبية، فإننا لا نشاطرهم الرأي تماماً، إذ نرى أن العناصِر اللغوية قد تكون عوناً للمترجم وتمكنه من الالتفات للكثير من المعاني. فإذا حاولنا تحليل نفس البيت السابق من منطلق لغوي أسلوبي لوجدنا:
أولاً: الجملة الاعتراضية، إن وردنا الماء، تضيف معنى جديداً توحي به طريقة مُعينة للقراءة، أي باستخدام الترقيم وهو أداة لغوية قد تؤدي لإضافة معان جديدة.
ثانياً: الدلالة المُستقبلية في استخدام الأفعال (نشربُ ويشربُ)، ما يدعم صفة الاستمرارية ويُعضِد الأسباب التي تدعو للفخر. إذ يود الشاعر الإشارة لدوام الحال هكذا أبد الآبدين: أي سنكون متفوقين على غيرنا دوماً، نشرب النقي، ويشربون الكدِر.
ثالثاً: غياب ” الأنا ” الفردية، واستخدام صيغة الجمع (ونشربُ)، ما يدل على اتحاد الكلمة، وذوبان شخصية الفرد في المجموعة وفي ذلك دلالة على القوة.
رابعاً: بما أن المعطوف عليه يكون دوماً أقوى من المعطوف، فقد استخدم الشاعر حرف العطف (و) لتعزيز مراميه الفخرية.
خامساً: لنتأمل في اختيار الشاعر لكلمة (غيرُنا)، إذ يكون بذلك قد وضع قومه في مرتبة لا تختلف في علوها وتميزها عن مرتبة بقية القبائل فحسب؛ إنما وضع تلك القبائل في مقام الحيوان والنبات التي تحتاج كذلك لشُرب الماء، ذلك أن لفظة (غيرنا) تشير لجميع مخلوقات الله التي تحتاج الماء باستثناء قوم الشاعر.
سادساً: يستخدم الشاعر، عندما يتعلق الأمر بقومه، يستخدم مفعولاً به يقبل الصفة والحال:
” ونشرب إن شربنا الماء صفواً “. فالماء هنا يقبل صفات مثل: زلالاً، عذباً، رقراقاً، سلسبيلاً وغير ذلك، في حين نراه يستخدم للآخرين مفعولاً به لا يقبل صفة ولا حالاً؛ لأنه حال وصفة في حد ذاته. فكلمة ” كدراً ” هي اسم وحال وصفة في ذات الوقت، وينطبق ذات القول على “طيناً “.
سابعاً: تأمل الطِباق، وهو من المحسنات في اللغة العربية (صفواً/ كدراً).
الخــاتـــمـة:
يتضح لنا مما تقدم أن الترجمة الحرفية ترفض تفسير النص؛ بينما لا تُعير ترجمة المعنى بنيته اللغوية وتركيبته الاسلوبية اهتماماً يُذكر. تبين لنا كذلك، ومن خِلال تحليلنا لبيتين من الشعر، تبين لنا أن تحليل النص، سواء بغرض استخلاص معانيه الخفية، أو من منطلق دراسة تركيبته اللغوية، يُعتبر غاية في الأهمية بالنسبة للمترجم؛ لأن ذك يُمكِنه من الفهم الدقيق للرسالة الكامنة في اللغة المصدر، وهو شرط لنقلها بكفاءة ووضوح للغة الهدف. تبين لنا أيضاً أن الترجمة الحرفية، ومن خِلال توفرها على الاهتمام بالتركيبة اللغوية للنص الأصلي وخصائصه الاسلوبية؛ إنما تستنبط بذلك بعض المعاني الكامنة فيه. وأنها، أي الترجمة الحرفية، تُعتبر مُكملة للنظرية التفسيرية، وليست نقيضاً لها. ولعل إسناد نظرية المعنى مهمة تفسير النص لشخص المترجم فقط هو ما دفع بالكثير من المنظرين في مجال الترجمة، وعلى رأسهم موريس بيرنييي، دفعهم للمناداة بإشراك كل مذاهب الترجمة من أجل استنطاق النص، سيما النصوص الأدبية. إذ من المؤكد أنه ليس بوسع تيار ترجمي بعينه الادعاء أن بوسعِه، منفرٍداً، إعطاء الأنموذج المُكتمل، والمنهجية المُثلي.
نقطتان أخيرتان نختتم بهما هذا البحث:
أولاً: ضرورة توفر الحِس الأدبي لمترجِم النصوص الأدبية، الامر الذي سيعينه على اختيار أقرب المعاني التي ينشدها الكاتب. نقول المعنى الأقرب، لأن المعنى الحقيقي يتعذر إدراك كنهه، وسبر أغواره. ذلك لأن تجربة الابداع الأدبي مُمعنة في الذاتية، تتسم بالخصوصية، وتتعلق بمشاعر مُختلطة مُتباينة تبايناً قد يصل لدرجة التنافر. وتتم مرحلة الابداع ذاتها عبر عملية مُخاض يجهلها الأديب نفسه أحياناً.
ثانياً: أن يفرد المترجم وقتاً للبحث بغرض تجويد الأداء، وألا يكتفي بأن يكون صدى باهِتاً للنص؛ وإنما يلعب دوره كموصِل جيد لرؤى الكاتب، دون إغفال لوضوح الرؤية فيما يتعلق بالقراء.
* بروفيسور بابكر ديومة
أستاذ الترجمة والنقد الأدبي/ جامعة الملك سعود
ثبت المراجع
(أ) مراجع تمت الإشارة إليها في متن البحث:
Abul A’la Mawdudi-Towards understanding Islam, L.I.S.O, 1968,P.25 (1)
(2) Newmark (P.) – Textbook of Translation. New York,1988, pp.45-46
(3)Herbulo (F.) -Le Traducteur Déchiré, Minard,Paris,1990
(4)Pergnier(M.)-L’équivalence en traduction,Meta,1987
(5) Seleskovitch(( Danica) – Langage, langues et mémoire,Paris, 1975
(6) Déjean (K.) – Qu’en est-il au juste du transcodage en traduction écrite?,Traduire ,1987
(7) Damas(L.) -Poètes d’expression française, Seuil,1947
مراجع عامة بالفرنسية:
(1) Delisle (J.) -L’analyse du discours comme méthode de traduction, Ottowa,1980
(2) Hurtado (A.) – La notion de fidélité en traduction, Didier,1990
(3) Nida (E.)etTaber (C.)-La Traduction :Théorie et méthode, Londres; 1971
(4) Pergnier (M.) – Les fondements Sociologiques de la traduction, Paris,1978
(5) Seleskovitch (D.) et Lederer (M.) – Interpréter pour traduire, Paris, 1984
مراجع عامة بالإنكليزية :
(1) Nord (C.) -Text analysis in Translation, Amsterdam,1990
(2)Wilss (w.) -Towards a multi-facet conception of translation behavior, Meta; 1989
يشتمل هذا البحث على جزء ين: يتعلق أولهما باستعراض للمناهِج والأساليب التي تُطبقها تيارات الترجمة المختلفة بغرض استنطاق النص. سيكون الاستعراض هنا سريعاً ومُقتضباً عند الحديث عن المذاهب غير المؤثرة، أو لنقل الأقل شيوعاً مثل: التراجم الحُرة والموسوعية والتوافقية التي أصبحت تُعرف بترجمة المواءمة. بيد أننا سنتوقف بعض الشيء عند أهم تيارين يشغلان الساحة حالياً ألا وهما: الترجمة الحرفية، والنظرية التفسيرية أو نظرية المعنى. أما الجزء الثاني فسيتناول تحليلاً لبيتين من الشِعر أحدهما من الفرنسية، وثانيهما من العربية نسعى من خلالهما لإيضاح استحالة استنباط مُجمل المعنى بتطبيق منهجية تيار ترجمي بعينه؛ وإنما يتطلب الأمر الاستعانة بالأطُر المنهجية للتيارات جميعها من ناحية، وضرورة تحليل النص المُستهدف من حيث الشكل والمضمون من ناحية أخرى. ذلك أن مثل هذا التحليل كفيل بإظهار عدة معانٍ ما كانت لتخطر للمُترجِم على بال إن هو اكتفى بالمدلول الظاهري للألفاظ.
عن الترجمة:
إن أبسط تعريف مُتفق عليه للترجمة هو: ” قول ذات الشيء كما ورد في أصله”. ولعل أولى إشكالياتها تكمن في تفسير لفظة ” ذات الشيء ” على وجه التحديد. ومعلوم أن عِلم اللغة المُعاصِر، شأنه شأن الترجمة، يواجِه الإشكالية ذاتها في سعيه لتبيان الصِلة بين الإطار اللغوي، والمعنى الذي يحمله.
يدور كل تاريخ الترجمة، في واقع الأمر، حول قضيتين جوهريتين: تتعلق أولاهما بإمكانية الترجمة ذاتها؛ بينما تهتم الثانية بتحديد درجة التقيد والالتزام بما ورد في النص الأصلي. ويبدو أن المسألة الأولى قد حُسِمت بالفعل ولم يعد يثيرها سوى القلائل. إذ طالما كان هنالك مترجمون يزاولون المهنة، نصوص تُترجم، ومؤتمرات تُعقد بمشاركة أناس يتحدثون شتى اللغات ويفهم بعضهم بعضا بفعل عملية الترجمة، فقد أصبحت هذه الأخيرة واقعاً ملموساً لا يطاله الشك. وحتى لو لم تكن كذلك، لجعل منها عالم اليوم بتعقيداته وتشابك مصالحه وتداخل شئونه أمراً مُمكناً، بل لازماً بحكم ضرورة الأشياء. تبقى، إذن، المسألة الأخرى المُتمثلة في درجة الصدق والدِقة في نقل مرامي النص المُراد ترجمته. هنا تتباين آراء المُختصين والباحثين، الأمر الذي أدى لبروز عدة تيارات لكل منها أنصارها ومعارضوها بطبيعة الحال. نذكر من هذه التيارات:
1) الترجمة الحُرة (la traduction libre):
لا يعبأ هذا التيار كثيراً بنقل معاني النص الأصلي. يكون المترجم حراً في تفسير هدف الكاتب ونواياه، ثم يسمح لنفسه بالتمتع بذات القدر من الحرية عند القيام بصياغة النص في اللغة الهدف، وهو ما يجعل علاقة الترجمة بالنص المصدر جد ضعيفة. إذ ينطلِق المترجم من النص الأصلي لصياغة نص جديد.
2) الترجمة الموسوعية (la traduction- Erudition):
يستهدف هذا النوع من التراجم جمهوراً مُتخصصاً يلم بأطراف، وربما بكل جزئيات الموضوع المُراد ترجمته. هنا يستخدم المترجم النص الأصلي كهدف للدراسة فيدخل عليه تعليقات فلسفية، ويصبغ عليه صبغاً نفسية، ويعطيه أبعاداً تاريخية واجتماعية بحيث تكون المحصلة النهائية إظهاراً لسعة علم المترجم، غزارة ثقافته، وتمكنه من شتى ضروب المعرفة، أكثر منها ترجمة النص ذاته.
وكمثال لهاتين الترجمتين، نعني الحرة والموسوعية، نقتبس التعريف التالي للفظة (الكُفر) التي وردت مِراراً في القرآن الكريم. إذ بدل أن يُركز المترجم على ترجمة الكلمة على اعتبار أنها إخفاء وإلغاء لوجود الخالق، يقول بدوافِع دعوية:
” الكُفر ضرب من الجهل، بل هو بالأحرى، الجهل بذاته. إذ أي جهل يفوق عدم المعرفة بالله، الخالق مالك الكون؟ فها هو المرء يشاهد المظاهر المتنوعة للطبيعة ويرى حركة الكون المتناسقة التي لا تتوقف عن الدوران والخلق البديع لجميع الكائنات”
ثم يستعرض المترجم معرفته بمكونات الجسم البشري فيضيف:
” يرى المرء عجائب الكون في جسده، بيد أنه يعجز عن فهم القوة التي أعطته الحياة من خامات مثل: الكربون، الكالسيوم، الصوديوم وما إلى ذلك” (1ص25)
3) الترجمة التوافقية، أو ترجمة المواءمة (la traduction-Adaptation)
يدخل هذا التيار في إطار الترجمة الحرة. ذلك أنه، وإن كان يحافظ على الإشارة للنص الأصلي، إلا أنه يعمل دوماً على تغيير عنصر من عناصره كمستوى اللغة مثلاً، أو الخاصية التي قد يتفرد بها ضرب من ضروب الإبداع الأدبي كالشعر، أو الرواية، أو المسرحية. أو أن يقوم بتغيرات جوهرية في معالم الحِقبة التاريخية للعمل كأن يأخذ ببعض المعطيات التي لم تكن متوفرة لحظة كتابة النص. جل من يلجأ لهذا التيار هم المترجمون في قطاعي السينما والمسرح بهدف عصرنة العمل القديم وتقريبه لعقلية المتلقي المُعاصِر. ويتم التحوير هنا وفقاً لنوعية ومستوى الجمهور المراد مخاطبته، أو الغرض من الخطاب، أو لاعتبارات أخرى ذاتية يقدرها المترجم. نعطي لهذا النوع من الترجمة مثالاً نسوقه من ترجمة لذات الداعية الإسلامي الذي اقتبسنا أجزاء من بعض تراجِمه آنفاً يتحدث فيه عن أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت، منذ يومها الأول، تنادي بحقوق الإنسان. ولشرح هذه الفكرة وتقريبها للقراء يضيف مُقارناً بما يجري في عالمنا المُعاصِر:
” أنظر إلى مسألة اللون، إذ لم يتمكن العالم بعد من إيجاد تواصل منطقي وإنساني من الملونين. فقد قُتِل وعُذِب الآلاف من البشر في الولايات المتحدة بسبب سواد بشرتهم. وُضِعت قوانين مختلفة للبيض والسود. حتى أنهم ما كانوا يستطيعون الدراسة تحت سقف واحد أو في ذات المدرسة أو الكلية. استمر هذا الوضع حتى السابع عشر من مايو من العام 1954م حين أفتت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التفرقة ومن أنها ضد المساواة في الحقوق الإنسانية” (1 ص153)
بيد أن أهم تيارين يشغلان الساحة حالياً هما الترجمة الحرفية (la traduction littérale) والنظرية التفسيرية، أو ما أصبح يُعرف اليوم بترجمة المعنى (la traduction du sens)
وعلى الرغم من الاعتقاد السائد في أوساط من يشتغلون بالترجمة بوجود اختلافات عميقة بين منهجية هذين التيارين وتباين جذري في استراتيجيتهما، إلا أنهما يلتقيان في نقطتين جوهريتين تكمنان في الإجابة على التساؤلين التاليين: هل الترجمة ممكنة أصلاً؟ ولئن كان الرد بالإيجاب، أيهما أفضل: الترجمة الحرفية، أم التفسيرية؟ والمتأمل لهذين التساؤلين يجدهما يبحثان عن إجابة للإشكالية التي تعرضنا إليها في صدر هذا البحث، ألا وهي مسألة تعريف “قول ذات الشيء كما ورد في أصله”. لكن، ونظراً لشيوع هاتين المنهجيتين، كما سبقت الإشارة، فسنتوقف عندهما بشيء من التفصيل، مع التركيز على منهجية كل منهما في ترجمة النص عموماً، والنص الأدبي على وجه الخصوص.
الترجمة الحرفية:
ينبغي التفريق هنا بين الترجمة الحرفية، وترجمة كلمة فكلمة (la traduction mot à mot).
إذ تقوم هذه الأخيرة على الشكل اللغوي والبحث عن المُقابلات في اللغة الهدف دون مراعاة لسياق النص، ثم صياغة الجملة المُترجمة وفقاً لتركيبتها في اللغة المصدر. أما الترجمة الحرفية فهي، وإن كانت تبحث كذلك عن مقابل المفردات في اللغة الهدف دون مراعاة للسياق، بيد أنها تعمل، قدر المستطاع، على أن تكون التركيبة اللغوية للغة المصدر مماثلة لنظيرتها في اللغة الهدف. يوضح بيتر نيو مارك ذلك بقوله عن ترجمة كلمة فكلمة:
” تُوضع مفردات اللغة الهدف تحت مفردات اللغة المصدر مباشرة مع الاحتفاظ على التركيبة اللغوية للغة المصدر. تُترجم كل كلمة بمفردها وتُعطى أكثر المعاني شيوعاً دون مراعاة للسياق. وتُترجم المفردات الثقافية فيها حرفياً ”
وعن الترجمة الحرفية يقول:
” تتحول التراكيب اللغوية للغة المصدر إلى أقرب تراكيب لغوية ممكنة تقابلها في اللغة الهدف، لكن تُترجم الكلمات كل على حِدة دون مراعاة للسياق” (2 صص45ــ46)
ينطلق أنصار هذه الترجمة الحرفية من أمثال بيتر نيو مان، ينطلقون من شعارين إثنين، وهما الحقيقة والدِقة. وينادون باحترام الكلمة الواردة في النص الأصلي والتقيد بها تقيداً مطلقاً، لأننا إنما:
“نترجم الكلمات فقط. إذ لا يوجد شيء يُمكِن ترجمته سوى الكلمات”(2 ص 73)
ولهذا ينتقد دعاة هذا التيار أنصار ترجمة المعنى على وجه الخصوص باعتبار أنهم يعتمدون على تحليل النص بدل التقيد بأفكار كاتبه ونقلها للقراء دون مساس. كما يأخذون عليهم إغفالهم، بل حتى تجاهلهم للصعوبات التي يُمكن أن تطرحها اللغة. يُلخِص بيت نيو مارك هذين المأخذين بقوله:
” يعتقد الكثير من المنظرين أن الترجمة ما هي إلا عملية شرح وتأويل وإعادة صياغة الأفكار. وأن دور اللغة لديهم لجد ثانوي. إذ ينظرون للغة كوعاء حامل للمعنى ما يعني إمكانية ترجمة كل شيء، وأن الصِعاب التي يمكن أن تطرحها هذه اللغة غير موجودة. أولئك هم أتباع المدرسة السلسكوفتشية للمترجمين الفوريين والتحريريين بباريس” (2 ص72)
النظرية التفسيرية، أو نظرية المعنى:
تُمثل هذه النظرية بلا جِدال المنهجية الأكثر شيوعاً في المجالات النظرية لدراسات الترجمة، وفي الممارسة العملية كذلك. إذ فتحت مجالاً جديداً، وآفاق أكثر رحابة لمفهوم التقيد بما ورد في النص الأصلي. ترى هذه النظرية، باديء ذي بدء، تنازع المترجم بين مسئوليتين: الرُغبة في الترجمة بصدق وأمانة ودون حذف أو إضافة من ناحية، وضرورة إقناع قاريء الترجمة من ناحية أخرى، الأمر الذي يُحتم عليه، أحياناً، إضافة بعض المُعطيات في مسعى لإقناع قارئه دون أن تكون تلك الإضافات موجودة في النص الأصلي.
يطرح أنصار النظريتين، أي الحرفية والتفسيرية، يطرحون تساؤلات جوهرية: هل يُمكِن للمترجم التصرف في النص؟ وهل بمقدوره إضافة أبعاد لم يتطرق إليها كاتبه بغرض إقناع القاريء؟ يتفق أتباع النظريتين في خطوة أولى من حيث المبدأ على ضرورة احترام شكل النص وأفكار كاتبه ما أمكن ذلك، لأن المترجم:
” مسئول قبل كل شيء أمام الكاتب الذي ينقل في عمله رسالة يحملها شكل مُعين، وتعابير مُحددة” (2ص 271)
تتم عملية استخلاص المعنى وفقاً للنظرية التفسيرية في ثلاث مراحل:
أولاً: عملية فهم النص. هنا يضع المترجم كافة قدراته المعرفية، لغوية كانت أم غير لغوية، لفهم النص المراد ترجمته. من تلك القدرات التاريخ، العلوم، علم اللغة، علم الاجتماع، الأمثال، الأقوال المأثورة، وما إلى ذلك من معارف مُساعِدة.
ثانياً: تقود عملية الفهم العميق للنص الأصلي لمرحلة وسيطة تُمثل الخطوة النهائية للفهم، والمرحلة الأولى لإعادة صياغة ما فُهِم باللغة الهدف. يُطلق على هذه الخطوة مرحلة تأطير النص.
ثالثاً: تأتي أخيراً مرحلة الصياغة التي تستدعي كذلك استنفار المترجم لكافة معارفه، لغوية كانت أم غير لغوية، لإيجاد المُقابلات اللازمة في اللغة الهدف.
ترى النظرية التفسيرية، إذن، وخِلافاً لرؤية الترجمة الحرفية، ترى أن التقيد بالنص الأصلي إنما يعني التقيد بالمعنى، بالشيء الذي يود الكاتب قوله، لأن الترجمة في منظورها:
” لا تعني إيجاد مقابل لكلمات لغة في لغة أخرى؛ إنما تسعى لإيجاد المعنى الذي ترمز إليه تلك الكلمات” (3ص 66)
أما عند إعادة صياغة المعنى فعلى المترجم:
أولاً: الأخذ بالوسائل التعبيرية المُتاحة في اللغة الهدف.
ثانياً: وضع قراء الترجمة في دائرة اهتمامه. إذ ينبغي عليه التساؤل: هل سيكون بمقدور القاريء الفهم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل سيفهم بنفس القدر الذي يفهم به متلقي الرسالة ممن يتحدثون لغة النص الأصلي كلغة أم؟
إن المُقابِل الترجمي (l’équivalence en traduction) بالنسبة للنظرية التفسيرية، لهو بالضرورة المُقابِل من حيث المعنى. وهو مُقابِل ديناميكي مُتحرِك يُستخلص من خلال الإطار الذي تمت فيه الترجمة، لأن المعنى نفسه متحرك يتغير بتغير الظروف الموضوعية والتاريخية. إذ عندما يذكر أبو الطيب المتنبي ” القنبلة” في شعره؛ إنما يريد بها الكوكبة من أحد عشر فارساً، معنى يختلف جذرياً مع القنبلة التي ألقيت على هيروشيما من حيث قدرتها التدميرية. تنظر النظرية التفسيرية للمعنى، إذن، كخليط من المُعادلات الظرفية (contextuelles) يأخذ في الاعتبار البعد التاريخي، الأمر الذي يزيد من معدلاته. ذلك لأنه، ووفقاً لتغير الحِقبة الزمنية تتبدل المواعين اللغوية والمعطيات الثقافية والوسط الاجتماعي الذي يستهدفه المترجم، وهو ما يُعرف بالصيغ المُتحركة (Dynamiques). وثمة صيغ ثابتة (Transcodages) وهي صيغ صالحة في أية حالة تواصل حقيقي، ولأي نص مهما كان نوعه مثل أسماء الأعلام، الأرقام، صيغ إلقاء التحية، القبول أو الاعتراض، الصيغ الجاهِزة، وما إلى ذلك.
ووفقاً لنظرية المعنى ثمة عوامل كثيرة تدخل في عملية الترجمة، من أهمها النظرة الذاتية للمترجم. ما يهم هو العمل على الترجمة بذكاء ووفقاً لعدة معايير ليس من بينها المُحافظة على سلامة النص كما ينادي بذلك دعاة الترجمة الحرفية. وترى النظرية أنه إن ابتعد المترجم عن الشكل الأصلي للنص؛ فإنما يفعل ذلك لسببين إثنين: أولهما الاقتراب من المعنى المُراد، وثانيهما احترام المواعين اللغوية في اللغة الهدف. ويرى أحد أعمدة هذه النظرية، موريس بيرنيي، (Maurice Bernier) يرى أنه:
” حين يخلص اللغوي، بتفحصه للعناصِر اللغوية للنص، أن الترجمة غير مُطابِقة، يستنتج المترجم الذي يعمل على استخلاص المعنى أنها جد مُطابقة. بمعنى أن عدم التطابق اللغوي قد يكون تطابقاً من حيث المعنى. وأن المترجم المُدرك لأبعاد مهمته، لا بد أن يسعى جاهِداً لاستنباط المعنى غير عابيء بكومة الكلمات” (4)
تصف دينكا سلسكوفيتش، وهي أم النظرية التفسيرية شاركها في تأطيرها والتنظير لها والعمل على ذيوعها زملاؤها وطلابها في المدرسة العليا للمترجمين الفوريين والتحريريين بجامعة السوربون، تصف المعنى بالكيمياء والشكل بالفيزياء، حيث تقول:
” اللغة بمثابة الكيمياء فيما يتعلق بالمعنى، فيزياء فيما يختص بالشكل. كيمياء، لأنه وانطلاقاً من عناصر لغوية محددة، يمكن استنباط كم هائل من المعاني الجديدة دون أن تفقد العناصر اللغوية هويتها الشكلية تماماً كما هو الحال مع العناصر التي تدخل في التجربة الكيميائية” (5 صص 49 ــ50)
ترى نظرية المعنى كذلك وجود تناغم بين المعنى والشكل اللغوي، سيما عندما لا يتوفر المقابل الترجمي في اللغة الهدف. حينها يلجأ المترجم لإعطاء بعض المقابلات التي قد تكون مثيرة للجدل وقد لا توجد في القواميس أصلاً مثل ” العلوج”، ” خارطة الطريق” إلخ. يعمد المترجم هنا لابتداع مقابل ترجمي متأثر بالشكل اللغوي، ونابع من الإطار الظرفي المُعين. بيد أنه ينبغي عدم خلط هذه المقابلات الترجمية المثيرة للجدل على اعتبار أنها استخدامات توليدية، أي استخدامات جديدة لمفردات قديمة (néologisme) ، أو حتى على اعتبار أنها تحديث أسلوبي (innovation stylistique)، ذلك لأن المترجم يجد نفسه مضطراً لإيجاد سياق كلامي عندما يكون المصطلح المراد ترجمته:
أ) لا يُمكن ترجمته ترجمة حرفية بحتة.
ب) لا يوجد في القواميس ثنائية اللغة.
مثال ذلك ترجمة التقارب السياسي بين الصين والولايات المتحد الأمريكية في منتصف السبعينيات بــ ” ديبلوماسية الكرة الطائرة”. إذ اعتمد المترجمون الفعل اللغوي، ذلك أن الانفراج في العلاقات بين البلدين إنما بدأ ظاهِرياً بفعل، ألا وهو إقامة مباراة في الكرة الطائرة.
تأخذ النظرية التفسيرية على الترجمة الحرفية كذلك تقيدها بالتراكيب اللغوية للغة المصدر ما يؤدي إلى:
” وضع العقبات أمام نجاح عملية الترجمة بسبب حصرها، أي الترجمة الحرفية، لجهود التحليل وإعادة الصياغة في الأُطر التي حددتها اللغة المصدر سلفاً، بدل السماح للمترجم بالبحث في كافة الاتجاهات. هذا البحث هو السبيل الوحيد لاكتشاف الصيغ الاسلوبية المُبتكرة في اللغة الهدف” (6)
ويتساءل مناصرو ترجمة المعنى: ما الذي يدفع المترجم للتقيد، عند صياغة النص في اللغة الهدف، ما الذي يدفعه للتقيد بالشكل الوارد في اللغة المصدر؟ أولا يكفي هذه اللغة الهدف أن تكون أصلاً في الموقف الأضعف؟ وهل يجوز إضعافها بصورة أكبر وتشويهها وإفقارها عن طريق التجاهل المستمر لمحسناتها وأساليبها المميزة وصيغها المُبتكرة؟ ويضيفون أنه ينبغي الرجوع في هذا المجال لتصفح تراجم قام بها مترجمون مؤهلون للتثبت من أن باستطاعة اللغة الهدف التحلي بكل المقومات الجمالية، تماماً كما اللغة الأصلية للنص. ذلك أن الترجمة، في نظر المتحمسين لنظرية المعنى، هي تلك التي لا تشبه الترجمة.
لا تكتفي الترجمة الحرفية بإعطاء المدلولات الأكثر شيوعاً للكلمات فحسب؛ إنما تحرم المترجم كذلك، وفقاً لمنتقديها، من فرصة التأمل والتأني لاستنباط مُجمل المعنى. تُشبه النظرية التفسيرية المعنى ببلح البحر (la moule). يقبع هذا البلح داخل الصدف الذي يُمثله الإطار اللغوي. لابدَ،إذن، من كسر هذا الصدف للوصول إلى البلح. ولا يرون أهمية لكيفية الكسر، ولا الطريقة التي يتم بها.
وإذا كانت الترجمة الحرفية ترفض إعطاء المترجم أي قدر من الحرية تُمكنه من الابداع وتبني الاستنتاجات، فإنها بذلك:
” تُنكِر على المترجم ما يُفرِقه عن الآلة، أي تُنكِر عليه الخلق والابتكار وتبني الخيارات الموضوعية. أضف إلى ذلك أن نظرتها لا تتوافق مع ملاحظات علماء اللغة المُعاصرين فيما يتعلق بطبيعة المقابلات الترجمية” (6 ص 71)
نتفق، من جانبنا، مع دعاة نظرية المعني فيما ذهبوا إليه من أن الترجمة الحرفية تحرم المترجم من التأمل اللازم لاستخلاص المرامي الحقيقية للنص. وللدلالة على ذلك نسوق مقطعين شِعريين لشاعر زنجي يتحدى فيهما المُستعمر، ويُهاجِم الاستعمار. يقول:
“Je suis un homme cafre
Je suis le serpent” (7)
تُعطي ترجمة هذين المقطعين حرفياً: ” أنا رجل كافر. أنا الثعبان”
فالمتأمل لهذه الترجمة القاموسية الحرفية، يجد أنها سطحية غير ذات قيمة لأنها تُفرِغ الكلمات من مضمونها وأغراضها الجوهرية. إذ لا يود الشاعر هنا إشهار إلحاده، بقدر ما يود الإشارة إلى أن محاولات المُستعمِر لتنصيره قد باءت بالفشل، ومن أن الاستعمار الذي أتى مُصطحباً للحملات التبشيرية لم يترك أثراً في حياته، إذ لا يزال يعتز بذاته وكينونته. فللفظة ” كافِر” هنا مدلولات عرقية وسياسية، إضافة لبعدها الديني. ثم إن الإشارة للثعبان لا تعدو أن تكون إشارة لقوته التي تُماثل خطر الأفعى في الأحراش الأفريقية. لا يستطيع المترجم معرفة ذلك إلا بالإلمام العميق بسياق النص، والأخذ في الاعتبار المُعطيات اللالغوية كتاريخ الاستعمار وعلاقة المُستعمِر بالمُستَعمر.
أما إذا تناولنا كلمة” كافِر” من منظور لغوي، فستعطينا كذلك بُعداً ما كان ليخطر على بال من يترجِم حرفياً. إذ من حقنا التساؤل: لمً اختار الشاعر هذه اللفظة على وجه التحديد وهي ذات أصل عربي؛ بينما تزخر اللغة الفرنسية بالمفردات التي تدل على الإلحاد بجميع درجاته مثل: (incroyant, irréligieux, mécréant, impie, paÏen, incrédule, infidèle, etc . .)
ونميل للاعتقاد أن الشاعر باستخدامه لكلمة لا تنتمي لأصول لغة المُستعمِر؛ إنما أراد استهجان تلك اللغة التي طالما عقد عليها الغُزاة الآمال في التأثير على مُستعمراتهم فِكرياً وثقافياً.
في نقد النظرية التفسيرية:
إضافة للانتقادات التي ساقها خصومها من أتباع الترجمة الحرفية كما ورد آنفاً، فإن هذه النظرية لم تعط، وهذه إحدى المآخذ التي يأخذها عليها أنصار تيارات تراجم أخرى، لم تعط تعريفاً علمياً دقيقاً للمعنى المُراد نقله. إذ من حقنا التساؤل: هل يتضمن البيت من الشِعر مثلاً معنى واحداً لا يقبل الجدل؟ وهل يجوز تحجيم مرامي الشاعر وقصرها على فهم المترجم فقط؟ وإذا كانت هنالك عُدة معان مُحتملة للبيت، فما الذي يُعطي المترجم الحق في اختيار إحداها واستبعاد الأخرى؟ ثم هل يلتزم المترجم بالإشارة لكل المعاني المُحتملة في سياق ترجمته، أم هل تراه يكتفي بإحداها، واضِعاً البقية في حاشية النص؟ وهل تُعتبر الحاشية أصلاً جزءاً من الترجمة؟ أو لا يُخاطِر المترجم، عندما يورد الكثير من المعاني ويلجأ لاستخدام الحواشي، ألا يُخاطِر بالخروج من دائرة الترجمة والولوج في فرع آخر من فروع المعرفة ألا وهو تحليل النص (analyse textuelle)؟ وإذا فعل ذلك أفلا يُثبت فعلياً مآخذ الترجمة الحرفية القائلة بأن الترجمة التفسيرية تُفسِر ولا تُترجم؟
لإيضاح إشكالية تعدد المعاني تلك سنقوم بتحليل بيت من مُعلقة عمرو بن كلثوم التي يبتدرها بالقول يفتخر بعزة قومه ومنعتهم وشِدة بأسهم وتفردهم بين القبائل:
ألا هُبي بصحنك فاصبحينا = ولا تُبقي خمور الأندرينا
إلى أن يصل في فخره للقول:
ونشربُ إن وردنا الماء صفواً = ويشربُ غيرنا كدراً وطينا
إذا قمنا بترجمة هذا البيت ترجمة حرفية للغة الفرنسية لأعطانا:
“Si nous abordons de l’eau,
Nous la boirons limpide,
Les autres la boiront troublée et boueuse”
لا ريب في أن هذا البيت يطرح أولاً إشكالية حضارية تتمثل في مفهوم” الوِرد”. ذلك أن الجمهور المُستهدف بالترجمة للغة الأجنبية لا يعرف في غالبيته العُظمى عملية السعي للحصول على المياه، إذ تصلهم هذه الأخيرة في دورهم بالأنابيب والصنابير. عليه يتوجب على المترجم شرح مفهوم الورد أولاً. ويزداد الأمر تعقيداً عند العكوف على استنباط المعنى، إذ للبيت معنى ظاهِري سهل تُقدِمه الترجمة الحرفية، ألا وهو الفرق بين صفاء الماء وكدره. معنى سطحي لا يروق لأنصار النظرية التفسيرية، علاوة على أنه لا يخدم الغرض الفخري للقصيدة في شيء، ولا يأتي بسوى مدلول شائع للغة.
قمنا من جانبنا بالتأمل في هذا البيت واستخرجنا منه احتمالية معان عِدة نرى أنها تخدم هدف الشاعر في الافتخار بقبيلته. من تلك المعاني التي جالت بخاطِرنا:
أولاً: نظراً لكثرة عددنا (والبُعد الديمغرافي من دواعي الفخر للقبيلة العربية)، فإننا نحيل الماء حين تغرف منه أكفنا من الصفاء للعكر.
ثانياً: لكثرة أنعامنا (وضخامة الثروة الحيوانية كانت وما تزال تُعطي الثقل الاقتصادي، وبالتالي الوزن الاجتماعي للقبيلة)، كثرتها تُحيل الماء من الصفاء إلى العِكر.
ثالثاً: إننا نصد الآخرين عن الماء عنوة واقتدارا حتى نرتوي وتشرب أنعامنا، وفي ذلك دليل على القوة والمِنعة وشِدة البأس.
رابعاً: إننا من ذوي الهِمم العالية والحيوية والنشاط. ننهض باكِراً حين يغط الآخرون في سُبات عميق. ننهل من الماء وهو في حالة صفاء، حتى إذا الكسالى فاترو الهِمة (يعني القبائل الأخرى)، وجدوه كدراً.
خامساً: إننا نمتلك أفضل البِقاع حيث نقطن في المرتفعات، حتى إذا هطلت الأمطار، حصلنا على ماء صاف. وعندما يسيل هذا الماء إلى الأسفل حيث يقطن الآخرون، يتلوث لاختلاطه بالثرى حيث يتبدل لونه، فيصبح عِكرا.
سادساً: إننا لا نشرب الماء إلا لماما. فنظراً لكثرة أنعامنا وما تجود به علينا من حليب، وما نصنعه بحليبها من ألبان، وبفعل كثرة أشجار أعنابنا ونخيلنا وما نستخرجه من ثمارها من عصائر وشراب، فإننا لا نلجأ لشرب الماء إلا نادراً. نستنبط هذا المعنى إذا ما تأملنا في الفواصل وقرأنا البيت على النحو التالي:
ونشرب، إن شربنا الماء، صفواً
فجملة، إن شربنا الماء، تصبح جملة اعتراضية ترمز لنُدرة الفعل وعدم انتظام واستمرارية الرُغبة في شرب الماء.
سابعاً: إن كلمة” الماء” هنا لا تعني الماء المُتعارف عليه؛ وإنما ترمز لكل مطايب الحياة. فكأنما يود الشاعر القول: إننا نحظى بكل طيب بهيج في شتى مناحي الحياة؛ بينما لا ينال سوانا سوى الغث الهزيل.
ثامناً: إننا من العارِفين الملمين بقواعِد صحة الأبدان، لذا لا نشرب سوى الماء الصافي، أما الآخرون، ولجهلهم بتلك القواعِد، فيشربونه كدراً مُلوثا.
تاسعاً: قد يعني الشاعر كل ما تقدم من معان.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: أي معنى سيختار المترجم المُسترشِد بالنظرية التفسيرية يا تُرى؟
في مسعى للإجابة على التساؤل أعلاه نقول: على المترجم، باديء ذي بدء، حصر كافة المعاني المُحتملة والتركيز عند الترجمة على أكثرها ملاءمة لسياق النص موضوع الترجمة والغرض الذي ينوي الكاتب، أو الشاعر ذيوعه. ولئن حاولنا تطبيق هذا النهج على بيت الشعر الذي قمنا بتحليله للتو، لاتضح لنا بجلاء أن السِمة الغالبة عليه لهي العزة والشجاعة. لذا، فإن أفضل ترجمة له قد تكون في معتقدنا:
“Nous vivons dans l’opulence, parce que nous sommes forts.
Les autres, et à cause de leur faiblesse, vivent la misère et la médiocrité”
ولئن دأب أتباع النظرية التفسيرية على انتقاد أنصار الترجمة الحرفية بسبب عدم اهتمامهم بالمعنى، وتركيزهم على العناصِر اللغوية والتراكيب الاسلوبية، فإننا لا نشاطرهم الرأي تماماً، إذ نرى أن العناصِر اللغوية قد تكون عوناً للمترجم وتمكنه من الالتفات للكثير من المعاني. فإذا حاولنا تحليل نفس البيت السابق من منطلق لغوي أسلوبي لوجدنا:
أولاً: الجملة الاعتراضية، إن وردنا الماء، تضيف معنى جديداً توحي به طريقة مُعينة للقراءة، أي باستخدام الترقيم وهو أداة لغوية قد تؤدي لإضافة معان جديدة.
ثانياً: الدلالة المُستقبلية في استخدام الأفعال (نشربُ ويشربُ)، ما يدعم صفة الاستمرارية ويُعضِد الأسباب التي تدعو للفخر. إذ يود الشاعر الإشارة لدوام الحال هكذا أبد الآبدين: أي سنكون متفوقين على غيرنا دوماً، نشرب النقي، ويشربون الكدِر.
ثالثاً: غياب ” الأنا ” الفردية، واستخدام صيغة الجمع (ونشربُ)، ما يدل على اتحاد الكلمة، وذوبان شخصية الفرد في المجموعة وفي ذلك دلالة على القوة.
رابعاً: بما أن المعطوف عليه يكون دوماً أقوى من المعطوف، فقد استخدم الشاعر حرف العطف (و) لتعزيز مراميه الفخرية.
خامساً: لنتأمل في اختيار الشاعر لكلمة (غيرُنا)، إذ يكون بذلك قد وضع قومه في مرتبة لا تختلف في علوها وتميزها عن مرتبة بقية القبائل فحسب؛ إنما وضع تلك القبائل في مقام الحيوان والنبات التي تحتاج كذلك لشُرب الماء، ذلك أن لفظة (غيرنا) تشير لجميع مخلوقات الله التي تحتاج الماء باستثناء قوم الشاعر.
سادساً: يستخدم الشاعر، عندما يتعلق الأمر بقومه، يستخدم مفعولاً به يقبل الصفة والحال:
” ونشرب إن شربنا الماء صفواً “. فالماء هنا يقبل صفات مثل: زلالاً، عذباً، رقراقاً، سلسبيلاً وغير ذلك، في حين نراه يستخدم للآخرين مفعولاً به لا يقبل صفة ولا حالاً؛ لأنه حال وصفة في حد ذاته. فكلمة ” كدراً ” هي اسم وحال وصفة في ذات الوقت، وينطبق ذات القول على “طيناً “.
سابعاً: تأمل الطِباق، وهو من المحسنات في اللغة العربية (صفواً/ كدراً).
الخــاتـــمـة:
يتضح لنا مما تقدم أن الترجمة الحرفية ترفض تفسير النص؛ بينما لا تُعير ترجمة المعنى بنيته اللغوية وتركيبته الاسلوبية اهتماماً يُذكر. تبين لنا كذلك، ومن خِلال تحليلنا لبيتين من الشعر، تبين لنا أن تحليل النص، سواء بغرض استخلاص معانيه الخفية، أو من منطلق دراسة تركيبته اللغوية، يُعتبر غاية في الأهمية بالنسبة للمترجم؛ لأن ذك يُمكِنه من الفهم الدقيق للرسالة الكامنة في اللغة المصدر، وهو شرط لنقلها بكفاءة ووضوح للغة الهدف. تبين لنا أيضاً أن الترجمة الحرفية، ومن خِلال توفرها على الاهتمام بالتركيبة اللغوية للنص الأصلي وخصائصه الاسلوبية؛ إنما تستنبط بذلك بعض المعاني الكامنة فيه. وأنها، أي الترجمة الحرفية، تُعتبر مُكملة للنظرية التفسيرية، وليست نقيضاً لها. ولعل إسناد نظرية المعنى مهمة تفسير النص لشخص المترجم فقط هو ما دفع بالكثير من المنظرين في مجال الترجمة، وعلى رأسهم موريس بيرنييي، دفعهم للمناداة بإشراك كل مذاهب الترجمة من أجل استنطاق النص، سيما النصوص الأدبية. إذ من المؤكد أنه ليس بوسع تيار ترجمي بعينه الادعاء أن بوسعِه، منفرٍداً، إعطاء الأنموذج المُكتمل، والمنهجية المُثلي.
نقطتان أخيرتان نختتم بهما هذا البحث:
أولاً: ضرورة توفر الحِس الأدبي لمترجِم النصوص الأدبية، الامر الذي سيعينه على اختيار أقرب المعاني التي ينشدها الكاتب. نقول المعنى الأقرب، لأن المعنى الحقيقي يتعذر إدراك كنهه، وسبر أغواره. ذلك لأن تجربة الابداع الأدبي مُمعنة في الذاتية، تتسم بالخصوصية، وتتعلق بمشاعر مُختلطة مُتباينة تبايناً قد يصل لدرجة التنافر. وتتم مرحلة الابداع ذاتها عبر عملية مُخاض يجهلها الأديب نفسه أحياناً.
ثانياً: أن يفرد المترجم وقتاً للبحث بغرض تجويد الأداء، وألا يكتفي بأن يكون صدى باهِتاً للنص؛ وإنما يلعب دوره كموصِل جيد لرؤى الكاتب، دون إغفال لوضوح الرؤية فيما يتعلق بالقراء.
* بروفيسور بابكر ديومة
أستاذ الترجمة والنقد الأدبي/ جامعة الملك سعود
ثبت المراجع
(أ) مراجع تمت الإشارة إليها في متن البحث:
Abul A’la Mawdudi-Towards understanding Islam, L.I.S.O, 1968,P.25 (1)
(2) Newmark (P.) – Textbook of Translation. New York,1988, pp.45-46
(3)Herbulo (F.) -Le Traducteur Déchiré, Minard,Paris,1990
(4)Pergnier(M.)-L’équivalence en traduction,Meta,1987
(5) Seleskovitch(( Danica) – Langage, langues et mémoire,Paris, 1975
(6) Déjean (K.) – Qu’en est-il au juste du transcodage en traduction écrite?,Traduire ,1987
(7) Damas(L.) -Poètes d’expression française, Seuil,1947
مراجع عامة بالفرنسية:
(1) Delisle (J.) -L’analyse du discours comme méthode de traduction, Ottowa,1980
(2) Hurtado (A.) – La notion de fidélité en traduction, Didier,1990
(3) Nida (E.)etTaber (C.)-La Traduction :Théorie et méthode, Londres; 1971
(4) Pergnier (M.) – Les fondements Sociologiques de la traduction, Paris,1978
(5) Seleskovitch (D.) et Lederer (M.) – Interpréter pour traduire, Paris, 1984
مراجع عامة بالإنكليزية :
(1) Nord (C.) -Text analysis in Translation, Amsterdam,1990
(2)Wilss (w.) -Towards a multi-facet conception of translation behavior, Meta; 1989