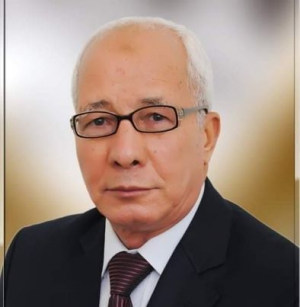تهدف هذه الدراسة إلى رصد تطور »الشعر المنثور« في العالم العربي ابتداء من 1905 وهي السنة التي نشر فيها أمين الريحاني أول قصيدة في الشعر المنثور، هذا الأخير استطاع بفعل حركة التحديث الشعري أن يبحث عن كتابة مغايرة للقصيدة العربية وتسمية جديدة، يتطلبها الزمن الحديث من أجل بناء الخطاب الشعري الذي كان مواكبا للحداثة الشعرية العالمية والإبدالات النصية الجديدة التي عرفتها القصيدة. فقد كان للتأثير الأوروبي دور فعال في ظهور هذا الجنس الشعري، إذ أن تمرد الشعراء على شكل القصيدة العمودية كان نتيجة احتكاك العرب بالشعر الأوروبي مما أدى إلى خلق أشكال جديدة كالشعر المنثور وإن كان استخدام هذا المصطلح يثير الكثير من الاضطراب والغموض والتداخل، في العالم العربي، ويثير العديد من الأسئلة.
فما هو مفهوم الشعر المنثور في العالم العربي؟ وكيف يمكن للنص أن يكون شعرا ونثرا في الآن نفسه؟ وما الذي طرأ على بنية الشعر حتى قرب من النثر؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر؟ وهل يتعلق الأمر بكتابة شعر بالنثر أم نثر بالشعر؟ ولماذا البحث عن قالب مختلف للشعر خارج الشعر؟ وهل الشعر المنثور خرق للحدود الأجناسية؟ وما هي المميزات النثرية في الشعر العربي والتجليات الشعرية في النثر العربي؟ ولماذا حصل هذا التداخل بينهما؟ ولماذا سلمنا بشعرية النثر رغم تخليه عن كثير من خصائص الشعر؟ وما هو الفرق بين الشعر المنثور في أوروبا وفي العالم العربي؟ وما هي وضعية الشعر المنثور في الآداب العالمية؟ وهل نجح النقاد في تصنيف الشعر المنثور كجنس مستقل بذاته؟ وكيف نصنف نصا ما أنه شعر منثور؟ ولماذا تعددت مصطلحاته؟ ولماذا اتصف بالغموض والخلط؟ وهل هو خلط مصطلحي أم خلط مفاهيمي؟ وهل الشعر المنثور نموذج التحديث الشعري في العالم العربي؟ ولماذا لم يفكر المغاربة بالشعر المنثور إلا في نهاية الأربعينيات؟ ولماذا العودة إلى الشعر المنثور في عصرنا؟ ألم يلعب الشعر المنثور دورا في تقريب الشعر من النثر؟ ولماذا لا يتحدث النقاد عن الشعر المنثور؟ ولماذا رفض بعضهم هذا الشعر؟ ومن هم الشعراء المحدثون الذين كان لهم لواء السبق في هذا الشعر؟ ولماذا لم يعد مصطلح الشعر المنثور شائعا ومتداولا؟ وهل اختفت دلالته التي صيغ من أجلها؟ أم أن المتخصصين لم يعودوا بحاجة إلى هذا المصطلح؟
هذه الأسئلة في الحقيقة هي ما يحدد موجهات اختيار الموضوع، وهي أسئلة تصل بنا إلى أن الشعر المنثور كجنس شعري ليس بديلا للقصيدة العمودية، ولكنه جنس شعري، جاء ليثبت حضوره الخاص وشعريته بفعل الإبدالات النصية الجديدة التي عرفتها القصيدة بفعل حركة التحديث الشعري، وما أريد أن أوضحه هو أن بحثنا لا يقتضي فقط التعريف بالشعر المنثور وخصائصه ومميزاته، فالشعر المنثور تعرفه كل الأمم الراقية إلا أن مصطلح »الشعر المنثور« في العالم العربي يطرح إشكالات متعددة أهمها عدم توحيد المصطلح في الممارسة النصية الرومانسية، لذلك آثرت تحديد مفهوم المصطلح عند أعلامه والوقوف على بعض نماذجه، وما طرحه هذا المصطلح من إشكال في الساحة النقدية، والظروف التاريخية التي هيأت لظهور هذا اللون من الشعر. وتعد مشكلة المصطلح أهم مشكلة واجهتها حتى خشيت أن تتحول هذه الدراسة من بحث نظري إلى بحث في المصطلح ونهج منهج الدراسة الأدبية المقارنة.
الشعر المنثور في العالم العربي يستخدم في تسمية أجناس أدبية متعددة ولعل هذا راجع إلى مسألة الترجمة غير الدقيقة، وقد استعمل الشعراء العرب الأجناس الأدبية الأوروبية كالشعر الحر والشعر المرسل وهي أجناس ذات تعريفات محددة في الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي. أما في الشعر العربي فقد وظف الشعراء في تعريفه طائفة مختلفة من المصطلحات حتى أصبح المصطلح الواحد يطلق لتسمية أجناس أدبية مختلفة نتيجة عدم اهتمام العديد من الشعراء بكيفية توظيف هذه المصطلحات عند شعراء آخرين، وقد حاولت تتبع مصطلح الشعر المنثور عند أعلامه والرجوع إلى المصطلح في أصله الإنجليزي والفرنسي كما فهمه الشعراء العرب.
نجد أن مصطلح الشعر المنثور يستخدم في مقابل ما يسمى في الأدب الإنجليزي poetey in prose« وكذلك في مقابل »الشعر الحر free verse« بالمفهوم الأمريكي الإنجليزي. وهنا نتساءل لماذا لم يحتفظ العرب بالمصطلح الدخيل وعمد معظم الشعراء والنقاد إلى التعريب ؟
هنا يطرح السؤال كيف نعثر على تسمية لجنس أدبي خارج سياق الثقافة العربية؟ ولماذا لم نحتفظ بنفس الكلمة الأجنبية؟ وإذا أردنا الاحتفاظ بنفس الكلمة ألا نصطدم بمسألة الثقافة العربية؟ لأن مشكلة المصطلح في اللغة العربية هي مسألة تتعلق بمشكلة السياق الثقافي كما أن ترجمة المصطلح هو نقل للمعرفة وليس نقلا للمصطلح في حد ذاته، ولهذا يعجز المصطلح في بعض الأحيان بعد جرده من سياقه الأصلي وتوظيفه في سياق جديد تحكمه ثقافة جديدة مختلفة.هكذا نجد أنفسنا أمام قضية ترجمة المصطلحات الحديثة التي نجد لها أبعادا دلالية وإيديولوجية في لغاتها الأصلية، فمن الصعوبة بمكان تجريدها من هذه الدلالات وإخضاعها لدلالات جديدة في سياق الواقع اللغوي في الثقافة العربية ولعل هذا ما جعل طه حسين يتمسك بمصطلح النثر الفني في فضاء عربي يتماشى مع اللغة الإيديولوجية السائدة.
إن كل مصطلح يرتبط في نشأته بالشخص الذي استعمله أول مرة، ومصطلح الشعر المنثور ارتبط في نشأته الأولى بأمين الريحاني. لكن لماذا تخلى الشعراء عن ترجمة الريحاني »الشعر المنثور« دون توضيح أسباب التخلي؟ أهو اختلاف في المدارس والاتجاهات ؟ أم أن الترجمة الثانية كانت أكثر صوابا وضبطا من الأولى؟ ولماذا لم يحتفظ الريحاني بالمصطلح الدخيل ?534;اللفظ الأجنبي?535; وعمد إلى التعريب؟ وهل يضير اللغة العربية أن تستخدم بعض المصطلحات في صيغة التعريب كما فعل شعراؤنا؟ وفي هذه الحالة ألا نجد صعوبة جمة في إيجاد ترجمة حرفية لهذه المصطلحات؟ وإذا ما قبلنا المصطلح كمصطلح دخيل إلى اللغة العربية ألا نجد بأن هذه المصطلحات الشعرية الأجنبية قد يكون لها معنى محدد في لغتها بينما لا نجد لها نفس المعنى في لغتنا أو قد تؤدي إلى ضلال المعنى؟
لا أريد لهذا العمل أن ينهج منهج الدراسة المقارنة، أو أن يكون تأريخا للشعر المنثور في العالم العربي بقدر ما ينظر في خصائص هذا الشعر، ومقوماته، كجنس شعري، وإعادة النظر في تسميته وفي مسألة ترجمة المصطلحات الحديثة لأن الترجمة غير الدقيقة تؤدي إلى الفهم الغامض لمعناه. وقد شغلنا في هذا العمل بعض الأسس النظرية للشعرية اللسانية بتوظيف »القيمة المهيمنة« »la valeur dominante« لـ»جاكوبسون« لتصنيف هذا الجنس الشعري وتعريفه، فقد لخص جاكوبسون في كتابهEssais de linguistique générale الوظائف التي تقوم بها اللغة في ست وظائف:
- الوظيفة المرجعية (أو الإحالية) (Fonction Référentielle)
- الوظيفة التعبيرية (أو الانفعالية) (Fonction Emotive)
- الوظيفة الطلبية (Fonction Conative)
- الوظيفة الشعرية (Fonction poétique)
- الوظيفة التنبيهية (Fonction Phatique)
- الوظيفة اللغوية الواصفة (Fonction Métalinguistique)
وقد اهتم »ياكبسون« بالقيمة المهيمنة la valeur dominante التي سأحاول توظيفها في هذا العمل للنظر في مستوى فاعلية المقومات الشعرية التي ستتحدد من خلال العنصر الشعري المهيمن في الخطاب لتصنيف هذا الجنس الشعري وتوضيحه بالاشتغال على نصوص يهيمن فيها الشعر والنثر.
ونحن ننجز هذا العمل واجهتنا مشاكل وصعوبات نذكر أهمها:
٭ مشكلة المصطلح، فالشعر المنثور عند الريحاني ترجمة للمصطلح الفرنسي »vers libre« والإنجليزي »free verse« وهو شعر يقوم على الإيقاع النثري أكثر من الإيقاع الوزني، ويجعل له الريحاني »وزنا جديدا مخصوصا، وقد تجيئ القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة.«(1) وهو تعريف ضعيف مما أدى إلى عمومية مفهوم المصطلح في الثقافة العربية، ورفض معظم النقاد لمصطلح الريحاني، باستعمال مصطلحات بديلة أدت إلى غموضه وإشكالية التلقي؛
٭ كثرة المصطلحات التي تطلق على الشيء الواحد. ولعل هذا راجع بالأساس إلى عدم اطلاع الشعراء والباحثين على المصطلحات التي استعملها الآخرون أو من سبقوهم؛
٭ عدم نقل المصطلح الأوروبي إلى اللغة العربية بكيفية سليمة؛
٭ القواميس العربية تكاد تخلو من مصطلح الشعر المنثور لكن مصطلح الشعر المرسل blank verse موجود بكثافة في مصطلحات اللغة الإنجليزية، ومصطلح الشعر الحر vers libre موجود كذلك بكثافة في مصطلحات اللغة الفرنسية.
٭ غياب الدراسات النظرية التي تهتم بالموضوع كانت سببا في صعوبة الإحاطة بالجانب التوثيقي، لأن الموضوع كان موزعا في مجلات، عانيت كثيرا من أجل الحصول على بعضها، والوقوف على نصوص نظرية وشعرية لأقطاب الشعر المنثور كأمين الريحاني، وجبران خليل جبران، وأحمد زكي أبو شادي، ومحمد الصباغ. إلا أنني لم أحصل على بعض المجلات المهمة في الموضوع »كمجلة المعتمد«، فلم يسمح لي مجال الإفاضة في ذكر نماذج لشعراء مغاربة كإدريس الجاي، ومحمد عزيز لحبابي وغيرهم من الشعراء. وهذا يوضح ما يعانيه الباحث من صعوبة الإحاطة بالجانب التوثيقي في الشعر العربي الحديث. لذلك اعتمدت على أربع مجلات أساسية وهي: مجلة »أبوللو«، ومجلة »الأديب«، ومجلة »الرسالة«، ومجلة »الكاتب«. بعد أن اطلعت على مجلات متعددة لم تهتم بالموضوع »كمجلة الشعر«، و»الأديب«، و»رسالة الأديب«، و»الأديب المعاصر«، و»الثقافة المغربية«، و»الحياة الثقافية«، و»الثقافة الجديدة«، ومجلة»آفاق«، و»أقلام«، و»علامات في النقد«، و»فكر ونقد«، و»كتابات معاصرة«...
اقتضت طبيعة الدراسة أن نحدد الإطار النظري الذي يدور حوله الحديث عن الشعر والنثر بتحديد مفهومهما في اللغة والأدب والفرق بينهما وترجيح النقاد بعضهما على الآخر، والخصائص اللغوية لكل منهما تمهيدا لدراسة مصطلح الشعر المنثور وما يثيره من إشكال عند النقاد والأدباء في العالم العربي. فالحديث عن الشعر والنثر هو بداية الحديث عن مسألة الأجناس الأدبية، وفي مصطلح »الشعر المنثور« نجد تلازما بين المنظوم والمنثور، مما استدعى البحث في حفريات هذا المصطلح.
أما المحور الثاني حاولت الوقوف فيه على أعلام الشعر المنثور كأمين الريحاني الذي ينعته النقاد بأبي الشعر المنثور وأحمد زكي وأبو شادي، وأحمد شوقي، وجبران خليل جبران، ومحمد الصباغ. وفي عرض النماذج حاولت توظيف »القيمة المهيمنة« la valeur dominante للنظر في مستوى فاعلية المقومات والمميزات الشعرية التي ستتحدد من خلال العنصر الشعري المهيمن في الخطاب والذي يؤثر في العناصر الأخرى. لنوضح هيمنة قيم جمالية كانت سائدة مرحلة انتشار الشعر المنثور، كما سنوضح ما يميز نصوص هذه المرحلة عن غيرها من النصوص وذلك بالاشتغال على نصوص يهيمن فيها الشعر والنثر، وقد تخضع لتصنيفات متعددة تحيل على الشعر المنثور.
في المحور الثالث سأحاول تقديم تصور عام حول الحداثة الشعرية، ويضم تقسيما رباعيا يوضح علاقة الشعر المنثور بحركة التحديث الشعري وبالحداثة الشعرية العالمية التي كانت سببا مباشرا في ظهور هذا الجنس الشعري عند بعض النقاد بالإضافة إلى إبراز سلطة النص المقدس وما كان له من تأثير على شعر هذه المرحلة، مع أخذ عينة من النصوص التي تحيل على الشعر المنثور لتوضيح الإبدالات النصية الجديدة في القصيدة العربية التي أصبحت تخضع لتصنيفات متعددة.
أ - الشعر المنثور والتحديث الشعري:
.1تحديد المصطلح:
1-1. مفهوم الشعر في اللغة:
جاء في القاموس: شَعَرَ- شِعْرًا وشَعْراً الرجل: قال الشعر، ولفلان: قال له شعرا. شَاعَرَه فشعره: غالبه في الشعر فغلبه. تَشاَعَر:تكلف قول الشعر وأرى من نفسه أنه شاعر.الشِّعْر: (مص) ج أَشْعار: كلام يقصد به الوزن والتقفية. الأَشْعَر: يقال هذا البيت اشعر من هذا أي أحسن منه. الشاعِر(فا) ج شُعَراء م شاعِرة ج شَوَاعِر وشاعِرات: قائل الشعر. شِعْرٌ شَاعِرٌ: جيد. الشُّعْرُور ج شَعَارِير، الواحدة »شُعْرُورَة«: الشاعر الضعيف جدا.(2) وجاء في معجم الأجناس والمفاهيم الأدبية أن تشكيلة البيت كانت، ولمدة طويلة، هي الخاصية الأساسية للشعر(...) إلا أن التطور الحديث يدفع إلى عزل الشعر عن البيت.(3) يضم تشكيل البيت الفرق والتكافؤ، ويكون الترجيح للتكافؤ في الصيغة الموزونة لدرجة أنّ ياكوبسون رأى فيه أساس اشتغال الخطاب الشعري.(4)
ويلاحظ من خلال هذه التعريفات أن الوزن هو المعيار الأساسي لعزل الشعر عما ليس شعرا، وقد أطلق العرب على كل علم شعرا، وإن غلب هذا المصطلح على كل كلام منظوم موزون مقفى، وعرفه العروضيون منذ الخليل بن أحمد البصري، بأنه الكلام الموزون على مقاييس العرب، أي الوزن المرتبط بمعنى وقافية.
2-1 مفهوم الشعر في الأدب:
اهتم القدماء بدراسة الشعر وتمييزه عن النثر، فابن طباطبا جعل الشعر نظما للنثر. والنظم عنده هو تخير اللفظ والوزن والصياغة، جاء في تعريفه للشعر »الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجَّته الأسماع، وفسد على الذوق. ونظمه محدود معلوم، فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه.«(5) وأهم ما في هذا التعريف كما يرى جابر عصفور هو »أنه يحدد الشعر على أساس الانتظام الخارجي للكلمات، صحيح أن التعريف لا يشير صراحة إلى القافية إلا أنها متضمنة فيه«(6) وبذلك يكون النظم والنثر قد ساهما في»تأليف العبارة«، يقول ابن وهب(7): »واعلم أن سائر العبارة في لسان العرب إما أن يكون منظوما أو منثورا. والمنظوم هو الشعر والمنثور هو الكلام«.
أما قدامة ابن جعفر فقد عرف الشعر على أنه »قول موزون مقفى يدل على معنى«(8). وجعل التسجيع والتقفية بنية للشعر، هي التي تخرج به عن مذهب النثر. فالوزن عنده، كما عند ابن طباطبا، يميز الشعر من النثر، إلا أنه لا يكفي وحده، إذ يتطلب الشعر تناسبا لا يتطلبه النثر. فالتناسب، وإن كان مصطلحا غير دقيق ولا يكفي بأغراض نقدية واضحة، كان هاجس النقاد العرب جميعا، وكأنهم كانوا يحدسون بعناصر متناقضة للشعر ينبغي على الشاعر أن يؤلف فيما بينها بشكل يوفر لها الانسجام. لقد عبر قدامة عن هذا التناسب بكلمة التآلف، فلما عرف الشعر وجعله قائما على أربعة عناصر هي: »الأربعة المفردات البسائط التي يدل عليها حده، والأربعة المؤتلفات: ائتلاف اللفظ مع المعنى، ائتلاف اللفظ مع الوزن، ائتلاف المعنى مع الوزن، ائتلاف المعنى مع القافية«. ولهذا التقسيم تعليل منطقي يسهم قدامة في تفصيله، إسهابا يتوخى الدقة، ولا يسلم من التعقيد.(9) واعتبر ابن رشيق »الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية«(10). وجعل حازم القرطاجني »الأوزان مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة جوهره«(11). ومن الأدباء في العصور الموالية من جعل الاستعارة أهم مقومات الشعر، فابن خلدون عرف الشعر بقوله »الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة، والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة«(12). وهكذا يبقى الوزن أهم مقومات الشعر. وقد تعرض محمد بنيس لقضية الوزن في مؤلفه (الشعرالعربي الحديث بنياته وإبدالاتها) يقول: كان قدامة يعرف الشعر بالقول الموزون المقفى الدال على معنى، ولكن وظيفة (أو وظائف) كل عنصر من هذه العناصر تنبه لها النقد العربي لاحقا. هكذا نرى المرزوقي يتناول الوظيفة النفسية في مقدمته لكتاب »شرح ديوان الحماسة« قائلا: »وإنما قلنا« على تخير من لذيذ الوزن »لأن لذيذه يطرب الطبع لإيقاعه، ويمازجه بصفائه، كما يطرب الفهم لصواب تركيبه، واعتدال نظومه« وهذه الوظيفة النفسية هي التي ستأخذ بعدا آخر عند حازم المتأثر بالفلاسفة المسلمين وترجمة الشعرية لأرسطو.«(13)
ويضيف محمد بنيس أن علو الأوزان في مختلف الثقافات كان عليه أن ينتظر الشكلانيين الروس لانفجار تصور مغاير، فهذا يوري تينيانوف يرى أن مبدأ الوزن »مؤسس على إعادة تجميع حركي للأداة اللفظية بحسب خصيصة نبرية. وبالتالي فإن أبسط ظاهرة وأهمها ستكون هي عزل مجموعة وزنية كوحدة، وهذا العزل هو في الوقت نفسه تصميم حركي للمجموعة الموالية، شبيهة بالأولى (ليست مطابقة لها، بل شبيهة بها)، وإذا انحسم التصميم الوزني فإننا نجد أنفسنا أمام نسق وزني، وإعادة التجميع الوزني تتم:
1) عبر تصميم وزني حركي - متتابع
2) بواسطة الحسم الوزني الحركي المتزامن الذي يؤالف بين الوحدات الوزنية في مجموعات أعلى هي الكيانات الوزنية. إضافة إلى أن العملية الأولى بطبيعة الحال ستكون المحرك المتقدم لإعادة التجميع، والثانية هي المحرك المتراجع. وهذا التصميم، وهذا الحسم (وفي الوقت نفسه هذه الوحدة) يمكنهما أن يؤثرا عمقيا ويمارسا تفكيكا للوحدات إلى أجزاء (القاسمة التفعيلة)، ويمكنهما أن يؤثرا في المجموعات العليا ويشعرانا بالشكل الوزني (السوناتة والأدوارية كأشكال وزنية). فهذه الخصيصة الإيقاعية المتقدمة - المتراجعة للوزن هي من بين الأسباب التي تجعل منه أهم مكون للإيقاع.«(14)
ويذكر محمد بنيس أن هذا التصور الحديث لقراءة الوزن »يعارض المفهوم القديم العربي وغير العربي، لوظيفة الوزن التزيينية والانفعالية المستقلة عن وظيفته البنائية للبيت والقصيدة برمتها، ثم الوظيفة البنائية لدلالية النص الشعري«(15)
وقد لقيت القافية انتقادات عنيفة من طرف الشعراء القدماء والمحدثين، لذا جاء تصنيف النقاد للمزدوجات والموشحات والمخمسات، على سبيل المثال، عند القدماء والشعر المنثور والشعر المرسل وقصيدة النثر إلى غير ذلك من التصنيفات في الشعر الحديث وهي نماذج تخلى فيها أصحابها عن ضرورة التقفية.
يرى محمد بنيس في تعريف الشعر بالقافية: »وهو النادر، لأننا لا نعثر إلا على أقوال متناثرة لبعض من يخص القافية دون غيرها من العناصر الأخرى. ومثاله رأي ابن سيرين الذي قال:« الشعر كلام عُقِد بالقوافي، فما حسن في الكلام حسن في الشعر، وكذلك ما قبح منه«(16).
من النقاد من يرى الأوزان والقوافي مظهرا للنظم لا للشعر »إذ قد يكون الرجل شاعرا ولا يحسن النظم، وقد يكون ناظما وليس في نظمه شعر. وإن كان الوزن والقافية يزيدان الشعر طلاوة، ووقعا في النفس، فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعر ويجوز سبكه في النثر«(17).
وقد رفض أصحاب الشعر المنثور هذا التعريف المتداول للشعر، فالوزن والقافية يقيد الشعر وهو ليس مقوما ضروريا، يقول أمين الريحاني: »فإذا جعل للصيغ أوزان وقياسات تقيدها تتقيد معها الأفكار والعواطف، فتجيء غالبا وفيها نقص أو حشو أو تبذل أو تشويه أو إبهام، وهذه بليتنا في تسعة أعشار الشعر المنظوم الموزون في هذه الأيام«(18). ويرى شعراء العصر الحديث أن الوزن والقافية أمر زائد على جوهر الشعر، يقول أدونيس »الشعر هو الكلام الموزون المقفى، عبارة تشوه الشعر فهي العلامة والشاهد على المحدودية والانغلاق وهي إلى ذلك معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها، فهذه الطبيعة عفوية، فطرية، انبثاقية وذلك حكم عقلي منطقي«(19). لهذا دعا الشعراء إلى تجاوز معايير القصيدة وتأسيس كتابة جديدة لا تلتزم بمراسم ومعايير الشعر العربي.
وقد تحدث ادريس بلمليح في مؤلفه (المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب) عن مبنى الشعر ومبنى النثر موضحا الفرق بين الشعر والترسل مستدلا بتحديد المرزوقي:»إن مبنى »الترسل« على أن يكون واضح المنهج، سهل المعنى، متسع الباع، واسع النطاق، تدل لوائحه على حقائقه وظواهره على بواطنه، إذ كان مورده على أسماع مفترقة (...) فمتى كان متسهلا متساويا، ومتسلسلا متجاوبا تساوت الآذان في تلقيه.« أما مبنى الشعر عند المرزوقي فعلى »العكس من جميع ذلك لأنه مبني على أوزان مقدرة، وحدود مقسمة، وقواف يساق ما قبلها إليها مهيأة، وعلى أن يقوم كل بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضمنا بأخيه، وهو عيب فيه. فلما كان مداه لا يمتد بأكثر من مقدار عروضه وضربه، وكلاهما قليل، وكان الشاعر يعمل قصيدته بيتا بيتا، وكل بيت يتقاضاه بالاتحاد، وجب أن يكون الفصل في أكثر الأحوال في المعنى وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه، والأخذ من حواشيه حتى يتسع اللفظ له فيؤديه على غموضه وخفائه« ويعلق ادريس بلمليح على أن التركيب الشعري عند المرزوقي »تركيب وزني إيقاعي، قائم بفسه، ولا مجال فيه للخلط بين الوحدة التركيبية التي تحدد خطاب النثر، وهي الجملة، والوحدة التركيبية التي يقوم عليها الخطاب الشعري، وهي البيت الذي لابد من أن ينتهي معناه بانتهاء مبناه، أي بمجيئ القافية.«(20)
ويضيف ادريس بلمليح في سياق حديثه عن التركيب الشعري أن مبنى الشعر، عند المرزوقي، نظام للتوازي »تفرضه مكونات الوزن على مكونات اللغة المنجزة في إطار الرسالة الشعرية« لأن مبنى الشعر يختلف كثيرا عن اللغة العادية وعن مبنى النثر الفني لأن نظام الشعر قائم على الوزن.(21) أما طه حسين فيرى أن الشعراء قد جددوا في »أوزان الشعر وقوافيه كما جددوا في صوره ومعانيه ملائمين بذلك بين شعرهم وحضارتهم، وقد لعب شعراء المغرب العربي بأوزانه وقوافيه ما شاء لهم اللعب. فاستحب الناس وما زالوا يستحبون لعبهم ذاك«(22). ويضيف »لم يعرف الشعر اليوناني القديم قافية ولم يعرف الشعر اللاتيني قافية وأبيح لكليهما رغم ذلك من الروعة والخلود ما لا يرقى إليه الشك. فليس على شبابنا من الشعراء بأس في ما أرى من أن يتحرروا من قيود الوزن والقافية إذا نافرت أمزجتهم وطبائعهم (...) وما أحر تشوقنا إلى لون جديد من هذا الفن الأدبي الرفيع يرضي حاجتنا إلى تصوير جديد للجمال.«(23)
يرى محمد غنيمي هلال في سياق حديثه عن موسيقى الشعر أن الإيقاع قد يتوافر في النثر، فيما يسميه قدامة بـ»الترصيع« »وقد بلغ الإيقاع في النثر درجة يقرب بها كل القرب من الشعر، أما الإيقاع في الشعر فتمثله التفعيلة في البحر العربي.«(24)
ويرى محمد بنيس أن الفلاسفة المسلمون أول من تبنى تعريف الشعر بالفصل بين الوزن والقافية متأثرين بكتاب »الشعرية« لأرسطو والشعر اليوناني، فجاء تعريف ابن سينا مميزا الشعر عند العرب وغيرهم، يقول:»إن الشعر هو كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة.«(25) أما الفارابي فقد قارن بين شعر العرب وغيرهم، يقول: »وأشعار العرب في القديم والحديث فكلها - ذوات قواف، إلا الشاذُّ منها، وأما أشعار سائر الأمم الذين سمعنا أشعارهم فجلها غير ذات قواف. وخاصة القديمة منها، وأما المحدثة منهم فهم يرومون بها أن يحتذوا في نهاياتها حذو العرب.«(26)
أما الدراسات الشعرية الغربية الخاصة بالشعر ومفهومه فلم تعط للشعر تعريفا موحدا، ويؤكد ج. ل. جوبير أنه »يصعب إعطاء تعريف موحد للشعر نظرا للتنوع الأقصى للأشكال والوظائف.«(27) مما يدل على أن هناك تصورات متعددة ومتغيرة لمفهوم الشعر، وهي تصورات ستستمر في الوجود من نص إلى آخر، مما يدل أن كل قصيدة جديدة يمكنها أن تضع محل السؤال تعريف الشعر نفسه.(28)
نستخلص من حديثنا عن مفهوم الشعر أن:
٭ الوزن هو المعيار الأساسي لعزل الشعر عن النثر.
٭ رفض أصحاب الشعر المنثور للتعريفات المتداولة، إذ رأوا أن الوزن والقافية يقيد الشعر، لذلك فهو ليس مقوما ضروريا.
٭ اختلاف الدراسات العربية والغربية في إعطاء تعريف محدد للشعر.
٣-١مفهوم النثـر في اللغة:
نثر الشيء: رماه متفرقا، والنثر خلاف النظم من الكلام(29) .
نثر الكلام: أكثره(30) .
النثري ومنثور: prose, prosaic;in prose; خلاف منظوم.(31)
جاء في لسان العرب. »هو النثرة أي الخيشوم وما ولاه، أو الفرجة بين الشاربين حيال وترة الأنف، أو الدرع الواسع، ونثر أنفه أخرج ما فيه من الأذى، ونثرت النخلة أخرجت ما في بطنها«
يعرف القاموس المحيط للفيروز آبادي كلمة »نَثَر« بنثر الشيء ينثُرُه نثْرا ونثاراً، رماه متفرقا كنثْرِهِ، فانتثر وتنَثَّر وتناثر والنثارةُ والنثَرُ ما تناثر منه، ما ينتثر من المائدة فيؤكل للثواب، وتناثروا مرضوا فماتوا، ونثر الكلام والولد أكثره، ونثر ينثر نثرا أو استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك من نفس الأنف كانتثر. توحي هذه المعاني جميعا بالتبعثر واللاتناسق لهذا سمي النثر نثرا لأن شكله يوحي بعدم التناسق عكس الشعر الذي يتميز بشكل واضح لأنه يتقيد بالوزن والقافية.
وفي المعجم الوسيط »يقال رجل نثر، مذياع للأخبار وللأسرار، والنثار والنثارة ما تناثر به الشيء.«(32) والمعجم الوسيط يقترب من المفهوم الأدبي لأنه »المنثور الكلام المرسل غير الموزون ولا المقفى، وهو خلاف المنظوم، والناثر من يجيد الكتابة نثرا، والنثر الكلام الجيد يرسل بلا وزن ولا قافية، وهو خلاف النظم، ويقال كلامه در نثير.«(33)
»النثر في الكلام لا يشبه النثر للحب، تلقيه كما اتفق بذارا، أو للطير، بل هو نظيم في مسلك العقل، والرؤية، منسوقا بنظام، تعبيرا عن خواطر ومواجيد، يقصد به الإبانة عن قصد، قد يجيئ مباشرا يساق لغرض الإفصاح عن فكرة، وقد يساق منمقا، متناغما، لغاية جمالية إلى جانب المقصود من إيراده.
وبذا يختلف النثر عن الشعر بأنه نميقة العقل، أو رغيبة الإبانة، بينما الشعر ينطلق من مناخ نفسي داخلي يسمى الحالة، وينسام على نسائم العاطفة، وأجنحة الخيال. النثر لمناخ النفس وأجوائها في المنطلقات الخارجية.
والشعر ينسل من داخل النفس ويدور في فلكها العميق، أو يتجنح للمدى القصي الأبعد«(34)
٤-١ مفهوم النثـر في الأدب:
لم يكن اهتمام الأدباء والنقاد بالشعر بأقل من اهتمامهم بالنثر والنظر في مفهومه ومقوماته وإن لم يصلنا منه إلا القليل. يرى ابن رشيق: أن ما ضاع من الموروث النثري أكثر كثيرا مما ضاع من الموروث الشعري»وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطيب أعراقها، وذكر أيامها الصالحة (...) فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره.«(35)
يرى محمد مندور أن »الإنسان عندما تعلم اللغة كان يتكلم نثرا للتعبير عن حاجات حياته، وللتفاهم مع غيره من البشر، والفرق كبير بين لغة الكلام النثرية، وبين النثر الأدبي، وأقدم النصوص التي وصلتنا نصوص شعرية لا نثرية، فالشعر تحفظه الذاكرة، والشعر أسهل حفظا من النثر، ولذلك وعت الذاكرة النصوص الشعرية، بينما لم تع النصوص النثرية كالخطب وغيرها، وتناقل البشر محفوظهم الشعري حتى اخترعت الكتابة، وبدأ عصر التدوين، فدونت أول الأمر الأشعار المحفوظة، ولذلك نطالع دائما في كتب الأدب أن الشعر أسبق ظهورا من النثر الأدبي«.(36)
وهكذا نلاحظ أن مفهوم النثر يختلف عن مفهوم الشعر، كما أن أقدم النصوص التي وصلتنا شعرية لا نثرية، لسهولة حفظ المنظوم عن المنثور. لذلك كان الشعر أسبق ظهورا من النثر الأدبي.
2- الفرق بين الشعر والنثـر:
لم يكن التفريق بين النثر والشعر واضحا عند العرب القدماء. وقد وصف عرب الجاهلية النثر القرآني بأنه شعر، ونجد انتقادا للشعر والشعراء في القرآن الكريم »والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون«(37). ويقول تعالى: »وما علمناه الشعر وما ينبغي له«(38). إلا أن النقاد لم يصنفوا القرآن الكريم لا نثرا ولا شعرا، فطه حسين يرى أن القرآن ليس شعرا ولا نثرا وإنما هو قرآن، ويرى صفاء خلوصي أن القرآن »ليس شعرا ولا نثرا إنما هو كلام سماوي إيقاعي أجمل من الشعر والنثر معا«(٩٣). ويضيف أنه لولا هذا الإيقاع الخاص بالقرآن الذي لا يجاريه أي إيقاع شعري أو نثري لما أمكن تجويده، لأن التجويد ضرب من الغناء الديني فالتفاعيل الرائعة التي تزدوج بعضها مع بعض فتؤلف هذا التأثير القوي المنسق الذي لا نجد له مثيلا أو ضربا. وهذا الإيقاع في الآيات المكية أقوى منه في الآيات المدنية.
ميز الشيخ شمس الدين النواجي في كتابه »مقدمة في صناعة النظم والنثر« بين كل من النظم والنثر والشعر فرأى أن النظم هو الكلام الموزون في الموازين العربية، وقد جمعها الخليل بن أحمد ورتبها في خمسة عشر بحرا وهي: الطويل، المديد، البسيط، الوافر، الكامل، الهزج، الرجز، الرمل السريع، المنسرح، الخفيف، المضارع، المقتضب، المجتث والمتقارب، وزاد الأخفش بحرا عليها، وسماه المتدارك. فأصبح الجميع ستة عشر بحرا، أطلق عليها: »علما العروض والقوافي.«(40). أما النثر فقد عرفه بـ»الكلام المرسل« أو »المسجع«، و»الشعر قول مقفى« موزون بالقصد.(41)
تطرق الجاحظ إلى فضل الكتاب في الثقافة العربية، فرأى للكتابة والخط ما يفوق دلالة الإشارة، لهذا رأى أن »فضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب.«(42) وهذا لا يعني أن الجاحظ يفخر بذلك ولكنه يوضح أن الشعر خاص باللغة العربية، كما أنه لا يقبل الترجمة، فـ»الشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل، ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب لا كالكلام المنثور، لهذا لا يمكن أن يكون أداة للتواصل الثقافي، فلو حول الشعر العربي بطُل الوزن الذي هو معجز الشعر العربي قائلا »وقد نقلت كتب الهند، وترجمت حكم اليونانية وحوّلت آداب الفرس، فبعضها ازداد حسنا وبعضها ما انتقص شيئا ولو حوّلت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن مع أنّهم لو حوّلوها لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهم.«(43)
أما قدامة ابن جعفر فأقام التفرقة بين النثر والشعر على أساس أن »الشعر محصور بالوزن، محصور بالقافية، يضيق على صاحبه. والنثر مطلق غير محصور فهو يتسع لقائله،« إلا أنه لا يرى الوزن كافيا لتسمية الكلام شعرا، فالشاعر »إنما سمي شاعرا لأنه يشعر من معاني القول وإصابة الوصف بما لا يشعر به غيره. وإذا كان إنما يستحق اسم الشاعر بما ذكرنا، فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفى.«(44)
يذكر التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة قولا لأبي عابد الكرخي وهو »أن النثر أصل الكلام والنظم فرعه، والأصل أشرف من الفرع والفرع أنقص من الأصل، لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فهي ظاهرة لأن جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر، ومن شرفه أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهي مع اختلاف اللغات كلها منثورة مبسوطة، ومن فضيلة النثر أيضا، كما أنه إلهي بالوحدة كذلك وهو طبيعي بالبدأة، والبدأة في الطبيعيات وحدة، كما أن الوحدة في الإلهيات بدأة.«(45) ونلاحظ أن التوحيدي يميل إلى تفضيل النثر على الشعر، لهذا جعله أصل الكلام وفي هذا تشريف له عن النظم الذي اعتبره فرعا وجاء في نفس الكتاب رأي »لعيسى الوزير« جاء فيه: »أن النثر من قبل العقل، والنظم من قبل الحس، ولدخول النظم في طي الحس دخلت إليه الآفة وغلبت عليه الضرورة واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هو النثر.«(46)
وقد سعى النقاد العرب القدامى إلى التمييز الدقيق بين الشعر والنثر للوقوف على الخصائص الجوهرية لهذا الفن، وقد اعتمد ابن الأثير الفوارق التالية:
٭ النظم وقف على الشعر دون النثر
٭ لكل فن من الفنيْن مفرداته
يتصف الشعر بالإيجاز والنثر بالإطالة (المثل السائر لابن الأثير)
وقد فضل بعض الأدباء الشعر في مخاطبة الملوك. يقول ابن رشيق: »من فضل الشعر أن الشاعر يخاطب الحاكم باسمه وينسبه إلى أمه، ويخاطبه بالكاف كما يخاطب أقل ألونة، فلا ينكر ذلك عليه.«(47)
يرى ابن رشيق القيرواني »أن النثر العربي أقدم في الوجود من الشعر وإلى أن النثر مطلق والشعر مقيد يحتاج إلى وزن وقافية.«(48)
أما محمد بنيس فيرى أن الأوزان قد كانت ومعها القافية، »هي المقياس السائد في فصل الشعر عن النثر، ومن ثم فإن الخروج على قوانينها التقليدية أول ما مس الأذن التقليدية، مما أحدث خللا لم يستسغه القارئ.«(49)
وفي التفريق بين الشعر والنثر يرى محمد غنيمي هلال أن النقد العربي لم يعن بأجناس النقد الموضوعية في النثر والشعر وإنما انحصر اهتمام النقاد في النثر الذاتي، وما نجده في أدب الرسائل فهو قريب إلى تاريخ الأدب »على أن كثيرا مما ذكروه في باب الرسائل مكرور مع ما أورده في الخطابة، ثم أن الرسائل والخطابة قد غزتهما - بعد تطورهما- دروب التخيل والمجاز، حتى قربا من الشعر، فأصبحت لغتهما في »الشعر المنثور« لا يفرقها من المنظوم غير الوزن. وقد كان الوزن هو الفاصل ما بين الشعر والنثر عند نقاد العرب، لأنهم لم يتناولوا في نقدهم غير الأدب الذاتي، والنثر فيه - كالشعر - حافل بضروب الخيال: على خلاف ما رأينا في النقد الموضوعي عند أرسطو لا يحفل بتنميق العبارة كثيرا في المسرحية والملحمة، ويرى أن الوزن ليس هو الفارق الوحيد بين الشعر والنثر، وأن الشعر الموضوعي غني بموارده الأخرى غير اللغوية، فهو أقل حاجة إلى استعمال المجاز، ولذا كان الكتاب - عند أرسطو - أحوج إلى استعمال المجاز من الشعراء.«(50) وأضاف أن أرسطو يرى أن الفصاحة والبلاغة»كما يردان في المنظوم، يردان في المنثور وأحسن مواقعها ما ورد في المنثور.«(51)
اكتشفت الدراسات الشكلية الحديثة أن اللغة الشعرية ذات بنية تميزها عن بنية الكلام النثري. فقد اهتم جون كوهن في كتابه »بنية اللغة الشعرية« بالمسألة الشعرية، حيث عالج اللغة الشعرية مستفيدا من التصور البنيوي للغة، فطبقه على الكلام أي الرسالة نفسها، حيث سيجعل من الشكل موضوع بحثه، فنظر في مجموعة من القضايا أهمها مستوى العبارة أو ثنائية »نظم- نثر« فجميع نظم الشعر تستند في الواقع إلى معايير متعارف عليها، وتشترك هذه المعايير في أنها لا تستخدم من اللغة إلا وحدات غير دالة. فإذا ما حبسنا نظرنا في النظم الفرنسي المطرد وجدناه يعتمد على الوزن والقافية، أي على المقطع والفونيم. والحال أن المقطع والفونيم وحدتان أصغر من الكلمة أو الفونيم أي أصغر من الوحدة الدلالية الدنيا ولا يغير شيئا من دلالة رسالة أن تكون بهذا العدد أو ذاك من المقاطع، كما لا يؤثر في معنى كلمة اشتراكهما مع غيرها في القافية. وقد ميز جون كوهن في كتابه »بنية اللغة الشعرية« بين نموذجي »الشعر« و»النثر«. يرى جون كوهن أن »النثر والشعر نموذجان مختلفان في الكتابة ويمكن تمييزهما داخل اللغة نفسها.«(52)
كما اعتبر الشعر نقيضا للنثر، »فالشعر ليس اختلافا عن النثر فحسب، بل إنه يتعارض معه كذلك، فهو ليس »اللا نثر«، بل »نقيض النثر«، الكلام النثري يعبر عن الفكرة وهذه بحد ذاتها استدلالية، مما يعني أن النثر يمضي من الأفكار إلى الأفكار.«(53)
فصل كوهن بين الشعر والنثر على أساس اختلاف المعنى في الشعر عنه في النثر. يقول: »في اللغة يقابل عادة الشكل بالمعنى ناسبين إلى الشكل المستوى الصوتي فقط، وفي الحقيقة يجب علينا أن نميز بين مستويين شكليين: الأول على صعيد الصوت، والثاني على صعيد المعنى. فللمعنى شكل أو »بنية« يتغير عندما نمر من الصياغة الشعرية إلى ترجمتها النثرية، فالترجمة تحافظ على المعنى لكن تفقدها.«(54)
ولأن الشكل هو لسان حال الشعر، فترجمة القصيدة إلى النثر يمكن أن تكون صحيحة إلى أبعد مدى نريده إلا أنها لا تحتفظ في الوقت نفسه بأي قدر من الشعر.(55)
الوزن عند جون كوهن لا يحقق الشعر إذا أضيف إلى النثر، فهو لا يوجد عنده »إلا كعلاقة بين الصوت والمعنى، إنه تركيب صوتي- دلالي. وبذلك يتميز عن باقي وسائل النظم كالاستعارة مثلا التي تندرج في المستوى الدلالي فقط«(56)
إذا كان الشعر، في نظر جون كوهن، نقيضا للنثر، فإن الشعر يتضمن النثر أيضا. الشعر دائري، والنثر خطوطي. وهذا المظهر المتناقض يبرز للعيان، ومع ذلك لم يقم له علم الشعر اعتبارا على الإطلاق، فلقد جعل هذا العلم من مسألة »الرجوع« سمة منعزلة، تضاف من الخارج إلى الكتابة بهدف منحها بعض الخصائص الموسيقية، في حين أن التناقض يكون البيت، لأنه ليس بكامله بيتا أي رجوعا، ولو كان كذلك لما كان باستطاعته أن يحمل معنى، وبما أنه يحمل معنى فإنه يظل خطوطيا. فالكتابة الشعرية هي شعر ونثر في آن. قسم من عناصرها يحقق الرجوع بينما يحقق القسم الآخر الخطوطية العادية للكلام. والعناصر الأخيرة تعمل في الاتجاه العادي للتفريق، أما العناصر الأولى فتعمل على العكس من ذلك، في الاتجاه اللآتفريقي.«(57)
وهكذا يوضح كوهن أن الكتابة الشعرية دائرية على »المستوى الإيقاعي« وخطوطية على »المستوى الدلالي«، ولذلك فهي تهدف إلى نوع من الموازاة بين هذين المستويين.
وترى بربرا جونسون (Barbara Johnson) في التفريق بين الشعر والنثر الاستحالة النظرية والتاريخية لتقرير مَن مِن الشعيرات الإثنتين تسبق الأخرى، ليست سوى حجرة عثرة من المنظور المنهجي. السؤال الذي تطرحه هذه الاستحالة - استحالة الدور الذي يلعبه، في القراءة، التوزيع الحيزي لامتداد نصي - هو بالتحديد السؤال الذي يطرحه مفهوم »الشعر في حالة نثر«. لأنه إذا كان، كما يرجوه كلوديل Claudel، »البيت الجوهري والأساسي« ليس سوى »فكرة معزولة ببياض«(58)، إذا كان الفرق الشكلي بين بيت شعري ونثر ينحصر بالدرجة الأولى في فرق المسافة، إذن كل تساؤل حول »شعرفي حالة نثر« محتو على تنظيم توزيع حيزي لا هو بطارئ له ولكنه يساهم في تكوينه.
لتحليل سير عمل مجال شعيراتنا الإثنتين، فلنقارنْ مثلا المقاطع التالية: زيت الكوك، مسك وقطران وقطران، مسك وزيت الكوك. ما الذي تغير في التبادلية في المواضع؟ الكلمات هي نفسها. لم يتغير شيئ لا في المعنى، ولا في الدلالة، ولا في العلامة، ولا في العلاقة النحوية. المقطع الأول أخذ من الشعيرة الشعرية، والمقطع الثاني أخذ من الشعيرة النثرية. المقطع الأول لا هو أكثر أدبيا، ولا أكثر مجازية، ولا أكثر نموذجية، ولا هو أكثر تركيبية من المقطع الثاني.
لنفترض أن الفرق بين النثر والشعر ليس هو الجوهر ولكن المرجع، هل لا نتوصل بالتحديد إلى المفهوم التناظري، خطأ، للعلاقة بين الشعر والنثر الذي يفترضه أن يعالجه »الشعر في حالة نثر«.
في الحقيقة النقص في الملاحظات السالفة ينقسم إلى قسمين:
1- لا تأخذ بعين الاعتبار بأن النثر، في مفهومه الشائع، ليس نصا موسوما »نثر« لكن عكس ذلك فهو نص لا يحمل أي إشارة لسانية، فهو الشيء الذي نفعله جميعا، مثل M. Jourdain دون أن نعلمه. فهل كل نص يُصرّ على قانون النثر يسمى »نثرا«؟ وهل الفرق بين النثر والشعر يظهر بين طابعين، أو بين وجود أو غياب النوع؟
2- إذا كان إبراز مدلول« نثر »ب« شعر في حالة نثر »يتعلق بإبراز قانون«لا شعر« أو »شعر منحرف« أو بصيغة أخرى إن »الشعر في حالة النثر« ينبني على الشعر الذي يندثر والذي لا يؤكد ماهيته إلا بإحالته على ما ليس هو، إذن »الشعر في حالة النثر« يُشتق، في الحقيقة، أيضا من بين رمزين اثنين يختار النص الانتماء إلى أحدهما.
نجد أنفسنا أمام عكسين يلتقيان فيما بينهما. الشعر في حالة النثرهو المصدر الذي منه تختل القطبية بين وجود وغياب، بين نثر وشعر.
إن وصف »الشعر في حالة النثر« لا يتم إلا من خلال هدم محاولة وصفه نفسها. عدم معرفة ماهية الفرق، هو في نفس الوقت تساؤل حول كيفية تغيير عدم التأكد بأثر رجعي التأكد السابق، والتحدث سوى انطلاق من عدمية هذا التأكيد.
إن سؤال الفرق، الذي لا يمكن لا الإجابة عليه ولا معرفة ماذا يسأل السؤال، لا يمكن إلا أن يتكرر، لكن تكرار هذا الخلل الوظيفي للسؤال هو الذي يولد نص الأشعارفي حالة النثر.(59)
نستخلص تعدد الفروق بين الشعر والنثر، إلا أنهما يلتقيان في قدرة كل منهما على بلوغ الجمال الفني سواء في صياغتهما الفنية أو في الإيقاع المميز لكل منهما، سواء كان إيقاعا نثريا أو إيقاعا شعريا أي الإيقاع الذي يبنيه الوزن والقافية أو اللفظة والتعبير.
يخيل إلي أن الفرق بين منزلة الشعر ومنزلة النثر يرجع بالأساس إلى طبيعة الموضوعات التي تحدد طبيعة جنس الكتابة، شعرا كان أم نثرا أو التوفيق بينهما.
3- ترجيح الشعر على النثـر:
اختلف النقاد في ترجيح الشعر على النثر. يرى زكي مبارك أن »إيثار الشعر على النثر له مظاهر كثيرة في البيئات العربية، فهذا أبو بكر الخوارزمي الذي كان يحفظ نحو خمسين ألف بيت من الشعر لم يعرف عنه أنه اهتم بحفظ الرسائل حتى ذكروا أنه لم يحفظ غير رسالة واحدة في »كتاب الصاحب« إلى ابن العميد جوابا عن كتابه عليه في وصف البحر. والواقع أن الشعر أقرب إلى النفس من هذه الناحية، وهو بالذاكرة أعلق، وعلى الألسنة أسير بفضل القوافي والأوزان.«(60)
ويذكر الكاتب أن من كُتّاب القرن الرابع من فاضل بين الشعر والنثر ومقام الكتاب ومقام الشعراء وقد لفت نظرهم ما كتبه الثعالبي في تفضيل النثر وابن رشيق في تفضيل الشعر ردا عليه، فالثعالبي نوه بفضل النثر للتفاهم في شؤون الحرب والسلم والصناعة والسياسة والإدارة. أما الموضوعات التي تمس الأحاسيس والعواطف فالشعر أصلح فيها من النثر.
ويأخذ الكاتب على الثعالبي حينما ذكر في أسباب ترجيح النثر على الشعر »أن الشعر تصون عنه الأنبياء وترفع عنه الملوك« فرأى بأن حجة التعالبي واهية لأن« الشعر أقرب إلى أرواح الأنبياء، وأنا لا أتصور الأنبياء إلا شعراء، وإن جهلوا القوافي والأوزان لأن الشعر الحق روح صرف، والنبوة الحقة شعر صراح.«(61)
وقد رد عبد القاهر الجرجاني في كتابه »دلائل الإعجاز« على من ذم الشعر والاشتغال بعلمه فدافع عنه مستدلا بالحديث النبوي الشريف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشعر وسماعه، وارتياحه له. ويرد الجرجاني على من ذم الشعر لأنه كلام موزون مقفى، يقول: »وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى، حتى كأن الوزن عيب، وحتى كأن الكلام إذا نُظم نظْم الشعر، اتضح في نفسه، وتغيرت حاله، فقد أبعد، وقال قولا لا يعرف له معنى، وخال العلماء في قولهم: »إنما الشعر كلام فحسنه حسن، وقبيحه قبيح. »وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أيضا.«(62)
أما التوحيدي فهو من نقاد القرن الرابع اتسمت آراؤه بالطابع الفلسفي. في هذه المرحلة »نشأت مسألة المفاضلة بين الشعر والنثر، وظهر فريقان متعارضان، كان كل منهما« يستعين في تفضيل الشعر أو النثر بأمور خارجة عن طبيعتهما أحيانا.«(63)
كما يورد التوحيدي آراء بعض المنتصرين للشعر. قال ابن نباتة: »من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه، والحجج لا تؤخذ إلا منه، أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون: (قال الشاعر) و(هذا كثير في الشعر) و(الشعر قد أتى به). فعلى هذا، الشاعر هو صاحب الحجة، والشعر هو الحجة.«(64) كما يقال »ما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها بيت من الشعر، ولا يقال: ما أحسن هذا الشعر لو كان فيه شيء من النثر، لأن صورة المنظوم محفوظة وصورة المنثور ضائعة.«(65)
يرى أبو هلال العسكري أن الشعر يغلب عليه الزور ولو أن الشاعر لا يرد منه إلا حسن الكلام أما النثر فعليه مدار السلطان والصدق لا يطلب إلا من الأنبياء، وفضل الشعر على النثر عند أبي هلال يرجع إلى استفاضته في الناس وتأثيره في الأعراض، والأنساب، فلا تطيب مجالس الظرفاء والأدباء إلا بإنشاده، وهو أصلح للألحان(66). ويضيف العسكري أن الشعر يسمح لعلية القوم من التطرق لمواضيع لو تناولوها نثرا جاءت ناقصة. يقول في الصناعتين: »...إن مجالس الظرفاء والأدباء، لا تطيب، ولا تؤنس، إلا بإنشاد الأشعار، ومذاكرة الأخيار، وأحسن الأخبارعندهم ما كان في أثنائها أشعار، وهذا شيء مفقود في غير الشعر.«(67)
يقول ابن رشيق »ليس للجودة في الشعر صفة إنما هو شيء يقع في النفس عند المميز«.
أما ابن رشيق ففضل الشعر على النثر، فقد جاء في باب »في فضل الشعر« من كتاب العمدة أن كلام العرب نوعان: منظوم ومنثور، ولكل منهما ثلاث طبقات: جيدة ومتوسطة ورديئة، فإذا اتفقت الطبقتان في القدر ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا لأن كل كلام منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة، فاللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وإذا كان موزونا تألفت أشتاته وهو في كل ذلك يشبه اللفظ بالدر إذا كان منثورا لم يؤمن عليه(68).
ابن رشيق فضل الشعر على النثر مستدلا على أن القرآن جاء منثورا لا منظوما »فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة، والمترسلين وليس بمترسل، وإعجازه الشعراء أشد برهانا. ألا ترى كيف نسبوا النبي صَ إلى الشعر لما غُلبوا وتبين عجزهم ؟ فقالوا: هو شاعر، لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته.«(69)
من الأدباء من فضل الشعر على النثر نذكر منهم ابن وهب الكاتب إذ يقول:
»واعلم أن الشعر أبلغ البلاغة.«(70 )
4- ترجيح النثـر على الشعر:
كما اختلف النقاد في ترجيح الشعر على النثر اختلفوا كذلك في ترجيح النثر على الشعر والمفاضلة بينهما. يرى القلقشندي في ترجيح النثر على الشعر أن النثر أرفع درجة من الشعر»إذ الشعر محصور في وزن وقافية يحتاج الشاعر معها إلى زيادة الألفاظ والتقديم فيها والتأخير، وقصر الممدود دون المقصور، وصرف ما لا ينصرف، ومنع ما ينصرف من الصرف، واستعمال الكلمة المرفوضة، وتبديل اللفظة الفصيحة بغيرها، وغير ذلك مما تلجئ إليه ضرورة الشعر فتكون معانيه تابعة لألفاظه، والكلام المنثور لا يحتاج فيه إلى شيء من ذلك، فتكون الفاظه تابعة لمعانيه«(71)
ويضيف أن النثر مبني على مصالح الأمة لما يشتمل عليه من مكاتبات الملوك وما يلتحق به من ولايات السيوف وأرباب الأقلام.(72)
في القرن الخامس الهجري »فضل المرزوقي النثر على الشعر ودعم وجهة نظره بالقول إن الخطابة كانت لدى الجاهليين أهم من الشعر، وإن الشعراء قد حطوا من قيمة الشعر بتعرضهم للسوقة حتى قيل (الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدنيء)، كما أن إعجاز القرآن لم يقع بالنظم، فلهذه الأسباب كان النثر أرفع شأنا من الشعر ومن ثم تأخرت رتبة الشعراء عن الكتاب.«(73)
في مقدمة »شرح ديوان الحماسة« يعلل المرزوقي تأخر رتبة المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب فيقول: »واعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء موجبة تأخر المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب لأمرين: أحدهما أن ملوكهم قبل الإسلام وبعده كانوا يتباهون بالخطابة، وكانوا يأنفون من الاشتهار بقرض الشعر، والثاني أنهم اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة، وتوصلوا به إلى السوقة كما توصلوا إلى العلية، وتعرضوا لأعراض الناس، ومما يدل على أن النثر أشرف من النظم أن الإعجاز به من الله تعالى جده والتحدي من الرسول عليه السلام وتعاطيه دون النظم، وقد قال الله عز وجل:« وما علمناه الشعر، وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.«(74)
ولشرف النثر قال الله تعالى: »إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.«(75) وقال ابن كعب الأنصاري: »من شرف النثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق إلا به آمرا وناهيا ومستخبرا ومخبرا وهاديا وواعظا، وغاضبا وراضيا.«(76)
يقول التوحيدي »ألا ترى أن الإنسان لا ينطق في أول حاله من لدن طفوليته إلى زمان مديد إلا بالمنثور المتبدد، والميسور المتردد ؟ ولا يلهم إلا ذاك، ولا يناغي إلا بذاك، وليس كذلك المنظوم لأنه صناعي، ألا ترى أنه داخل في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف مع توقي الكسر واحتمال أصناف الزحاف، لأنه لما هبطت درجته عن تلك الربوة العالية دخلته الآفة من كل ناحية.«(77)
جمع التوحيدي الكثير من الآراء، ونجد فيما جمعه حول مسألة إعجاز القرآن من حجج أبي عابد الكرخي مثلا في تفضيل النثر: »أن النثر أصل الكلام والشعر فرعه، والأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل. لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فهي ظاهرة لأن جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر، وإنما يتعرضون من نظم في الثاني بداعيةٍ عارضة، وسبب باعث وأمر معين. ومن شرف النثر أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهي، مع اختلاف اللغات، كلها منثورة مبسوطة، متباينة الأوزان، متباعدة الأبنية، مختلفة التصاريف، لا تتقيد بالوزن، ولا تدخل في الأعاريض، ومن شرفه أيضا أن الوحدة فيه أظهر، وليس كالمنظوم داخلا في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف، مع توقّي الكسر واحتمال أصناف الزحاف.«(78) وذهب عيسى الوزير إلى »أن النثر من قبل العقل، والنظم من قبل الحس.«(79) وقال ابن طراوة - وكان من فصحاء أهل العصر في العراق - »النثر كالحرة والنظم كالأمة، والأمة قد تكون أحسن وجها وأدمث شمائل وأحلى حركات، إلا أنها لا توصف بكرم جوهر الحرة.«(80)
»الحاتمي في القرن الرابع الهجري، يجعل في كتابه »حلية المحاضرة« بابا في نظم المنثور، أي نقل المعنى من النثر إلى الشعر.«(81)
يحدد العسكري الخصائص التي يجب توفرها في الكاتب فيقول: »ينبغي أن تعلم أن الكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جمة وآلات كثيرة من معرفة العربية لتنقيح الألفاظ، وإصابة المعاني، وإلى الحساب وعلم المساحة والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلة وغير ذلك مما ليس هنا موضع ذكره وشرحه لأننا إنما عملنا هذا الكتاب لمن استكمل هذه الآلات كلها وبقي عليه المعرفة بصنعة الكلام وهي أصعبها وأشدها.«(82)
لخص ابن قتيبة في كتابه »أدب الكاتب« تحديد الخصائص التي تؤدي إلى الوصول إلى رتبة الكتاب كحفظ القرآن الكريم والإلمام بالحديث الشريف ليعرف الكاتب»الصدر والمصدر، والحال والظرف، وشيئا من التعاريف والأبنية وانقلاب الياء عن الواو، والألف عن الياء، وأشباه ذلك.«(83)
في المثل السائر يضع ابن الأثير أصول الكتابة ويحدد الشروط التي يجب على الكاتب الاقتداء بها لممارسة الكتابة من أهمها: »تصفح الكاتب كتابة المتقدمين، ويطلع على أوضاعهم في استعمال الألفاظ والمعاني، ثم يحذو حذوهم، وثانيهما أن يمزج كتابة المتقدمين بما يستجيده لنفسه من ريادة حسنة، إما في تحسين ألفاظه أو في تحسين معانيه، الثالثة أن لا يتصفح كتابة المتقدمين، ولا يطلع على شيء منها، بل يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم، وكثير من الأخبار النبوية، وعدة من دواوين فحول الشعراء، ممن غلب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظ، ثم يأخذ في الاقتباس، فيقوم ويقع، ويخطئ ويصيب، ويضل ويهتدي، حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه.«(84)
ويميل ابن الأثير إلى الطريقة التي ينتهجها الكاتب لنفسه فيبدع فيها. وقد جعل ابن الأثير من إلمام الكاتب بحل الآيات القرآنية والأخبار النبوية والأبيات الشعرية أهم مقومات الكتابة قائلا: »ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها، وأظفرتني بكنوز جواهرها، إذ لم يظفر غيري بأحجارها فما وجدت أعون الأشياء عليها إلا حل آيات القرآن الكريم، والأخبار النبوية، وحل الأبيات الشعرية.«(85)
ويذكر علي شلق أن نثر عبد الحميد كان »ذو رونق، تعانق أناقة الممارسة فيه ملاطف الاستعداد، وتتواكب الصنعة مع البراعة، يأخذ من النغم الموسيقي حلاوة وتطرية، وتواقيع متراتبة، ومن الشعر عذوبة، وصاحبة، ومن المعمارية تناغم لبنة مع أختها، وتلاحم مدماك بسقف، وذلك التلاقي العجيب بين عمارة العود، والقنطرة، والطنف، والبهاء، فتراه يرسل إرسالا دون تكلف الكلام، أو يسجع أحيانا دون تعلم للتنغيم.«(86)
ابن الأثير من أهم النقاد الذين اهتموا بالسجع، ففي رأيه »لو كان مذموما لما ورد في القرآن الكريم فإنه قد أتى منه بالكثير حتى أنه لا يؤتى بالصورة جميعا مسجوعة كصورة الرحمان وصورة القمر وغيرها. وبالجملة لم تخل منه صورة من الصور.«(87) وأضاف »أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام، والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء، والنفس تميل إليه بالطبع، ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد، إذ لو كان ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب من الأدباء سجاعا، وما من أحد منهم ولو شدا شيئا يسيرا من الأدب إلا ويمكنه أن يؤلف ألفاظا مسجوعة ويأتي بها في كلام، بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة طنانة رنانة، لا غثة ولا باردة. وأعني بقول رثة وباردة أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لها من الحسن ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن، وهو في الذي يأتي به من الألفاظ المسجوعة كمن ينقش أثوابا من الكرسف أو ينظم عقدا من الخزف الملون وهذا مقام تزل عنه الأقدام ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد. ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا. فإذا صفي الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد فإن وراء ذلك مطلوبا آخر: وهو أن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى لا أن يكون المعنى فيه تابعا للفظ، فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه، على باطن مشوه، ويكون مثله كغمد من ذهب على نصل من خشب.«(88)
وقف ابن الأثير على خصائص السجع وشروطه ولم يعتبره أعلى درجات القول لأن القرآن الكريم لم يأت كله مسجوعا، بل جاء بالمسجوع وغير المسجوع. وقد رأى زكي مبارك أن »بناء الجملة لم يخرج في جوهره عن السجع طوال القرن الثاني والثالث.«(89)
ويذكر جودت فخر الدين أن ابن الأثير رأى »النثر حلا للشعر، أو للآيات القرآنية أو الأحاديث والأخبار النبوية، كما جعل لكل (حل) طريقة خاصة به، وقال بان تعلم الكتابة إنما يتم عن طريق حفظ الأشعار والآيات والأحاديث. لقد كان ابن الأثير - فيما يبدو- يبحث عن مادة (معرفية) للكتابة النثرية، فوجد إلى جانب القرآن والحديث النبوي مصدرا آخر للمعرفة هو الشعر، وذلك لغزارة معانيه، كما يتضح لنا فيما يأتي« فإن قيل: الكلام قسمان: منظوم ومنثور، فلم حضضت على حفظ المنظوم وجعلته مادة للمنثور، وهلا كان الأمر بالعكس؟ قلت في الجواب: إن الأشعار أكثر والمعاني فيها أغزر، وسبب ذلك أن العرب الذين هم أصل الفصاحة جل كلامهم شعر، ولا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيرا، ولو كثر فإنه لم ينقل عنهم، بل المنقول عنهم هو الشعر، فأودعوا أشعارهم كل المعاني.(90)
اهتم النقاد القدماء بالنثر الفني وتوضيحه وعلاقته بالشعر كما حددوا الأسس التي تقوم عليها الكتابة لما كان من دور للكاتب في المحيط الاجتماعي والأدبي والسياسي.
نستخلص مما تقدم أن النثر لا يقل أهمية عن الشعر، فقد ظل منافسا له عبر العصور ويرجع عدم الاهتمام به في مرحلة من مراحل التاريخ الأدبي إلى ضياع معظم الموروث النثري الذي أدى إلى تراجعه عن الشعر في فترة من الفترات.
عبد القاهر الجرجاني في »دلائل الإعجاز« وضح أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة وإنما لملاءمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تليها، فاللفظة قد تروق في موضع وتوحش في موضع آخر.(91)
في حين نجد أن زكي مبارك يرى أن تقديم الثعالبي للنثر كان لغرض شخصي، »فخوارزمشاه الذي قدم إليه »نثر النظم وحل العقد« كان من هواة أن يقدم النثر على الشعر إيثارا لبعض الكتاب، أو حقدا على بعض الشعراء«، وهذا ليس بغريب من كتاب ذلك العصر، فأحكامهم تتأثر بأهواء الرؤساء، ويضيف زكي مبارك أن ابن رشيق الذي فضل الشعر على النثر يقول: »ولم أهجهم بهذا الرد وأورد هذه الحجة لولا أن السيد أبقاه الله قد جمع النوعين، وحاز الفضيلتين، فهما نقطتان من بحره، ونوارتان من زهره«، وهذا دليل على أن الحقائق تصور بحسب ما توحي به الأهواء.(92)
وأضاف الكاتب أن التأليف في نقد النثر كان قليلا بالنسبة للتأليف في نقد الشعر، لأن القدماء كانوا يرون الشعر أرفع فنون الجمال، أما النثر فلم يكن إلا أداة من أدوات التعبير عن الأغراض العلمية والسياسية والدينية. ويضيف بأن الوقت قد حان للعناية بالنثر، فهو اليوم صاحب السلطان في المشرق والمغرب.(93)
وأشار قدامة ابن جعفر »إلى أن السجع في الكلام كمثل القافية في الشعر، وإن كانت القافية غير مستغنى عنها والسجع مستغنى عنه فأما أن يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من فاعله، وعي من قائله.«(94)
وأشاد ابن خلدون بكتاب الرسائل، فقال »فإن صاحب خطة الرسائل والكتابة لابد أن يتخير من أرفع طبقات الناس، وأهل المروءة والحشمة منهم.«(95)
أما محمد كرد علي في »أمراء البيان« فقد بين دور الكاتب وعلو منزلته: »فقد رفع الملوك من بني العباس بعض كتابهم إلى الوزارات، وقلما رفعوا شاعرا لشعره لأن الشعر خيال وحس، والكتابة عقل وحقيقة، وحاجة الملوك في تدبيرها إلى العقول أكثر من احتياجها إلى العواطف، والعلوم على اختلاف ضروبها تكتب نثرا.«(96)
أما سؤال التوحيدي »أيهما أشد تأثيرا« في النفس، الشعر أم النثر ؟ وقد أجاب عنه أبو سليمان المنطقي إذ قال: »النظم أدل على الطبيعة لأنه من حيز التركيب، والنثر أدل على العقل لأنه من حيز البساطة. وإنما تقبلنا المنظوم بأكثر مما تقبلنا المنثور لأنا للطبيعة أكثر منا للعقل، والوزن معشوق للطبيعة والحس، ولذلك يفتقر له عندما يعرض استكراه في اللفظ، والعقل يطلب المعنى، فلذلك لا حظ للفظ عنده وإن كان متشوقا معشوقا.«(97) وقد أشار جودت فخر الدين إلى أن التوحيدي أثار أسئلة عميقة فيما يتعلق »بطبيعة التركيب الشعري وما يتبعها من تأثير في النفوس، وإن كانت أسئلة صادرة عن هموم فلسفية أو فكرية... يبدو ذلك واضحا في طرحه للسؤال السابق بصيغة أخرى على أبي سليمان: »لم لا يطرب النثر كما يطرب الشعر ؟ فكان الجواب: لأننا منتظمون، فما لاءمنا أطربنا، وصورة الواحد (أي الوحدة) فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة.« وقد خلص أبو سليمان المنطقي من ذلك إلى تعليل إعجاز القرآن بأن صاحب الرسالة »غلبت عليه الوحدة، فلم ينظم من تلقاء نفسه، ولم يستطعه، ولا ألقى إلى الناس عن القوة الإلهية شيئا على ذلك النهج المعروف، بل ترفع عن كل ذلك، وخص في عرض ما كانوا يعتادونه ويألفونه بأسلوب حير كل سامع.«(98)
نستخلص أن العلاقة بين الشعر والنثر لا تتحدد بالعروض فحسب، لأسباب متعددة وهي:
٭ أن العروض يؤدي إلى الصنعة والتكلف.
٭ تغير الذوق تجاه الأوزان.
٭ وجود إيقاع خاص بالنثر.
5- علاقة الشعر بالنثـر:
فيما يتعلق بقضية الشعر وعلاقته بالنثر، فقد أشار أبو حيان إلى أن العروض لا يكفي الشاعر إذا لم يكن مطبوعا، لأن العروض صناعة قد تؤدي إلى التكلف، كما تنبه إلى تغير الذوق تجاه الأوزان مع تقادم الزمن وزبادة التخلي عن إنشاد الشعر، ملاحظا بذلك العلاقة بين الأوزان والألحان. وأكثر من ذلك، تنبه أبو حيان إلى إيقاع خاص بالنثر، فزاد على ابن طباطبا في تقريبه بين الشعر والنثر من ناحية المعنى، تقريبا بينهما من ناحية الإيقاع، وخلص إلى القول »أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه نظم.«(٩٩)
ويرى جودت فخر الدين أنه »لم يطرأ أي جديد جوهري على قضية العلاقة بين الشعر والنثر والمفاضلة بينهما في القرنين السادس والسابع للهجرة. إلا أن ابن الأثير قد قلب مفهوم الصنعة عند ابن طباطبا رأسا على عقبه، بأن جعل الشعر مادة للنثر بدل أن يكون النثر مادة للشعر عند ابن طباطبا. لذلك فقد نصح ابن الأثير الكتاب بحفظ الأشعار: »من أحب أن يكون كاتبا، أو كان عنده طبع مجيب، فعليه بحفظ الدواوين ذوات العدد، ولا يقنع بالقليل من ذلك، ثم يأخذ في نثر الشعر من محفوظاته، وطريقه أن يبتدئ فيأخذ قصيدا من القصائد، فينثره بيتا بيتا على التوالي، ولا يستنكف في الابتداء أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأكثرها، فإنه لا يستطيع إلا ذلك، وإذا مرنت نفسه، وتدرب خاطره، ارتفع عن هذه الدرجة، وصار يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده، ثم يرتفع عن ذلك حتى يكسوه ضروبا من العبارات المختلفة.«(100) وقد شبه غنيمي هلال علاقة النثر بالشعر بعلاقة المشي بالرقص. »فالمشي له غاية محددة تتحكم في إيقاع الخطو، وتنظم شكل الخطو المتتابع الذي ينتهي بتمام الغاية منه. أما الرقص فعلى العكس من ذلك، فعلى الرغم من استخدامه نفس أجزاء الجسم وأعضائه التي تستخدم في المشي، له نظام حركات هي غاية في حد ذاتها.«(101) ويضيف أن الشعر أيضا هو تأمل في التجربة الذاتية وهو الخلق الأدبي مرده الذوق لا الفكر لأن موضوع الذوق هو الجمال. لهذا كانت صلة الشعر بالحقائق العلمية كامنة في جمالها أو قبحها دون البرهنة عليها. وإذا كان الشعر يستعين بالموسيقى الكلامية فلقوتها الإيحائية وقدرتها على التعبير.(102)
»ومن قبل كان الشعر لا يتميز عن النثر إلا بالوزن والقافية. وكان هذا التفريق شكليا لا يبين عن روح الشعر، ولهذا تحدثوا قديما عن الشعر المنثور، كأنهم أقروا بأن روح الشعر قد توجد حيث لا نظم كما هو مصطلح عليه، وقد أصبح ينظر في الشعر إلى تلك الحميا، وإلى ذلك الشعور المشبوه في التعبير عن التجربة الذاتية. وفي هذا انصرف الشعر الحديث في جوهره إلى الموضوعات الغنائية. فالشعر التعليمي نظم لا شعر وكذلك الملاحم، فهي لا تعد شعرا إلا فيما قد تحتوي عليه من بعض مقطوعات غنائية، وكلاهما في العصر الحديث إلحاد في عالم الفن. أما المسرحية فهي -من حيث أنها مسرحية - ليست شعرا وجدانيا، لأن موضوعها وطولها لا يتمشيان مع ما عليه الشعر الوجداني، ولكنها قد تعد شعرا فيما تدل عليه من جوانب وجدانية - بوصفها عدة مقطوعات وجدانية دون نظر إلى وحدتها المسرحية الموضوعية، لأن مثل هذه الوحدة تضر بوحدة الشعر الوجداني.«(103)
وقد أقر غنيمي هلال أن ما يقصد بالغنائية لدى كل من موليير وراسين فهي ذاتية موضوعية.
6 - لغة الشعر ولغة النثـر:
فرق محمد غنيمي هلال بين لغة الشعر ولغة النثر، فجعل »لغة الشعر لغة العاطفة ولغة النثر لغة العقل، ذلك أن غاية النثر نقل أفكار المتكلم والكاتب. فعبارته يجب أن تشف في يسر عن القصد، والجمل فيه تقريرية، وعلامات على معانيها، ووسائل تنتهي بانتهاء الغاية منها. وموضوعه حدث من الأحداث أو مسألة من المسائل المبنية أولا على الأفكار. أما الشعر فإنه يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وبما حوله شعرا يتجاوب هو معه، فيندفع إلى الكشف فنيا عن خبايا النفس أو الكون استجابة لهذا الشعور، وفي لغة هي صور.«(104) صور إيحائية، تريد للكلمات قوتها التصويرية الفطرية الحسية، فيعيد بذلك إلى اللغة »دلالتها الهيروغليفية التصويرية.«(105) وقد مثل غنيمي هلال بقول فولتير »إن الشعر وضع صورة متألقة مكان الفكرة الطبيعية في النثر.«(106)
عمل الشاعر الاستجابة لشعوره أما الناثر فعمله تلبية لفكرة أو حجة. لهذا فجمال النثر كامن في صياغته وغايته وجمال الشعر في إيحائه.
يقارن محمد غنيمي هلال بين أسلوب الشعر والنثر فيرى أن »لغة الشعر موزونة. وأوزان الشعر مختلفة، ولكل وزن ما يلائمه من المعاني والأجناس الأدبية. وأما لغة النثر فليست موزونة. وينبغي ألا تكون الخطبة في عبارات موزونة، لأن الوزن يقضي- بمظهر المصطنع - على ثقة السامعين في الخطيب، ويصرف أنظاره إلى شيء آخر في نفس الوزن.ولكن ينبغي ألا تكون الخطبة خالية من الإيقاع لأنه يساعد على الإقناع. فالنثر إذا ينبغي أن يكون إيقاعيا وغير موزون.(107) أما لغة الشعر الحديث، عند بعض النقاد، فهي« الإطار العام الشعري للقصيدة من حيث صور هذا الإطار، وطريقة بنائه، وتجربته البشرية وهو ما تؤديه اللغة الشعرية من خلال الصور الشعرية والصور الموسيقية والموقف الخاص بالشاعر في تجربته البشرية«.(108)
اهتم أحمد الشايب بلغة النثر فجعلها »لغة العقل يقرر قضاياه، ويسجل نتائجه، والشعر لغة العاطفة، غالبا يصورها ويثيرها، والعقل أسرع إلى التطور، وأقبل لعوامل الرقي لأنه تفكير نظري غير مقيد بعرف أو تقاليد.«(109)
وأشار ابن طباطبا إلى أن»أحسن الشعر أن يخرج كالنثر سهولة وانتظاما.«(110) وجعل من النظم خاصية مميزة للشعر وقد جعل النثر أهم مرحلة لإرساء قواعد الشعر وبنائه قائلا »إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه.«(111)
ووضح جودت فخر الدين أن »الشاعر، حسب (مفهوم الصنعة) لابن طباطبا، يفكر نثرا يأتي بمعانيه من النثر ليصوغها أو لينظمها شعرا. فابن طباطبا لا يلحظ يالتالي، التباين في بنية المعنى بين الصيغة الشعرية والصيغة النثرية. المعنى عنده نثري في كل حال وإنما الشعر نظم يقوم على عناصر الصياغة من تخير وتركيب واستنساب وتنقيح«(112) وفي هذا لا يجد ابن طباطبا مفرا من قبول فكرة الجاحظ عن المعاني الملقاة في الطريق، فيرد براعة الصنعة، أو براعة الشعر، إلى عملية نظم المعاني وإعادة ترتيبها. لكنه يتميز عن الجاحظ بأمرين: أولهما أنه يدرك تفاوت المعاني من حيث قيمتها، فلا يسوي بينها كما فعل الجاحظ في عبارته المشهورة عن المعاني الملقاة في الطرق، وثانيهما أنه يفهم العلاقة بين المعاني والألفاظ فهما أرحب، يسوي بين المعنى والمحتوى كما يسوي بين الشكل والألفاظ.«(113). ويؤكد جودت فخر الدين »أن هذا التوحيد الذي أقره ابن طباطبا بين المعنى الشعري والمعنى النثري جعله يقارب بين القصيدة والرسالة، فرأى أن »الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر محلول«. فالمعنى الشعري، عنده، مستقل عن شكله الوزني، إذ »الوزن في تقدير ابن طباطبا مجرد قالب خارجي«، وقد أدى به ذلك إلى افتراض لذتين يولدهما الشعر: اللذة الحسية -الإيقاع، واللذة العقلية - المعنى.«(114)
صنف غنيمي هلال النثر إلى نوعين: »مستمر ومطرد، أو مقسم متقابل والأول ما ليست فيه وقفات طبيعية بين أجزائه التي لا يربط بينها سوى ألفاظ الربط، من حروف العطف والتعليق. والوقف الطبيعي يأتي في نهايتها. وهذا النوع من الأسلوب غير مستحسن، لأنه يستمر غير محدود حتى النهاية. والمرء يجب أن يرى أمامه مواضع للوقف. وإنما يلهث الناس في السباق قبل أن يروا الغاية، ولكن حين يرونها يدأبون في السير دون شعور بجهد. ولهذا يفضل أر سطو، الخطابة، العبارة المقسمة المتقابلة الأجزاء على أن يكون كل جزء منها غير طويل، »حيث يدركه الطرف بنظرة واحدة« وهذا النوع من العبارة مستحسن سهل الاتباع. أما حسنه فلأن العبارة فيه محدودة، يشعر السامع فيها أنه أفاد من كل جزء من أجزائها ليصل إلى نتيجة من سماعها وأما سهولة الاتباع فلأن العبارة يمكن تذكرها بسهولة، لأنها مقسمة إلى أجزاء، فهي أشبه بالشعر في تقسيمها العددي، والشعر أسهل اتباعا من النثر. على أن كل جزء من الأجزاء يجب أن يستقل بمعنى. ويجب كذلك ألا ينقطع فجأة بالإضافة إلى الجزء لسوفوكليس: »هذه أرض كاليدون، ومن أرض بليونيز طالعنا السهول الباسمة عبر المضيق.«(115)
جاء في »مجلة أبوللو 1934« مقال »نظرات في الشعر« لمختار الوكيل ميز فيه الكاتب بين لغة النثر والنظم، والنثر والشعر، والشعر والنظم، والنثر الشعري معتبرا لغة الشعر لغة المثل الأعلى.(116) فرأى أن الخلاف يتسع كثيرا بين النثر والشعر من حيث أنهما أداة للتعبير. فالمرء ينفعل في حياته بدوافع مختلفة لا يكاد يميز أسبابها وتأثيرها: فتارة يخضع لسلطان العقل دون أن يعرف سبب ذلك وبذلك يبتعد عن العاطفة التي تجذب المرء نحو الأمر الذي ترغب فيه. ويخضع له خضوعا مطلقا من حيث لا يدري لذلك من سبب مشروع، هذا والعقل يختبر الأشياء ويفحصها ببرودة وجفاف ويضغط على كل ما عساه يمت إلى العاطفة بسبب، ويقرر في الأخير حالة واحدة، تستنبطه من تفكيره الصارم، ويقف حيالها لا يريم ولا يتحول، في حين أن العاطفة تجذب المرء نحو المر الذي تحبذه وترغب فيه.(117)
وأشار في تمييزه بين النثر والنظم أن »التعبير عما يجول بالفكر عن طريق الألفاظ سبيلان مختلفان: أحدهما يتبع قواعد اللغة المقررة ولا يحيد عنها قيد أنملة، ويجري أسلوبه بحيث يوضح في جلاء الأفكار والآراء المقصودة منه، وهذا ما يعرف بالنثر، والآخر يخرج على تلك القواعد حيثما يضطر إلى ذلك، ويخرج كذلك على حروف الهجاء وتراكيب الألفاظ حين تضطره الموسيقى، ويعبر عن أفكاره وآرائه بأساليب تميل إلى الغرابة وتدعو التأمل والتفكير، وهو ما نطلق عليه اسم النظم. وهنا يعن لنا السؤال الآتي: أي السبيلين يتبع المرء في التعبير عن أفكاره: الشعر أم النثر؟(118)
واستخلص الكاتب في تمييزه بين الشعر والنظم أن الناس »قد اصطلحوا منذ القديم على أن الشعر إنما يجب أن يجيء في صورة تميزه عن لغة الحوار والكتابة العادية، فكان أن تدرأ الشعر برداء النظم وهكذا بقي النظم إلى وقتنا هذا عاملا أساسيا في قول الشعر«(119)
وقد تمتزج لغة الشعر بالنثر في بعض الأجناس الشعرية كالملاحم. فالبستاني يرى أن الملاحم عند اليونان مزيج من النثر والشعر، إذ يرى أن الشعر عند جميع الأمم لا يأتي على نسق واحد وربما كان هذا التباين سببا إلى ظهور أنواع من الجمال مختلفة الأشكال والصور، يقول »فالشاعر القصصي من اليونان وخلفائهم كان إذا قص حادثة رواها كلها شعرا وأما الشاعر العربي فينشد الشعر حيث يحسن وقعه وأكثر ما يكون ذلك في الوصف والخطاب والجواب ويقول الباقي نثرا. وفي هذه الطريقة نوع من التفكيه المأنوس. وهي طريقة شعراء البادية حتى يومنا. جلست مرة إلى حلقة شاعر منهم ينشد على نغم ربابته فشرع في مقدمة نثرية قصيرة حتى بلغ إلى وصف حسناء فجعل يتغنى بالشعر على نغم آلة الطرب فلما استتم قصيدته رجع إلى الكلام النثري بضع دقائق حتى بلغ وصف وقعة بين قبيلتين فرجع إلى الإنشاد وهكذا ظل يتراوح قوله بين نثر وشعر نحو ثلاث ساعات، وذلك أيضا شأن القصاصين في كثير من الحواضر العربية.(120) وهكذا نلاحظ أن خاصية الخطاب الشعري متميزة عن الكتابة العادية لما يتميز به الشعر من خضوع لسلطان العاطفة وخرق لقواعد اللغة، وقد تحدث محمد بلبداوي عن خاصية الخطاب الشعري عند الأوروبيين، يقول: »ابتدأت جماعة (مو) وهي تعيد البحث والنظر في خاصية هذا الخطاب بمناقشة مصطلح »الانزياح Lécar« ومعادلاته المترددة على أقلام باحثين متنوعي الاهتمامات. من هذه المعادلات على سبيل المثال: »تجاوزAbus« (فاليري)، و»انتهاك viol« (ج. كوهن). و»زلةscandale« (بارث)، و»شذوذ anomalie« (تودروف)، و»جنون« folie (أراكون) و»انحرافdéviation« (سبيتزر) »هدمsubversion« (ج. بيطار) J. Peytard، و»خرقinfractio« (م. ثيري.Thiry M.). ولاحظت الجماعة أن هذه المصطلحات مع أنها تنتمي إلى معجم أخلاقي لم يبد أي واحد من خالقيها أو مروجيها أي رد فعل حيال هذا الأصل المعجمي الذي قد يوحي في المجمل الأعم أو يحيل على تلك النظرية التي تعتبر الفن ظاهرة مرضية، والتي كان لها صيت قوي في القرن التاسع عشر.(121)
7- الشعر المنثور وإشكالية المصطلح:
لقد التصق مصطلح الشعر المنثور بحركة التحديث الشعري التي أعلن عنها كل من امين الريحاني وأحمد زكي أبو شادي وجبران خليل جبران، وإبراهيم ناجي، وأبو القاسم الشابي، وحسن كامل الصيرفي، وعلي محمود طه، وخليل شيبوب، وغيرهم من الشعراء. وقد عرف محمد حسن عواد الشعر المنثور بقوله: »الشعر المنثور شعر أصيل قائم في الآداب كلها، ومعروف معترف به في العربية لا يحتاج الأمر فيه إلى جدال لأن الشعر في حقيقة أمره موجة أو سيال باطني يبعث فكرة كبيرة، أو فطرة مستهوية تتصل بعالم من عوالم الدنيا أو من عوالم النفس الإنسانية فهو حياة من حيوات النفس وليس صياغة أو هندسة أو لعبا بالألفاظ. هذه الفلسفة نستطيع أن ندرك منها أن للشعر الحديث تاريخا هائلا منذ القدم. وليس هو جديد علينا كما يذهب بعض الكتاب إلى تسميته بالموضة الجديدة. وأذكر هنا أن العرب كانوا يسمون القرآن شعرا(...) وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يدافع عن القرآن(...) إذن نعرف من ذلك أنهم يعرفون الشعر غير القافية والوزن.(122)
وقد قام الشعر المنثور على أساس نثري باستخدام موسيقى الفكر التي تعتمد على التوازي والترادف والتقابل والتنظيم التصاعدي للأفكار، إلى جانب تكرار السطور والكلمات والأفكار في مجموعات متنوعة وذلك تقليدا للشعر الحر الذي يكتبه الإفرنج.(123)
لم يعرف أي جنس من الشعر ما عرفه الشعر المنثور من إشكالية المصطلح. فقد كان الريحاني أول من استعمل هذا المصطلح سنة 1905، وتبعه مطران سنة 1906 في مرثيته لأستاذه اليازجي، حيث حاول أن يتحرر فيها من قيود الوزن والقافية.(124) ثم جاءت بعد ذلك محاولات الشعراء الشبان الذين تعددت تسمياتهم وتصنيفاتهم على صفحات المجلات الذائعة الصيت كمجلة »أبوللو«، ومجلة »الرسالة«، ومجلة »الأديب«٭ وغيرها من المجلات. ويعتبر الريحاني أول شاعر عربي اهتم بالشعر المنثور كحركة شعرية جديدة في الشعر العربي. وهو ما يدعى عنده بالفرنسية (vers libre) وبالإنجليزية (free verse) أي »الشعر الحر الطليق«، وذلك بفعل إطلاق شيكسبير الشعر الإنجليزي من قيود القافية. وإطلاق وولت وايتمان الشعر من قيود العروض. وقد جعل الريحاني لهذا الشعر الطليق »وزنا جديدا مخصوصا، وقد تجيئ القصيدة من أبحر عديدة متنوعة.(125) إلا أننا نجد شعراء آخرين أطلقوا على الشعر غير المقفى مصطلح »الشعر المرسل« محاكاة لما كان يسمى بالإنجليزية بـ(blank vers)« ويرى بعض النقاد أن هذا الجنس من الشعر ليس جديدا على الشعر العربي الذي عرف قديما في نماذجه الشعر غير المقفى(ومنهم من صنف هذا النوع من الشعر بالشعر المنثور). وكثيرا ما كان يخلط النقاد بين الشعر المنثور والشعر المرسل.
يعتبر محمد فريد أبو حديد أول شاعر كتب الشعر المرسل في مصر والعالم العربي. وكتب أبو شادي كذلك الشعر المرسل، كما كتب الشعر الحر. وقد وصل الشعر المرسل على يد علي أحمد باكثير درجة عالية مقلدا شكسبير في مسرحياته فاعتمد تجربة الشعر غير المقفى. ففي تقديمه لمسرحية »روميو وجولييت« وصف نظمه بأنه »مزيج من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر«(126). إلا أن هذه المصطلحات لم تخرج من دائرة »الشعر المنثور«. فكتابة الشعر غير المقفى ليس أمرا جديدا، فقد عرف الشعر العربي قديما كتابة الشعر الغير المقفى، إذ يعتبر رزق الله حسون، أول شاعر كتب الشعر غير المقفى في الأدب العربي الحديث، إلا أنه لم يطلق تسمية على تجربته الجديدة، واكتفى بالقول أنها جاءت »على أسلوب الشعر القديم بلا قافية.« وفي مقال لنجيب حداد قارن فيه بين الشعر الأوربي والشعر العربي، وأطلق على هذا الشعر اسم »الشعر الأبيض« وهو ترجمة حرفية للمصطلح الفرنسي vers blanc واستعمل هذا المصطلح أيضا ل. شيخو في كتابه »تاريخ الآداب العربية في الربيع الأول من القرن العشرين« حيث عرفه بقوله »فيما يدعونه بالشعر الأبيض غير المقفى«. على حين سماه نعيمة في الغربال »الشعر المطلق (غير المقفى)«. أما إبراهيم العريض فاستخدم »الشعر المطلق« مرادفا للشعر المرسل. وسماه خفاجي في كتابه »مذاهب الأدب« »الشعر المطلق أو المرسل«. وعلى أية حال فإن المصطلح الذي يقابـل blank verse في العربية ويحظى بالشيوع هو »الشعر المرسل« وهو المصطلح الذي استخدمه معظم الشعراء والنقاد العرب، ولا سيما المصريون. أم نيقولا فياض فقد رأى أن يطلق على تجربته القائمة على أساس التقنية العروضية - والتي طورها إلى »شعر غير منتظم« أو »النظم المرسل المنطلق«- مصطلح »الشعر الطليق«. وقد اقترح حسين الغنام ساخرا أن تسمى هذه التجربة »النثر المشعور« أو »الشعرالمنثور«.
وثمة نقاد آخرون مثل سامي الكيالى وخفاجي يخلطون هذا المصطلح بمصطلح آخر هو الشعر المنثورPoerty in prose او الشعر الحر Free verse الذي يقوم على الإيقاع النثري أكثر من الإيقاع الوزني. وقد سبب اختلاف المصطلحات المستخدمة خلطا في فهم القراء الذين لم يستطيعوا التمييز بوضوح بينها، وخاصة أن بعض النقاد يسمي المزدوج والرباعيات شعرا مرسلا.(127)
أما ميخائيل نعيمة فقد أطلق على الشعر المنثور مصطلح »الشعر المنسرح«، وذلك »خلال مقالة كتبها عن«وولت وايتمان«. وأوضح أن كلمة »المنسرح« لا تمت بصلة إلى البحر الخليلي المعروف، وإنما الدافع لاختيارها، ما تعنيه هذه الكلمة، من الانطلاق والحركة في الجري إلى الهدف بسهولة ويسر ودون قيود. وخلص نعيمة إلى أن أبرز صفات هذا النوع من الشعر هي، عدم تقييده بوزن أو بقافية، وجريه »على السجية جريا ليس يخلو من الإيقاع الموسيقي والرنة الشعرية«. ويضيف الكاتب أن تحديد نعيمة »أكثر دقة من التحديدات الريحانية وأقرب إلى مفهوم هذا الفن الشعري كما حدده رواده والنقاد الحديثون.«(128)
وهكذا نلاحظ أنه كلما اتصل العرب بالشعر الأوربي بحثوا عن وسائط جديدة تمكنهم من الخروج بالقصيدة العربية إلى أشكال فنية حديثة، لهذا تعددت مصطلحات الشعر بتعدد تصنيفاته، فوجد النقاد أنفسهم أمام مصطلحات متعددة تحيل على جنس شعري واحد وهو »الشعر المنثور«.
وفيما يلي جرد لبعض المصطلحات التي تحيل على الشعر المنثور والتي ضمتها صفحات المجلات الأدبية المواكبة لحركة التحديث الشعري، كمجلة »الأديب« ومجلة »أبوللو«، ومجلة »الكاتب«، ومجلة »الرسالة« أو في تقديم الشعراء والنقاد لبعض الدواوين الشعرية المواكبة لحركة التحديث الشعري.
المصطلحات التي أدرجت في خانة الشعر المنثور
قصة منثورة- الياقوت المنثور- الموضة الجديدة- قصيدة قصصية- الشعر المرسل- النثر الفني- مجمع البحور- النظم المرسل المنطلق- البيت المنثور- النثيرة- قصيدة نثر- النثر المشعور-الشعر العصري- الشعر الحر- الشعر الطليق- الشعر المطلق- النثر الموقع- نظم مرسل حر- الشعر المنثور- القصيدة المنثورة- الشعر الجديد- الشعر المنطلق- الشعر الحر الطليق.
فما هو مفهوم الشعر المنثور في العالم العربي؟ وكيف يمكن للنص أن يكون شعرا ونثرا في الآن نفسه؟ وما الذي طرأ على بنية الشعر حتى قرب من النثر؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر؟ وهل يتعلق الأمر بكتابة شعر بالنثر أم نثر بالشعر؟ ولماذا البحث عن قالب مختلف للشعر خارج الشعر؟ وهل الشعر المنثور خرق للحدود الأجناسية؟ وما هي المميزات النثرية في الشعر العربي والتجليات الشعرية في النثر العربي؟ ولماذا حصل هذا التداخل بينهما؟ ولماذا سلمنا بشعرية النثر رغم تخليه عن كثير من خصائص الشعر؟ وما هو الفرق بين الشعر المنثور في أوروبا وفي العالم العربي؟ وما هي وضعية الشعر المنثور في الآداب العالمية؟ وهل نجح النقاد في تصنيف الشعر المنثور كجنس مستقل بذاته؟ وكيف نصنف نصا ما أنه شعر منثور؟ ولماذا تعددت مصطلحاته؟ ولماذا اتصف بالغموض والخلط؟ وهل هو خلط مصطلحي أم خلط مفاهيمي؟ وهل الشعر المنثور نموذج التحديث الشعري في العالم العربي؟ ولماذا لم يفكر المغاربة بالشعر المنثور إلا في نهاية الأربعينيات؟ ولماذا العودة إلى الشعر المنثور في عصرنا؟ ألم يلعب الشعر المنثور دورا في تقريب الشعر من النثر؟ ولماذا لا يتحدث النقاد عن الشعر المنثور؟ ولماذا رفض بعضهم هذا الشعر؟ ومن هم الشعراء المحدثون الذين كان لهم لواء السبق في هذا الشعر؟ ولماذا لم يعد مصطلح الشعر المنثور شائعا ومتداولا؟ وهل اختفت دلالته التي صيغ من أجلها؟ أم أن المتخصصين لم يعودوا بحاجة إلى هذا المصطلح؟
هذه الأسئلة في الحقيقة هي ما يحدد موجهات اختيار الموضوع، وهي أسئلة تصل بنا إلى أن الشعر المنثور كجنس شعري ليس بديلا للقصيدة العمودية، ولكنه جنس شعري، جاء ليثبت حضوره الخاص وشعريته بفعل الإبدالات النصية الجديدة التي عرفتها القصيدة بفعل حركة التحديث الشعري، وما أريد أن أوضحه هو أن بحثنا لا يقتضي فقط التعريف بالشعر المنثور وخصائصه ومميزاته، فالشعر المنثور تعرفه كل الأمم الراقية إلا أن مصطلح »الشعر المنثور« في العالم العربي يطرح إشكالات متعددة أهمها عدم توحيد المصطلح في الممارسة النصية الرومانسية، لذلك آثرت تحديد مفهوم المصطلح عند أعلامه والوقوف على بعض نماذجه، وما طرحه هذا المصطلح من إشكال في الساحة النقدية، والظروف التاريخية التي هيأت لظهور هذا اللون من الشعر. وتعد مشكلة المصطلح أهم مشكلة واجهتها حتى خشيت أن تتحول هذه الدراسة من بحث نظري إلى بحث في المصطلح ونهج منهج الدراسة الأدبية المقارنة.
الشعر المنثور في العالم العربي يستخدم في تسمية أجناس أدبية متعددة ولعل هذا راجع إلى مسألة الترجمة غير الدقيقة، وقد استعمل الشعراء العرب الأجناس الأدبية الأوروبية كالشعر الحر والشعر المرسل وهي أجناس ذات تعريفات محددة في الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي. أما في الشعر العربي فقد وظف الشعراء في تعريفه طائفة مختلفة من المصطلحات حتى أصبح المصطلح الواحد يطلق لتسمية أجناس أدبية مختلفة نتيجة عدم اهتمام العديد من الشعراء بكيفية توظيف هذه المصطلحات عند شعراء آخرين، وقد حاولت تتبع مصطلح الشعر المنثور عند أعلامه والرجوع إلى المصطلح في أصله الإنجليزي والفرنسي كما فهمه الشعراء العرب.
نجد أن مصطلح الشعر المنثور يستخدم في مقابل ما يسمى في الأدب الإنجليزي poetey in prose« وكذلك في مقابل »الشعر الحر free verse« بالمفهوم الأمريكي الإنجليزي. وهنا نتساءل لماذا لم يحتفظ العرب بالمصطلح الدخيل وعمد معظم الشعراء والنقاد إلى التعريب ؟
هنا يطرح السؤال كيف نعثر على تسمية لجنس أدبي خارج سياق الثقافة العربية؟ ولماذا لم نحتفظ بنفس الكلمة الأجنبية؟ وإذا أردنا الاحتفاظ بنفس الكلمة ألا نصطدم بمسألة الثقافة العربية؟ لأن مشكلة المصطلح في اللغة العربية هي مسألة تتعلق بمشكلة السياق الثقافي كما أن ترجمة المصطلح هو نقل للمعرفة وليس نقلا للمصطلح في حد ذاته، ولهذا يعجز المصطلح في بعض الأحيان بعد جرده من سياقه الأصلي وتوظيفه في سياق جديد تحكمه ثقافة جديدة مختلفة.هكذا نجد أنفسنا أمام قضية ترجمة المصطلحات الحديثة التي نجد لها أبعادا دلالية وإيديولوجية في لغاتها الأصلية، فمن الصعوبة بمكان تجريدها من هذه الدلالات وإخضاعها لدلالات جديدة في سياق الواقع اللغوي في الثقافة العربية ولعل هذا ما جعل طه حسين يتمسك بمصطلح النثر الفني في فضاء عربي يتماشى مع اللغة الإيديولوجية السائدة.
إن كل مصطلح يرتبط في نشأته بالشخص الذي استعمله أول مرة، ومصطلح الشعر المنثور ارتبط في نشأته الأولى بأمين الريحاني. لكن لماذا تخلى الشعراء عن ترجمة الريحاني »الشعر المنثور« دون توضيح أسباب التخلي؟ أهو اختلاف في المدارس والاتجاهات ؟ أم أن الترجمة الثانية كانت أكثر صوابا وضبطا من الأولى؟ ولماذا لم يحتفظ الريحاني بالمصطلح الدخيل ?534;اللفظ الأجنبي?535; وعمد إلى التعريب؟ وهل يضير اللغة العربية أن تستخدم بعض المصطلحات في صيغة التعريب كما فعل شعراؤنا؟ وفي هذه الحالة ألا نجد صعوبة جمة في إيجاد ترجمة حرفية لهذه المصطلحات؟ وإذا ما قبلنا المصطلح كمصطلح دخيل إلى اللغة العربية ألا نجد بأن هذه المصطلحات الشعرية الأجنبية قد يكون لها معنى محدد في لغتها بينما لا نجد لها نفس المعنى في لغتنا أو قد تؤدي إلى ضلال المعنى؟
لا أريد لهذا العمل أن ينهج منهج الدراسة المقارنة، أو أن يكون تأريخا للشعر المنثور في العالم العربي بقدر ما ينظر في خصائص هذا الشعر، ومقوماته، كجنس شعري، وإعادة النظر في تسميته وفي مسألة ترجمة المصطلحات الحديثة لأن الترجمة غير الدقيقة تؤدي إلى الفهم الغامض لمعناه. وقد شغلنا في هذا العمل بعض الأسس النظرية للشعرية اللسانية بتوظيف »القيمة المهيمنة« »la valeur dominante« لـ»جاكوبسون« لتصنيف هذا الجنس الشعري وتعريفه، فقد لخص جاكوبسون في كتابهEssais de linguistique générale الوظائف التي تقوم بها اللغة في ست وظائف:
- الوظيفة المرجعية (أو الإحالية) (Fonction Référentielle)
- الوظيفة التعبيرية (أو الانفعالية) (Fonction Emotive)
- الوظيفة الطلبية (Fonction Conative)
- الوظيفة الشعرية (Fonction poétique)
- الوظيفة التنبيهية (Fonction Phatique)
- الوظيفة اللغوية الواصفة (Fonction Métalinguistique)
وقد اهتم »ياكبسون« بالقيمة المهيمنة la valeur dominante التي سأحاول توظيفها في هذا العمل للنظر في مستوى فاعلية المقومات الشعرية التي ستتحدد من خلال العنصر الشعري المهيمن في الخطاب لتصنيف هذا الجنس الشعري وتوضيحه بالاشتغال على نصوص يهيمن فيها الشعر والنثر.
ونحن ننجز هذا العمل واجهتنا مشاكل وصعوبات نذكر أهمها:
٭ مشكلة المصطلح، فالشعر المنثور عند الريحاني ترجمة للمصطلح الفرنسي »vers libre« والإنجليزي »free verse« وهو شعر يقوم على الإيقاع النثري أكثر من الإيقاع الوزني، ويجعل له الريحاني »وزنا جديدا مخصوصا، وقد تجيئ القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة.«(1) وهو تعريف ضعيف مما أدى إلى عمومية مفهوم المصطلح في الثقافة العربية، ورفض معظم النقاد لمصطلح الريحاني، باستعمال مصطلحات بديلة أدت إلى غموضه وإشكالية التلقي؛
٭ كثرة المصطلحات التي تطلق على الشيء الواحد. ولعل هذا راجع بالأساس إلى عدم اطلاع الشعراء والباحثين على المصطلحات التي استعملها الآخرون أو من سبقوهم؛
٭ عدم نقل المصطلح الأوروبي إلى اللغة العربية بكيفية سليمة؛
٭ القواميس العربية تكاد تخلو من مصطلح الشعر المنثور لكن مصطلح الشعر المرسل blank verse موجود بكثافة في مصطلحات اللغة الإنجليزية، ومصطلح الشعر الحر vers libre موجود كذلك بكثافة في مصطلحات اللغة الفرنسية.
٭ غياب الدراسات النظرية التي تهتم بالموضوع كانت سببا في صعوبة الإحاطة بالجانب التوثيقي، لأن الموضوع كان موزعا في مجلات، عانيت كثيرا من أجل الحصول على بعضها، والوقوف على نصوص نظرية وشعرية لأقطاب الشعر المنثور كأمين الريحاني، وجبران خليل جبران، وأحمد زكي أبو شادي، ومحمد الصباغ. إلا أنني لم أحصل على بعض المجلات المهمة في الموضوع »كمجلة المعتمد«، فلم يسمح لي مجال الإفاضة في ذكر نماذج لشعراء مغاربة كإدريس الجاي، ومحمد عزيز لحبابي وغيرهم من الشعراء. وهذا يوضح ما يعانيه الباحث من صعوبة الإحاطة بالجانب التوثيقي في الشعر العربي الحديث. لذلك اعتمدت على أربع مجلات أساسية وهي: مجلة »أبوللو«، ومجلة »الأديب«، ومجلة »الرسالة«، ومجلة »الكاتب«. بعد أن اطلعت على مجلات متعددة لم تهتم بالموضوع »كمجلة الشعر«، و»الأديب«، و»رسالة الأديب«، و»الأديب المعاصر«، و»الثقافة المغربية«، و»الحياة الثقافية«، و»الثقافة الجديدة«، ومجلة»آفاق«، و»أقلام«، و»علامات في النقد«، و»فكر ونقد«، و»كتابات معاصرة«...
اقتضت طبيعة الدراسة أن نحدد الإطار النظري الذي يدور حوله الحديث عن الشعر والنثر بتحديد مفهومهما في اللغة والأدب والفرق بينهما وترجيح النقاد بعضهما على الآخر، والخصائص اللغوية لكل منهما تمهيدا لدراسة مصطلح الشعر المنثور وما يثيره من إشكال عند النقاد والأدباء في العالم العربي. فالحديث عن الشعر والنثر هو بداية الحديث عن مسألة الأجناس الأدبية، وفي مصطلح »الشعر المنثور« نجد تلازما بين المنظوم والمنثور، مما استدعى البحث في حفريات هذا المصطلح.
أما المحور الثاني حاولت الوقوف فيه على أعلام الشعر المنثور كأمين الريحاني الذي ينعته النقاد بأبي الشعر المنثور وأحمد زكي وأبو شادي، وأحمد شوقي، وجبران خليل جبران، ومحمد الصباغ. وفي عرض النماذج حاولت توظيف »القيمة المهيمنة« la valeur dominante للنظر في مستوى فاعلية المقومات والمميزات الشعرية التي ستتحدد من خلال العنصر الشعري المهيمن في الخطاب والذي يؤثر في العناصر الأخرى. لنوضح هيمنة قيم جمالية كانت سائدة مرحلة انتشار الشعر المنثور، كما سنوضح ما يميز نصوص هذه المرحلة عن غيرها من النصوص وذلك بالاشتغال على نصوص يهيمن فيها الشعر والنثر، وقد تخضع لتصنيفات متعددة تحيل على الشعر المنثور.
في المحور الثالث سأحاول تقديم تصور عام حول الحداثة الشعرية، ويضم تقسيما رباعيا يوضح علاقة الشعر المنثور بحركة التحديث الشعري وبالحداثة الشعرية العالمية التي كانت سببا مباشرا في ظهور هذا الجنس الشعري عند بعض النقاد بالإضافة إلى إبراز سلطة النص المقدس وما كان له من تأثير على شعر هذه المرحلة، مع أخذ عينة من النصوص التي تحيل على الشعر المنثور لتوضيح الإبدالات النصية الجديدة في القصيدة العربية التي أصبحت تخضع لتصنيفات متعددة.
أ - الشعر المنثور والتحديث الشعري:
.1تحديد المصطلح:
1-1. مفهوم الشعر في اللغة:
جاء في القاموس: شَعَرَ- شِعْرًا وشَعْراً الرجل: قال الشعر، ولفلان: قال له شعرا. شَاعَرَه فشعره: غالبه في الشعر فغلبه. تَشاَعَر:تكلف قول الشعر وأرى من نفسه أنه شاعر.الشِّعْر: (مص) ج أَشْعار: كلام يقصد به الوزن والتقفية. الأَشْعَر: يقال هذا البيت اشعر من هذا أي أحسن منه. الشاعِر(فا) ج شُعَراء م شاعِرة ج شَوَاعِر وشاعِرات: قائل الشعر. شِعْرٌ شَاعِرٌ: جيد. الشُّعْرُور ج شَعَارِير، الواحدة »شُعْرُورَة«: الشاعر الضعيف جدا.(2) وجاء في معجم الأجناس والمفاهيم الأدبية أن تشكيلة البيت كانت، ولمدة طويلة، هي الخاصية الأساسية للشعر(...) إلا أن التطور الحديث يدفع إلى عزل الشعر عن البيت.(3) يضم تشكيل البيت الفرق والتكافؤ، ويكون الترجيح للتكافؤ في الصيغة الموزونة لدرجة أنّ ياكوبسون رأى فيه أساس اشتغال الخطاب الشعري.(4)
ويلاحظ من خلال هذه التعريفات أن الوزن هو المعيار الأساسي لعزل الشعر عما ليس شعرا، وقد أطلق العرب على كل علم شعرا، وإن غلب هذا المصطلح على كل كلام منظوم موزون مقفى، وعرفه العروضيون منذ الخليل بن أحمد البصري، بأنه الكلام الموزون على مقاييس العرب، أي الوزن المرتبط بمعنى وقافية.
2-1 مفهوم الشعر في الأدب:
اهتم القدماء بدراسة الشعر وتمييزه عن النثر، فابن طباطبا جعل الشعر نظما للنثر. والنظم عنده هو تخير اللفظ والوزن والصياغة، جاء في تعريفه للشعر »الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجَّته الأسماع، وفسد على الذوق. ونظمه محدود معلوم، فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه.«(5) وأهم ما في هذا التعريف كما يرى جابر عصفور هو »أنه يحدد الشعر على أساس الانتظام الخارجي للكلمات، صحيح أن التعريف لا يشير صراحة إلى القافية إلا أنها متضمنة فيه«(6) وبذلك يكون النظم والنثر قد ساهما في»تأليف العبارة«، يقول ابن وهب(7): »واعلم أن سائر العبارة في لسان العرب إما أن يكون منظوما أو منثورا. والمنظوم هو الشعر والمنثور هو الكلام«.
أما قدامة ابن جعفر فقد عرف الشعر على أنه »قول موزون مقفى يدل على معنى«(8). وجعل التسجيع والتقفية بنية للشعر، هي التي تخرج به عن مذهب النثر. فالوزن عنده، كما عند ابن طباطبا، يميز الشعر من النثر، إلا أنه لا يكفي وحده، إذ يتطلب الشعر تناسبا لا يتطلبه النثر. فالتناسب، وإن كان مصطلحا غير دقيق ولا يكفي بأغراض نقدية واضحة، كان هاجس النقاد العرب جميعا، وكأنهم كانوا يحدسون بعناصر متناقضة للشعر ينبغي على الشاعر أن يؤلف فيما بينها بشكل يوفر لها الانسجام. لقد عبر قدامة عن هذا التناسب بكلمة التآلف، فلما عرف الشعر وجعله قائما على أربعة عناصر هي: »الأربعة المفردات البسائط التي يدل عليها حده، والأربعة المؤتلفات: ائتلاف اللفظ مع المعنى، ائتلاف اللفظ مع الوزن، ائتلاف المعنى مع الوزن، ائتلاف المعنى مع القافية«. ولهذا التقسيم تعليل منطقي يسهم قدامة في تفصيله، إسهابا يتوخى الدقة، ولا يسلم من التعقيد.(9) واعتبر ابن رشيق »الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية«(10). وجعل حازم القرطاجني »الأوزان مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة جوهره«(11). ومن الأدباء في العصور الموالية من جعل الاستعارة أهم مقومات الشعر، فابن خلدون عرف الشعر بقوله »الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة، والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة«(12). وهكذا يبقى الوزن أهم مقومات الشعر. وقد تعرض محمد بنيس لقضية الوزن في مؤلفه (الشعرالعربي الحديث بنياته وإبدالاتها) يقول: كان قدامة يعرف الشعر بالقول الموزون المقفى الدال على معنى، ولكن وظيفة (أو وظائف) كل عنصر من هذه العناصر تنبه لها النقد العربي لاحقا. هكذا نرى المرزوقي يتناول الوظيفة النفسية في مقدمته لكتاب »شرح ديوان الحماسة« قائلا: »وإنما قلنا« على تخير من لذيذ الوزن »لأن لذيذه يطرب الطبع لإيقاعه، ويمازجه بصفائه، كما يطرب الفهم لصواب تركيبه، واعتدال نظومه« وهذه الوظيفة النفسية هي التي ستأخذ بعدا آخر عند حازم المتأثر بالفلاسفة المسلمين وترجمة الشعرية لأرسطو.«(13)
ويضيف محمد بنيس أن علو الأوزان في مختلف الثقافات كان عليه أن ينتظر الشكلانيين الروس لانفجار تصور مغاير، فهذا يوري تينيانوف يرى أن مبدأ الوزن »مؤسس على إعادة تجميع حركي للأداة اللفظية بحسب خصيصة نبرية. وبالتالي فإن أبسط ظاهرة وأهمها ستكون هي عزل مجموعة وزنية كوحدة، وهذا العزل هو في الوقت نفسه تصميم حركي للمجموعة الموالية، شبيهة بالأولى (ليست مطابقة لها، بل شبيهة بها)، وإذا انحسم التصميم الوزني فإننا نجد أنفسنا أمام نسق وزني، وإعادة التجميع الوزني تتم:
1) عبر تصميم وزني حركي - متتابع
2) بواسطة الحسم الوزني الحركي المتزامن الذي يؤالف بين الوحدات الوزنية في مجموعات أعلى هي الكيانات الوزنية. إضافة إلى أن العملية الأولى بطبيعة الحال ستكون المحرك المتقدم لإعادة التجميع، والثانية هي المحرك المتراجع. وهذا التصميم، وهذا الحسم (وفي الوقت نفسه هذه الوحدة) يمكنهما أن يؤثرا عمقيا ويمارسا تفكيكا للوحدات إلى أجزاء (القاسمة التفعيلة)، ويمكنهما أن يؤثرا في المجموعات العليا ويشعرانا بالشكل الوزني (السوناتة والأدوارية كأشكال وزنية). فهذه الخصيصة الإيقاعية المتقدمة - المتراجعة للوزن هي من بين الأسباب التي تجعل منه أهم مكون للإيقاع.«(14)
ويذكر محمد بنيس أن هذا التصور الحديث لقراءة الوزن »يعارض المفهوم القديم العربي وغير العربي، لوظيفة الوزن التزيينية والانفعالية المستقلة عن وظيفته البنائية للبيت والقصيدة برمتها، ثم الوظيفة البنائية لدلالية النص الشعري«(15)
وقد لقيت القافية انتقادات عنيفة من طرف الشعراء القدماء والمحدثين، لذا جاء تصنيف النقاد للمزدوجات والموشحات والمخمسات، على سبيل المثال، عند القدماء والشعر المنثور والشعر المرسل وقصيدة النثر إلى غير ذلك من التصنيفات في الشعر الحديث وهي نماذج تخلى فيها أصحابها عن ضرورة التقفية.
يرى محمد بنيس في تعريف الشعر بالقافية: »وهو النادر، لأننا لا نعثر إلا على أقوال متناثرة لبعض من يخص القافية دون غيرها من العناصر الأخرى. ومثاله رأي ابن سيرين الذي قال:« الشعر كلام عُقِد بالقوافي، فما حسن في الكلام حسن في الشعر، وكذلك ما قبح منه«(16).
من النقاد من يرى الأوزان والقوافي مظهرا للنظم لا للشعر »إذ قد يكون الرجل شاعرا ولا يحسن النظم، وقد يكون ناظما وليس في نظمه شعر. وإن كان الوزن والقافية يزيدان الشعر طلاوة، ووقعا في النفس، فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعر ويجوز سبكه في النثر«(17).
وقد رفض أصحاب الشعر المنثور هذا التعريف المتداول للشعر، فالوزن والقافية يقيد الشعر وهو ليس مقوما ضروريا، يقول أمين الريحاني: »فإذا جعل للصيغ أوزان وقياسات تقيدها تتقيد معها الأفكار والعواطف، فتجيء غالبا وفيها نقص أو حشو أو تبذل أو تشويه أو إبهام، وهذه بليتنا في تسعة أعشار الشعر المنظوم الموزون في هذه الأيام«(18). ويرى شعراء العصر الحديث أن الوزن والقافية أمر زائد على جوهر الشعر، يقول أدونيس »الشعر هو الكلام الموزون المقفى، عبارة تشوه الشعر فهي العلامة والشاهد على المحدودية والانغلاق وهي إلى ذلك معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها، فهذه الطبيعة عفوية، فطرية، انبثاقية وذلك حكم عقلي منطقي«(19). لهذا دعا الشعراء إلى تجاوز معايير القصيدة وتأسيس كتابة جديدة لا تلتزم بمراسم ومعايير الشعر العربي.
وقد تحدث ادريس بلمليح في مؤلفه (المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب) عن مبنى الشعر ومبنى النثر موضحا الفرق بين الشعر والترسل مستدلا بتحديد المرزوقي:»إن مبنى »الترسل« على أن يكون واضح المنهج، سهل المعنى، متسع الباع، واسع النطاق، تدل لوائحه على حقائقه وظواهره على بواطنه، إذ كان مورده على أسماع مفترقة (...) فمتى كان متسهلا متساويا، ومتسلسلا متجاوبا تساوت الآذان في تلقيه.« أما مبنى الشعر عند المرزوقي فعلى »العكس من جميع ذلك لأنه مبني على أوزان مقدرة، وحدود مقسمة، وقواف يساق ما قبلها إليها مهيأة، وعلى أن يقوم كل بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضمنا بأخيه، وهو عيب فيه. فلما كان مداه لا يمتد بأكثر من مقدار عروضه وضربه، وكلاهما قليل، وكان الشاعر يعمل قصيدته بيتا بيتا، وكل بيت يتقاضاه بالاتحاد، وجب أن يكون الفصل في أكثر الأحوال في المعنى وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه، والأخذ من حواشيه حتى يتسع اللفظ له فيؤديه على غموضه وخفائه« ويعلق ادريس بلمليح على أن التركيب الشعري عند المرزوقي »تركيب وزني إيقاعي، قائم بفسه، ولا مجال فيه للخلط بين الوحدة التركيبية التي تحدد خطاب النثر، وهي الجملة، والوحدة التركيبية التي يقوم عليها الخطاب الشعري، وهي البيت الذي لابد من أن ينتهي معناه بانتهاء مبناه، أي بمجيئ القافية.«(20)
ويضيف ادريس بلمليح في سياق حديثه عن التركيب الشعري أن مبنى الشعر، عند المرزوقي، نظام للتوازي »تفرضه مكونات الوزن على مكونات اللغة المنجزة في إطار الرسالة الشعرية« لأن مبنى الشعر يختلف كثيرا عن اللغة العادية وعن مبنى النثر الفني لأن نظام الشعر قائم على الوزن.(21) أما طه حسين فيرى أن الشعراء قد جددوا في »أوزان الشعر وقوافيه كما جددوا في صوره ومعانيه ملائمين بذلك بين شعرهم وحضارتهم، وقد لعب شعراء المغرب العربي بأوزانه وقوافيه ما شاء لهم اللعب. فاستحب الناس وما زالوا يستحبون لعبهم ذاك«(22). ويضيف »لم يعرف الشعر اليوناني القديم قافية ولم يعرف الشعر اللاتيني قافية وأبيح لكليهما رغم ذلك من الروعة والخلود ما لا يرقى إليه الشك. فليس على شبابنا من الشعراء بأس في ما أرى من أن يتحرروا من قيود الوزن والقافية إذا نافرت أمزجتهم وطبائعهم (...) وما أحر تشوقنا إلى لون جديد من هذا الفن الأدبي الرفيع يرضي حاجتنا إلى تصوير جديد للجمال.«(23)
يرى محمد غنيمي هلال في سياق حديثه عن موسيقى الشعر أن الإيقاع قد يتوافر في النثر، فيما يسميه قدامة بـ»الترصيع« »وقد بلغ الإيقاع في النثر درجة يقرب بها كل القرب من الشعر، أما الإيقاع في الشعر فتمثله التفعيلة في البحر العربي.«(24)
ويرى محمد بنيس أن الفلاسفة المسلمون أول من تبنى تعريف الشعر بالفصل بين الوزن والقافية متأثرين بكتاب »الشعرية« لأرسطو والشعر اليوناني، فجاء تعريف ابن سينا مميزا الشعر عند العرب وغيرهم، يقول:»إن الشعر هو كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة.«(25) أما الفارابي فقد قارن بين شعر العرب وغيرهم، يقول: »وأشعار العرب في القديم والحديث فكلها - ذوات قواف، إلا الشاذُّ منها، وأما أشعار سائر الأمم الذين سمعنا أشعارهم فجلها غير ذات قواف. وخاصة القديمة منها، وأما المحدثة منهم فهم يرومون بها أن يحتذوا في نهاياتها حذو العرب.«(26)
أما الدراسات الشعرية الغربية الخاصة بالشعر ومفهومه فلم تعط للشعر تعريفا موحدا، ويؤكد ج. ل. جوبير أنه »يصعب إعطاء تعريف موحد للشعر نظرا للتنوع الأقصى للأشكال والوظائف.«(27) مما يدل على أن هناك تصورات متعددة ومتغيرة لمفهوم الشعر، وهي تصورات ستستمر في الوجود من نص إلى آخر، مما يدل أن كل قصيدة جديدة يمكنها أن تضع محل السؤال تعريف الشعر نفسه.(28)
نستخلص من حديثنا عن مفهوم الشعر أن:
٭ الوزن هو المعيار الأساسي لعزل الشعر عن النثر.
٭ رفض أصحاب الشعر المنثور للتعريفات المتداولة، إذ رأوا أن الوزن والقافية يقيد الشعر، لذلك فهو ليس مقوما ضروريا.
٭ اختلاف الدراسات العربية والغربية في إعطاء تعريف محدد للشعر.
٣-١مفهوم النثـر في اللغة:
نثر الشيء: رماه متفرقا، والنثر خلاف النظم من الكلام(29) .
نثر الكلام: أكثره(30) .
النثري ومنثور: prose, prosaic;in prose; خلاف منظوم.(31)
جاء في لسان العرب. »هو النثرة أي الخيشوم وما ولاه، أو الفرجة بين الشاربين حيال وترة الأنف، أو الدرع الواسع، ونثر أنفه أخرج ما فيه من الأذى، ونثرت النخلة أخرجت ما في بطنها«
يعرف القاموس المحيط للفيروز آبادي كلمة »نَثَر« بنثر الشيء ينثُرُه نثْرا ونثاراً، رماه متفرقا كنثْرِهِ، فانتثر وتنَثَّر وتناثر والنثارةُ والنثَرُ ما تناثر منه، ما ينتثر من المائدة فيؤكل للثواب، وتناثروا مرضوا فماتوا، ونثر الكلام والولد أكثره، ونثر ينثر نثرا أو استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك من نفس الأنف كانتثر. توحي هذه المعاني جميعا بالتبعثر واللاتناسق لهذا سمي النثر نثرا لأن شكله يوحي بعدم التناسق عكس الشعر الذي يتميز بشكل واضح لأنه يتقيد بالوزن والقافية.
وفي المعجم الوسيط »يقال رجل نثر، مذياع للأخبار وللأسرار، والنثار والنثارة ما تناثر به الشيء.«(32) والمعجم الوسيط يقترب من المفهوم الأدبي لأنه »المنثور الكلام المرسل غير الموزون ولا المقفى، وهو خلاف المنظوم، والناثر من يجيد الكتابة نثرا، والنثر الكلام الجيد يرسل بلا وزن ولا قافية، وهو خلاف النظم، ويقال كلامه در نثير.«(33)
»النثر في الكلام لا يشبه النثر للحب، تلقيه كما اتفق بذارا، أو للطير، بل هو نظيم في مسلك العقل، والرؤية، منسوقا بنظام، تعبيرا عن خواطر ومواجيد، يقصد به الإبانة عن قصد، قد يجيئ مباشرا يساق لغرض الإفصاح عن فكرة، وقد يساق منمقا، متناغما، لغاية جمالية إلى جانب المقصود من إيراده.
وبذا يختلف النثر عن الشعر بأنه نميقة العقل، أو رغيبة الإبانة، بينما الشعر ينطلق من مناخ نفسي داخلي يسمى الحالة، وينسام على نسائم العاطفة، وأجنحة الخيال. النثر لمناخ النفس وأجوائها في المنطلقات الخارجية.
والشعر ينسل من داخل النفس ويدور في فلكها العميق، أو يتجنح للمدى القصي الأبعد«(34)
٤-١ مفهوم النثـر في الأدب:
لم يكن اهتمام الأدباء والنقاد بالشعر بأقل من اهتمامهم بالنثر والنظر في مفهومه ومقوماته وإن لم يصلنا منه إلا القليل. يرى ابن رشيق: أن ما ضاع من الموروث النثري أكثر كثيرا مما ضاع من الموروث الشعري»وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطيب أعراقها، وذكر أيامها الصالحة (...) فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره.«(35)
يرى محمد مندور أن »الإنسان عندما تعلم اللغة كان يتكلم نثرا للتعبير عن حاجات حياته، وللتفاهم مع غيره من البشر، والفرق كبير بين لغة الكلام النثرية، وبين النثر الأدبي، وأقدم النصوص التي وصلتنا نصوص شعرية لا نثرية، فالشعر تحفظه الذاكرة، والشعر أسهل حفظا من النثر، ولذلك وعت الذاكرة النصوص الشعرية، بينما لم تع النصوص النثرية كالخطب وغيرها، وتناقل البشر محفوظهم الشعري حتى اخترعت الكتابة، وبدأ عصر التدوين، فدونت أول الأمر الأشعار المحفوظة، ولذلك نطالع دائما في كتب الأدب أن الشعر أسبق ظهورا من النثر الأدبي«.(36)
وهكذا نلاحظ أن مفهوم النثر يختلف عن مفهوم الشعر، كما أن أقدم النصوص التي وصلتنا شعرية لا نثرية، لسهولة حفظ المنظوم عن المنثور. لذلك كان الشعر أسبق ظهورا من النثر الأدبي.
2- الفرق بين الشعر والنثـر:
لم يكن التفريق بين النثر والشعر واضحا عند العرب القدماء. وقد وصف عرب الجاهلية النثر القرآني بأنه شعر، ونجد انتقادا للشعر والشعراء في القرآن الكريم »والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون«(37). ويقول تعالى: »وما علمناه الشعر وما ينبغي له«(38). إلا أن النقاد لم يصنفوا القرآن الكريم لا نثرا ولا شعرا، فطه حسين يرى أن القرآن ليس شعرا ولا نثرا وإنما هو قرآن، ويرى صفاء خلوصي أن القرآن »ليس شعرا ولا نثرا إنما هو كلام سماوي إيقاعي أجمل من الشعر والنثر معا«(٩٣). ويضيف أنه لولا هذا الإيقاع الخاص بالقرآن الذي لا يجاريه أي إيقاع شعري أو نثري لما أمكن تجويده، لأن التجويد ضرب من الغناء الديني فالتفاعيل الرائعة التي تزدوج بعضها مع بعض فتؤلف هذا التأثير القوي المنسق الذي لا نجد له مثيلا أو ضربا. وهذا الإيقاع في الآيات المكية أقوى منه في الآيات المدنية.
ميز الشيخ شمس الدين النواجي في كتابه »مقدمة في صناعة النظم والنثر« بين كل من النظم والنثر والشعر فرأى أن النظم هو الكلام الموزون في الموازين العربية، وقد جمعها الخليل بن أحمد ورتبها في خمسة عشر بحرا وهي: الطويل، المديد، البسيط، الوافر، الكامل، الهزج، الرجز، الرمل السريع، المنسرح، الخفيف، المضارع، المقتضب، المجتث والمتقارب، وزاد الأخفش بحرا عليها، وسماه المتدارك. فأصبح الجميع ستة عشر بحرا، أطلق عليها: »علما العروض والقوافي.«(40). أما النثر فقد عرفه بـ»الكلام المرسل« أو »المسجع«، و»الشعر قول مقفى« موزون بالقصد.(41)
تطرق الجاحظ إلى فضل الكتاب في الثقافة العربية، فرأى للكتابة والخط ما يفوق دلالة الإشارة، لهذا رأى أن »فضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب.«(42) وهذا لا يعني أن الجاحظ يفخر بذلك ولكنه يوضح أن الشعر خاص باللغة العربية، كما أنه لا يقبل الترجمة، فـ»الشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل، ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب لا كالكلام المنثور، لهذا لا يمكن أن يكون أداة للتواصل الثقافي، فلو حول الشعر العربي بطُل الوزن الذي هو معجز الشعر العربي قائلا »وقد نقلت كتب الهند، وترجمت حكم اليونانية وحوّلت آداب الفرس، فبعضها ازداد حسنا وبعضها ما انتقص شيئا ولو حوّلت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن مع أنّهم لو حوّلوها لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهم.«(43)
أما قدامة ابن جعفر فأقام التفرقة بين النثر والشعر على أساس أن »الشعر محصور بالوزن، محصور بالقافية، يضيق على صاحبه. والنثر مطلق غير محصور فهو يتسع لقائله،« إلا أنه لا يرى الوزن كافيا لتسمية الكلام شعرا، فالشاعر »إنما سمي شاعرا لأنه يشعر من معاني القول وإصابة الوصف بما لا يشعر به غيره. وإذا كان إنما يستحق اسم الشاعر بما ذكرنا، فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفى.«(44)
يذكر التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة قولا لأبي عابد الكرخي وهو »أن النثر أصل الكلام والنظم فرعه، والأصل أشرف من الفرع والفرع أنقص من الأصل، لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فهي ظاهرة لأن جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر، ومن شرفه أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهي مع اختلاف اللغات كلها منثورة مبسوطة، ومن فضيلة النثر أيضا، كما أنه إلهي بالوحدة كذلك وهو طبيعي بالبدأة، والبدأة في الطبيعيات وحدة، كما أن الوحدة في الإلهيات بدأة.«(45) ونلاحظ أن التوحيدي يميل إلى تفضيل النثر على الشعر، لهذا جعله أصل الكلام وفي هذا تشريف له عن النظم الذي اعتبره فرعا وجاء في نفس الكتاب رأي »لعيسى الوزير« جاء فيه: »أن النثر من قبل العقل، والنظم من قبل الحس، ولدخول النظم في طي الحس دخلت إليه الآفة وغلبت عليه الضرورة واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هو النثر.«(46)
وقد سعى النقاد العرب القدامى إلى التمييز الدقيق بين الشعر والنثر للوقوف على الخصائص الجوهرية لهذا الفن، وقد اعتمد ابن الأثير الفوارق التالية:
٭ النظم وقف على الشعر دون النثر
٭ لكل فن من الفنيْن مفرداته
يتصف الشعر بالإيجاز والنثر بالإطالة (المثل السائر لابن الأثير)
وقد فضل بعض الأدباء الشعر في مخاطبة الملوك. يقول ابن رشيق: »من فضل الشعر أن الشاعر يخاطب الحاكم باسمه وينسبه إلى أمه، ويخاطبه بالكاف كما يخاطب أقل ألونة، فلا ينكر ذلك عليه.«(47)
يرى ابن رشيق القيرواني »أن النثر العربي أقدم في الوجود من الشعر وإلى أن النثر مطلق والشعر مقيد يحتاج إلى وزن وقافية.«(48)
أما محمد بنيس فيرى أن الأوزان قد كانت ومعها القافية، »هي المقياس السائد في فصل الشعر عن النثر، ومن ثم فإن الخروج على قوانينها التقليدية أول ما مس الأذن التقليدية، مما أحدث خللا لم يستسغه القارئ.«(49)
وفي التفريق بين الشعر والنثر يرى محمد غنيمي هلال أن النقد العربي لم يعن بأجناس النقد الموضوعية في النثر والشعر وإنما انحصر اهتمام النقاد في النثر الذاتي، وما نجده في أدب الرسائل فهو قريب إلى تاريخ الأدب »على أن كثيرا مما ذكروه في باب الرسائل مكرور مع ما أورده في الخطابة، ثم أن الرسائل والخطابة قد غزتهما - بعد تطورهما- دروب التخيل والمجاز، حتى قربا من الشعر، فأصبحت لغتهما في »الشعر المنثور« لا يفرقها من المنظوم غير الوزن. وقد كان الوزن هو الفاصل ما بين الشعر والنثر عند نقاد العرب، لأنهم لم يتناولوا في نقدهم غير الأدب الذاتي، والنثر فيه - كالشعر - حافل بضروب الخيال: على خلاف ما رأينا في النقد الموضوعي عند أرسطو لا يحفل بتنميق العبارة كثيرا في المسرحية والملحمة، ويرى أن الوزن ليس هو الفارق الوحيد بين الشعر والنثر، وأن الشعر الموضوعي غني بموارده الأخرى غير اللغوية، فهو أقل حاجة إلى استعمال المجاز، ولذا كان الكتاب - عند أرسطو - أحوج إلى استعمال المجاز من الشعراء.«(50) وأضاف أن أرسطو يرى أن الفصاحة والبلاغة»كما يردان في المنظوم، يردان في المنثور وأحسن مواقعها ما ورد في المنثور.«(51)
اكتشفت الدراسات الشكلية الحديثة أن اللغة الشعرية ذات بنية تميزها عن بنية الكلام النثري. فقد اهتم جون كوهن في كتابه »بنية اللغة الشعرية« بالمسألة الشعرية، حيث عالج اللغة الشعرية مستفيدا من التصور البنيوي للغة، فطبقه على الكلام أي الرسالة نفسها، حيث سيجعل من الشكل موضوع بحثه، فنظر في مجموعة من القضايا أهمها مستوى العبارة أو ثنائية »نظم- نثر« فجميع نظم الشعر تستند في الواقع إلى معايير متعارف عليها، وتشترك هذه المعايير في أنها لا تستخدم من اللغة إلا وحدات غير دالة. فإذا ما حبسنا نظرنا في النظم الفرنسي المطرد وجدناه يعتمد على الوزن والقافية، أي على المقطع والفونيم. والحال أن المقطع والفونيم وحدتان أصغر من الكلمة أو الفونيم أي أصغر من الوحدة الدلالية الدنيا ولا يغير شيئا من دلالة رسالة أن تكون بهذا العدد أو ذاك من المقاطع، كما لا يؤثر في معنى كلمة اشتراكهما مع غيرها في القافية. وقد ميز جون كوهن في كتابه »بنية اللغة الشعرية« بين نموذجي »الشعر« و»النثر«. يرى جون كوهن أن »النثر والشعر نموذجان مختلفان في الكتابة ويمكن تمييزهما داخل اللغة نفسها.«(52)
كما اعتبر الشعر نقيضا للنثر، »فالشعر ليس اختلافا عن النثر فحسب، بل إنه يتعارض معه كذلك، فهو ليس »اللا نثر«، بل »نقيض النثر«، الكلام النثري يعبر عن الفكرة وهذه بحد ذاتها استدلالية، مما يعني أن النثر يمضي من الأفكار إلى الأفكار.«(53)
فصل كوهن بين الشعر والنثر على أساس اختلاف المعنى في الشعر عنه في النثر. يقول: »في اللغة يقابل عادة الشكل بالمعنى ناسبين إلى الشكل المستوى الصوتي فقط، وفي الحقيقة يجب علينا أن نميز بين مستويين شكليين: الأول على صعيد الصوت، والثاني على صعيد المعنى. فللمعنى شكل أو »بنية« يتغير عندما نمر من الصياغة الشعرية إلى ترجمتها النثرية، فالترجمة تحافظ على المعنى لكن تفقدها.«(54)
ولأن الشكل هو لسان حال الشعر، فترجمة القصيدة إلى النثر يمكن أن تكون صحيحة إلى أبعد مدى نريده إلا أنها لا تحتفظ في الوقت نفسه بأي قدر من الشعر.(55)
الوزن عند جون كوهن لا يحقق الشعر إذا أضيف إلى النثر، فهو لا يوجد عنده »إلا كعلاقة بين الصوت والمعنى، إنه تركيب صوتي- دلالي. وبذلك يتميز عن باقي وسائل النظم كالاستعارة مثلا التي تندرج في المستوى الدلالي فقط«(56)
إذا كان الشعر، في نظر جون كوهن، نقيضا للنثر، فإن الشعر يتضمن النثر أيضا. الشعر دائري، والنثر خطوطي. وهذا المظهر المتناقض يبرز للعيان، ومع ذلك لم يقم له علم الشعر اعتبارا على الإطلاق، فلقد جعل هذا العلم من مسألة »الرجوع« سمة منعزلة، تضاف من الخارج إلى الكتابة بهدف منحها بعض الخصائص الموسيقية، في حين أن التناقض يكون البيت، لأنه ليس بكامله بيتا أي رجوعا، ولو كان كذلك لما كان باستطاعته أن يحمل معنى، وبما أنه يحمل معنى فإنه يظل خطوطيا. فالكتابة الشعرية هي شعر ونثر في آن. قسم من عناصرها يحقق الرجوع بينما يحقق القسم الآخر الخطوطية العادية للكلام. والعناصر الأخيرة تعمل في الاتجاه العادي للتفريق، أما العناصر الأولى فتعمل على العكس من ذلك، في الاتجاه اللآتفريقي.«(57)
وهكذا يوضح كوهن أن الكتابة الشعرية دائرية على »المستوى الإيقاعي« وخطوطية على »المستوى الدلالي«، ولذلك فهي تهدف إلى نوع من الموازاة بين هذين المستويين.
وترى بربرا جونسون (Barbara Johnson) في التفريق بين الشعر والنثر الاستحالة النظرية والتاريخية لتقرير مَن مِن الشعيرات الإثنتين تسبق الأخرى، ليست سوى حجرة عثرة من المنظور المنهجي. السؤال الذي تطرحه هذه الاستحالة - استحالة الدور الذي يلعبه، في القراءة، التوزيع الحيزي لامتداد نصي - هو بالتحديد السؤال الذي يطرحه مفهوم »الشعر في حالة نثر«. لأنه إذا كان، كما يرجوه كلوديل Claudel، »البيت الجوهري والأساسي« ليس سوى »فكرة معزولة ببياض«(58)، إذا كان الفرق الشكلي بين بيت شعري ونثر ينحصر بالدرجة الأولى في فرق المسافة، إذن كل تساؤل حول »شعرفي حالة نثر« محتو على تنظيم توزيع حيزي لا هو بطارئ له ولكنه يساهم في تكوينه.
لتحليل سير عمل مجال شعيراتنا الإثنتين، فلنقارنْ مثلا المقاطع التالية: زيت الكوك، مسك وقطران وقطران، مسك وزيت الكوك. ما الذي تغير في التبادلية في المواضع؟ الكلمات هي نفسها. لم يتغير شيئ لا في المعنى، ولا في الدلالة، ولا في العلامة، ولا في العلاقة النحوية. المقطع الأول أخذ من الشعيرة الشعرية، والمقطع الثاني أخذ من الشعيرة النثرية. المقطع الأول لا هو أكثر أدبيا، ولا أكثر مجازية، ولا أكثر نموذجية، ولا هو أكثر تركيبية من المقطع الثاني.
لنفترض أن الفرق بين النثر والشعر ليس هو الجوهر ولكن المرجع، هل لا نتوصل بالتحديد إلى المفهوم التناظري، خطأ، للعلاقة بين الشعر والنثر الذي يفترضه أن يعالجه »الشعر في حالة نثر«.
في الحقيقة النقص في الملاحظات السالفة ينقسم إلى قسمين:
1- لا تأخذ بعين الاعتبار بأن النثر، في مفهومه الشائع، ليس نصا موسوما »نثر« لكن عكس ذلك فهو نص لا يحمل أي إشارة لسانية، فهو الشيء الذي نفعله جميعا، مثل M. Jourdain دون أن نعلمه. فهل كل نص يُصرّ على قانون النثر يسمى »نثرا«؟ وهل الفرق بين النثر والشعر يظهر بين طابعين، أو بين وجود أو غياب النوع؟
2- إذا كان إبراز مدلول« نثر »ب« شعر في حالة نثر »يتعلق بإبراز قانون«لا شعر« أو »شعر منحرف« أو بصيغة أخرى إن »الشعر في حالة النثر« ينبني على الشعر الذي يندثر والذي لا يؤكد ماهيته إلا بإحالته على ما ليس هو، إذن »الشعر في حالة النثر« يُشتق، في الحقيقة، أيضا من بين رمزين اثنين يختار النص الانتماء إلى أحدهما.
نجد أنفسنا أمام عكسين يلتقيان فيما بينهما. الشعر في حالة النثرهو المصدر الذي منه تختل القطبية بين وجود وغياب، بين نثر وشعر.
إن وصف »الشعر في حالة النثر« لا يتم إلا من خلال هدم محاولة وصفه نفسها. عدم معرفة ماهية الفرق، هو في نفس الوقت تساؤل حول كيفية تغيير عدم التأكد بأثر رجعي التأكد السابق، والتحدث سوى انطلاق من عدمية هذا التأكيد.
إن سؤال الفرق، الذي لا يمكن لا الإجابة عليه ولا معرفة ماذا يسأل السؤال، لا يمكن إلا أن يتكرر، لكن تكرار هذا الخلل الوظيفي للسؤال هو الذي يولد نص الأشعارفي حالة النثر.(59)
نستخلص تعدد الفروق بين الشعر والنثر، إلا أنهما يلتقيان في قدرة كل منهما على بلوغ الجمال الفني سواء في صياغتهما الفنية أو في الإيقاع المميز لكل منهما، سواء كان إيقاعا نثريا أو إيقاعا شعريا أي الإيقاع الذي يبنيه الوزن والقافية أو اللفظة والتعبير.
يخيل إلي أن الفرق بين منزلة الشعر ومنزلة النثر يرجع بالأساس إلى طبيعة الموضوعات التي تحدد طبيعة جنس الكتابة، شعرا كان أم نثرا أو التوفيق بينهما.
3- ترجيح الشعر على النثـر:
اختلف النقاد في ترجيح الشعر على النثر. يرى زكي مبارك أن »إيثار الشعر على النثر له مظاهر كثيرة في البيئات العربية، فهذا أبو بكر الخوارزمي الذي كان يحفظ نحو خمسين ألف بيت من الشعر لم يعرف عنه أنه اهتم بحفظ الرسائل حتى ذكروا أنه لم يحفظ غير رسالة واحدة في »كتاب الصاحب« إلى ابن العميد جوابا عن كتابه عليه في وصف البحر. والواقع أن الشعر أقرب إلى النفس من هذه الناحية، وهو بالذاكرة أعلق، وعلى الألسنة أسير بفضل القوافي والأوزان.«(60)
ويذكر الكاتب أن من كُتّاب القرن الرابع من فاضل بين الشعر والنثر ومقام الكتاب ومقام الشعراء وقد لفت نظرهم ما كتبه الثعالبي في تفضيل النثر وابن رشيق في تفضيل الشعر ردا عليه، فالثعالبي نوه بفضل النثر للتفاهم في شؤون الحرب والسلم والصناعة والسياسة والإدارة. أما الموضوعات التي تمس الأحاسيس والعواطف فالشعر أصلح فيها من النثر.
ويأخذ الكاتب على الثعالبي حينما ذكر في أسباب ترجيح النثر على الشعر »أن الشعر تصون عنه الأنبياء وترفع عنه الملوك« فرأى بأن حجة التعالبي واهية لأن« الشعر أقرب إلى أرواح الأنبياء، وأنا لا أتصور الأنبياء إلا شعراء، وإن جهلوا القوافي والأوزان لأن الشعر الحق روح صرف، والنبوة الحقة شعر صراح.«(61)
وقد رد عبد القاهر الجرجاني في كتابه »دلائل الإعجاز« على من ذم الشعر والاشتغال بعلمه فدافع عنه مستدلا بالحديث النبوي الشريف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشعر وسماعه، وارتياحه له. ويرد الجرجاني على من ذم الشعر لأنه كلام موزون مقفى، يقول: »وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى، حتى كأن الوزن عيب، وحتى كأن الكلام إذا نُظم نظْم الشعر، اتضح في نفسه، وتغيرت حاله، فقد أبعد، وقال قولا لا يعرف له معنى، وخال العلماء في قولهم: »إنما الشعر كلام فحسنه حسن، وقبيحه قبيح. »وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أيضا.«(62)
أما التوحيدي فهو من نقاد القرن الرابع اتسمت آراؤه بالطابع الفلسفي. في هذه المرحلة »نشأت مسألة المفاضلة بين الشعر والنثر، وظهر فريقان متعارضان، كان كل منهما« يستعين في تفضيل الشعر أو النثر بأمور خارجة عن طبيعتهما أحيانا.«(63)
كما يورد التوحيدي آراء بعض المنتصرين للشعر. قال ابن نباتة: »من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه، والحجج لا تؤخذ إلا منه، أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون: (قال الشاعر) و(هذا كثير في الشعر) و(الشعر قد أتى به). فعلى هذا، الشاعر هو صاحب الحجة، والشعر هو الحجة.«(64) كما يقال »ما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها بيت من الشعر، ولا يقال: ما أحسن هذا الشعر لو كان فيه شيء من النثر، لأن صورة المنظوم محفوظة وصورة المنثور ضائعة.«(65)
يرى أبو هلال العسكري أن الشعر يغلب عليه الزور ولو أن الشاعر لا يرد منه إلا حسن الكلام أما النثر فعليه مدار السلطان والصدق لا يطلب إلا من الأنبياء، وفضل الشعر على النثر عند أبي هلال يرجع إلى استفاضته في الناس وتأثيره في الأعراض، والأنساب، فلا تطيب مجالس الظرفاء والأدباء إلا بإنشاده، وهو أصلح للألحان(66). ويضيف العسكري أن الشعر يسمح لعلية القوم من التطرق لمواضيع لو تناولوها نثرا جاءت ناقصة. يقول في الصناعتين: »...إن مجالس الظرفاء والأدباء، لا تطيب، ولا تؤنس، إلا بإنشاد الأشعار، ومذاكرة الأخيار، وأحسن الأخبارعندهم ما كان في أثنائها أشعار، وهذا شيء مفقود في غير الشعر.«(67)
يقول ابن رشيق »ليس للجودة في الشعر صفة إنما هو شيء يقع في النفس عند المميز«.
أما ابن رشيق ففضل الشعر على النثر، فقد جاء في باب »في فضل الشعر« من كتاب العمدة أن كلام العرب نوعان: منظوم ومنثور، ولكل منهما ثلاث طبقات: جيدة ومتوسطة ورديئة، فإذا اتفقت الطبقتان في القدر ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا لأن كل كلام منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة، فاللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وإذا كان موزونا تألفت أشتاته وهو في كل ذلك يشبه اللفظ بالدر إذا كان منثورا لم يؤمن عليه(68).
ابن رشيق فضل الشعر على النثر مستدلا على أن القرآن جاء منثورا لا منظوما »فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة، والمترسلين وليس بمترسل، وإعجازه الشعراء أشد برهانا. ألا ترى كيف نسبوا النبي صَ إلى الشعر لما غُلبوا وتبين عجزهم ؟ فقالوا: هو شاعر، لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته.«(69)
من الأدباء من فضل الشعر على النثر نذكر منهم ابن وهب الكاتب إذ يقول:
»واعلم أن الشعر أبلغ البلاغة.«(70 )
4- ترجيح النثـر على الشعر:
كما اختلف النقاد في ترجيح الشعر على النثر اختلفوا كذلك في ترجيح النثر على الشعر والمفاضلة بينهما. يرى القلقشندي في ترجيح النثر على الشعر أن النثر أرفع درجة من الشعر»إذ الشعر محصور في وزن وقافية يحتاج الشاعر معها إلى زيادة الألفاظ والتقديم فيها والتأخير، وقصر الممدود دون المقصور، وصرف ما لا ينصرف، ومنع ما ينصرف من الصرف، واستعمال الكلمة المرفوضة، وتبديل اللفظة الفصيحة بغيرها، وغير ذلك مما تلجئ إليه ضرورة الشعر فتكون معانيه تابعة لألفاظه، والكلام المنثور لا يحتاج فيه إلى شيء من ذلك، فتكون الفاظه تابعة لمعانيه«(71)
ويضيف أن النثر مبني على مصالح الأمة لما يشتمل عليه من مكاتبات الملوك وما يلتحق به من ولايات السيوف وأرباب الأقلام.(72)
في القرن الخامس الهجري »فضل المرزوقي النثر على الشعر ودعم وجهة نظره بالقول إن الخطابة كانت لدى الجاهليين أهم من الشعر، وإن الشعراء قد حطوا من قيمة الشعر بتعرضهم للسوقة حتى قيل (الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدنيء)، كما أن إعجاز القرآن لم يقع بالنظم، فلهذه الأسباب كان النثر أرفع شأنا من الشعر ومن ثم تأخرت رتبة الشعراء عن الكتاب.«(73)
في مقدمة »شرح ديوان الحماسة« يعلل المرزوقي تأخر رتبة المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب فيقول: »واعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء موجبة تأخر المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب لأمرين: أحدهما أن ملوكهم قبل الإسلام وبعده كانوا يتباهون بالخطابة، وكانوا يأنفون من الاشتهار بقرض الشعر، والثاني أنهم اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة، وتوصلوا به إلى السوقة كما توصلوا إلى العلية، وتعرضوا لأعراض الناس، ومما يدل على أن النثر أشرف من النظم أن الإعجاز به من الله تعالى جده والتحدي من الرسول عليه السلام وتعاطيه دون النظم، وقد قال الله عز وجل:« وما علمناه الشعر، وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.«(74)
ولشرف النثر قال الله تعالى: »إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.«(75) وقال ابن كعب الأنصاري: »من شرف النثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق إلا به آمرا وناهيا ومستخبرا ومخبرا وهاديا وواعظا، وغاضبا وراضيا.«(76)
يقول التوحيدي »ألا ترى أن الإنسان لا ينطق في أول حاله من لدن طفوليته إلى زمان مديد إلا بالمنثور المتبدد، والميسور المتردد ؟ ولا يلهم إلا ذاك، ولا يناغي إلا بذاك، وليس كذلك المنظوم لأنه صناعي، ألا ترى أنه داخل في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف مع توقي الكسر واحتمال أصناف الزحاف، لأنه لما هبطت درجته عن تلك الربوة العالية دخلته الآفة من كل ناحية.«(77)
جمع التوحيدي الكثير من الآراء، ونجد فيما جمعه حول مسألة إعجاز القرآن من حجج أبي عابد الكرخي مثلا في تفضيل النثر: »أن النثر أصل الكلام والشعر فرعه، والأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل. لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فهي ظاهرة لأن جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر، وإنما يتعرضون من نظم في الثاني بداعيةٍ عارضة، وسبب باعث وأمر معين. ومن شرف النثر أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهي، مع اختلاف اللغات، كلها منثورة مبسوطة، متباينة الأوزان، متباعدة الأبنية، مختلفة التصاريف، لا تتقيد بالوزن، ولا تدخل في الأعاريض، ومن شرفه أيضا أن الوحدة فيه أظهر، وليس كالمنظوم داخلا في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف، مع توقّي الكسر واحتمال أصناف الزحاف.«(78) وذهب عيسى الوزير إلى »أن النثر من قبل العقل، والنظم من قبل الحس.«(79) وقال ابن طراوة - وكان من فصحاء أهل العصر في العراق - »النثر كالحرة والنظم كالأمة، والأمة قد تكون أحسن وجها وأدمث شمائل وأحلى حركات، إلا أنها لا توصف بكرم جوهر الحرة.«(80)
»الحاتمي في القرن الرابع الهجري، يجعل في كتابه »حلية المحاضرة« بابا في نظم المنثور، أي نقل المعنى من النثر إلى الشعر.«(81)
يحدد العسكري الخصائص التي يجب توفرها في الكاتب فيقول: »ينبغي أن تعلم أن الكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جمة وآلات كثيرة من معرفة العربية لتنقيح الألفاظ، وإصابة المعاني، وإلى الحساب وعلم المساحة والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلة وغير ذلك مما ليس هنا موضع ذكره وشرحه لأننا إنما عملنا هذا الكتاب لمن استكمل هذه الآلات كلها وبقي عليه المعرفة بصنعة الكلام وهي أصعبها وأشدها.«(82)
لخص ابن قتيبة في كتابه »أدب الكاتب« تحديد الخصائص التي تؤدي إلى الوصول إلى رتبة الكتاب كحفظ القرآن الكريم والإلمام بالحديث الشريف ليعرف الكاتب»الصدر والمصدر، والحال والظرف، وشيئا من التعاريف والأبنية وانقلاب الياء عن الواو، والألف عن الياء، وأشباه ذلك.«(83)
في المثل السائر يضع ابن الأثير أصول الكتابة ويحدد الشروط التي يجب على الكاتب الاقتداء بها لممارسة الكتابة من أهمها: »تصفح الكاتب كتابة المتقدمين، ويطلع على أوضاعهم في استعمال الألفاظ والمعاني، ثم يحذو حذوهم، وثانيهما أن يمزج كتابة المتقدمين بما يستجيده لنفسه من ريادة حسنة، إما في تحسين ألفاظه أو في تحسين معانيه، الثالثة أن لا يتصفح كتابة المتقدمين، ولا يطلع على شيء منها، بل يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم، وكثير من الأخبار النبوية، وعدة من دواوين فحول الشعراء، ممن غلب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظ، ثم يأخذ في الاقتباس، فيقوم ويقع، ويخطئ ويصيب، ويضل ويهتدي، حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه.«(84)
ويميل ابن الأثير إلى الطريقة التي ينتهجها الكاتب لنفسه فيبدع فيها. وقد جعل ابن الأثير من إلمام الكاتب بحل الآيات القرآنية والأخبار النبوية والأبيات الشعرية أهم مقومات الكتابة قائلا: »ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها، وأظفرتني بكنوز جواهرها، إذ لم يظفر غيري بأحجارها فما وجدت أعون الأشياء عليها إلا حل آيات القرآن الكريم، والأخبار النبوية، وحل الأبيات الشعرية.«(85)
ويذكر علي شلق أن نثر عبد الحميد كان »ذو رونق، تعانق أناقة الممارسة فيه ملاطف الاستعداد، وتتواكب الصنعة مع البراعة، يأخذ من النغم الموسيقي حلاوة وتطرية، وتواقيع متراتبة، ومن الشعر عذوبة، وصاحبة، ومن المعمارية تناغم لبنة مع أختها، وتلاحم مدماك بسقف، وذلك التلاقي العجيب بين عمارة العود، والقنطرة، والطنف، والبهاء، فتراه يرسل إرسالا دون تكلف الكلام، أو يسجع أحيانا دون تعلم للتنغيم.«(86)
ابن الأثير من أهم النقاد الذين اهتموا بالسجع، ففي رأيه »لو كان مذموما لما ورد في القرآن الكريم فإنه قد أتى منه بالكثير حتى أنه لا يؤتى بالصورة جميعا مسجوعة كصورة الرحمان وصورة القمر وغيرها. وبالجملة لم تخل منه صورة من الصور.«(87) وأضاف »أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام، والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء، والنفس تميل إليه بالطبع، ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد، إذ لو كان ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب من الأدباء سجاعا، وما من أحد منهم ولو شدا شيئا يسيرا من الأدب إلا ويمكنه أن يؤلف ألفاظا مسجوعة ويأتي بها في كلام، بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة طنانة رنانة، لا غثة ولا باردة. وأعني بقول رثة وباردة أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لها من الحسن ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن، وهو في الذي يأتي به من الألفاظ المسجوعة كمن ينقش أثوابا من الكرسف أو ينظم عقدا من الخزف الملون وهذا مقام تزل عنه الأقدام ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد. ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا. فإذا صفي الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد فإن وراء ذلك مطلوبا آخر: وهو أن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى لا أن يكون المعنى فيه تابعا للفظ، فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه، على باطن مشوه، ويكون مثله كغمد من ذهب على نصل من خشب.«(88)
وقف ابن الأثير على خصائص السجع وشروطه ولم يعتبره أعلى درجات القول لأن القرآن الكريم لم يأت كله مسجوعا، بل جاء بالمسجوع وغير المسجوع. وقد رأى زكي مبارك أن »بناء الجملة لم يخرج في جوهره عن السجع طوال القرن الثاني والثالث.«(89)
ويذكر جودت فخر الدين أن ابن الأثير رأى »النثر حلا للشعر، أو للآيات القرآنية أو الأحاديث والأخبار النبوية، كما جعل لكل (حل) طريقة خاصة به، وقال بان تعلم الكتابة إنما يتم عن طريق حفظ الأشعار والآيات والأحاديث. لقد كان ابن الأثير - فيما يبدو- يبحث عن مادة (معرفية) للكتابة النثرية، فوجد إلى جانب القرآن والحديث النبوي مصدرا آخر للمعرفة هو الشعر، وذلك لغزارة معانيه، كما يتضح لنا فيما يأتي« فإن قيل: الكلام قسمان: منظوم ومنثور، فلم حضضت على حفظ المنظوم وجعلته مادة للمنثور، وهلا كان الأمر بالعكس؟ قلت في الجواب: إن الأشعار أكثر والمعاني فيها أغزر، وسبب ذلك أن العرب الذين هم أصل الفصاحة جل كلامهم شعر، ولا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيرا، ولو كثر فإنه لم ينقل عنهم، بل المنقول عنهم هو الشعر، فأودعوا أشعارهم كل المعاني.(90)
اهتم النقاد القدماء بالنثر الفني وتوضيحه وعلاقته بالشعر كما حددوا الأسس التي تقوم عليها الكتابة لما كان من دور للكاتب في المحيط الاجتماعي والأدبي والسياسي.
نستخلص مما تقدم أن النثر لا يقل أهمية عن الشعر، فقد ظل منافسا له عبر العصور ويرجع عدم الاهتمام به في مرحلة من مراحل التاريخ الأدبي إلى ضياع معظم الموروث النثري الذي أدى إلى تراجعه عن الشعر في فترة من الفترات.
عبد القاهر الجرجاني في »دلائل الإعجاز« وضح أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة وإنما لملاءمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تليها، فاللفظة قد تروق في موضع وتوحش في موضع آخر.(91)
في حين نجد أن زكي مبارك يرى أن تقديم الثعالبي للنثر كان لغرض شخصي، »فخوارزمشاه الذي قدم إليه »نثر النظم وحل العقد« كان من هواة أن يقدم النثر على الشعر إيثارا لبعض الكتاب، أو حقدا على بعض الشعراء«، وهذا ليس بغريب من كتاب ذلك العصر، فأحكامهم تتأثر بأهواء الرؤساء، ويضيف زكي مبارك أن ابن رشيق الذي فضل الشعر على النثر يقول: »ولم أهجهم بهذا الرد وأورد هذه الحجة لولا أن السيد أبقاه الله قد جمع النوعين، وحاز الفضيلتين، فهما نقطتان من بحره، ونوارتان من زهره«، وهذا دليل على أن الحقائق تصور بحسب ما توحي به الأهواء.(92)
وأضاف الكاتب أن التأليف في نقد النثر كان قليلا بالنسبة للتأليف في نقد الشعر، لأن القدماء كانوا يرون الشعر أرفع فنون الجمال، أما النثر فلم يكن إلا أداة من أدوات التعبير عن الأغراض العلمية والسياسية والدينية. ويضيف بأن الوقت قد حان للعناية بالنثر، فهو اليوم صاحب السلطان في المشرق والمغرب.(93)
وأشار قدامة ابن جعفر »إلى أن السجع في الكلام كمثل القافية في الشعر، وإن كانت القافية غير مستغنى عنها والسجع مستغنى عنه فأما أن يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من فاعله، وعي من قائله.«(94)
وأشاد ابن خلدون بكتاب الرسائل، فقال »فإن صاحب خطة الرسائل والكتابة لابد أن يتخير من أرفع طبقات الناس، وأهل المروءة والحشمة منهم.«(95)
أما محمد كرد علي في »أمراء البيان« فقد بين دور الكاتب وعلو منزلته: »فقد رفع الملوك من بني العباس بعض كتابهم إلى الوزارات، وقلما رفعوا شاعرا لشعره لأن الشعر خيال وحس، والكتابة عقل وحقيقة، وحاجة الملوك في تدبيرها إلى العقول أكثر من احتياجها إلى العواطف، والعلوم على اختلاف ضروبها تكتب نثرا.«(96)
أما سؤال التوحيدي »أيهما أشد تأثيرا« في النفس، الشعر أم النثر ؟ وقد أجاب عنه أبو سليمان المنطقي إذ قال: »النظم أدل على الطبيعة لأنه من حيز التركيب، والنثر أدل على العقل لأنه من حيز البساطة. وإنما تقبلنا المنظوم بأكثر مما تقبلنا المنثور لأنا للطبيعة أكثر منا للعقل، والوزن معشوق للطبيعة والحس، ولذلك يفتقر له عندما يعرض استكراه في اللفظ، والعقل يطلب المعنى، فلذلك لا حظ للفظ عنده وإن كان متشوقا معشوقا.«(97) وقد أشار جودت فخر الدين إلى أن التوحيدي أثار أسئلة عميقة فيما يتعلق »بطبيعة التركيب الشعري وما يتبعها من تأثير في النفوس، وإن كانت أسئلة صادرة عن هموم فلسفية أو فكرية... يبدو ذلك واضحا في طرحه للسؤال السابق بصيغة أخرى على أبي سليمان: »لم لا يطرب النثر كما يطرب الشعر ؟ فكان الجواب: لأننا منتظمون، فما لاءمنا أطربنا، وصورة الواحد (أي الوحدة) فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة.« وقد خلص أبو سليمان المنطقي من ذلك إلى تعليل إعجاز القرآن بأن صاحب الرسالة »غلبت عليه الوحدة، فلم ينظم من تلقاء نفسه، ولم يستطعه، ولا ألقى إلى الناس عن القوة الإلهية شيئا على ذلك النهج المعروف، بل ترفع عن كل ذلك، وخص في عرض ما كانوا يعتادونه ويألفونه بأسلوب حير كل سامع.«(98)
نستخلص أن العلاقة بين الشعر والنثر لا تتحدد بالعروض فحسب، لأسباب متعددة وهي:
٭ أن العروض يؤدي إلى الصنعة والتكلف.
٭ تغير الذوق تجاه الأوزان.
٭ وجود إيقاع خاص بالنثر.
5- علاقة الشعر بالنثـر:
فيما يتعلق بقضية الشعر وعلاقته بالنثر، فقد أشار أبو حيان إلى أن العروض لا يكفي الشاعر إذا لم يكن مطبوعا، لأن العروض صناعة قد تؤدي إلى التكلف، كما تنبه إلى تغير الذوق تجاه الأوزان مع تقادم الزمن وزبادة التخلي عن إنشاد الشعر، ملاحظا بذلك العلاقة بين الأوزان والألحان. وأكثر من ذلك، تنبه أبو حيان إلى إيقاع خاص بالنثر، فزاد على ابن طباطبا في تقريبه بين الشعر والنثر من ناحية المعنى، تقريبا بينهما من ناحية الإيقاع، وخلص إلى القول »أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه نظم.«(٩٩)
ويرى جودت فخر الدين أنه »لم يطرأ أي جديد جوهري على قضية العلاقة بين الشعر والنثر والمفاضلة بينهما في القرنين السادس والسابع للهجرة. إلا أن ابن الأثير قد قلب مفهوم الصنعة عند ابن طباطبا رأسا على عقبه، بأن جعل الشعر مادة للنثر بدل أن يكون النثر مادة للشعر عند ابن طباطبا. لذلك فقد نصح ابن الأثير الكتاب بحفظ الأشعار: »من أحب أن يكون كاتبا، أو كان عنده طبع مجيب، فعليه بحفظ الدواوين ذوات العدد، ولا يقنع بالقليل من ذلك، ثم يأخذ في نثر الشعر من محفوظاته، وطريقه أن يبتدئ فيأخذ قصيدا من القصائد، فينثره بيتا بيتا على التوالي، ولا يستنكف في الابتداء أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأكثرها، فإنه لا يستطيع إلا ذلك، وإذا مرنت نفسه، وتدرب خاطره، ارتفع عن هذه الدرجة، وصار يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده، ثم يرتفع عن ذلك حتى يكسوه ضروبا من العبارات المختلفة.«(100) وقد شبه غنيمي هلال علاقة النثر بالشعر بعلاقة المشي بالرقص. »فالمشي له غاية محددة تتحكم في إيقاع الخطو، وتنظم شكل الخطو المتتابع الذي ينتهي بتمام الغاية منه. أما الرقص فعلى العكس من ذلك، فعلى الرغم من استخدامه نفس أجزاء الجسم وأعضائه التي تستخدم في المشي، له نظام حركات هي غاية في حد ذاتها.«(101) ويضيف أن الشعر أيضا هو تأمل في التجربة الذاتية وهو الخلق الأدبي مرده الذوق لا الفكر لأن موضوع الذوق هو الجمال. لهذا كانت صلة الشعر بالحقائق العلمية كامنة في جمالها أو قبحها دون البرهنة عليها. وإذا كان الشعر يستعين بالموسيقى الكلامية فلقوتها الإيحائية وقدرتها على التعبير.(102)
»ومن قبل كان الشعر لا يتميز عن النثر إلا بالوزن والقافية. وكان هذا التفريق شكليا لا يبين عن روح الشعر، ولهذا تحدثوا قديما عن الشعر المنثور، كأنهم أقروا بأن روح الشعر قد توجد حيث لا نظم كما هو مصطلح عليه، وقد أصبح ينظر في الشعر إلى تلك الحميا، وإلى ذلك الشعور المشبوه في التعبير عن التجربة الذاتية. وفي هذا انصرف الشعر الحديث في جوهره إلى الموضوعات الغنائية. فالشعر التعليمي نظم لا شعر وكذلك الملاحم، فهي لا تعد شعرا إلا فيما قد تحتوي عليه من بعض مقطوعات غنائية، وكلاهما في العصر الحديث إلحاد في عالم الفن. أما المسرحية فهي -من حيث أنها مسرحية - ليست شعرا وجدانيا، لأن موضوعها وطولها لا يتمشيان مع ما عليه الشعر الوجداني، ولكنها قد تعد شعرا فيما تدل عليه من جوانب وجدانية - بوصفها عدة مقطوعات وجدانية دون نظر إلى وحدتها المسرحية الموضوعية، لأن مثل هذه الوحدة تضر بوحدة الشعر الوجداني.«(103)
وقد أقر غنيمي هلال أن ما يقصد بالغنائية لدى كل من موليير وراسين فهي ذاتية موضوعية.
6 - لغة الشعر ولغة النثـر:
فرق محمد غنيمي هلال بين لغة الشعر ولغة النثر، فجعل »لغة الشعر لغة العاطفة ولغة النثر لغة العقل، ذلك أن غاية النثر نقل أفكار المتكلم والكاتب. فعبارته يجب أن تشف في يسر عن القصد، والجمل فيه تقريرية، وعلامات على معانيها، ووسائل تنتهي بانتهاء الغاية منها. وموضوعه حدث من الأحداث أو مسألة من المسائل المبنية أولا على الأفكار. أما الشعر فإنه يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وبما حوله شعرا يتجاوب هو معه، فيندفع إلى الكشف فنيا عن خبايا النفس أو الكون استجابة لهذا الشعور، وفي لغة هي صور.«(104) صور إيحائية، تريد للكلمات قوتها التصويرية الفطرية الحسية، فيعيد بذلك إلى اللغة »دلالتها الهيروغليفية التصويرية.«(105) وقد مثل غنيمي هلال بقول فولتير »إن الشعر وضع صورة متألقة مكان الفكرة الطبيعية في النثر.«(106)
عمل الشاعر الاستجابة لشعوره أما الناثر فعمله تلبية لفكرة أو حجة. لهذا فجمال النثر كامن في صياغته وغايته وجمال الشعر في إيحائه.
يقارن محمد غنيمي هلال بين أسلوب الشعر والنثر فيرى أن »لغة الشعر موزونة. وأوزان الشعر مختلفة، ولكل وزن ما يلائمه من المعاني والأجناس الأدبية. وأما لغة النثر فليست موزونة. وينبغي ألا تكون الخطبة في عبارات موزونة، لأن الوزن يقضي- بمظهر المصطنع - على ثقة السامعين في الخطيب، ويصرف أنظاره إلى شيء آخر في نفس الوزن.ولكن ينبغي ألا تكون الخطبة خالية من الإيقاع لأنه يساعد على الإقناع. فالنثر إذا ينبغي أن يكون إيقاعيا وغير موزون.(107) أما لغة الشعر الحديث، عند بعض النقاد، فهي« الإطار العام الشعري للقصيدة من حيث صور هذا الإطار، وطريقة بنائه، وتجربته البشرية وهو ما تؤديه اللغة الشعرية من خلال الصور الشعرية والصور الموسيقية والموقف الخاص بالشاعر في تجربته البشرية«.(108)
اهتم أحمد الشايب بلغة النثر فجعلها »لغة العقل يقرر قضاياه، ويسجل نتائجه، والشعر لغة العاطفة، غالبا يصورها ويثيرها، والعقل أسرع إلى التطور، وأقبل لعوامل الرقي لأنه تفكير نظري غير مقيد بعرف أو تقاليد.«(109)
وأشار ابن طباطبا إلى أن»أحسن الشعر أن يخرج كالنثر سهولة وانتظاما.«(110) وجعل من النظم خاصية مميزة للشعر وقد جعل النثر أهم مرحلة لإرساء قواعد الشعر وبنائه قائلا »إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه.«(111)
ووضح جودت فخر الدين أن »الشاعر، حسب (مفهوم الصنعة) لابن طباطبا، يفكر نثرا يأتي بمعانيه من النثر ليصوغها أو لينظمها شعرا. فابن طباطبا لا يلحظ يالتالي، التباين في بنية المعنى بين الصيغة الشعرية والصيغة النثرية. المعنى عنده نثري في كل حال وإنما الشعر نظم يقوم على عناصر الصياغة من تخير وتركيب واستنساب وتنقيح«(112) وفي هذا لا يجد ابن طباطبا مفرا من قبول فكرة الجاحظ عن المعاني الملقاة في الطريق، فيرد براعة الصنعة، أو براعة الشعر، إلى عملية نظم المعاني وإعادة ترتيبها. لكنه يتميز عن الجاحظ بأمرين: أولهما أنه يدرك تفاوت المعاني من حيث قيمتها، فلا يسوي بينها كما فعل الجاحظ في عبارته المشهورة عن المعاني الملقاة في الطرق، وثانيهما أنه يفهم العلاقة بين المعاني والألفاظ فهما أرحب، يسوي بين المعنى والمحتوى كما يسوي بين الشكل والألفاظ.«(113). ويؤكد جودت فخر الدين »أن هذا التوحيد الذي أقره ابن طباطبا بين المعنى الشعري والمعنى النثري جعله يقارب بين القصيدة والرسالة، فرأى أن »الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر محلول«. فالمعنى الشعري، عنده، مستقل عن شكله الوزني، إذ »الوزن في تقدير ابن طباطبا مجرد قالب خارجي«، وقد أدى به ذلك إلى افتراض لذتين يولدهما الشعر: اللذة الحسية -الإيقاع، واللذة العقلية - المعنى.«(114)
صنف غنيمي هلال النثر إلى نوعين: »مستمر ومطرد، أو مقسم متقابل والأول ما ليست فيه وقفات طبيعية بين أجزائه التي لا يربط بينها سوى ألفاظ الربط، من حروف العطف والتعليق. والوقف الطبيعي يأتي في نهايتها. وهذا النوع من الأسلوب غير مستحسن، لأنه يستمر غير محدود حتى النهاية. والمرء يجب أن يرى أمامه مواضع للوقف. وإنما يلهث الناس في السباق قبل أن يروا الغاية، ولكن حين يرونها يدأبون في السير دون شعور بجهد. ولهذا يفضل أر سطو، الخطابة، العبارة المقسمة المتقابلة الأجزاء على أن يكون كل جزء منها غير طويل، »حيث يدركه الطرف بنظرة واحدة« وهذا النوع من العبارة مستحسن سهل الاتباع. أما حسنه فلأن العبارة فيه محدودة، يشعر السامع فيها أنه أفاد من كل جزء من أجزائها ليصل إلى نتيجة من سماعها وأما سهولة الاتباع فلأن العبارة يمكن تذكرها بسهولة، لأنها مقسمة إلى أجزاء، فهي أشبه بالشعر في تقسيمها العددي، والشعر أسهل اتباعا من النثر. على أن كل جزء من الأجزاء يجب أن يستقل بمعنى. ويجب كذلك ألا ينقطع فجأة بالإضافة إلى الجزء لسوفوكليس: »هذه أرض كاليدون، ومن أرض بليونيز طالعنا السهول الباسمة عبر المضيق.«(115)
جاء في »مجلة أبوللو 1934« مقال »نظرات في الشعر« لمختار الوكيل ميز فيه الكاتب بين لغة النثر والنظم، والنثر والشعر، والشعر والنظم، والنثر الشعري معتبرا لغة الشعر لغة المثل الأعلى.(116) فرأى أن الخلاف يتسع كثيرا بين النثر والشعر من حيث أنهما أداة للتعبير. فالمرء ينفعل في حياته بدوافع مختلفة لا يكاد يميز أسبابها وتأثيرها: فتارة يخضع لسلطان العقل دون أن يعرف سبب ذلك وبذلك يبتعد عن العاطفة التي تجذب المرء نحو الأمر الذي ترغب فيه. ويخضع له خضوعا مطلقا من حيث لا يدري لذلك من سبب مشروع، هذا والعقل يختبر الأشياء ويفحصها ببرودة وجفاف ويضغط على كل ما عساه يمت إلى العاطفة بسبب، ويقرر في الأخير حالة واحدة، تستنبطه من تفكيره الصارم، ويقف حيالها لا يريم ولا يتحول، في حين أن العاطفة تجذب المرء نحو المر الذي تحبذه وترغب فيه.(117)
وأشار في تمييزه بين النثر والنظم أن »التعبير عما يجول بالفكر عن طريق الألفاظ سبيلان مختلفان: أحدهما يتبع قواعد اللغة المقررة ولا يحيد عنها قيد أنملة، ويجري أسلوبه بحيث يوضح في جلاء الأفكار والآراء المقصودة منه، وهذا ما يعرف بالنثر، والآخر يخرج على تلك القواعد حيثما يضطر إلى ذلك، ويخرج كذلك على حروف الهجاء وتراكيب الألفاظ حين تضطره الموسيقى، ويعبر عن أفكاره وآرائه بأساليب تميل إلى الغرابة وتدعو التأمل والتفكير، وهو ما نطلق عليه اسم النظم. وهنا يعن لنا السؤال الآتي: أي السبيلين يتبع المرء في التعبير عن أفكاره: الشعر أم النثر؟(118)
واستخلص الكاتب في تمييزه بين الشعر والنظم أن الناس »قد اصطلحوا منذ القديم على أن الشعر إنما يجب أن يجيء في صورة تميزه عن لغة الحوار والكتابة العادية، فكان أن تدرأ الشعر برداء النظم وهكذا بقي النظم إلى وقتنا هذا عاملا أساسيا في قول الشعر«(119)
وقد تمتزج لغة الشعر بالنثر في بعض الأجناس الشعرية كالملاحم. فالبستاني يرى أن الملاحم عند اليونان مزيج من النثر والشعر، إذ يرى أن الشعر عند جميع الأمم لا يأتي على نسق واحد وربما كان هذا التباين سببا إلى ظهور أنواع من الجمال مختلفة الأشكال والصور، يقول »فالشاعر القصصي من اليونان وخلفائهم كان إذا قص حادثة رواها كلها شعرا وأما الشاعر العربي فينشد الشعر حيث يحسن وقعه وأكثر ما يكون ذلك في الوصف والخطاب والجواب ويقول الباقي نثرا. وفي هذه الطريقة نوع من التفكيه المأنوس. وهي طريقة شعراء البادية حتى يومنا. جلست مرة إلى حلقة شاعر منهم ينشد على نغم ربابته فشرع في مقدمة نثرية قصيرة حتى بلغ إلى وصف حسناء فجعل يتغنى بالشعر على نغم آلة الطرب فلما استتم قصيدته رجع إلى الكلام النثري بضع دقائق حتى بلغ وصف وقعة بين قبيلتين فرجع إلى الإنشاد وهكذا ظل يتراوح قوله بين نثر وشعر نحو ثلاث ساعات، وذلك أيضا شأن القصاصين في كثير من الحواضر العربية.(120) وهكذا نلاحظ أن خاصية الخطاب الشعري متميزة عن الكتابة العادية لما يتميز به الشعر من خضوع لسلطان العاطفة وخرق لقواعد اللغة، وقد تحدث محمد بلبداوي عن خاصية الخطاب الشعري عند الأوروبيين، يقول: »ابتدأت جماعة (مو) وهي تعيد البحث والنظر في خاصية هذا الخطاب بمناقشة مصطلح »الانزياح Lécar« ومعادلاته المترددة على أقلام باحثين متنوعي الاهتمامات. من هذه المعادلات على سبيل المثال: »تجاوزAbus« (فاليري)، و»انتهاك viol« (ج. كوهن). و»زلةscandale« (بارث)، و»شذوذ anomalie« (تودروف)، و»جنون« folie (أراكون) و»انحرافdéviation« (سبيتزر) »هدمsubversion« (ج. بيطار) J. Peytard، و»خرقinfractio« (م. ثيري.Thiry M.). ولاحظت الجماعة أن هذه المصطلحات مع أنها تنتمي إلى معجم أخلاقي لم يبد أي واحد من خالقيها أو مروجيها أي رد فعل حيال هذا الأصل المعجمي الذي قد يوحي في المجمل الأعم أو يحيل على تلك النظرية التي تعتبر الفن ظاهرة مرضية، والتي كان لها صيت قوي في القرن التاسع عشر.(121)
7- الشعر المنثور وإشكالية المصطلح:
لقد التصق مصطلح الشعر المنثور بحركة التحديث الشعري التي أعلن عنها كل من امين الريحاني وأحمد زكي أبو شادي وجبران خليل جبران، وإبراهيم ناجي، وأبو القاسم الشابي، وحسن كامل الصيرفي، وعلي محمود طه، وخليل شيبوب، وغيرهم من الشعراء. وقد عرف محمد حسن عواد الشعر المنثور بقوله: »الشعر المنثور شعر أصيل قائم في الآداب كلها، ومعروف معترف به في العربية لا يحتاج الأمر فيه إلى جدال لأن الشعر في حقيقة أمره موجة أو سيال باطني يبعث فكرة كبيرة، أو فطرة مستهوية تتصل بعالم من عوالم الدنيا أو من عوالم النفس الإنسانية فهو حياة من حيوات النفس وليس صياغة أو هندسة أو لعبا بالألفاظ. هذه الفلسفة نستطيع أن ندرك منها أن للشعر الحديث تاريخا هائلا منذ القدم. وليس هو جديد علينا كما يذهب بعض الكتاب إلى تسميته بالموضة الجديدة. وأذكر هنا أن العرب كانوا يسمون القرآن شعرا(...) وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يدافع عن القرآن(...) إذن نعرف من ذلك أنهم يعرفون الشعر غير القافية والوزن.(122)
وقد قام الشعر المنثور على أساس نثري باستخدام موسيقى الفكر التي تعتمد على التوازي والترادف والتقابل والتنظيم التصاعدي للأفكار، إلى جانب تكرار السطور والكلمات والأفكار في مجموعات متنوعة وذلك تقليدا للشعر الحر الذي يكتبه الإفرنج.(123)
لم يعرف أي جنس من الشعر ما عرفه الشعر المنثور من إشكالية المصطلح. فقد كان الريحاني أول من استعمل هذا المصطلح سنة 1905، وتبعه مطران سنة 1906 في مرثيته لأستاذه اليازجي، حيث حاول أن يتحرر فيها من قيود الوزن والقافية.(124) ثم جاءت بعد ذلك محاولات الشعراء الشبان الذين تعددت تسمياتهم وتصنيفاتهم على صفحات المجلات الذائعة الصيت كمجلة »أبوللو«، ومجلة »الرسالة«، ومجلة »الأديب«٭ وغيرها من المجلات. ويعتبر الريحاني أول شاعر عربي اهتم بالشعر المنثور كحركة شعرية جديدة في الشعر العربي. وهو ما يدعى عنده بالفرنسية (vers libre) وبالإنجليزية (free verse) أي »الشعر الحر الطليق«، وذلك بفعل إطلاق شيكسبير الشعر الإنجليزي من قيود القافية. وإطلاق وولت وايتمان الشعر من قيود العروض. وقد جعل الريحاني لهذا الشعر الطليق »وزنا جديدا مخصوصا، وقد تجيئ القصيدة من أبحر عديدة متنوعة.(125) إلا أننا نجد شعراء آخرين أطلقوا على الشعر غير المقفى مصطلح »الشعر المرسل« محاكاة لما كان يسمى بالإنجليزية بـ(blank vers)« ويرى بعض النقاد أن هذا الجنس من الشعر ليس جديدا على الشعر العربي الذي عرف قديما في نماذجه الشعر غير المقفى(ومنهم من صنف هذا النوع من الشعر بالشعر المنثور). وكثيرا ما كان يخلط النقاد بين الشعر المنثور والشعر المرسل.
يعتبر محمد فريد أبو حديد أول شاعر كتب الشعر المرسل في مصر والعالم العربي. وكتب أبو شادي كذلك الشعر المرسل، كما كتب الشعر الحر. وقد وصل الشعر المرسل على يد علي أحمد باكثير درجة عالية مقلدا شكسبير في مسرحياته فاعتمد تجربة الشعر غير المقفى. ففي تقديمه لمسرحية »روميو وجولييت« وصف نظمه بأنه »مزيج من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر«(126). إلا أن هذه المصطلحات لم تخرج من دائرة »الشعر المنثور«. فكتابة الشعر غير المقفى ليس أمرا جديدا، فقد عرف الشعر العربي قديما كتابة الشعر الغير المقفى، إذ يعتبر رزق الله حسون، أول شاعر كتب الشعر غير المقفى في الأدب العربي الحديث، إلا أنه لم يطلق تسمية على تجربته الجديدة، واكتفى بالقول أنها جاءت »على أسلوب الشعر القديم بلا قافية.« وفي مقال لنجيب حداد قارن فيه بين الشعر الأوربي والشعر العربي، وأطلق على هذا الشعر اسم »الشعر الأبيض« وهو ترجمة حرفية للمصطلح الفرنسي vers blanc واستعمل هذا المصطلح أيضا ل. شيخو في كتابه »تاريخ الآداب العربية في الربيع الأول من القرن العشرين« حيث عرفه بقوله »فيما يدعونه بالشعر الأبيض غير المقفى«. على حين سماه نعيمة في الغربال »الشعر المطلق (غير المقفى)«. أما إبراهيم العريض فاستخدم »الشعر المطلق« مرادفا للشعر المرسل. وسماه خفاجي في كتابه »مذاهب الأدب« »الشعر المطلق أو المرسل«. وعلى أية حال فإن المصطلح الذي يقابـل blank verse في العربية ويحظى بالشيوع هو »الشعر المرسل« وهو المصطلح الذي استخدمه معظم الشعراء والنقاد العرب، ولا سيما المصريون. أم نيقولا فياض فقد رأى أن يطلق على تجربته القائمة على أساس التقنية العروضية - والتي طورها إلى »شعر غير منتظم« أو »النظم المرسل المنطلق«- مصطلح »الشعر الطليق«. وقد اقترح حسين الغنام ساخرا أن تسمى هذه التجربة »النثر المشعور« أو »الشعرالمنثور«.
وثمة نقاد آخرون مثل سامي الكيالى وخفاجي يخلطون هذا المصطلح بمصطلح آخر هو الشعر المنثورPoerty in prose او الشعر الحر Free verse الذي يقوم على الإيقاع النثري أكثر من الإيقاع الوزني. وقد سبب اختلاف المصطلحات المستخدمة خلطا في فهم القراء الذين لم يستطيعوا التمييز بوضوح بينها، وخاصة أن بعض النقاد يسمي المزدوج والرباعيات شعرا مرسلا.(127)
أما ميخائيل نعيمة فقد أطلق على الشعر المنثور مصطلح »الشعر المنسرح«، وذلك »خلال مقالة كتبها عن«وولت وايتمان«. وأوضح أن كلمة »المنسرح« لا تمت بصلة إلى البحر الخليلي المعروف، وإنما الدافع لاختيارها، ما تعنيه هذه الكلمة، من الانطلاق والحركة في الجري إلى الهدف بسهولة ويسر ودون قيود. وخلص نعيمة إلى أن أبرز صفات هذا النوع من الشعر هي، عدم تقييده بوزن أو بقافية، وجريه »على السجية جريا ليس يخلو من الإيقاع الموسيقي والرنة الشعرية«. ويضيف الكاتب أن تحديد نعيمة »أكثر دقة من التحديدات الريحانية وأقرب إلى مفهوم هذا الفن الشعري كما حدده رواده والنقاد الحديثون.«(128)
وهكذا نلاحظ أنه كلما اتصل العرب بالشعر الأوربي بحثوا عن وسائط جديدة تمكنهم من الخروج بالقصيدة العربية إلى أشكال فنية حديثة، لهذا تعددت مصطلحات الشعر بتعدد تصنيفاته، فوجد النقاد أنفسهم أمام مصطلحات متعددة تحيل على جنس شعري واحد وهو »الشعر المنثور«.
وفيما يلي جرد لبعض المصطلحات التي تحيل على الشعر المنثور والتي ضمتها صفحات المجلات الأدبية المواكبة لحركة التحديث الشعري، كمجلة »الأديب« ومجلة »أبوللو«، ومجلة »الكاتب«، ومجلة »الرسالة« أو في تقديم الشعراء والنقاد لبعض الدواوين الشعرية المواكبة لحركة التحديث الشعري.
المصطلحات التي أدرجت في خانة الشعر المنثور
قصة منثورة- الياقوت المنثور- الموضة الجديدة- قصيدة قصصية- الشعر المرسل- النثر الفني- مجمع البحور- النظم المرسل المنطلق- البيت المنثور- النثيرة- قصيدة نثر- النثر المشعور-الشعر العصري- الشعر الحر- الشعر الطليق- الشعر المطلق- النثر الموقع- نظم مرسل حر- الشعر المنثور- القصيدة المنثورة- الشعر الجديد- الشعر المنطلق- الشعر الحر الطليق.