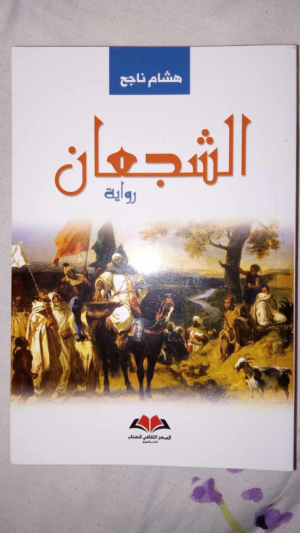أيار 1955: بيروت الثقافيّة تستعدّ لاستقبال حدث ثقافيّ فكريّ وسياسيّ، كبير وفريد: مناظرة بين علميْن بارزيْن من أعلام الثقافة العربيّة الحديثة: طه حسين ورئيف خوري. موضوع المناظرة مثير للفضول وملتبس: "لمن يكتب الأديب؟ للخاصة أم للكافّة؟" ولأمرٍ ما، شاء منظِّمُ المناظرة ومحرِّكُها، سهيل ادريس، أن يوكل لرئيف خوري أخذَ جانب "الكافة،" وأن يطلب من طه حسين أخذ جانب "الخاصة." تحمّس رئيف لهذا الاختيار، وأظهر طه أنّه استجاب للطلب، ثم ظهر أنّه إنّما استجاب للموضوع لأمرٍ يبدو كأنّه "خارج الموضوع."
إذا كانت المحاضرات والندوات وأحداثٌ عاديّة تكتسب أهميّتها من أسماء المشاركين فيها، أساسًا، فإنّ "المناظرة،" أي السجال العلنيّ، وبالأخصّ بين علميْن من وزن طه حسين ورئيف خوري، تعطي الحدث فرادته، بما يبرّر ذلك الاستعدادَ الحماسيّ له في مختلف الأوساط الثقافيّة في لبنان... فاختيرت لمكانِ المناظرة قاعةُ الأونيسكو. في ذلك العام، كنتُ معبّاً ضدّ رئيف خوري، ميّالًا، ولو بحذر وترقّب، لما سيقوله طه حسين. وكنّا، حسين مروة وأنا، نتعاون في تحرير مجلة الثقافة الوطنيّة (ثقافيّة فكريّة شهريّة، يصدرها الشيوعيون في لبنان). وكانت "الحرب" معلنة، في صحافة الشيوعيين، ضدّ رئيف خوري وآخرين، بتهم: التحريفية، والخروج على الخطّ الأمميّ، والعداء للاتحاد السوفياتي... وكان الأدباء التقدميون والماركسيون في مصر يخوضون (باسم الأدب الجديد والأدباء الشباب) معركةً ضدّ طه حسين والعقّاد والحكيم، بدعوى أنّ هؤلاء يمثّلون الأدبَ القديم المحافظ، والأدباءَ الشيوخ والبرجعاجيين... وأدّت صحفُنا الشيوعيّة هنا "قسطَها" في هذا الاتجاه. وكنّا قد عملنا، حسين مروّة وأنا، على جمع كتابات نقديّة لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، وإصدارها (عام 1954) في كتاب بعنوان في الثقافة المصريّة، الذي اعتُبر بمثابة "البيان الثقافيّ" للأدباء الشباب الماركسيين في تلك المعركة.
ذهبتُ، إذن، إلى قاعة الأونيسكو، متوقِّعًا أن أشهد انفجارَ معارك كلاميّة في كلّ اتجاه: رئيف خوري "الخارج على الماركسيّة" في معركة ضدّ الشيوعيين، وضدّ طه حسين "الخارج،" هو أيضًا، على طليعيّة وتجديديّة طه حسين نفسه والمشتبك كذلك مع أدباء ونقّاد ماركسيين!
كانت تلك أوّلَ مرّة أسمع فيها رئيف خوري، خطيبًا: صوت هادر، وهامة هادرة، يخطب بجسمه كلّه، بحركة جسمه وإيقاعات يديه، وانفعالاته الحماسيّة في كلّ كلمة أو جملة تتطلّب هذا الحماس. وكانت ابتسامته الساخرة تعطي كلامه واقعًا محبّبًا. وكان رئيف خوري صادقًا؛ فرغم أنّني كنت معبّأً ضدّه، فقد وصل إليّ صدقُه. وصدقُه هذا، إلى تماسك منطقه، كان يعطي كلامَه قدرةَ الإقناع.
وفي حدود معرفتي، يومها، بالمفاهيم الماركسيّة حول الأدب والفنّ والواقعيّة و"الأدب الهادف" وما أشبه... لم أجد في كلام رئيف ما يتناقض مع تلك المفاهيم، وشعرتُ بأنّه يعطي تلك المفاهيم روحًا وتلاوينَ محليّةً، عربيّة، تبعدها عن عموميّة التجريد وتقرّبها إلى نبض الحياة الراهنة. على أنّني وجدتُ يومها في كلامه الانتقاديّ لوضع الأدب والأدباء في الاتحاد السوفياتيّ، وافتقارهم الى الحريّة، ما حسبتُ أنه يتناقض مع المضمون العام لخطابه (سيتبيّن لنا، بعد سنوات وتجارب مريرة، واختبارٍ عينيّ لواقع أوضاع الأدب والأدباء في الاتحاد السوفياتي حتى قبل انهياره بسنوات كثيرة، أنّ كلام رئيف ذاك كان هو الصحيح، وهو المنسجم مع منطق فهمه الماركسيّ، في خطابه، للدور الاجتماعيّ التحرّري للأدب، ولضرورة استقلالية الأديب في علاقته مع السلطة.
وعندما جاء دورُ طه حسين، كنتُ أتساءل: هل سيدخل في عراك مع رئيف خوري ومع طه حسين الآخر، الذي كان طليعيًّا مجدِّدًا؟
وسط أمواج هادرة من التصفيق الحماسي والمحبّ، أوصلوا طه حسين إلى المنبر. لا أذكر الآن (بعد أربعين عامًا من هذا الحدث) هل ألقى طه حسين خطابه واقفًا أمْ جالسًا على كرسيّ خلف المنبر. لكنّني أتذكّر أنّه كان منتصبَ الظهر، واضعًا يديه أمامه، على حافة المنبر أو على ركبتيه، دون أن يحرّكهما. جسمه هادئ يكاد لا يتحرّك فيه سوى الشفتين. والكلام يصدر عنه منغومًا موقّعًا كأنّه يرتّله ترتيلًا. يلقي كلامه (وهو الأعمى) بتدفّق ويُسرٍ كأنّه يقرأ في لوحةٍ ما أمامه كلامًا مكتوبًا بخطّ واضح. وتشعر، من نبرته وإيقاعات صوته ووقفاته، بعلامات الكلام: هنا نقطة، وهناك فاصلة، وهنا استفهام، وهناك علامة تعجّب أو أكثر، وهنا سطر جديد، وهناك مقطع جديد من الموضوع. كلّ هذا يسري إليك في صوت عذب، ساحر فعلًا، ويعرف كيف يجذبك إليه، ولا تعرف كيف انجذبتَ بكليّتك إليه، فإذا أنت فيه، في خضم الكلام، وإذا عيناك شاخصتان في اتجاه وجه الرجل وشفتيه، وسمعك يصغي إلى موسيقى الكلام.
لم يقل طه حسين ما كنتُ قد توقّعتُه منه. كان في كلامه، أولًا، ما ينقض توقّعاتي وتصوّراتي المسبّقة، الآتية من غبار تلك المعركة التي ثارت بينه وبين الأدباء التقدميين والماركسيين المصريين في تلك الفترة. وكان في كلامه، ثانيًا، ما ينسجم مع طه حسين الأصيل الذي عرفناه، ومع تراثه هو نفسه في فهمه للأدب ودوره.
فقد فاجأنا طه حسين، وفاجأ بالأخصّ الصديق سهيل إدريس منظِّمَ تلك المناظرة، بأن بدأ حديثه بالقول: "يجب أن أقول لكم الحقَّ قبل أن آخذ معكم في هذا الحديث؛ فأنا لم ألتزم بالدفاع عن الخاصّة ولا عن العامّة." بل هو إنما وافق، كما قال في نوع من المراوغة المحببة، على اقتراح إدريس لأنه أراد أن يزور لبنان ويلقى اللبنانيين. ثم قال، صراحة: "هذه المناظرة أو هذه الموقعة أو المعركة أو هذه الخصومة، إنما هي، فيما أعتقد، شيءٌ مصطنعٌ لا أعرف له أساسًا ولا أعرف له أصلًا."
وواصل حديثه في البرهنة على دعواه هذه. فالأدب إنما يُكتب ليُقرأ. والأديب إذ يكتب "فهو لا يكتب للخاصّة، ولا يفكّر في الخاصّة، وهو لا يكتب للعامّة، ولا يفكّر في العامّة، وإنما يكتب لغيره، يكتب لمَن يتاح له أن يقرأ." والأدب الذي كانت تقرأه فئة قليلة في الماضي صارت تقرأه الكثرةُ الكاثرة في زماننا مع انتشار التعليم والثقافة.
***
فإذا عاد القارئ الآن إلى المقارنة المتأنّية بين ما قاله رئيف خوري وما قاله طه حسين، في تلك المناظرة الشهيرة الفريدة، فسيجد أنّهما قد اختلفا بتفصيلٍ هنا وتفصيلٍ هناك، ومبالغةٍ حادّةٍ هنا ومواربةٍ ليّنةٍ هناك. لكنّه سيجد أنّهما يتفقان في الأساس: في موقفهما المبدئي من الأدب، كنتاج جماليّ، وكفعلِ خلقٍ فرديٍّ ولكنْ بمادّةٍ اجتماعيّة، وفي الدور الذي يؤدّيه الأدبُ لا في تنمية التذوّق الجماليّ الإنسانيّ فحسب، بل في إنارة الوعي وإنارة الطريق إلى الحريّة والتقدّم أيضًا.
واتفق الاثنان أيضًا في توجيه الانتقاد الى حال الأدب والادباء في الاتحاد السوفياتيّ وافتقارهم إلى الحريّة. وقد وجّهتْ صحافتُنا الشيوعيّة النقدَ الشديد، والانفعاليّ، إلى المتناظريْن معًا، على هذه الناحية بالذات، من دون دخول جدّيّ في أساس الموضوع! وكان علينا أن ننتظر سنوات وسنوات لنعرف، ونتأكّد، أنّهما، في هذا، قد كانا ـــ معًا ـــ على حقّ.
وسنرى، بعد عام واحد من هذه المناظرة، أنّ هؤلاء المتناظرين "المتخاصمين" جميعًا: طه حسين، ورئيف خوري، وسهيل إدريس، وعدد من الأدباء الشيوعيين العرب، سيلتقون في "مؤتمر الأدباء العرب الثاني" في بلودان 1955، ويعلنون، في الأدب والفكر والسياسة، موقفًا متقدّمًا، تحرّريًّا، وعلى درجة رفيعةٍ من الانسجام.
من ذاكرة (الآداب، أيّار 1955)
* عن صفحة يا طالع الشجرة
إذا كانت المحاضرات والندوات وأحداثٌ عاديّة تكتسب أهميّتها من أسماء المشاركين فيها، أساسًا، فإنّ "المناظرة،" أي السجال العلنيّ، وبالأخصّ بين علميْن من وزن طه حسين ورئيف خوري، تعطي الحدث فرادته، بما يبرّر ذلك الاستعدادَ الحماسيّ له في مختلف الأوساط الثقافيّة في لبنان... فاختيرت لمكانِ المناظرة قاعةُ الأونيسكو. في ذلك العام، كنتُ معبّاً ضدّ رئيف خوري، ميّالًا، ولو بحذر وترقّب، لما سيقوله طه حسين. وكنّا، حسين مروة وأنا، نتعاون في تحرير مجلة الثقافة الوطنيّة (ثقافيّة فكريّة شهريّة، يصدرها الشيوعيون في لبنان). وكانت "الحرب" معلنة، في صحافة الشيوعيين، ضدّ رئيف خوري وآخرين، بتهم: التحريفية، والخروج على الخطّ الأمميّ، والعداء للاتحاد السوفياتي... وكان الأدباء التقدميون والماركسيون في مصر يخوضون (باسم الأدب الجديد والأدباء الشباب) معركةً ضدّ طه حسين والعقّاد والحكيم، بدعوى أنّ هؤلاء يمثّلون الأدبَ القديم المحافظ، والأدباءَ الشيوخ والبرجعاجيين... وأدّت صحفُنا الشيوعيّة هنا "قسطَها" في هذا الاتجاه. وكنّا قد عملنا، حسين مروّة وأنا، على جمع كتابات نقديّة لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، وإصدارها (عام 1954) في كتاب بعنوان في الثقافة المصريّة، الذي اعتُبر بمثابة "البيان الثقافيّ" للأدباء الشباب الماركسيين في تلك المعركة.
ذهبتُ، إذن، إلى قاعة الأونيسكو، متوقِّعًا أن أشهد انفجارَ معارك كلاميّة في كلّ اتجاه: رئيف خوري "الخارج على الماركسيّة" في معركة ضدّ الشيوعيين، وضدّ طه حسين "الخارج،" هو أيضًا، على طليعيّة وتجديديّة طه حسين نفسه والمشتبك كذلك مع أدباء ونقّاد ماركسيين!
كانت تلك أوّلَ مرّة أسمع فيها رئيف خوري، خطيبًا: صوت هادر، وهامة هادرة، يخطب بجسمه كلّه، بحركة جسمه وإيقاعات يديه، وانفعالاته الحماسيّة في كلّ كلمة أو جملة تتطلّب هذا الحماس. وكانت ابتسامته الساخرة تعطي كلامه واقعًا محبّبًا. وكان رئيف خوري صادقًا؛ فرغم أنّني كنت معبّأً ضدّه، فقد وصل إليّ صدقُه. وصدقُه هذا، إلى تماسك منطقه، كان يعطي كلامَه قدرةَ الإقناع.
وفي حدود معرفتي، يومها، بالمفاهيم الماركسيّة حول الأدب والفنّ والواقعيّة و"الأدب الهادف" وما أشبه... لم أجد في كلام رئيف ما يتناقض مع تلك المفاهيم، وشعرتُ بأنّه يعطي تلك المفاهيم روحًا وتلاوينَ محليّةً، عربيّة، تبعدها عن عموميّة التجريد وتقرّبها إلى نبض الحياة الراهنة. على أنّني وجدتُ يومها في كلامه الانتقاديّ لوضع الأدب والأدباء في الاتحاد السوفياتيّ، وافتقارهم الى الحريّة، ما حسبتُ أنه يتناقض مع المضمون العام لخطابه (سيتبيّن لنا، بعد سنوات وتجارب مريرة، واختبارٍ عينيّ لواقع أوضاع الأدب والأدباء في الاتحاد السوفياتي حتى قبل انهياره بسنوات كثيرة، أنّ كلام رئيف ذاك كان هو الصحيح، وهو المنسجم مع منطق فهمه الماركسيّ، في خطابه، للدور الاجتماعيّ التحرّري للأدب، ولضرورة استقلالية الأديب في علاقته مع السلطة.
وعندما جاء دورُ طه حسين، كنتُ أتساءل: هل سيدخل في عراك مع رئيف خوري ومع طه حسين الآخر، الذي كان طليعيًّا مجدِّدًا؟
وسط أمواج هادرة من التصفيق الحماسي والمحبّ، أوصلوا طه حسين إلى المنبر. لا أذكر الآن (بعد أربعين عامًا من هذا الحدث) هل ألقى طه حسين خطابه واقفًا أمْ جالسًا على كرسيّ خلف المنبر. لكنّني أتذكّر أنّه كان منتصبَ الظهر، واضعًا يديه أمامه، على حافة المنبر أو على ركبتيه، دون أن يحرّكهما. جسمه هادئ يكاد لا يتحرّك فيه سوى الشفتين. والكلام يصدر عنه منغومًا موقّعًا كأنّه يرتّله ترتيلًا. يلقي كلامه (وهو الأعمى) بتدفّق ويُسرٍ كأنّه يقرأ في لوحةٍ ما أمامه كلامًا مكتوبًا بخطّ واضح. وتشعر، من نبرته وإيقاعات صوته ووقفاته، بعلامات الكلام: هنا نقطة، وهناك فاصلة، وهنا استفهام، وهناك علامة تعجّب أو أكثر، وهنا سطر جديد، وهناك مقطع جديد من الموضوع. كلّ هذا يسري إليك في صوت عذب، ساحر فعلًا، ويعرف كيف يجذبك إليه، ولا تعرف كيف انجذبتَ بكليّتك إليه، فإذا أنت فيه، في خضم الكلام، وإذا عيناك شاخصتان في اتجاه وجه الرجل وشفتيه، وسمعك يصغي إلى موسيقى الكلام.
لم يقل طه حسين ما كنتُ قد توقّعتُه منه. كان في كلامه، أولًا، ما ينقض توقّعاتي وتصوّراتي المسبّقة، الآتية من غبار تلك المعركة التي ثارت بينه وبين الأدباء التقدميين والماركسيين المصريين في تلك الفترة. وكان في كلامه، ثانيًا، ما ينسجم مع طه حسين الأصيل الذي عرفناه، ومع تراثه هو نفسه في فهمه للأدب ودوره.
فقد فاجأنا طه حسين، وفاجأ بالأخصّ الصديق سهيل إدريس منظِّمَ تلك المناظرة، بأن بدأ حديثه بالقول: "يجب أن أقول لكم الحقَّ قبل أن آخذ معكم في هذا الحديث؛ فأنا لم ألتزم بالدفاع عن الخاصّة ولا عن العامّة." بل هو إنما وافق، كما قال في نوع من المراوغة المحببة، على اقتراح إدريس لأنه أراد أن يزور لبنان ويلقى اللبنانيين. ثم قال، صراحة: "هذه المناظرة أو هذه الموقعة أو المعركة أو هذه الخصومة، إنما هي، فيما أعتقد، شيءٌ مصطنعٌ لا أعرف له أساسًا ولا أعرف له أصلًا."
وواصل حديثه في البرهنة على دعواه هذه. فالأدب إنما يُكتب ليُقرأ. والأديب إذ يكتب "فهو لا يكتب للخاصّة، ولا يفكّر في الخاصّة، وهو لا يكتب للعامّة، ولا يفكّر في العامّة، وإنما يكتب لغيره، يكتب لمَن يتاح له أن يقرأ." والأدب الذي كانت تقرأه فئة قليلة في الماضي صارت تقرأه الكثرةُ الكاثرة في زماننا مع انتشار التعليم والثقافة.
***
فإذا عاد القارئ الآن إلى المقارنة المتأنّية بين ما قاله رئيف خوري وما قاله طه حسين، في تلك المناظرة الشهيرة الفريدة، فسيجد أنّهما قد اختلفا بتفصيلٍ هنا وتفصيلٍ هناك، ومبالغةٍ حادّةٍ هنا ومواربةٍ ليّنةٍ هناك. لكنّه سيجد أنّهما يتفقان في الأساس: في موقفهما المبدئي من الأدب، كنتاج جماليّ، وكفعلِ خلقٍ فرديٍّ ولكنْ بمادّةٍ اجتماعيّة، وفي الدور الذي يؤدّيه الأدبُ لا في تنمية التذوّق الجماليّ الإنسانيّ فحسب، بل في إنارة الوعي وإنارة الطريق إلى الحريّة والتقدّم أيضًا.
واتفق الاثنان أيضًا في توجيه الانتقاد الى حال الأدب والادباء في الاتحاد السوفياتيّ وافتقارهم إلى الحريّة. وقد وجّهتْ صحافتُنا الشيوعيّة النقدَ الشديد، والانفعاليّ، إلى المتناظريْن معًا، على هذه الناحية بالذات، من دون دخول جدّيّ في أساس الموضوع! وكان علينا أن ننتظر سنوات وسنوات لنعرف، ونتأكّد، أنّهما، في هذا، قد كانا ـــ معًا ـــ على حقّ.
وسنرى، بعد عام واحد من هذه المناظرة، أنّ هؤلاء المتناظرين "المتخاصمين" جميعًا: طه حسين، ورئيف خوري، وسهيل إدريس، وعدد من الأدباء الشيوعيين العرب، سيلتقون في "مؤتمر الأدباء العرب الثاني" في بلودان 1955، ويعلنون، في الأدب والفكر والسياسة، موقفًا متقدّمًا، تحرّريًّا، وعلى درجة رفيعةٍ من الانسجام.
من ذاكرة (الآداب، أيّار 1955)
* عن صفحة يا طالع الشجرة