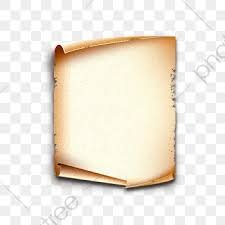رغم كل ما يظهر من نصوص سابقة، كانت الرواية هي النص الأول.
بالنسبة لي؛ بعد طرق أبواب المُحاولات، ومشاغبات الحرف، والوقت المديد اللاهث في الركض خلف مراوغات الكتابة: الفكرة والقالب والتراكيب واللغة؛ جاءت القصة القصيرة كخطوة بِكرٍ في عالم النشر، ثم تسلحتُ بالجرأة ولذت بها لأطرح روايتي الأولى (سماء قريبة أعرفها)، والصادرة عن دار نوفا بلس عام 2010. إن كنت أريد إرفاد الصورة بنحو أكثر دقة، فـ (سماء قريبة) لم تكن تجربة روائية أولى؛ حيث كانت الرواية منذ مستهل الوعي، وحين رفت أجنحة فراشات الشغف بالحرف هي محطة أولى لبوح القلم. بدأ ذلك في مقاعد دراسة المرحلة المتوسطة، حيث كتبت ما كنت أسميه رواية آنذاك. كانت تحمل عنوان (محطات وأشجان) عام 1995، ثم (لحظات الغروب) عام 1998، والتي نشرت كحلقات في مجلة صوت الخليج الكويتية، ثم نشرتُ على حساب والدي رواية (العودة)، التي أحتفظ بنسخة واحدة منها منذ عام 1999 حينها كنت في السنة الأخيرة من الثانوية العامة.
لكني إن أردت أن أنظر إلى مسار الكتابة بجدية أكبر سأعتبر أن تجربتي الروائية في (سماء قريبة أعرفها) أخذت تتخذ ملامح أكثر وضوحاً، وأكثر تخصصاً، حيث فررتُ من قيد اللغة وبدأتُ أجتهد في إبراز روح الحكاية.
جاءت (سماء قريبة) بعد نصوص قصصية عديدة، حيث قدمت للنشر مجموعة (آخر الشطآن)، ثم مجموعة (بوح الندى)، إذ ألح بعدها الحنين القديم للرواية، وصار لزاماً عليّ أن أُقدم على تلك الخطوة الأجرأ لأسير في مسارات السرد وتحولاته؛ خصوصا إذ كانت المادة التي بين يديَ لا يمكن تطويعها في نص قصصي قصير؛ بل تتطلب أشكالاً متمددة، وآفاقاً رحبة من السرد، وشخوصاً تصرخ في متاهة عقلي لأعرض أصواتها وتحولاتها. بالطبع لم تكن العملية سهلة؛ فإن كانت الكتابة في سن صغير تأتي طواعية ومنسابة وسيالة، تتكئ على السليقة وتجري من منابع الموهبة وحسب، وينظر إليها الكاتب بعين الرضا والاطمئنان، ويشعر أنه سيد حروفه وقائد أحداثه؛ فإنها بعد سن النضج وبعد المواجهات المكرورة مع الحرف في نص أي كان نوعه تصبح عصية وربما متمنعة.
في (سماء قريبة) كنت أحتاج لأن أعبر مضيق السارد الواحد؛ لأني شعرت أن لكل شخصية في النص صوت خاص لا يمكن لساردٍ عليمٍ مهما كانت معرفته بالأحداث ودخائل الشخصيات أن ينجح في إيصاله. لم يكن يجدر بي أن أروّض استقلالية تلك الشخصيات، ولم يكن يقدر ذلك السارد العليم على عدم الانزياح لشخصية ما؛ كأن يُدين من خلاله سرده “ياسمين” أو أن يجعل القارئ يغفر لـ “أمل” أو أن يتفهم “مصطفى”؛ لذلك حررت الشخصيات من أسر السارد الواحد، وأفسحت لها المجال. صار لها أن تبوح بكل شيء أرادته وفق خياراتها وقناعاتها الخاصة، وتركت للنص مساحة أخيرة في الرواية، يجد فيها أحد المتلقين بعض الإجابات. ربما هذا ما أعطى الرواية قدراً من المرونة، وتفاوتاً في تقبل وتقييم الشخصيات وأفعالها عند تلقي القارئ.
قضيت سنة ونصف السنة في كتابة الرواية. رغم أن الرواية تقدم حالة اجتماعية وروحية؛ إلا أنني احتجت للبحث في تاريخ حوادث معينة وفعاليات خاصة زامنت أحداث الرواية، ومراكز شاءت أن تزج نفسها في تركيبة النص، مثل مبنى بنك الدم في منطقة الجابرية في الكويت. بدأت رحلة البحث عن إجابات للأسئلة، واستعنت بالمعارف للاستدلال على القائمين على الفعاليات، والعاملين في مبنى بنك الدم. كذلك، احتجت لبعض النصائح القانونية حول الحالة الاجتماعية التي تتعرض لها إحدى شخصيات العمل، ولما تجمّعت المادة في ملف المخطط، جاءت الحبسة!
كنت أحتاج للمقاومة، لإسكات وسوسة تثبّط الخطو في المسار، وسوسة مثل: ما جدوى هذا العمل؟ كيف سيظهر أمام هذا الحشد المتناسل من الروايات الجادة أو التي تستهين بالمتلقي؟ ماذا لو صرفت النظر وعدت للبيت الآمن، للنص القصصي الأليف، المتعاون، الطيّع كما كنتُ أحسبه؟ لماذا علي السير في طريق الرواية المفخخ؟ لكن صوتاً طاغيا آخر كان يَرجُّني، ويطرد تلك الوسوسة ويؤكد لي: لديك في هذا العمل (من) يستحق الالتفات إليه.
نعم، ربما.
في العمل أصوات لشخصيات أحاول تكوين تركيبتها من معاناة مستمرة في المجتمع، مثلاً الإبن المأخوذ بجريرة الأب الميت بحقنة مخدرات زائدة. يحاصر هذا الإبن في قالب الإدانة وتأويل الأفعال وفق معطيات الوراثة، ويراقب بعين التوجس الدائم، ويعاني من عدم الشعور بالسلام ورضا الذات بسببه كرههِ لأبيه الذي يعلّق على وجهه ملامحه. في الرواية أيضا أرملة غامضة، وشابة ساخطة، وزوجة راضخة، وعاشق مجروح. أود أن يستمع المتلقي لهم؛ لذا تركت التفكير في مستقبل العمل وتعاونت مع شخصياته. صرت أنصت كل يوم لما تبثه من فكرة ومعاناة وتساؤلات، وأتممت أخيراً زراعة الشخصيات والأحداث في مشتل النص.
على عكس (بجماليون)، ولأني في الأصل قارئة نهمة؛ عَبَرَت على ذائقتي العديد من الأعمال الأدبية الجميلة. بعد إتمام المخطوط، لم أجد في رواية (سماء قريبة أعرفها) ذلك الألق الذي أستطيع أن أفخر به. نعم، كان فيها الكثير مما أود قوله، الكثير مما أود إيصاله؛ لكن هل كانت التقنيات والمرافد كما كنت آمل؟ والنتيجة ككل، هل كانت مُرضية؟
رغم ذلك واتتني الشجاعة، وبعثت بها إلى الناشر بعد أن تلقيت تشجيعاً منه، ومن قُرّاء وأصدقاء الدائرة المقربة، الذين أثق في نظرتهم، وأعتمد على تجربتهم، وصارت الرواية التي ركضت في رحم الحلم كائناً حقيقيا.
عملية الطباعة كانت يسيرة جداً، أُقابل – دائماً – بكرم الناشر وجمال احتفائه منذ التجارب الأولى، وإلى اليوم حيث أعيش المرحلة المطمئنة؛ ربما لأني أتعامل مع ناشر يستوعب تطلعاتي وأهدافي. كذلك، في تجربة طباعة (سماء قريبة)، لم أكن أقلق حول خطوات التدقيق والغلاف. بالطبع تشكلت لدي اليوم تطلعات أكبر، وصرت أكثر حرصاً على الشكل النهائي للإصدار، لكن يبقى أني في تلك المرحلة لم أقع في منزلق الخيبة أو القلق أو الحساسية. سارت الخطوات في خطها المتصاعد: قبول المخطوط، الصف، التدقيق، المراجعة والمراجعة وأخيراً الغلاف.
وبالمثل سارت عملية النشر. صدرت الرواية في موسم معرض الكويت للكتاب، الموسم المزدهر، حيث تُقبل شريحة كبرى من القراء على الرواية. كنت أستطيع ملاحظة (سماء قريبة) وهي تحظى بحُسن التداول، والتنفس في حقل القراءة. ردود أفعال جميلة وصلتني، وملاحظات عديدة، وكتجربة أولى أظل أمتن لكل ما وردني حولها، من مدح أو ملاحظة أو حتى ذم، الأشياء التي أعطتني ضوء لتجلية رؤية التجارب القادمة.
بالتأكيد، كنت أطمع بالمزيد من القراءة، والمزيد من ردود الأفعال، ولا أعتقد أن القناعة في هذا المضمار أمر لائق. نعم، لم أكتفِ وعطشت للمزيد، لكن هذا العطش تحور؛ ليحفزني لمعاودة تجربة الكتابة في نصوص أخرى.
(سماء قريبة أعرفها) لم تكن تجربة عابرة، ولم تكن عميقة أيضاً، كانت تنزح عن خانة الضعف وتقترب من خانة المتانة. لو عاد لي الخيار لكتبتها مرة أخرى. لن أغيّر من أحداثها. لن أمسّ روحها الخاصة، لكني قد أضيف لها بعض الفصول. قد أعزز بعض السرد المشهدي. قد أضيف فصل أمل التي لم يسمح لها بالكلام أثناء الرواية، والتي طلب مني بعض ممن قرأ الرواية أن أفسح لها مجالاً لتتحدث. أنا اليوم أبقى في قنطرة الحيرة. هل أستمع لبوح أمل، أم أعاملها كالمجتمع الذي يُكممها ويبقيها تحت ناظريه تماماً؟
هذه التجربة الروائية، بمعطياتها ونتاجاتها جعلتني أتريث كثيرا في الخطوات القادمة؛ وأكدت لي بضرورة الاشتغال الحثيث للمشاريع المقبلة بتأني ودراية. كانت الضوء الأول، وأتمنى أن يكون القادم أجمل.
تسنيم الحبيب – الكويت

 samaward.net
samaward.net
بالنسبة لي؛ بعد طرق أبواب المُحاولات، ومشاغبات الحرف، والوقت المديد اللاهث في الركض خلف مراوغات الكتابة: الفكرة والقالب والتراكيب واللغة؛ جاءت القصة القصيرة كخطوة بِكرٍ في عالم النشر، ثم تسلحتُ بالجرأة ولذت بها لأطرح روايتي الأولى (سماء قريبة أعرفها)، والصادرة عن دار نوفا بلس عام 2010. إن كنت أريد إرفاد الصورة بنحو أكثر دقة، فـ (سماء قريبة) لم تكن تجربة روائية أولى؛ حيث كانت الرواية منذ مستهل الوعي، وحين رفت أجنحة فراشات الشغف بالحرف هي محطة أولى لبوح القلم. بدأ ذلك في مقاعد دراسة المرحلة المتوسطة، حيث كتبت ما كنت أسميه رواية آنذاك. كانت تحمل عنوان (محطات وأشجان) عام 1995، ثم (لحظات الغروب) عام 1998، والتي نشرت كحلقات في مجلة صوت الخليج الكويتية، ثم نشرتُ على حساب والدي رواية (العودة)، التي أحتفظ بنسخة واحدة منها منذ عام 1999 حينها كنت في السنة الأخيرة من الثانوية العامة.
لكني إن أردت أن أنظر إلى مسار الكتابة بجدية أكبر سأعتبر أن تجربتي الروائية في (سماء قريبة أعرفها) أخذت تتخذ ملامح أكثر وضوحاً، وأكثر تخصصاً، حيث فررتُ من قيد اللغة وبدأتُ أجتهد في إبراز روح الحكاية.
جاءت (سماء قريبة) بعد نصوص قصصية عديدة، حيث قدمت للنشر مجموعة (آخر الشطآن)، ثم مجموعة (بوح الندى)، إذ ألح بعدها الحنين القديم للرواية، وصار لزاماً عليّ أن أُقدم على تلك الخطوة الأجرأ لأسير في مسارات السرد وتحولاته؛ خصوصا إذ كانت المادة التي بين يديَ لا يمكن تطويعها في نص قصصي قصير؛ بل تتطلب أشكالاً متمددة، وآفاقاً رحبة من السرد، وشخوصاً تصرخ في متاهة عقلي لأعرض أصواتها وتحولاتها. بالطبع لم تكن العملية سهلة؛ فإن كانت الكتابة في سن صغير تأتي طواعية ومنسابة وسيالة، تتكئ على السليقة وتجري من منابع الموهبة وحسب، وينظر إليها الكاتب بعين الرضا والاطمئنان، ويشعر أنه سيد حروفه وقائد أحداثه؛ فإنها بعد سن النضج وبعد المواجهات المكرورة مع الحرف في نص أي كان نوعه تصبح عصية وربما متمنعة.
في (سماء قريبة) كنت أحتاج لأن أعبر مضيق السارد الواحد؛ لأني شعرت أن لكل شخصية في النص صوت خاص لا يمكن لساردٍ عليمٍ مهما كانت معرفته بالأحداث ودخائل الشخصيات أن ينجح في إيصاله. لم يكن يجدر بي أن أروّض استقلالية تلك الشخصيات، ولم يكن يقدر ذلك السارد العليم على عدم الانزياح لشخصية ما؛ كأن يُدين من خلاله سرده “ياسمين” أو أن يجعل القارئ يغفر لـ “أمل” أو أن يتفهم “مصطفى”؛ لذلك حررت الشخصيات من أسر السارد الواحد، وأفسحت لها المجال. صار لها أن تبوح بكل شيء أرادته وفق خياراتها وقناعاتها الخاصة، وتركت للنص مساحة أخيرة في الرواية، يجد فيها أحد المتلقين بعض الإجابات. ربما هذا ما أعطى الرواية قدراً من المرونة، وتفاوتاً في تقبل وتقييم الشخصيات وأفعالها عند تلقي القارئ.
قضيت سنة ونصف السنة في كتابة الرواية. رغم أن الرواية تقدم حالة اجتماعية وروحية؛ إلا أنني احتجت للبحث في تاريخ حوادث معينة وفعاليات خاصة زامنت أحداث الرواية، ومراكز شاءت أن تزج نفسها في تركيبة النص، مثل مبنى بنك الدم في منطقة الجابرية في الكويت. بدأت رحلة البحث عن إجابات للأسئلة، واستعنت بالمعارف للاستدلال على القائمين على الفعاليات، والعاملين في مبنى بنك الدم. كذلك، احتجت لبعض النصائح القانونية حول الحالة الاجتماعية التي تتعرض لها إحدى شخصيات العمل، ولما تجمّعت المادة في ملف المخطط، جاءت الحبسة!
كنت أحتاج للمقاومة، لإسكات وسوسة تثبّط الخطو في المسار، وسوسة مثل: ما جدوى هذا العمل؟ كيف سيظهر أمام هذا الحشد المتناسل من الروايات الجادة أو التي تستهين بالمتلقي؟ ماذا لو صرفت النظر وعدت للبيت الآمن، للنص القصصي الأليف، المتعاون، الطيّع كما كنتُ أحسبه؟ لماذا علي السير في طريق الرواية المفخخ؟ لكن صوتاً طاغيا آخر كان يَرجُّني، ويطرد تلك الوسوسة ويؤكد لي: لديك في هذا العمل (من) يستحق الالتفات إليه.
نعم، ربما.
في العمل أصوات لشخصيات أحاول تكوين تركيبتها من معاناة مستمرة في المجتمع، مثلاً الإبن المأخوذ بجريرة الأب الميت بحقنة مخدرات زائدة. يحاصر هذا الإبن في قالب الإدانة وتأويل الأفعال وفق معطيات الوراثة، ويراقب بعين التوجس الدائم، ويعاني من عدم الشعور بالسلام ورضا الذات بسببه كرههِ لأبيه الذي يعلّق على وجهه ملامحه. في الرواية أيضا أرملة غامضة، وشابة ساخطة، وزوجة راضخة، وعاشق مجروح. أود أن يستمع المتلقي لهم؛ لذا تركت التفكير في مستقبل العمل وتعاونت مع شخصياته. صرت أنصت كل يوم لما تبثه من فكرة ومعاناة وتساؤلات، وأتممت أخيراً زراعة الشخصيات والأحداث في مشتل النص.
على عكس (بجماليون)، ولأني في الأصل قارئة نهمة؛ عَبَرَت على ذائقتي العديد من الأعمال الأدبية الجميلة. بعد إتمام المخطوط، لم أجد في رواية (سماء قريبة أعرفها) ذلك الألق الذي أستطيع أن أفخر به. نعم، كان فيها الكثير مما أود قوله، الكثير مما أود إيصاله؛ لكن هل كانت التقنيات والمرافد كما كنت آمل؟ والنتيجة ككل، هل كانت مُرضية؟
رغم ذلك واتتني الشجاعة، وبعثت بها إلى الناشر بعد أن تلقيت تشجيعاً منه، ومن قُرّاء وأصدقاء الدائرة المقربة، الذين أثق في نظرتهم، وأعتمد على تجربتهم، وصارت الرواية التي ركضت في رحم الحلم كائناً حقيقيا.
عملية الطباعة كانت يسيرة جداً، أُقابل – دائماً – بكرم الناشر وجمال احتفائه منذ التجارب الأولى، وإلى اليوم حيث أعيش المرحلة المطمئنة؛ ربما لأني أتعامل مع ناشر يستوعب تطلعاتي وأهدافي. كذلك، في تجربة طباعة (سماء قريبة)، لم أكن أقلق حول خطوات التدقيق والغلاف. بالطبع تشكلت لدي اليوم تطلعات أكبر، وصرت أكثر حرصاً على الشكل النهائي للإصدار، لكن يبقى أني في تلك المرحلة لم أقع في منزلق الخيبة أو القلق أو الحساسية. سارت الخطوات في خطها المتصاعد: قبول المخطوط، الصف، التدقيق، المراجعة والمراجعة وأخيراً الغلاف.
وبالمثل سارت عملية النشر. صدرت الرواية في موسم معرض الكويت للكتاب، الموسم المزدهر، حيث تُقبل شريحة كبرى من القراء على الرواية. كنت أستطيع ملاحظة (سماء قريبة) وهي تحظى بحُسن التداول، والتنفس في حقل القراءة. ردود أفعال جميلة وصلتني، وملاحظات عديدة، وكتجربة أولى أظل أمتن لكل ما وردني حولها، من مدح أو ملاحظة أو حتى ذم، الأشياء التي أعطتني ضوء لتجلية رؤية التجارب القادمة.
بالتأكيد، كنت أطمع بالمزيد من القراءة، والمزيد من ردود الأفعال، ولا أعتقد أن القناعة في هذا المضمار أمر لائق. نعم، لم أكتفِ وعطشت للمزيد، لكن هذا العطش تحور؛ ليحفزني لمعاودة تجربة الكتابة في نصوص أخرى.
(سماء قريبة أعرفها) لم تكن تجربة عابرة، ولم تكن عميقة أيضاً، كانت تنزح عن خانة الضعف وتقترب من خانة المتانة. لو عاد لي الخيار لكتبتها مرة أخرى. لن أغيّر من أحداثها. لن أمسّ روحها الخاصة، لكني قد أضيف لها بعض الفصول. قد أعزز بعض السرد المشهدي. قد أضيف فصل أمل التي لم يسمح لها بالكلام أثناء الرواية، والتي طلب مني بعض ممن قرأ الرواية أن أفسح لها مجالاً لتتحدث. أنا اليوم أبقى في قنطرة الحيرة. هل أستمع لبوح أمل، أم أعاملها كالمجتمع الذي يُكممها ويبقيها تحت ناظريه تماماً؟
هذه التجربة الروائية، بمعطياتها ونتاجاتها جعلتني أتريث كثيرا في الخطوات القادمة؛ وأكدت لي بضرورة الاشتغال الحثيث للمشاريع المقبلة بتأني ودراية. كانت الضوء الأول، وأتمنى أن يكون القادم أجمل.
تسنيم الحبيب – الكويت

الضوء الأول – مجلة سماورد
تسنيم الحبيب – الكويت: رغم كل ما يظهر من نصوص سابقة، كانت الرواية هي النص الأول. بالنسبة لي؛ بعد طرق أبواب المُحاولات، ومشاغبات الحرف، والوقت المديد اللاهث في الركض خلف مراوغات الكتابة: الفكرة والقالب والتراكيب واللغة؛ جاءت القصة القصيرة كخطوة بِكرٍ في عالم النشر، ثم تسلحتُ بالجرأة ولذت بها...
 samaward.net
samaward.net