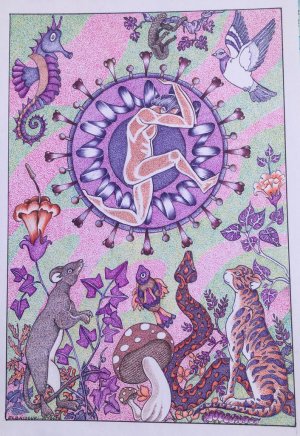نشرت مجلة هسبريس- تمودا سنتي 1973 و1974 ضمن عدديْها 14 و15 دراسة مطولة، في قسمين، لبرنار روزنبرجي وحميد التريكي، وُسمتبـ”المجاعات والأوبئة في مغرب القرنين 16 و17“. وقد ترجم عبد الرحيم حزلهذا العمل ونشره في شكل مؤلَّف واحد، وذلكفي طبعتين، الأولىعن جذور للنشر عام 2007، والثانية عن دار الأمان عام 2010.
خصص الباحثان دراستهما للأزمات المناخية والصحية التي عاشها المغرب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، قصد تقديم عناصر جديدة لتفسير تاريخ المغرب الديموغرافي والاقتصادي والسياسي، وقد بررا اختيارهما الزمني بأهمية القرنين في تشكيل وجه المغرب المعاصر، حتى وإن لم ينالا حظهما من اهتمام الباحثين. وتعتبر دراستهما هذه أولى المساهمات العلمية للبحث في تاريخ الأزمات الغذائية والصحية في المغرب.
استهلت الدراسة بطرح إشكالية المصادر التي يواجهها البحث في مثل هذه المواضيع في تاريخ المغرب، فالمصادر المغربية تكاد تنحصر في الكتب الإخبارية والمنقبية، لانعدام سجلات كتلك التي توفرت بكنائس وأديرة أوربا، كما أن سجلات الحالة المدنية متأخرة جدا. وإن كانت المصادر الأجنبية أفيد، فإنها لا تخلو من نواقص ناجمة عن اهتمام مؤلفيها، منتجار ودبلوماسيين وغيرهم، بالوقائع التي تمس مصالحهم ومصالح دولهم بالمغرب. وعلى العموم، مع استثناءات طفيفة، فالمعلومات التي يقدمها هذان النوعان من المصادر هي معلومات مقتضبة، متفرقة وعامة، لم تسمح بمقاربة الأزمة في شموليتها وبتحديد انعكاساتها الديموغرافية والاقتصادية والسياسية، كما أن إمكانية تدقيق حجم الخسائر البشرية ضئيلة في ظل الأرقام المبالغ فيها التي تقدمها، والتي لا تسمح إلا بتقدير نسبي، في حين أن طبيعة المرضغابت في غالب الأحيان عن المؤلفَين كما غابت عن المعاصِرين لها. على سبيل المثال، ليس لكلمتي وباء وطاعون معنى دقيق، بحيث سميت بهما جل الأمراض التي أصابت المغاربة خلال هذه الفترة.
تتبع الباحثان الترتيب الكرونولوجي لتقديم الأزمات التي تعرض لها المغرب، مع إبراز ترابطاتها مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والبحث في قواسمهما المشتركة، رغم أن العديد من المتغيرات بيَّنت أن لكل أزمة خصوصياتها. ولأن دراسة الأزمات المناخية والصحية بالمغرب لا تكتمل في معزل عن محيطها الجغرافي، فقد عملا، قدر الإمكان، على رصد الحالات المشابهة ببعض البلدان المجاورة بشمال إفريقيا وبشبه الجزيرة الإيبيرية.
وتتوزع الدراسة إلى ثلاثة أقسام متكاملة. شمل القسم الأول عرضا لأزمات القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهي وباء نهاية القرن الخامس عشر وبدايةالسادس عشر،ومجاعة وطاعون 1521-1522، وآفات 1525-1557، وأوبئة 1557-1558 و1580، وكوارث نهاية القرن، ثم مآسي 1613-1635، وأخيرا أزمات النصف الثاني من القرن السابع عشر.وخصص القسم الثاني لتحليل سمات هذه الأزمات وميكانيزمات تطورها من خلال محوري أزمات البقاء والأوبئة، أما القسم الأخير فشخصت فيهآثار الأزمات على المجتمع والاقتصاد والسياسة،عبر البحث في آثارهاالمادية والنفسية والمعنوية، وانعكاس التقلص الديموغرافي الناجم عنها على الاقتصاد، ثم مساهمتها في إنجاح وإنهاء المشاريع السياسية.
دخل المغرب القرن السادس عشر متأثرا بأوبئة نهاية القرن السابق، وآخرها مرض التيفوس الوبائي الذي حمله بعض اللاجئين المسلمين واليهود بعد سقوط غرناطة سنة 1492. واستهل القرن بوباء ظهر في فاس سنة 1509 ثم في منطقة سوس سنتي 1511-1512، وفي سنتي 1516 و1517 أدى الجفاف إلى تراجع المحاصيل الزراعية خاصة بالسهول الأطلنتية، مما أضر بالمواقع البرتغالية بالمنطقة، وحولها من مُصدِّرة للحبوب إلى مستوردة لها، كما أدخلها في مواجهات عنيفة مع القبائل التي تعودت على الخضوع قبل الأزمة،ثم أصبحت ترفض أداء ضريبة المحصول الزراعي السنوي.
وفي سنة 1519 فقد المغرب عددا مهما من ساكنته بسبب الوفيات الناجمة عن الطاعون، قبل أن يعاني من أخطر أزمات القرنين وأكثرها حدة،وهي أزمة 1521-1522، التي استمرت لثلاث سنوات ولم تنته إلا سنة 1524. بدأت الأزمة بجفاف أفضى إلى تراجع الزراعة حتى بالأراضي المسقية، ثم إلى غلاء المعيشة وحدوث مجاعة شديدة، ألجأت المغاربة إلى بيع أنفسهم وأبنائهم مقابل ما يقتاتون به، قبل أن يتوج الطاعون هذه الكوارث المتعاقبة، ويستنزف ما تبقى لديهم من جهد على المقاومة. أضرت الأزمة بالسهول الأطلنتية أكثر من غيرها، وأضعفت الجانبين المغربي والبرتغالي، مما يفسر توقف المواجهات بينهما، كما ساهمت في بروز بعض المتصوفة بفضل أعمالهم الخيرية، مثل الشيخ الغزواني بفاس وأتباعه بمراكش، والشيخ أبو عثمان سعيد بمكناس.
بعد تسع سنوات فقط، تعرضت البلاد إلى وباء قاتل، أعقبه وباء آخر سنة 1536، ثم جفاف وغلاء سنة 1540، ثم زحف الجراد على ما بقي من المحاصيل، فكانت النتيجة حدوث المجاعة سنة 1541. وقد تضرر في هذه الأزمة القسم الجنوبي من المغرب، عكس الأزمات السابقة، واعتبرها المغاربة من غضب الله على الأعمال العدوانية التي قام بها الشريفان السعديان محمد الشيخ وأحمد الأعرج أثناء حروبهما، وإن ساعدت أمطار خريف سنة 1541 في تقليص حدة المجاعة وتراجع ارتفاع الأثمان.
في سنة 1553 حملت بعض السفن عدوى طاعون من تركيا إلى الجزائر، وانتشر في المناطق المجاورة لها قبل أن ينتقل إلى المغرب، وفي سنة 1557 انتشر الطاعون بشمال المغرب انطلاقا من جبال الريف، ثم انتقل في السنة التي تليها إلى باقي المناطق لينعت بـ”الطاعون الكبير“، الذي ذهب بعُشر ساكنة المغرب حسب المؤرخ أحمد الناصري. لم تكن الأزمة بنفس خطورة أزمة 1520-1522، لكن وقوعها بعد 35 سنة فقط عن بداية الأزمة الأولى، التي لم تلتئم ندوبها بعد، أثر سلبا على ديموغرافية المغرب واقتصاده. عاود الوباء الظهور سنة 1580 بعد أن هيأت له مجاعة وغلاء السنة التي قبلها ظروف انتشاره، وقد سمته المصادر المغربية بـ”السعال الكبير“ نسبة لأعراض السعال الشديد التي تظهر على المصابين به، ونتيجة للأثر السلبي الذي أحدثه بنفوس المغاربة، خاصة العامة منهم، فقد اعتبروه هو الآخر من علامانسخط الله، لأن غنائم معركة وادي المخازن لم تقسم حسب الضوابط الشرعية. وهكذا تبدو بداية حكم السلطان أحمد المنصور، بخلافالصورة التي تعطيها عنها الإنجازات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، مرحلة شدائد عانى منها المغاربة بسبب الجوع والطاعون.
ولم ينج المغرب من الأوبئة الخطيرة التي برزت بأوربا وشمال إفريقيا والإمبراطورية العثمانية نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، ومن بينها وباء قاتل ظهر بالمغرب سنتي 1597-1598، وعاود الظهور بشكل أقوى انطلاقا من سنة 1602، بعد فترة كُمون دامت ثلاث سنوات. استمر الوباء إلى سنة 1608، وتزامن مع حدوث المجاعة والحروب بين أبناء السلطان أحمد المنصور، فخلق مناخا اعتبر بمثابة إعلان عن قيام الساعة.
أضر الوباء أكثر بالفئات الفقيرة والمعدمة، واختلفت حدته حسب المناطق، إلا أن المدن كانت الأكثر تضررا إذ فقدت مابين ثلث ونصف ساكنتها. وقدأصيب جهاز المخزن بالضعف بعد وفاة السلطان أحمد المنصور، فلم يستطعمواجهة الأزمة، بلازداد التمرد ضد السلطة المركزية، وتكاثرت أعمال العنف والنهب التي طالت المنشآت الحيوية للاقتصاد السعدي، كمزارع ومصانع السكر، وضاعفت حروب أبناء السلطان أحمد المنصورمن آثار الأزمة، فبدأ المغرب مرحلة جديدة من تاريخه بساكنة متقلصة عدديا وضعيفة على مستويات عدة.
عقب هذا الوباء الشديد، بعد خمس سنوات، أدى تأخرسقوط الأمطار إلى ارتفاع في الأسعار، ثم إلى حصول مجاعة شديدة. وبعد عشر سنوات فقط، اجتاحت البلاد مآسي أكبر وأطول، بدأت سنة 1624 وانتهت في ثلاثينيات القرن، تميزت بدورات وبائية متكررة، بدأت من شمال المغرب، ومن فاس بالتحديد، ورافقتها مجاعة شديدة تركت البلاد ضعيفة ومنهكة وغير قادرة على كواجهة أزمات النصف الثاني من القرن.
فقد نجم عن جفاف خريف سنة 1650 حدوث غلاء شديد،تضخمت خلاله الأسعار اثنا عشر مرة، كما أن أمطار الربيع التي عادة ما تنقذ السنة الفلاحية لم تسقط، مما زاد من اشتداد حدة الجفاف. وفي أكتوبر 1656 بدأ الطاعون بالانتشار واستمر سنة كاملة. وأدى جفاف شتاء 1661 إلى حدوث مجاعةتسببتفي إفراغ تجمعات سكنية كاملة بمنطقة تادلة سواء بسبب هلاك أهلها أو لهجرتهم نحو المناطق الجنوبية والصحراوية الأقل تضررا، ولن يعود هؤلاء الجياع المهاجرون إلا بعد هطول أمطار خريف نفس السنة. وفي السنة الموالية عانت البلاد من مجاعة بسبب الجفاف أيضا، تبعها وباء أصاب كل المغرب، كانت الكارثة عامة وإن لم تتضرر منها منطقة السفح الجنوبي للأطلس بنفس الحدة، وقد كانت نتائجها، حسب المؤلفَين، مهمَّة بحيث خلقت وضعية تفسر وقائع أكثر أهمية.
الظاهر، من خلال هذا العرض الكرونولوجي المقتضب لأزمات القرنين السادس عشر والسابع عشر، أن أغلب الآفات أصلها أسباب مناخية، لهذا شبه برنار روزنبرجي وحميد التريكي آليات الأزمة بالمغرب بتلك التي وصفت بأوربا وبباقي البلدان المغاربية، إذ تتلخص القاعدة في أن الأزمات الشديدة سببها توالي سنتين سيئتين، فسنة سيئة تعني قلقا حقيقيا يعبِّر عنه الغلاء، لكن نادرا ما تحدث مجاعة قاتلة، لأن الإنسان معتاد على الادخار تحسبالأهوال السماء. وإذا جاءت سنة سيئة ثانية تحدث المجاعة لا محالة، وإذا كانت السنة الثالثة جافة أيضا تحل الكارثة، فتنفذ المدخرات وتتضخم الأسعار وتتضاعف الوفيات، مثل ما حدث سنوات 1521-1524، 1603-1606و1661-1625…
تبدأ السنة الفلاحية عادة بالحرث والبذرمع أولى أمطار الخريف التي ترطب الأرض وتنبث العشب الضروري لقطعان الماشية، وإذا تأخرت يبدأ القلق في البوادي ثم المدن، فترتفع الأسعار ومع مرور الأسابيع يزداد القلق وتزداد معه الأسعار ارتفاعا. وبمجرد ما تهطل أمطار كافية في دجنبر أو يناير تبدأ الأسعار في الانخفاض، وترجع إلى مستواها العاديإذا كان الحصاد جيدا بعد أمطار فصل الربيع، كما حدث سنة 1553. لكن قد يحدث أن يأتي الربيع جافا بعد الزرع والأمطار الجيدة، فتتضرر المحاصيل ويهدد الفلاح بضياع مابذره، وهو ما وقع سنوات 1516-1517، 1520، 1613 و1662.
وقد لاحظ الباحثان أن الجفاف يجر وراءه أسراب الجراد، الذي عُد جزءا من موكبه المخيف. يأتيالجراد على المزروعات المسقية بواحات المناطق الجنوبية، بعد أن يتسرب إليها من الصحراء، ثم ينتقل إلى داخل البلاد حيث يساعده مناخ الجفاف على التكاثر، وإذا لم تقض على بيضه أمطار الربيع، فإنه ينسف ما تبقى من محصول زراعي هزيل، مثل ما حدث إثر جفاف سنة1540.
عملت مثل هذه الأزمات الزراعية المتكررة على توجيه المغاربة إلى اتخاذ تدابير تعين على مواجهتها أو على الأقل الحد من أضرارها، ومن بينها الادخار وتنويع المحصول الزراعي.
فعلى مستوى البوادي المغربية،اشتهرت في الأطلس الكبير، وخاصة في سفحه الجنوبي وبالأطلس الصغير، مؤسسة المخازن الجماعية (أكادير، إغْرْم)، وهي بنايات شديدة التحصين، تمتلك داخلها كل أسرة غرفة تخزينللحبوب، والفواكه المجففة، والعسل، والسمن…. وقد قدمت هذه المؤسسة إفادة كبيرة للسعديين، أثناء تحركهم العسكريالذي تزامن مع أزمة 1520-1524، كما استفادت منها أيضا أسرة تازروالت في القرن السابع عشر. أما السهول الأطلنتية، حيث تغيب مثل هذه المؤسسات، فقد استعان فيها الفلاحون بمطامير محفورة في أرضٍ كلسية لتخزين جزء من محصول السنوات الجيدة.
وعلى مستوى المدن، كان تدبير التخزين لفائدة الساكنة الحضرية من اختصاصات المخزن، الذي حرص على امتلاء الأهراء والسهر على أمنها، ذلك أنه من المهم أن يكون الحاكم قادرا على تموين رعيته بالمدن، خاصة المدن العواصم، حتى يضمن ولاءها.ولأن الاحتياط لا يمكن أن يمنع التضرر من القحط والجوع عندما تطول سنوات الجفاف، وتنفذ المدخرات، فقد كان الحرص علىتنويع الإنتاج الزراعي.
ومن المعروف أن القمح والشعير هي أهم أنواع الحبوب التي تنتجها الأراضي المغربية منذ القدم، والأكثر تضررا من تأخر الأمطار. ثم يليها الدخن (إيلاَّن بالأمازيغية، أو سورغو)، الذي كان يتمركز إنتاجه بالجبال وبنسبة أقل بالسهول قبل أن تغزو أراضيه الذرة انطلاقا من القرن السادس عشر.
احتل إنتاج الدخن مكانة مهمة، وردت في شأنها إشارات مصدرية عديدة، ويعود ذلك إلى دوره في منع حدوث المجاعة بعد سنة سيئة. ينمو الدخن في فترة متأخرة عن فترة القمح والشعير، ويكون حصاده في فصل الخريف، حيث يكون محصول الحبوب ضعفا. وقد أشير إلى دوره المنقذ هذا بمنطقة فاس، في خريف سنة 1540، عندما أدت وفرة حصاده إلى انخفاض الأثمان في الأسواق، بعد أن شهد غلاءً مفرطا، نجم عن قلق الناس من تأثير تأخر أمطار نفس الشهر على زراعة القمح والشعير.كما أنه نجى، حسب شهادة كاتب إسباني،المغاربة في بداية القرن السابع عشرمن المجاعة بسبب ضعف إنتاج القمح. وربما تفسِّر نجاعة هذا النوع من الحبوب الإفريقية في مواجهة الأزمات الغذائية تشبث المغاربة به إلى أن أظهرت حبوب الذرة فعالية أكبر في نفس الظروف.
علاوة على الحبوب، احتلت القطاني مثل العدسوالحمصوالفاصولياء وبعض البذوركالخروب والأركان، هي الأخرى مكانة هامة في النظام الغذائي الاعتيادي للمغاربة، وكانت أهميتها تزداد في الأيام التي تنعدم فيها المواد التي تستعمل في صنع الخبز.
وقدمت التمور موردا غذائيا غنيا لأهل المجالات الصحراوية، حيث لا تحتل زراعة الحبوب نفس الأهمية، وبالتالي لا يكون التخوف من آثار السنة السيئة إلا إذا امتدت لأكثر من موسم فلاحي، حيث يبدأ النخيل بالتضرر من الجفاف.
هذه إذن بعض الإنتاجات الزراعية التي ساعدت المغاربة على مواجهة أزمات الغذاء، تضاف إليها موارد غذائية أخرى، كان يتم اللجوء إليها إذا كان الجفاف شديدا وامتد لأكثر من موسم فلاحي، مثل البلوط والبقول والبسباس البري والكرنينة وقلب أشجار النخيل الصغير النخيل المثمر بالواحات، ثم يرني، النبات السام الذي كان يستخدم، بعد معالجته، كدقيق يصنع منه الخبز أو الكسكس.
أما اللحوم، فتصبح أساس النظام الغذائي لمربي الماشية إثر ندرة الحبوب والخضر ونقص العشب، فتذبح الماشية عن طيب خاطر أهلها، كما حدث في مجاعة 1662. ومع ذلك يتم الحفاظ على الدواب التي تعين على عملية الحرث، كما يتم الاحتفاظ بقدر من الحبوب من أجل بذرها عند سقوط الأمطار. أما خيرات البحر فقد كان المستفيد منها بشكل أكبر هم سكان السواحل.
وتبقى الأشكال الاقتصادية الأكثر بدائية: القنص، الصيد، الالتقاط، آخر الحلول التي يلجأ إليها الإنسان زمن المسغبة، قبل أن تحتل المكانة الأولى عند اشتداد الأزمة.
يدعو الباحثان إلى فهم العلاقة القائمة بين القحط والمجاعة من جهة وبين الأوبئة من جهة ثانية، بحيث يبدو أن المجاعة تمهد الطريق أمام الأوبئة، فالبنية الجسدية التي أنهكها الجوع تكون على استعداد كبير لاستقبال الأمراض. ويتساءل المؤلفان في نفس السياق حول مساهمة الجفاف في انتشار الوباء، ذلك أن انحباس المطر يدفع بعض الحيوانات الحاملة لجراثيم وبائية إلى البحث عما تقتات به في الأماكن المأهولة.
دفعت صعوبة التشخيص السريري لأوبئة القرنين السادس عشر والسابع عشر بالمغرب، في ظل ضعف وعدم دقة النصوص المصدرية في وصف الظاهرة الوبائية، بالباحثين إلى التركيز على دراسة الطاعون، لأنه الأكثر ترددا بالمغرب والمعلومات حوله أكثر وفرة.وفي هذا الإطار، استفادا من التراكم المعرفي الذي تحقق في مجال دراسة الأوبئة لإضاءة بعض الجوانب حول هذا الوباء، الذي تعرض له المغاربة في السنوات التالية على الأقل: 1521-1523، 1557-1558، 1596، 1610، 1626 و1631.
يعود الطاعون إلى عصية يرسين[1]، وهي جرثومة تعيش في وسط تبلغ حرارته 25 درجة، لها سُمِّية متغايرة تختلف حسب طريقة الإصابة بها. تمر الجرثومة بسهولة عبر الغشاء المخاطي، لكنها لا تستطيع اختراق الجلد إلا عبر جرح مهما كان صغيرا، بحيث يكون جرح لدغة برغوثة كاف في هذه الحالة.
وتختلف أعراض الإصابة بالطاعون عند الإنسان حسب كيفية دخول الجرثومة للجسد، فإذا نفذت عبر الجلد، تظهر طبقة سوداء على موضع نفاذها بعد حضانة مدتها ستة أيام، وهذه الجرثومة تنخر الأنسجة، وهي المسماة بالجمرة الخبيثة، ثم تظهر بعد مدة وجيزة عُقد مؤلمة وصلبة تميل إلى التقيح في الفخذ وتحت الإبطين وعند الرقبة، وهي الدمال أو الدبل (الطاعون الدملي أو الدبلي)، فتشتد الحمى على المصاب وتصحبها اضطرابات عصبية وعقلية. وإذا لم يمت المريض فمن الممكن أن يشفى بعد مرور مدة تتراوح بين ستة وثمانيةأيام على إصابته. أما إذا تسربت الجرثومة عبر الغشاء المخاطي وأصابت الرئتين، فإن تطور المرض يكون أسرع ويتسبب في هلاك المريض لا محالة.
تنتقل جرثومة الطاعون في الحالة الثانية من إنسان إلى آخر عبر رذاذ العطس، خاصة في فصل الشتاء، أو تنقلها القوارض والبراغيث. هذه الأخيرة ساهمت بشكل كبير في انتشار الأوبئة بالمغرب، لهذا اهتم بها الباحثان عند تحليل أسباب انتشار الطاعون، وبيَّنا أنها تعيش في بيئة معيَّنةلا تتحمل أكثر من 20 درجة وأقل من 15 درجة، وتناسبها الرطوبة المرتفعة،مما يفسر سبب انتشار الوباء في الشتاء واختفائه في الصيف مع طفرته في الربيع، كما أن انجذابها للون الأبيض المفضَّل عند أهل الحواضر، ونفورها من بعض روائح النباتات والحيوانات مثل الأحصنة والغنم والجمال، هو ما يفسرتفشي الطاعون بالمدن، وتمتع المناطق الصحراوية والجبلية بنوع من الحصانة إزاءه. فالجفاف الشديد والحرارة في الأولى، والبرودة النسبية في الثانية، علاوة على تعايش الأهالي مع ماشيتهم يثبط من تحركه وتكاثره، في حين أن النشاط الاقتصادي لساكنة السهول الأطلنتية يمنع استفادتها من بعض هذه الامتيازات، لكثرة القوارض بالأراضي الزراعية، والتي تقوم هي الأخرى مقام البراغيث في نقل الوباء.ولذلك، يبيِّن هذا التحليل أن الطاعون بالمغرب وباء موسمي، يظهر في الشتاء وبالأخص في الربيع، ويختفي في الصيف، وبأنه مجالي، يصيب مناطق أكثر أو أقل من أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب تشخيص الأوبئة في المغرب بمعزل عن البلدان المجاورة خاصة الجزائر، التي كانت تنتقل إليها العدوى انطلاقا من الجهة الشرقية، وكان قراصنتها يرسون بسفنهم بموانئ المغرب الشمالية، كميناء بادس وتطوان، وأحيانا تصل إلى العرائش وسلا، لهذا رجح المؤلفان أن وباء 1557-1558 انتقل من الجزائر إلى المغرب، لتركزه بالمنطقة الشمالية والريف على الخصوص. في حين أن وباء سنة 1597، والذي تضررت منه نفس المنطقة، كان مصدره إسبانيا، لكن انتقاله إلى بلاد سوس مكن من تكوينه بؤرة محلية انتشر منها من جديد بعد بضع سنوات.
وقد لاحظ الباحثان أن أوبئة القرن السابع عشر كانت أكثر ترددا، وأطول في الزمن من أوبئة القرن الذي قبله، كما أن ظهورها بالجنوب أعطى الانطباع بتكون بؤرة وبائية بهذه المناطق، مثل وباء 1601، 1613-1614 و1624-1630.ونفس الملاحظة أبداها الدكتور رونو في دراسته عن أوبئة القرن الثامن عشر في المغرب، بحيث توصل إلى ظاهرة توطن الطاعون في مجال الواحات المتاخمة للصحراء.وبالتالي فقد جرى رصد مصدرين لانتقال الوباء، أولهما خارجي عن طريق انتقال العدوى من البلدان المجاورة، الجزائر وإسبانيا، إلى موانئ الساحل الشمالي، وثانيهما محلي ناجم عن تشكل بؤر داخلية.
ورغم التأطير الديني[2] لحصر المرض، فإن ضعف المعرفة الطبية لم يسمح بمقاومته، لهذا رأى برنار روزنبرجي وحميد التريكي أن مساعدة المؤمنين على تقبل الموت بالطاعون على أنه شهادة لا يخلو من حكمة[3]،كما أن الحاجة إلى الحد من الاتصال بين الناس لمنع انتقال العدوى وانتشار القلق غايات تبرر منع التنقل، ومع ذلك أكدا على أنه يجب الإقرار بأن الموقف المتولد عن هذه التعاليم هو السلبية التي تدفع لانتظار المصير باستسلام وخضوع للقدر المحتوم.
من جهة أخرى، أشار المؤلفان إلى موروث شفهي كان يردده الأمازيغ عند القفز على النار أثناء الاحتفال: نعبرك يا نار ونترك لك البراغيث والقمل، وبصيغة أخرى، نترك لك المرض والبؤس والحمى وبراغيثنا والأذى[4].ويبين هذا الموروث، حسب الباحثين، معرفة المغاربة بدور الحرارة في قتل البراغيث دون التأكيد على معرفتهم بدورها في نقل الأمراض. وتساءل المؤلفان أيضا عن استخدام الطب المغربي لمادة الكِينِينْ[5] في ترياق العلاج من الأمراض الوبائية، مثلما استخدمه المولى سليمان عند إصابته بطاعون 1799-1800.والأكيد حسب الإشارات المصدرية، أن الفرار والهرب من أرض الوباء، كان الحل الوحيد أمام مغاربة تلك الحقبة الذين اعتبروا في عمومهم أن الطاعون هو انتقام من الله.
انعكست هذه الأزمات الغذائية والصحية على المجتمع ماديا ومعنويا.على المستوى المادي، برزتفاوت أمام الجوع والموت، بسبب اختلاف وسائل مواجهة الأزمة. ففي الوقت الذي استعانت فيه حاميات المواقع البرتغالية بالقمح المستورد من البلد الأم للتخفيف من أثر مجاعة سنوات 1516-1517 و1520-1522، لم تتمكن السلطتان القائمتان بكل من مملكتي فاس ومراكش من استيراد حاجياتهما بسبب انعدام وسائل وإمكانات جلب الأقوات من الخارج، كما نبه إلى ذلك المؤرخ البرتغالي برناردو رودريكس.وتكرر نفس الاختلافبين مناطق المغرب، إذ أبانت المخازن الجماعية بالمناطق الجنوبية عن نجاعتها لتخفيض آثار القحط والمجاعة، في حين كانت معاناة المناطق الأخرى أشد.وسُجل التفاوتأيضا في مواجهة الأزمات بين الفئات الاجتماعية، ذلك أن الموت عصف بالفقراء والمعدومين أكثر من الأغنياء،والشيوخ والأطفال أكثر من الشباب. وبينما كانت فئة عريضة من المجتمع المغربي تعاني من محدودية وسائل مقاومتها للأزمات، كانت فئة قليلة منه تضخم ثرواتها، من خلال المضاربة في أثمان السلع زمن القحط، والإشراف على بيع المغاربة المتضورين جوعا إلى تجار العبيد، وتجميع العقارات بعد أن عرضها أصحابها للبيع حتى يتمكنوا من مسايرة أسعار المواد الغذائية المرتفعة. وقد لاحظ الباحثان أن نقص الأقوات والمجاعة يقويان علاقات التبعية بين المعدمين وأصحاب المال أو السلطة، وهو ما لا ينطبق على الأوبئة التي تتسبب في قلة اليد العاملة في البوادي والمدن بسبب الموت، وبالتالي تجعل سادة الأرض وأصحاب السلطة على استعداد للدفع أكثر من أجل الحصول على العمال، مما يؤدي إلى تحسن معيشة هذه الفئة الاجتماعية. وعلى العموم أبدى برنارد روزنبرجي وحميد التريكي ثلاث ملاحظات حول الآثار المادية للأزمات على المجتمع، وهي:
1- يشجعالغلاء ونقص المواد الغذائية المضاربات والمديونية، مما يساهم في إغناء الغني وإفقار الفقير.
2- يتيحانتقال الملكيات بسبب البيع، أو اختفاء الأفراد، وإعادة توزيع حقيقية للثروات، تختلف آثارها من منطقة إلى أخرى.
3- السرقةوالنهب وأخذ أقوات الغير بالقوة هي أفعال لمجموعات أو أفراد، يلجؤون إليها في سبيل ضمان البقاء.
وإذا كان من الصعب وضع جرد للآثار المادية للأزمة المناخية والصحية على المجتمع، فإن المصادر تقدم مؤشرات أكثر عن عواقبها النفسية والمعنوية الناتجة عن السلوكيات المتطرفة التي يلجأ إليها، مثل:
بيع النفس أو أفراد من الأسرة من أجل ما يُقتات به، إلى درجة أن المعاصرين لأزمة 1520-1522 وصفوا شحن السفن الأوربية بكل من آزمور وآسفي للمغاربة الجياع بعملية شحن سمك الشابل التي كانت رائجة بالمنطقة.
الارتداد عن الدين بحثا عن إله آخر يُعين على الخروج من الأزمة، وفي هذا الإطار اعتنق العديد من اليهود الإسلام، وتنصر العديد من المسلمين.
تجاهل القيم الدينية والقوانين الأخلاقية في سبيل الحصول على القوت، إذ تلجأ النساء إلى الدعارة،مثلما حدث في مجاعة 1626 بمراكش، وتنتشر السرقة وعمليات النهب والقتل. وما قاله المؤرخ اليهودي ڤاجْدا يعبر بقوة عن هذه الوضعية السائدة في سنة 1615:”لم ينج من المجاعة إلا ليموت بالسيف، لأن انعدام الأمن ساد في كل الطرق“. وأشار برتغاليٌّ أنه خلال مجاعة 1521، كانلإحدى القبائلمخزون هام من القمح والشعير،غنم منه البرتغاليون الشيء الكثير، وذلك لا يعود إلى ادخارهم وإنما لسرقتهم حبوب الشاوية كلها.
أكل الأطعمة القذرة كالجيف، وفي بعض الحالات القصوى أكل لحوم البشر مثلما وقع سنة 1662.
يتساءل المؤلفان: فكيف لا تترك هذه المآسي أثرها على الناجين؟
بمجرد أن تطل الأزمات بوجوهها البشعة (الجوع، والطاعون، والموت)، فإنها تُغرقالأزمات الإنسان المغربي في أنانيته وفي جو يكتنفه الشعور بفناء الدنيا وقرب قيام الساعة، وتجعله ينتظر ظهور المهدي الذي يخلص الأرض من الفساد، مثل ابن أبي محلي. هذه الظاهرة لم تكن حكرا على المغاربة أو على المسلمين عامة، بحيث عرفت أوربا شيوع معتقدات مماثلة خلال موجات الطاعون.وعلاوة على ذلك، أدى تعاقب الكوارث والآفات خلال القرن السادس عشر والسابع عشر على الخصوص إلى تراجع المغرب على عدة مستويات. فقد دوَّن المؤرخون المغاربة بحسرة كبيرة فراغ المدن، وإخلاء القرى، وانحطاط العلوم والآداب، واختفاء أعيان المجتمع من فقهاء وعلماء. وإن لم يشيروا إلى الآثار الاقتصادية، فإن الأزمات الديموغرافية كفيلة بوضع استنتاج أولي عن التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال هذين القرنين.
واجه المغرب في ظرف مئة سنة مختلف الأوبئة والمجاعات، نجم عنها ثلاث أزمات ديموغرافية حادة هي أزمة 1625-1631، ثم أزمة 1661-1663 وفي الأخير أزمة 1678-1681.كان امتداد هذه الأزمات يتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وتتباعد عن بعضها البعض بفاصل يتراوح بين خمس عشرة سنة وثلاثين سنة، مما جعل القرن السابع عشر أكثر حلكة من القرن الذي سبقه، بمعدل سنة كارثيةكل ثلاث سنوات. ولم تكن أزمات القرن السادس عشر أقل حدة رغم وتيرتها الضعيفة. هذه الحصيلة الكئيبة كانت تكفي للإقرار بأن ساكنة المغرب خلال هذه الفترة لا يمكن أن تعرف إلا الركود والتراجع. وتوضح أوصاف الحسن الوزان وبعده مارمول كاربخا لهذا التراجع خاصة بالسهول الأطلنتية، التي أعطى حولها المؤلفان معلومات أكثر. وإن كانت المعطيات المصدرية لا تسمح برسم خريطةلساكنة المغرب خلال القرنين المذكورين، فالأكيد، حسب برنار روزنبرجي وحميد التريكي، أن التقييمات التي أنجزت في القرنينالثامن عشر والتاسع عشر انطلاقا من تقديرات الحسن الوزان، لم تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن الأزمات المتكررة، ويرجحان في هذا الإطار، أن المغرب لم يكن أكثر تعميرا من بداية القرن السادس عشرلما بدأ الأوربيون إعادة اكتشافه إثر وباء 1818.
وكما أثرت الأزمات على نسبة سكان المغرب، فقد خلَّفت تحولات على مستوى توزيعهم، مما انعكس بدوره على الاقتصاد المغربي.
أدى اختفاء الساكنة المستقرة التي كانت تقطن بالسهول الأطلنتية في بداية القرن السادس عشر إلى استيطانها من قبل البدو الرحل، الذين يعيشون بالدرجة الأولى على تربية الماشية. استمرت هذه الوضعية إلى القرن التاسع عشر وفجر العشرين، وأثار اندهاش الأوربيين وجود هذا النمط الاقتصادي بمجالات ذات مؤهلات طبيعية هامة. وإذا فسر بعضهم ذلك بعجز السكان عن الاستفادة من الأراضي وبتعرضهم لغارات الأعراب، فإن الباحثيْن أرجعاها إلى التاريخ الديموغرافي للمنطقة. فالحروب مع البرتغاليين والمجاعات والأوبئة أبعدت السكان عن مواطنهم، وهيأتها لاستقبال هجرات وافدة من المجالات شبه الصحراوية، وفي هذا الإطار قدم المؤلفان تحرك قبيلة الرحامنة كنموذج لهذه الهجرات. فإلى حدود بداية القرن السادس عشر كان الرحامنة بالصحراء يمارسون الانتجاع ما بين أقاوتشيت، ثم استجلبهما السعديون لتعمير المجال بعد مجاعة 1521-1522.
وهكذا، شكلت المجالات الصحراوية، وبصفة أقل الجبلية، خزانات بشرية تساهم في إعادة تعمير السهول، ويفسر جزء من هذه الظاهرة بالنجاة النسبية لهذه المناطق من المجاعات والأوبئة كما بينا سالفا، وإلى غياب التوازن بين مواردها المحدودة والنمو السريع للساكنة.وإن كانت هذه الظاهرة تعيد التوزيع الديموغرافي للمغرب، خاصة بالمناطق المتضررة، فإنها تعيد هيكلة اقتصادها. ذلك أن القبائل الصحراوية التي تغريها السهول الخالية، لا تهاجر بخيمها وقطعان ماشيتها فقط، بل تهاجر كذلك بنمط عيشها، فتمارس الانتجاع والترحال على أراض كانت قبل سنوات منتجة للحبوب. وبما أن جملة من العوامل الاقتصادية والجبائية جعلت المخزن يشكل الجهة القادرة على تغيير نمط هؤلاء الوافدين الجدد في اتجاه الاستقرار، فإن الصراع حول الحكم والاضطرابات ساهمت في احتفاظ تلك القبائل بنمط عيشها المألوف.
لهذه الأسباب، يرى المؤلفان أن مقاربة الركود الاقتصادي يجب أن تتم في علاقته بالتقلص الديموغرافي الناتج عن الأزمات المتكررة، فالإنتاج لا يتضرر مؤقتا زمن الأزمات فقط، بل يصبح غير منتظم بسبب تكرارها وبسبب الخسائر البشرية التي تحدثها. وعادة ما تنخفض الأسعار وتسود وفرة نسبية بعد التعديل الكبير للطلب، بسبب قضاء الوباء على جزء كبير من الساكنة. فالوفرة الإنتاجية التي ميزت عهد محمد الشيخ الأصغر، في سنوات 1636-1650، تعود إلى تزامن الظروف المناخية المواتية مع الانخفاض الكبيرلعدد السكان، مما سمح بالاستفادة من مداخيلتصدير الفائض. وبالتالي فإن المدةالتي تفصل بين الأزمات هي فترة رواج الأسواق، لكن يجب الانتباه إلى أن الوضع يناسب المستهلك الحضري والمستورد، ولا يساهم في زيادة الإنتاج، ومع ذلك فإنه يفيد، من ناحية أخرى، في تشجيع الانتعاش الديموغرافي المؤقت.
زيادة على الإنتاج الفلاحي، يتقلص الإنتاج الحرفي لأن كافة الموارد تخصَّص للموارد للتغذية، كما تتراجع الصناعة وتجارة منتوجات الترف، ولنا أن نتخيل الضرر الذي يصيب اقتصاد المدن، إضافة إلى أن ظروف الأزمات لم تكن مواتية للحياة الفكرية الحضرية، فتتراجع بعض المهن المرتبطة بها، مثل التدريس والتعليم. ومادام القرن السابع عشر كان هو قرن الأزمات بامتياز، فإن الباحثين جعلا منه حقبة تراجُعالمدن المغربية وغياب المغرب في التجارة الدولية، وذلك بسبب جملة من العوامل، من بينها تراجع الإنتاج وانخفاض الطلب على المنتجات الخارجية، وتدمير وسائل إنتاج ذات أهمية كبرى، ونقصد بها مزارع ومصانع السكر، فقد أدى تخريبها إلى حرمان المغرب من أداة ثمينة للمبادلات الخارجية، بحيثكان من الصعب أن تعوَّض بأي منتوج فلاحي آخر. وقد تزامن هذا التدهور مع تحولات كبيرة شهدها الاقتصاد العالمي في نفس الفترة، ومع تجاوز الوساطة المغربية بين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء، مما جعل نتائج هذا الغياب ظاهرة دائمة.
وعلى المستوى السياسي، ساهمت ثلاث أزمات حادة في التطورات السياسية التي شهدها القرنان، وهي أزمات 1521-1523، 1597-1610، و1660-1661.نبه كل من برناردو رودريكسو دييغو دي طوريس، المعاصرين لأحداث قيام الدولة السعدية، إلى ارتباط دخول السعديين إلى مراكش واتخاذها عاصمة لحكمهم بأزمة 1521-1523. فقد أشار المؤرخ الأول إلى أن الشريف استغل ظروف خسارة مملكتي فاس ومراكش لآلاف من البشر، للتحكم في مراكش التي وجدها شبه مقفرة، وأوضح الثاني أنه بالرغم من أن المجاعة والوباء أساءا كثيرا إلى الشريفين، فإن الأخيرين لم يدخرا جهدا لتوفير الطعام للناس بمناطق نفوذهما، وكان أكثر الناس حصولا على الطعام هم أهل مراكش وتارودانت. وقد بينا سالفا الاختلاف المجالي للأزمات، مما أدى إلى اختلال في توازن القوى بين السلطة الوطاسية والحاميات البرتغالية والسلطة السعدية الصاعدة التي كانت أكبر مستفيد من الجفاف وما سببه من آفات. ذلك أن الانتماء المجالي للسعديين ومجال انطلاقهم ساعدهم كثيرا على مواجهة انعكاسات ضعف التساقطات، بحكم الاعتماد على تخزين الأقوات والسقي، وفي آن واحد كرس ضعف الوطاسيين وأضر بالوجود الوجود البرتغالي بالمغرب، وأصبح التباين واضحا، في القدرة على مواجهة الأزمة، بين سلطة في طور الانهيار وأخرى في طور النشأة. واعتبر برنارد روزنبرجي وحميد التريكي أنه من بين العلامات التي كانت تعبر عن تحول ميزان القوى، كون إحدى الشخصيات التي برزت بوضوح خلال المجاعة – يعقوب بن الغربية المشرف على بيع المغاربة- تفر من أزمور وتتملص من ولائها للبرتغاليين وتلجأ إلى الشريف السعدي، فمثل هذه الشخصيات تحس باتجاه التغيير وتوالي، وفقا لمصالحها، الطرف المرشح لاكتساب المزيد من القوة والنفوذ.
وعلى عكس ذلك، أدت أزمة 1597-1610، الشبيهة بالأزمة الأولى في آثارها الديموغرافية، إلى انتهاء دولة السعديين، بعد التشكيك في شرعية حكمهم، واتهامهم بالتسبب في نزول العقاب الإلهي الذي حل بالمغاربة، نتيجة للصراع الدائر بينهم حول الحكم، وإدخالهم النصارى إلى بلاد الإسلام. إن المخزن السعدي الذي بني ببطء مدة قرن من الزمن، لم يتمكن من مقاومة ثلاث عشرة سنة من الأزمات الصعبة، والتي كان التغلب عليها مستحيلا في غياب حزم السلطان أحمد المنصور وما رافقه من هدوء واستقرار.وتفسر أزمة 1660-1661 السرعة والسهولة المذهلة التي أخضع بها مولاي رشيد المغرب، بعد قضائه على الزعامات السياسية الإقليمية التي ظهرت بالمغرب من جديد، وعملت على مواجهة الأزماتفي إطار محلي خلال مرحلة غابت فيها هيمنة مؤسسة المخزن.
وفي الختام، أكد الباحثان على أهمية عنصري الأزمة والوباء في تفسير بعض الوقائع التاريخية، فضعف الدولة السعدية بعد أحمد المنصور يزداد وضوحا عندما نستحضر الأزمة الديموغرافية بدل أن نختزله في نزاع الأبناء. كما أن بعض الظواهر المرتبطة بالديموغرافيا مثل انتشار الاقتصاد الرعوي وشبه الرعوي، واختفاء بعض المراكز الحضرية والقروية، والامتيازات النسبية للمناطق الجبلية والصحراوية، والعودة القوية للقبيلة في الحياة السياسية، ثم مكانة المرابطين والزوايا في الحياة الدينية، كلها عناصر تسلط الضوء على التحول البطيء الذي عرفه التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، في حين تبدو الأزمات كعامل يفسر دورات ارتقاء الأسر الحاكمةوانهيارها. ولم يغفل الباحثان إثارة انتباه المهتمين إلى بعض الإشكالات التي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للبحث في تاريخ المغرب، مثل النظام الغذائي للمغاربة وأثره على الصحة والإنتاجية، والأسعار زمن الآفات، وفترات الاستقرار والرخاء النسبي بين الأزمات والاضطرابات، والهبات والتحبيس زمن الأزمة، والازدواجية المتوترة التي كانت تسم علاقة المهدوية بالأزمة والأسر الحاكمة، فضلا عن البحث في الترابط بين قدوم الرحل إلى المناطق الوسطى من المغرب وانتشار الربط وانتساب أصول أغلب أصحابها إلى الساقية الحمراء، علاوة على الدعوة إلى إنجاز كارطوغرافيا مؤسسات التخزين، والبحث عن الآثار النفسية للآفات في الأدب والفن.
[1] عصية يرسين[Bacille de Yersin]: هي عصية مسؤولة عن الوباء اكتشفت سنة 1894، وتنسب إلى مكتشفها ألكسندر يرسين [Alexandre Yersin].
[2]قال الرسول صلى الله عن الطاعون:”إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه“.
[3] ورد في حديث نبوي شريف، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم.
[4] حول هذه الطقوس يرجع إلى:
Laoust E., « Noms et cérémonies des feux de joie chez les Berbères du Haut et de l’Anti-Atlas »,Hespéris, I (1921) : 3-65.
[5]الكينين [Quinine]: مركب طبي، يستخرج من شجر الكينا، كانت تستخدمه قبائل الكيشوا في البيرو وبوليفيا للعلاج، ثم نقله عنها المبشرون إلى أوربا حيث استخدم في علاج الملاريا، وهو يتميز بكونه مخفض للحرارة ومسكن للآلام، علاوة على علاجه للملاريا والالتهابات.
Bernard Rosenberger et Hamid Triki, «Famines et épidémies auMaroc aux XVIe et XVIIe siècles»,Hespéris-Tamuda, vol. XIV, 1973, pp. 109-175 ; vol. XV, 1974, pp. 5-103.
برنار روزنبرجي وحميد التريكي، المجاعات والأوبئة في مغرب القرنين 16 و17،ترجمةعبد الرحيم حزل،الطبعة الثانية، الرباط، دار الأمان، 2010.
خصص الباحثان دراستهما للأزمات المناخية والصحية التي عاشها المغرب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، قصد تقديم عناصر جديدة لتفسير تاريخ المغرب الديموغرافي والاقتصادي والسياسي، وقد بررا اختيارهما الزمني بأهمية القرنين في تشكيل وجه المغرب المعاصر، حتى وإن لم ينالا حظهما من اهتمام الباحثين. وتعتبر دراستهما هذه أولى المساهمات العلمية للبحث في تاريخ الأزمات الغذائية والصحية في المغرب.
استهلت الدراسة بطرح إشكالية المصادر التي يواجهها البحث في مثل هذه المواضيع في تاريخ المغرب، فالمصادر المغربية تكاد تنحصر في الكتب الإخبارية والمنقبية، لانعدام سجلات كتلك التي توفرت بكنائس وأديرة أوربا، كما أن سجلات الحالة المدنية متأخرة جدا. وإن كانت المصادر الأجنبية أفيد، فإنها لا تخلو من نواقص ناجمة عن اهتمام مؤلفيها، منتجار ودبلوماسيين وغيرهم، بالوقائع التي تمس مصالحهم ومصالح دولهم بالمغرب. وعلى العموم، مع استثناءات طفيفة، فالمعلومات التي يقدمها هذان النوعان من المصادر هي معلومات مقتضبة، متفرقة وعامة، لم تسمح بمقاربة الأزمة في شموليتها وبتحديد انعكاساتها الديموغرافية والاقتصادية والسياسية، كما أن إمكانية تدقيق حجم الخسائر البشرية ضئيلة في ظل الأرقام المبالغ فيها التي تقدمها، والتي لا تسمح إلا بتقدير نسبي، في حين أن طبيعة المرضغابت في غالب الأحيان عن المؤلفَين كما غابت عن المعاصِرين لها. على سبيل المثال، ليس لكلمتي وباء وطاعون معنى دقيق، بحيث سميت بهما جل الأمراض التي أصابت المغاربة خلال هذه الفترة.
تتبع الباحثان الترتيب الكرونولوجي لتقديم الأزمات التي تعرض لها المغرب، مع إبراز ترابطاتها مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والبحث في قواسمهما المشتركة، رغم أن العديد من المتغيرات بيَّنت أن لكل أزمة خصوصياتها. ولأن دراسة الأزمات المناخية والصحية بالمغرب لا تكتمل في معزل عن محيطها الجغرافي، فقد عملا، قدر الإمكان، على رصد الحالات المشابهة ببعض البلدان المجاورة بشمال إفريقيا وبشبه الجزيرة الإيبيرية.
وتتوزع الدراسة إلى ثلاثة أقسام متكاملة. شمل القسم الأول عرضا لأزمات القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهي وباء نهاية القرن الخامس عشر وبدايةالسادس عشر،ومجاعة وطاعون 1521-1522، وآفات 1525-1557، وأوبئة 1557-1558 و1580، وكوارث نهاية القرن، ثم مآسي 1613-1635، وأخيرا أزمات النصف الثاني من القرن السابع عشر.وخصص القسم الثاني لتحليل سمات هذه الأزمات وميكانيزمات تطورها من خلال محوري أزمات البقاء والأوبئة، أما القسم الأخير فشخصت فيهآثار الأزمات على المجتمع والاقتصاد والسياسة،عبر البحث في آثارهاالمادية والنفسية والمعنوية، وانعكاس التقلص الديموغرافي الناجم عنها على الاقتصاد، ثم مساهمتها في إنجاح وإنهاء المشاريع السياسية.
دخل المغرب القرن السادس عشر متأثرا بأوبئة نهاية القرن السابق، وآخرها مرض التيفوس الوبائي الذي حمله بعض اللاجئين المسلمين واليهود بعد سقوط غرناطة سنة 1492. واستهل القرن بوباء ظهر في فاس سنة 1509 ثم في منطقة سوس سنتي 1511-1512، وفي سنتي 1516 و1517 أدى الجفاف إلى تراجع المحاصيل الزراعية خاصة بالسهول الأطلنتية، مما أضر بالمواقع البرتغالية بالمنطقة، وحولها من مُصدِّرة للحبوب إلى مستوردة لها، كما أدخلها في مواجهات عنيفة مع القبائل التي تعودت على الخضوع قبل الأزمة،ثم أصبحت ترفض أداء ضريبة المحصول الزراعي السنوي.
وفي سنة 1519 فقد المغرب عددا مهما من ساكنته بسبب الوفيات الناجمة عن الطاعون، قبل أن يعاني من أخطر أزمات القرنين وأكثرها حدة،وهي أزمة 1521-1522، التي استمرت لثلاث سنوات ولم تنته إلا سنة 1524. بدأت الأزمة بجفاف أفضى إلى تراجع الزراعة حتى بالأراضي المسقية، ثم إلى غلاء المعيشة وحدوث مجاعة شديدة، ألجأت المغاربة إلى بيع أنفسهم وأبنائهم مقابل ما يقتاتون به، قبل أن يتوج الطاعون هذه الكوارث المتعاقبة، ويستنزف ما تبقى لديهم من جهد على المقاومة. أضرت الأزمة بالسهول الأطلنتية أكثر من غيرها، وأضعفت الجانبين المغربي والبرتغالي، مما يفسر توقف المواجهات بينهما، كما ساهمت في بروز بعض المتصوفة بفضل أعمالهم الخيرية، مثل الشيخ الغزواني بفاس وأتباعه بمراكش، والشيخ أبو عثمان سعيد بمكناس.
بعد تسع سنوات فقط، تعرضت البلاد إلى وباء قاتل، أعقبه وباء آخر سنة 1536، ثم جفاف وغلاء سنة 1540، ثم زحف الجراد على ما بقي من المحاصيل، فكانت النتيجة حدوث المجاعة سنة 1541. وقد تضرر في هذه الأزمة القسم الجنوبي من المغرب، عكس الأزمات السابقة، واعتبرها المغاربة من غضب الله على الأعمال العدوانية التي قام بها الشريفان السعديان محمد الشيخ وأحمد الأعرج أثناء حروبهما، وإن ساعدت أمطار خريف سنة 1541 في تقليص حدة المجاعة وتراجع ارتفاع الأثمان.
في سنة 1553 حملت بعض السفن عدوى طاعون من تركيا إلى الجزائر، وانتشر في المناطق المجاورة لها قبل أن ينتقل إلى المغرب، وفي سنة 1557 انتشر الطاعون بشمال المغرب انطلاقا من جبال الريف، ثم انتقل في السنة التي تليها إلى باقي المناطق لينعت بـ”الطاعون الكبير“، الذي ذهب بعُشر ساكنة المغرب حسب المؤرخ أحمد الناصري. لم تكن الأزمة بنفس خطورة أزمة 1520-1522، لكن وقوعها بعد 35 سنة فقط عن بداية الأزمة الأولى، التي لم تلتئم ندوبها بعد، أثر سلبا على ديموغرافية المغرب واقتصاده. عاود الوباء الظهور سنة 1580 بعد أن هيأت له مجاعة وغلاء السنة التي قبلها ظروف انتشاره، وقد سمته المصادر المغربية بـ”السعال الكبير“ نسبة لأعراض السعال الشديد التي تظهر على المصابين به، ونتيجة للأثر السلبي الذي أحدثه بنفوس المغاربة، خاصة العامة منهم، فقد اعتبروه هو الآخر من علامانسخط الله، لأن غنائم معركة وادي المخازن لم تقسم حسب الضوابط الشرعية. وهكذا تبدو بداية حكم السلطان أحمد المنصور، بخلافالصورة التي تعطيها عنها الإنجازات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، مرحلة شدائد عانى منها المغاربة بسبب الجوع والطاعون.
ولم ينج المغرب من الأوبئة الخطيرة التي برزت بأوربا وشمال إفريقيا والإمبراطورية العثمانية نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، ومن بينها وباء قاتل ظهر بالمغرب سنتي 1597-1598، وعاود الظهور بشكل أقوى انطلاقا من سنة 1602، بعد فترة كُمون دامت ثلاث سنوات. استمر الوباء إلى سنة 1608، وتزامن مع حدوث المجاعة والحروب بين أبناء السلطان أحمد المنصور، فخلق مناخا اعتبر بمثابة إعلان عن قيام الساعة.
أضر الوباء أكثر بالفئات الفقيرة والمعدمة، واختلفت حدته حسب المناطق، إلا أن المدن كانت الأكثر تضررا إذ فقدت مابين ثلث ونصف ساكنتها. وقدأصيب جهاز المخزن بالضعف بعد وفاة السلطان أحمد المنصور، فلم يستطعمواجهة الأزمة، بلازداد التمرد ضد السلطة المركزية، وتكاثرت أعمال العنف والنهب التي طالت المنشآت الحيوية للاقتصاد السعدي، كمزارع ومصانع السكر، وضاعفت حروب أبناء السلطان أحمد المنصورمن آثار الأزمة، فبدأ المغرب مرحلة جديدة من تاريخه بساكنة متقلصة عدديا وضعيفة على مستويات عدة.
عقب هذا الوباء الشديد، بعد خمس سنوات، أدى تأخرسقوط الأمطار إلى ارتفاع في الأسعار، ثم إلى حصول مجاعة شديدة. وبعد عشر سنوات فقط، اجتاحت البلاد مآسي أكبر وأطول، بدأت سنة 1624 وانتهت في ثلاثينيات القرن، تميزت بدورات وبائية متكررة، بدأت من شمال المغرب، ومن فاس بالتحديد، ورافقتها مجاعة شديدة تركت البلاد ضعيفة ومنهكة وغير قادرة على كواجهة أزمات النصف الثاني من القرن.
فقد نجم عن جفاف خريف سنة 1650 حدوث غلاء شديد،تضخمت خلاله الأسعار اثنا عشر مرة، كما أن أمطار الربيع التي عادة ما تنقذ السنة الفلاحية لم تسقط، مما زاد من اشتداد حدة الجفاف. وفي أكتوبر 1656 بدأ الطاعون بالانتشار واستمر سنة كاملة. وأدى جفاف شتاء 1661 إلى حدوث مجاعةتسببتفي إفراغ تجمعات سكنية كاملة بمنطقة تادلة سواء بسبب هلاك أهلها أو لهجرتهم نحو المناطق الجنوبية والصحراوية الأقل تضررا، ولن يعود هؤلاء الجياع المهاجرون إلا بعد هطول أمطار خريف نفس السنة. وفي السنة الموالية عانت البلاد من مجاعة بسبب الجفاف أيضا، تبعها وباء أصاب كل المغرب، كانت الكارثة عامة وإن لم تتضرر منها منطقة السفح الجنوبي للأطلس بنفس الحدة، وقد كانت نتائجها، حسب المؤلفَين، مهمَّة بحيث خلقت وضعية تفسر وقائع أكثر أهمية.
الظاهر، من خلال هذا العرض الكرونولوجي المقتضب لأزمات القرنين السادس عشر والسابع عشر، أن أغلب الآفات أصلها أسباب مناخية، لهذا شبه برنار روزنبرجي وحميد التريكي آليات الأزمة بالمغرب بتلك التي وصفت بأوربا وبباقي البلدان المغاربية، إذ تتلخص القاعدة في أن الأزمات الشديدة سببها توالي سنتين سيئتين، فسنة سيئة تعني قلقا حقيقيا يعبِّر عنه الغلاء، لكن نادرا ما تحدث مجاعة قاتلة، لأن الإنسان معتاد على الادخار تحسبالأهوال السماء. وإذا جاءت سنة سيئة ثانية تحدث المجاعة لا محالة، وإذا كانت السنة الثالثة جافة أيضا تحل الكارثة، فتنفذ المدخرات وتتضخم الأسعار وتتضاعف الوفيات، مثل ما حدث سنوات 1521-1524، 1603-1606و1661-1625…
تبدأ السنة الفلاحية عادة بالحرث والبذرمع أولى أمطار الخريف التي ترطب الأرض وتنبث العشب الضروري لقطعان الماشية، وإذا تأخرت يبدأ القلق في البوادي ثم المدن، فترتفع الأسعار ومع مرور الأسابيع يزداد القلق وتزداد معه الأسعار ارتفاعا. وبمجرد ما تهطل أمطار كافية في دجنبر أو يناير تبدأ الأسعار في الانخفاض، وترجع إلى مستواها العاديإذا كان الحصاد جيدا بعد أمطار فصل الربيع، كما حدث سنة 1553. لكن قد يحدث أن يأتي الربيع جافا بعد الزرع والأمطار الجيدة، فتتضرر المحاصيل ويهدد الفلاح بضياع مابذره، وهو ما وقع سنوات 1516-1517، 1520، 1613 و1662.
وقد لاحظ الباحثان أن الجفاف يجر وراءه أسراب الجراد، الذي عُد جزءا من موكبه المخيف. يأتيالجراد على المزروعات المسقية بواحات المناطق الجنوبية، بعد أن يتسرب إليها من الصحراء، ثم ينتقل إلى داخل البلاد حيث يساعده مناخ الجفاف على التكاثر، وإذا لم تقض على بيضه أمطار الربيع، فإنه ينسف ما تبقى من محصول زراعي هزيل، مثل ما حدث إثر جفاف سنة1540.
عملت مثل هذه الأزمات الزراعية المتكررة على توجيه المغاربة إلى اتخاذ تدابير تعين على مواجهتها أو على الأقل الحد من أضرارها، ومن بينها الادخار وتنويع المحصول الزراعي.
فعلى مستوى البوادي المغربية،اشتهرت في الأطلس الكبير، وخاصة في سفحه الجنوبي وبالأطلس الصغير، مؤسسة المخازن الجماعية (أكادير، إغْرْم)، وهي بنايات شديدة التحصين، تمتلك داخلها كل أسرة غرفة تخزينللحبوب، والفواكه المجففة، والعسل، والسمن…. وقد قدمت هذه المؤسسة إفادة كبيرة للسعديين، أثناء تحركهم العسكريالذي تزامن مع أزمة 1520-1524، كما استفادت منها أيضا أسرة تازروالت في القرن السابع عشر. أما السهول الأطلنتية، حيث تغيب مثل هذه المؤسسات، فقد استعان فيها الفلاحون بمطامير محفورة في أرضٍ كلسية لتخزين جزء من محصول السنوات الجيدة.
وعلى مستوى المدن، كان تدبير التخزين لفائدة الساكنة الحضرية من اختصاصات المخزن، الذي حرص على امتلاء الأهراء والسهر على أمنها، ذلك أنه من المهم أن يكون الحاكم قادرا على تموين رعيته بالمدن، خاصة المدن العواصم، حتى يضمن ولاءها.ولأن الاحتياط لا يمكن أن يمنع التضرر من القحط والجوع عندما تطول سنوات الجفاف، وتنفذ المدخرات، فقد كان الحرص علىتنويع الإنتاج الزراعي.
ومن المعروف أن القمح والشعير هي أهم أنواع الحبوب التي تنتجها الأراضي المغربية منذ القدم، والأكثر تضررا من تأخر الأمطار. ثم يليها الدخن (إيلاَّن بالأمازيغية، أو سورغو)، الذي كان يتمركز إنتاجه بالجبال وبنسبة أقل بالسهول قبل أن تغزو أراضيه الذرة انطلاقا من القرن السادس عشر.
احتل إنتاج الدخن مكانة مهمة، وردت في شأنها إشارات مصدرية عديدة، ويعود ذلك إلى دوره في منع حدوث المجاعة بعد سنة سيئة. ينمو الدخن في فترة متأخرة عن فترة القمح والشعير، ويكون حصاده في فصل الخريف، حيث يكون محصول الحبوب ضعفا. وقد أشير إلى دوره المنقذ هذا بمنطقة فاس، في خريف سنة 1540، عندما أدت وفرة حصاده إلى انخفاض الأثمان في الأسواق، بعد أن شهد غلاءً مفرطا، نجم عن قلق الناس من تأثير تأخر أمطار نفس الشهر على زراعة القمح والشعير.كما أنه نجى، حسب شهادة كاتب إسباني،المغاربة في بداية القرن السابع عشرمن المجاعة بسبب ضعف إنتاج القمح. وربما تفسِّر نجاعة هذا النوع من الحبوب الإفريقية في مواجهة الأزمات الغذائية تشبث المغاربة به إلى أن أظهرت حبوب الذرة فعالية أكبر في نفس الظروف.
علاوة على الحبوب، احتلت القطاني مثل العدسوالحمصوالفاصولياء وبعض البذوركالخروب والأركان، هي الأخرى مكانة هامة في النظام الغذائي الاعتيادي للمغاربة، وكانت أهميتها تزداد في الأيام التي تنعدم فيها المواد التي تستعمل في صنع الخبز.
وقدمت التمور موردا غذائيا غنيا لأهل المجالات الصحراوية، حيث لا تحتل زراعة الحبوب نفس الأهمية، وبالتالي لا يكون التخوف من آثار السنة السيئة إلا إذا امتدت لأكثر من موسم فلاحي، حيث يبدأ النخيل بالتضرر من الجفاف.
هذه إذن بعض الإنتاجات الزراعية التي ساعدت المغاربة على مواجهة أزمات الغذاء، تضاف إليها موارد غذائية أخرى، كان يتم اللجوء إليها إذا كان الجفاف شديدا وامتد لأكثر من موسم فلاحي، مثل البلوط والبقول والبسباس البري والكرنينة وقلب أشجار النخيل الصغير النخيل المثمر بالواحات، ثم يرني، النبات السام الذي كان يستخدم، بعد معالجته، كدقيق يصنع منه الخبز أو الكسكس.
أما اللحوم، فتصبح أساس النظام الغذائي لمربي الماشية إثر ندرة الحبوب والخضر ونقص العشب، فتذبح الماشية عن طيب خاطر أهلها، كما حدث في مجاعة 1662. ومع ذلك يتم الحفاظ على الدواب التي تعين على عملية الحرث، كما يتم الاحتفاظ بقدر من الحبوب من أجل بذرها عند سقوط الأمطار. أما خيرات البحر فقد كان المستفيد منها بشكل أكبر هم سكان السواحل.
وتبقى الأشكال الاقتصادية الأكثر بدائية: القنص، الصيد، الالتقاط، آخر الحلول التي يلجأ إليها الإنسان زمن المسغبة، قبل أن تحتل المكانة الأولى عند اشتداد الأزمة.
يدعو الباحثان إلى فهم العلاقة القائمة بين القحط والمجاعة من جهة وبين الأوبئة من جهة ثانية، بحيث يبدو أن المجاعة تمهد الطريق أمام الأوبئة، فالبنية الجسدية التي أنهكها الجوع تكون على استعداد كبير لاستقبال الأمراض. ويتساءل المؤلفان في نفس السياق حول مساهمة الجفاف في انتشار الوباء، ذلك أن انحباس المطر يدفع بعض الحيوانات الحاملة لجراثيم وبائية إلى البحث عما تقتات به في الأماكن المأهولة.
دفعت صعوبة التشخيص السريري لأوبئة القرنين السادس عشر والسابع عشر بالمغرب، في ظل ضعف وعدم دقة النصوص المصدرية في وصف الظاهرة الوبائية، بالباحثين إلى التركيز على دراسة الطاعون، لأنه الأكثر ترددا بالمغرب والمعلومات حوله أكثر وفرة.وفي هذا الإطار، استفادا من التراكم المعرفي الذي تحقق في مجال دراسة الأوبئة لإضاءة بعض الجوانب حول هذا الوباء، الذي تعرض له المغاربة في السنوات التالية على الأقل: 1521-1523، 1557-1558، 1596، 1610، 1626 و1631.
يعود الطاعون إلى عصية يرسين[1]، وهي جرثومة تعيش في وسط تبلغ حرارته 25 درجة، لها سُمِّية متغايرة تختلف حسب طريقة الإصابة بها. تمر الجرثومة بسهولة عبر الغشاء المخاطي، لكنها لا تستطيع اختراق الجلد إلا عبر جرح مهما كان صغيرا، بحيث يكون جرح لدغة برغوثة كاف في هذه الحالة.
وتختلف أعراض الإصابة بالطاعون عند الإنسان حسب كيفية دخول الجرثومة للجسد، فإذا نفذت عبر الجلد، تظهر طبقة سوداء على موضع نفاذها بعد حضانة مدتها ستة أيام، وهذه الجرثومة تنخر الأنسجة، وهي المسماة بالجمرة الخبيثة، ثم تظهر بعد مدة وجيزة عُقد مؤلمة وصلبة تميل إلى التقيح في الفخذ وتحت الإبطين وعند الرقبة، وهي الدمال أو الدبل (الطاعون الدملي أو الدبلي)، فتشتد الحمى على المصاب وتصحبها اضطرابات عصبية وعقلية. وإذا لم يمت المريض فمن الممكن أن يشفى بعد مرور مدة تتراوح بين ستة وثمانيةأيام على إصابته. أما إذا تسربت الجرثومة عبر الغشاء المخاطي وأصابت الرئتين، فإن تطور المرض يكون أسرع ويتسبب في هلاك المريض لا محالة.
تنتقل جرثومة الطاعون في الحالة الثانية من إنسان إلى آخر عبر رذاذ العطس، خاصة في فصل الشتاء، أو تنقلها القوارض والبراغيث. هذه الأخيرة ساهمت بشكل كبير في انتشار الأوبئة بالمغرب، لهذا اهتم بها الباحثان عند تحليل أسباب انتشار الطاعون، وبيَّنا أنها تعيش في بيئة معيَّنةلا تتحمل أكثر من 20 درجة وأقل من 15 درجة، وتناسبها الرطوبة المرتفعة،مما يفسر سبب انتشار الوباء في الشتاء واختفائه في الصيف مع طفرته في الربيع، كما أن انجذابها للون الأبيض المفضَّل عند أهل الحواضر، ونفورها من بعض روائح النباتات والحيوانات مثل الأحصنة والغنم والجمال، هو ما يفسرتفشي الطاعون بالمدن، وتمتع المناطق الصحراوية والجبلية بنوع من الحصانة إزاءه. فالجفاف الشديد والحرارة في الأولى، والبرودة النسبية في الثانية، علاوة على تعايش الأهالي مع ماشيتهم يثبط من تحركه وتكاثره، في حين أن النشاط الاقتصادي لساكنة السهول الأطلنتية يمنع استفادتها من بعض هذه الامتيازات، لكثرة القوارض بالأراضي الزراعية، والتي تقوم هي الأخرى مقام البراغيث في نقل الوباء.ولذلك، يبيِّن هذا التحليل أن الطاعون بالمغرب وباء موسمي، يظهر في الشتاء وبالأخص في الربيع، ويختفي في الصيف، وبأنه مجالي، يصيب مناطق أكثر أو أقل من أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب تشخيص الأوبئة في المغرب بمعزل عن البلدان المجاورة خاصة الجزائر، التي كانت تنتقل إليها العدوى انطلاقا من الجهة الشرقية، وكان قراصنتها يرسون بسفنهم بموانئ المغرب الشمالية، كميناء بادس وتطوان، وأحيانا تصل إلى العرائش وسلا، لهذا رجح المؤلفان أن وباء 1557-1558 انتقل من الجزائر إلى المغرب، لتركزه بالمنطقة الشمالية والريف على الخصوص. في حين أن وباء سنة 1597، والذي تضررت منه نفس المنطقة، كان مصدره إسبانيا، لكن انتقاله إلى بلاد سوس مكن من تكوينه بؤرة محلية انتشر منها من جديد بعد بضع سنوات.
وقد لاحظ الباحثان أن أوبئة القرن السابع عشر كانت أكثر ترددا، وأطول في الزمن من أوبئة القرن الذي قبله، كما أن ظهورها بالجنوب أعطى الانطباع بتكون بؤرة وبائية بهذه المناطق، مثل وباء 1601، 1613-1614 و1624-1630.ونفس الملاحظة أبداها الدكتور رونو في دراسته عن أوبئة القرن الثامن عشر في المغرب، بحيث توصل إلى ظاهرة توطن الطاعون في مجال الواحات المتاخمة للصحراء.وبالتالي فقد جرى رصد مصدرين لانتقال الوباء، أولهما خارجي عن طريق انتقال العدوى من البلدان المجاورة، الجزائر وإسبانيا، إلى موانئ الساحل الشمالي، وثانيهما محلي ناجم عن تشكل بؤر داخلية.
ورغم التأطير الديني[2] لحصر المرض، فإن ضعف المعرفة الطبية لم يسمح بمقاومته، لهذا رأى برنار روزنبرجي وحميد التريكي أن مساعدة المؤمنين على تقبل الموت بالطاعون على أنه شهادة لا يخلو من حكمة[3]،كما أن الحاجة إلى الحد من الاتصال بين الناس لمنع انتقال العدوى وانتشار القلق غايات تبرر منع التنقل، ومع ذلك أكدا على أنه يجب الإقرار بأن الموقف المتولد عن هذه التعاليم هو السلبية التي تدفع لانتظار المصير باستسلام وخضوع للقدر المحتوم.
من جهة أخرى، أشار المؤلفان إلى موروث شفهي كان يردده الأمازيغ عند القفز على النار أثناء الاحتفال: نعبرك يا نار ونترك لك البراغيث والقمل، وبصيغة أخرى، نترك لك المرض والبؤس والحمى وبراغيثنا والأذى[4].ويبين هذا الموروث، حسب الباحثين، معرفة المغاربة بدور الحرارة في قتل البراغيث دون التأكيد على معرفتهم بدورها في نقل الأمراض. وتساءل المؤلفان أيضا عن استخدام الطب المغربي لمادة الكِينِينْ[5] في ترياق العلاج من الأمراض الوبائية، مثلما استخدمه المولى سليمان عند إصابته بطاعون 1799-1800.والأكيد حسب الإشارات المصدرية، أن الفرار والهرب من أرض الوباء، كان الحل الوحيد أمام مغاربة تلك الحقبة الذين اعتبروا في عمومهم أن الطاعون هو انتقام من الله.
انعكست هذه الأزمات الغذائية والصحية على المجتمع ماديا ومعنويا.على المستوى المادي، برزتفاوت أمام الجوع والموت، بسبب اختلاف وسائل مواجهة الأزمة. ففي الوقت الذي استعانت فيه حاميات المواقع البرتغالية بالقمح المستورد من البلد الأم للتخفيف من أثر مجاعة سنوات 1516-1517 و1520-1522، لم تتمكن السلطتان القائمتان بكل من مملكتي فاس ومراكش من استيراد حاجياتهما بسبب انعدام وسائل وإمكانات جلب الأقوات من الخارج، كما نبه إلى ذلك المؤرخ البرتغالي برناردو رودريكس.وتكرر نفس الاختلافبين مناطق المغرب، إذ أبانت المخازن الجماعية بالمناطق الجنوبية عن نجاعتها لتخفيض آثار القحط والمجاعة، في حين كانت معاناة المناطق الأخرى أشد.وسُجل التفاوتأيضا في مواجهة الأزمات بين الفئات الاجتماعية، ذلك أن الموت عصف بالفقراء والمعدومين أكثر من الأغنياء،والشيوخ والأطفال أكثر من الشباب. وبينما كانت فئة عريضة من المجتمع المغربي تعاني من محدودية وسائل مقاومتها للأزمات، كانت فئة قليلة منه تضخم ثرواتها، من خلال المضاربة في أثمان السلع زمن القحط، والإشراف على بيع المغاربة المتضورين جوعا إلى تجار العبيد، وتجميع العقارات بعد أن عرضها أصحابها للبيع حتى يتمكنوا من مسايرة أسعار المواد الغذائية المرتفعة. وقد لاحظ الباحثان أن نقص الأقوات والمجاعة يقويان علاقات التبعية بين المعدمين وأصحاب المال أو السلطة، وهو ما لا ينطبق على الأوبئة التي تتسبب في قلة اليد العاملة في البوادي والمدن بسبب الموت، وبالتالي تجعل سادة الأرض وأصحاب السلطة على استعداد للدفع أكثر من أجل الحصول على العمال، مما يؤدي إلى تحسن معيشة هذه الفئة الاجتماعية. وعلى العموم أبدى برنارد روزنبرجي وحميد التريكي ثلاث ملاحظات حول الآثار المادية للأزمات على المجتمع، وهي:
1- يشجعالغلاء ونقص المواد الغذائية المضاربات والمديونية، مما يساهم في إغناء الغني وإفقار الفقير.
2- يتيحانتقال الملكيات بسبب البيع، أو اختفاء الأفراد، وإعادة توزيع حقيقية للثروات، تختلف آثارها من منطقة إلى أخرى.
3- السرقةوالنهب وأخذ أقوات الغير بالقوة هي أفعال لمجموعات أو أفراد، يلجؤون إليها في سبيل ضمان البقاء.
وإذا كان من الصعب وضع جرد للآثار المادية للأزمة المناخية والصحية على المجتمع، فإن المصادر تقدم مؤشرات أكثر عن عواقبها النفسية والمعنوية الناتجة عن السلوكيات المتطرفة التي يلجأ إليها، مثل:
بيع النفس أو أفراد من الأسرة من أجل ما يُقتات به، إلى درجة أن المعاصرين لأزمة 1520-1522 وصفوا شحن السفن الأوربية بكل من آزمور وآسفي للمغاربة الجياع بعملية شحن سمك الشابل التي كانت رائجة بالمنطقة.
الارتداد عن الدين بحثا عن إله آخر يُعين على الخروج من الأزمة، وفي هذا الإطار اعتنق العديد من اليهود الإسلام، وتنصر العديد من المسلمين.
تجاهل القيم الدينية والقوانين الأخلاقية في سبيل الحصول على القوت، إذ تلجأ النساء إلى الدعارة،مثلما حدث في مجاعة 1626 بمراكش، وتنتشر السرقة وعمليات النهب والقتل. وما قاله المؤرخ اليهودي ڤاجْدا يعبر بقوة عن هذه الوضعية السائدة في سنة 1615:”لم ينج من المجاعة إلا ليموت بالسيف، لأن انعدام الأمن ساد في كل الطرق“. وأشار برتغاليٌّ أنه خلال مجاعة 1521، كانلإحدى القبائلمخزون هام من القمح والشعير،غنم منه البرتغاليون الشيء الكثير، وذلك لا يعود إلى ادخارهم وإنما لسرقتهم حبوب الشاوية كلها.
أكل الأطعمة القذرة كالجيف، وفي بعض الحالات القصوى أكل لحوم البشر مثلما وقع سنة 1662.
يتساءل المؤلفان: فكيف لا تترك هذه المآسي أثرها على الناجين؟
بمجرد أن تطل الأزمات بوجوهها البشعة (الجوع، والطاعون، والموت)، فإنها تُغرقالأزمات الإنسان المغربي في أنانيته وفي جو يكتنفه الشعور بفناء الدنيا وقرب قيام الساعة، وتجعله ينتظر ظهور المهدي الذي يخلص الأرض من الفساد، مثل ابن أبي محلي. هذه الظاهرة لم تكن حكرا على المغاربة أو على المسلمين عامة، بحيث عرفت أوربا شيوع معتقدات مماثلة خلال موجات الطاعون.وعلاوة على ذلك، أدى تعاقب الكوارث والآفات خلال القرن السادس عشر والسابع عشر على الخصوص إلى تراجع المغرب على عدة مستويات. فقد دوَّن المؤرخون المغاربة بحسرة كبيرة فراغ المدن، وإخلاء القرى، وانحطاط العلوم والآداب، واختفاء أعيان المجتمع من فقهاء وعلماء. وإن لم يشيروا إلى الآثار الاقتصادية، فإن الأزمات الديموغرافية كفيلة بوضع استنتاج أولي عن التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال هذين القرنين.
واجه المغرب في ظرف مئة سنة مختلف الأوبئة والمجاعات، نجم عنها ثلاث أزمات ديموغرافية حادة هي أزمة 1625-1631، ثم أزمة 1661-1663 وفي الأخير أزمة 1678-1681.كان امتداد هذه الأزمات يتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وتتباعد عن بعضها البعض بفاصل يتراوح بين خمس عشرة سنة وثلاثين سنة، مما جعل القرن السابع عشر أكثر حلكة من القرن الذي سبقه، بمعدل سنة كارثيةكل ثلاث سنوات. ولم تكن أزمات القرن السادس عشر أقل حدة رغم وتيرتها الضعيفة. هذه الحصيلة الكئيبة كانت تكفي للإقرار بأن ساكنة المغرب خلال هذه الفترة لا يمكن أن تعرف إلا الركود والتراجع. وتوضح أوصاف الحسن الوزان وبعده مارمول كاربخا لهذا التراجع خاصة بالسهول الأطلنتية، التي أعطى حولها المؤلفان معلومات أكثر. وإن كانت المعطيات المصدرية لا تسمح برسم خريطةلساكنة المغرب خلال القرنين المذكورين، فالأكيد، حسب برنار روزنبرجي وحميد التريكي، أن التقييمات التي أنجزت في القرنينالثامن عشر والتاسع عشر انطلاقا من تقديرات الحسن الوزان، لم تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن الأزمات المتكررة، ويرجحان في هذا الإطار، أن المغرب لم يكن أكثر تعميرا من بداية القرن السادس عشرلما بدأ الأوربيون إعادة اكتشافه إثر وباء 1818.
وكما أثرت الأزمات على نسبة سكان المغرب، فقد خلَّفت تحولات على مستوى توزيعهم، مما انعكس بدوره على الاقتصاد المغربي.
أدى اختفاء الساكنة المستقرة التي كانت تقطن بالسهول الأطلنتية في بداية القرن السادس عشر إلى استيطانها من قبل البدو الرحل، الذين يعيشون بالدرجة الأولى على تربية الماشية. استمرت هذه الوضعية إلى القرن التاسع عشر وفجر العشرين، وأثار اندهاش الأوربيين وجود هذا النمط الاقتصادي بمجالات ذات مؤهلات طبيعية هامة. وإذا فسر بعضهم ذلك بعجز السكان عن الاستفادة من الأراضي وبتعرضهم لغارات الأعراب، فإن الباحثيْن أرجعاها إلى التاريخ الديموغرافي للمنطقة. فالحروب مع البرتغاليين والمجاعات والأوبئة أبعدت السكان عن مواطنهم، وهيأتها لاستقبال هجرات وافدة من المجالات شبه الصحراوية، وفي هذا الإطار قدم المؤلفان تحرك قبيلة الرحامنة كنموذج لهذه الهجرات. فإلى حدود بداية القرن السادس عشر كان الرحامنة بالصحراء يمارسون الانتجاع ما بين أقاوتشيت، ثم استجلبهما السعديون لتعمير المجال بعد مجاعة 1521-1522.
وهكذا، شكلت المجالات الصحراوية، وبصفة أقل الجبلية، خزانات بشرية تساهم في إعادة تعمير السهول، ويفسر جزء من هذه الظاهرة بالنجاة النسبية لهذه المناطق من المجاعات والأوبئة كما بينا سالفا، وإلى غياب التوازن بين مواردها المحدودة والنمو السريع للساكنة.وإن كانت هذه الظاهرة تعيد التوزيع الديموغرافي للمغرب، خاصة بالمناطق المتضررة، فإنها تعيد هيكلة اقتصادها. ذلك أن القبائل الصحراوية التي تغريها السهول الخالية، لا تهاجر بخيمها وقطعان ماشيتها فقط، بل تهاجر كذلك بنمط عيشها، فتمارس الانتجاع والترحال على أراض كانت قبل سنوات منتجة للحبوب. وبما أن جملة من العوامل الاقتصادية والجبائية جعلت المخزن يشكل الجهة القادرة على تغيير نمط هؤلاء الوافدين الجدد في اتجاه الاستقرار، فإن الصراع حول الحكم والاضطرابات ساهمت في احتفاظ تلك القبائل بنمط عيشها المألوف.
لهذه الأسباب، يرى المؤلفان أن مقاربة الركود الاقتصادي يجب أن تتم في علاقته بالتقلص الديموغرافي الناتج عن الأزمات المتكررة، فالإنتاج لا يتضرر مؤقتا زمن الأزمات فقط، بل يصبح غير منتظم بسبب تكرارها وبسبب الخسائر البشرية التي تحدثها. وعادة ما تنخفض الأسعار وتسود وفرة نسبية بعد التعديل الكبير للطلب، بسبب قضاء الوباء على جزء كبير من الساكنة. فالوفرة الإنتاجية التي ميزت عهد محمد الشيخ الأصغر، في سنوات 1636-1650، تعود إلى تزامن الظروف المناخية المواتية مع الانخفاض الكبيرلعدد السكان، مما سمح بالاستفادة من مداخيلتصدير الفائض. وبالتالي فإن المدةالتي تفصل بين الأزمات هي فترة رواج الأسواق، لكن يجب الانتباه إلى أن الوضع يناسب المستهلك الحضري والمستورد، ولا يساهم في زيادة الإنتاج، ومع ذلك فإنه يفيد، من ناحية أخرى، في تشجيع الانتعاش الديموغرافي المؤقت.
زيادة على الإنتاج الفلاحي، يتقلص الإنتاج الحرفي لأن كافة الموارد تخصَّص للموارد للتغذية، كما تتراجع الصناعة وتجارة منتوجات الترف، ولنا أن نتخيل الضرر الذي يصيب اقتصاد المدن، إضافة إلى أن ظروف الأزمات لم تكن مواتية للحياة الفكرية الحضرية، فتتراجع بعض المهن المرتبطة بها، مثل التدريس والتعليم. ومادام القرن السابع عشر كان هو قرن الأزمات بامتياز، فإن الباحثين جعلا منه حقبة تراجُعالمدن المغربية وغياب المغرب في التجارة الدولية، وذلك بسبب جملة من العوامل، من بينها تراجع الإنتاج وانخفاض الطلب على المنتجات الخارجية، وتدمير وسائل إنتاج ذات أهمية كبرى، ونقصد بها مزارع ومصانع السكر، فقد أدى تخريبها إلى حرمان المغرب من أداة ثمينة للمبادلات الخارجية، بحيثكان من الصعب أن تعوَّض بأي منتوج فلاحي آخر. وقد تزامن هذا التدهور مع تحولات كبيرة شهدها الاقتصاد العالمي في نفس الفترة، ومع تجاوز الوساطة المغربية بين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء، مما جعل نتائج هذا الغياب ظاهرة دائمة.
وعلى المستوى السياسي، ساهمت ثلاث أزمات حادة في التطورات السياسية التي شهدها القرنان، وهي أزمات 1521-1523، 1597-1610، و1660-1661.نبه كل من برناردو رودريكسو دييغو دي طوريس، المعاصرين لأحداث قيام الدولة السعدية، إلى ارتباط دخول السعديين إلى مراكش واتخاذها عاصمة لحكمهم بأزمة 1521-1523. فقد أشار المؤرخ الأول إلى أن الشريف استغل ظروف خسارة مملكتي فاس ومراكش لآلاف من البشر، للتحكم في مراكش التي وجدها شبه مقفرة، وأوضح الثاني أنه بالرغم من أن المجاعة والوباء أساءا كثيرا إلى الشريفين، فإن الأخيرين لم يدخرا جهدا لتوفير الطعام للناس بمناطق نفوذهما، وكان أكثر الناس حصولا على الطعام هم أهل مراكش وتارودانت. وقد بينا سالفا الاختلاف المجالي للأزمات، مما أدى إلى اختلال في توازن القوى بين السلطة الوطاسية والحاميات البرتغالية والسلطة السعدية الصاعدة التي كانت أكبر مستفيد من الجفاف وما سببه من آفات. ذلك أن الانتماء المجالي للسعديين ومجال انطلاقهم ساعدهم كثيرا على مواجهة انعكاسات ضعف التساقطات، بحكم الاعتماد على تخزين الأقوات والسقي، وفي آن واحد كرس ضعف الوطاسيين وأضر بالوجود الوجود البرتغالي بالمغرب، وأصبح التباين واضحا، في القدرة على مواجهة الأزمة، بين سلطة في طور الانهيار وأخرى في طور النشأة. واعتبر برنارد روزنبرجي وحميد التريكي أنه من بين العلامات التي كانت تعبر عن تحول ميزان القوى، كون إحدى الشخصيات التي برزت بوضوح خلال المجاعة – يعقوب بن الغربية المشرف على بيع المغاربة- تفر من أزمور وتتملص من ولائها للبرتغاليين وتلجأ إلى الشريف السعدي، فمثل هذه الشخصيات تحس باتجاه التغيير وتوالي، وفقا لمصالحها، الطرف المرشح لاكتساب المزيد من القوة والنفوذ.
وعلى عكس ذلك، أدت أزمة 1597-1610، الشبيهة بالأزمة الأولى في آثارها الديموغرافية، إلى انتهاء دولة السعديين، بعد التشكيك في شرعية حكمهم، واتهامهم بالتسبب في نزول العقاب الإلهي الذي حل بالمغاربة، نتيجة للصراع الدائر بينهم حول الحكم، وإدخالهم النصارى إلى بلاد الإسلام. إن المخزن السعدي الذي بني ببطء مدة قرن من الزمن، لم يتمكن من مقاومة ثلاث عشرة سنة من الأزمات الصعبة، والتي كان التغلب عليها مستحيلا في غياب حزم السلطان أحمد المنصور وما رافقه من هدوء واستقرار.وتفسر أزمة 1660-1661 السرعة والسهولة المذهلة التي أخضع بها مولاي رشيد المغرب، بعد قضائه على الزعامات السياسية الإقليمية التي ظهرت بالمغرب من جديد، وعملت على مواجهة الأزماتفي إطار محلي خلال مرحلة غابت فيها هيمنة مؤسسة المخزن.
وفي الختام، أكد الباحثان على أهمية عنصري الأزمة والوباء في تفسير بعض الوقائع التاريخية، فضعف الدولة السعدية بعد أحمد المنصور يزداد وضوحا عندما نستحضر الأزمة الديموغرافية بدل أن نختزله في نزاع الأبناء. كما أن بعض الظواهر المرتبطة بالديموغرافيا مثل انتشار الاقتصاد الرعوي وشبه الرعوي، واختفاء بعض المراكز الحضرية والقروية، والامتيازات النسبية للمناطق الجبلية والصحراوية، والعودة القوية للقبيلة في الحياة السياسية، ثم مكانة المرابطين والزوايا في الحياة الدينية، كلها عناصر تسلط الضوء على التحول البطيء الذي عرفه التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، في حين تبدو الأزمات كعامل يفسر دورات ارتقاء الأسر الحاكمةوانهيارها. ولم يغفل الباحثان إثارة انتباه المهتمين إلى بعض الإشكالات التي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للبحث في تاريخ المغرب، مثل النظام الغذائي للمغاربة وأثره على الصحة والإنتاجية، والأسعار زمن الآفات، وفترات الاستقرار والرخاء النسبي بين الأزمات والاضطرابات، والهبات والتحبيس زمن الأزمة، والازدواجية المتوترة التي كانت تسم علاقة المهدوية بالأزمة والأسر الحاكمة، فضلا عن البحث في الترابط بين قدوم الرحل إلى المناطق الوسطى من المغرب وانتشار الربط وانتساب أصول أغلب أصحابها إلى الساقية الحمراء، علاوة على الدعوة إلى إنجاز كارطوغرافيا مؤسسات التخزين، والبحث عن الآثار النفسية للآفات في الأدب والفن.
[1] عصية يرسين[Bacille de Yersin]: هي عصية مسؤولة عن الوباء اكتشفت سنة 1894، وتنسب إلى مكتشفها ألكسندر يرسين [Alexandre Yersin].
[2]قال الرسول صلى الله عن الطاعون:”إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه“.
[3] ورد في حديث نبوي شريف، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم.
[4] حول هذه الطقوس يرجع إلى:
Laoust E., « Noms et cérémonies des feux de joie chez les Berbères du Haut et de l’Anti-Atlas »,Hespéris, I (1921) : 3-65.
[5]الكينين [Quinine]: مركب طبي، يستخرج من شجر الكينا، كانت تستخدمه قبائل الكيشوا في البيرو وبوليفيا للعلاج، ثم نقله عنها المبشرون إلى أوربا حيث استخدم في علاج الملاريا، وهو يتميز بكونه مخفض للحرارة ومسكن للآلام، علاوة على علاجه للملاريا والالتهابات.
Bernard Rosenberger et Hamid Triki, «Famines et épidémies auMaroc aux XVIe et XVIIe siècles»,Hespéris-Tamuda, vol. XIV, 1973, pp. 109-175 ; vol. XV, 1974, pp. 5-103.
برنار روزنبرجي وحميد التريكي، المجاعات والأوبئة في مغرب القرنين 16 و17،ترجمةعبد الرحيم حزل،الطبعة الثانية، الرباط، دار الأمان، 2010.