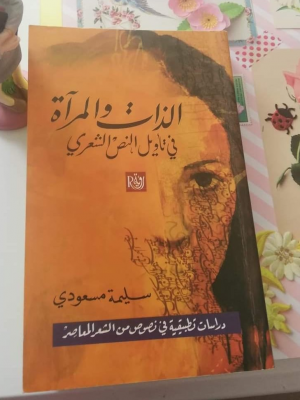إن انفتاح الشعر على الأسئلة الفلسفية الكبرى والآفاق المعرفية الشاسعة جعله في عودة دائمة إلى ذاته ليفكر فيها، عبر حركية التأمل والمحاورة وفتح الاستشكالات العميقة، لذا كانت التجارب الوجودية الكبرى تجسيدا رؤيويا وشعريا لارتحالات الذات عبر سؤال الحقيقة والمعرفة . وإذا كانت المعرفة تفكيرا يخضع للعقل والحواس والحدس، فإن المعرفة الشعرية أرقى انواع المعرفة تذوتا - لا بمعنى الأنوية المنغلقة، بل بمعنى الدوران حول الذات - لأنها تنطلق من الذات باعتبارها فاعلا أساسيا في اكتشاف المعارف وتشكيلها، حيث الذات نفسها مجال لأسئلة وتصورات ومفاهيم لا حدود لها، تتجاوز الواقعي في أبعاده النفسية وعلاقاته الاجتماعية، لتقارب عالم الروح والميتافيزيقا باعتبارها مجالا واسعا للتساؤل والبحث، ومن ثم للمعرفة، لتتحول هذه الأخيرة إلى كيان مطلق غير محدود ولا منغلق ولانهائي، وهو ما يجعل عالم الشعر عالما ممتدا مترامي الأطراف، مشرعا على امتداد الرؤى والتأويلات، ويسعى للإفصاح عن الذات وكيمياء مكوناتها وأشكال تشظيها، عبر مختلف تفاعلاتها، ورهافة إحساسها بالأشياء والموجودات والآخرية الغيرية والواقع، ورؤيتها للعالم واختبارها للحياة .
إن الذات هي السؤال الملحاح المؤرق الذي يسكن الفلسفة، والروح التي تسكن الشعر. وما ذات الشاعر إلا تلك الهوية الشعرية التي تتجسد عبر نصوص الشعر، مسفرة ومضمرة لتفاعلات وعلاقات وكينونات قائمة بذاتها، إنها فلسفة الكينونة الشعرية التي تبدي مقدرة غير عادية في تجسيد المجرد وتقريب البعيد، ومظهرة الخفي، و طاقة مميزة في الكشف والخلق والأنسنة . لذلك فإن كتابة الذات وانكتابها شعرا هي تلك الاسئلة المواربة التي ارتهن الشعر نفسه للإجابة عنها، عبر ملاحقة ما يستعصى القبض عليه من تجليات روحية وعلاقات وجودية ومواقف أنطولوجية وأخرى إيديولوجية، لا يتمكن غير الشعر من اكتشاف تقاسيمها ومعالمها ومظهرتها،وهو ما جعل كل نص شعري كتابة للذات وكشفا عن كيمياء حضورها .
تشتغل هذه الدراسة على رصد كيمياء الذات في نصوص شعرية جزائرية، وفق استراتيجية تأويلية جمالية، تركز علي الرؤية والتشكيل في آن، لتبرز التلاحم بين الجانبين في توليد الدلالات وتناسل المعنى .
الذات وأبجدية الأسئلة:
يعد سؤال الذات من أهم الأسئلة الاستشكالات التي شهدها التفكير الإنساني طيلة مسيرته التاريخية، وهو على درجة من الهلامية والزئبقية، بحيث ينفتح على شتى التعريفات والتحديدات والعلاقات، وينفلت منها في آن، إذ لا يمكن القول سوى إنها الوجود ذاته، باعتبار أن هذا الوجود كائن عديم التحديد والتمظهر والوجود والمعنى، إن لم تختبره الذات الإنسانية وتعطيه ملامحه وأشكاله، وهو ما يفيض على معنى الذات نفسها، ويجعلها منفتحة على معان تأويلية أكثر من أي شيء آخر، وعلى حد رؤية ريكور يكون معنى الذات معنى فريدا في كل مرة.
إن مفهوم الذات ليس ثابتا، بل مفتوح على شتى التحولات الثقافية والاحتمالات الإنسانية، لأننا لا نتعامل مع كائن محدد التقاسيم لا يبرحها ولا تبرحه، بل نتعامل مع كائن، هو الأكثر مرونة وزئبقية من كل الكائنات الشعرية، وأكثرها انفتاحا على شتى الأسئلة التي تحيط بالوجود الإنساني، إذ عملت شتى الطروحات التي اجتهدت لمقاربة مفهومات الذات على تقويض الصور التقليدية لها، باعتبارها عقلا خالصا وإجابة ثابتة ونهائية، بل عملت على تحويلها إلى صيرورة دؤوب من الأسئلة والاستشكالات والتأويلات عبر دينامية وحركية تفاعلاتها وعلائقها مع كل ما يحيط بها في الكون، ورصد أشكالها الثقافية التي نراها تشهد تحولات رهيبة.
لقد حاولت الفلسفة قبلا وضع تأسيسات فلسفية تختزل مفهومات للذات، لكن العقل الفلسفي كان يمارس عملية النقد والمراجعة باستمرار لما يؤسس له، ما كشف عن تاريخ من التحولات شهدته هذه المفهومات .
تشرعنا الكتابة على الذات وكيميائها على أسئلة الحقيقة والعالم والغيب والواقع والكينونة والوجود، وهي من أكثر الأسئلة الإنسانية حيرة واستشكالا، لأنها لا تقف على الظاهري والمتمظهر في الكينونة والوجود، بل تحفر في علاقات عميقة ترتبط بالمناطق الأكثر عمقا وغموضا منها. وممارسة السؤال في حد ذاته يجسد بحث الذات عن الحقيقة، وعن ماهيتها هي وماهيات الأشياء، فكل سؤال يشكل حضور الذات أمام ذاتها، ووعيا مفتوحا لانهائيا.
إن حضور الذات في قطاعات المعرفة يأتي من هذا المنظور التساؤلي، ومن وعي ممارس لاكتشاف مختلف أنظمة العلوم والمعارف، بل وعي ممارس للتعايش داخل هذه المنظومات، مع إخضاع المنظومات الموجودة للمساءلة الدائمة، وبالتالي ممارسة التجاوز والانفصام والتصدع، وتفجير أشكال الأنظمة القديمة والمستهلكة، وممارسة التحوير الدائم والدؤوب في بني الفكر، لاستبعاد الثبوتيات واليقينيات والدوغمائيات، وهو ما جعل ميشيل فوكو يرى أن: «المعرفة هي كذلك ذاك الفضاء الذي يمكن للذات أن تحتل فيه موقعا تتكلم منه عن موضوعات اهتمامها داخل خطاب معين» .
تتشكل المعرفة عبر اختيار الذات لمعرفية ذاتها ومعرفية العالم، وهناك في حقيقة الأمر تداخل كبير إلى درجة التماهي بين المعرفتين، فالذات تكتشف نفسها إذ تكتشف العالم، والعكس صحيح أيضا، أي أنها تكتشف العالم حين تكتشف نفسها، لأنها متصلة به ومنفصلة عنه في آن؛ هي متصلة باعتبارها الجزء الواعي في العالم، الذي يخاطب الأشياء ويقاربها ويغير فيها، وهي منفصلة من حيث كونها تمتلك خصوصياتها وكيانها الخاص، الذي يدفعها إلى أن تنظر إلى ذاتها كعالم قائم بذاته، مفعم بالحيوات والتحولات والعلاقات والمتغيرات ودينامية التواجد. فوجود الذات في العالم هو الوجود الكلي: « هذا الوجود الكلي هو الوجود الوحيد الذي يعي ذاته، ويسمح لتبادل الوعي، وعيها هو ذاتها هو عين ذاتها، وعيها المندرج على كل صور الحياة، هو هي...لا شيء فوق الذات، كل ما تصورته الذات من فوق هو منها، الذات هي التي تفيض، فيضها هو وجودها على نحو» .
فالذات كمعرفة هي كينونة قائمة بذاتها، لا تنفصل عن الذات الإنسانية، لكنها تهيء لها سبل التفاعل مع العالم الذي يحيط بها . تفاعل الكينونة ها هنا إذا سمح لنا أن نمظهره كفعل، لا يتخلى عن منطق البحث عن الحقيقة، إذ يصبح هذا المنطق في حد ذاته أنطولوجيا وفعلا كينونيا يؤكد حضور الذات . فالذات موجودة لأنها تمارس البحث عن الحقيقة. ويتجلى هذا الوجود في المعرفة التي هي نفسها هذا البحث عن الحقيقة، بكل استشكالاته واحتمالاته ونتائجه ومغالطاته وتصويباته وتجاوزه، لترتكز كينونة الذات بمنجزاتها المعرفية هذه، فتؤكد حضورها في العالم:« فكينونة الكائن هو ما هو حاضر بامتياز، حيث يسمح بإمكان الكائن، أو الأجدر بنا القول إن الكينونة هي الحاضر فعلا، إذ على أساسه يصبح الكائن ماثلا» .
إن سؤال الحقيقة هو سؤال المعرفة، وهو الذي يشمل كل أسئلة الإنسان ؛انطلاقا من سؤال الذات وعودة إليها وتلك المسافة الممتدة بينهما، بكل ما عرجت عليه من شؤون العالم وأشيائه ومكوناته، رغم اعتقادنا بعدم وجود أسئلة لا تعنى بالمعرفة، فيكفي أن يوجد سؤال حتى يؤكد شرطه المعرفي وعلاقته بالذات من قريب أو بعيد، لكن القضية تتحول إلى مكان الأسئلة في سلم تراتبها القيمي بالنسبة لهذه الذات ،وارتباطها بسياقات ثقافية معينة تعني اشتراطات ما، داخل زمان ومكان معينين، قد يفرضان بدورهما حتميات معينة في الطريق إلى الحقيقة، تتمرأى فيها وجهة نظر الذات إلى نفسها وإلى العالم.
وتحقق المعرفة للذات حريتها وانطلاقها من جهة، وتحررها من جاذبية اليقينيات الراسخة من جهة أخرى: « ومعرفة الذات تتمثل كبحث في حس الحياة، وبحث في الانعتاق، يعني اكتشاف الحقيقة، حقيقة تظهر وتتجلى بصورة دائمة الجدة، وبانتهائها إلى الحكمة، تصنع الذات من الإنسان كائنا حرا، سيد مملكته» فمن سنة الخلق أن الحقيقة كائن صيروري متغير باستمرار، لا يأخذ بعدا نهائيا وشكلا ثابتا، أما وظيفة الذات الإنسانية في الوجود فملاحقة هذا الكائن في صيروراته وتحولاته، وهو ما يكشف عن تطورات المعرفة، التي هي في وتيرة من التحول والتطور والصيرورة: « إن ما أبحث عنه في ذاتي ما يزال فريسة للظل، فيجب أن أكتشفه في حب للنمو وغير مشروط، وإن لم أفعل فكل ما أطلبه يفر مني، فلا أستطيع أن أقبض على شيء، فالتوجه نحو النور ينفي كل إشفاق على ذاتي، والبحث يجب أن يجري مطعما بالشجاعة» .
إن هذا البحث الدؤوب عن الحقيقة هو نفسه ما يجعل الذات محل بحث دائم عن حقيقتها، إذ تتحول في هذا السياق إلى ذات وموضوع في آن، لتتأمل ذاتها، محاولة اكتشافها. وتأخذ هذه الذات نفسها وضع عدم الثبات واليقينية، انطلاقا من كونها جزءا من عالم الحقيقة، لا تكتشف بشكل نهائي، بل تأخذ في كل وضع حضاري وسياق ثقافي، بل وفي كل سؤال، وضعا مختلفا ومتغايرا، لأنها هي نفسها الذات العارفة أو الباحثة عن المعرفة، هذه الأخيرة التي بدورها تساهم في تشكيلها، وتقدم لها شطرا كبيرا من أنطولوجيا كينونتها: « فمعرفة الذات إذا معرفة مستمرة في اكتشاف ذاتها، وليس تناولها بالتعيين أو الوصف أمرا ممكنا، ذلك لأنه ليس في استطاعة أحد أن يملك امتلاءة الرؤية، لما لا يراه وهو في الظلمة» .
فالذات كائن غير مكتمل، لكنه مجبول على فطرة البحث عن الاكتمال وهذه هي الجدوى من خلق الإنسان كائنا واعيا باحثا عن الحقيقة، وفي ضوء هذه الفكرة بإمكاننا أن نؤول الآية القرآنية: « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» .
إن الذات فاعل ومفعول به في آن في عالم المعرفة، بل إن أكثر الاستشكالات حدة هي تلك التي تتعلق بها كجوهر إنساني يحدق به التشكيك، والإصرار الدؤوب على مساءلة اليقينيات وتقويضها. وللسبب نفسه تضافرت جهود الإنسانيات، من فلسفة وتاريخ وأنثروبولوجيا وأدب وفنون وعلم النفس والسياسة وعلم الاجتماع، لتشكل علما واحدا ينصب على دراسة الذات، خصوصا ونحن نواجه هذا المد الجارف للعلوم التكنولوجية وفق استراتيجيات لا تخلو من نوايا غير حسنة في تغريب الإنسان عن معرفة الذات وأسئلتها، في نوع من تحويل الإنسان إلى كائن مبرمج خاضع لنظام المصفوفة .
وعي الذات ورؤية العالم:
إن رؤية العالم هي العلائق التي تبتنيها الذات في تماسها مع العالم ووعيها به، في نوع من الانتقال من الفكر إلى الروح، ومن الواقع إلى ما وراءه، ومن الوعي إلى الميتاوعي، إنها سعي الذات إلى الارتقاء بالإنسان نحو آفاق أكثر إنسانية وجمالا، وإزاحة القبح الذي سيطر على العالم، فتشمل شتى المواقف والوضعيات الفلسفية التي تتخذها الذات مما يجري في العالم من تغيرات وتحولات و: « تشتمل عبارة رؤية العالم على دلالة إنسانية ومثالية قريبة من المعنى الأكثر اتساعا للفلسفة، استجاب استخدامها في فرنسا ما بين 1950- 1960 في النظرية الماركسية للمجتمع إلى الرغبة في مقاومة المشروع البنيوي والسوسيولوجيا التجريبية للأحداث الأدبية في آن معا .تدين أفهمتها من قبل غولدمان إلى فئة كليانية هيجل، (تحيل الوقائع المفردة إلى كليانية تاريخية، تأخذ معناها في إطارها)، كما إلى جمالية لوكاتش الماركسية (فئات الانعكاس) و(النموذجي) جدلية الشكل والمضمون وفكر ماكس فيبير (مفاهيم "النموذج المثالي" و"الإمكانية الموضوعية"» .
وعليه فإن رؤية العالم هي الخروج عن النسق الجمالي الذي احتبست فيه الآداب والفنون، نحو المعطيات والاشتراطات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية. إنها بنية دلالية شاملة تتجاوز النظر التجزيئي للمتون الإبداعية، وتلاحمه بالمواقف والتوجهات التي يمكن أن يكون قد تمخض عنها، عبر رصد شتى التفاعلات التي كانت، أو بإمكانها أن تكون، بين المتن وبين سياقاته ومواقفه، عبر زاوية نظر كليانية، تجمع الموقف من الوجود بالتمظهر الجمالي له.
ويرى الدكتور جابر عصفور أن: «مصطلح رؤية العالم أو رؤيا العالم من المصطلحات التي شاعت في العقود الأخيرة، وذلك في مدى تأثرنا بالنقد الأورو- أمريكي ومصطلحاته، ولكن بما لا يقطع بين المصطلحين والأصول الدلالية التي تتقبلها في لغتنا، وتجد ما يدعم استخدامها في ميراثنا البلاغي والنقدي» .
هكذا يربط جابر عصفور بين هذا المصطلح في توظيفه ودلالته النقدية الغربية، وبين الدلالة المعجمية والتوظيفات التي تأخذها كل من رؤية- ورؤيا في أصل استعمالاتها اللغوية، لينطلق بعدها في رصد انعكاس الدلالة النقدية الغربية والدلالة اللغوية العربية على توظيفاتها في الأعمال الأدبية والنقدية على السواء: « تصبح دلالة رؤية العالم في الأعمال الإبداعية قرينة جماع الآراء والتصورات المتجانسة علائقيا في منظور واحد، أو وجهة نظر واحدة، تؤديها الأعمال الإبداعية في علاقتها بالعالم الفعلي، أو الواقع المتعين الذي يعيشه المبدع أو يخاطبه، أو يواجهه بما يراه فيه، كأنه يصفه أمام مرآته، كي يرى جوانب سلبه أو إيجابه في مدى سعي العمل الإبداعي إلى الارتقاء بالإنسان وواقعه (أو عالمه) من شروط الضرورة إلى آفاق الحرية» .
إن رؤية العالم هي العلاقة المباشرة التي تجمع الذات بالعالم وما يتمخض عن هذه العلاقة من معرفة وتداعيات وأسئلة، وتعد في الحقيقة نوعا من المعرفة الوجودية التي يتضافر فيها جانبان: معرفة تقارب الأعماق القصية من الذات والوجود معا، ومعرفة تستهدف ما يجري في العالم من حوادث الوجود.
ونقصد بالعلاقة المباشرة هنا قدرة الذات وإرادتها على أن تكتشف بنفسها وبأسئلتها هي، وإن كانت نتيجة ركام ميراث من المعارف والثقافات، تكتشف العالم الذي هو في حقيقته عالمان: عالم داخلي يعني الذات نفسها، وعالم خارجي محسوس وغير محسوس، تنتمي إليه الذات بشكل أو بآخر، ومع العالمين تنبني علائق فطرية غريزية وأخرى مكتسبة، لتيسر انوجاد الذات في العالم، وحتى بإمكانها أن تسيره، وهو ما يمكن أن نطلق عليه المعرفة كوعي عميق بالوجود داخله وخارجه: « ليس علينا أن نختار بين فلسفة تستقر في العالم فرضتها ذاته أو في الآخر، وبين فلسفة تستقر فينا، بين فلسفة تتناول تجربتنا الداخلية، وبين فلسفة ستحكم عليها من الخارج باسم مقاييس منطقية... إننا نقيم كما الإنسان الطبيعي في داخلنا وفي الأشياء، في داخلنا وفي الآخر» .
من هذا المنظور الفلسفي تكون الذات أو الروح قطعة من العالم كشيء لا ريب فيه، يؤكد على حضور العالم في حد ذاته كجزء من الذات عن طريق المعرفة، لذلك فإن كل حيادية إزاء وجود العالم فيها نوع من نفي الذات في حد ذاتها .
إن الذات ليس جسدا وليس بإمكانها أن تتمظهر ككائن موجود إلا عبر وعيها ومعرفتها، وما تحققها عبر انوجادها في العالم، وإذا كان عقلها العلمي متمظهرا بشكل محسوس عبر التكنولوجيا وتجليات العلوم التقنية المختلفة، فإن وجودها الروحي والعقلي يظهر في مدى الانسجام أو التصادم الروحي الذي تحققه عبر تفاعلاتها مع العالم، وهو في الحالتين يكشف عن تعالق كبير بينهما (الذات والعالم) فالروح كوعي بالذات بمنطق هيجل هي التي تفصح عن هذه العلاقة، بل إن هي في حقيقة الأمر إلا العلاقة بين الذات والعالم: «الروح لا يكون لنفسه عالم واحدا وحسب، بل عالما مضاعفا ومنفصلا ومتضادا، وعالم الروح الإيتيقي إنما هو الحاضر الخاص بتلك الروح» . إذ تجمع الروح مختلف علاقات التضاد والتصادم الصراعي، وعلاقات التداخل الإئتلافي بين الذات والعالم، وهذا بدوره ناجم عن وعي الذات في احتكاكها بالعالم الخارجي: «إن روح هذا العالم إنما هو الماهية الروحية المستنفذة بوعي الذات بعلم نفسه، كهذا الوعي بالذات الحاضر في الحال والكائن لذاته» فروح العالم هو بشكل أو بآخر هو رؤية العالم ورؤياه وهو الرؤية التي تضيق معها العبارة، لأنها لا تنحبس في شكل أو هيئة واحدة ثابتة، والتي يسعى الفن بمختلف أشكاله على رصدها ومظهرة أشكالها وتحولاتها:« لقد تحول الروح عبر دين الفن عن صورة الجوهر، ليدخل في صورة الذات، لأن دين الفن ينتج شكل الروح، فيضع هذا الدين إذا في داخله الفعل أو الوعي بالذات» .
إن هذه العلاقة التي بإمكاننا أن نصفها بالطبيعية بين الذات والعالم كنوع من الوعي أو الروح، هي ما تحاول سياسة العولمة الإمبريالية القضاء عليه، في سعيها نحو تشييء الكائن الإنساني، وإخضاعه للمنظومة القائمة على العقل الصناعي التصنيعي، وهو ما خلف نوعا من الاغتراب الذي تعانيه الذات، وتحسه عبر مختلف الفئات الإنسانية، وعلى اختلاف مستوياتها الروحية والعلمية، وهو ما يعد في حقيقة الأمر تصدعا كبيرا في معمار الوجود الإنساني، وشرخا في طبيعته، حيث يعد الإنسان كائنا تنتجه المصفوفة بمواصفات خاصة وأنظمة بعينها، وهذا ما يدفع إلى شعور بالنفي والفقدان والاغتراب ، يخيم على حياة الإنسان ذوات ومجتمعات وأمما: «هذا هو نوع الإنسان الذي نجحت النزعة الصناعية في إنتاجه، الآلة الذاتية Automatou الإنسان المتغرب، هو متغرب بمعنى أن أفعاله وقواه أصبحت غريبة عنه، إنها تقف فوقه وضده، وتحكمه بدلا من أن يكون هو المتحكم بها، لقد حولت قوى حياته إلى أشياء ومؤسسات، وقد أصبحت هذه الأشياء والمؤسسات أصناما، إنه يعايشها، لا باعتبارها نتيجة جهده الشخصي، بل كشيء منفصل عنه، شيء يعبده ويخضع له» .
إن المأزق الإنساني الأكبر الذي شهدته الإنسانية هو هذا النكران للعالم والذات كروح ووعي عقلي ووجداني في الآن نفسه، وهو ما تحاول الإنسانيات والفنون المختلفة التصدي له وإيقاف مده، بإبراز مدى بشاعته وقبحه وتداعياته الخطيرة على الوجود الإنساني.
الذات والشعر: الصوت والصدى:
لم يعد سؤال الذات ليعني التفكير الفلسفي وحده، بقدر ما أصبح أهم الأسئلة التي تجترحها الشعرية المعاصرة، وهو ما شكل ذلك التجاسر المعرفي بين الفلسفة والشعر. ففي تلك المسافة التي يتقاطعان فيها تسكن الذات الإنسانية لتراوح فيهما، لا لتبرز جدلية التفارق بينهما كعالمين مختلفين، بل على العكس من ذلك، لتثبت مستوى التداخل الكامن بين السؤال الفلسفي والسؤال الشعري، حتى عدت الذات من أهم التخوم التي تشهد تماس عالميهما، على اختلاف أساليب التفكير فيهما، بل إنها السكنى التي يحل فيها العالمان، ويعودان إليها بعد كل ارتحال: « إن الشاعر ينافس إذن الفيلسوف نفسه على مملكة الأفكار، إنه يكاد يستولي على هذه المملكة، إذ بوسعه أن يعطي الأفكار شكلا حسيا على درجة من الكمال لا مثيل له في الطبيعة» .
إن سؤال الذات والشعر، وسؤال الذات في الشعر، من الأسئلة التي ألحت في حضورها على الإنسان مفكر ومبدعا، ولم تكن حبيسة الاهتمامات الجمالية في مقاربة العالم واستقباله، بل انتقلت إلى البعد المعرفي، وما يطرحه من أسئلة وبحث، حيث يتحول السؤال إلى سؤال المعرفة وسؤال الوجود نفسه، هذا السؤال الحميمي والمؤرق في آن، الباحث عن أشكال تمظهر وعلائق حضور، إنه يخرج بالذات إلى العالم، ولا يبقيها حبيسة عوالمها الباطنية وتساؤلاتها الملحاحة وأجوبتها المواربة وجوانيتها الغامضة، وهو ما جعل الشعر أرقى أنواع الفنون عند الفلاسفة أنفسهم، لأنه الوحيد- حسب إيمانويل كانط - الذي: « يتجرأ على تجسيد أفكار العقل اللامرئية من جنس الجحيم والخلود، والخلق، أو الموت والجسد، والحب والمجد» .
إن الشعر لا يكتفي بتلبية المطالب الجمالية للذات- مبدعا ومتلقيا- بل هدفه في المقام الأسمى مظهرة مختلف الحالات العقلية والوجدانية والروحية التي تعانيها الذات الشاعرة في تفاعلها الحيوي مع كل ما يحيط بها، وما يمر بها، من متغيرات، أما المطالب الجمالية فهي استدعاءات تفرضها هذه الحالات وحاجاتها، و تستجيب لها إمكانات الشاعر وأدواته، وهو ما يوحد التجربة في كيان واحد، فلا تنفصل المعطيات الفكرية عن تجلياتها الجمالية، إنهما يكونان كائنا واحدا، متلحم الروح والجسد، فكل فكرة جميلة هي شكل جميل في الآن نفسه، عبر تلك المقدرة على رؤية الذات بكل مكوناتها وعوالمها وعلاقاتها، وتجسيد هذه الرؤية شعرا. وهي رؤية التي تتجاوز في كثير من الأحيان المستويات العادية للمعرفة، أو على الأقل هذا ما يجب أن يكون: « فالشاعر يسمو إلى مقام الأفكار الجمالية، بوصفها أفكارا تتخطى حدود التجربة الممكنة، وهنا بالضبط يتجلى الشاعر بوصفه الفنان الوحيد المجهز بمخيلة تزاحم العقل في بحثه عن المثل الأسمى» ، إذ يمتلك الشعر خصوصيه القدرة على النفاذ إلى تلك العلاقات _الدقيقة والعميقة في آن_ للذات في وجودها الروحي والنفسي والإيديولوجي والاجتماعي، وفي تفاعلاتها الحية بمختلف ما يحيط بها. إن الشعر: «نوع من الوعي الذي يدرك الوجود الطبيعي والإنساني إدراكا خاصا، يختلف فيه عن أشكال الوعي الأخرى» .
وكل وعي شعري يصدر في حقيقة الأمر عن خلفية ومرجعية فلسفية تؤمن بها الذوات الشاعرة، وتنطلق منها، لتؤسس لأخرى أوسع في مقاربة الحياة والموجودات، ولذلك فإن الخوض في مسألة الذات الشاعرة والذات في الشعر هي مسألة على درجة عظيمة من الخطورة، لأنها تفتحنا على أسئلة أنطولوجية عميقة، وعلى مغامرة فلسفية جمالية في آن، عبر ذلك التعدد في دلالات الذات وعدم إمكانية تطويقها في جوهر واحد ومعاني ثابتة، فالذات كائن ميتافيزيقي لا يتجلى إلا عبر وسائط تعمل على جسدنتها وجسدنة علاقاتها وتفاعلاتها الكيميائية- الروحية- وأهم هذه الوسائط الشعر الذي بإمكانه أن يمظهرها، على اختلاف الأنساق الفلسفية التي تصدر عنها، والتي تؤول إليها بعد ارتحالاتها الشعرية، فملاحقة الذات التي تكتب نفسها شعرا نوع من محاولة القبض على الأشكال التي تأخذها، رغم أننا نؤمن بأن استغراق حضور الذات داخل الشعر، لا يعني أن تتمظهر وفق تمظهر ميتافيزيقي تجريدي، بل يتلون هذا الحضور وفق متطلبات رؤية الذات الشاعرة ورؤية النص في آن معين ومكان معين، على اعتبار أن كل نص قد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشروطه الحضارية ومعرفية الذات وظروفها ومواقفها ومستويات تداخلها مع العوامل الخارجية والغيرية. وهو ما يشكل ملامح هذا الحضور بشكل مختلف عن سابقه ولاحقه في كل نص شعري.
و كل حضور للذات يضمر في كل نص شعري شيئا غير قليل من مواقف فلسفية بعينها، ما يجعل كل نص شعري مرتبطا بشرطه الفلسفي: « ما هو مؤكد لدينا اليوم هو أن الشعر لم يعد يقع خارج أسئلة الفلاسفة عن الحقيقة، أو بعيدا عن تأملاتهم القصوى حول شكل الحياة التي لا تزال متاحة في أفق البشر» .
إن الذات في الشعر لا يمكن أن تحيا منكفئة على نفسها، مهما بلغت تجاربها من التذوت والأنوية ما يجعلها في معزل، بل حتى في معزلها هذا تشاركها أصوات الأشياء المحيطة بها، وهو ما يجعلها تتشظى عبر مختلف علائقها، ووفق هذا التشظي تحقق كينونتها الوجودية وكينونتها الشعرية في آن، بما أوتيته من رهافة الإحساس بالأشياء وإدراك لحساسية الحياة والموجودات، حيث يتكثف الشعور ويمتزج بالوعي، لتتمخض المعرفة الشعرية ذات الخصوصية والتميز، وهو ما دفع بودلير إلى القول: « هذه الأشياء كلها تفكر عبري، وأنا أفكر عبرها، إنها تفكر أقول، ولكن بالمعنى الموسيقي، وعلى نحو جذاب، أي من دون تمحكات، ومن دون جدالات شكلية، ومن دون استنتاجات» .
إن الذات تعي العالم لتعي وجودها، وأحيانا يكون وعي الكينونة الذاتية مرتبطا بوعي العالم الخارجي، وفي ضوء هذه المعطيات فإن التفاعلات والعلاقات بين الذات والعالم هي الميكانيزم الذي يحرك الشعر، هذا الأخير الذي جسدها كأفصح ما يكون عبر دينامية الحدس الشعري الذي هو حقيقته أهم المكونات الكيميائية لهذه الذات ذاتها، وأهم مفعل لمسافاتها في العالم والواقع، وعن طريقه تتشكل علاقات الاتصال والانفصال بينهما، ما يحول بدوره العالم إلى كائنات ؛ إما أن تكتشفها الذات، وإما أن تخلقها عبر تصوراتها وفلسفتها ورؤيتها وحتى استيهاماتها. ففي الشعر لا تسكن العالم وحسب، بل العالم أيضا يسكن الذات ويتضمن فيها، ويتحول في علاقة انعكاسية تبادلية بالمنطق الرياضي إلى كائن، إذ يتشكل عبر العقل الشعري للذات بوعيه ولا وعيه، وفكره وتخيلاته ومعرفيته: « أن يبعث الروح في العالم، وأن ينفخ فيه الحياة، وأن يبتكر العالم وفق أفكاره الخاصة، كما يقول فيكو، وبفعله هذا أن يبرر حدود الأنا، أي أن يضيعها (حسب بودلير)» .
ولأن الذات تجمع العوالم المختلفة: المتداخلة إلى درجة التماهي، والمتباينة إلى درجة التصادم فإن الذات الشاعرة مفتوحة على مختلف التجارب والحالات، ومتجاوزة في كثيرة من الأحيان شروطها التاريخية ،خصوصا عندما يتعلق الأمر بالذات الشاعرة الحداثية: « هي ذات الشاعر الحداثي، وقد أخذ يعلو على ذاته غير الشاعرة (أي على أناه الجمعية أو التاريخية) في فضاء الذات عموما، ليتجاوز وضع الذات في العالم، أي وقد أخذ يتجاوز (رؤياويا) جزئية وضعه الأنطولوجي في الواقع التاريخي أو المعاصر بالانفتاح على كلية وضعه الأنطولوجي في العالم الممكن في التجربة» . هذا الوضع الفلسفي والوجودي والشعري جاء متجاوزا لكل الأوضاع التي اتخذتها الذات الشاعرة عبر العصور.
لقد شكلت الذات جزءا من واقع جماعي في الشعر القديم، فلم تكن لتنفصل عن الكيان الجماعي من حيث المفهومات والرؤى والموضوعات وهو ما دعا إلى أن تكون المعاني جاهزة وواحدية الدلالة ومكرورة وسابقة على النص، باستثناء نصوص المتصوفة التي أخذت بعدا مغايرا من حيث الحفر في الكيانات العميقة للذات الإنسانية، واكتشاف مناطق وأفضية غير عادية منها، وهو ما جعلها تعاني غربة وتصدعات فادحة مع المجتمع المتعاصر معها، وجعل نصوصها تبدو غريبة عن منطق عصرها وجمهوره، وهو ما زاد من وطأة الاغتراب الذي يشعر به الصوفي، ليؤثر هذا بفاعلية أكثر، ما يدفعه بقوة أكثر إلى التشبث بعالم الشعر كملاذ آمن، باعتباره العالم الوحيد الذي بإمكانه الإنصات لهذه الأبعاد والأفضية غير المألوفة، والذي بإمكانه تسميتها لغة ومظهرتها تخييلا.
هذا الشعور بالاغتراب ازداد حدة مع الذات الشاعرة المعاصرة، المفتوحة على فلسفات وعلوم وثقافات وأوضاع إنسانية أكثر مأساوية وقتامة، في مجتمع قائم على المدنية والصناعية، وقائم على فلسفات اقتصادية وسياسية بشعة، تستهدف القضاء على الذات الإنسانية لتحل محلها العقل الصناعي الاستغلالي، الذي أراد تجريد الإنسانية من خصوصياتها الروحية والثقافية، ليجعلها مستلبة للمركزية الغربية بتوجهاتها الليبرالية التي تستهدف إماتة الهويات وخصوصيات الذوات الجماعية أمما ومجتمعات من أجل التحكم في مصائرها وإخضاعها لنظام العولمة (المصفوفة) الصناعي الآلي وإشاعة الحروب والدمار بينها وإماتة الإنسان فيها، وهو ما انعكس على الذات الشاعرة كحالات من القلق الوجودي والتصدع النفسي والتصادم والخوف والتمرد، كأوضاع سلبية، بينما ارتأت بعض الذوات الشاعرة التعامل بوعي روحي أعمق ،عبر البحث عن استعادة الحياة والجمال المنطوي في أعماق الكون، أو محاورة الواقع بتفكيك أوضاعه ومحاولة تحديها.
د. سليمة مسعودي
* من كتاب:
الذات والمرآة في تأويل النص الشعري الصادر عن دار رؤية للنشر.
وقد شاركت به وبجزء من الفصل في مداخلة لملتقى راهن الشعر الجزائري - مارس 2018

 www.facebook.com
www.facebook.com
إن الذات هي السؤال الملحاح المؤرق الذي يسكن الفلسفة، والروح التي تسكن الشعر. وما ذات الشاعر إلا تلك الهوية الشعرية التي تتجسد عبر نصوص الشعر، مسفرة ومضمرة لتفاعلات وعلاقات وكينونات قائمة بذاتها، إنها فلسفة الكينونة الشعرية التي تبدي مقدرة غير عادية في تجسيد المجرد وتقريب البعيد، ومظهرة الخفي، و طاقة مميزة في الكشف والخلق والأنسنة . لذلك فإن كتابة الذات وانكتابها شعرا هي تلك الاسئلة المواربة التي ارتهن الشعر نفسه للإجابة عنها، عبر ملاحقة ما يستعصى القبض عليه من تجليات روحية وعلاقات وجودية ومواقف أنطولوجية وأخرى إيديولوجية، لا يتمكن غير الشعر من اكتشاف تقاسيمها ومعالمها ومظهرتها،وهو ما جعل كل نص شعري كتابة للذات وكشفا عن كيمياء حضورها .
تشتغل هذه الدراسة على رصد كيمياء الذات في نصوص شعرية جزائرية، وفق استراتيجية تأويلية جمالية، تركز علي الرؤية والتشكيل في آن، لتبرز التلاحم بين الجانبين في توليد الدلالات وتناسل المعنى .
الذات وأبجدية الأسئلة:
يعد سؤال الذات من أهم الأسئلة الاستشكالات التي شهدها التفكير الإنساني طيلة مسيرته التاريخية، وهو على درجة من الهلامية والزئبقية، بحيث ينفتح على شتى التعريفات والتحديدات والعلاقات، وينفلت منها في آن، إذ لا يمكن القول سوى إنها الوجود ذاته، باعتبار أن هذا الوجود كائن عديم التحديد والتمظهر والوجود والمعنى، إن لم تختبره الذات الإنسانية وتعطيه ملامحه وأشكاله، وهو ما يفيض على معنى الذات نفسها، ويجعلها منفتحة على معان تأويلية أكثر من أي شيء آخر، وعلى حد رؤية ريكور يكون معنى الذات معنى فريدا في كل مرة.
إن مفهوم الذات ليس ثابتا، بل مفتوح على شتى التحولات الثقافية والاحتمالات الإنسانية، لأننا لا نتعامل مع كائن محدد التقاسيم لا يبرحها ولا تبرحه، بل نتعامل مع كائن، هو الأكثر مرونة وزئبقية من كل الكائنات الشعرية، وأكثرها انفتاحا على شتى الأسئلة التي تحيط بالوجود الإنساني، إذ عملت شتى الطروحات التي اجتهدت لمقاربة مفهومات الذات على تقويض الصور التقليدية لها، باعتبارها عقلا خالصا وإجابة ثابتة ونهائية، بل عملت على تحويلها إلى صيرورة دؤوب من الأسئلة والاستشكالات والتأويلات عبر دينامية وحركية تفاعلاتها وعلائقها مع كل ما يحيط بها في الكون، ورصد أشكالها الثقافية التي نراها تشهد تحولات رهيبة.
لقد حاولت الفلسفة قبلا وضع تأسيسات فلسفية تختزل مفهومات للذات، لكن العقل الفلسفي كان يمارس عملية النقد والمراجعة باستمرار لما يؤسس له، ما كشف عن تاريخ من التحولات شهدته هذه المفهومات .
تشرعنا الكتابة على الذات وكيميائها على أسئلة الحقيقة والعالم والغيب والواقع والكينونة والوجود، وهي من أكثر الأسئلة الإنسانية حيرة واستشكالا، لأنها لا تقف على الظاهري والمتمظهر في الكينونة والوجود، بل تحفر في علاقات عميقة ترتبط بالمناطق الأكثر عمقا وغموضا منها. وممارسة السؤال في حد ذاته يجسد بحث الذات عن الحقيقة، وعن ماهيتها هي وماهيات الأشياء، فكل سؤال يشكل حضور الذات أمام ذاتها، ووعيا مفتوحا لانهائيا.
إن حضور الذات في قطاعات المعرفة يأتي من هذا المنظور التساؤلي، ومن وعي ممارس لاكتشاف مختلف أنظمة العلوم والمعارف، بل وعي ممارس للتعايش داخل هذه المنظومات، مع إخضاع المنظومات الموجودة للمساءلة الدائمة، وبالتالي ممارسة التجاوز والانفصام والتصدع، وتفجير أشكال الأنظمة القديمة والمستهلكة، وممارسة التحوير الدائم والدؤوب في بني الفكر، لاستبعاد الثبوتيات واليقينيات والدوغمائيات، وهو ما جعل ميشيل فوكو يرى أن: «المعرفة هي كذلك ذاك الفضاء الذي يمكن للذات أن تحتل فيه موقعا تتكلم منه عن موضوعات اهتمامها داخل خطاب معين» .
تتشكل المعرفة عبر اختيار الذات لمعرفية ذاتها ومعرفية العالم، وهناك في حقيقة الأمر تداخل كبير إلى درجة التماهي بين المعرفتين، فالذات تكتشف نفسها إذ تكتشف العالم، والعكس صحيح أيضا، أي أنها تكتشف العالم حين تكتشف نفسها، لأنها متصلة به ومنفصلة عنه في آن؛ هي متصلة باعتبارها الجزء الواعي في العالم، الذي يخاطب الأشياء ويقاربها ويغير فيها، وهي منفصلة من حيث كونها تمتلك خصوصياتها وكيانها الخاص، الذي يدفعها إلى أن تنظر إلى ذاتها كعالم قائم بذاته، مفعم بالحيوات والتحولات والعلاقات والمتغيرات ودينامية التواجد. فوجود الذات في العالم هو الوجود الكلي: « هذا الوجود الكلي هو الوجود الوحيد الذي يعي ذاته، ويسمح لتبادل الوعي، وعيها هو ذاتها هو عين ذاتها، وعيها المندرج على كل صور الحياة، هو هي...لا شيء فوق الذات، كل ما تصورته الذات من فوق هو منها، الذات هي التي تفيض، فيضها هو وجودها على نحو» .
فالذات كمعرفة هي كينونة قائمة بذاتها، لا تنفصل عن الذات الإنسانية، لكنها تهيء لها سبل التفاعل مع العالم الذي يحيط بها . تفاعل الكينونة ها هنا إذا سمح لنا أن نمظهره كفعل، لا يتخلى عن منطق البحث عن الحقيقة، إذ يصبح هذا المنطق في حد ذاته أنطولوجيا وفعلا كينونيا يؤكد حضور الذات . فالذات موجودة لأنها تمارس البحث عن الحقيقة. ويتجلى هذا الوجود في المعرفة التي هي نفسها هذا البحث عن الحقيقة، بكل استشكالاته واحتمالاته ونتائجه ومغالطاته وتصويباته وتجاوزه، لترتكز كينونة الذات بمنجزاتها المعرفية هذه، فتؤكد حضورها في العالم:« فكينونة الكائن هو ما هو حاضر بامتياز، حيث يسمح بإمكان الكائن، أو الأجدر بنا القول إن الكينونة هي الحاضر فعلا، إذ على أساسه يصبح الكائن ماثلا» .
إن سؤال الحقيقة هو سؤال المعرفة، وهو الذي يشمل كل أسئلة الإنسان ؛انطلاقا من سؤال الذات وعودة إليها وتلك المسافة الممتدة بينهما، بكل ما عرجت عليه من شؤون العالم وأشيائه ومكوناته، رغم اعتقادنا بعدم وجود أسئلة لا تعنى بالمعرفة، فيكفي أن يوجد سؤال حتى يؤكد شرطه المعرفي وعلاقته بالذات من قريب أو بعيد، لكن القضية تتحول إلى مكان الأسئلة في سلم تراتبها القيمي بالنسبة لهذه الذات ،وارتباطها بسياقات ثقافية معينة تعني اشتراطات ما، داخل زمان ومكان معينين، قد يفرضان بدورهما حتميات معينة في الطريق إلى الحقيقة، تتمرأى فيها وجهة نظر الذات إلى نفسها وإلى العالم.
وتحقق المعرفة للذات حريتها وانطلاقها من جهة، وتحررها من جاذبية اليقينيات الراسخة من جهة أخرى: « ومعرفة الذات تتمثل كبحث في حس الحياة، وبحث في الانعتاق، يعني اكتشاف الحقيقة، حقيقة تظهر وتتجلى بصورة دائمة الجدة، وبانتهائها إلى الحكمة، تصنع الذات من الإنسان كائنا حرا، سيد مملكته» فمن سنة الخلق أن الحقيقة كائن صيروري متغير باستمرار، لا يأخذ بعدا نهائيا وشكلا ثابتا، أما وظيفة الذات الإنسانية في الوجود فملاحقة هذا الكائن في صيروراته وتحولاته، وهو ما يكشف عن تطورات المعرفة، التي هي في وتيرة من التحول والتطور والصيرورة: « إن ما أبحث عنه في ذاتي ما يزال فريسة للظل، فيجب أن أكتشفه في حب للنمو وغير مشروط، وإن لم أفعل فكل ما أطلبه يفر مني، فلا أستطيع أن أقبض على شيء، فالتوجه نحو النور ينفي كل إشفاق على ذاتي، والبحث يجب أن يجري مطعما بالشجاعة» .
إن هذا البحث الدؤوب عن الحقيقة هو نفسه ما يجعل الذات محل بحث دائم عن حقيقتها، إذ تتحول في هذا السياق إلى ذات وموضوع في آن، لتتأمل ذاتها، محاولة اكتشافها. وتأخذ هذه الذات نفسها وضع عدم الثبات واليقينية، انطلاقا من كونها جزءا من عالم الحقيقة، لا تكتشف بشكل نهائي، بل تأخذ في كل وضع حضاري وسياق ثقافي، بل وفي كل سؤال، وضعا مختلفا ومتغايرا، لأنها هي نفسها الذات العارفة أو الباحثة عن المعرفة، هذه الأخيرة التي بدورها تساهم في تشكيلها، وتقدم لها شطرا كبيرا من أنطولوجيا كينونتها: « فمعرفة الذات إذا معرفة مستمرة في اكتشاف ذاتها، وليس تناولها بالتعيين أو الوصف أمرا ممكنا، ذلك لأنه ليس في استطاعة أحد أن يملك امتلاءة الرؤية، لما لا يراه وهو في الظلمة» .
فالذات كائن غير مكتمل، لكنه مجبول على فطرة البحث عن الاكتمال وهذه هي الجدوى من خلق الإنسان كائنا واعيا باحثا عن الحقيقة، وفي ضوء هذه الفكرة بإمكاننا أن نؤول الآية القرآنية: « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» .
إن الذات فاعل ومفعول به في آن في عالم المعرفة، بل إن أكثر الاستشكالات حدة هي تلك التي تتعلق بها كجوهر إنساني يحدق به التشكيك، والإصرار الدؤوب على مساءلة اليقينيات وتقويضها. وللسبب نفسه تضافرت جهود الإنسانيات، من فلسفة وتاريخ وأنثروبولوجيا وأدب وفنون وعلم النفس والسياسة وعلم الاجتماع، لتشكل علما واحدا ينصب على دراسة الذات، خصوصا ونحن نواجه هذا المد الجارف للعلوم التكنولوجية وفق استراتيجيات لا تخلو من نوايا غير حسنة في تغريب الإنسان عن معرفة الذات وأسئلتها، في نوع من تحويل الإنسان إلى كائن مبرمج خاضع لنظام المصفوفة .
وعي الذات ورؤية العالم:
إن رؤية العالم هي العلائق التي تبتنيها الذات في تماسها مع العالم ووعيها به، في نوع من الانتقال من الفكر إلى الروح، ومن الواقع إلى ما وراءه، ومن الوعي إلى الميتاوعي، إنها سعي الذات إلى الارتقاء بالإنسان نحو آفاق أكثر إنسانية وجمالا، وإزاحة القبح الذي سيطر على العالم، فتشمل شتى المواقف والوضعيات الفلسفية التي تتخذها الذات مما يجري في العالم من تغيرات وتحولات و: « تشتمل عبارة رؤية العالم على دلالة إنسانية ومثالية قريبة من المعنى الأكثر اتساعا للفلسفة، استجاب استخدامها في فرنسا ما بين 1950- 1960 في النظرية الماركسية للمجتمع إلى الرغبة في مقاومة المشروع البنيوي والسوسيولوجيا التجريبية للأحداث الأدبية في آن معا .تدين أفهمتها من قبل غولدمان إلى فئة كليانية هيجل، (تحيل الوقائع المفردة إلى كليانية تاريخية، تأخذ معناها في إطارها)، كما إلى جمالية لوكاتش الماركسية (فئات الانعكاس) و(النموذجي) جدلية الشكل والمضمون وفكر ماكس فيبير (مفاهيم "النموذج المثالي" و"الإمكانية الموضوعية"» .
وعليه فإن رؤية العالم هي الخروج عن النسق الجمالي الذي احتبست فيه الآداب والفنون، نحو المعطيات والاشتراطات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية. إنها بنية دلالية شاملة تتجاوز النظر التجزيئي للمتون الإبداعية، وتلاحمه بالمواقف والتوجهات التي يمكن أن يكون قد تمخض عنها، عبر رصد شتى التفاعلات التي كانت، أو بإمكانها أن تكون، بين المتن وبين سياقاته ومواقفه، عبر زاوية نظر كليانية، تجمع الموقف من الوجود بالتمظهر الجمالي له.
ويرى الدكتور جابر عصفور أن: «مصطلح رؤية العالم أو رؤيا العالم من المصطلحات التي شاعت في العقود الأخيرة، وذلك في مدى تأثرنا بالنقد الأورو- أمريكي ومصطلحاته، ولكن بما لا يقطع بين المصطلحين والأصول الدلالية التي تتقبلها في لغتنا، وتجد ما يدعم استخدامها في ميراثنا البلاغي والنقدي» .
هكذا يربط جابر عصفور بين هذا المصطلح في توظيفه ودلالته النقدية الغربية، وبين الدلالة المعجمية والتوظيفات التي تأخذها كل من رؤية- ورؤيا في أصل استعمالاتها اللغوية، لينطلق بعدها في رصد انعكاس الدلالة النقدية الغربية والدلالة اللغوية العربية على توظيفاتها في الأعمال الأدبية والنقدية على السواء: « تصبح دلالة رؤية العالم في الأعمال الإبداعية قرينة جماع الآراء والتصورات المتجانسة علائقيا في منظور واحد، أو وجهة نظر واحدة، تؤديها الأعمال الإبداعية في علاقتها بالعالم الفعلي، أو الواقع المتعين الذي يعيشه المبدع أو يخاطبه، أو يواجهه بما يراه فيه، كأنه يصفه أمام مرآته، كي يرى جوانب سلبه أو إيجابه في مدى سعي العمل الإبداعي إلى الارتقاء بالإنسان وواقعه (أو عالمه) من شروط الضرورة إلى آفاق الحرية» .
إن رؤية العالم هي العلاقة المباشرة التي تجمع الذات بالعالم وما يتمخض عن هذه العلاقة من معرفة وتداعيات وأسئلة، وتعد في الحقيقة نوعا من المعرفة الوجودية التي يتضافر فيها جانبان: معرفة تقارب الأعماق القصية من الذات والوجود معا، ومعرفة تستهدف ما يجري في العالم من حوادث الوجود.
ونقصد بالعلاقة المباشرة هنا قدرة الذات وإرادتها على أن تكتشف بنفسها وبأسئلتها هي، وإن كانت نتيجة ركام ميراث من المعارف والثقافات، تكتشف العالم الذي هو في حقيقته عالمان: عالم داخلي يعني الذات نفسها، وعالم خارجي محسوس وغير محسوس، تنتمي إليه الذات بشكل أو بآخر، ومع العالمين تنبني علائق فطرية غريزية وأخرى مكتسبة، لتيسر انوجاد الذات في العالم، وحتى بإمكانها أن تسيره، وهو ما يمكن أن نطلق عليه المعرفة كوعي عميق بالوجود داخله وخارجه: « ليس علينا أن نختار بين فلسفة تستقر في العالم فرضتها ذاته أو في الآخر، وبين فلسفة تستقر فينا، بين فلسفة تتناول تجربتنا الداخلية، وبين فلسفة ستحكم عليها من الخارج باسم مقاييس منطقية... إننا نقيم كما الإنسان الطبيعي في داخلنا وفي الأشياء، في داخلنا وفي الآخر» .
من هذا المنظور الفلسفي تكون الذات أو الروح قطعة من العالم كشيء لا ريب فيه، يؤكد على حضور العالم في حد ذاته كجزء من الذات عن طريق المعرفة، لذلك فإن كل حيادية إزاء وجود العالم فيها نوع من نفي الذات في حد ذاتها .
إن الذات ليس جسدا وليس بإمكانها أن تتمظهر ككائن موجود إلا عبر وعيها ومعرفتها، وما تحققها عبر انوجادها في العالم، وإذا كان عقلها العلمي متمظهرا بشكل محسوس عبر التكنولوجيا وتجليات العلوم التقنية المختلفة، فإن وجودها الروحي والعقلي يظهر في مدى الانسجام أو التصادم الروحي الذي تحققه عبر تفاعلاتها مع العالم، وهو في الحالتين يكشف عن تعالق كبير بينهما (الذات والعالم) فالروح كوعي بالذات بمنطق هيجل هي التي تفصح عن هذه العلاقة، بل إن هي في حقيقة الأمر إلا العلاقة بين الذات والعالم: «الروح لا يكون لنفسه عالم واحدا وحسب، بل عالما مضاعفا ومنفصلا ومتضادا، وعالم الروح الإيتيقي إنما هو الحاضر الخاص بتلك الروح» . إذ تجمع الروح مختلف علاقات التضاد والتصادم الصراعي، وعلاقات التداخل الإئتلافي بين الذات والعالم، وهذا بدوره ناجم عن وعي الذات في احتكاكها بالعالم الخارجي: «إن روح هذا العالم إنما هو الماهية الروحية المستنفذة بوعي الذات بعلم نفسه، كهذا الوعي بالذات الحاضر في الحال والكائن لذاته» فروح العالم هو بشكل أو بآخر هو رؤية العالم ورؤياه وهو الرؤية التي تضيق معها العبارة، لأنها لا تنحبس في شكل أو هيئة واحدة ثابتة، والتي يسعى الفن بمختلف أشكاله على رصدها ومظهرة أشكالها وتحولاتها:« لقد تحول الروح عبر دين الفن عن صورة الجوهر، ليدخل في صورة الذات، لأن دين الفن ينتج شكل الروح، فيضع هذا الدين إذا في داخله الفعل أو الوعي بالذات» .
إن هذه العلاقة التي بإمكاننا أن نصفها بالطبيعية بين الذات والعالم كنوع من الوعي أو الروح، هي ما تحاول سياسة العولمة الإمبريالية القضاء عليه، في سعيها نحو تشييء الكائن الإنساني، وإخضاعه للمنظومة القائمة على العقل الصناعي التصنيعي، وهو ما خلف نوعا من الاغتراب الذي تعانيه الذات، وتحسه عبر مختلف الفئات الإنسانية، وعلى اختلاف مستوياتها الروحية والعلمية، وهو ما يعد في حقيقة الأمر تصدعا كبيرا في معمار الوجود الإنساني، وشرخا في طبيعته، حيث يعد الإنسان كائنا تنتجه المصفوفة بمواصفات خاصة وأنظمة بعينها، وهذا ما يدفع إلى شعور بالنفي والفقدان والاغتراب ، يخيم على حياة الإنسان ذوات ومجتمعات وأمما: «هذا هو نوع الإنسان الذي نجحت النزعة الصناعية في إنتاجه، الآلة الذاتية Automatou الإنسان المتغرب، هو متغرب بمعنى أن أفعاله وقواه أصبحت غريبة عنه، إنها تقف فوقه وضده، وتحكمه بدلا من أن يكون هو المتحكم بها، لقد حولت قوى حياته إلى أشياء ومؤسسات، وقد أصبحت هذه الأشياء والمؤسسات أصناما، إنه يعايشها، لا باعتبارها نتيجة جهده الشخصي، بل كشيء منفصل عنه، شيء يعبده ويخضع له» .
إن المأزق الإنساني الأكبر الذي شهدته الإنسانية هو هذا النكران للعالم والذات كروح ووعي عقلي ووجداني في الآن نفسه، وهو ما تحاول الإنسانيات والفنون المختلفة التصدي له وإيقاف مده، بإبراز مدى بشاعته وقبحه وتداعياته الخطيرة على الوجود الإنساني.
الذات والشعر: الصوت والصدى:
لم يعد سؤال الذات ليعني التفكير الفلسفي وحده، بقدر ما أصبح أهم الأسئلة التي تجترحها الشعرية المعاصرة، وهو ما شكل ذلك التجاسر المعرفي بين الفلسفة والشعر. ففي تلك المسافة التي يتقاطعان فيها تسكن الذات الإنسانية لتراوح فيهما، لا لتبرز جدلية التفارق بينهما كعالمين مختلفين، بل على العكس من ذلك، لتثبت مستوى التداخل الكامن بين السؤال الفلسفي والسؤال الشعري، حتى عدت الذات من أهم التخوم التي تشهد تماس عالميهما، على اختلاف أساليب التفكير فيهما، بل إنها السكنى التي يحل فيها العالمان، ويعودان إليها بعد كل ارتحال: « إن الشاعر ينافس إذن الفيلسوف نفسه على مملكة الأفكار، إنه يكاد يستولي على هذه المملكة، إذ بوسعه أن يعطي الأفكار شكلا حسيا على درجة من الكمال لا مثيل له في الطبيعة» .
إن سؤال الذات والشعر، وسؤال الذات في الشعر، من الأسئلة التي ألحت في حضورها على الإنسان مفكر ومبدعا، ولم تكن حبيسة الاهتمامات الجمالية في مقاربة العالم واستقباله، بل انتقلت إلى البعد المعرفي، وما يطرحه من أسئلة وبحث، حيث يتحول السؤال إلى سؤال المعرفة وسؤال الوجود نفسه، هذا السؤال الحميمي والمؤرق في آن، الباحث عن أشكال تمظهر وعلائق حضور، إنه يخرج بالذات إلى العالم، ولا يبقيها حبيسة عوالمها الباطنية وتساؤلاتها الملحاحة وأجوبتها المواربة وجوانيتها الغامضة، وهو ما جعل الشعر أرقى أنواع الفنون عند الفلاسفة أنفسهم، لأنه الوحيد- حسب إيمانويل كانط - الذي: « يتجرأ على تجسيد أفكار العقل اللامرئية من جنس الجحيم والخلود، والخلق، أو الموت والجسد، والحب والمجد» .
إن الشعر لا يكتفي بتلبية المطالب الجمالية للذات- مبدعا ومتلقيا- بل هدفه في المقام الأسمى مظهرة مختلف الحالات العقلية والوجدانية والروحية التي تعانيها الذات الشاعرة في تفاعلها الحيوي مع كل ما يحيط بها، وما يمر بها، من متغيرات، أما المطالب الجمالية فهي استدعاءات تفرضها هذه الحالات وحاجاتها، و تستجيب لها إمكانات الشاعر وأدواته، وهو ما يوحد التجربة في كيان واحد، فلا تنفصل المعطيات الفكرية عن تجلياتها الجمالية، إنهما يكونان كائنا واحدا، متلحم الروح والجسد، فكل فكرة جميلة هي شكل جميل في الآن نفسه، عبر تلك المقدرة على رؤية الذات بكل مكوناتها وعوالمها وعلاقاتها، وتجسيد هذه الرؤية شعرا. وهي رؤية التي تتجاوز في كثير من الأحيان المستويات العادية للمعرفة، أو على الأقل هذا ما يجب أن يكون: « فالشاعر يسمو إلى مقام الأفكار الجمالية، بوصفها أفكارا تتخطى حدود التجربة الممكنة، وهنا بالضبط يتجلى الشاعر بوصفه الفنان الوحيد المجهز بمخيلة تزاحم العقل في بحثه عن المثل الأسمى» ، إذ يمتلك الشعر خصوصيه القدرة على النفاذ إلى تلك العلاقات _الدقيقة والعميقة في آن_ للذات في وجودها الروحي والنفسي والإيديولوجي والاجتماعي، وفي تفاعلاتها الحية بمختلف ما يحيط بها. إن الشعر: «نوع من الوعي الذي يدرك الوجود الطبيعي والإنساني إدراكا خاصا، يختلف فيه عن أشكال الوعي الأخرى» .
وكل وعي شعري يصدر في حقيقة الأمر عن خلفية ومرجعية فلسفية تؤمن بها الذوات الشاعرة، وتنطلق منها، لتؤسس لأخرى أوسع في مقاربة الحياة والموجودات، ولذلك فإن الخوض في مسألة الذات الشاعرة والذات في الشعر هي مسألة على درجة عظيمة من الخطورة، لأنها تفتحنا على أسئلة أنطولوجية عميقة، وعلى مغامرة فلسفية جمالية في آن، عبر ذلك التعدد في دلالات الذات وعدم إمكانية تطويقها في جوهر واحد ومعاني ثابتة، فالذات كائن ميتافيزيقي لا يتجلى إلا عبر وسائط تعمل على جسدنتها وجسدنة علاقاتها وتفاعلاتها الكيميائية- الروحية- وأهم هذه الوسائط الشعر الذي بإمكانه أن يمظهرها، على اختلاف الأنساق الفلسفية التي تصدر عنها، والتي تؤول إليها بعد ارتحالاتها الشعرية، فملاحقة الذات التي تكتب نفسها شعرا نوع من محاولة القبض على الأشكال التي تأخذها، رغم أننا نؤمن بأن استغراق حضور الذات داخل الشعر، لا يعني أن تتمظهر وفق تمظهر ميتافيزيقي تجريدي، بل يتلون هذا الحضور وفق متطلبات رؤية الذات الشاعرة ورؤية النص في آن معين ومكان معين، على اعتبار أن كل نص قد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشروطه الحضارية ومعرفية الذات وظروفها ومواقفها ومستويات تداخلها مع العوامل الخارجية والغيرية. وهو ما يشكل ملامح هذا الحضور بشكل مختلف عن سابقه ولاحقه في كل نص شعري.
و كل حضور للذات يضمر في كل نص شعري شيئا غير قليل من مواقف فلسفية بعينها، ما يجعل كل نص شعري مرتبطا بشرطه الفلسفي: « ما هو مؤكد لدينا اليوم هو أن الشعر لم يعد يقع خارج أسئلة الفلاسفة عن الحقيقة، أو بعيدا عن تأملاتهم القصوى حول شكل الحياة التي لا تزال متاحة في أفق البشر» .
إن الذات في الشعر لا يمكن أن تحيا منكفئة على نفسها، مهما بلغت تجاربها من التذوت والأنوية ما يجعلها في معزل، بل حتى في معزلها هذا تشاركها أصوات الأشياء المحيطة بها، وهو ما يجعلها تتشظى عبر مختلف علائقها، ووفق هذا التشظي تحقق كينونتها الوجودية وكينونتها الشعرية في آن، بما أوتيته من رهافة الإحساس بالأشياء وإدراك لحساسية الحياة والموجودات، حيث يتكثف الشعور ويمتزج بالوعي، لتتمخض المعرفة الشعرية ذات الخصوصية والتميز، وهو ما دفع بودلير إلى القول: « هذه الأشياء كلها تفكر عبري، وأنا أفكر عبرها، إنها تفكر أقول، ولكن بالمعنى الموسيقي، وعلى نحو جذاب، أي من دون تمحكات، ومن دون جدالات شكلية، ومن دون استنتاجات» .
إن الذات تعي العالم لتعي وجودها، وأحيانا يكون وعي الكينونة الذاتية مرتبطا بوعي العالم الخارجي، وفي ضوء هذه المعطيات فإن التفاعلات والعلاقات بين الذات والعالم هي الميكانيزم الذي يحرك الشعر، هذا الأخير الذي جسدها كأفصح ما يكون عبر دينامية الحدس الشعري الذي هو حقيقته أهم المكونات الكيميائية لهذه الذات ذاتها، وأهم مفعل لمسافاتها في العالم والواقع، وعن طريقه تتشكل علاقات الاتصال والانفصال بينهما، ما يحول بدوره العالم إلى كائنات ؛ إما أن تكتشفها الذات، وإما أن تخلقها عبر تصوراتها وفلسفتها ورؤيتها وحتى استيهاماتها. ففي الشعر لا تسكن العالم وحسب، بل العالم أيضا يسكن الذات ويتضمن فيها، ويتحول في علاقة انعكاسية تبادلية بالمنطق الرياضي إلى كائن، إذ يتشكل عبر العقل الشعري للذات بوعيه ولا وعيه، وفكره وتخيلاته ومعرفيته: « أن يبعث الروح في العالم، وأن ينفخ فيه الحياة، وأن يبتكر العالم وفق أفكاره الخاصة، كما يقول فيكو، وبفعله هذا أن يبرر حدود الأنا، أي أن يضيعها (حسب بودلير)» .
ولأن الذات تجمع العوالم المختلفة: المتداخلة إلى درجة التماهي، والمتباينة إلى درجة التصادم فإن الذات الشاعرة مفتوحة على مختلف التجارب والحالات، ومتجاوزة في كثيرة من الأحيان شروطها التاريخية ،خصوصا عندما يتعلق الأمر بالذات الشاعرة الحداثية: « هي ذات الشاعر الحداثي، وقد أخذ يعلو على ذاته غير الشاعرة (أي على أناه الجمعية أو التاريخية) في فضاء الذات عموما، ليتجاوز وضع الذات في العالم، أي وقد أخذ يتجاوز (رؤياويا) جزئية وضعه الأنطولوجي في الواقع التاريخي أو المعاصر بالانفتاح على كلية وضعه الأنطولوجي في العالم الممكن في التجربة» . هذا الوضع الفلسفي والوجودي والشعري جاء متجاوزا لكل الأوضاع التي اتخذتها الذات الشاعرة عبر العصور.
لقد شكلت الذات جزءا من واقع جماعي في الشعر القديم، فلم تكن لتنفصل عن الكيان الجماعي من حيث المفهومات والرؤى والموضوعات وهو ما دعا إلى أن تكون المعاني جاهزة وواحدية الدلالة ومكرورة وسابقة على النص، باستثناء نصوص المتصوفة التي أخذت بعدا مغايرا من حيث الحفر في الكيانات العميقة للذات الإنسانية، واكتشاف مناطق وأفضية غير عادية منها، وهو ما جعلها تعاني غربة وتصدعات فادحة مع المجتمع المتعاصر معها، وجعل نصوصها تبدو غريبة عن منطق عصرها وجمهوره، وهو ما زاد من وطأة الاغتراب الذي يشعر به الصوفي، ليؤثر هذا بفاعلية أكثر، ما يدفعه بقوة أكثر إلى التشبث بعالم الشعر كملاذ آمن، باعتباره العالم الوحيد الذي بإمكانه الإنصات لهذه الأبعاد والأفضية غير المألوفة، والذي بإمكانه تسميتها لغة ومظهرتها تخييلا.
هذا الشعور بالاغتراب ازداد حدة مع الذات الشاعرة المعاصرة، المفتوحة على فلسفات وعلوم وثقافات وأوضاع إنسانية أكثر مأساوية وقتامة، في مجتمع قائم على المدنية والصناعية، وقائم على فلسفات اقتصادية وسياسية بشعة، تستهدف القضاء على الذات الإنسانية لتحل محلها العقل الصناعي الاستغلالي، الذي أراد تجريد الإنسانية من خصوصياتها الروحية والثقافية، ليجعلها مستلبة للمركزية الغربية بتوجهاتها الليبرالية التي تستهدف إماتة الهويات وخصوصيات الذوات الجماعية أمما ومجتمعات من أجل التحكم في مصائرها وإخضاعها لنظام العولمة (المصفوفة) الصناعي الآلي وإشاعة الحروب والدمار بينها وإماتة الإنسان فيها، وهو ما انعكس على الذات الشاعرة كحالات من القلق الوجودي والتصدع النفسي والتصادم والخوف والتمرد، كأوضاع سلبية، بينما ارتأت بعض الذوات الشاعرة التعامل بوعي روحي أعمق ،عبر البحث عن استعادة الحياة والجمال المنطوي في أعماق الكون، أو محاورة الواقع بتفكيك أوضاعه ومحاولة تحديها.
د. سليمة مسعودي
* من كتاب:
الذات والمرآة في تأويل النص الشعري الصادر عن دار رؤية للنشر.
وقد شاركت به وبجزء من الفصل في مداخلة لملتقى راهن الشعر الجزائري - مارس 2018
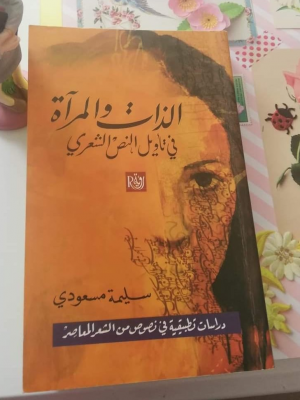
Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
 www.facebook.com
www.facebook.com