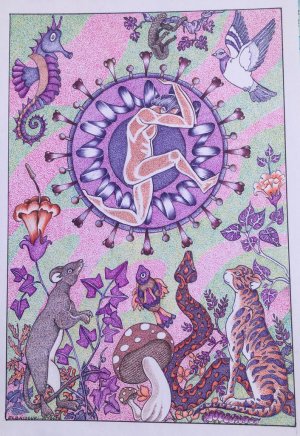بعد ما يقرب من خمسة عشر عامًا من النسيان والإهمال، فتش الشّيخ الستينيّ المهيب في خزانة أوراقه العامرة، فاستخرج منها مُسَوَّدَة قديمة لمخطوط كان قد عزم على تصنيفه قبل أن تشغله عنه صروف الدّهر ونوائب الأيّام.
وفي داره التي ذهبت الفاجعة بنصف قاطنيها، أمسك الشّيخ بقلمه ليكتب عن قصّة واحدٍ من أشرس الأمراض التي عصفت رياحها بمصر المحروسة في القرون الوسطى، وليسهب في عرض الرّؤية الإسلاميّة الأكثر ذيوعًا وحضورًا لذلك القاتل الفتّاك.
هكذا تكوّن المشهد -إذن- من ثلاثة عناصر، أوّلها: الوباء القاتل الذي ضرب البلاد في عام 833ه، وعُرف وقتها باسم “الطاعون الكبير”. وثانيها: الشّيخ العلّامة المُحدِّث الشهير “ابن حجر العسقلانيّ” المتوفى عام 852ه. أمّا ثالث العناصر، فكان كتاب “بذل الماعون في فضل الطاعون”، وكان في حقيقته ثمرة شرعيّة لتلاقح خصب بين حقيقة مفجعة أودت بحياة الآلاف من المصريين من جهة، ومشاعر ابن حجر الفيّاضة التي ألمّت بالشّيخ الوقور في محنته ومصيبته من جهة أخرى. كما كان هذا الكتاب -في الوقت ذاته- المدوّنة الأكثر شهرة، والتي لطالما تردّد ذكرها على ألسنة المسلمين في أوقات الأوبئة والطّواعين والمحن في القرون الخالية.
موت وخراب وكساد: كيف ظهر “الطّاعون الكبير” في كتابات المؤرّخين المسلمين؟
في أواسط القرن الثامن الهجريّ/ أواسط القرن الرابع عشر الميلاديّ، وبعد أن وضعت الحروب الصليبيّة أوزارها مُعلنةً نهاية أحد أكثر فصول التّاريخ دمويّة بين الشرق والغرب، شاءت الأقدار أن يعود الدمار مرةً أخرى ليهدد البشريّة، في صورة أوبئة وطواعين قاتلة.
في تلك الفترة انتشر الوباء الذي عُرف بـ”الطّاعون الأسود” في أوروبا، وقضى على ما يقرب من ثلث سكانها، وبعد أن سحق مئات الآلاف في شمال البحر المتوسط، انتقل في النصف الأول من القرن التاسع الهجريّ/ الخامس عشر الميلاديّ، إلى السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، ليضرب المسلمين في مصر وبلاد الشام، وليحصد أرواح الآلاف منهم.
الطّاعون ضرب مصر في تلك الفترة على هيئة موجات متتابعة، كان أوّلها ما وقع في سنة 819ه، ولكنّه وصل إلى أوجه وعنفوانه في عهد السلطان المملوكيّ “الأشرف برسباي” سنة 833ه، وهي الفترة التي شهدت ما تعارف المؤرّخون المسلمون على تسميته باسم “الطّاعون الكبير”.
بالإضافة إلى “ابن حجر العسقلانيّ” الذي أفرد كتابًا مختصًّا في موضوع الطّاعون، فقد كان هناك العديد من المؤرّخين الذين نقلوا في كتاباتهم آثار هذا الطّاعون المدمّرة وعواقبه الوخيمة. على رأس هؤلاء، مؤرخان متميّزان معاصران لأحداث هذا الوباء، هما “تقيُّ الدين المقريزي” المتوفّى عام 845ه، و”ابن تغري بردي” المتوفى عام 874ه، هذا بالإضافة إلى “ابن إياس الحنفي” المتوفّى 930ه، والذي وإن لم يكن قد عاصر تلك الأحداث؛ إلا أنه قد وصفها في كتابه الموسوعيّ بشكل دقيق ومسهب.
“المقريزي” اهتم في كتابه “السلوك”، بتقديم صورة بانوراميّة للواقع الصعب الذي عاشه المصريون في 833ه، فقال: “ومن كثرة الشُّغل بالمرضى والأموات، تعطّلت الأسواق من البيع والشراء، وتزايد ازدحام الناس في طلب الأكفان والنعوش، فَحُمِلَت الأموات على الألواح وعلى الأقفاص وعلى الأيدي. وعجز الناس عن دفن أمواتهم، فصاروا يبيتون بها في المقابر والحفّارون طول ليلتهم يحفرون. وعملوا حفائر كبيرة بلغ في الحفرة منها عدة أموات. وأكلت الكلاب كثيرًا من أطراف الأموات”.
أما تلميذه “ابن تغري بردي”، فقد رسم صورة أكثر قتامة للمشهد، عندما استعرض في كتابه “النّجوم الزاهرة”، تأثير الوباء في مختلف فئات المجتمع، وفي الحيوانات أيضًا، فقال: “وُجِدَ بنيل مصر والبرك، كثيرٌ من السّمك والتّماسيح قد طفت على وجه الماء ميتة، ومن مات من عندنا من المماليك والعبيد والجواري والخدم فلا يدخل تحت حصر، كل ذلك والطّاعون في زيادةٍ ونموٍّ حتى أيقن كل أحد أنه هالكٌ لا محالة”. كما تحدث عن مجموعة من الحلول الخرافيّة التي لجأ إليها المصريون للنجاة من براثن ذلك العدوّ غير المرئيّ، فقال في ذلك: “خرج قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني في جمع موفور إلى الصحراء خارج القاهرة، وجلس بجانب تربة الملك الظاهر برقوق ووعظ الناس، فكثر ضجيج الناس وبكاؤهم في دعائهم وتضرعهم، ثم انفضّوا. فتزايدت عدة الأموات في هذا اليوم عما كانت في أمسه”.
أما “ابن إياس الحنفي” فربما مكّنه بُعده عن فترة الوباء من ملاحظة بعض النقاط المهمة على الصعيدين السياسيّ والاجتماعيّ؛ إذ أورد في كتابه معلِّقًا على الأموات: “وصار لا تعرف جثة الأمير المقدم ألف من جثة المملوك، وهم أبدان بلا رءوس”، وهي ملاحظة مهمة، خصوصًا وأنّ “الطّاعون الكبير” قد فتك ببعض رجال السلطنة والحكم، ومنهم على سبيل المثال، الأمير “سيف الدين يشبك بن عبدالله”، وهو الأخ الأكبر للسّلطان “الأشرف برسباي”. فيما ذكر “ابن إياس” في كتابه معلِّقًا على الفئات العمرية التي سقطت في تلك الغمّة: “لم يترك الطاعون شبابًا أو عجائز، فكان إذا دخل الدار يُفنيها من أهلها، ويختم على أبواب ساكنيها، وصارت مفاتيح المنازل المغلقة تُعلَّق في أرجل النعوش”.
“ابن حجر العسقلانيّ”.. شارح “البخاري” الذي سلبه الطّاعون نصف أولاده
وُلد “شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي”، الذي اشتُهر بـ”ابن حجر العسقلانيّ” في عام 773ه بمدينة الفسطاط بمصر. ورغم أصوله التي ترجع إلى مدينة عسقلان بفلسطين؛ إلا أنه قد تربّى في أحضان المحروسة، بعدما توفي والداه مبكرًا، وتعهّده أحد أقاربه المقيمين بمصر بالرّعاية والتربية.
الطفل الصغير سرعان ما كشف عن موهبة عظيمة في الحفظ والتعليم، فدرس على كبار شيوخ عصره، ثم رحل إلى اليمن والحجاز والشام للسّماع من العلماء والمحدِّثين، وبعدها رجع إلى مصر ليصنّف أهم كتبه، وهو كتاب “فتح الباري في شرح صحيح البخاري”، الذي يُعدُّ الشرح الأكثر اعتبارًا وموثوقيّة لأهمّ المدوّنات الحديثيّة عند أهل السنّة والجماعة.
“ابن حجر” الذي كان من جملة المعاصرين للطّاعون الكبير، صنّف كتابًا متميزًا في الطّاعون وما يتصل به من شرائع وأحكام، وهو المسمّى “بذل الماعون في أحكام الطاعون”. فعلى الرغم من أن الثقافة الإسلامية قد عرفت ما يزيد على الثلاثين كتابًا عن هذا الوباء؛ إلا أن العديد من الأسئلة الجدليّة قد دارت حول طبيعته وأسبابه، وكانت تلك الأسئلة تظهر في الذهنيّة الجمعيّة الإسلاميّة من وقت إلى آخر.
فكرة تصنيف كتاب عن الأحاديث النبوية المرتبطة بالطاعون، والأحكام الشرعيّة والفقهيّة المتعلّقة به؛ طرأت على بال “ابن حجر” بعد وقوع الوباء في مصر في عام 819ه، والذي توفيت فيه ابنتاه “فاطمة” و”عالية”. ولكن يبدو أن تلك الفكرة قد توارت جانبًا بعض الشيء بعد انقشاع الغمة ونهاية الوباء؛ إذ عاد “ابن حجر” لمؤلفاته المتخصّصة في علوم الحديث، وترك مسوّدة كتاب الطّاعون مهملة في ركن منزوٍ من مكتبته.
ولكن ومع اشتداد موجة “الطاعون الكبير” في عام 833ه، عادت فكرة كتاب الطّاعون مرةً أخرى إلى ذهن “العسقلانيّ”. ورغم أننا لا نعرف على وجه التحديد السبب في ذلك؛ إلا أنه يبدو أنّ وفاة ابنته الكبرى -الأقرب إليه- “زين خاتون” في ذلك الوباء؛ قد أثارت مشاعره وعصفت بكيانه، خصوصًا أن ابنته قد توفّيت وهي تحمل جنينها، مما عظّم من فقدان “ابن حجر” وخسارته، وذكّره بحال يُتمه في صغره، وكيف أن الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت، وأنه فقد نصف أهله في غضون أعوام قلائل.
كان من الطبيعيّ -إذن- أن تُثير تلك الأحزان مشاعر “ابن حجر” المضّطربة، فنراه يقبل في أولى سنوات عقده السادس، على إعادة النظر في مسوّدات مخطوطه القديم، فيعيد قراءتها وينقّح ما فيها، خصوصًا أنّه كانت ثمّة حاجة شعبيّة مُلحّة لتصنيف كتاب عن ذلك الوباء الفتّاك، وهو ما يظهر في كلام “ابن حجر” في مقدمة كتابه، عندما ذكر أنه قد صنفه بناء على طلب من العديد من أصحابه ومعارفه.
كما أنّ الطرق والوسائل البِدعيَّة -بحسب وصف “ابن حجر”- التي لجأ إليها المصريّون زمن “الطاعون الكبير” لكشف الغمة ودفع البلاء، كانت بحسب ما يذكر في كتابه: “من الأسباب الحاملة لي على تبييض هذا الكتاب…”.
التوفيق بين العقوبة والابتلاء، ووخز الجن، وتكذيب عدوى الطاعون؛ أهم ما ورد في “بذل الماعون”.
يقع كتاب “بذل الماعون” بعد طباعته في العصر الحديث فيما يزيد على ثلاثمائة ورقة، وقد تضمّن العديد من المسائل المهمّة التي تؤطّر للفهم الإسلاميّ السنّيّ لمرض الطاعون، مما يجعل من هذا الكتاب مصنفًا فريدًا للتعرّف على وجهة نظر مسلمي العصور الوسطى في هذا الوباء القاتل الذي أودى بحياة مئات الآلاف من البشر.
النقطة الأولى، هي تلك المتعلقة بسبب حدوث الطاعون من الأساس؛ إذ يعرض “ابن حجر” في كتابه للأقوال المختلفة المفسِّرة لوقوع الطّواعين، ويذكر أنه “قد وردت آثار وحكايات لا تُحصى في تثبيت كون الطاعون من وخز الجنّ”، ثم ينقل بعض الرّوايات الطبيّة المفسّرة لوقوع الطّاعون. وفي النهاية يميل للتفسير التوفيقي، الذي يجمع التفسيرات الطبية مع الآثار النبوية ذات الطابع الغيبي، فقال: “والذي يفترق به الطاعون من الوباء، أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثرُ من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طعن الجن…”.
ويحاول “العسقلانيّ” في هذا المقام أن يُعقلن هذا التفسير، وأن يجد له شواهد من القصص الديني المتواتر، فيقول: “ولا مانع أن يأذن الله تعالى لمؤمني الجن في عقوبة من شاء من الإنس بذلك، وإن كان فيهم غير المذنب، كما يقع الإذن لبعض الملائكة في خسف بلد من البلاد بمن فيها، أو بإغراق سفينة عظيمة، أو بإيقاع زلزلة عظيمة تخرب منازل كثيرة…”.
وفي واحدة من القصص المُتخيلة التي يسوقها “العسقلاني” لتأكيد كلامه، ينقل عن بعض أصحابه الموثوق فيهم، أنه قد سمع صوت اثنين من الجن يختلفان حول طعن أحد البشر، فكان أولهما يريد طعنه، أما الآخر فكان ينهاه عن ذلك، ثم اتفقا في نهاية الأمر على طعن فرس الرجل، فإذا بالفرس “وقد ذهبت عينُها من أثر الضربة”.
ورغم أن “ابن حجر” قد أورد في كتابه مجموعة من الآثار والأذكار التي تحفظ قائلها من طعن الجن، ومنها -على سبيل المثال- سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتان؛ إلا أن صاحب “فتح الباري” ينبّه في نهاية حديثه عن تلك الآثار إلى كونها مفيدة لمجموعة معينة من الناس، فيقول: “إنما يحصل النفع بهذه الآيات والكلمات لمن صفا قلبه من الكدر، وأخلص في التوبة، وندم على ما فرط فيه وفرط، وإلا فإذا غلبت أسباب الداء على أسباب الدواء، ربما بطل نفع الأدوية…”.
النقطة الثانية المهمة في كتاب “العسقلاني”، هي محاولة مؤلِّفه الجمع بين الأحاديث النبوية ظاهرة التعارض، التي يذهب بعضها إلى أن الطاعون شر وعقوبة، بينما يذهب بعضها الآخر إلى أنه شهادة ورحمة.
يذهب “العسقلاني” إلى إثبات صفة الشهادة لضحايا الطاعون؛ إذ إنهم “يشاركون شهيد المعركة في الشهادة، وفي بعض الصفات الأخروية”. ويورد عددًا من الأحاديث والمرويّات التي تؤكد أن الطّاعون رحمة، ويثبت هذا المعنى رغم ما في هذا المرض الفتاك من عذاب وشر، ويفسر ذلك التعارض الظاهر بقوله: “إن كونه شهادة ورحمة، ليس المراد بوصفه ذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه وأنه سببه”.
ويحاول “ابن حجر” هنا أن يجمع بين الرّوايات التي تفسّر الطّاعون بكونه عقوبة من الله مع الروايات الأخرى التي تفسره بكونه رحمة وشهادة، فيقول: “لكنّ الغرض أن كون الطاعون من انتقام الله تعالى، بسبب هتك حرماته، لا ينافي أن يكون شهادة ورحمة في حق جميع من طُعن.. فهو زيادة لحسنات من لم يباشر الفاحشة، ولم يقصر فيما يجب عليه من الأمر والنهي.. بخلاف غير هؤلاء، فلا يكون لهم ذلك إلا مجرد عقوبة…”.
أما النقطة الثالثة الأكثر أهمية في كتاب “بذل الماعون”، أن الطاعون كان بحمولته الثقيلة التي لطالما أَلقى بها في المجتمعات الإسلامية، سببٌ في إثارة السؤال المُلحّ حول السببية، وطريقة نشر العدوى بين الناس، وإذا كانت تلك العدوى تحدث بسبب الطّاعون نفسه، أم لسبب آخر خفيّ.
هذا السؤال يظهر في التفسيرات الكثيرة المرتبطة بحديث الرسول الوارد في البخاري: “لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد”، فالأشاعرة -وهم السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة- قد نفوا مبدأ السببية، وقالوا إن المرض المرتبط بالطاعون والوباء لا ينتج بسبب خصائص ذاتية في الطاعون، بل إنه يرتبط بالطاعون ويقترن به بحكم العادة ليس أكثر. بينما ذهب الماتريدية وغير ذلك من طوائف أهل السنة إلى إثبات وجود السببية والخصائص المؤثرة في الأشياء، ولنا أن نتخيل كيف كان النقاش والجدل العقائديان يتجددان مع انتشار كل موجة من موجات الطاعون والوباء في بلاد الإسلام في العصور الوسطى.
هذا الجدل العقائدي، شارك فيه “ابن حجر العسقلاني” في كتابه، معتمدًا على أفكاره الأشعرية القحة، فذهب إلى إنكار العدوى، وفسر أن النهي الوارد في بعض الأحاديث في ألا يرد الممرض على المصح “ليس لإثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله، فربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى، فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه…”.
وفي موضع آخر من كتابه، رد قول بعض الفقهاء الذين أفتوا بوقوع عدوى الطاعون، وبوجوب ابتعاد السليم عن المطعون، فقال: “لا تقبل شهادة من شهد بذلك، لأن الحس يكذبه، فهذه الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية، وقل أن يخلو بيت منها، ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته، ومخالطتهم له أشد من مخالطة الأجانب قطعًا، والكثير منهم سالم من ذلك، فمن شهد بأن ذلك سبب في أذى المخالط فهو مكابر…”.
وهكذا، أصر “ابن حجر” على نفي العدوى، مستشهدًا بعدم إصابة بعض المخالطين للمطعون، غير ملتفت إلى ما يُعرف الآن باسم المناعة، التي من شأنها تفسير ذلك المشهد الذي وقف عنده “العسقلاني” متسائلًا مندهشًا.
المصادر والمراجع :
محمد يسري أبوهدور
كاتب وباحث مصري
وفي داره التي ذهبت الفاجعة بنصف قاطنيها، أمسك الشّيخ بقلمه ليكتب عن قصّة واحدٍ من أشرس الأمراض التي عصفت رياحها بمصر المحروسة في القرون الوسطى، وليسهب في عرض الرّؤية الإسلاميّة الأكثر ذيوعًا وحضورًا لذلك القاتل الفتّاك.
هكذا تكوّن المشهد -إذن- من ثلاثة عناصر، أوّلها: الوباء القاتل الذي ضرب البلاد في عام 833ه، وعُرف وقتها باسم “الطاعون الكبير”. وثانيها: الشّيخ العلّامة المُحدِّث الشهير “ابن حجر العسقلانيّ” المتوفى عام 852ه. أمّا ثالث العناصر، فكان كتاب “بذل الماعون في فضل الطاعون”، وكان في حقيقته ثمرة شرعيّة لتلاقح خصب بين حقيقة مفجعة أودت بحياة الآلاف من المصريين من جهة، ومشاعر ابن حجر الفيّاضة التي ألمّت بالشّيخ الوقور في محنته ومصيبته من جهة أخرى. كما كان هذا الكتاب -في الوقت ذاته- المدوّنة الأكثر شهرة، والتي لطالما تردّد ذكرها على ألسنة المسلمين في أوقات الأوبئة والطّواعين والمحن في القرون الخالية.
موت وخراب وكساد: كيف ظهر “الطّاعون الكبير” في كتابات المؤرّخين المسلمين؟
في أواسط القرن الثامن الهجريّ/ أواسط القرن الرابع عشر الميلاديّ، وبعد أن وضعت الحروب الصليبيّة أوزارها مُعلنةً نهاية أحد أكثر فصول التّاريخ دمويّة بين الشرق والغرب، شاءت الأقدار أن يعود الدمار مرةً أخرى ليهدد البشريّة، في صورة أوبئة وطواعين قاتلة.
في تلك الفترة انتشر الوباء الذي عُرف بـ”الطّاعون الأسود” في أوروبا، وقضى على ما يقرب من ثلث سكانها، وبعد أن سحق مئات الآلاف في شمال البحر المتوسط، انتقل في النصف الأول من القرن التاسع الهجريّ/ الخامس عشر الميلاديّ، إلى السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، ليضرب المسلمين في مصر وبلاد الشام، وليحصد أرواح الآلاف منهم.
الطّاعون ضرب مصر في تلك الفترة على هيئة موجات متتابعة، كان أوّلها ما وقع في سنة 819ه، ولكنّه وصل إلى أوجه وعنفوانه في عهد السلطان المملوكيّ “الأشرف برسباي” سنة 833ه، وهي الفترة التي شهدت ما تعارف المؤرّخون المسلمون على تسميته باسم “الطّاعون الكبير”.
بالإضافة إلى “ابن حجر العسقلانيّ” الذي أفرد كتابًا مختصًّا في موضوع الطّاعون، فقد كان هناك العديد من المؤرّخين الذين نقلوا في كتاباتهم آثار هذا الطّاعون المدمّرة وعواقبه الوخيمة. على رأس هؤلاء، مؤرخان متميّزان معاصران لأحداث هذا الوباء، هما “تقيُّ الدين المقريزي” المتوفّى عام 845ه، و”ابن تغري بردي” المتوفى عام 874ه، هذا بالإضافة إلى “ابن إياس الحنفي” المتوفّى 930ه، والذي وإن لم يكن قد عاصر تلك الأحداث؛ إلا أنه قد وصفها في كتابه الموسوعيّ بشكل دقيق ومسهب.
“المقريزي” اهتم في كتابه “السلوك”، بتقديم صورة بانوراميّة للواقع الصعب الذي عاشه المصريون في 833ه، فقال: “ومن كثرة الشُّغل بالمرضى والأموات، تعطّلت الأسواق من البيع والشراء، وتزايد ازدحام الناس في طلب الأكفان والنعوش، فَحُمِلَت الأموات على الألواح وعلى الأقفاص وعلى الأيدي. وعجز الناس عن دفن أمواتهم، فصاروا يبيتون بها في المقابر والحفّارون طول ليلتهم يحفرون. وعملوا حفائر كبيرة بلغ في الحفرة منها عدة أموات. وأكلت الكلاب كثيرًا من أطراف الأموات”.
أما تلميذه “ابن تغري بردي”، فقد رسم صورة أكثر قتامة للمشهد، عندما استعرض في كتابه “النّجوم الزاهرة”، تأثير الوباء في مختلف فئات المجتمع، وفي الحيوانات أيضًا، فقال: “وُجِدَ بنيل مصر والبرك، كثيرٌ من السّمك والتّماسيح قد طفت على وجه الماء ميتة، ومن مات من عندنا من المماليك والعبيد والجواري والخدم فلا يدخل تحت حصر، كل ذلك والطّاعون في زيادةٍ ونموٍّ حتى أيقن كل أحد أنه هالكٌ لا محالة”. كما تحدث عن مجموعة من الحلول الخرافيّة التي لجأ إليها المصريون للنجاة من براثن ذلك العدوّ غير المرئيّ، فقال في ذلك: “خرج قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني في جمع موفور إلى الصحراء خارج القاهرة، وجلس بجانب تربة الملك الظاهر برقوق ووعظ الناس، فكثر ضجيج الناس وبكاؤهم في دعائهم وتضرعهم، ثم انفضّوا. فتزايدت عدة الأموات في هذا اليوم عما كانت في أمسه”.
أما “ابن إياس الحنفي” فربما مكّنه بُعده عن فترة الوباء من ملاحظة بعض النقاط المهمة على الصعيدين السياسيّ والاجتماعيّ؛ إذ أورد في كتابه معلِّقًا على الأموات: “وصار لا تعرف جثة الأمير المقدم ألف من جثة المملوك، وهم أبدان بلا رءوس”، وهي ملاحظة مهمة، خصوصًا وأنّ “الطّاعون الكبير” قد فتك ببعض رجال السلطنة والحكم، ومنهم على سبيل المثال، الأمير “سيف الدين يشبك بن عبدالله”، وهو الأخ الأكبر للسّلطان “الأشرف برسباي”. فيما ذكر “ابن إياس” في كتابه معلِّقًا على الفئات العمرية التي سقطت في تلك الغمّة: “لم يترك الطاعون شبابًا أو عجائز، فكان إذا دخل الدار يُفنيها من أهلها، ويختم على أبواب ساكنيها، وصارت مفاتيح المنازل المغلقة تُعلَّق في أرجل النعوش”.
“ابن حجر العسقلانيّ”.. شارح “البخاري” الذي سلبه الطّاعون نصف أولاده
وُلد “شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي”، الذي اشتُهر بـ”ابن حجر العسقلانيّ” في عام 773ه بمدينة الفسطاط بمصر. ورغم أصوله التي ترجع إلى مدينة عسقلان بفلسطين؛ إلا أنه قد تربّى في أحضان المحروسة، بعدما توفي والداه مبكرًا، وتعهّده أحد أقاربه المقيمين بمصر بالرّعاية والتربية.
الطفل الصغير سرعان ما كشف عن موهبة عظيمة في الحفظ والتعليم، فدرس على كبار شيوخ عصره، ثم رحل إلى اليمن والحجاز والشام للسّماع من العلماء والمحدِّثين، وبعدها رجع إلى مصر ليصنّف أهم كتبه، وهو كتاب “فتح الباري في شرح صحيح البخاري”، الذي يُعدُّ الشرح الأكثر اعتبارًا وموثوقيّة لأهمّ المدوّنات الحديثيّة عند أهل السنّة والجماعة.
“ابن حجر” الذي كان من جملة المعاصرين للطّاعون الكبير، صنّف كتابًا متميزًا في الطّاعون وما يتصل به من شرائع وأحكام، وهو المسمّى “بذل الماعون في أحكام الطاعون”. فعلى الرغم من أن الثقافة الإسلامية قد عرفت ما يزيد على الثلاثين كتابًا عن هذا الوباء؛ إلا أن العديد من الأسئلة الجدليّة قد دارت حول طبيعته وأسبابه، وكانت تلك الأسئلة تظهر في الذهنيّة الجمعيّة الإسلاميّة من وقت إلى آخر.
فكرة تصنيف كتاب عن الأحاديث النبوية المرتبطة بالطاعون، والأحكام الشرعيّة والفقهيّة المتعلّقة به؛ طرأت على بال “ابن حجر” بعد وقوع الوباء في مصر في عام 819ه، والذي توفيت فيه ابنتاه “فاطمة” و”عالية”. ولكن يبدو أن تلك الفكرة قد توارت جانبًا بعض الشيء بعد انقشاع الغمة ونهاية الوباء؛ إذ عاد “ابن حجر” لمؤلفاته المتخصّصة في علوم الحديث، وترك مسوّدة كتاب الطّاعون مهملة في ركن منزوٍ من مكتبته.
ولكن ومع اشتداد موجة “الطاعون الكبير” في عام 833ه، عادت فكرة كتاب الطّاعون مرةً أخرى إلى ذهن “العسقلانيّ”. ورغم أننا لا نعرف على وجه التحديد السبب في ذلك؛ إلا أنه يبدو أنّ وفاة ابنته الكبرى -الأقرب إليه- “زين خاتون” في ذلك الوباء؛ قد أثارت مشاعره وعصفت بكيانه، خصوصًا أن ابنته قد توفّيت وهي تحمل جنينها، مما عظّم من فقدان “ابن حجر” وخسارته، وذكّره بحال يُتمه في صغره، وكيف أن الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت، وأنه فقد نصف أهله في غضون أعوام قلائل.
كان من الطبيعيّ -إذن- أن تُثير تلك الأحزان مشاعر “ابن حجر” المضّطربة، فنراه يقبل في أولى سنوات عقده السادس، على إعادة النظر في مسوّدات مخطوطه القديم، فيعيد قراءتها وينقّح ما فيها، خصوصًا أنّه كانت ثمّة حاجة شعبيّة مُلحّة لتصنيف كتاب عن ذلك الوباء الفتّاك، وهو ما يظهر في كلام “ابن حجر” في مقدمة كتابه، عندما ذكر أنه قد صنفه بناء على طلب من العديد من أصحابه ومعارفه.
كما أنّ الطرق والوسائل البِدعيَّة -بحسب وصف “ابن حجر”- التي لجأ إليها المصريّون زمن “الطاعون الكبير” لكشف الغمة ودفع البلاء، كانت بحسب ما يذكر في كتابه: “من الأسباب الحاملة لي على تبييض هذا الكتاب…”.
التوفيق بين العقوبة والابتلاء، ووخز الجن، وتكذيب عدوى الطاعون؛ أهم ما ورد في “بذل الماعون”.
يقع كتاب “بذل الماعون” بعد طباعته في العصر الحديث فيما يزيد على ثلاثمائة ورقة، وقد تضمّن العديد من المسائل المهمّة التي تؤطّر للفهم الإسلاميّ السنّيّ لمرض الطاعون، مما يجعل من هذا الكتاب مصنفًا فريدًا للتعرّف على وجهة نظر مسلمي العصور الوسطى في هذا الوباء القاتل الذي أودى بحياة مئات الآلاف من البشر.
النقطة الأولى، هي تلك المتعلقة بسبب حدوث الطاعون من الأساس؛ إذ يعرض “ابن حجر” في كتابه للأقوال المختلفة المفسِّرة لوقوع الطّواعين، ويذكر أنه “قد وردت آثار وحكايات لا تُحصى في تثبيت كون الطاعون من وخز الجنّ”، ثم ينقل بعض الرّوايات الطبيّة المفسّرة لوقوع الطّاعون. وفي النهاية يميل للتفسير التوفيقي، الذي يجمع التفسيرات الطبية مع الآثار النبوية ذات الطابع الغيبي، فقال: “والذي يفترق به الطاعون من الوباء، أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثرُ من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طعن الجن…”.
ويحاول “العسقلانيّ” في هذا المقام أن يُعقلن هذا التفسير، وأن يجد له شواهد من القصص الديني المتواتر، فيقول: “ولا مانع أن يأذن الله تعالى لمؤمني الجن في عقوبة من شاء من الإنس بذلك، وإن كان فيهم غير المذنب، كما يقع الإذن لبعض الملائكة في خسف بلد من البلاد بمن فيها، أو بإغراق سفينة عظيمة، أو بإيقاع زلزلة عظيمة تخرب منازل كثيرة…”.
وفي واحدة من القصص المُتخيلة التي يسوقها “العسقلاني” لتأكيد كلامه، ينقل عن بعض أصحابه الموثوق فيهم، أنه قد سمع صوت اثنين من الجن يختلفان حول طعن أحد البشر، فكان أولهما يريد طعنه، أما الآخر فكان ينهاه عن ذلك، ثم اتفقا في نهاية الأمر على طعن فرس الرجل، فإذا بالفرس “وقد ذهبت عينُها من أثر الضربة”.
ورغم أن “ابن حجر” قد أورد في كتابه مجموعة من الآثار والأذكار التي تحفظ قائلها من طعن الجن، ومنها -على سبيل المثال- سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتان؛ إلا أن صاحب “فتح الباري” ينبّه في نهاية حديثه عن تلك الآثار إلى كونها مفيدة لمجموعة معينة من الناس، فيقول: “إنما يحصل النفع بهذه الآيات والكلمات لمن صفا قلبه من الكدر، وأخلص في التوبة، وندم على ما فرط فيه وفرط، وإلا فإذا غلبت أسباب الداء على أسباب الدواء، ربما بطل نفع الأدوية…”.
النقطة الثانية المهمة في كتاب “العسقلاني”، هي محاولة مؤلِّفه الجمع بين الأحاديث النبوية ظاهرة التعارض، التي يذهب بعضها إلى أن الطاعون شر وعقوبة، بينما يذهب بعضها الآخر إلى أنه شهادة ورحمة.
يذهب “العسقلاني” إلى إثبات صفة الشهادة لضحايا الطاعون؛ إذ إنهم “يشاركون شهيد المعركة في الشهادة، وفي بعض الصفات الأخروية”. ويورد عددًا من الأحاديث والمرويّات التي تؤكد أن الطّاعون رحمة، ويثبت هذا المعنى رغم ما في هذا المرض الفتاك من عذاب وشر، ويفسر ذلك التعارض الظاهر بقوله: “إن كونه شهادة ورحمة، ليس المراد بوصفه ذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه وأنه سببه”.
ويحاول “ابن حجر” هنا أن يجمع بين الرّوايات التي تفسّر الطّاعون بكونه عقوبة من الله مع الروايات الأخرى التي تفسره بكونه رحمة وشهادة، فيقول: “لكنّ الغرض أن كون الطاعون من انتقام الله تعالى، بسبب هتك حرماته، لا ينافي أن يكون شهادة ورحمة في حق جميع من طُعن.. فهو زيادة لحسنات من لم يباشر الفاحشة، ولم يقصر فيما يجب عليه من الأمر والنهي.. بخلاف غير هؤلاء، فلا يكون لهم ذلك إلا مجرد عقوبة…”.
أما النقطة الثالثة الأكثر أهمية في كتاب “بذل الماعون”، أن الطاعون كان بحمولته الثقيلة التي لطالما أَلقى بها في المجتمعات الإسلامية، سببٌ في إثارة السؤال المُلحّ حول السببية، وطريقة نشر العدوى بين الناس، وإذا كانت تلك العدوى تحدث بسبب الطّاعون نفسه، أم لسبب آخر خفيّ.
هذا السؤال يظهر في التفسيرات الكثيرة المرتبطة بحديث الرسول الوارد في البخاري: “لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد”، فالأشاعرة -وهم السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة- قد نفوا مبدأ السببية، وقالوا إن المرض المرتبط بالطاعون والوباء لا ينتج بسبب خصائص ذاتية في الطاعون، بل إنه يرتبط بالطاعون ويقترن به بحكم العادة ليس أكثر. بينما ذهب الماتريدية وغير ذلك من طوائف أهل السنة إلى إثبات وجود السببية والخصائص المؤثرة في الأشياء، ولنا أن نتخيل كيف كان النقاش والجدل العقائديان يتجددان مع انتشار كل موجة من موجات الطاعون والوباء في بلاد الإسلام في العصور الوسطى.
هذا الجدل العقائدي، شارك فيه “ابن حجر العسقلاني” في كتابه، معتمدًا على أفكاره الأشعرية القحة، فذهب إلى إنكار العدوى، وفسر أن النهي الوارد في بعض الأحاديث في ألا يرد الممرض على المصح “ليس لإثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله، فربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى، فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه…”.
وفي موضع آخر من كتابه، رد قول بعض الفقهاء الذين أفتوا بوقوع عدوى الطاعون، وبوجوب ابتعاد السليم عن المطعون، فقال: “لا تقبل شهادة من شهد بذلك، لأن الحس يكذبه، فهذه الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية، وقل أن يخلو بيت منها، ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته، ومخالطتهم له أشد من مخالطة الأجانب قطعًا، والكثير منهم سالم من ذلك، فمن شهد بأن ذلك سبب في أذى المخالط فهو مكابر…”.
وهكذا، أصر “ابن حجر” على نفي العدوى، مستشهدًا بعدم إصابة بعض المخالطين للمطعون، غير ملتفت إلى ما يُعرف الآن باسم المناعة، التي من شأنها تفسير ذلك المشهد الذي وقف عنده “العسقلاني” متسائلًا مندهشًا.
المصادر والمراجع :
محمد يسري أبوهدور
كاتب وباحث مصري