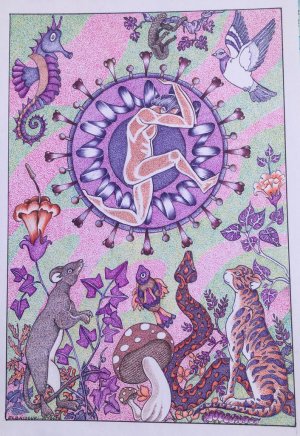( إن كل شيء في الطبيعة غنائيٌّ في جوهره المثالي، مأساويٌّ في قَدَرِه، هَزْليٌّ في وجوده )
الفيلسوف الأمريكوـ إسباني: خورْخي سانْتانْيانا ( 1863 ـ 1952)
جاء في قول منسوب للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ). لكن، حرف « لو « الدال على التقليل والامتناع، يقول كل شيء. فالقتل ممتنع بالتأكيد، لأن القتل، عادة، يقع على الشيء المادي، يقع على الشيء الملموس والمحسوس. وبما أن الفقر ليس رجلا ولن يكون، إنما هو مجاز فحسبُ، فقتله ممتنعٌ بل مستحيل. ويعني ذلك من بين ما يعنيه: استمرار الفقر لأنه غير متشكل ولا مُصَوْرَن، بل مستشكل ومتحول يتمرأى تداعياتٍ وذيولا وعقابيلَ، بحسب الدرجات والفئات والمنازل، ويلبس لبوسات تختلف من شخص إلى شخص آخرَ، حِدَّةً وخِفَّةً.
وقياساً عليه، فإن جائحة كوفيد19 كالفقر ليست رجلا لتقتل، إذ هي تسلسل جينومي لفيروس فاتك يُرى بالمجاهر الدقيقة في المختبرات، وأماكن البحث والتجريب، يتعقبه العلماء حثيثا تعقبا يدعو إلى الإعجاب والإكبار والتبجيل ـ فإذا هو كالزئبق لا يستقر في مكان، ولا يطاوع اليد الطالبة الراغبة متى ما امتدت إلى جمعه لغلْبِه قصد وَأْدِه أو تسخيره لأنه يحمل في ذاته بذرة مسخه وتحوله.
لقد حيرت الجائحة الكونَ والإنسانَ، حيرت علماء البيولوجيا والميكروبيولوجيا، والفيروسولوجيا، ومختبرات الأبحاث والتجارب العلمية الدقيقة المرفودة بالتكنولوجيا الفائقة. حيرتهم من حيث تأبّيها على الانصياع، والبقاء بهيأتها الأولى، وشكلها البدْئي. وحيَّرَتْهم من حيث حصادُها وإزْهاقُها لأرواح الملايين عبر المعمورة. حصادٌ شَرِسٌ كاسح لا يهدأ لحظةً حتى يواصل العبث بمنجله اللامرئي في الحقول الإنسانية شمالا وجنوبا يستوي في ذلك الدول المصنعة التي بلغت شأواً بعيدا في العلم والتكنولوجيا، والزوبعة الرقمية، والدول النامية ( الرعوية والزراعية والمتعثرة ) التي تخاف دوما جائحة الجراد الذي لا يبقي ولا يذر، والتي تخطو بتؤدة لاستجلاب وازْدِرَاع ما حققته الدول « المثال «.
وليس بخافٍ أن البشرية عرفت ـ عبر تواريخها الطويلة والممتدة ـ أنواعا منوعة من الأمراض الفتاكة، والأوبئة الجارفة، والشرور المتزايدة، وكانت جابهتها بالقليل المتاح، بالحد المتوسط من الاكتشافات والفتوحات العلمية والطبية، ونجحت في حصارها، وتطويق أذاها وشرها. غير أن الوباء الحالي لا يزال يضرب الأفئدة والرؤوس من كل الأعمار، ومن دون هوادة، مُيَتِّما الأسرَ والعوائل والمجتمعات، عَسُرَ على الراسخين في الطب، والأبحاث الميكروبية والبكتيرية والفيروسية، السيطرة عليه، ورَكْنِه إلى زاوية النسيان، وطيّه طيَّ كتابٍ لا يفتح أبدا، كتابٍ شبيه بكتاب (اسم الوردة ) لأمبرتو إيكو. ذلك أن كورونا 19 تلبس لكل حال لبوسها، ولكل طاريء متحور « ماركته المسجلة «. ويتسمى إغريقيا أو لا تينيا كلما انهار كائن في مكان ما، كأن المصطلحات والمفاهيم قابعةٌ تنتظر الفيروسات ليتداولها الكون حتى تحيا، ويحيا بها الناس، وهكذا دواليك إلى أن يصبح الكوفيد ضيفا عزيزاً مرحبا به بيننا تماما مثل الرَّشْح الأنفي، والإنفلونزا الموسمية، والسّارسْ، ومرض السكري، والصداع النصفي، والألم والفقر، وغيرها. وهذا ما يصرح به الأطباء الكبار وكأنهم غُلِبوا، وكأن الأمر أصبح قدرا مقدوراً.
وإذاً، لِمَ أقلقُ راحة الثقافة، وأجُرُّها إلى مجال ومضمار لا يندرج في وارِد وصميم انشغالها وانهمامها؟. وَهَبْ أنني نجحت في الاحتيال على إدخالها المضمار والمجال، وإيلاجها سَمَّ الخياط، فماذا هي فاعلة، وكيف، وبأي ثمن قبل أن ترتد إلى دارتها النبيلة المشرقة المحوطة بالقيم الخالدة، والمثل العليا، خُلْواً من العدوى، والرشح الأنفي، وانحباس التنفس، وضيق الصدر، والسعال، وخفقان القلب، والموت في المحصلة؟
بالإمكان القول إن الثقافة وهي تواجه الوباء، وتتصدى له بطريقتها، وأدواتها، إنما تواجه الطبيعة. ويزداد الأمر استشكالا وانغلاقا إذا علمنا أن الفيروس الفتاك هذا، ذوطبيعة غامضة مستعصية يتأرجح معناها الانوجادي بين معنى انتقام الطبيعة لنفسها، وبين معنى أن يكون مصدره حيوانا ما، أو صنيعة يد آثمة، ونتيج علم يراد به المحو والتدمير.
لكن، دعنا عند السطح ـ من دون إيغال في التعالم والغوص والاستقصاء ـ لنقول إن الثقافة تواجه الطبيعةَ، لأن الطبيعة عانت معاناة شديدة منذ أن غزاها الإنسان مسلحا بالعلم والتقنية والجشع. وكانت ساكنة هادئة حنونا تعطي من غير مَنٍّ ولا حساب. فانتفاضها الذي تعلن عنه، بين الفينة والأخرى، ماهو ـ في النتيجة ـ سوى محاولة رد ابنِ رَحِمِها الإنسان، إلى رشده وصوابه، والكف عن غيّه ورعونته وجنونه.
وعلى الرغم من أن كوكبة منيرة من الشعراء والأدباء والمفكرين، والفلاسفة، والموسيقيين، والتشكيليين، حذرت ـ في ما كتبتْ وطرحت وأبدعتْ، وصدحتْ ـ من مخاطر وأهوال الصناعة والتصنيع، والتبضيع، والتسليع، والمَكْنَنَة، والتَّكنجة، والرَّبْوبَة وما يترتب عليها من أعطاب وإفقار وشرور، وإدقاع للكثرة الكاثرة من بني الإنسان، فإن عجلة الاختراع، والذكاء الاصطناعي، والاكتشافات، وغزو أعماق البحار، وباطن الأرض، والفضاء الكوني بعامة، لم تتوقف لحظةً، بل استمر تزييتها وتصليحها، وتبديعها أكثر لتعطي أوفر، وما ضَرَّها إذا طحنت في طريقها، الحجرَ والشجرَ والطيرَ، والبشرَ.
هي ذي الثقافة التي نواجه بها الجائحةَ، لا بالدعاء عليها بالويل والثبور، بل بالقضاء المكين عليها عن طريق العلم والبحث الطبي الدؤوب، وبوجوب إيقاظ الضمائر النائمة أو المنومة، وتشكيل جبهة ثقافية كونية بكل اللغات والتعبيرات، تعيد الاعتبار للإنسان، مطلق إنسان بتوفير الطعام لكل فم، والدواء لكل داء، والسكن اللائق للفقير والمُقْتَلع، والخيرات التي يعج بها الكون، للقاصي والداني، للساكن في القرى والبوادي، والمدن، يستوي في ذلك، جنوب الكرة وشمالها. إذْ أبانت الجائحة الكونية الرهيبة عن استمرار الفروق بين الناس، وانحفار الهوة أكثر، وارتفاع حصائل الهجرة والضياع والفقر، واستشراس الظلم والاحتكار والاحتقار والانتحار.
ولنا في ما نكتبه اليومَ من شعر ورواية، وقصة، ومسرح، وفكر، وما نغنيه من أغانٍ، وندونه من موسيقا، ونرسمه من لوحات تشكيلية، وما نعرضه من أفلام سينمائية متنوعة، وما كتبه أسلافنا: أرحاما، وأشباها، ومواطنين، وأغياراً، بكل اللغات، لنا فيه ما يدفع خطر الجائحة، ويبعد شبحها المخيف والمهدد، ويُرَغِّبُنا في العيش المشترك، في المحبة الكونية، والتقدير المتبادل، والاختلاف الغني، والسلام العام المهيمن، وتقاسم النعم والآلاء والخيرات في ما بيننا.
إن كوكبنا الأزرقَ يغرق رويدا.. رويداً في وَهْدة سحيقة، وهدةٍ بلا قرار، وما لم نتكاتفْ ونتساندْ، وندكَّ أسباب ودواعي التفرقة والخلافات المفتعلة، فإن الجائحةَ ستستمر كاشفةً ـ في كل مرة وكَرَّةٍ ـ عن وجهها البغيض، لا بسةً دروعاً واقية لا يؤثر فيها لا سيوف ولا رصاصٌ ولا متفجر، ولا دواء ولا دعاء. إنها جائحة الظلم والتبعيد، والتبغيض، والأنانية المقيتة، والمركزية الصَّلِفَة، والشمس البشرية المُدَّاعاة والمُفْتَراة.
الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 07/01/2022

الفيلسوف الأمريكوـ إسباني: خورْخي سانْتانْيانا ( 1863 ـ 1952)
جاء في قول منسوب للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ). لكن، حرف « لو « الدال على التقليل والامتناع، يقول كل شيء. فالقتل ممتنع بالتأكيد، لأن القتل، عادة، يقع على الشيء المادي، يقع على الشيء الملموس والمحسوس. وبما أن الفقر ليس رجلا ولن يكون، إنما هو مجاز فحسبُ، فقتله ممتنعٌ بل مستحيل. ويعني ذلك من بين ما يعنيه: استمرار الفقر لأنه غير متشكل ولا مُصَوْرَن، بل مستشكل ومتحول يتمرأى تداعياتٍ وذيولا وعقابيلَ، بحسب الدرجات والفئات والمنازل، ويلبس لبوسات تختلف من شخص إلى شخص آخرَ، حِدَّةً وخِفَّةً.
وقياساً عليه، فإن جائحة كوفيد19 كالفقر ليست رجلا لتقتل، إذ هي تسلسل جينومي لفيروس فاتك يُرى بالمجاهر الدقيقة في المختبرات، وأماكن البحث والتجريب، يتعقبه العلماء حثيثا تعقبا يدعو إلى الإعجاب والإكبار والتبجيل ـ فإذا هو كالزئبق لا يستقر في مكان، ولا يطاوع اليد الطالبة الراغبة متى ما امتدت إلى جمعه لغلْبِه قصد وَأْدِه أو تسخيره لأنه يحمل في ذاته بذرة مسخه وتحوله.
لقد حيرت الجائحة الكونَ والإنسانَ، حيرت علماء البيولوجيا والميكروبيولوجيا، والفيروسولوجيا، ومختبرات الأبحاث والتجارب العلمية الدقيقة المرفودة بالتكنولوجيا الفائقة. حيرتهم من حيث تأبّيها على الانصياع، والبقاء بهيأتها الأولى، وشكلها البدْئي. وحيَّرَتْهم من حيث حصادُها وإزْهاقُها لأرواح الملايين عبر المعمورة. حصادٌ شَرِسٌ كاسح لا يهدأ لحظةً حتى يواصل العبث بمنجله اللامرئي في الحقول الإنسانية شمالا وجنوبا يستوي في ذلك الدول المصنعة التي بلغت شأواً بعيدا في العلم والتكنولوجيا، والزوبعة الرقمية، والدول النامية ( الرعوية والزراعية والمتعثرة ) التي تخاف دوما جائحة الجراد الذي لا يبقي ولا يذر، والتي تخطو بتؤدة لاستجلاب وازْدِرَاع ما حققته الدول « المثال «.
وليس بخافٍ أن البشرية عرفت ـ عبر تواريخها الطويلة والممتدة ـ أنواعا منوعة من الأمراض الفتاكة، والأوبئة الجارفة، والشرور المتزايدة، وكانت جابهتها بالقليل المتاح، بالحد المتوسط من الاكتشافات والفتوحات العلمية والطبية، ونجحت في حصارها، وتطويق أذاها وشرها. غير أن الوباء الحالي لا يزال يضرب الأفئدة والرؤوس من كل الأعمار، ومن دون هوادة، مُيَتِّما الأسرَ والعوائل والمجتمعات، عَسُرَ على الراسخين في الطب، والأبحاث الميكروبية والبكتيرية والفيروسية، السيطرة عليه، ورَكْنِه إلى زاوية النسيان، وطيّه طيَّ كتابٍ لا يفتح أبدا، كتابٍ شبيه بكتاب (اسم الوردة ) لأمبرتو إيكو. ذلك أن كورونا 19 تلبس لكل حال لبوسها، ولكل طاريء متحور « ماركته المسجلة «. ويتسمى إغريقيا أو لا تينيا كلما انهار كائن في مكان ما، كأن المصطلحات والمفاهيم قابعةٌ تنتظر الفيروسات ليتداولها الكون حتى تحيا، ويحيا بها الناس، وهكذا دواليك إلى أن يصبح الكوفيد ضيفا عزيزاً مرحبا به بيننا تماما مثل الرَّشْح الأنفي، والإنفلونزا الموسمية، والسّارسْ، ومرض السكري، والصداع النصفي، والألم والفقر، وغيرها. وهذا ما يصرح به الأطباء الكبار وكأنهم غُلِبوا، وكأن الأمر أصبح قدرا مقدوراً.
وإذاً، لِمَ أقلقُ راحة الثقافة، وأجُرُّها إلى مجال ومضمار لا يندرج في وارِد وصميم انشغالها وانهمامها؟. وَهَبْ أنني نجحت في الاحتيال على إدخالها المضمار والمجال، وإيلاجها سَمَّ الخياط، فماذا هي فاعلة، وكيف، وبأي ثمن قبل أن ترتد إلى دارتها النبيلة المشرقة المحوطة بالقيم الخالدة، والمثل العليا، خُلْواً من العدوى، والرشح الأنفي، وانحباس التنفس، وضيق الصدر، والسعال، وخفقان القلب، والموت في المحصلة؟
بالإمكان القول إن الثقافة وهي تواجه الوباء، وتتصدى له بطريقتها، وأدواتها، إنما تواجه الطبيعة. ويزداد الأمر استشكالا وانغلاقا إذا علمنا أن الفيروس الفتاك هذا، ذوطبيعة غامضة مستعصية يتأرجح معناها الانوجادي بين معنى انتقام الطبيعة لنفسها، وبين معنى أن يكون مصدره حيوانا ما، أو صنيعة يد آثمة، ونتيج علم يراد به المحو والتدمير.
لكن، دعنا عند السطح ـ من دون إيغال في التعالم والغوص والاستقصاء ـ لنقول إن الثقافة تواجه الطبيعةَ، لأن الطبيعة عانت معاناة شديدة منذ أن غزاها الإنسان مسلحا بالعلم والتقنية والجشع. وكانت ساكنة هادئة حنونا تعطي من غير مَنٍّ ولا حساب. فانتفاضها الذي تعلن عنه، بين الفينة والأخرى، ماهو ـ في النتيجة ـ سوى محاولة رد ابنِ رَحِمِها الإنسان، إلى رشده وصوابه، والكف عن غيّه ورعونته وجنونه.
وعلى الرغم من أن كوكبة منيرة من الشعراء والأدباء والمفكرين، والفلاسفة، والموسيقيين، والتشكيليين، حذرت ـ في ما كتبتْ وطرحت وأبدعتْ، وصدحتْ ـ من مخاطر وأهوال الصناعة والتصنيع، والتبضيع، والتسليع، والمَكْنَنَة، والتَّكنجة، والرَّبْوبَة وما يترتب عليها من أعطاب وإفقار وشرور، وإدقاع للكثرة الكاثرة من بني الإنسان، فإن عجلة الاختراع، والذكاء الاصطناعي، والاكتشافات، وغزو أعماق البحار، وباطن الأرض، والفضاء الكوني بعامة، لم تتوقف لحظةً، بل استمر تزييتها وتصليحها، وتبديعها أكثر لتعطي أوفر، وما ضَرَّها إذا طحنت في طريقها، الحجرَ والشجرَ والطيرَ، والبشرَ.
هي ذي الثقافة التي نواجه بها الجائحةَ، لا بالدعاء عليها بالويل والثبور، بل بالقضاء المكين عليها عن طريق العلم والبحث الطبي الدؤوب، وبوجوب إيقاظ الضمائر النائمة أو المنومة، وتشكيل جبهة ثقافية كونية بكل اللغات والتعبيرات، تعيد الاعتبار للإنسان، مطلق إنسان بتوفير الطعام لكل فم، والدواء لكل داء، والسكن اللائق للفقير والمُقْتَلع، والخيرات التي يعج بها الكون، للقاصي والداني، للساكن في القرى والبوادي، والمدن، يستوي في ذلك، جنوب الكرة وشمالها. إذْ أبانت الجائحة الكونية الرهيبة عن استمرار الفروق بين الناس، وانحفار الهوة أكثر، وارتفاع حصائل الهجرة والضياع والفقر، واستشراس الظلم والاحتكار والاحتقار والانتحار.
ولنا في ما نكتبه اليومَ من شعر ورواية، وقصة، ومسرح، وفكر، وما نغنيه من أغانٍ، وندونه من موسيقا، ونرسمه من لوحات تشكيلية، وما نعرضه من أفلام سينمائية متنوعة، وما كتبه أسلافنا: أرحاما، وأشباها، ومواطنين، وأغياراً، بكل اللغات، لنا فيه ما يدفع خطر الجائحة، ويبعد شبحها المخيف والمهدد، ويُرَغِّبُنا في العيش المشترك، في المحبة الكونية، والتقدير المتبادل، والاختلاف الغني، والسلام العام المهيمن، وتقاسم النعم والآلاء والخيرات في ما بيننا.
إن كوكبنا الأزرقَ يغرق رويدا.. رويداً في وَهْدة سحيقة، وهدةٍ بلا قرار، وما لم نتكاتفْ ونتساندْ، وندكَّ أسباب ودواعي التفرقة والخلافات المفتعلة، فإن الجائحةَ ستستمر كاشفةً ـ في كل مرة وكَرَّةٍ ـ عن وجهها البغيض، لا بسةً دروعاً واقية لا يؤثر فيها لا سيوف ولا رصاصٌ ولا متفجر، ولا دواء ولا دعاء. إنها جائحة الظلم والتبعيد، والتبغيض، والأنانية المقيتة، والمركزية الصَّلِفَة، والشمس البشرية المُدَّاعاة والمُفْتَراة.
الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 07/01/2022

الثقافةُ في مواجهة الوباء - AL ITIHAD
( إن كل شيء في الطبيعة غنائيٌّ في جوهره المثالي، مأساويٌّ في قَدَرِه، هَزْليٌّ في وجوده ) الفيلسوف الأمريكوـ إسباني:
alittihad.info