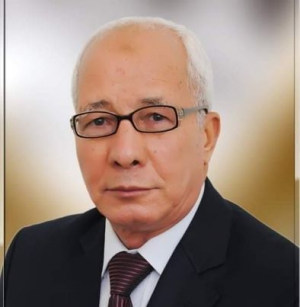رابعاً: جغرافية الأطلال المرقسية:
إن الذي يحاول من الدارسين والباحثين أن يحلّل الوسط القبلي، عن طريق قراءة الشعر، وقراءة الطلليّات المعلقاتية بعامة، والطللية المرقسيَّة بخاصة؛ يلاحظ، إذا توحّدت ملاحظة مع ملاحظتنا، أن الأحياز التي كانت تشكل هذا الذي يسميه الانتروبولوجيون وعلماء الاجتماع "الوسط": تتسم بالجمالية مما يجعلنا، ونحن نُعْنَى بمُدارَسَةِ هذا الحيز الجغرافي وتحليله ومحاولة فهمه -خصوصاً- أثناء ذلك، نذهب إلى أن هذه الجمالية الحادة نتحسسها لدى عامة المعلقاتيين في تعاملهم مع الحيز ونظرتهم إليه.
وعلى الرغم من أن هذه الأحياز التي تصادفنا في قراءة هذه الطلليات هي أمكنة جغرافية، كما ثبت ذلك في معاجم البلدان العربية، وهي سيرة كانت ذهبت بنا إلى حقل الانتروبولوجيا، في وجه من هذه الدراسة، ما دامت هذه الأحياز أمكنةً، ومِياهاً، وودياناً، ومراعي، وجبالاً، وروابي، وقفاراً مُقْوِيَةً. وما دامت هذه الأمكنة بجذاميرها تشكل وسطاً تقليدياً تجري فيه الحياة على أبسط ما تكون من البدائية، وتجري فيه العلاقات بين الناس على أساس رابطة القربى (نظام العشيرة)، وهلم جرا...
فإن مُدارَسَتِها، كما نرى، تندرج ضمن حقل الأنتروبولوجيا.
ولكن، هل يمكن تحديدُ منزلِ حبيبة امرئ القيس، أو أنثاه، من خلال بعض الإشارات الجغرافية المقتضبة طوراً، والغامضة طوراً، والمُورَدَة تحت الشك طوراً آخر()؟ إن المعلومات التي احتفظ لنا بها معجم ياقوت تميل إلى أن كلاً من "الدَّخول، وحومل، وتوضِحَ، والمقراة، مواضع بين إِمّرة، وأَسْوَد العين"(). لكن ما المعرِّفُ به، بأوضح من المعَّرف، وإذاً، فأين تقع إِمّرة هذه، وأسود العين هذا؟
يذكر ياقوت الحموي أن "امّرة الحمى لغنى وأسد، وهي أدنى حمى ضربة أحماه عثمان لإبل الصدقة. وهو اليوم (بالقياس إلى يوم ياقوت) لعامر بن صعصعة"(). بينما يعدّ أسود العين عبارة عن "جبل بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكة"().
ونلاحظ أن هذين المكانين الشهيرين اللذين عرّف بهما السُكّريُّ، لدى شرح بيتي امرئ القيس الأوليْن في معلقته:
1- أن أحدهما، وهو امّرة، مجال فسيح، ومرعىً خصيب، وكأنه لم يكن مملوكاً لأحد، ولذلك أحماه عثمان بن عفّان رضي الله عنه لإبل الصدقة. وربما كان قبل ذلك لغنى وأسد، ثم زالت مُلكيتها عنه. ويدل إحماءُ عثمان لإمرة ووقْفُها على إبل الصدقة أن هذا الرَّجَا من الأرض كان منقطعاً على نحو ما من العمران مما كان يجعله لائقاً للرعي، كما كان معشوشباً مُمْرِعاً، وهو سبب آخر لجعله أليق للرعي. ونلاحظ أن الحموي لم يومئ إلى مائية هذا المكان الذي كأنه كان بادية قاحلة.
2- وأن أحَدَهُما الآخر جبل بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكّة، ويبدو أنه مرتفع شامخ، من أجل ذلك قال الشاعر فيه:
إذا ما فقدتُمْ أَسْوَدَ العَيْنِ كنُتمُ = كِرَاماً، وأنتُمْ ما أقَام أَلائِمُ()
وإذا كان هذان المكانان (المرعى والجبل) اللذان عَرَّفَ بهما السكرى الأماكن الخمسة التي وردت في بيتي امرئ القيس ليس لهما في معجم الشهرة والذيوع لدى الناس ما يجعلهما حقاً صالحين لشرح غيرهما؛ فإن الطمع في تحديد مواقع سقْطِ اللِّوى، (وتحدث كثير من القدماء عن "السِقْطِ" على أنه "منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه" ()، وعن "الِلِّوَى" على أنه "رمل يعوج ويلتوى"(). فكأنه، إذاً، غَيْرُ مكانٍ؛ وإنما هو وصفٌ له، وتحديدٌ لتضاريسه؛ ولكن كيف يوصف مكانٌ لا مكانية له؟ إننا نعتقد أنه موضع يقع، من الوجهة الجغرافية، بين الأمكنة الأربعة الأخراة) والدخول، وحومل، وتوضح، والمقراة، يُعَدُّ من العسر بمكان بعيد. ولكننا من خلال بحثنا عن هذه الأماكن في معجم البلدان لياقوت، ولم نكد نعثر إلاّ على مكان "توضح" في سَوَائِه()، كما لم نستطع العثور في جميع المظان التي بمكتبتنا على تعريف أو ذكر لمكان "سقط اللوى"، فاقتنعنا بأنه كان مجرد مَعْبَرٍ عَرَضي نزل به أهلُ امرأ القيس هذه زمناً، ثم زايلوه إلى الأبد فباد ذكره، ودرس أثره إلاّ في هذا البيت المرقسي العجيب. والآية على أن هذا الموضع كان مغموراً مجهولاً، لدى عامة العرب، وقل لدى عامة الجغرافيين العرب، أن امرأَ القيس أُضْطُرَّ إلى أن يذكر، على غير دأب الشعراء في تحديد مواقع الأمكنة أو ذكرها، أربعة مواضع أخراة يبدو أنها كانت أشهر وأعرف لدى الناس من هذا المكان "السحري": سِقْط اللِوى؛ فجعله بينها مجتمعةً تحْدَوْدِقُ به ؛ فكأنه تعريفٌ قانوني يشمل الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية، على دأب الذين يكتبون عقود تمليك الأرض()
ونحن نعتقد أن سِقْط اللِوى، هذا، لم يَكُ، بأي وجه، مُسْتَقَراً ومُقاماً لأهل أنثى الشاعر؛ وإنما كان في الغالب مَرْعىً جادت به عليه السماء فمر به القوم فمكثوا فيه إلى حين إجهاد ما كان فيه من كلأٍ، ثم تحملوا عنه إلى سوائه...
والآية على ذلك أن معاد الضمير في قوله: "لما نسجتها" اختلف النحاة في تخريجه، ومنهم أبو الحسن، وأبو علي الفارسي: فهو إما يعود على "المقراة"، وإما يعود على المواضع الخمسة كلها(). فالعجب من شاعر يذكر حبيبة ويربطها بمكان محدد، ثم لايكاد يمضي إلى البيت الموالي حتى يتنكر لذلك المكان فيهمل إعادة الضمير عليه، وينصرف إلى سَوائِه. فما أنسى الشاعر سِقْط لِوَاهَ؟ وما أعجله إلى سواه؛ والحال أن أنثاه كانت تحيا في الموضع الأول، ولم تذكر المواضع الأربعة الأخراة إلاّ على سبيل التعريف به، والتحديد له؟ فما هذا الإشكال؟ إلاّ أن يكون "بين" في بيت امرئ القيس وارداً بمعنى المصاحبة أو العطف، فنعم. ولكن لا أحد من النحاة يجعل "بين" بهذا المعنى، فماذا؟
كأن هناك سَقْطاً في الكلام، ضاع من الرواة، وقع لِمَا بعد "سِقْط اللِوى"؛ وإلاّ فكيف يتحدَّث الناص عن مكان، ثم يعيد الضمير على سواه، في حيز ضيق من الكلام؟ هل يعقل أن تكون الأمكنة الخمسة بجذاميرها دارِسَةً عافيَةً، ومُقْفِرَةًً بالية، والحال أن البكاء إنما كان ينصرف، أصلاً، إلى المكان الأول، إلى سِقْط اللِّوى، لا إلى الأمكنة التي يقتصر دورها، في ظاهرة الدلالة، على مجرد التعريف به؟ وما جدوى ذِكْرِ الأمكنة التالية واّتِرَاك المكان المقصود، المكان الذي كان يُؤوي منزل الحبيب؟ ومهما يكن من شأن، فإن هذه الحبيبة، فيما يبدو، لم تك إلا ورقيّة، إذ نلفي ذا القروح يفرغ لوصف النساء الحقيقيات، فيما بعد من معلقته، فيذكر بعضهن بأسمائهن (فاطمة -أم الرباب -أم الحويرث -عنيزة (ولعلها غير فاطمة، وهو ما يزعمه الرواة) ويعفّ عن ذكر أسماء الأخريات. وقد ألفيناه يبدع في الوصف الجسدي المفصل: للشعر، والكشح، والساقين، والترائب، والبشرة، والخد، والعينين، والجيد، والأصابع، والقامة الفارعة...
وكل ذلك إذا صَدَّقنا، وسنكون إذاً سُذَّجاً، أن معلقة امرئ القيس (والطللية التي نحن بصدد تحليلها طرف منها)، كما أَثْبِتَتْ في المتون، وكما تداولها حَمَّادٌ وخَلَف، هي حقاً كلها من حُرِّ شعره، وخالص إبداعه، وأنها، إذن، استطاعت أن تُفْلِتَ من عبث الرواة المحترفين الذين كانوا يتزيدون في الأشعار، وخصوصاً منهم حماداً الراوية الذي عاث في الشعر الجاهلي فساداً فلا يَصْلُحُ بعده أبداً، مع أنه "كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها (....). وكان غير موثوق به، وكان ينحل الرجل غيره، وينحله غير شعره، ويزيد في الأشعار"(). وكان حبيب بن يونس لا يبرح يردد، في حيرة وحزن: "العجب ممن يأخذ عن حمادٍ، وكان يكذب...."(). وقد حاولنا أن نتتبع آراء النقاد الأقدمين في حماد الراوية وخلف الأحمر، حول كذبهما وزيادتهما في أشعار الناس، وذلك فيما لدينا من مصادر محدودة في مكتبتنا الشخصية، فبلغ ذلك تسعة مصادر على الأقل لكل منهما().
وعلى الرغم من أننا سنتناول هذه المسألة في مقالة مستقلة، وسنُعيدُها ببعض ذلك جَذَعَةً؛ فإننا نلاحظ أن هناك مكرراتٍ في معلقة امرئ القيس، كتكرار بعض الأوصاف الجسدية أكثر من مرة واحدة، وذلك على أساس أن الذي يكذب يَنْسى، وأقصد كَذَبَة الرواة. ولو كانت كلها من حر قوله لما كررت هذه الأوصاف وذلك على غرار ما نلفيه من تكرار الكشح مرتين، والساق مرتين، والتشبيه بمصباح الراهب مرتين... كما نلاحظ هذا الاختلاف الشنيع بين روايتي الزوزني، والقرشي، فالقرشي يضيف آباييت كثيرة لم يذكرها الزوزني، وخصوصاً في المطلع الطلليّ مما يدل على عبث حماد الذي يعود معظم الشعر الجاهلي وروايته إليه، وقد عرفنا ما قال فيه قدماء العلماء....
ومهما يكن من شأن، فإننا استطعنا أن نعرف، بفضل ياقوت الحموي، أن موضع الحومل لا تحديد لموقعه، ولا لصفته، وهل هو ماء، أو جبل، أو مرعى، وإنما سمي حوملاً "من الحمل لَمّا كثر التحميل"() منه، وأن "الدَّخول اسم واد من أودية العلية بأرض اليمامة" ()، وأن هذا الدَّخول، لدى نهاية الأمر، هو من مياه عمرو بن كلاب. وزعموا أنه كان بئراً نميرةً كثيرة الأمواه()، وأن هناك دَخولاً آخر ذُكِرَ في قول شاعر من شعرائهم، ولكنه لم يكُ دَخُولَ عمرو بن كلاب، وإنما كان ماءً لبني العجلان(). كما أن هناك توضح آخر باليمامة يقول فيه شاعرهم:
أيا أثلاثَ القاعِ من بَطْن تُوضِحٍ = حنيني إلى أَفْيائِكُنَّ طويلُ()
ويبدو أن هذا الموضع كان قرية من قرى أرض قرقري الخصبة التي كان "فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة"()،وأن توضح والمقراة "قريتان من نواحي اليمامة"().
وقد يَسْتبين من خلال هذه التلميحات أن سقط اللوى كان بين أماكن تتسم بشيء من الخصب، وأن تلك المواضع كانت مواقع مياه كان العرب يتقصدونها. ولم نستطع التوصل إلى أكثر من هذه النتيجة، إنْ حقّ أن يكون مثلُ هذا نتيجة!
خامساً: جمالية الحيز الطللي:
لانحسب أن الناص ذكر هذه الديار، وأومأ إلى هذه الآثار، وهو في معرض سَوْقٍ لذكريات جميلة بادت، وأزمنة قشيبة بَليتْ، وفتيات فاتنات الملامح، بَضَّات الترائب، سود الجفون، أسيلات الخدود، نحيلات القدود، ضامرات الكشوح، مستشزرات الشّعور: ثم لاَ يقْرِن تلكم الذكريات بالجمال البديع، ولا يربطها بعهد الشباب الجديد، ولا يغمسها في غدران وعيون، لَتَترَهْيَأَ من بعد ذلك بين الرياض والزروع. فالحبيب هنا يعني امرأة، والمرأة قد تعني مجرد أنثى، ولكنّ أُنثِيَّتها() هي التي، ربما، تضفي عليها شعاع الحب، ويعني الحب حزماً من الذكريات المتراكمة؛ وتعني الذكريات هذه الأسقاط من الأزمن العائمة في أحياز الأمكنة التي تشكل، لدى نهاية الأمر، متضافرةً بجذاميرها، شحناً من التمثلات التي تعتور الذاكرة، أو تتواثب في مجاهلها الشاسعة؛ كلما حدث حنين عارم إلى ماضٍ غابر، أو دعا داعٍ إلى نبش معيش الأمس الدابر.
ذلك بأننا نذهب إلى أن هذه الأحياز، أو هذه المواضع التي أراد الناص أن يتخذها مسرحاً لعرض بعض ذكرياته العذاب، في بعض هذه الأبيات الشعرية الوحشية، أو العذرية، أو الغجرية: هي في معظمها مياهٌ للعرب كانت معروفةٍ لديهم، مثل الدخول الذي كان وادياً جارياً، ولا يعقل أن يكون هناك وادٌ في بلاد العرب، أو في بعض بلاد اليمن، ثم لا ماء فيه. فعهدنا بتلك الأودية السحيقة مسايل للماء، ومجارٍ للسيول، ومدافع للعيون. فكان فيها ظل وماء، وفيها دفء واعتدال. ولأمر ما ألفينا شجر البن يخضر فيها وينضر، ثم يزهر ويثمر، فتراه يتخذ منابته المخضوضرة في جنبات تلك الأودية السحيقة التي لا نكاد نلفي لها مثيلاً في العالم: الظل، والماء، والاعتدال الدائم على وجه الدهر.
ولا يقال إلا نحو ذلك في توضح والمقراة اللتين كانتا قريتين من نواحي اليمامة(). ولا يعقل أن تكون قرية يقطنها الناس، ولا يكون فيها ماء و لامرعىً ولا شجر، ولا يكون بِدِمنَها وعرصاتها، ومرتفعاتها وقيعانها، نَبْتٌ ولا كلأٌ ولا اخضرار. إن ذِكْرَ المواضع الغانية، لا يمكن إلاّ أن ينشأ عنه الحد الأدنى من التصور الجمالي المتجسد في ضرورة وجود الماء الذي يفضي بالضرورة إلى وجود الشجر والزرع الذي يفضي بالضرورة إلى وجود الحياة الغانية التي تفضي بالضرورة إلى التخاصب والتزواج والتعايش والتحابّ.
فلا يترعرع الحبّ إلا في ظل شجر، وحول ماء جارٍ، وفي وادٍ ممرع، ووسط مخصب؛ إذا لم تكن بلاد العرب كلها مجرد رمال قاحلة، وسوافٍ عاصفة؛ فإن فيها مواضع ليس أجمل منها على الأرض...
ونريد أن نتوقف لدى ضربين من الحيز ونحن نحاولُ مُدارَسَةَ جماليَّاتِهِ، في بعض هذه الأبيات الستة:
الحيز بين الانتساج والانتساخ، والحيز الأخضر، عافّيِنْ عما بقي من أضربه إلى حين.
1- الحيز بين الانتساج والانتساخ:
يصادفنا في طللية امرئ القيس حين يتحول من حال إلى حال، ومن وجه إلى وجه، في إفراز الجمال، فترى سطحه ينتسخ، وشكله ينتسج؛ وذلك بفعل انتساج الرمال وحركتها الناشئة عن عصف الرياح، وهبوب السافيات. فتلك الأحيازَ قاومت الطبيعة بالطبيعة، وقل: إنّ الطبيعة العذراء هي التي تقاوم ذاتها، فانْتَسأ العفاءُ بفضل الرياح التي كانت تذرو الرمال على هذا الوسط الصحراوي العجيب:
لم يعف رسمُها* لما = نسجتْها من جَنوب وشَمأَلِ
ويبدو أن حركة الانتساخ الرملي التي كان ينشأ عنها مناظرُ عاريةٌ عجيبة كانت تتم تارة بفعل هبوب الرياح من الجنوب نحو الشمال، وتارةً أخراة بفعل هبوب الرياح من الشمال إلى الجنوب.
ونلاحظ أنّ الحيز الشعريّ هنا لا يزال يبدّل سطحه، ويغيّر وجهه، كلما هبت عليه الرياح؛ وكلما سكنت عنه، أيضاً، هذه الرياح. والتبدل الذي يعتوره إنما كان يتمّ بفعل حركة الرياح وسكونها معاً. وواضح أن الحيز هنا ذو لونٍ أصفر ضاربٍ إلى الحُمْرة، لأنه لون الرمال. وهو حيز، إذاً، أغبرُ أشعث لأنَّ السوافي لم تبرح تثير مادّته هذه فتفعل فعلها فيما حَوالَها، ومن ذلك حيلولتها بين هذه الأطلال والدروسَ فلا تَدْرُسُ؛ فإذا هي باقيةٌ قائمة، محتفظة بأهم مما كان فيها من أثافي القدور، ومن معاطن الإبل، ومن حظائر الغنم، وربما من مرابط الخيل: أطلال كأنها ليست أطلالاً، وكأنّها لا تبرح غانية كما كانت بالأمس.
2- الحيز الأصفر وملحمة الألوان:
إن اللون الأصفر، وقل اللَّون الأدكن؛ اللون المتشكّل في أصله من لونين اثنين أصفر وآخر أحمر، أو قريب من الحمرة: كان يتلاقى مع لون آخر يماثله، أو يقترب من مماثلته؛ وهو لون الشمس المتمثّل في أشعّتها المذّهبة العجيبة. فكان لون سطح الأرض يمتزج بلون آخر آتٍ من نحو العلاء: فيذوب اللون في اللون، ويتزاوج الشكل مع الشكل، فيُحْدِثان ملحمة عبقرية طبيعية من الألوان الساكنة الناعسة، وهي ألوان ما تَحْتَ، والألوان المتحركة المتحفّزة وهي ألوان ما فوق.
وكانت هذه الألوان لا تلبث، هي أيضاً، أن تنتسخ وتنتسج تبعاً لما يعتورها من شعاع وفَيْءٍ، وضياء وظلّ؛ فإذا بعضُها مصفرٌّ فاقع يشّع من بعيد فيبهر البصر، ويسحر الجنان؛ وإذا بعضها داكن خامد، كأنه سكون نائم، أو منظر عائم؛ لأنه وقع تحت ظلّ الشمس؛ ولأنّ سطحه كان متعالياً بعضه على بعض بحكم أنّ السطح لا يكون في كلّ الأطوار ممتدّاً لا عوج فيه ولا أمت، ولا ارتفاع ولا انخفاض؛ وإنما تراه في كثير من أطواره السطحية مرتفعاً بعضه، ومنخفضاً بعضه، ومنبسطاً بعضه الآخر، فإذا هو يشكّل أضرباً من الحيز الداكن الخامد وهو الواقع تحت سلطان الظلّ؛ وأضرباً أخراةً من الحيز المصفّر المشعّ، وهو الواقع تحت سلطان الشمس المتوّهجة.
وكان هذا الحيز الملحميّ لا يلبث أن ينفلت من هذين الشكلين ليجّسد شكلاً ثالثاً هو الشكل المغبرّ المتكوّن من حبّات الرمال المتطايرة حين تذروها السوافي فتتناثر فيما حوالها من الفضاء شظايا. وهو شكلٌ حيزيٌّ بمقدار ما هو مذهلٌ مريع، بمقدار ماهو غجريّ وحشيّ، يجسّد الطبيعة في عذريتها، وعبقريّتها وتغيّرها، وانتساخ مظهرها تبعاً لما يعتور أطوارها، ويخامر أحوالها.
ومن الواضح أنَّ هذا الحيز -الثالث- متحركٌ لا ثابت، ومتناثر لا ساكن؛ وهو الذي كان يفضي بسطح الرسوم المرقسيّة السحرية إلى أن تظلّ باقيّةً غير فانيةٍ، وقائمة غير ذاهبة؛ وكلّ أولئك أمور حدثت بفعل انتساج الرمال التي إنّما تناسجت، هي أيضاً، بفعل هبوب السوافي عليها تارة من تلقاء الجنوب، وتارة أخراةً من تلقاء الشمال؛ في حركة كأنها دائبة، ونشاط كأنه أزليّ. وكأنّ كلّ أولئك إنما كان لأجل حفظ الحيز الأصليّ الثابت من أن يَبْلى ويَدْرُسْ.
فهل يمكن أن يوجد أسحر وأبهر من هذا الحيز الثلاثي الأشكال، المركّب الألوان، المتغيّر الأطوار، من حال إلى حال؟
3- الحيّز الأخضر وملحمة الجمال العذريّ:
يصادفنا في هذه الطللية العجيبة ضرب من الحيز يتّسم بجملة من المظاهر المفضية إلى تشكيل ملامح من الجمال تتضافر بجذمورها لتبدع لوحة طبيعة عبقرية، وتتمثّل خصوصاً في :
أ- بعر الآرام:
إنّا لنعلم أن بَعَر الآرام، وتواثب الأرانب، وغناء الطير، ونحوها: بمقدار ما تدلّ على وحشيّة المكان وإقفاره، تدلّ على خصبه وإمْرَاعِهِ، وتواجد الخضرة فيه، في الوقت ذاته. سواء علينا أكانت تلك الخضرة ناشئة عن مياه المطر، أم عن مياه الغدارن والعيون؛ فإنها في الحالين الاثنتين تدلّ على الخصب والإمراع. إذ لا ينبغي أن يكون بعرٌ إلا بارتعاء؛ ولا ارتعاءٌ إلاّ لعشب أخضر.
إنّا؛ حقاً، لو قرأنا "بعر الآرام"، تقليديّاً، لما انتهينا إلى شيء مما زعمناه، ولكانت قراءتُنا إيّاه على مقتضى السابقين؛ وإذاً لما كان لقراءتنا وجوبٌ ولا غناءٌ. ولكننا نحن سخّرنا في هذه القراءة التأويليّة ما نطلق عليه "الحيز الخلفيّ" الذي أفادنا بالتسلسل الذهني بهذا الذي استنتجناه من قراءة هذه العبارة. إنّ بعر الآرام، فعلاً، وحقّاً، وانطلاقاً من سياق النص، يسبّب شبكة من المعطيات الدلالية التي تفضي حقاً إلى بعض ما اهتدينا إليه.
ب- العَرَصات:
تعني العرصات في اللغة المعجميّة الملاعب والمغاني التي تحدودق بالمنازل، وتحيط بالدور. فهي من هذه الوجهة تحيل على حيز مرتبط بعمران كائن أو كان. فكأنّ العرصات عبارة عن مساحة مخضرة ممتدّة يسرح مع خضرتها الطرف، وتمتدّ مع امتدادها العين المبهورة بعبقرية الطبيعة ورونقها وأناقتها. فهذه الآرام التي يُتَحدَثُ عنها تمثل مع هذه العرصات وسطاً طبيعياً عذرياً ، أو متوحشاً غجرياً، لمَّا تُهذّبه مهذّبات الحضارة بالتضيع والتغيير. فهناك إذن الخضرة؛ وهناك إذاً ما يعيش في أحضان هذه الخضرة (الآرام)؛ وهناك من يحسُّ بهذه الخضرة العرصاتية، أو يمتزج بها، أو يندمج فيها بشعور أو بدون شعور.
ج- وقيعانها:
لو لم يتحدث النصّ عن القيعان بعد العرصات لحقّ لنا أن نتأوّل هذا الحيز على أنه وَعْرٌ حَزْنٌ، وعلى أنه شاهقٌ عالٍ، ولكنه حين أعقبه بـ "القيعان" أسْتَبان أنّ هذه العرصات المرقسيّة كانت تَخْضَوضِرُ فتمتدّ ظلالها في كل اتجاه، ولعلها كانت تتربّع في قيعةٍ من الأرض حيث إنها مظنونةٌ باحتقان الماء.
ولا نعتقد، لمن سيعترض علينا، بأنّ تلك القيعان كانت مجدبة، وأن تلك الآرام كانت تتواثب وتتلاعب في مجرّد الرمال القاحلة. كما لاينبغي أن ينصرف الوهم إلى أنّ الحيز الشعري الجميل الذي كان يحنّ إليه امرؤ القيس، ويتلذّذ بذكراه، كان مجرد قفر عجيب. وإلاّ فبم كانت تلك الآرام تقتات؟ وأين كانت من شجر الأراك؟ ثم أين كانت تختبئ لتتّقي عدوان القنّاصين المتربّصين بها؟ ثم من سيستطيع أن يثبت لنا بأن حيز امرئ القيس المتحدّث عنه هنا كان مجرد رمال جافّة، وحجارة صلدة، ومناظر موحشة؟ وما القول في العرصات، والسّمرات، والآرام، والمنزل...؟
د. سَمُرات الحيّ:
قد تكون هذه السَمُرات مجرد بيان للعرصات المتقدمة الذكر، وذلك من الوجهة الوصفية الخالصة، لكن من الوجهة الدلالية تعني، أو قد تعني أنّ الشأن منصرف، هنا، وفعلاً، إلى طبيعة مخضرّة عذراء؛ وأنّ الاخضرار لم يَكُ، ربما، وقفاً على ما ابتعد عن الحيّ وانتشر حَوَاله من فضاء يبدو كأنه مريع؛ وإنما نلفيه أيضاً يوفر، ربما، في هذا الحيّ الذي تباسَقَتْ سَمُراته المخضرّة فتَرَهْيَأت أغصانها المورقة فامتدّت أفقياً وعمودياً: فنشأ عنها شيء من الظلّ والنّعمة والرّغد...
ونلاحظ أنّ خضرة العرصَات كأنها وقفت على الآرام وما كان يشبهها من حيوانات وحشية كالذئاب وسوائها؛ بينما خضرةُ السَّمُرات وقفَتْ هنا على الإنسان يتظلّل بظلّها، ويتنسّم بنسيم أغصانها المصطفقة، وفروعها المتراصة. فعلاقة الطبيعة انصرفت في الحال الأولى إلى مجرد حيوان، بينما انصرفت في الحال الأخراة إلى الإنسان.
هـ- رسْم دارس:
لعلّ من عجيب المفارقات، ولطيف المباعدات، أن يغتدي الخراب اليباب مظنّةً للجمال البديع، ومقصدةً لاستعادة الذكريات العذاب. فالرسم الدارس من حيث هو ديارٌ بالية، وبنايات متهدّمة: لا جمال فيه، ولا إلهام منه، ولا سعادة تجثم حَوالَه. بيد أنّ الذي جعل من جَلاله جمالاً، ومن شقائه سعادة، ومن وحشته أُلفَةً، ومن بشاعته نُضْرَةً؛ هو تلكم الذكريات الجميلة التي كان يطويها في نفسه، وتلك العلاقات العاطفية الكريمة العارمة، وتلكم الأزمنة التي قضّاها أناسٌ فيها حتّى ضجّت بهم، وغصّت بوجودهم: ما بين ذاهبٍ وآتٍ، وخارج وداخل، وسارٍ وقائمٍ، ويقظان ونائمٍ، ومفارق ومُوامقٍ، ومُغاضِب ومعانق... حياة على الشظف رغيدة، وعلى الاضطراب وديعة، وعلى الشقّاء سعيدة.... الحبّ والشعر، والشعر والحب، على الرغم من كلّ المهدّدات التي كانت تمثّل في الإغارات المشنونة، والحروب المستعرة...
أو لم يكن فيما توقفنا لديه من هذه المنازل القائمة، والمغاني الممرعة، والقيعان المخصبة، والعرصات المخضوضرة، والسّمرات الباسقة، والرسوم الدارسة الموقورة أطلالها بالأسرار والألغاز، والمشحونة رواكدها برسيس الذكريات العذاب: ما يجعل هذه الأخبار طافحاً جمالها...؟
***
ولمّا كنّا نعلّق شأناً مهماً على مدارسة الحيز وتحليل أنواعه في هذه المعلّقات، فإنّ ما عرضنا له في نهاية هذه المقالة يحملنا على عقد مقالة بحذافيرها لجمالية الحيز في المعلّقات، من حيث هو، وليس من حيث هو طلل، وهو الأمر الذي حاولنا أن نعوج عليه معاجاً عجلاً في نهاية هذه المقالة. حقاً، أنّ الطلل ينضوي تحت مفهوم الحيز، بامتياز، ولكنّ للطلل شأناً آخر ينصرف إلى سير أخراة اجتهدنا في أن نعرض له في القسم الأكبر من هذه المقالة.
إن الذي يحاول من الدارسين والباحثين أن يحلّل الوسط القبلي، عن طريق قراءة الشعر، وقراءة الطلليّات المعلقاتية بعامة، والطللية المرقسيَّة بخاصة؛ يلاحظ، إذا توحّدت ملاحظة مع ملاحظتنا، أن الأحياز التي كانت تشكل هذا الذي يسميه الانتروبولوجيون وعلماء الاجتماع "الوسط": تتسم بالجمالية مما يجعلنا، ونحن نُعْنَى بمُدارَسَةِ هذا الحيز الجغرافي وتحليله ومحاولة فهمه -خصوصاً- أثناء ذلك، نذهب إلى أن هذه الجمالية الحادة نتحسسها لدى عامة المعلقاتيين في تعاملهم مع الحيز ونظرتهم إليه.
وعلى الرغم من أن هذه الأحياز التي تصادفنا في قراءة هذه الطلليات هي أمكنة جغرافية، كما ثبت ذلك في معاجم البلدان العربية، وهي سيرة كانت ذهبت بنا إلى حقل الانتروبولوجيا، في وجه من هذه الدراسة، ما دامت هذه الأحياز أمكنةً، ومِياهاً، وودياناً، ومراعي، وجبالاً، وروابي، وقفاراً مُقْوِيَةً. وما دامت هذه الأمكنة بجذاميرها تشكل وسطاً تقليدياً تجري فيه الحياة على أبسط ما تكون من البدائية، وتجري فيه العلاقات بين الناس على أساس رابطة القربى (نظام العشيرة)، وهلم جرا...
فإن مُدارَسَتِها، كما نرى، تندرج ضمن حقل الأنتروبولوجيا.
ولكن، هل يمكن تحديدُ منزلِ حبيبة امرئ القيس، أو أنثاه، من خلال بعض الإشارات الجغرافية المقتضبة طوراً، والغامضة طوراً، والمُورَدَة تحت الشك طوراً آخر()؟ إن المعلومات التي احتفظ لنا بها معجم ياقوت تميل إلى أن كلاً من "الدَّخول، وحومل، وتوضِحَ، والمقراة، مواضع بين إِمّرة، وأَسْوَد العين"(). لكن ما المعرِّفُ به، بأوضح من المعَّرف، وإذاً، فأين تقع إِمّرة هذه، وأسود العين هذا؟
يذكر ياقوت الحموي أن "امّرة الحمى لغنى وأسد، وهي أدنى حمى ضربة أحماه عثمان لإبل الصدقة. وهو اليوم (بالقياس إلى يوم ياقوت) لعامر بن صعصعة"(). بينما يعدّ أسود العين عبارة عن "جبل بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكة"().
ونلاحظ أن هذين المكانين الشهيرين اللذين عرّف بهما السُكّريُّ، لدى شرح بيتي امرئ القيس الأوليْن في معلقته:
1- أن أحدهما، وهو امّرة، مجال فسيح، ومرعىً خصيب، وكأنه لم يكن مملوكاً لأحد، ولذلك أحماه عثمان بن عفّان رضي الله عنه لإبل الصدقة. وربما كان قبل ذلك لغنى وأسد، ثم زالت مُلكيتها عنه. ويدل إحماءُ عثمان لإمرة ووقْفُها على إبل الصدقة أن هذا الرَّجَا من الأرض كان منقطعاً على نحو ما من العمران مما كان يجعله لائقاً للرعي، كما كان معشوشباً مُمْرِعاً، وهو سبب آخر لجعله أليق للرعي. ونلاحظ أن الحموي لم يومئ إلى مائية هذا المكان الذي كأنه كان بادية قاحلة.
2- وأن أحَدَهُما الآخر جبل بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكّة، ويبدو أنه مرتفع شامخ، من أجل ذلك قال الشاعر فيه:
إذا ما فقدتُمْ أَسْوَدَ العَيْنِ كنُتمُ = كِرَاماً، وأنتُمْ ما أقَام أَلائِمُ()
وإذا كان هذان المكانان (المرعى والجبل) اللذان عَرَّفَ بهما السكرى الأماكن الخمسة التي وردت في بيتي امرئ القيس ليس لهما في معجم الشهرة والذيوع لدى الناس ما يجعلهما حقاً صالحين لشرح غيرهما؛ فإن الطمع في تحديد مواقع سقْطِ اللِّوى، (وتحدث كثير من القدماء عن "السِقْطِ" على أنه "منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه" ()، وعن "الِلِّوَى" على أنه "رمل يعوج ويلتوى"(). فكأنه، إذاً، غَيْرُ مكانٍ؛ وإنما هو وصفٌ له، وتحديدٌ لتضاريسه؛ ولكن كيف يوصف مكانٌ لا مكانية له؟ إننا نعتقد أنه موضع يقع، من الوجهة الجغرافية، بين الأمكنة الأربعة الأخراة) والدخول، وحومل، وتوضح، والمقراة، يُعَدُّ من العسر بمكان بعيد. ولكننا من خلال بحثنا عن هذه الأماكن في معجم البلدان لياقوت، ولم نكد نعثر إلاّ على مكان "توضح" في سَوَائِه()، كما لم نستطع العثور في جميع المظان التي بمكتبتنا على تعريف أو ذكر لمكان "سقط اللوى"، فاقتنعنا بأنه كان مجرد مَعْبَرٍ عَرَضي نزل به أهلُ امرأ القيس هذه زمناً، ثم زايلوه إلى الأبد فباد ذكره، ودرس أثره إلاّ في هذا البيت المرقسي العجيب. والآية على أن هذا الموضع كان مغموراً مجهولاً، لدى عامة العرب، وقل لدى عامة الجغرافيين العرب، أن امرأَ القيس أُضْطُرَّ إلى أن يذكر، على غير دأب الشعراء في تحديد مواقع الأمكنة أو ذكرها، أربعة مواضع أخراة يبدو أنها كانت أشهر وأعرف لدى الناس من هذا المكان "السحري": سِقْط اللِوى؛ فجعله بينها مجتمعةً تحْدَوْدِقُ به ؛ فكأنه تعريفٌ قانوني يشمل الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية، على دأب الذين يكتبون عقود تمليك الأرض()
ونحن نعتقد أن سِقْط اللِوى، هذا، لم يَكُ، بأي وجه، مُسْتَقَراً ومُقاماً لأهل أنثى الشاعر؛ وإنما كان في الغالب مَرْعىً جادت به عليه السماء فمر به القوم فمكثوا فيه إلى حين إجهاد ما كان فيه من كلأٍ، ثم تحملوا عنه إلى سوائه...
والآية على ذلك أن معاد الضمير في قوله: "لما نسجتها" اختلف النحاة في تخريجه، ومنهم أبو الحسن، وأبو علي الفارسي: فهو إما يعود على "المقراة"، وإما يعود على المواضع الخمسة كلها(). فالعجب من شاعر يذكر حبيبة ويربطها بمكان محدد، ثم لايكاد يمضي إلى البيت الموالي حتى يتنكر لذلك المكان فيهمل إعادة الضمير عليه، وينصرف إلى سَوائِه. فما أنسى الشاعر سِقْط لِوَاهَ؟ وما أعجله إلى سواه؛ والحال أن أنثاه كانت تحيا في الموضع الأول، ولم تذكر المواضع الأربعة الأخراة إلاّ على سبيل التعريف به، والتحديد له؟ فما هذا الإشكال؟ إلاّ أن يكون "بين" في بيت امرئ القيس وارداً بمعنى المصاحبة أو العطف، فنعم. ولكن لا أحد من النحاة يجعل "بين" بهذا المعنى، فماذا؟
كأن هناك سَقْطاً في الكلام، ضاع من الرواة، وقع لِمَا بعد "سِقْط اللِوى"؛ وإلاّ فكيف يتحدَّث الناص عن مكان، ثم يعيد الضمير على سواه، في حيز ضيق من الكلام؟ هل يعقل أن تكون الأمكنة الخمسة بجذاميرها دارِسَةً عافيَةً، ومُقْفِرَةًً بالية، والحال أن البكاء إنما كان ينصرف، أصلاً، إلى المكان الأول، إلى سِقْط اللِّوى، لا إلى الأمكنة التي يقتصر دورها، في ظاهرة الدلالة، على مجرد التعريف به؟ وما جدوى ذِكْرِ الأمكنة التالية واّتِرَاك المكان المقصود، المكان الذي كان يُؤوي منزل الحبيب؟ ومهما يكن من شأن، فإن هذه الحبيبة، فيما يبدو، لم تك إلا ورقيّة، إذ نلفي ذا القروح يفرغ لوصف النساء الحقيقيات، فيما بعد من معلقته، فيذكر بعضهن بأسمائهن (فاطمة -أم الرباب -أم الحويرث -عنيزة (ولعلها غير فاطمة، وهو ما يزعمه الرواة) ويعفّ عن ذكر أسماء الأخريات. وقد ألفيناه يبدع في الوصف الجسدي المفصل: للشعر، والكشح، والساقين، والترائب، والبشرة، والخد، والعينين، والجيد، والأصابع، والقامة الفارعة...
وكل ذلك إذا صَدَّقنا، وسنكون إذاً سُذَّجاً، أن معلقة امرئ القيس (والطللية التي نحن بصدد تحليلها طرف منها)، كما أَثْبِتَتْ في المتون، وكما تداولها حَمَّادٌ وخَلَف، هي حقاً كلها من حُرِّ شعره، وخالص إبداعه، وأنها، إذن، استطاعت أن تُفْلِتَ من عبث الرواة المحترفين الذين كانوا يتزيدون في الأشعار، وخصوصاً منهم حماداً الراوية الذي عاث في الشعر الجاهلي فساداً فلا يَصْلُحُ بعده أبداً، مع أنه "كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها (....). وكان غير موثوق به، وكان ينحل الرجل غيره، وينحله غير شعره، ويزيد في الأشعار"(). وكان حبيب بن يونس لا يبرح يردد، في حيرة وحزن: "العجب ممن يأخذ عن حمادٍ، وكان يكذب...."(). وقد حاولنا أن نتتبع آراء النقاد الأقدمين في حماد الراوية وخلف الأحمر، حول كذبهما وزيادتهما في أشعار الناس، وذلك فيما لدينا من مصادر محدودة في مكتبتنا الشخصية، فبلغ ذلك تسعة مصادر على الأقل لكل منهما().
وعلى الرغم من أننا سنتناول هذه المسألة في مقالة مستقلة، وسنُعيدُها ببعض ذلك جَذَعَةً؛ فإننا نلاحظ أن هناك مكرراتٍ في معلقة امرئ القيس، كتكرار بعض الأوصاف الجسدية أكثر من مرة واحدة، وذلك على أساس أن الذي يكذب يَنْسى، وأقصد كَذَبَة الرواة. ولو كانت كلها من حر قوله لما كررت هذه الأوصاف وذلك على غرار ما نلفيه من تكرار الكشح مرتين، والساق مرتين، والتشبيه بمصباح الراهب مرتين... كما نلاحظ هذا الاختلاف الشنيع بين روايتي الزوزني، والقرشي، فالقرشي يضيف آباييت كثيرة لم يذكرها الزوزني، وخصوصاً في المطلع الطلليّ مما يدل على عبث حماد الذي يعود معظم الشعر الجاهلي وروايته إليه، وقد عرفنا ما قال فيه قدماء العلماء....
ومهما يكن من شأن، فإننا استطعنا أن نعرف، بفضل ياقوت الحموي، أن موضع الحومل لا تحديد لموقعه، ولا لصفته، وهل هو ماء، أو جبل، أو مرعى، وإنما سمي حوملاً "من الحمل لَمّا كثر التحميل"() منه، وأن "الدَّخول اسم واد من أودية العلية بأرض اليمامة" ()، وأن هذا الدَّخول، لدى نهاية الأمر، هو من مياه عمرو بن كلاب. وزعموا أنه كان بئراً نميرةً كثيرة الأمواه()، وأن هناك دَخولاً آخر ذُكِرَ في قول شاعر من شعرائهم، ولكنه لم يكُ دَخُولَ عمرو بن كلاب، وإنما كان ماءً لبني العجلان(). كما أن هناك توضح آخر باليمامة يقول فيه شاعرهم:
أيا أثلاثَ القاعِ من بَطْن تُوضِحٍ = حنيني إلى أَفْيائِكُنَّ طويلُ()
ويبدو أن هذا الموضع كان قرية من قرى أرض قرقري الخصبة التي كان "فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة"()،وأن توضح والمقراة "قريتان من نواحي اليمامة"().
وقد يَسْتبين من خلال هذه التلميحات أن سقط اللوى كان بين أماكن تتسم بشيء من الخصب، وأن تلك المواضع كانت مواقع مياه كان العرب يتقصدونها. ولم نستطع التوصل إلى أكثر من هذه النتيجة، إنْ حقّ أن يكون مثلُ هذا نتيجة!
خامساً: جمالية الحيز الطللي:
لانحسب أن الناص ذكر هذه الديار، وأومأ إلى هذه الآثار، وهو في معرض سَوْقٍ لذكريات جميلة بادت، وأزمنة قشيبة بَليتْ، وفتيات فاتنات الملامح، بَضَّات الترائب، سود الجفون، أسيلات الخدود، نحيلات القدود، ضامرات الكشوح، مستشزرات الشّعور: ثم لاَ يقْرِن تلكم الذكريات بالجمال البديع، ولا يربطها بعهد الشباب الجديد، ولا يغمسها في غدران وعيون، لَتَترَهْيَأَ من بعد ذلك بين الرياض والزروع. فالحبيب هنا يعني امرأة، والمرأة قد تعني مجرد أنثى، ولكنّ أُنثِيَّتها() هي التي، ربما، تضفي عليها شعاع الحب، ويعني الحب حزماً من الذكريات المتراكمة؛ وتعني الذكريات هذه الأسقاط من الأزمن العائمة في أحياز الأمكنة التي تشكل، لدى نهاية الأمر، متضافرةً بجذاميرها، شحناً من التمثلات التي تعتور الذاكرة، أو تتواثب في مجاهلها الشاسعة؛ كلما حدث حنين عارم إلى ماضٍ غابر، أو دعا داعٍ إلى نبش معيش الأمس الدابر.
ذلك بأننا نذهب إلى أن هذه الأحياز، أو هذه المواضع التي أراد الناص أن يتخذها مسرحاً لعرض بعض ذكرياته العذاب، في بعض هذه الأبيات الشعرية الوحشية، أو العذرية، أو الغجرية: هي في معظمها مياهٌ للعرب كانت معروفةٍ لديهم، مثل الدخول الذي كان وادياً جارياً، ولا يعقل أن يكون هناك وادٌ في بلاد العرب، أو في بعض بلاد اليمن، ثم لا ماء فيه. فعهدنا بتلك الأودية السحيقة مسايل للماء، ومجارٍ للسيول، ومدافع للعيون. فكان فيها ظل وماء، وفيها دفء واعتدال. ولأمر ما ألفينا شجر البن يخضر فيها وينضر، ثم يزهر ويثمر، فتراه يتخذ منابته المخضوضرة في جنبات تلك الأودية السحيقة التي لا نكاد نلفي لها مثيلاً في العالم: الظل، والماء، والاعتدال الدائم على وجه الدهر.
ولا يقال إلا نحو ذلك في توضح والمقراة اللتين كانتا قريتين من نواحي اليمامة(). ولا يعقل أن تكون قرية يقطنها الناس، ولا يكون فيها ماء و لامرعىً ولا شجر، ولا يكون بِدِمنَها وعرصاتها، ومرتفعاتها وقيعانها، نَبْتٌ ولا كلأٌ ولا اخضرار. إن ذِكْرَ المواضع الغانية، لا يمكن إلاّ أن ينشأ عنه الحد الأدنى من التصور الجمالي المتجسد في ضرورة وجود الماء الذي يفضي بالضرورة إلى وجود الشجر والزرع الذي يفضي بالضرورة إلى وجود الحياة الغانية التي تفضي بالضرورة إلى التخاصب والتزواج والتعايش والتحابّ.
فلا يترعرع الحبّ إلا في ظل شجر، وحول ماء جارٍ، وفي وادٍ ممرع، ووسط مخصب؛ إذا لم تكن بلاد العرب كلها مجرد رمال قاحلة، وسوافٍ عاصفة؛ فإن فيها مواضع ليس أجمل منها على الأرض...
ونريد أن نتوقف لدى ضربين من الحيز ونحن نحاولُ مُدارَسَةَ جماليَّاتِهِ، في بعض هذه الأبيات الستة:
الحيز بين الانتساج والانتساخ، والحيز الأخضر، عافّيِنْ عما بقي من أضربه إلى حين.
1- الحيز بين الانتساج والانتساخ:
يصادفنا في طللية امرئ القيس حين يتحول من حال إلى حال، ومن وجه إلى وجه، في إفراز الجمال، فترى سطحه ينتسخ، وشكله ينتسج؛ وذلك بفعل انتساج الرمال وحركتها الناشئة عن عصف الرياح، وهبوب السافيات. فتلك الأحيازَ قاومت الطبيعة بالطبيعة، وقل: إنّ الطبيعة العذراء هي التي تقاوم ذاتها، فانْتَسأ العفاءُ بفضل الرياح التي كانت تذرو الرمال على هذا الوسط الصحراوي العجيب:
لم يعف رسمُها* لما = نسجتْها من جَنوب وشَمأَلِ
ويبدو أن حركة الانتساخ الرملي التي كان ينشأ عنها مناظرُ عاريةٌ عجيبة كانت تتم تارة بفعل هبوب الرياح من الجنوب نحو الشمال، وتارةً أخراة بفعل هبوب الرياح من الشمال إلى الجنوب.
ونلاحظ أنّ الحيز الشعريّ هنا لا يزال يبدّل سطحه، ويغيّر وجهه، كلما هبت عليه الرياح؛ وكلما سكنت عنه، أيضاً، هذه الرياح. والتبدل الذي يعتوره إنما كان يتمّ بفعل حركة الرياح وسكونها معاً. وواضح أن الحيز هنا ذو لونٍ أصفر ضاربٍ إلى الحُمْرة، لأنه لون الرمال. وهو حيز، إذاً، أغبرُ أشعث لأنَّ السوافي لم تبرح تثير مادّته هذه فتفعل فعلها فيما حَوالَها، ومن ذلك حيلولتها بين هذه الأطلال والدروسَ فلا تَدْرُسُ؛ فإذا هي باقيةٌ قائمة، محتفظة بأهم مما كان فيها من أثافي القدور، ومن معاطن الإبل، ومن حظائر الغنم، وربما من مرابط الخيل: أطلال كأنها ليست أطلالاً، وكأنّها لا تبرح غانية كما كانت بالأمس.
2- الحيز الأصفر وملحمة الألوان:
إن اللون الأصفر، وقل اللَّون الأدكن؛ اللون المتشكّل في أصله من لونين اثنين أصفر وآخر أحمر، أو قريب من الحمرة: كان يتلاقى مع لون آخر يماثله، أو يقترب من مماثلته؛ وهو لون الشمس المتمثّل في أشعّتها المذّهبة العجيبة. فكان لون سطح الأرض يمتزج بلون آخر آتٍ من نحو العلاء: فيذوب اللون في اللون، ويتزاوج الشكل مع الشكل، فيُحْدِثان ملحمة عبقرية طبيعية من الألوان الساكنة الناعسة، وهي ألوان ما تَحْتَ، والألوان المتحركة المتحفّزة وهي ألوان ما فوق.
وكانت هذه الألوان لا تلبث، هي أيضاً، أن تنتسخ وتنتسج تبعاً لما يعتورها من شعاع وفَيْءٍ، وضياء وظلّ؛ فإذا بعضُها مصفرٌّ فاقع يشّع من بعيد فيبهر البصر، ويسحر الجنان؛ وإذا بعضها داكن خامد، كأنه سكون نائم، أو منظر عائم؛ لأنه وقع تحت ظلّ الشمس؛ ولأنّ سطحه كان متعالياً بعضه على بعض بحكم أنّ السطح لا يكون في كلّ الأطوار ممتدّاً لا عوج فيه ولا أمت، ولا ارتفاع ولا انخفاض؛ وإنما تراه في كثير من أطواره السطحية مرتفعاً بعضه، ومنخفضاً بعضه، ومنبسطاً بعضه الآخر، فإذا هو يشكّل أضرباً من الحيز الداكن الخامد وهو الواقع تحت سلطان الظلّ؛ وأضرباً أخراةً من الحيز المصفّر المشعّ، وهو الواقع تحت سلطان الشمس المتوّهجة.
وكان هذا الحيز الملحميّ لا يلبث أن ينفلت من هذين الشكلين ليجّسد شكلاً ثالثاً هو الشكل المغبرّ المتكوّن من حبّات الرمال المتطايرة حين تذروها السوافي فتتناثر فيما حوالها من الفضاء شظايا. وهو شكلٌ حيزيٌّ بمقدار ما هو مذهلٌ مريع، بمقدار ماهو غجريّ وحشيّ، يجسّد الطبيعة في عذريتها، وعبقريّتها وتغيّرها، وانتساخ مظهرها تبعاً لما يعتور أطوارها، ويخامر أحوالها.
ومن الواضح أنَّ هذا الحيز -الثالث- متحركٌ لا ثابت، ومتناثر لا ساكن؛ وهو الذي كان يفضي بسطح الرسوم المرقسيّة السحرية إلى أن تظلّ باقيّةً غير فانيةٍ، وقائمة غير ذاهبة؛ وكلّ أولئك أمور حدثت بفعل انتساج الرمال التي إنّما تناسجت، هي أيضاً، بفعل هبوب السوافي عليها تارة من تلقاء الجنوب، وتارة أخراةً من تلقاء الشمال؛ في حركة كأنها دائبة، ونشاط كأنه أزليّ. وكأنّ كلّ أولئك إنما كان لأجل حفظ الحيز الأصليّ الثابت من أن يَبْلى ويَدْرُسْ.
فهل يمكن أن يوجد أسحر وأبهر من هذا الحيز الثلاثي الأشكال، المركّب الألوان، المتغيّر الأطوار، من حال إلى حال؟
3- الحيّز الأخضر وملحمة الجمال العذريّ:
يصادفنا في هذه الطللية العجيبة ضرب من الحيز يتّسم بجملة من المظاهر المفضية إلى تشكيل ملامح من الجمال تتضافر بجذمورها لتبدع لوحة طبيعة عبقرية، وتتمثّل خصوصاً في :
أ- بعر الآرام:
إنّا لنعلم أن بَعَر الآرام، وتواثب الأرانب، وغناء الطير، ونحوها: بمقدار ما تدلّ على وحشيّة المكان وإقفاره، تدلّ على خصبه وإمْرَاعِهِ، وتواجد الخضرة فيه، في الوقت ذاته. سواء علينا أكانت تلك الخضرة ناشئة عن مياه المطر، أم عن مياه الغدارن والعيون؛ فإنها في الحالين الاثنتين تدلّ على الخصب والإمراع. إذ لا ينبغي أن يكون بعرٌ إلا بارتعاء؛ ولا ارتعاءٌ إلاّ لعشب أخضر.
إنّا؛ حقاً، لو قرأنا "بعر الآرام"، تقليديّاً، لما انتهينا إلى شيء مما زعمناه، ولكانت قراءتُنا إيّاه على مقتضى السابقين؛ وإذاً لما كان لقراءتنا وجوبٌ ولا غناءٌ. ولكننا نحن سخّرنا في هذه القراءة التأويليّة ما نطلق عليه "الحيز الخلفيّ" الذي أفادنا بالتسلسل الذهني بهذا الذي استنتجناه من قراءة هذه العبارة. إنّ بعر الآرام، فعلاً، وحقّاً، وانطلاقاً من سياق النص، يسبّب شبكة من المعطيات الدلالية التي تفضي حقاً إلى بعض ما اهتدينا إليه.
ب- العَرَصات:
تعني العرصات في اللغة المعجميّة الملاعب والمغاني التي تحدودق بالمنازل، وتحيط بالدور. فهي من هذه الوجهة تحيل على حيز مرتبط بعمران كائن أو كان. فكأنّ العرصات عبارة عن مساحة مخضرة ممتدّة يسرح مع خضرتها الطرف، وتمتدّ مع امتدادها العين المبهورة بعبقرية الطبيعة ورونقها وأناقتها. فهذه الآرام التي يُتَحدَثُ عنها تمثل مع هذه العرصات وسطاً طبيعياً عذرياً ، أو متوحشاً غجرياً، لمَّا تُهذّبه مهذّبات الحضارة بالتضيع والتغيير. فهناك إذن الخضرة؛ وهناك إذاً ما يعيش في أحضان هذه الخضرة (الآرام)؛ وهناك من يحسُّ بهذه الخضرة العرصاتية، أو يمتزج بها، أو يندمج فيها بشعور أو بدون شعور.
ج- وقيعانها:
لو لم يتحدث النصّ عن القيعان بعد العرصات لحقّ لنا أن نتأوّل هذا الحيز على أنه وَعْرٌ حَزْنٌ، وعلى أنه شاهقٌ عالٍ، ولكنه حين أعقبه بـ "القيعان" أسْتَبان أنّ هذه العرصات المرقسيّة كانت تَخْضَوضِرُ فتمتدّ ظلالها في كل اتجاه، ولعلها كانت تتربّع في قيعةٍ من الأرض حيث إنها مظنونةٌ باحتقان الماء.
ولا نعتقد، لمن سيعترض علينا، بأنّ تلك القيعان كانت مجدبة، وأن تلك الآرام كانت تتواثب وتتلاعب في مجرّد الرمال القاحلة. كما لاينبغي أن ينصرف الوهم إلى أنّ الحيز الشعري الجميل الذي كان يحنّ إليه امرؤ القيس، ويتلذّذ بذكراه، كان مجرد قفر عجيب. وإلاّ فبم كانت تلك الآرام تقتات؟ وأين كانت من شجر الأراك؟ ثم أين كانت تختبئ لتتّقي عدوان القنّاصين المتربّصين بها؟ ثم من سيستطيع أن يثبت لنا بأن حيز امرئ القيس المتحدّث عنه هنا كان مجرد رمال جافّة، وحجارة صلدة، ومناظر موحشة؟ وما القول في العرصات، والسّمرات، والآرام، والمنزل...؟
د. سَمُرات الحيّ:
قد تكون هذه السَمُرات مجرد بيان للعرصات المتقدمة الذكر، وذلك من الوجهة الوصفية الخالصة، لكن من الوجهة الدلالية تعني، أو قد تعني أنّ الشأن منصرف، هنا، وفعلاً، إلى طبيعة مخضرّة عذراء؛ وأنّ الاخضرار لم يَكُ، ربما، وقفاً على ما ابتعد عن الحيّ وانتشر حَوَاله من فضاء يبدو كأنه مريع؛ وإنما نلفيه أيضاً يوفر، ربما، في هذا الحيّ الذي تباسَقَتْ سَمُراته المخضرّة فتَرَهْيَأت أغصانها المورقة فامتدّت أفقياً وعمودياً: فنشأ عنها شيء من الظلّ والنّعمة والرّغد...
ونلاحظ أنّ خضرة العرصَات كأنها وقفت على الآرام وما كان يشبهها من حيوانات وحشية كالذئاب وسوائها؛ بينما خضرةُ السَّمُرات وقفَتْ هنا على الإنسان يتظلّل بظلّها، ويتنسّم بنسيم أغصانها المصطفقة، وفروعها المتراصة. فعلاقة الطبيعة انصرفت في الحال الأولى إلى مجرد حيوان، بينما انصرفت في الحال الأخراة إلى الإنسان.
هـ- رسْم دارس:
لعلّ من عجيب المفارقات، ولطيف المباعدات، أن يغتدي الخراب اليباب مظنّةً للجمال البديع، ومقصدةً لاستعادة الذكريات العذاب. فالرسم الدارس من حيث هو ديارٌ بالية، وبنايات متهدّمة: لا جمال فيه، ولا إلهام منه، ولا سعادة تجثم حَوالَه. بيد أنّ الذي جعل من جَلاله جمالاً، ومن شقائه سعادة، ومن وحشته أُلفَةً، ومن بشاعته نُضْرَةً؛ هو تلكم الذكريات الجميلة التي كان يطويها في نفسه، وتلك العلاقات العاطفية الكريمة العارمة، وتلكم الأزمنة التي قضّاها أناسٌ فيها حتّى ضجّت بهم، وغصّت بوجودهم: ما بين ذاهبٍ وآتٍ، وخارج وداخل، وسارٍ وقائمٍ، ويقظان ونائمٍ، ومفارق ومُوامقٍ، ومُغاضِب ومعانق... حياة على الشظف رغيدة، وعلى الاضطراب وديعة، وعلى الشقّاء سعيدة.... الحبّ والشعر، والشعر والحب، على الرغم من كلّ المهدّدات التي كانت تمثّل في الإغارات المشنونة، والحروب المستعرة...
أو لم يكن فيما توقفنا لديه من هذه المنازل القائمة، والمغاني الممرعة، والقيعان المخصبة، والعرصات المخضوضرة، والسّمرات الباسقة، والرسوم الدارسة الموقورة أطلالها بالأسرار والألغاز، والمشحونة رواكدها برسيس الذكريات العذاب: ما يجعل هذه الأخبار طافحاً جمالها...؟
***
ولمّا كنّا نعلّق شأناً مهماً على مدارسة الحيز وتحليل أنواعه في هذه المعلّقات، فإنّ ما عرضنا له في نهاية هذه المقالة يحملنا على عقد مقالة بحذافيرها لجمالية الحيز في المعلّقات، من حيث هو، وليس من حيث هو طلل، وهو الأمر الذي حاولنا أن نعوج عليه معاجاً عجلاً في نهاية هذه المقالة. حقاً، أنّ الطلل ينضوي تحت مفهوم الحيز، بامتياز، ولكنّ للطلل شأناً آخر ينصرف إلى سير أخراة اجتهدنا في أن نعرض له في القسم الأكبر من هذه المقالة.