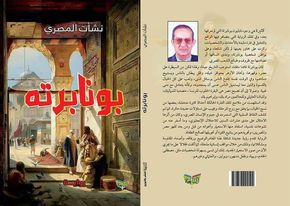حين أراد فلاسفة اليونان أن يقنعوا العوام بأن أفكارهم صادرة عن سلطة عليا مقدّسة، كتبوها بلغة شعرية.. وحين عجز العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن، اتهموا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر.. وحين يصل الصوفي إلى مستوى الكشف والفناء، يصبح، في أقرب الاحتمالات، شاعرا، أو يكون كلامه شعريا بامتياز.. "فإذا تهذّب ظاهر العبد وباطنه صار صوفيا أدبيًا" هكذا يقول الغزالي..
ما أريد الوصول إليه هو أن الشعر شيءٌ إلهيّ، وكلما هو إلهيّ يرفض بالطبع منطقَ القيود والحدود.. فالشاعر يموت فنيا إذا وُضعتْ أمام طاقته الإبداعية خطوط حمراء، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية، فالحرية جوهر الفن، وحبيبته التي تهبها لذةَ الحدس..
نفوس الشعراء تنزع إلى المطلق اللامتناهي، لأنهم أنبياء بلا وحي يحدّد بوصلَتهم، أو لنقُلْ بوحي طيّعٍ لهواهم، فهم لا يخضعون إلا لفطرتهم الإلهية، وعفويتهم الجبّارة، وبراءتهم الجريئة، فإذا خرجوا عن هذا النسغ فالسلام عليهم وعلى الشعر!
الشاعر يجب أن يُترك على جموحه ومجونه وشهوته، بمعنى حركيته المطلقة حتى يبدع، فالالتزام عدوّ الإبداع، ومتعة الخطيئة فضاءُ الفنّ الأصيل.. إن شئت فارجع إلى المراحل الذهبية للشعر العربي، أو بالأحرى الأدب العالمي، تجد أن الشعراء الذين ليس لهم أي انتماءات سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية يحددها العصر أو المصر، والذين خرجوا من قفص التدين واحتضنوا أثير الخطيئة، هم في الغالب أنضج إبداعًا، وأكثر تألقا في سماء الإنتاج الفني.. ذلك، لأن الفن يأبى الرقابة، فهو تمردٌ، حياةٌ بامتلاء..
ولهذا كُنْتُ دائما ضدّ إقحام العنف في عالم الفنّ.. لماذا -بحق الجحائم السبع- يُقتل شاعر أو روائي أو رسّام جرّاءَ أعماله الإبداعية؟ ولماذا المصادرة والاضطهاد؟ لماذا هذا الإرهاب الذي يهدد الأمن الفني، وينذر بضياع الجمال، وموت السحر؟
فالفنّ "هروب الى الحرية" كما يعبّر بيغوفيتش، وعزف على أوتار الخيال، وسروح في مدينة لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الحجر والوصاية والإشراف، تلك مدينة الشعراء والأدباء والرسّامين والروائيين، وهي لهم بمثابة البحر للسمك، فإذا استوطنوا غيرها ماتوا وماتت مواهبهم وفنونهم..
الفن حدس لا منطق له ولا أخلاق، فهو -وإن كان في بعض الأحيان مستوحى من الواقع- إلا أنه لا يعيد هذا الواقع كما هو، ولكن يحاول صناعته وخلقه من جديد، فالواقع لا يهم الفنان بقدر ما تهمّه قيمة الصورة التي تتولد في مخيلته بمجرد احتكاكه به.. وتلك الصورة، التي يرسمها فنيّا، لا تنبع من وعي، وإنما من وجدان..
فالشعراء يتبعون ظنونهم، يقولون ما تملي عليهم حدوسهم، ويستمعون إلى العالم الباطني أكثر مما يستنطقون العالم الخارجي، تأمّل معي قول أبي نواس:
هذا.. على أن لا يُفهم من كلامي شيطنة الفنّ ورميه في أقنوم الابتذال، أنا لا أقبل المساس بمعتقدات الناس ولا بالثوابت الوطنية والثقافية والاجتماعية، فاحترام المقدّسات من صفات العلية، وهو مبدأ لا يخضع للطعن، فلا يليق بفنان أن يتخذ من فنه نفقا يوصله إلى الخلط بين ما هو مقدس ومدنّس، وبين ما هو لاهوت وناسوت.. فالحرية إن لم تُضبط سرعان ما تتحوّر إلى فوضى جامحة تهدد مصالح العامة..
لكن الشيء الذي يجب أن يفهمه القارئ، هو أن الشعر، والفنّ عموما، لا يُعنى بالحقائق والأفكار والمفاهيم، فذلك شأن العلم والفلسفة.. فالفلاسفة والعلماء يكتبون ما يؤمنون به.. ويحاولون، من خلال أعمالهم، اختزالَ العالم في قوالب فكرية يحددونها هم، و يضعون العالم فيها، ويرون أنها، هي وحدها، القدّ المناسب للعالم، وما سواها إما فضفاض أو قزم دون الحجم المطلوب..
في حين أن الفنّان حين يضيق ذرعا بالواقع.. لا يحاول تغييره، ولا التعبير عن انطباعاته المباشرة عنه.. بقدر ما يهمه صناعة واقع آخر موازٍ يحتضن أحلامه، ويمنحه فرصة الاحتكاك بحنينه الداخلي، الذي يطمئن إليه أكثر.. فهو "لا يحاول أن يعيد خلق الواقع، بل يتحدث معه" كما عبّر أدونيس.. مستعملا في ذلك أساليب الرمز والإشارة والخيال..
ولذا حين سأل أحد الصحفيين البريطانين الكاتبةَ الشهيرة "فيرجينيا وولف" : "هل تكتبين لتعكسي الواقع؟" أجابت: "بالتأكيد لا.. لأنّ نسخة واحدة من هذا الشيء اللعين تكفي.."
فالعمل الفنّي أبعد من ذلك، فهو انفجار عشوائي، وانبجاس طائش، بحيث إن الفنان"لا ينطلق من فكرة واضحة محددة، بل من حالة لا يعرفها، هو نفسه، معرفة دقيقة، ذلك أنه لا يخضع في تجربته للموضوع أو الفكرة أو الايديولوجية أو العقل أو المنطق.. إن حدسه، كرؤيا وفعالية وحركة، هو الذي يوجهه ويأخذ بيده" ، يقول أدونيس..
هذا عالم الفنّ، غنائي بامتياز، حدس مجرّد، استدلال مطوي..، إنه صورة النّفس، والفضاء فيه لا تتّسع إلا للأنا وحدها، الآخر غير حاضر، أو -بالأحرى- غير مرحّب.. بينما عالم العلم والفلسفة يعجّ بالآخر، يُحاوَل فيه الاحتكارُ عليه برومانسية مبتذلة بطلُها العقل لا القلب، المنطق لا العاطفة، الحقيقة لا الأسطورة، الواقع لا الخرافة..
ولذا لا ينبغي أن تُقرأ الأعمال الفنية كما تُقرأ الأعمال الفكرية، فحين نجا الروائي الكبير نجيب محفوظ من محاولة اغتياله جرّاء نشر روايته "أولاد حارتنا" قال: (إن مشكلة "أولاد حارتنا" منذ البداية أنني كتبتها "رواية"، وقرأها بعض الناس "كتابا")..
فإذا استوعبنا كنهَ هذا الكلام، وحاولنا -ولو عبثا- الإطلال من نفس النافذة التي يطل منها هذا الفنان العظيم، فإننا سندرك حينئذ أن أشنع الجرائم التي يمكن أن ترتكبها البشرية، هي أن يلقى شاعر أو روائي أو رسّام أو أيّ فنّان مصرعه في سبيل الإبداع، وابتكار الجمال.. جريمة بالكاد لا تُغتفر..
ما أريد الوصول إليه هو أن الشعر شيءٌ إلهيّ، وكلما هو إلهيّ يرفض بالطبع منطقَ القيود والحدود.. فالشاعر يموت فنيا إذا وُضعتْ أمام طاقته الإبداعية خطوط حمراء، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية، فالحرية جوهر الفن، وحبيبته التي تهبها لذةَ الحدس..
نفوس الشعراء تنزع إلى المطلق اللامتناهي، لأنهم أنبياء بلا وحي يحدّد بوصلَتهم، أو لنقُلْ بوحي طيّعٍ لهواهم، فهم لا يخضعون إلا لفطرتهم الإلهية، وعفويتهم الجبّارة، وبراءتهم الجريئة، فإذا خرجوا عن هذا النسغ فالسلام عليهم وعلى الشعر!
الشاعر يجب أن يُترك على جموحه ومجونه وشهوته، بمعنى حركيته المطلقة حتى يبدع، فالالتزام عدوّ الإبداع، ومتعة الخطيئة فضاءُ الفنّ الأصيل.. إن شئت فارجع إلى المراحل الذهبية للشعر العربي، أو بالأحرى الأدب العالمي، تجد أن الشعراء الذين ليس لهم أي انتماءات سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية يحددها العصر أو المصر، والذين خرجوا من قفص التدين واحتضنوا أثير الخطيئة، هم في الغالب أنضج إبداعًا، وأكثر تألقا في سماء الإنتاج الفني.. ذلك، لأن الفن يأبى الرقابة، فهو تمردٌ، حياةٌ بامتلاء..
ولهذا كُنْتُ دائما ضدّ إقحام العنف في عالم الفنّ.. لماذا -بحق الجحائم السبع- يُقتل شاعر أو روائي أو رسّام جرّاءَ أعماله الإبداعية؟ ولماذا المصادرة والاضطهاد؟ لماذا هذا الإرهاب الذي يهدد الأمن الفني، وينذر بضياع الجمال، وموت السحر؟
فالفنّ "هروب الى الحرية" كما يعبّر بيغوفيتش، وعزف على أوتار الخيال، وسروح في مدينة لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الحجر والوصاية والإشراف، تلك مدينة الشعراء والأدباء والرسّامين والروائيين، وهي لهم بمثابة البحر للسمك، فإذا استوطنوا غيرها ماتوا وماتت مواهبهم وفنونهم..
الفن حدس لا منطق له ولا أخلاق، فهو -وإن كان في بعض الأحيان مستوحى من الواقع- إلا أنه لا يعيد هذا الواقع كما هو، ولكن يحاول صناعته وخلقه من جديد، فالواقع لا يهم الفنان بقدر ما تهمّه قيمة الصورة التي تتولد في مخيلته بمجرد احتكاكه به.. وتلك الصورة، التي يرسمها فنيّا، لا تنبع من وعي، وإنما من وجدان..
فالشعراء يتبعون ظنونهم، يقولون ما تملي عليهم حدوسهم، ويستمعون إلى العالم الباطني أكثر مما يستنطقون العالم الخارجي، تأمّل معي قول أبي نواس:
"غيرّ أنّي قائلٌ ما أتاني .. من ظنوني مكذِبٌ للعيان
آخذٌ نفسي بتأليف شيء .. واحدٍ في اللفظ شتّى المعاني
قائمٌ في الوهم حتى إذا ما .. رمتُه رمتَُ مُعَمّى المكان
فكأني تابع حسنَ شيء .. من أمامي ليس بالمسْتَبان"
وانظر إلى هذا البيت الذي ينسب إلى أحد شعراء الجاهلية:"ربّ همّ فرّجتُه بعزيم "" وغيوب كشّفتُها بظنون"
فهم يقرّون بأن ما يقولونه ليس مرآة الحقيقة ولا قناة الواقع، ولذا لم يلزموا أحدا به، ليسوا على منطق الفلاسفة ومروّجي الايدولوجيات.. فكلما يطالب به الشعراء والأدباء عموما هو غُنج الفن، ومناغاة الإبداع.. يريدون من العالم أن يرقص مع أغنياتهم لا أن يحاول فهم الليريك.. ذلك شيئهم هم، وفئة خاصة يربطه بهم دم الفنّ، وقرابة الذوق الرّفيع..هذا.. على أن لا يُفهم من كلامي شيطنة الفنّ ورميه في أقنوم الابتذال، أنا لا أقبل المساس بمعتقدات الناس ولا بالثوابت الوطنية والثقافية والاجتماعية، فاحترام المقدّسات من صفات العلية، وهو مبدأ لا يخضع للطعن، فلا يليق بفنان أن يتخذ من فنه نفقا يوصله إلى الخلط بين ما هو مقدس ومدنّس، وبين ما هو لاهوت وناسوت.. فالحرية إن لم تُضبط سرعان ما تتحوّر إلى فوضى جامحة تهدد مصالح العامة..
لكن الشيء الذي يجب أن يفهمه القارئ، هو أن الشعر، والفنّ عموما، لا يُعنى بالحقائق والأفكار والمفاهيم، فذلك شأن العلم والفلسفة.. فالفلاسفة والعلماء يكتبون ما يؤمنون به.. ويحاولون، من خلال أعمالهم، اختزالَ العالم في قوالب فكرية يحددونها هم، و يضعون العالم فيها، ويرون أنها، هي وحدها، القدّ المناسب للعالم، وما سواها إما فضفاض أو قزم دون الحجم المطلوب..
في حين أن الفنّان حين يضيق ذرعا بالواقع.. لا يحاول تغييره، ولا التعبير عن انطباعاته المباشرة عنه.. بقدر ما يهمه صناعة واقع آخر موازٍ يحتضن أحلامه، ويمنحه فرصة الاحتكاك بحنينه الداخلي، الذي يطمئن إليه أكثر.. فهو "لا يحاول أن يعيد خلق الواقع، بل يتحدث معه" كما عبّر أدونيس.. مستعملا في ذلك أساليب الرمز والإشارة والخيال..
ولذا حين سأل أحد الصحفيين البريطانين الكاتبةَ الشهيرة "فيرجينيا وولف" : "هل تكتبين لتعكسي الواقع؟" أجابت: "بالتأكيد لا.. لأنّ نسخة واحدة من هذا الشيء اللعين تكفي.."
فالعمل الفنّي أبعد من ذلك، فهو انفجار عشوائي، وانبجاس طائش، بحيث إن الفنان"لا ينطلق من فكرة واضحة محددة، بل من حالة لا يعرفها، هو نفسه، معرفة دقيقة، ذلك أنه لا يخضع في تجربته للموضوع أو الفكرة أو الايديولوجية أو العقل أو المنطق.. إن حدسه، كرؤيا وفعالية وحركة، هو الذي يوجهه ويأخذ بيده" ، يقول أدونيس..
هذا عالم الفنّ، غنائي بامتياز، حدس مجرّد، استدلال مطوي..، إنه صورة النّفس، والفضاء فيه لا تتّسع إلا للأنا وحدها، الآخر غير حاضر، أو -بالأحرى- غير مرحّب.. بينما عالم العلم والفلسفة يعجّ بالآخر، يُحاوَل فيه الاحتكارُ عليه برومانسية مبتذلة بطلُها العقل لا القلب، المنطق لا العاطفة، الحقيقة لا الأسطورة، الواقع لا الخرافة..
ولذا لا ينبغي أن تُقرأ الأعمال الفنية كما تُقرأ الأعمال الفكرية، فحين نجا الروائي الكبير نجيب محفوظ من محاولة اغتياله جرّاء نشر روايته "أولاد حارتنا" قال: (إن مشكلة "أولاد حارتنا" منذ البداية أنني كتبتها "رواية"، وقرأها بعض الناس "كتابا")..
فإذا استوعبنا كنهَ هذا الكلام، وحاولنا -ولو عبثا- الإطلال من نفس النافذة التي يطل منها هذا الفنان العظيم، فإننا سندرك حينئذ أن أشنع الجرائم التي يمكن أن ترتكبها البشرية، هي أن يلقى شاعر أو روائي أو رسّام أو أيّ فنّان مصرعه في سبيل الإبداع، وابتكار الجمال.. جريمة بالكاد لا تُغتفر..