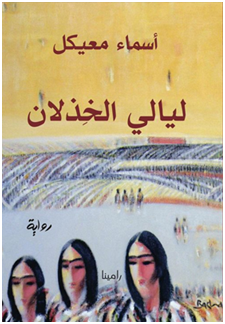كانت الوردة اسماً
ونحن لا نمسك إلاّ الأسماء
امبرتو ايكو
*****
مالذي يهمّنا في الفن ومالذي نرومه من الكتابة؟
أن نستعيد حدّة مشاعرنا التي قلّمها التكرار. أم اختبار طرق الحياة والتفافاتها المدوِّخة دون أن نحرك القدمين؟
الحياة ولد أرعن طائش، ونحن بالغون جداً على الركض خلفه؛ ولكن يمكننا إغراءه بقطعة حلوى. وإذا كان الفن إغراءً فإن بإمكانه أيضاً أن يظهر لنا ما يستبد بالمرء حين يكتب أو يبدع. وهذا ما يقدمه لنا النص وحده دون غيره.
مختارات
في كتاب “القصص” وفي مجمل التجربة الأدبيّة للكاتب والناقد المصري سيد الوكيل. نعثر على الطفل الذي يحاول استيعاب الفوضى، (فوضى العالم، فوضى الزمن) لكنها الفوضى الجماليّة، وهو في نصوصه أشبه ببطل هنري باربوس الذي يحدق من ثقب في الجدار. وإذا كان الأخير غارقاً في العدم واللانتماء يصف الحواف الحادة الجارحة للحب والحياة والعلاقات. فإن الأول يجابه كل ذلك من خلال الذاكرة. عبر نصوص تحمل أسماء أبطالها. (ترزاكي –دانيال-فواز مطاوع –منسي)
أحيانا يترك الكاتب السرد للطبيب المبتدئ الذي يبحث عن عيادة للإيجار-كما في قصة ترزاكي-فهو يلتقي بطبيب عجوز تنازل عن المهنة وراح يعمل حاوٍ للإفاعي وساحر يكلم الحيوانات؛ ولأن للجسد شكل الروح العميقة. فإن ملامحه الجسدية تكشف تدهور روحه. فشعره مشعث وهو يعب من زجاجة الكحول وتذكرنا هيئته بالجنون اليائس لإدغار آلان بو. وحين ينحني ليخرج علبة من الديدان والأفاعي يفرُّ الشاب متعثراً بالدرج المعتم.
يتبع السرد جريان الحياة وتدفقها غير العادل ضرورة. وربما العدالة فكرة اخترعها مظلوم وعَلِقَ بها، كما يعلق فأر في لاصق قوي؛ لذا لا بدّ قبول الحياة كما هي بكل انثناءاتها ومتاهاتها. وبدون إجابات. وهذا ما نجده في هذه التجربة الأدبية والنصوص التي تتضمنها كتاب “القصص”
فليس ضرورياً أن نعرف كل الحكاية، دائما هناك ثغرات وجزء ناقص فيها. فدانيال الطفل اللطيف في قصة ” دانيال” هو صديق السارد ورفيق طفولته. دانيال الطفل اللطيف الذكي الطويل، يغِّمس الآن خبزاً في ماء وملح ويتناول ما يحسبه القربان المقدس في ردهة مشفىً للأمراض العقلية!
ياترى مالذي حدث لدانيال في كندا؟
لا أحد يعرف لا السارد، ولا القارئ ولا توجد ضرورة لنعرف إننا نرى وحسب!
يقال إن “أكثر العناصر إفحاماً في عمل فني غالباً ما تكون لحظات صمته”
فالكاتب يدون تجربته ويبدل مظهرها وليس معنياً بتقديم إجابة للقارئ. وهو يلعب مع أصدقاءه لعبة الغميضّة، يناديهم من الذاكرة واحداً تلو الآخر، وهو مطبق العينين ومفرود اليدين وهو يتعرف عليهم عبر سماع ضحكات فواز مطاوع ومرحه الرجوليّ ويقارنها بصورة الوجه فوق -صفحات الجريدة-إنه الوجه المنقرش بالدماء لفواز نفسه بجلبابه الأبيض وذقنه المشعثّة! وعلينا نحن كقراء أن نخترع الباقي اختراعاً…
يقال “أن كل أسلوب هو وسيلة للتشديد على أمر ما” والأسلوب هنا يُقدم لنا عبر الإشارات الحسية، كالرائحة والصورة، والظل، واللمسة، بكل كثافتها وهي عناصر تزوغ من براثن للنسيان.
في قصة رجل وامرأة يتثاءب الشرطي ضَجِراً من محنة أب وأم فقدا طفلهما، كيف وأين؟ هل نسياه أم سرقه أحدهم؟ ما عمره؟ لا يوجد أي شيء فقط لمسات قلقة وتنهدات والضجر وكله يجري تحت ريح باردة وناعمة تؤجج الحنين بينهما.
يتخذ السرد في تجربة “سيد الوكيل” بُعداً تأملّياً، عبر مخاطبته للإدراك الحسي والحدسي في آن. كما في قصة البركة. يحمل السارد الذي يتأمل الشارع ويراقب حركة الأشياء الشتائية، عدسة كاميرا تذكرنا بسينما المخرج الكرواتي آرسين آسيتوجيك. بحيث تنعدم اللغة وترصد العدسة حركات وإيماءات الشخوص محاولاً أن يحدس ما يجري في داخلها!
هكذا ندخل لعبة الاحتمالات فالسارد ليس متيقناً من مشاعر الكائنات التي يضعها تحت عدسته. فالمعنى متضمن في تعابير الجسد في الغضب أو الحزن، في انعكاس الظل لعاشقين دون ملامح، في ارتعاش ذبالة الشمعة أمام ريح باردة.
في قصة إيقاع شجي وحيد من مجموعة للروح غناها. نطالع غرفة مشفى، سريرين شاغرين، مثلث من الجبن، نسمات هواء باردة من جهة النيل، أغنية لأم كلثوم “لا قلت لي مكانك فين” أنات، آهة مكتومة، يد العجوز فوق كتف السارد الذي يعينه على السير. ذكريات العجوز عن طقم عبد الوهاب وطربوشه، وإلحاح أم كلثوم على ترديد “لا قلت لي مكانك فين” فالشخصيات تتكلم بأقل الكلمات، لكنها تومئ. تتنهد، في قصة أثقل من روحي عليّ. نسمع سّنّ إبرة الماكينة وهو يدور وينزلق فوق الحرير، ويرمي وراءه مزيداً من الغرزات الصغيرة “كسرب النمل كلما حادت عن طريق خط لها تعود” أما الحب فهو يظهر في الشَعر المنفلت والفستان المنحسر عند الركبتين، ورائحة الجسد المختزنة في الملابس.
تشبه المجموعة متوالية يظهر فيها الأشخاص ويختفون كفواز مطاوع ويظهر الواقع كطيف أو صورة شعرية حيث ” أطراف السجائر المتوهجة تطفو كزهرات على مياه راكدة”
يشتغل سيد الوكيل على الإدراك الحسي الجمالي، ويؤسس علاقة وثيقة مع المتلقي ويمكن القول إنه يعتمد فينومينولوجيا الإدراك الحسي بحيث يُظهر لنا جانباً واحداً من المكعب الذي يدعى “الحياة”
كتب هوسرل مرة ” إنّ المكعب منظوراً له من جانب واحد-لا يُظهِر أيّ شيء في جوانبه الأخرى المخفيّة”
بحيث نستطيع ان نسمع صوت المفتاح في القفل، وأن نرى الجار السلفي يفسد القصة. ونرى احتمالات الموت الكثيرة لشاب وحيد كما في قصة “مثل واحد آخر” وهو ذاته عنوان الجزء الثالث من كتاب القصص التي يهيمن عليها الموت.
في قصة “كل ما عليك أن تموت” يقول السارد لصديقه: اسمع يا محمود، الأحلام هكذا. إما أن نصدقها أو نظل مستيقظين للأبد.
هذا ويشرك الكاتب القارئ معه في بناء قصة مشهد يضع القارئ المفترض وجهاً لوجه أمام السارد الذي يحدثه بخطته لبناء حكايته. لكن كل خطته تتخربط بمرو امرأة لا نرى منها سوى عينيها. وبهذا لا يعرف السارد كيف ينهي المشهد بالعدم أم الخواء والمعاني المجردة.
الزمن يجري والسارد يعرف ذلك والقارئ ضمناً يعرف. لكن كيف سنتمكن من إقناع “سعد الطالع” الرجل السبعيني في قصة “شرفات مغلقة” أن زمنه انتهى! وأنه وهو عامل التشريفات ومهمته تنحصر في التهليل لسيارة الوزير. لكن الوزير الجديد يقرر الاستغناء عن هذا العرف المتمثل في رجل التشريفات. فمن يقنع سعد الطالع أن ما كان يعتبر مهنة يعتّد بها صار مجرد تهريج الآن!
لا يمكن العودة بالزمن (هذا مضمون لمح البصر) ولا يمكن العودة من نفس الطريق، لقد عبرت الماء الآثن والأحجار القلقة في كل مكان.
نأتي العالم بيدين فارغتين ولن نغادره إلا بعد أن نرد كل متعلقاتنا كما أتينا. وفي غرفة العناية الإلهية تتكثف الدينا في مائة جنية، وسكرتير يخلع عن عيني السارد النظارة؛ ويد إلهيّة تربّت على كتفه مطالبة أياه بالمائة جنيه. فيهرب بين قطع الأثاث “حتى انتهيت إلى باب أخير، عندئذ سمعت صوت سكرتيره يهتف بي، ها أنت تعرف الطريق بدون نظارة”
كتب أحدهم مرة: أنه وفي كل التفاتة يسجل جهازنا الشميّ والسمعيّ والبصري آلاف الروائح والأصوات والصور. وما الفن إلا محاولة الإمساك بكل ذلك! بحيث يبدو المضمون مجرد ذريعة للتمسك بالشكل الجميل.
من السهل أن نقبل التشابهات والمصادفات في الحياة، ولكن من المحال تصديق ذلك في الأدب؛ الذي يجد صعوبة في إقناعنا؛ إلا إذا استطاع أن يقلد حبكاتها ومكائدها وألعابها البهلوانية. لكن “مجموعة القصص” التي هي مختارات من عدة مجاميع قصصية لسيد الوكيل. تجنح بنا كسفينة قراصنة، تحتفي بالحياة بكل تقلباتها. وتقبل الموت بنفس الخفة التي نقبل فيها على الحياة. ونقع في قلب الوجود الماثل في ضحكة ترن في الذاكرة، أو نغم قديم، ابتسامة، أو التفاتة. أو قبلة. وربما يكون هذا جوهر ما قصده ماركيز حين كتب أن “الفن يكمن في هذا التفصيل بالذات، أن ينجح بتحويل المألوف والبديهي إلى إدهاشي”
هناك لعبة شعبية تدعى “الطميمة” أو “الغميضة” في هذه اللعبة يدور مجموعة من الصبية حول طفل يقف في منتصف الدائرة، وقد وضع عصابة فوق عينيه. وهذا الأخير الذي يتبرع بالوقوف في منتصف الدائرة بهذه الهيئة عليه أن يتعرف إليهم بوسيلة أخرى تبدأ بالأنامل واللمس والرائحة ولا تنتهي بالقلب.
هذا الطفل سيقضي حياته وهو يحدق من ثقب باربوس. يتنهد مع الآخرين، ويفرح معهم ويتألم لغيابهم. هذا الطفل /الكاتب. ستكون مهمته أن يرصد وعبر منظار قلبه وذاكرته كيف تتوهج نجمة وكيف يكون موتها!
فدوى العبود/كاتبة سورية

 sadazakera.wordpress.com
sadazakera.wordpress.com
ونحن لا نمسك إلاّ الأسماء
امبرتو ايكو
*****
مالذي يهمّنا في الفن ومالذي نرومه من الكتابة؟
أن نستعيد حدّة مشاعرنا التي قلّمها التكرار. أم اختبار طرق الحياة والتفافاتها المدوِّخة دون أن نحرك القدمين؟
الحياة ولد أرعن طائش، ونحن بالغون جداً على الركض خلفه؛ ولكن يمكننا إغراءه بقطعة حلوى. وإذا كان الفن إغراءً فإن بإمكانه أيضاً أن يظهر لنا ما يستبد بالمرء حين يكتب أو يبدع. وهذا ما يقدمه لنا النص وحده دون غيره.
مختارات
في كتاب “القصص” وفي مجمل التجربة الأدبيّة للكاتب والناقد المصري سيد الوكيل. نعثر على الطفل الذي يحاول استيعاب الفوضى، (فوضى العالم، فوضى الزمن) لكنها الفوضى الجماليّة، وهو في نصوصه أشبه ببطل هنري باربوس الذي يحدق من ثقب في الجدار. وإذا كان الأخير غارقاً في العدم واللانتماء يصف الحواف الحادة الجارحة للحب والحياة والعلاقات. فإن الأول يجابه كل ذلك من خلال الذاكرة. عبر نصوص تحمل أسماء أبطالها. (ترزاكي –دانيال-فواز مطاوع –منسي)
أحيانا يترك الكاتب السرد للطبيب المبتدئ الذي يبحث عن عيادة للإيجار-كما في قصة ترزاكي-فهو يلتقي بطبيب عجوز تنازل عن المهنة وراح يعمل حاوٍ للإفاعي وساحر يكلم الحيوانات؛ ولأن للجسد شكل الروح العميقة. فإن ملامحه الجسدية تكشف تدهور روحه. فشعره مشعث وهو يعب من زجاجة الكحول وتذكرنا هيئته بالجنون اليائس لإدغار آلان بو. وحين ينحني ليخرج علبة من الديدان والأفاعي يفرُّ الشاب متعثراً بالدرج المعتم.
يتبع السرد جريان الحياة وتدفقها غير العادل ضرورة. وربما العدالة فكرة اخترعها مظلوم وعَلِقَ بها، كما يعلق فأر في لاصق قوي؛ لذا لا بدّ قبول الحياة كما هي بكل انثناءاتها ومتاهاتها. وبدون إجابات. وهذا ما نجده في هذه التجربة الأدبية والنصوص التي تتضمنها كتاب “القصص”
فليس ضرورياً أن نعرف كل الحكاية، دائما هناك ثغرات وجزء ناقص فيها. فدانيال الطفل اللطيف في قصة ” دانيال” هو صديق السارد ورفيق طفولته. دانيال الطفل اللطيف الذكي الطويل، يغِّمس الآن خبزاً في ماء وملح ويتناول ما يحسبه القربان المقدس في ردهة مشفىً للأمراض العقلية!
ياترى مالذي حدث لدانيال في كندا؟
لا أحد يعرف لا السارد، ولا القارئ ولا توجد ضرورة لنعرف إننا نرى وحسب!
يقال إن “أكثر العناصر إفحاماً في عمل فني غالباً ما تكون لحظات صمته”
فالكاتب يدون تجربته ويبدل مظهرها وليس معنياً بتقديم إجابة للقارئ. وهو يلعب مع أصدقاءه لعبة الغميضّة، يناديهم من الذاكرة واحداً تلو الآخر، وهو مطبق العينين ومفرود اليدين وهو يتعرف عليهم عبر سماع ضحكات فواز مطاوع ومرحه الرجوليّ ويقارنها بصورة الوجه فوق -صفحات الجريدة-إنه الوجه المنقرش بالدماء لفواز نفسه بجلبابه الأبيض وذقنه المشعثّة! وعلينا نحن كقراء أن نخترع الباقي اختراعاً…
يقال “أن كل أسلوب هو وسيلة للتشديد على أمر ما” والأسلوب هنا يُقدم لنا عبر الإشارات الحسية، كالرائحة والصورة، والظل، واللمسة، بكل كثافتها وهي عناصر تزوغ من براثن للنسيان.
في قصة رجل وامرأة يتثاءب الشرطي ضَجِراً من محنة أب وأم فقدا طفلهما، كيف وأين؟ هل نسياه أم سرقه أحدهم؟ ما عمره؟ لا يوجد أي شيء فقط لمسات قلقة وتنهدات والضجر وكله يجري تحت ريح باردة وناعمة تؤجج الحنين بينهما.
يتخذ السرد في تجربة “سيد الوكيل” بُعداً تأملّياً، عبر مخاطبته للإدراك الحسي والحدسي في آن. كما في قصة البركة. يحمل السارد الذي يتأمل الشارع ويراقب حركة الأشياء الشتائية، عدسة كاميرا تذكرنا بسينما المخرج الكرواتي آرسين آسيتوجيك. بحيث تنعدم اللغة وترصد العدسة حركات وإيماءات الشخوص محاولاً أن يحدس ما يجري في داخلها!
هكذا ندخل لعبة الاحتمالات فالسارد ليس متيقناً من مشاعر الكائنات التي يضعها تحت عدسته. فالمعنى متضمن في تعابير الجسد في الغضب أو الحزن، في انعكاس الظل لعاشقين دون ملامح، في ارتعاش ذبالة الشمعة أمام ريح باردة.
في قصة إيقاع شجي وحيد من مجموعة للروح غناها. نطالع غرفة مشفى، سريرين شاغرين، مثلث من الجبن، نسمات هواء باردة من جهة النيل، أغنية لأم كلثوم “لا قلت لي مكانك فين” أنات، آهة مكتومة، يد العجوز فوق كتف السارد الذي يعينه على السير. ذكريات العجوز عن طقم عبد الوهاب وطربوشه، وإلحاح أم كلثوم على ترديد “لا قلت لي مكانك فين” فالشخصيات تتكلم بأقل الكلمات، لكنها تومئ. تتنهد، في قصة أثقل من روحي عليّ. نسمع سّنّ إبرة الماكينة وهو يدور وينزلق فوق الحرير، ويرمي وراءه مزيداً من الغرزات الصغيرة “كسرب النمل كلما حادت عن طريق خط لها تعود” أما الحب فهو يظهر في الشَعر المنفلت والفستان المنحسر عند الركبتين، ورائحة الجسد المختزنة في الملابس.
تشبه المجموعة متوالية يظهر فيها الأشخاص ويختفون كفواز مطاوع ويظهر الواقع كطيف أو صورة شعرية حيث ” أطراف السجائر المتوهجة تطفو كزهرات على مياه راكدة”
يشتغل سيد الوكيل على الإدراك الحسي الجمالي، ويؤسس علاقة وثيقة مع المتلقي ويمكن القول إنه يعتمد فينومينولوجيا الإدراك الحسي بحيث يُظهر لنا جانباً واحداً من المكعب الذي يدعى “الحياة”
كتب هوسرل مرة ” إنّ المكعب منظوراً له من جانب واحد-لا يُظهِر أيّ شيء في جوانبه الأخرى المخفيّة”
بحيث نستطيع ان نسمع صوت المفتاح في القفل، وأن نرى الجار السلفي يفسد القصة. ونرى احتمالات الموت الكثيرة لشاب وحيد كما في قصة “مثل واحد آخر” وهو ذاته عنوان الجزء الثالث من كتاب القصص التي يهيمن عليها الموت.
في قصة “كل ما عليك أن تموت” يقول السارد لصديقه: اسمع يا محمود، الأحلام هكذا. إما أن نصدقها أو نظل مستيقظين للأبد.
هذا ويشرك الكاتب القارئ معه في بناء قصة مشهد يضع القارئ المفترض وجهاً لوجه أمام السارد الذي يحدثه بخطته لبناء حكايته. لكن كل خطته تتخربط بمرو امرأة لا نرى منها سوى عينيها. وبهذا لا يعرف السارد كيف ينهي المشهد بالعدم أم الخواء والمعاني المجردة.
الزمن يجري والسارد يعرف ذلك والقارئ ضمناً يعرف. لكن كيف سنتمكن من إقناع “سعد الطالع” الرجل السبعيني في قصة “شرفات مغلقة” أن زمنه انتهى! وأنه وهو عامل التشريفات ومهمته تنحصر في التهليل لسيارة الوزير. لكن الوزير الجديد يقرر الاستغناء عن هذا العرف المتمثل في رجل التشريفات. فمن يقنع سعد الطالع أن ما كان يعتبر مهنة يعتّد بها صار مجرد تهريج الآن!
لا يمكن العودة بالزمن (هذا مضمون لمح البصر) ولا يمكن العودة من نفس الطريق، لقد عبرت الماء الآثن والأحجار القلقة في كل مكان.
نأتي العالم بيدين فارغتين ولن نغادره إلا بعد أن نرد كل متعلقاتنا كما أتينا. وفي غرفة العناية الإلهية تتكثف الدينا في مائة جنية، وسكرتير يخلع عن عيني السارد النظارة؛ ويد إلهيّة تربّت على كتفه مطالبة أياه بالمائة جنيه. فيهرب بين قطع الأثاث “حتى انتهيت إلى باب أخير، عندئذ سمعت صوت سكرتيره يهتف بي، ها أنت تعرف الطريق بدون نظارة”
كتب أحدهم مرة: أنه وفي كل التفاتة يسجل جهازنا الشميّ والسمعيّ والبصري آلاف الروائح والأصوات والصور. وما الفن إلا محاولة الإمساك بكل ذلك! بحيث يبدو المضمون مجرد ذريعة للتمسك بالشكل الجميل.
من السهل أن نقبل التشابهات والمصادفات في الحياة، ولكن من المحال تصديق ذلك في الأدب؛ الذي يجد صعوبة في إقناعنا؛ إلا إذا استطاع أن يقلد حبكاتها ومكائدها وألعابها البهلوانية. لكن “مجموعة القصص” التي هي مختارات من عدة مجاميع قصصية لسيد الوكيل. تجنح بنا كسفينة قراصنة، تحتفي بالحياة بكل تقلباتها. وتقبل الموت بنفس الخفة التي نقبل فيها على الحياة. ونقع في قلب الوجود الماثل في ضحكة ترن في الذاكرة، أو نغم قديم، ابتسامة، أو التفاتة. أو قبلة. وربما يكون هذا جوهر ما قصده ماركيز حين كتب أن “الفن يكمن في هذا التفصيل بالذات، أن ينجح بتحويل المألوف والبديهي إلى إدهاشي”
هناك لعبة شعبية تدعى “الطميمة” أو “الغميضة” في هذه اللعبة يدور مجموعة من الصبية حول طفل يقف في منتصف الدائرة، وقد وضع عصابة فوق عينيه. وهذا الأخير الذي يتبرع بالوقوف في منتصف الدائرة بهذه الهيئة عليه أن يتعرف إليهم بوسيلة أخرى تبدأ بالأنامل واللمس والرائحة ولا تنتهي بالقلب.
هذا الطفل سيقضي حياته وهو يحدق من ثقب باربوس. يتنهد مع الآخرين، ويفرح معهم ويتألم لغيابهم. هذا الطفل /الكاتب. ستكون مهمته أن يرصد وعبر منظار قلبه وذاكرته كيف تتوهج نجمة وكيف يكون موتها!
فدوى العبود/كاتبة سورية

النـــــــظر مــــــــــن ثقــــــــب باربـــــــوس قراءة في كتاب “مختارات قصصية ” سيد الوكيل
فدوى العبود/ سوريا كانت الوردة اسماً ونحن لا نمسك إلاّ الأسماء امبرتو ايكو ***** مالذي يهمّنا في الفن ومالذي نرومه من الكتابة؟ أن نستعيد حدّة مشاعرنا التي قلّمها التكرار. أم اختبار طرق الحياة والت…