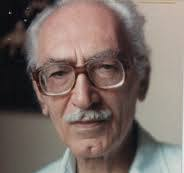الخيال الجنسي للذكور في مجتمعاتنا العربية عالم أسطوري لا تعرفه النساء، ولا يعترف به الرجال عادةً في العلن إلا متحدثين عن "آخرين" وليس عن أنفسهم. في استطلاعي العشوائي لملامح من الأزمة الجنسية في بلداننا، لم أكن أسأل عن حالات الاشتهاء الجنسي المغاير، أي بين مختلفي الجنس، بل كنت أستطلع فرضية تمهيدية تختبر فكرة أن فهم ظاهرة التحرش الجنسي، ولاسيما النسخة المتوحشة منها في مصر، لا يمكن أن يكتمل إلا باستكشاف هذا العالم الغريب والعجيب من تصورات الذكور عن العملية الجنسية، سواء في جانب الاستمتاع أم من زاوية هيمنة "الفاعل" على "المفعول بها". أتت ردود المتجاوبين مع السؤال الذي طرحتُه عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتصحّح الفرضية. فليس الخيال الجنسي مجرد رافد من روافد مشكلة التحرش، بل هو مشكلة أصلية، ربما يكون التحرش فرعاً بسيطاً من فروعها يحتاج لنموه بيئة آمنة من العقوبة، ثم يتوحش في ظروف تحفيزية وتشجيعية أخرى.
ولعل الأهم من رصد ملامح أزمتنا الجنسية العميقة هو حصرها وترتيبها وتفسير علاقاتها البيَنية، كأسباب ثم كحوافز ثم كنتائج. ولأننا نفتقد في عالمنا العربي عموماً ما يمكن الاعتماد عليه من دراسات إحصائية (فهي إن وُجدت ستُعتبر ضعيفة المصداقية في جوّ معادٍ للبحث السوسيولوجي على المستويات كافة، سياسياً وأمنياً واجتماعياً وأكاديمياً). وفيما يخص الجنس تحديداً، فليس أمامنا سوى الترجيح في تحليلات كيفية تعتمد على الملاحظة والمعايشة والمقابلات..
خيال الذكر العربي: وهم الفحولة المهيمنة
لا يمكن نفي العلاقة بين تأخر سن الزواج وبين مشكلة التحرش، لكن يمكن الجدل بأن العلاقة ليست سببية، بدليل عدم انقطاع التحرش وسط المتزوجين من الذكور بنسب مرتفعة (وكلمة "نسبة" هنا تقديرية وليست إحصائية)، والأصح أنها علاقة تحفيزية. المقصود بالتحفيز ليس تحفيزاً جنسياً بسيطاً، بل تحفيز مركّب لإعادة إنتاج علاقة القوة والهيمنة المستبيحة للطرف الأضعف، بعد أن وقع الذكَر تحت استباحة جسده من قبل السلطة – بمفهومها الواسع – وظروف المعيشة المادية. تشارك الأنثى – بالطبع – الذكر في القهر المعيشي والسياسي، بل يزداد قهرها عن قهره لكونها أنثى في مجتمع يتمحور حول الذكر. لكنا هنا نحاول تتبع الطرف المعتدي، الذي انتقل من التحرش الجنسي إلى مرحلة الاستباحة. يتعرض الجسد للإذلال في تفاصيل الحياة اليومية؛ تنقطع عنه الكهرباء، فيتوقف موتور رفع المياه في العمارات الخرسانية المرتفعة، فلا يجد ما يغسل به وجهه صباحاً، ويعمل في عطلةٍ من المراوح ومكيفات الهواء في قيظ الظهيرة، أو يتناول عشاءه في الظلام. تنتهكه المواصلات العامة، ويخنقه المرور في سيارته الخاصة. ترهقه طوابير البيروقراطية، وتذل شركات الاتصالات والإنترنت أنفاسه. يتوزع إذلال الجسد على حواسه الخمس. يسمع ضجيجاً مزعجاً، يرى قبحاً منفّراً، يتنفس هواءً مسمماً، يشرب ماءً ملوثاً، يأكل طعاماً مسرطناً.. وحين يريد الفرار، تعترضه العوائق المحلية والأجنبية من تصريح السفر إلى تأشيرة دخول البلاد الأخرى. يعود في نهاية يومه، بعد مسيرة طويلة من إذلال البدن والروح والإرادة، فيجد الشيب في شعره ولا يجد رفيقة في سريره.
تلجأ نسبة كبيرة من الذكور إلى المكيّفات والمخدرات لتخفيف وطأة القهر والإذلال على أنفسهم، وبعضهم يذهب للحصول على خدمة جنسية مدفوعة الأجر. يقضي وطره فيكتشف أنه قد وقع في الحرام الديني والمخاطرة الصحية، يحتقر فعلته، لكنه لا يعترف – وقتئذٍ – بمسؤوليته ولا بضعفه الذي أوقعه في ما لا يريد هو، أو ما يريده الناس ويقبله، فيؤذي الطرف الآخر، العاملة في مجال الخدمات الجنسية، معنوياً، وربما بدنياً. يظل الذكر في دوامة قهر السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، فلا يستطيع الدخول في علاقة جنسية مرْضية اجتماعياً وأخلاقياً إلا بالزواج المؤجل والمعطّل، من دون أن يؤمّن ذلك له – بالضرورة – الرضا والإشباع الجنسي.
تتعرض فحولة الذكر المعنوية للقهر والإذلال من السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعجز عن مقاومتها في الاتجاه المضاد، فيَخضع جسده ليكون ممراً للقوة المهيمنة والمستبيحة إلى الطرف الأضعف. يؤدي الذكر دور "الضحية الوسيطة"، التي هي بدورها جانية – كاملة المسؤولية – على طرف أضعف، الأنثى. قد تكون الضحية الوسيطة أباً على أبنائه، أو مديراً على مرؤوسيه، أو كبير عائلة على شقيقاته وأشقائه، لكنّا هنا نرصد ما يخص الجنس تحديداً. يفتح الذكر المواقع الإباحية فيتشكل خياله الجنسي وفق تصورات أسطورية ومريضة رسمها صانعو الأفلام لأغراض ربحية، وربما يقرأ أو يسمع عن قصص جنسية من التراث العربي والإسلامي يتحسر بسببها على حاله. يتحسس فحولته الحقيقية فيجدها في خطر. يتضاعف القهر الجسدي ويضاف إليه قمع جنسي ممزوج بالحرمان والخيال السقيم. وفي ثقافة ترى المرأة تابعاً، وخروجها إلى المجال العام تهديداً، وتمكينها ظلماً وانقلاباً على المعايير الذكورية، يتطور القهر الجنسي إلى عداء لتلك الأجساد المرغوبة المستحيلة، عداء تغذّيه دوافع انتقامية لا تنفك تبحث في مكبّ نفايات التسويغات عن أي ذريعة لاستباحة جسد الأنثى، التي يقال عنها – فيما يقال – أنها خرجت من بيتها لتسطو على وظائف الذكور المتعطلين، ولتكون عرضة لما تستحقه (وتريده!) من انتهاك.
في هذا السياق، يمكن فهم لماذا تتعرض الإناث في مصر للتحرش الجنسي بالعصيّ الخشبية من دون لمس جسدي مباشر، أو لماذا اعتدَى مجموعة من المتحرشين في قلب ميدان التحرير على ضحيتهم بطعن أعضائها الجنسية بالسكين. كذلك، يمكننا تفسير السعار الذي لم يستثنِ عيون المنتقبات أو أحذية النساء في مجتمعات الفصل الصارم بين الجنسين، كما يمكن فهم سبب توريث الاستباحة للأطفال من الذكور الذين لم يبلغوا الحُلُم، إذْ خرج التحرش عن كونه فعلاً جنسياً شهوانياً من قبل الضحية الوسيطة، أو المعتدِي المقهور المحروم (والمسؤول)، إلى فجاجة حقيقته كانتقامٍ ذي طابع جنسي ضد الضحية النهائية المعتدَى عليها، الأضعف اجتماعياً وسياسياً، والمخذولة من حماية سلطة الدولة وحكم القانون. وحين تصرخ الضحية أو تستغيث، أو تخاف فتسكت مقهورة، يستدعي خيال الذكر ما رآه في أفلام السادية الجنسية فيُقْنع نفسه ومن حوله بأنها سعيدة – بل مستمتعة – بجريمته/ جريمتهم.
اللحم المستباح: سطو أم صفقة؟
تأخُّر سن الزواج، والإثارة الجنسية غير السوية، وغياب الردع القانوني إذاً هي من عوامل بزوغ أزمة التحرش الجنسي ونموها واستفحالها. لكن الجزم بعلاقة سببية مباشرة لا يزال بعيداً عن هذا المثلث التحفيزي. أتجاسر لأجادل بوجود صفقة اجتماعية كبرى لاستباحة أجساد النساء. نعم، صفقة! إذ أن الأمر لم يعدْ بعدُ في دائرة التلصص والاختلاس، بل بلغ درجة غير مسبوقة من التبجح ولوم الضحية، تشي بأن هناك اتفاقاً موسعاً متعدد الأطراف عقده شركاء الجريمة، مجتمعين بالحضور والفعل والكلام، أو متواطئين بالغياب والصمت.
تدور آلة قهر الأجساد وإذلالها بلا هوادة تحت إشراف سلطة بوليسية عسكرية تدرك تماماً ما تصنعه. وتغيب دولة القانون وردع المجرمين، إذْ تنصرف الشرطة إلى الأمن السياسي، وتنشغل السلطة القضائية بحفظ مصالحها الطبقية والشللية وتحالفاتها السياسية والاقتصادية، ويظل التشريع قاصراً طوعاً أو كرهاً. أما المجتمع، فتسوده أجيال نشأت في رأسمالية الدولة، ثم ترعرعت متشربة ثقافة القطط السمان التي فتح لها السادات مصاريع أبواب كامب ديفيد والعودة من حقول آبار استخراج المال والتدين المظهري، وتتسلط على أجيال ولدت في الثمانينيات والتسعينيات لتفرض عليهم عُقَد الاستهلاك وأمراضه، وتشترط في الزواج ما لم يدر بخلد بني عبس، فيشيخ عنترة قبل أن يخضّب شِيب رأسه عشية زفافه على عبلة في فندق ذي نجومٍ خمس وراقصات ثلاث، إحداهن تعرف عن العريس ما لا تعرفه العروس بعد. تتشنج النسويات رافضاتٍ ربط تأخر سن الزواج بظاهرة التحرش الجنسي خوفاً من فهمها كعلاقة سببية بسيطة، فيسود هنا نوع من الإرهاب الفكري، ويظل الفهم مبتسراً.
يبدع صناع السينما في الانحطاط. تارةً يمجّدون صفع الأنثى التي تبكي برقة وأنوثة خاضعة في حضن صافعها، الفحل المسيطر (عادل إمام نموذجاً)، وتارةً يروّجون للتحرش الجنسي بالقول واللمس باعتباره مغازلة ماهرة ينجح بها الفتى الوسيم في اصطياد الجميلات (تامر حسني مثالاً)، فضلاً عن تغذية الخيال الجنسي البائس بأوهام فحولة الذكر المصري/العربي التي تخفق لها قلوب العذارى وتشتاق إلى لقياها الشقراوات. أما الحقوقيون والتقدميون فقد قص الرقيب الليبرالي ألسنتهم خشية اتهامهم بمعاداة "حرية الإبداع والتعبير" فتركوا نقد أفلام صناعة التحرش الجنسي والاستباحة للخطاب المحافظ وصهره الرجعي بركاكتهما المعهودة وحسّهما الأدبي والفني المتقهقر.
وأما شيوخ الاستباحة وكهنة معبدها وسدنة أستارها، فهم بلا شك رجال الدين من المسلمين والمسيحيين سواءً بسواء، الذين تفوقوا على المنطق الذكوري الشعبوي بتجذير الوساخة دينياً. في زمن مضى، كان الخطاب الديني يدعو الذكور إلى غض البصر قبل أن يحض الإناث – بلطف – على الحجاب. كان ذلك قبل أن يتحول الحجاب من أقلية في المدن الكبرى إلى أكثرية في الطبقات الدنيا والشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة المتوسطة (موجة وجدي غنيم)، ثم إلى أغلبية ساحقة بانضمام الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة وقطاعات واسعة من الطبقة البرجوازية الكبيرة (موضة عمرو خالد). حينئذٍ كشر الخطاب الديني عن أنيابه ليحمّل ما ظهر من أجساد النساء عبء الغلاء والبلاء والوباء. وما لبث الخطاب الديني يلوم المرأة حتى بلغ ذروته مع صعود الإسلاميين بعد الثورة المصرية، فرأينا أحدهم يلوم ضحية التحرش الجنسي، ولو كانت منتقبة بالبرقع، لأنها خرجت من بيتها ابتداءً، ثم سمعنا الخسة والضعة ناطقتيْن على لسانِ آخرَ يستنكر على الضحية نزولها للتظاهر ضد الحكم العسكري نهاية 2011، ويحملها مسؤولية اعتداء العسكر عليها بالركل في بطنها المكشوف بعد هتك ستر عباءتها. أما القساوسة فهم أجبن من اتخاذ موقف لحماية بناتهم إذا تحرش بهن رجال الشرطة المنوط بهم حماية كنائسهم، أو بالأدق كنائس النظام.. أخيراً، فإن "تبعيض" الفئات المذكورة أعلاه للسلامة من التعميم الذي قد يراه البعض مجحفاً، ليس من مسؤولية الكاتب هنا، بل هي مسؤولية المنتمين إلى تلك الفئات إذا أرادوا مقاومة الانحطاط والتبرؤ من الصفقة الوقحة!
* باحث في علم الاجتماع السياسي ــ من مصر
ولعل الأهم من رصد ملامح أزمتنا الجنسية العميقة هو حصرها وترتيبها وتفسير علاقاتها البيَنية، كأسباب ثم كحوافز ثم كنتائج. ولأننا نفتقد في عالمنا العربي عموماً ما يمكن الاعتماد عليه من دراسات إحصائية (فهي إن وُجدت ستُعتبر ضعيفة المصداقية في جوّ معادٍ للبحث السوسيولوجي على المستويات كافة، سياسياً وأمنياً واجتماعياً وأكاديمياً). وفيما يخص الجنس تحديداً، فليس أمامنا سوى الترجيح في تحليلات كيفية تعتمد على الملاحظة والمعايشة والمقابلات..
خيال الذكر العربي: وهم الفحولة المهيمنة
لا يمكن نفي العلاقة بين تأخر سن الزواج وبين مشكلة التحرش، لكن يمكن الجدل بأن العلاقة ليست سببية، بدليل عدم انقطاع التحرش وسط المتزوجين من الذكور بنسب مرتفعة (وكلمة "نسبة" هنا تقديرية وليست إحصائية)، والأصح أنها علاقة تحفيزية. المقصود بالتحفيز ليس تحفيزاً جنسياً بسيطاً، بل تحفيز مركّب لإعادة إنتاج علاقة القوة والهيمنة المستبيحة للطرف الأضعف، بعد أن وقع الذكَر تحت استباحة جسده من قبل السلطة – بمفهومها الواسع – وظروف المعيشة المادية. تشارك الأنثى – بالطبع – الذكر في القهر المعيشي والسياسي، بل يزداد قهرها عن قهره لكونها أنثى في مجتمع يتمحور حول الذكر. لكنا هنا نحاول تتبع الطرف المعتدي، الذي انتقل من التحرش الجنسي إلى مرحلة الاستباحة. يتعرض الجسد للإذلال في تفاصيل الحياة اليومية؛ تنقطع عنه الكهرباء، فيتوقف موتور رفع المياه في العمارات الخرسانية المرتفعة، فلا يجد ما يغسل به وجهه صباحاً، ويعمل في عطلةٍ من المراوح ومكيفات الهواء في قيظ الظهيرة، أو يتناول عشاءه في الظلام. تنتهكه المواصلات العامة، ويخنقه المرور في سيارته الخاصة. ترهقه طوابير البيروقراطية، وتذل شركات الاتصالات والإنترنت أنفاسه. يتوزع إذلال الجسد على حواسه الخمس. يسمع ضجيجاً مزعجاً، يرى قبحاً منفّراً، يتنفس هواءً مسمماً، يشرب ماءً ملوثاً، يأكل طعاماً مسرطناً.. وحين يريد الفرار، تعترضه العوائق المحلية والأجنبية من تصريح السفر إلى تأشيرة دخول البلاد الأخرى. يعود في نهاية يومه، بعد مسيرة طويلة من إذلال البدن والروح والإرادة، فيجد الشيب في شعره ولا يجد رفيقة في سريره.
تلجأ نسبة كبيرة من الذكور إلى المكيّفات والمخدرات لتخفيف وطأة القهر والإذلال على أنفسهم، وبعضهم يذهب للحصول على خدمة جنسية مدفوعة الأجر. يقضي وطره فيكتشف أنه قد وقع في الحرام الديني والمخاطرة الصحية، يحتقر فعلته، لكنه لا يعترف – وقتئذٍ – بمسؤوليته ولا بضعفه الذي أوقعه في ما لا يريد هو، أو ما يريده الناس ويقبله، فيؤذي الطرف الآخر، العاملة في مجال الخدمات الجنسية، معنوياً، وربما بدنياً. يظل الذكر في دوامة قهر السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، فلا يستطيع الدخول في علاقة جنسية مرْضية اجتماعياً وأخلاقياً إلا بالزواج المؤجل والمعطّل، من دون أن يؤمّن ذلك له – بالضرورة – الرضا والإشباع الجنسي.
تتعرض فحولة الذكر المعنوية للقهر والإذلال من السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعجز عن مقاومتها في الاتجاه المضاد، فيَخضع جسده ليكون ممراً للقوة المهيمنة والمستبيحة إلى الطرف الأضعف. يؤدي الذكر دور "الضحية الوسيطة"، التي هي بدورها جانية – كاملة المسؤولية – على طرف أضعف، الأنثى. قد تكون الضحية الوسيطة أباً على أبنائه، أو مديراً على مرؤوسيه، أو كبير عائلة على شقيقاته وأشقائه، لكنّا هنا نرصد ما يخص الجنس تحديداً. يفتح الذكر المواقع الإباحية فيتشكل خياله الجنسي وفق تصورات أسطورية ومريضة رسمها صانعو الأفلام لأغراض ربحية، وربما يقرأ أو يسمع عن قصص جنسية من التراث العربي والإسلامي يتحسر بسببها على حاله. يتحسس فحولته الحقيقية فيجدها في خطر. يتضاعف القهر الجسدي ويضاف إليه قمع جنسي ممزوج بالحرمان والخيال السقيم. وفي ثقافة ترى المرأة تابعاً، وخروجها إلى المجال العام تهديداً، وتمكينها ظلماً وانقلاباً على المعايير الذكورية، يتطور القهر الجنسي إلى عداء لتلك الأجساد المرغوبة المستحيلة، عداء تغذّيه دوافع انتقامية لا تنفك تبحث في مكبّ نفايات التسويغات عن أي ذريعة لاستباحة جسد الأنثى، التي يقال عنها – فيما يقال – أنها خرجت من بيتها لتسطو على وظائف الذكور المتعطلين، ولتكون عرضة لما تستحقه (وتريده!) من انتهاك.
في هذا السياق، يمكن فهم لماذا تتعرض الإناث في مصر للتحرش الجنسي بالعصيّ الخشبية من دون لمس جسدي مباشر، أو لماذا اعتدَى مجموعة من المتحرشين في قلب ميدان التحرير على ضحيتهم بطعن أعضائها الجنسية بالسكين. كذلك، يمكننا تفسير السعار الذي لم يستثنِ عيون المنتقبات أو أحذية النساء في مجتمعات الفصل الصارم بين الجنسين، كما يمكن فهم سبب توريث الاستباحة للأطفال من الذكور الذين لم يبلغوا الحُلُم، إذْ خرج التحرش عن كونه فعلاً جنسياً شهوانياً من قبل الضحية الوسيطة، أو المعتدِي المقهور المحروم (والمسؤول)، إلى فجاجة حقيقته كانتقامٍ ذي طابع جنسي ضد الضحية النهائية المعتدَى عليها، الأضعف اجتماعياً وسياسياً، والمخذولة من حماية سلطة الدولة وحكم القانون. وحين تصرخ الضحية أو تستغيث، أو تخاف فتسكت مقهورة، يستدعي خيال الذكر ما رآه في أفلام السادية الجنسية فيُقْنع نفسه ومن حوله بأنها سعيدة – بل مستمتعة – بجريمته/ جريمتهم.
اللحم المستباح: سطو أم صفقة؟
تأخُّر سن الزواج، والإثارة الجنسية غير السوية، وغياب الردع القانوني إذاً هي من عوامل بزوغ أزمة التحرش الجنسي ونموها واستفحالها. لكن الجزم بعلاقة سببية مباشرة لا يزال بعيداً عن هذا المثلث التحفيزي. أتجاسر لأجادل بوجود صفقة اجتماعية كبرى لاستباحة أجساد النساء. نعم، صفقة! إذ أن الأمر لم يعدْ بعدُ في دائرة التلصص والاختلاس، بل بلغ درجة غير مسبوقة من التبجح ولوم الضحية، تشي بأن هناك اتفاقاً موسعاً متعدد الأطراف عقده شركاء الجريمة، مجتمعين بالحضور والفعل والكلام، أو متواطئين بالغياب والصمت.
تدور آلة قهر الأجساد وإذلالها بلا هوادة تحت إشراف سلطة بوليسية عسكرية تدرك تماماً ما تصنعه. وتغيب دولة القانون وردع المجرمين، إذْ تنصرف الشرطة إلى الأمن السياسي، وتنشغل السلطة القضائية بحفظ مصالحها الطبقية والشللية وتحالفاتها السياسية والاقتصادية، ويظل التشريع قاصراً طوعاً أو كرهاً. أما المجتمع، فتسوده أجيال نشأت في رأسمالية الدولة، ثم ترعرعت متشربة ثقافة القطط السمان التي فتح لها السادات مصاريع أبواب كامب ديفيد والعودة من حقول آبار استخراج المال والتدين المظهري، وتتسلط على أجيال ولدت في الثمانينيات والتسعينيات لتفرض عليهم عُقَد الاستهلاك وأمراضه، وتشترط في الزواج ما لم يدر بخلد بني عبس، فيشيخ عنترة قبل أن يخضّب شِيب رأسه عشية زفافه على عبلة في فندق ذي نجومٍ خمس وراقصات ثلاث، إحداهن تعرف عن العريس ما لا تعرفه العروس بعد. تتشنج النسويات رافضاتٍ ربط تأخر سن الزواج بظاهرة التحرش الجنسي خوفاً من فهمها كعلاقة سببية بسيطة، فيسود هنا نوع من الإرهاب الفكري، ويظل الفهم مبتسراً.
يبدع صناع السينما في الانحطاط. تارةً يمجّدون صفع الأنثى التي تبكي برقة وأنوثة خاضعة في حضن صافعها، الفحل المسيطر (عادل إمام نموذجاً)، وتارةً يروّجون للتحرش الجنسي بالقول واللمس باعتباره مغازلة ماهرة ينجح بها الفتى الوسيم في اصطياد الجميلات (تامر حسني مثالاً)، فضلاً عن تغذية الخيال الجنسي البائس بأوهام فحولة الذكر المصري/العربي التي تخفق لها قلوب العذارى وتشتاق إلى لقياها الشقراوات. أما الحقوقيون والتقدميون فقد قص الرقيب الليبرالي ألسنتهم خشية اتهامهم بمعاداة "حرية الإبداع والتعبير" فتركوا نقد أفلام صناعة التحرش الجنسي والاستباحة للخطاب المحافظ وصهره الرجعي بركاكتهما المعهودة وحسّهما الأدبي والفني المتقهقر.
وأما شيوخ الاستباحة وكهنة معبدها وسدنة أستارها، فهم بلا شك رجال الدين من المسلمين والمسيحيين سواءً بسواء، الذين تفوقوا على المنطق الذكوري الشعبوي بتجذير الوساخة دينياً. في زمن مضى، كان الخطاب الديني يدعو الذكور إلى غض البصر قبل أن يحض الإناث – بلطف – على الحجاب. كان ذلك قبل أن يتحول الحجاب من أقلية في المدن الكبرى إلى أكثرية في الطبقات الدنيا والشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة المتوسطة (موجة وجدي غنيم)، ثم إلى أغلبية ساحقة بانضمام الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة وقطاعات واسعة من الطبقة البرجوازية الكبيرة (موضة عمرو خالد). حينئذٍ كشر الخطاب الديني عن أنيابه ليحمّل ما ظهر من أجساد النساء عبء الغلاء والبلاء والوباء. وما لبث الخطاب الديني يلوم المرأة حتى بلغ ذروته مع صعود الإسلاميين بعد الثورة المصرية، فرأينا أحدهم يلوم ضحية التحرش الجنسي، ولو كانت منتقبة بالبرقع، لأنها خرجت من بيتها ابتداءً، ثم سمعنا الخسة والضعة ناطقتيْن على لسانِ آخرَ يستنكر على الضحية نزولها للتظاهر ضد الحكم العسكري نهاية 2011، ويحملها مسؤولية اعتداء العسكر عليها بالركل في بطنها المكشوف بعد هتك ستر عباءتها. أما القساوسة فهم أجبن من اتخاذ موقف لحماية بناتهم إذا تحرش بهن رجال الشرطة المنوط بهم حماية كنائسهم، أو بالأدق كنائس النظام.. أخيراً، فإن "تبعيض" الفئات المذكورة أعلاه للسلامة من التعميم الذي قد يراه البعض مجحفاً، ليس من مسؤولية الكاتب هنا، بل هي مسؤولية المنتمين إلى تلك الفئات إذا أرادوا مقاومة الانحطاط والتبرؤ من الصفقة الوقحة!
* باحث في علم الاجتماع السياسي ــ من مصر