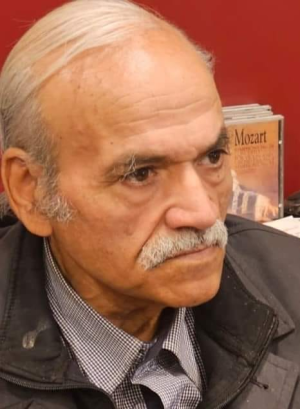عبر التاريخ تلازم التجريد مع التجسيد في جدل مستمر للبحث عن الحقيقة ولتحقيق المصلحة ولتوفير الشعور بالأمان وحسن الخلاص.
عبر التاريخ كانت الطبيعة والغريزة والمتعة واللذة والألم ترتبط بالتجسيد، في حين كان استنتاج الذهن يميل إلى الاستخلاص والاستنتاج والفهم والاستنباط والتقييم والتعديل للتحكم بالفكر والقول في الفعل. فكانت محاولات التجريد.
كانت اللغة هي الوسيلة، وكان ما تحمله الألفاظ من دلالات تتطور وتتراكم لتنتج مفاهيم واصطلاحات مركبة جامعة في الذهن أفكار وحقائق موجهة بتنظيم للفعل وللعادات والتقاليد والأعراف، من خلال قوانين وأحكام وتشريعات.
لقد استطاعت اللغة أن تكون المركب الذي سيطور مسار الإنسانية من التجسيد الى التجريد، من المرحلة الطبيعية إلى المرحلة الثقافية بلغة الأنثروبولوجيا، من المرحلة البدائية إلى البناء الحضاري، من الحياة البسيطة إلى المركبة، من الفعل الحسي المباشر إلى الرمز الآمر.
هذه اللغة، استطاعت كذلك أن تختزل تعقيد الحياة وصعوبة نفوذ سلطة من السلطات عبر القانون، عبر كلام الكهنة ولسان الآلهة الوثنية، وجعلته يخدع الإنسان البدائي حتى يخضع، حتى يتحول من متوحش مفترس إلى لطيف متحضر وديع.
ركبت اللغة أسطول الديانات فرَقَتْ من الصغيرة إلى الكبيرة، من الطبيعة الأرضية ـ الوضعية إلى السماوية المجردة.
كم جربت تأليه البشر، لكن خانها موت الإله، هيكله العظمي، ذهاب روحه وأوامره الكاريزمية المخيفة والمرعبة. كيف ستحافظ على سلطتها؟ لم يمت الإله، صَعُدَ إلى السماء، يحكم من فوق، تَرك تعاليمه في الهند كما في مصر كما في أدغال إفريقيا وأمريكا... لقد تجرد الإله بعد أن تجسد، أصبح روحا بعد أن كان مادة. لكن سلطة خطابه لا زالت حاضرة قوية فعالة، ضمن استمراره بمؤسساته وكهنوته وطبقته ومصالحها.
لقد قامت الأديان السماوية عبر التاريخ بتصفية هذا المخاض الذي أصبح دوامة تغرق الإنسانية في الرجوع إلى التجسيد. دعت منذ آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام أجمعين، دعت إلى عبادة إله واحد، إلى نزع الروحانية والتقديس من كل الآلهة الوضعية: طبيعية أو بشرية أو خرافية...
هدم إبراهيم عليه السلام أوثان معبد قومه، جعل فعله سخرية عبثية من العقل الإنساني الذي لا يزال واهيا في عبادة الأحجار المجسمة، اخترق محمدٌ (صلى الله عليه وسلم) الكعبة وهدم أصنامها التي تفوق المئات، وأذن المؤذن فوقها ب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نداءٌ وصيحة تجريد ومحاربة للتجسيد الذي غرقت فيه الإنسانية.
وعبر التاريخ الإنساني والإسلامي، هناك حذر متبادل بين لاوعي الإنسان المتراكم عبر الزمن، والدافن والمخبئ لنزوعه الطبيعي والغريزي والبدائي... بين اللاوعي المخزون وبين رقيب الأديان السماوية في تجريد الإله، وجعله (ليس كمثله شيء) كما في القرآن الكريم، سورة الشورى.
لكن، ألمْ تفشل المسيحية في عملية التجريد؟ أم إنها مزجت بين تجسيد وتجريد، بتأليه المسيح، حتى تجعله إلها خالدا؟ ولكن، ألم تعتبره، أو لنقل لمَ لمْ تعتبره إلها خلال حياته؟ فقط بعد مماته؟ حيلٌ بدائية مع مراحل التطور الإنساني التاريخي... ربما.
عبر التاريخ الإسلامي، بقي التجسيد مادة خاما، خصبة حية في حكايات الجدات وروايات الأساطير. تُرْوى مع اقتراب المنام، حتى تسكن النفس إليها خلال النوم، حتى تخترق الأحلام وتخترق اللاشعور، فترتاح في تربة لا يصلها رقيب ديانات التوحيد. ستكتفي لتكون أضغاث أحلام. للاستئناس أو للحفاظ على الاستمرار. مادام كل كائن يبحث للحفاظ على نوعه...
لقد بقي التجسيد مادة خصبة تتشكل مع إبداع الإنسان، باحثا عن تفعيله في الاحتفالات والموسم، في علاقته وتأبينه للموتى، كانوا أجدادا أو رجال دين صالحين مؤثرين.
ربما حَذَرُ الإسلام من التجسيد يتجلى في موقفه من التماثيل والصور، في خوف رجاله من أصوات موسوسة خفية في وسائل الإعلام الحديثة والمعاصرة... ربما.
ذلك لأننا نجد حدا في الرفض والتطرف والإقصاء لعناصر الحداثة خوفا على هذا التجريد، مادام الإنسان ضعيفا مائلا إلى تجسيد. ولكن هل يمكن أن نجعل التجريد رجوعا إلى الوراء؟ نكوصا؟ رفضا للواقع ومنتجاته الحداثية والمعاصرة؟ ذهاب بالتاريخ إلى الماضي وليس إلى الحاضر والمستقبل؟ تساؤلٌ جوابُه خارج الواقع والمنطق والموضوعية. لكن تجلياته حاضرة موجودة في الأذهان وفي السلوكات والمواقف.
هل سيعني التجريد في مستوى آخر، رفض لأي تجسيد؟ لأي تشكل واقعي؟ عيش في المثال والفكرة والروح؟ طبعا لا. فهذا مستوى آخر من التحليل.
بين المومن والمسلم دمج لتجريد في تجسيد، مع تجسيد. فالإيمان تجريد للعقيدة، سحب للبساط من تحت أي تقديس لبركان أو حجر... أما الإسلام فهو تجسيد لهذا المجرد في الواقع بحضور الإله المجرد، المزيح لكل خرافة أو أسطورة أرضية... هكذا يرتبط عقل وروح الإنسان بالمجرد في الأوامر والنواهي، في العقيدة والعبادة، فيجسد ما يتلقاه من الآمر المجرد، من الإله الذي ليس كمثله شيء.
ألم يصل عمر بن الخطاب في عملية إيمانه بالمجرد الكامل إلى درجة التعليق على تقبيل الحجر الأسود بتساؤله الإبهامي: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبَّلتك"؟
ألم يعلق الرسول على شكل الكعبة وبنائها، فلم يعِد بناءها خوفا على عدم تهيؤ قومه لمرحلة تجريد أكبر في عبادة الإله المجرد الذي ليس كمثله شيء؟
ألم يتجرد المتصوفة عن المادة والجسد ويحاولوا قهرهما حتى يقع الحلول مع المجرد؟ حتى إن رابعة العدوية هي من دعت الكعبة لكي تطوف حولها بشكل من الأشكال اللامادية، ما دام الإلخ يحل في ذاتها!
ألم يتمسح الناس بالأضرحة ويمارسوا تجسيد عبادة متألمة، سالخة للجسد الذي لم يستطع أن يجرد إيمانه وعبادته عن حياته المادية والاجتماعية؟
ألم يجسدوا عجزهم عن الحج لممارسة المناسك، في حج تعويضي لمحروم من طقوس ما؟ نسميه عندنا بحج المسكين؟ فوجدنا محاج كثيرة؟ وأضرحة كثيرة يُطاف حولها، يذكر الذكر حولها، تقدس منابعها، تقسم طقوس أيامها بين صعود جبل وتطهير جسد مائي وتمسح قدسي، وتفجير نفسي لكل الاختلالات والعُقد والضغوطات الداخلية والاجتماعية، ومحاولة شراء لقوة الغيبي والمجرد بالغالي والنفيس من الأموال ـ حيث سخاء العطاء كبير ـ؟
فليحذر التجريد عملية التجسيد. ما تزال الجدلية قائمة في التجاذب بينهما، ممثلها فوق خشبة المسرح هو هذا الانسان الزئبقي المنفلت في القبضة عن حقيقته بين التجريد والتجسيد، كما انفلت عن قبضة موسى عليه السلام حين تم صنع العجل الذهبي والانصهار مع اللذة والمتعة والمادة... وتستمر الحكاية إلى ما لا نهاية بين التجريد والتجسيد.
حسن إمامي
عبر التاريخ كانت الطبيعة والغريزة والمتعة واللذة والألم ترتبط بالتجسيد، في حين كان استنتاج الذهن يميل إلى الاستخلاص والاستنتاج والفهم والاستنباط والتقييم والتعديل للتحكم بالفكر والقول في الفعل. فكانت محاولات التجريد.
كانت اللغة هي الوسيلة، وكان ما تحمله الألفاظ من دلالات تتطور وتتراكم لتنتج مفاهيم واصطلاحات مركبة جامعة في الذهن أفكار وحقائق موجهة بتنظيم للفعل وللعادات والتقاليد والأعراف، من خلال قوانين وأحكام وتشريعات.
لقد استطاعت اللغة أن تكون المركب الذي سيطور مسار الإنسانية من التجسيد الى التجريد، من المرحلة الطبيعية إلى المرحلة الثقافية بلغة الأنثروبولوجيا، من المرحلة البدائية إلى البناء الحضاري، من الحياة البسيطة إلى المركبة، من الفعل الحسي المباشر إلى الرمز الآمر.
هذه اللغة، استطاعت كذلك أن تختزل تعقيد الحياة وصعوبة نفوذ سلطة من السلطات عبر القانون، عبر كلام الكهنة ولسان الآلهة الوثنية، وجعلته يخدع الإنسان البدائي حتى يخضع، حتى يتحول من متوحش مفترس إلى لطيف متحضر وديع.
ركبت اللغة أسطول الديانات فرَقَتْ من الصغيرة إلى الكبيرة، من الطبيعة الأرضية ـ الوضعية إلى السماوية المجردة.
كم جربت تأليه البشر، لكن خانها موت الإله، هيكله العظمي، ذهاب روحه وأوامره الكاريزمية المخيفة والمرعبة. كيف ستحافظ على سلطتها؟ لم يمت الإله، صَعُدَ إلى السماء، يحكم من فوق، تَرك تعاليمه في الهند كما في مصر كما في أدغال إفريقيا وأمريكا... لقد تجرد الإله بعد أن تجسد، أصبح روحا بعد أن كان مادة. لكن سلطة خطابه لا زالت حاضرة قوية فعالة، ضمن استمراره بمؤسساته وكهنوته وطبقته ومصالحها.
لقد قامت الأديان السماوية عبر التاريخ بتصفية هذا المخاض الذي أصبح دوامة تغرق الإنسانية في الرجوع إلى التجسيد. دعت منذ آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام أجمعين، دعت إلى عبادة إله واحد، إلى نزع الروحانية والتقديس من كل الآلهة الوضعية: طبيعية أو بشرية أو خرافية...
هدم إبراهيم عليه السلام أوثان معبد قومه، جعل فعله سخرية عبثية من العقل الإنساني الذي لا يزال واهيا في عبادة الأحجار المجسمة، اخترق محمدٌ (صلى الله عليه وسلم) الكعبة وهدم أصنامها التي تفوق المئات، وأذن المؤذن فوقها ب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نداءٌ وصيحة تجريد ومحاربة للتجسيد الذي غرقت فيه الإنسانية.
وعبر التاريخ الإنساني والإسلامي، هناك حذر متبادل بين لاوعي الإنسان المتراكم عبر الزمن، والدافن والمخبئ لنزوعه الطبيعي والغريزي والبدائي... بين اللاوعي المخزون وبين رقيب الأديان السماوية في تجريد الإله، وجعله (ليس كمثله شيء) كما في القرآن الكريم، سورة الشورى.
لكن، ألمْ تفشل المسيحية في عملية التجريد؟ أم إنها مزجت بين تجسيد وتجريد، بتأليه المسيح، حتى تجعله إلها خالدا؟ ولكن، ألم تعتبره، أو لنقل لمَ لمْ تعتبره إلها خلال حياته؟ فقط بعد مماته؟ حيلٌ بدائية مع مراحل التطور الإنساني التاريخي... ربما.
عبر التاريخ الإسلامي، بقي التجسيد مادة خاما، خصبة حية في حكايات الجدات وروايات الأساطير. تُرْوى مع اقتراب المنام، حتى تسكن النفس إليها خلال النوم، حتى تخترق الأحلام وتخترق اللاشعور، فترتاح في تربة لا يصلها رقيب ديانات التوحيد. ستكتفي لتكون أضغاث أحلام. للاستئناس أو للحفاظ على الاستمرار. مادام كل كائن يبحث للحفاظ على نوعه...
لقد بقي التجسيد مادة خصبة تتشكل مع إبداع الإنسان، باحثا عن تفعيله في الاحتفالات والموسم، في علاقته وتأبينه للموتى، كانوا أجدادا أو رجال دين صالحين مؤثرين.
ربما حَذَرُ الإسلام من التجسيد يتجلى في موقفه من التماثيل والصور، في خوف رجاله من أصوات موسوسة خفية في وسائل الإعلام الحديثة والمعاصرة... ربما.
ذلك لأننا نجد حدا في الرفض والتطرف والإقصاء لعناصر الحداثة خوفا على هذا التجريد، مادام الإنسان ضعيفا مائلا إلى تجسيد. ولكن هل يمكن أن نجعل التجريد رجوعا إلى الوراء؟ نكوصا؟ رفضا للواقع ومنتجاته الحداثية والمعاصرة؟ ذهاب بالتاريخ إلى الماضي وليس إلى الحاضر والمستقبل؟ تساؤلٌ جوابُه خارج الواقع والمنطق والموضوعية. لكن تجلياته حاضرة موجودة في الأذهان وفي السلوكات والمواقف.
هل سيعني التجريد في مستوى آخر، رفض لأي تجسيد؟ لأي تشكل واقعي؟ عيش في المثال والفكرة والروح؟ طبعا لا. فهذا مستوى آخر من التحليل.
بين المومن والمسلم دمج لتجريد في تجسيد، مع تجسيد. فالإيمان تجريد للعقيدة، سحب للبساط من تحت أي تقديس لبركان أو حجر... أما الإسلام فهو تجسيد لهذا المجرد في الواقع بحضور الإله المجرد، المزيح لكل خرافة أو أسطورة أرضية... هكذا يرتبط عقل وروح الإنسان بالمجرد في الأوامر والنواهي، في العقيدة والعبادة، فيجسد ما يتلقاه من الآمر المجرد، من الإله الذي ليس كمثله شيء.
ألم يصل عمر بن الخطاب في عملية إيمانه بالمجرد الكامل إلى درجة التعليق على تقبيل الحجر الأسود بتساؤله الإبهامي: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبَّلتك"؟
ألم يعلق الرسول على شكل الكعبة وبنائها، فلم يعِد بناءها خوفا على عدم تهيؤ قومه لمرحلة تجريد أكبر في عبادة الإله المجرد الذي ليس كمثله شيء؟
ألم يتجرد المتصوفة عن المادة والجسد ويحاولوا قهرهما حتى يقع الحلول مع المجرد؟ حتى إن رابعة العدوية هي من دعت الكعبة لكي تطوف حولها بشكل من الأشكال اللامادية، ما دام الإلخ يحل في ذاتها!
ألم يتمسح الناس بالأضرحة ويمارسوا تجسيد عبادة متألمة، سالخة للجسد الذي لم يستطع أن يجرد إيمانه وعبادته عن حياته المادية والاجتماعية؟
ألم يجسدوا عجزهم عن الحج لممارسة المناسك، في حج تعويضي لمحروم من طقوس ما؟ نسميه عندنا بحج المسكين؟ فوجدنا محاج كثيرة؟ وأضرحة كثيرة يُطاف حولها، يذكر الذكر حولها، تقدس منابعها، تقسم طقوس أيامها بين صعود جبل وتطهير جسد مائي وتمسح قدسي، وتفجير نفسي لكل الاختلالات والعُقد والضغوطات الداخلية والاجتماعية، ومحاولة شراء لقوة الغيبي والمجرد بالغالي والنفيس من الأموال ـ حيث سخاء العطاء كبير ـ؟
فليحذر التجريد عملية التجسيد. ما تزال الجدلية قائمة في التجاذب بينهما، ممثلها فوق خشبة المسرح هو هذا الانسان الزئبقي المنفلت في القبضة عن حقيقته بين التجريد والتجسيد، كما انفلت عن قبضة موسى عليه السلام حين تم صنع العجل الذهبي والانصهار مع اللذة والمتعة والمادة... وتستمر الحكاية إلى ما لا نهاية بين التجريد والتجسيد.
حسن إمامي