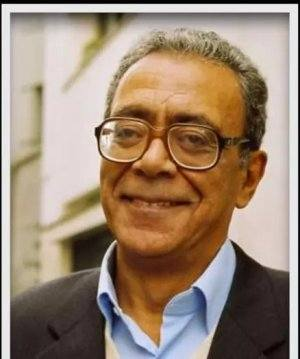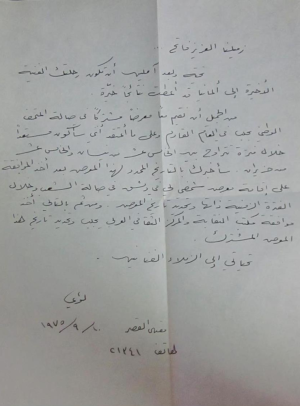إن الموتَ يُمثِّل قيمةً أساسية في الحياة . ولا نُبالِغ إذا قُلنا إن الموت هو الحياة الحقيقية . ولا يوجد إنسان لا يؤمن بالموت ، أو لا يُفكِّر به . والإنسانُ قد تنهار عقيدته فَيَجْحد وجودَ الله تعالى، ولكنْ لا يمكنه أن يَجحد وجودَ الموت . إذن ، فالموتُ هو حَجر الزاوية في البناء البشري. والحديثُ عن الموت هو الفلسفة النهائية الحاسمة ، ومختصر الخبرات الحياتية برمتها .
والشعراءُ _ باعتبارهم أكثر المخلوقات حساسيةً والتقاطاً لعناصر الطبيعة _ لا يَقدرون على الإفلات من ” إغراء الموت ” حتى لو أرادوا ذلك . وهذا يُفسِّر ذِكرَ الموت في أشعارهم ، وجعل الفلسفات والمناهج الفكرية تَدور حَوْله . فالموتُ مجالٌ خصب للتأمل في النهاية ، والأحزان ، والفِراق ، … إلخ .
والمعلَّقاتُ اعتنت بموضوع الموت ، واستمدَّت منه فلسفةً للحياة ، ومنهجاً فكرياً للإنسانية . وقد عبَّر أصحابُ المعلَّقات عن فكرة الفناء ، وعدم الخلود في الدنيا ، وأن الموت شامل لكل الأحياء، ولا مفر منه ، واستحالة العودة من الموت ، وأنه مُقدَّر . وفي الجهة المقابِلة ، نجد أفكاراً تتحدث عن ضرورة الذهاب إلى الموت وعدم انتظاره . فهو قادمٌ _ لا محالة _ فينبغي أخذ المبادَرة . وتبرز_ أيضاً _ فكرةُ عدم المبالاة بالموت، ولا بد للإنسان أن يعيش حياته بالطُّول والعَرْض ، وأن يَستمتع قَدْر المستطاع لأنه لن يَعيش إلا مرة واحدة فقط . وتَظهر فكرة ” الموت صُدفة ” ، وأنه حالة عبثية تأتي بشكل أعمى ، وغير مُسَيْطَر عليه . وهذه العقيدةُ متأثرة بالنسق الفكري الوثني الذي لا يؤمن بالحياة بعد الموت ( الحياة الآخِرة ) .
إننا أمام حالة شِعرية متفردة تتحدث عن الموت ، وتورده في سياق فني فلسفي يَعكس طبيعةَ عقائد أصحاب المعلَّقات ، والماهياتِ الفكرية الكامنة في ذواتهم ، والأحداث التاريخية المصاحِبة للشاعر وفلسفته في الموت والحياة على السواء ، لأن الأشياء تُعرَف بأضدادها .
1_ لا خلود في الدنيا :
الدنيا دارٌ زائلة لا يمكن أن تَمنح الخلودَ للعناصر . ففاقدُ الشيء لا يُعطيه . وبما أن الدنيا ذاتها غير خالدة ، إذن فلا خلود فيها . إنها فانيةٌ هِيَ ومحتوياتها. والناسُ يَرون الموت والأموات كلَّ يومٍ رأي العَيْن ، فلا مجال للتكذيب أو الشك . وكلُّ إنسان مهما تطاول عُمُرُه ، لا بد أن يُحمَل يوماً ما إلى المقبرة . وهذا الأمرُ من كثرة ما اعتاد عليه الناسُ ، صار أمراً عادياً لا يُحرِّك المشاعرَ ، ولا يُثير مكنوناتِ الصدور. فالاعتياديةُ تَجعل الإنسانَ أعمى، وعاجزاً عن رؤية الأشياء بعين البصيرة ، وغارقاً في نظام حياتي روتيني مغلَق .
ونحن نجد الشاعر طَرَفة بن العبد يشير إلى قضية ” اللاخلود ” فيقول :
ألا أيُّهذا اللائمي أَشْهَدُ الوَغَــى وأن أنهلَ اللذاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
يقول: ألا أيها الإنسان الذي يُلومني على حضور الحرب، وحضورِ الملذات، هل تخلِّدني إن كففتُ عنها ؟ .
إن الشاعرَ يُؤْمن بعدم الخلود في الدنيا . وسواءٌ شاركَ الإنسانُ في الحرب أم نام في بَيْته ، ففي كلا الحالتين لن يَنعم بالخلود . لذلك فهو يُريد أن يَعيش حياته على هواه بلا ضوابط ، أن يعيش بالطُّول والعَرْض ، ويَستمتع بكل لحظة ، ويَفعل ما يَحلو له. ففي كل الحالات ، هُو غير خالد ، والموتُ قادمٌ لا محالة ، والمسألةُ مسألةُ وقتٍ لا أكثر ولا أقل. وهذه القناعةُ لم تُكسِب الشاعرَ إحساساً بالمسؤولية ، بل على العكس ، أغرقته في اللامبالاة واللاجَدْوى ، وأكسبته شعوراً بالعَدَم والضياع . وبما أن الموتَ قادمٌ ، والخلود متعذِّر ، فلماذا لا يستمتع بحياته ويشارك في الحرب ويصنع مجدَه الشخصي ومجدَ قبيلته ويَنهل من اللذات قبل أن يداهمه الموت ؟! . إنها رُوحٌ جاهلية وثنية تَعتبر الموتَ نقطة النهاية ، ولا شيء بعدها. وبالتالي ، لا بد من استغلال الحياة الدنيا في الاستمتاع ، وتحقيق رغائب النَّفس كاملةً غير منقوصة . ومن الواضح أن سلوكَ الشاعرِ العابثَ قد سَبَّبَ له المتاعبَ ، وجلبَ له الانتقاداتِ والعتابَ . وبالطبع ، فإن الشخص الذي يَرى التصرفاتِ الطائشة للشاعر لا بد أن يَلومه . وهذا اللومُ يَنبع من تطبيقات العقل الجمعي ، ويَنطلق من فلسفة اجتماعية سائدة تتطلب التوازنَ في أداء الأعمال، وتحمُّلَ المسؤولية، واحترامَ قيمة الحياة، وعدم تضييعها في اللذات الوقتية ، والسلوكياتِ غير المحسوبة .
2_ الذهاب إلى الموت وعدم انتظاره :
من الواضح أن الشاعر طَرَفة بن العبد يؤسس فلسفته الخاصة بالموت وملابساته ، وما يُرافقه من أحداث فكرية أو مادية واقعية . وها هُوَ يقول :
فإنْ كُنتَ لا تسطيعُ دَفْعَ مَنِيَّتي فَدَعْني أُبادِرْها بما مَلَكَتْ يدي
إن الشاعر يَبني فلسفته الذاتية حول فكرة ” استحالة دفع الموت ” ، لكنه يُحيط هذه الفكرة الصحيحة بسلوكيات خاطئة وتطبيقاتٍ سلبية. فالشاعرُ يرى ضرورةَ الغرق في الملذات والشهوات بلا حساب ، لأن الموت قادمٌ بشكل مؤكَّد لا شك فيه . فبدلاً من أن يصبح الموت باعثاً على الزهد والاستقامة ، يصبح باعثاً على اللامبالاة والعبث والتبذير . وهذه هي فلسفة طَرَفة بن العبد التي بثَّها في أشعاره .
يقول طَرَفة : فإن كنتَ لا تستطيع أن تدفع مَوْتي ، فدعني أُبادر الموتَ بإنفاق أملاكي .
إنه في سِباق مع الموت ، ويُريد أن يُسابق الموتَ قبل أن يُباغته . وهكذا تتجلى روحُ المبادَرة ، مُبادَرة الموت واقتحام عالَمه ، وذلك بإضاعة الممتلكات ، وتبذير الأموال، والاستمتاع بالملذات إلى الدرجة القُصوى. فالموتُ سيتلفُ أملاكَ الشاعر، ولن يُبقيَ له شيئاً . لذلك يَحاول الشاعرُ أن يَسبق الموتَ ، ويأخذ على عاتقه إتلاف أمواله بنَفْسه ، وعدم منح الموت هذه الفرصة .
والمنهجيةُ الفلسفيةُ المسيطرة على الشاعر في هذا السياق هي أن الموت لا بد منه ، فلا معنى للبخل ، وتركِ الملذات ، وإدارةِ الظَّهر للشهوات . فعلى المرء أن يَستمتع بالحياة ولذاتها بكل الوسائل المتاحة ، فالغايةُ تبرِّر الوسيلةَ ، والإنسانُ لن يَعيش مرةً أُخرى ، فعليه اغتنام هذه الفرصة قبل فواتها. فالمتعةُ إذا ذَهبت لن تَعود . وهكذا يُصبح الموتُ حافزاً على الغرق في الشهوات بلا ضوابط ، وليس حافزاً على العمل المثمر ، وسلوكِ الطريق القويم .
ومن الملاحَظ أن فلسفةَ طَرَفة بن العبد تنطوي على ردة فعل عكسية . فالمفروضُ أن يَقطعَ الموتُ لذاتِ النفوس ورغباتها ، ويدفعَ إلى الصلاح والخير ، باعتباره هادمَ اللذات ، ومُفرِّق الجماعات ، ومُيتِّم البنين والبنات . أمَّا في حالة طَرَفة ، فقد تحوَّلت صدمةُ الموت إلى مزيد من الشهوانية والعبث واللاجَدْوى. ففي بعض الأحيان، يؤدي النُّورُ الباهر إلى العَمى لا قوة الإبصار . كما أن كَثرة الشَّد يُرخي . وهذا ما نراه جلياً في فلسفة طَرَفة المتعلقة بالموت، وتطبيقاتها الشعرية .
3_ عدم المبالاة بالموت :
يواصل الشاعرُ طَرَفة بن العبد سياسته تجاه الموت ، حيث إنه لا يُبالي به ، ولا يُقيم له وزناً . هذه هي القاعدة الأساسية في فلسفته حول الموت . أمَّا الاستثناءُ فهو ما عبَّر عنه في قَوْله :
وَلَوْلا ثَلاثٌ هُنَّ مِن عِيشَةِ الفَتى وَجَدِّكَ لم أحفِلْ متى قامَ عُوَّدي
يقول طَرَفة : فَلَوْلا حُبِّي ثلاث خِصال هُنَّ من لذة الفتى الكريم لم أبالِ متى أقام عُوَّدي من عندي آيسين من حياتي . أي لم أُبالِ متى مِتُّ .
وهذا البيتُ يَحمل تشويقاً كبيراً ، ويشدُّ انتباهَ السامع . فالشاعرُ يَنظر إلى الموت على أنه نهاية المطاف ، وأن الحياة مهزلةٌ كبرى. وهو لا يُبالي بالموت ولا الحياة على حَدٍّ سَواء . لكنَّ هناك ثلاث خصال تَجعله حريصاً على حياته، ومُبالياً بالموت إلى حَد بعيد . وهذه الخِصالُ هي : شرب الخمر، وإغاثة اللهفان ، والاستمتاع بالنساء .
وما يهمنا هنا هو ارتباط الموت بالمتعة . فالشاعرُ يعتنق ” عدم المبالاة بالموت ” كعقيدة ثابتة لا محيص عنها . والقضيةُ عنده محسومة بشكل نهائي ، والمسألةُ مسألةُ مبدأ .
لكنَّ هذه العقيدة تنهار وتصبح لاغيةً ، عندما ترتبط حياةُ الشاعر بثلاثة أمور : الأول _ شرب الخمر الذي يُشكِّل قضيةً أساسية في المجتمع الجاهلي . والثاني _ إغاثة اللهفان ، وهو أمرٌ ثابت في التقاليد العربية القَبَلية ولا مساومة عليه . والثالث_ الاستمتاع بالنساء ، وهذه قضية مركزية في الثقافة الجاهلية الشهوانية .
إذن ، هذه القضايا الثلاث تَمنح الشاعرَ شرعيةَ وجوده ، وتَمنح حياته المعنى والجدوى . وبدونها تصبح حياته كعدمها ، ويصبح الموتُ مرحَّباً به لأنه الحَل الأكثر نجاعةً . كما أن هذه الخِصال تم لصقُها بالفتى الكريم تحديداً،وكأنها مميِّزاتُ هويةِ الفتى الكريم الشريف، وأركانُ وجوده.
4_ الموت شامل لكل الأحياء :
الموتُ لا يُفرِّق بين الناس على أساس الدِّين أو اللون أو العِرْق . إنه حصادٌ شامل لا يَستثني أحداً . فالموتُ هو حَجرُ الرَّحى الذي يَطحن كلَّ شيء بلا تمييز ، ولا يتوقف عن الطحن أبداً .
وقد أشار الشاعر طَرَفة بن العبد إلى أن الموتَ شاملٌ للجميع بلا محاباة ولا تفرقة ، فقال :
أرى الموتَ يَعتامُ الكرامَ وَيَصْطفي عَقيلَةَ مالِ الفاحِشِ المُتَشَــدِّدِ
فالموتُ يعمُّ الأجوادَ ، ويختارهم ، ويُنهي وجودَهم ، ويَصطفي الكرامَ وكرائمَ أموال البخلاء . فلا الكريمُ نجا من الموت ولا البخيلُ ( الفاحش ). وهذان الصنفان ( الكِرام / البخلاء ) لم يستطيعا الإفلاتَ من قبضة الموت .
إذن ، فالموتُ شاملٌ للجميع ، ومسيطرٌ على الأضداد . وكلُّ شخصٍ سوفَ يَموت ، سواءٌ كان كريماً أم بخيلاً، غنياً أم فقيراً، شريفاً أم حقيراً، صالحاً أم طالحاً ، عالِماً أم جاهلاً ، قوياً أم ضعيفاً .. إلخ. لقد ساوى الموتُ بين الأضداد، وألغى التناقضاتِ ، وسَوَّى بين الجميع ، فلم يُحابِ أحداً على حساب أحد، ولم يُفرِّق بين الناس. فالموتُ لا يَعرف التمييزَ العنصري ، أو الدبلوماسية ، أو المحاباة .
والصفاتُ السلبية لم تَعُد بخير على أصحابها ، ولم تَجلب لهم نفعاً ، ولم تَحرسهم من الموت . والشاعرُ ركَّز على موضوع البُخل. فالبخيلُ الذي قَضى حياته عبداً للمال وحارساً له ، لم ينجُ من الموت . وفي نهاية المطاف ، وَقَعَ عليه اختيارُ الموت ، كما وَقع على الكريم . وقد مات الاثنان ، لكنَّ الفرق الجوهري أن الكريم تركَ ذِكرى طيبة وسيرةً عطرة ، أمَّا البخيل فعاشَ مذموماً وماتَ مذموماً ، وسُمعته في الحضيض . ومِن هنا تبرز أهميةُ التحلي بالصفات الحميدة لأنها مَنبع الذكرى العطرة الباقية بعد الموت .
5_ الطريق إلى الفناء :
ولادةُ الإنسان هي بدء العد التنازلي لوجوده. ومُذ وُجد على هذه الأرض ، وهو يَسير إلى نهايته الحتمية . فالبدايةُ هي جَرس إنذار للنهاية . والحياةُ تتناقص بشكل تدريجي . والإنسانُ مثل أوراق التقويم، كلما سَقطت ورقةٌ ذهبَ بعضُه . وكذلك الإنسان كلما مَرَّ عليه يومٌ ذهبَ بعضُه.
يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد :
أرى العيشَ كنزاً ناقِصاً كلَّ ليلةٍ وَما تَنْقُصِ الأيامُ والدَّهرُ يَنفَـدِ
فالعيشُ _ حَسْب رؤية الشاعر _ هو كنز يَنقص كلَّ ليلةٍ . إنه يتناقص باستمرار ، ولا يوجد شيءٌ يُعوِّض هذا النقصَ . وكلُّ شيء يَنقص فإن مصيرَه إلى النفاد ، والوصول إلى نقطة النهاية . وما تَنقصه الأيامُ والدهرُ يَنفد ويَنتهي مهما كان كثيراً أو كبيراً . وكذلك العيشُ صائر إلى النفاد والانتهاء لا محالة .
والعيشُ مثل البحيرة التي تجف شيئاً فشيئاً، ويتبخر ماؤها، دون وجود روافد تغذِّيها. وسوفَ يأتي يومٌ تجفُّ تماماً، وتصبح أثراً إِثر عَيْن. وهذا الانتهاءُ آتٍ حتماً ، وكلُّ آتٍ قريبٌ . وما بَقِيَ من الدنيا أقل مما مَضى . إنه شعورٌ بالنهاية الأكيدة ، واستشعارُ قُرب الفناء الحتمي .
والشاعرُ يُشبِّه العيشَ بالكنز ، وهو المال المدفون تحت الأرض أو ما يُحرَز في المال . كما أن مفهوم الكنز يشتمل على معنى الجمع والادخار . وهذا يدل على مركزية العيش باعتباره تجميعاً للسنوات والأحلام والذكريات . فالعيشُ كتلةٌ من الأضداد والتناقضات ، تتجمعُ فيه الأفراحُ والأحزانُ، والنجاح والفشل ، والحياة والموت . وكلُّ هذه العناصر تتناقص تدريجياً ، فالإيجابياتُ تتلاشى والسلبياتُ تتلاشى . والعيشُ بكافة محتوياته مآله إلى النفاد. إنها رحلةُ العد التنازلي ، لا تتوقف حتى تصل إلى ساعة الصفر ( النفاد / الانتهاء / النهاية ) .
6_ لا مفر من الموت :
الإنسانُ واقعٌ في قَبضة الموت _ رغمَ أنفه _ . وعندما تَحين ساعته ستشتدُّ قبضةُ الموت على روحه ، فَيَسْقط . ومهما ضَرَبَ الإنسانُ في الأرض ، وشَرَّقَ وغَرَّبَ ، فلا بد أن يَعود إلى الموت بِقَدَمَيْه مثلما يَعودُ الطفلُ إلى حِضن أُمِّه . وكلُّ حركاتِ الإنسان وعنفوانه وإشراقه إنما تتم في دائرة الموت التي تَضيق شيئاً فشيئاً . فالخناقُ يشتدُّ على الإنسان بشكل تدريجي . والحياةُ الإنسانية لا تتحرك بمنأى عن الموت ، بل تتحرك تحت ظلال الموت . وهذه الفُسحة المتاحة للإنسان( الحياة ) محصورة في زنزانة ضيقة، تقترب جُدرانها من الإنسان ( السجين ) يوماً بعد يوم. ولا يمكن الهرب من الموت بأية وسيلة ، فلا مفر منه ، ولا يمكن التخلص من الموت إلا بالموت . يقول الشاعرُ طَرَفة بن العبد :
لَعَمْرُكَ إنَّ الموْتَ ما أخطأَ الفتى لكالطِّوَلِ المُرْخَى وَثِنْياهُ باليَـدِ
إن الشاعرَ يُقسِم أن الموت في مدة إخطائه الفتى ، أي مجاوزته إياه ، بمنزلة حبل طول للدابة ترعى فيه وطرفاه بيد صاحبه .
والموتُ لا يُخطِئ الفتى، ومعنى الإخطاء هو المجاوزة . أي إن الفُسحة التي يتحرك فيها الإنسانُ كالفُسحة التي تتحرك فيها الدابة المربوطة بحبل طرفاه في قبضة مالكها . ومهما اقتربت الدابةُ أو ابتعدتْ فستظل تحت هيمنة صاحبها، لأنه يسيطر عليها بواسطة الحبل الذي لا تَقْدر على الإفلات منه . وكما أن الدابة لا تَقْدر على التخلص من قَيْدها ، فكذلك الإنسان لا يَقْدر على التخلص من قَيْده . والموتُ بمنزلة صاحب الدابة التي أرخى لها الحبلَ .
وَحَسْبَ منظور الشاعر ، فإن حياة الإنسان إنما هي وقتٌ مُسْتَقْطَع سَمَحَ به الموتُ . والإنسانُ يتحرك تحت عَيْن الموت الذي يُراقب تحركاتِ البشر ، بعد أن أعطى الإذنَ بممارستها . وبالتالي ، فالحياة الإنسانية برمتها تتحرك في ظلال الموت ، ولا يمكن الإفلاتُ من ساعة النهاية إذا حانت .
والشاعرُ يُعطي للموت مشيئةً ذاتية ، ويَجعله سيداً على الحياة ، وفاعلاً لا مفعولاً به . وهذه العقيدةُ نابعة _ بصورة غير مباشرة_ من عدم إيمان الشاعر باليوم الآخِر. فقلبُ الشاعرِ يَخلو تماماً من الإيمان بمَلَكِ الموت ، وأنه مُوَكَّل بقبض الأرواح ، وأن الموت مفعول به وليس فاعلاً .
فالموتُ _ في فلسفة الشاعر _ حالةٌ مستقلة قائمة بذاتها ذات سياق منفصل تماماً عن الإيمان بالغيب ، ومتى شاء الموتُ قاد الإنسانَ إلى نهايته الحاسمة ، لأن الإنسان واقع في شِباك الموت ، وقضيةُ النهايةِ قضيةُ وقتٍ _ لا أكثر ولا أقل _ ، وهذا الوقتُ يحدِّده الموتُ بأن يشدَّ الحبلَ .
وفي هذا السياقِ يَظهر عجزُ الإنسانِ المطْلقُ ، وتمركزه في أشد لحظات ضَعفه وانكساره . وأنه مجرد ردة فعل بلا حَوْلٍ ولا قوة ، يَستجيب _ رغم أنفه _ للفعل الأعلى ( الموت ) . وهذا الموتُ يمتلك السُّلطةَ المطْلقة على الحياة الإنسانية ، لأنه القوة المهيمنة ، والفعل القاهر الذي لا يَصمد أمامه شيء. ويَظهر _ أيضاً _ من سياق الفكر الشِّعري عند طَرَفة أن الحياة الإنسانية مجرد منحة من الموت الذي أرخى الحبلَ لكي تدور عَجلةُ الحياة . وبعبارة أخرى ، إن الموت له اليد الطولى في هذا الوجود ، لأنه أذنَ للحياة بالحركة والدوران ، وسمحَ للإنسان بالتحرك ، ولو بشكل مؤقَّت .
ويؤكد الشاعرُ زُهير بن أبي سُلمى استحالةَ الفرار من الموت ، وعدمَ إمكانية الهروب منه . ولكن الشاعر يُقدِّم منظورَه الخاص ، ويَطرح فلسفته الذاتية في الموضوع ، ويؤسس منظومةً شِعرية ذات علاقة وثيقة بالموت ، وعدم القدرة على الإفلات منه . يقول زُهير بن أبي سُلمى :
ومَن هَابَ أسبابَ المنـايا يَنَلْنَهُ وإنْ يَرْقَ أسبابَ السماءِ بِسُلَّمِ
الخوفُ من الموت شعورٌ إنساني طبيعي وغريزي . فالفِطرةُ الإنسانية متعلقة بالحياة وزينتها ، وتَنفر من النهاية القاصمة التي تتجلى في الموت ( النقطة على آخر سطر الوجود الإنساني ) . لكنَّ الخوفَ من الموت لا يُجدي نفعاً ، وليس له أي تأثير في مقاومة الموت أو منعه أو تأجيله . ولا يمكن لأحدٍ أن يتحصن من الموت . ولو أمعنَ الإنسانُ النظرَ في قضية الموت لآمنَ أنه ذاهبٌ إلى الموت بقدميه من حيث لا يَدري .
واللافت في الموضوع أن الخوفَ من الموت يصير موتاً بحد ذاته ، وهذا هو الموت في الحياة . وهناك أمواتٌ كثيرون يتحركون في الحياة ، قضوا حياتهم أمواتاً منتظرين المِيتة الكبرى النهائية الحاسمة . وفي أحيان كثيرة تكون الإجراءاتُ التي يتخذها الإنسانُ لحمايته من الموت هي سبب هلاكه . وكما قيل : مِن مَأمنه يُؤتى الحَذِرُ.
ومَن خافَ أسباب المنايا نالته ، ولا فائدة من خوفه وهيبته إياها ، ولو رامَ الصعود إلى السماء فراراً منها . وبعبارة أخرى ، مَن هابَ طرقَ المنايا أن يَسلكها تأتيه المنايا . إذن ، فالموتُ واقعٌ لا محالة ، تعدَّدت أشكالُه لكن المضمون واحد .
والإنسانُ محاصَرٌ بالموت من كل الجهات ، يَهرب من الموت إلى الموت. ولو قرَّر أن يَصعد إلى السماء بسُلَّم هروباً من الموت لأدركه الموتُ . وهذا أعظم حصار في تاريخ الوجود الإنساني . إنه الحصار الذي يَفرضه الموتُ على الإنسان الذي يَقف عاجزاً أمامه بلا حِيلة ولا وسيلة .
ويؤكد الشاعر لَبيد بن أبي ربيعة أن الموت لا يمكن الفرار منه ، وجميعَ المخلوقات تقف أمامه عاجزةً لا حَوْلَ لها ولا قوة ، فيقول :
صَادَفْنَ مِنْها غِرَّةً فَأَصبنَهـا إنَّ المنايا لا تَطيشُ سِهامُهـا
والشاعرُ يتحدث عن عالَم الحيوانات، ويصف في صدر البيت عملية الافتراس الأساسية في مملكة الحيوان . فهو يقول : صَادفت الكلابُ أو الذئابُ غفلةً من البقر فأصبنَ تلك الغفلة أو تلك البقرة بافتراس ولدها ، أي وجدتها غافلة عن ولدها فاصطادته . إنها الغفلة القاتلة التي أدَّت إلى القتل والنهاية. وهذا هو قانون الغاب ، حيث القويُّ يَقتل الضعيفَ ، وكلُّ مخلوقٍ يتربص بالآخر ويراقب نقاطَ ضعفه ، والكُلُّ ضد الكُل . إنه الصراعُ المأساوي في عالَم الحيوانات المنطلقة من الغريزة لا العقلِ .
ثم يؤسس الشاعرُ في عجز البيت فلسفةَ الموت . والموتُ لا يوجد في عالَم الإنسان فَحَسْب ، بل أيضاً موجود بكثافة في عالَم الحيوان ، ويملك حضوراً طاغياً بسبب الاحتكام إلى الغريزة ، والفِطرة المتوحشة ، دون وجود أي أثر للعقل أو المنطق .
وها هُوَ يؤكد الحقيقة الساطعة التي يَخضع لها كلُّ المخلوقات” إنَّ المنايا لا تَطيشُ سِهامُهـا ” . فلا مفر من الموت ، لأن الموتَ لا يُخطِئ هدفَه . وسِهامُ المنايا لا تَطيش ، أي لا تُخطِئ . ولفظُ “السِّهام ” يشير إلى قسوة الموت وخشونته ودقة إصابته ، فهذه السهام تَعرف طريقَها جيداً ، ولا تَحيد عنه . إن مسارَها مرسومٌ بدقة منذ نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول ( الإصابة ) ، وهي تخترق أجسادَ المخلوقات التي تقف عاجزةً تماماً أمام هجوم الموت الذي لا يَستسلم ولا يَتراجع .
7_ نشر خبر الوفاة :
إن العقليةَ الجاهلية محصورة في قيم الشرف ، والمجد ، وانتشار الصِّيت ، ونيل ثناء الناس وإشادتهم . فهي عقليةٌ دنيوية غارقة في الرياء والشُّهرة والسُّمعة، ولا يوجد في قاموسها الوثني قيمُ الإخلاص لله تعالى ، أو العمل ابتغاء وجهه الكريم . فهذه المعاني غائبة تماماً عن الفكر العربي في الجاهلية . وقد كانت نيةُ العربيِّ الباعثة على العمل ، هي صناعة تاريخه الشخصي ، وتاريخ قبيلته ، وتحقيق المكاسب الروحية والمادية في الحياة الدنيا _ لا أكثر ولا أقل _ . ووفق المنظور الجاهلي لا توجد حياةٌ بعد الموت ، ولا يوجد ثواب أو عقاب . إذن ، فالدنيا هي البداية والنهاية، وهي أكبر الْهَم ، ومَبْلغ العِلم ، ومنتهى الآمال والآجال. ومن هنا نفهم فلسفةَ الحرص على نشر خبر الوفاة، وإشاعته بين الناس .
يقول الشاعرُ طَرَفة بن العبد :
فإنْ مُتُّ فانعيني بما أنا أَهْلُــهُ وَشُقِّي عَليَّ الجَيْبَ يا ابنةَ معبَدِ
لا يُريد الشاعرُ أن يموت مجهولاً ، وهو يَرفض أن يكون نكرةً في هذه الحياة . لذلك يوصي ابنةَ أخيه ( معبد ) أن تنشر خبر وفاته مع الإطراء والتبجيل . إنه حريصٌ على خلود ذِكْره بين الناس بعد رحيله ، وحريصٌ أيضاً أن تُطبِّق شهرته الآفاق بعد موته. يريدُ إشاعةَ خبر هلاكه. وقد وكَّل ابنةَ أخيه بهذه المهمة بعد مماته . يوصيها أن تنعاه بما يستحقه من الثناء. والنعي هو إشاعةُ خبر الموت. ومن خلال هذا الرؤية ، يتضح حرصُ الشاعر على تلميع صورته بعد وفاته ، وترسيخها في الأذهان لكي تظل عصيةً على النسيان أو التجاهل . إنه في سباق مع الزمن ، ويحاول الاستثمار في التاريخ . يحاول صناعة تاريخه الشخصي ، والحصول على الخلود في كل الأزمنة ، والبقاء حياً بين الناس رغم رحيله جسدياً .
يقول لها : إذا هلكتُ فأشيعي خبرَ هلاكي بمدحي الذي أستحقه وأستوجبه . كما يوصيها أيضاً بشق الجيب حزناً عليه. ولا يَخفى أن حزن المرأة ممزوج بالبكاء .
والجيبُ ما يُفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس ، والمراد بشقِّه إكمال فتحه إلى آخره ، وهو أحد أشكال النياحة، ومن علامات السخط، ورفض القضاء والقَدَر ، وعدم التسليم بالأمر الواقع.
إن الشاعرَ يحس أن عمره قصير ، ويستشعر قُربَ رحيله . وقد كان إحساسُ الشاعر صادقاً ، فقد ماتَ طَرَفة بن العبد وهو في السادسة والعشرين من العُمر . وهذا ليس غريباً ، فالشاعرُ قد عاشَ حياته بشكل عابث متهور ، وأقحمَ نَفْسَه في مشكلات كثيرة ، وصنعَ له أعداء كثيرين .
وهذا الشعورُ بدنوِّ الأجل ملتصقٌ بالحنين إلى دفء الأنثى ، والحاجة إلى حنانها وعطفها ورعايتها . فالشاعرُ عندما يَسبح في مدار الموت ، يكون مكسوراً وعاجزاً وغارقاً في لحظة ضَعفه ، وربما تكون هذه أفضل لحظة لتذكر الدفء الأنثوي ، لذلك نراه في لحظة الضعف هذه ، يخاطب ابنةَ أخيه، ويبدو أنها كانت قريبةً من عَمِّها الشاعر، وتكنُّ له مشاعر الحب والاحترام . ولو كانت غير ذلك لَمَا ذَكَرَها في هذا الموقف الحرج . إنه يَستعين بها لكي تُكمِل مسيرته نحو المجد بعد مماته ، وهذا يتجلى في نَعْيه ومدحه والثناء عليه وترسيخ صورته ” المثالية ” في أذهان الناس . ولا يوجد أفضل من النساء في ندب الموتى ، والحزنِ على الأموات .
وهكذا يتضح الدورُ العبثي للمرأة الجاهلية . فهي مجرد بُوق لإيصال رسائل الجزع والسخط . وضعها المجتمعُ في هذه المهنة الدونية، وهي ارتضتها بلا أدنى اعتراض . فصار شَقُّ الجيوب أو اللطمُ أو النياحة من الصفات الملازِمة للمرأة العربية. وهذه الخِصالُ القبيحة صارت ماركة مُسجَّلة باسم المرأة، وصارت المرأةُ والسَّخط وجهَيْن لعملة واحدة صَكَّها المجتمعُ الجاهلي البدائي .
8_ ” الموت صُدفة” :
يمثِّل الموتُ صدمةً فكرية في المجتمع الجاهلي الوثني . والكثيرون لا يَقدرون على تحمُّل هذه الصدمة الشديدة ، وهذا قادهم إلى اعتبار الموت مجرد عملية عبثية ، ولعبة صبيانية ، لا طائل من ورائها . وهذه نظرةٌ نابعة من صميم العقيدة الوثنية التي لا تؤمن بالحياة بعد الموت . وأصحابُ هذه العقيدة الفاسدة يَضعون وجودَهم تحت شعار” أرحامٌ تَدفع وأرضٌ تَبلع “. فالموتُ_ عندهم _ هو نهاية المطاف ولا شيء بعده . يقول الشاعرُ زُهير بن أبي سُلمى :
رَأيتُ المنايا خَبطَ عَشواء مَن تُصِبْ تُمِتْه وَمَنْ تُخطئْ يُعَمَّر فيهـــرَمِ
إنه يَعتبر الموتَ مقامرةً غير محسوبة، متأرجحةً بين النجاح والفشل . والموتُ _ في نظر الشاعر _ سهمٌ قد يُصيب الهدفَ ، وقد يُخطئه . وهو بذلك لا يَرى أيةَ قوة محرِّكة للموت ومسيطرة عليه . وإنما يَنظر إليه باعتباره فِعلاً ميكانيكياً غامضاً ونابعاً من ذاته ، ومتذبذباً بين إصابة الهدف وعدم إصابته . والموتُ في منظور الشاعر كالقطار الذي قد يَلتزم بالسكة فيصل إلى وجهته، وقد يَنحرف عنها فلا يصل إلى المحطة المقصودة .
والشاعرُ عاشَ لمدة طويلة ، وامتدَّت به الحياة حتى قاربَ المئة أو كاد . وقد سئمَ من حياته الطويلة ، واشتاقَ إلى الموت لأنه اعتبره راحةً من الملل والسآمة والروتين . ولم يَجد تفسيراً لطول عُمره وبلوغه مرحلة الهرم إلا اعتقاد أن الموتَ أخطأه ، وأن سهمَه طاشَ هذه المرة . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مقدار القرف الذي وصلَ إليه الشاعرُ ، وجعله يستعجل الموتَ ، ويتمنى قدومَه بأسرع وقت .
ولا شك أن زُهيراً_ بسبب طول عُمره _ قد رأى الكثيرين من الأقارب والأصدقاء والأعداء قد ماتوا. إنهم يَتساقطون واحداً تلو الآخر على مرأى منه ومسمع . لذلك عندما يقول : (( رَأيتُ المنايا )) ، فهذا يدل على خبرة تراكمية . ولكنَّ هذه الخبرة لم تزده إلا انحرافاً وضلالاً وسآمةً . فهو يَعتبر أن المنايا تصيب الناس على غير نسق وترتيب وبصيرة كما أن الناقة تطأ على غير بصيرة. والعشواءُ هي الناقة التي لا تُبصِر ليلاً . ثم قال : من أصابته المنايا أَهْلَكَتْهُ وَمَن أخطأته أبقته فبلغ الهرم . إذن ، فالموت _ وفق هذه الرؤية _ نسقٌ عابث ، وعملية عشوائية تفتقد إلى البصيرة، ولا تتمتع بدقة الإصابة. ولا قوةٌ مسيطرة على الموت ، ولا منطقٌ يَحْكمه . والعمليةُ برمتها تُشبه لعبة القِمار ، قد يفوز فيها الشخصُ وقد يَخسر .
9_ لا أحد يَعود من الموت :
يُشكِّل الموتُ رحلةً بلا عودة. ذهابٌ بلا إياب. وكلُّ شخصٍ غابَ سَيَرْجع يوماً ما، إلا غائب الموت فإنه لا يَرجع. وهذه المفارَقةُ الصادمة تعكس عَظَمةَ الموت، وضآلةَ الإنسان الضعيف الذي سَيَرْحل رغمَ أنفه ، ولا أمل في عودته . فالموتُ هو السَّفرُ النهائي ، والرحلةُ الأخيرة .
يقول الشاعرُ عُبَيْد بن الأبرَص :
وكلُّ ذي غَيْبةٍ يَـؤوبُ وغائبُ الموْتِ لا يَؤوبُ
يُقسِّم الشاعرُ الغَيْبةَ إلى قِسْمَيْن: غَيبة يؤوب منها الإنسانُ ، أي يَرْجع . وغَيبة لا يؤوب منها.
والغَيبةُ الأولى يمكن أن تكون سَفَراً أو هجرةً أو رحلةً عادية .. إلخ . وهذه الأمورُ ليست نهاية المطاف ، ولا تُعَدُّ نقطة النهاية لحياة الإنسان . وكلُّ غَيْبةٍ من هذا النوع يَرجع منها الإنسان ، لأنها غَيبة وقتية زائلة سُرعان ما تنتهي ، ولا تشكِّل تهديداً لوجود الإنسان .
أمَّا الغَيبةُ الثانية ، فهي غَيبةُ الموت التي لا يمكن الرجوع منها إطلاقاً . فغائبُ الموتِ ذهبَ ولن يَعود . وهذا الأمرُ بديهي ، ويُعتبَر مُسلَّمة لا تَقبل النقاش عند جميع العقلاء _مهما كانت عقائدهم وأجناسهم _ .
وهذا البيتُ قد يَبدو للوهلة الأولى عادياً وتقريرياً ومباشِراً ، ولا شِعرية فيه . إلا أن المتأمل فيه يجد الشِّعرية كامنة في عملية المقارنة التي تحمل معاني الأضداد والتنافر والتعاكس . والمفارَقةُ الواضحة في البيت ( يَؤوب / لا يَؤوب ) هي فلسفة الخلاصة الشِّعرية . والمقارنةُ بين هاتين الغَيْبَتَيْن تُبْرِز معنى الموت وخصائصه بصورة شديدة الوضوح ، وبضدِّها تتبيَّن الأشياءُ .
10_ الموت مُقدَّر :
إن التفكر في الموت يؤدي إلى إدراك حقيقة أنه مُقدَّر، وخاضعٌ لقوة عُليا هي قوة الخالق تعالى. ولا يمكن أن يكون الموتُ عبثاً أو لعبةً عمياء . فلكلِّ مخلوقٍ أجلٌ محدَّد ، لم يمكن تقديمه ولا تأخيره.
يقول الشاعرُ عمرو بن كلثوم :
وإنَّا سَوْفَ تُدرِكنا المنايا مُقَدَّرَةً لنا وَمُقدَّرينــا
ومن هذا المنطلق الشعري، تبرز المعادَلةُ الوجودية الحاسمة : (( الموتُ خُلق للإنسان، والإنسانُ خُلق للموت/الموتُ مُقدَّر للإنسان، والإنسانُ مُقدَّر للموت )). وهذه التبادلية واضحةٌ في فلسفة الشاعر. فهو يقول: سَوْفَ تُدركنا مقاديرُ موتنا ، وقد قُدِّرت تلك المقادير لنا ، وقُدِّرنا لها .
إذن ، فالقضيةُ محسومةٌ منذ الأزل ، ودقيقة إلى حَد العِصمة من الخطأ . فالموتُ لا يُخطِئ هدفَه أبداً . فالموتُ سوفَ يُدرِك الناسَ أينما كانوا ، وهو مُقدَّر لهم ، كما أن الناسَ مُقدَّرون له . وهذا يشير إلى أهميةِ اللقاء بين الإنسان والموت ، وحتميةِ المواجَهةِ غير المتكافئة . واعتماداً على هذا المبدأ الأساسي يمكن القول إن الإنسانَ والموتَ وجهان لعُملة واحدة ، لا يَقْدر أيٌّ منهما على الهرب من الآخر. ومُنذ ولادة الإنسان ارتبطَ مصيرُه بالموت، فالولادةُ هي بدء العَد التنازلي ، وهي نقطة الانطلاق نحو لقاء الموت .
ولا يَخفى أن فِعلَ التقدير ( تقدير المنايا للناس، وتقدير الناس للمنايا ) لا يمكن أن يقوم بذاته، بل هو خاضعٌ للفاعل المسيطر على هذه العملية ، والفاعلُ هو اللهُ المقدِّرُ الذي وَضع كلَّ شيء في نِصابه الصحيح ، وقَدَّر أقواتَ الخلائق ومقاديرَ الموت منذ الأزل . ولن تَموت نَفْسٌ حتى تستوفيَ أجلَها كاملاً غير منقوص .
كاتب من الأردن
والشعراءُ _ باعتبارهم أكثر المخلوقات حساسيةً والتقاطاً لعناصر الطبيعة _ لا يَقدرون على الإفلات من ” إغراء الموت ” حتى لو أرادوا ذلك . وهذا يُفسِّر ذِكرَ الموت في أشعارهم ، وجعل الفلسفات والمناهج الفكرية تَدور حَوْله . فالموتُ مجالٌ خصب للتأمل في النهاية ، والأحزان ، والفِراق ، … إلخ .
والمعلَّقاتُ اعتنت بموضوع الموت ، واستمدَّت منه فلسفةً للحياة ، ومنهجاً فكرياً للإنسانية . وقد عبَّر أصحابُ المعلَّقات عن فكرة الفناء ، وعدم الخلود في الدنيا ، وأن الموت شامل لكل الأحياء، ولا مفر منه ، واستحالة العودة من الموت ، وأنه مُقدَّر . وفي الجهة المقابِلة ، نجد أفكاراً تتحدث عن ضرورة الذهاب إلى الموت وعدم انتظاره . فهو قادمٌ _ لا محالة _ فينبغي أخذ المبادَرة . وتبرز_ أيضاً _ فكرةُ عدم المبالاة بالموت، ولا بد للإنسان أن يعيش حياته بالطُّول والعَرْض ، وأن يَستمتع قَدْر المستطاع لأنه لن يَعيش إلا مرة واحدة فقط . وتَظهر فكرة ” الموت صُدفة ” ، وأنه حالة عبثية تأتي بشكل أعمى ، وغير مُسَيْطَر عليه . وهذه العقيدةُ متأثرة بالنسق الفكري الوثني الذي لا يؤمن بالحياة بعد الموت ( الحياة الآخِرة ) .
إننا أمام حالة شِعرية متفردة تتحدث عن الموت ، وتورده في سياق فني فلسفي يَعكس طبيعةَ عقائد أصحاب المعلَّقات ، والماهياتِ الفكرية الكامنة في ذواتهم ، والأحداث التاريخية المصاحِبة للشاعر وفلسفته في الموت والحياة على السواء ، لأن الأشياء تُعرَف بأضدادها .
1_ لا خلود في الدنيا :
الدنيا دارٌ زائلة لا يمكن أن تَمنح الخلودَ للعناصر . ففاقدُ الشيء لا يُعطيه . وبما أن الدنيا ذاتها غير خالدة ، إذن فلا خلود فيها . إنها فانيةٌ هِيَ ومحتوياتها. والناسُ يَرون الموت والأموات كلَّ يومٍ رأي العَيْن ، فلا مجال للتكذيب أو الشك . وكلُّ إنسان مهما تطاول عُمُرُه ، لا بد أن يُحمَل يوماً ما إلى المقبرة . وهذا الأمرُ من كثرة ما اعتاد عليه الناسُ ، صار أمراً عادياً لا يُحرِّك المشاعرَ ، ولا يُثير مكنوناتِ الصدور. فالاعتياديةُ تَجعل الإنسانَ أعمى، وعاجزاً عن رؤية الأشياء بعين البصيرة ، وغارقاً في نظام حياتي روتيني مغلَق .
ونحن نجد الشاعر طَرَفة بن العبد يشير إلى قضية ” اللاخلود ” فيقول :
ألا أيُّهذا اللائمي أَشْهَدُ الوَغَــى وأن أنهلَ اللذاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
يقول: ألا أيها الإنسان الذي يُلومني على حضور الحرب، وحضورِ الملذات، هل تخلِّدني إن كففتُ عنها ؟ .
إن الشاعرَ يُؤْمن بعدم الخلود في الدنيا . وسواءٌ شاركَ الإنسانُ في الحرب أم نام في بَيْته ، ففي كلا الحالتين لن يَنعم بالخلود . لذلك فهو يُريد أن يَعيش حياته على هواه بلا ضوابط ، أن يعيش بالطُّول والعَرْض ، ويَستمتع بكل لحظة ، ويَفعل ما يَحلو له. ففي كل الحالات ، هُو غير خالد ، والموتُ قادمٌ لا محالة ، والمسألةُ مسألةُ وقتٍ لا أكثر ولا أقل. وهذه القناعةُ لم تُكسِب الشاعرَ إحساساً بالمسؤولية ، بل على العكس ، أغرقته في اللامبالاة واللاجَدْوى ، وأكسبته شعوراً بالعَدَم والضياع . وبما أن الموتَ قادمٌ ، والخلود متعذِّر ، فلماذا لا يستمتع بحياته ويشارك في الحرب ويصنع مجدَه الشخصي ومجدَ قبيلته ويَنهل من اللذات قبل أن يداهمه الموت ؟! . إنها رُوحٌ جاهلية وثنية تَعتبر الموتَ نقطة النهاية ، ولا شيء بعدها. وبالتالي ، لا بد من استغلال الحياة الدنيا في الاستمتاع ، وتحقيق رغائب النَّفس كاملةً غير منقوصة . ومن الواضح أن سلوكَ الشاعرِ العابثَ قد سَبَّبَ له المتاعبَ ، وجلبَ له الانتقاداتِ والعتابَ . وبالطبع ، فإن الشخص الذي يَرى التصرفاتِ الطائشة للشاعر لا بد أن يَلومه . وهذا اللومُ يَنبع من تطبيقات العقل الجمعي ، ويَنطلق من فلسفة اجتماعية سائدة تتطلب التوازنَ في أداء الأعمال، وتحمُّلَ المسؤولية، واحترامَ قيمة الحياة، وعدم تضييعها في اللذات الوقتية ، والسلوكياتِ غير المحسوبة .
2_ الذهاب إلى الموت وعدم انتظاره :
من الواضح أن الشاعر طَرَفة بن العبد يؤسس فلسفته الخاصة بالموت وملابساته ، وما يُرافقه من أحداث فكرية أو مادية واقعية . وها هُوَ يقول :
فإنْ كُنتَ لا تسطيعُ دَفْعَ مَنِيَّتي فَدَعْني أُبادِرْها بما مَلَكَتْ يدي
إن الشاعر يَبني فلسفته الذاتية حول فكرة ” استحالة دفع الموت ” ، لكنه يُحيط هذه الفكرة الصحيحة بسلوكيات خاطئة وتطبيقاتٍ سلبية. فالشاعرُ يرى ضرورةَ الغرق في الملذات والشهوات بلا حساب ، لأن الموت قادمٌ بشكل مؤكَّد لا شك فيه . فبدلاً من أن يصبح الموت باعثاً على الزهد والاستقامة ، يصبح باعثاً على اللامبالاة والعبث والتبذير . وهذه هي فلسفة طَرَفة بن العبد التي بثَّها في أشعاره .
يقول طَرَفة : فإن كنتَ لا تستطيع أن تدفع مَوْتي ، فدعني أُبادر الموتَ بإنفاق أملاكي .
إنه في سِباق مع الموت ، ويُريد أن يُسابق الموتَ قبل أن يُباغته . وهكذا تتجلى روحُ المبادَرة ، مُبادَرة الموت واقتحام عالَمه ، وذلك بإضاعة الممتلكات ، وتبذير الأموال، والاستمتاع بالملذات إلى الدرجة القُصوى. فالموتُ سيتلفُ أملاكَ الشاعر، ولن يُبقيَ له شيئاً . لذلك يَحاول الشاعرُ أن يَسبق الموتَ ، ويأخذ على عاتقه إتلاف أمواله بنَفْسه ، وعدم منح الموت هذه الفرصة .
والمنهجيةُ الفلسفيةُ المسيطرة على الشاعر في هذا السياق هي أن الموت لا بد منه ، فلا معنى للبخل ، وتركِ الملذات ، وإدارةِ الظَّهر للشهوات . فعلى المرء أن يَستمتع بالحياة ولذاتها بكل الوسائل المتاحة ، فالغايةُ تبرِّر الوسيلةَ ، والإنسانُ لن يَعيش مرةً أُخرى ، فعليه اغتنام هذه الفرصة قبل فواتها. فالمتعةُ إذا ذَهبت لن تَعود . وهكذا يُصبح الموتُ حافزاً على الغرق في الشهوات بلا ضوابط ، وليس حافزاً على العمل المثمر ، وسلوكِ الطريق القويم .
ومن الملاحَظ أن فلسفةَ طَرَفة بن العبد تنطوي على ردة فعل عكسية . فالمفروضُ أن يَقطعَ الموتُ لذاتِ النفوس ورغباتها ، ويدفعَ إلى الصلاح والخير ، باعتباره هادمَ اللذات ، ومُفرِّق الجماعات ، ومُيتِّم البنين والبنات . أمَّا في حالة طَرَفة ، فقد تحوَّلت صدمةُ الموت إلى مزيد من الشهوانية والعبث واللاجَدْوى. ففي بعض الأحيان، يؤدي النُّورُ الباهر إلى العَمى لا قوة الإبصار . كما أن كَثرة الشَّد يُرخي . وهذا ما نراه جلياً في فلسفة طَرَفة المتعلقة بالموت، وتطبيقاتها الشعرية .
3_ عدم المبالاة بالموت :
يواصل الشاعرُ طَرَفة بن العبد سياسته تجاه الموت ، حيث إنه لا يُبالي به ، ولا يُقيم له وزناً . هذه هي القاعدة الأساسية في فلسفته حول الموت . أمَّا الاستثناءُ فهو ما عبَّر عنه في قَوْله :
وَلَوْلا ثَلاثٌ هُنَّ مِن عِيشَةِ الفَتى وَجَدِّكَ لم أحفِلْ متى قامَ عُوَّدي
يقول طَرَفة : فَلَوْلا حُبِّي ثلاث خِصال هُنَّ من لذة الفتى الكريم لم أبالِ متى أقام عُوَّدي من عندي آيسين من حياتي . أي لم أُبالِ متى مِتُّ .
وهذا البيتُ يَحمل تشويقاً كبيراً ، ويشدُّ انتباهَ السامع . فالشاعرُ يَنظر إلى الموت على أنه نهاية المطاف ، وأن الحياة مهزلةٌ كبرى. وهو لا يُبالي بالموت ولا الحياة على حَدٍّ سَواء . لكنَّ هناك ثلاث خصال تَجعله حريصاً على حياته، ومُبالياً بالموت إلى حَد بعيد . وهذه الخِصالُ هي : شرب الخمر، وإغاثة اللهفان ، والاستمتاع بالنساء .
وما يهمنا هنا هو ارتباط الموت بالمتعة . فالشاعرُ يعتنق ” عدم المبالاة بالموت ” كعقيدة ثابتة لا محيص عنها . والقضيةُ عنده محسومة بشكل نهائي ، والمسألةُ مسألةُ مبدأ .
لكنَّ هذه العقيدة تنهار وتصبح لاغيةً ، عندما ترتبط حياةُ الشاعر بثلاثة أمور : الأول _ شرب الخمر الذي يُشكِّل قضيةً أساسية في المجتمع الجاهلي . والثاني _ إغاثة اللهفان ، وهو أمرٌ ثابت في التقاليد العربية القَبَلية ولا مساومة عليه . والثالث_ الاستمتاع بالنساء ، وهذه قضية مركزية في الثقافة الجاهلية الشهوانية .
إذن ، هذه القضايا الثلاث تَمنح الشاعرَ شرعيةَ وجوده ، وتَمنح حياته المعنى والجدوى . وبدونها تصبح حياته كعدمها ، ويصبح الموتُ مرحَّباً به لأنه الحَل الأكثر نجاعةً . كما أن هذه الخِصال تم لصقُها بالفتى الكريم تحديداً،وكأنها مميِّزاتُ هويةِ الفتى الكريم الشريف، وأركانُ وجوده.
4_ الموت شامل لكل الأحياء :
الموتُ لا يُفرِّق بين الناس على أساس الدِّين أو اللون أو العِرْق . إنه حصادٌ شامل لا يَستثني أحداً . فالموتُ هو حَجرُ الرَّحى الذي يَطحن كلَّ شيء بلا تمييز ، ولا يتوقف عن الطحن أبداً .
وقد أشار الشاعر طَرَفة بن العبد إلى أن الموتَ شاملٌ للجميع بلا محاباة ولا تفرقة ، فقال :
أرى الموتَ يَعتامُ الكرامَ وَيَصْطفي عَقيلَةَ مالِ الفاحِشِ المُتَشَــدِّدِ
فالموتُ يعمُّ الأجوادَ ، ويختارهم ، ويُنهي وجودَهم ، ويَصطفي الكرامَ وكرائمَ أموال البخلاء . فلا الكريمُ نجا من الموت ولا البخيلُ ( الفاحش ). وهذان الصنفان ( الكِرام / البخلاء ) لم يستطيعا الإفلاتَ من قبضة الموت .
إذن ، فالموتُ شاملٌ للجميع ، ومسيطرٌ على الأضداد . وكلُّ شخصٍ سوفَ يَموت ، سواءٌ كان كريماً أم بخيلاً، غنياً أم فقيراً، شريفاً أم حقيراً، صالحاً أم طالحاً ، عالِماً أم جاهلاً ، قوياً أم ضعيفاً .. إلخ. لقد ساوى الموتُ بين الأضداد، وألغى التناقضاتِ ، وسَوَّى بين الجميع ، فلم يُحابِ أحداً على حساب أحد، ولم يُفرِّق بين الناس. فالموتُ لا يَعرف التمييزَ العنصري ، أو الدبلوماسية ، أو المحاباة .
والصفاتُ السلبية لم تَعُد بخير على أصحابها ، ولم تَجلب لهم نفعاً ، ولم تَحرسهم من الموت . والشاعرُ ركَّز على موضوع البُخل. فالبخيلُ الذي قَضى حياته عبداً للمال وحارساً له ، لم ينجُ من الموت . وفي نهاية المطاف ، وَقَعَ عليه اختيارُ الموت ، كما وَقع على الكريم . وقد مات الاثنان ، لكنَّ الفرق الجوهري أن الكريم تركَ ذِكرى طيبة وسيرةً عطرة ، أمَّا البخيل فعاشَ مذموماً وماتَ مذموماً ، وسُمعته في الحضيض . ومِن هنا تبرز أهميةُ التحلي بالصفات الحميدة لأنها مَنبع الذكرى العطرة الباقية بعد الموت .
5_ الطريق إلى الفناء :
ولادةُ الإنسان هي بدء العد التنازلي لوجوده. ومُذ وُجد على هذه الأرض ، وهو يَسير إلى نهايته الحتمية . فالبدايةُ هي جَرس إنذار للنهاية . والحياةُ تتناقص بشكل تدريجي . والإنسانُ مثل أوراق التقويم، كلما سَقطت ورقةٌ ذهبَ بعضُه . وكذلك الإنسان كلما مَرَّ عليه يومٌ ذهبَ بعضُه.
يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد :
أرى العيشَ كنزاً ناقِصاً كلَّ ليلةٍ وَما تَنْقُصِ الأيامُ والدَّهرُ يَنفَـدِ
فالعيشُ _ حَسْب رؤية الشاعر _ هو كنز يَنقص كلَّ ليلةٍ . إنه يتناقص باستمرار ، ولا يوجد شيءٌ يُعوِّض هذا النقصَ . وكلُّ شيء يَنقص فإن مصيرَه إلى النفاد ، والوصول إلى نقطة النهاية . وما تَنقصه الأيامُ والدهرُ يَنفد ويَنتهي مهما كان كثيراً أو كبيراً . وكذلك العيشُ صائر إلى النفاد والانتهاء لا محالة .
والعيشُ مثل البحيرة التي تجف شيئاً فشيئاً، ويتبخر ماؤها، دون وجود روافد تغذِّيها. وسوفَ يأتي يومٌ تجفُّ تماماً، وتصبح أثراً إِثر عَيْن. وهذا الانتهاءُ آتٍ حتماً ، وكلُّ آتٍ قريبٌ . وما بَقِيَ من الدنيا أقل مما مَضى . إنه شعورٌ بالنهاية الأكيدة ، واستشعارُ قُرب الفناء الحتمي .
والشاعرُ يُشبِّه العيشَ بالكنز ، وهو المال المدفون تحت الأرض أو ما يُحرَز في المال . كما أن مفهوم الكنز يشتمل على معنى الجمع والادخار . وهذا يدل على مركزية العيش باعتباره تجميعاً للسنوات والأحلام والذكريات . فالعيشُ كتلةٌ من الأضداد والتناقضات ، تتجمعُ فيه الأفراحُ والأحزانُ، والنجاح والفشل ، والحياة والموت . وكلُّ هذه العناصر تتناقص تدريجياً ، فالإيجابياتُ تتلاشى والسلبياتُ تتلاشى . والعيشُ بكافة محتوياته مآله إلى النفاد. إنها رحلةُ العد التنازلي ، لا تتوقف حتى تصل إلى ساعة الصفر ( النفاد / الانتهاء / النهاية ) .
6_ لا مفر من الموت :
الإنسانُ واقعٌ في قَبضة الموت _ رغمَ أنفه _ . وعندما تَحين ساعته ستشتدُّ قبضةُ الموت على روحه ، فَيَسْقط . ومهما ضَرَبَ الإنسانُ في الأرض ، وشَرَّقَ وغَرَّبَ ، فلا بد أن يَعود إلى الموت بِقَدَمَيْه مثلما يَعودُ الطفلُ إلى حِضن أُمِّه . وكلُّ حركاتِ الإنسان وعنفوانه وإشراقه إنما تتم في دائرة الموت التي تَضيق شيئاً فشيئاً . فالخناقُ يشتدُّ على الإنسان بشكل تدريجي . والحياةُ الإنسانية لا تتحرك بمنأى عن الموت ، بل تتحرك تحت ظلال الموت . وهذه الفُسحة المتاحة للإنسان( الحياة ) محصورة في زنزانة ضيقة، تقترب جُدرانها من الإنسان ( السجين ) يوماً بعد يوم. ولا يمكن الهرب من الموت بأية وسيلة ، فلا مفر منه ، ولا يمكن التخلص من الموت إلا بالموت . يقول الشاعرُ طَرَفة بن العبد :
لَعَمْرُكَ إنَّ الموْتَ ما أخطأَ الفتى لكالطِّوَلِ المُرْخَى وَثِنْياهُ باليَـدِ
إن الشاعرَ يُقسِم أن الموت في مدة إخطائه الفتى ، أي مجاوزته إياه ، بمنزلة حبل طول للدابة ترعى فيه وطرفاه بيد صاحبه .
والموتُ لا يُخطِئ الفتى، ومعنى الإخطاء هو المجاوزة . أي إن الفُسحة التي يتحرك فيها الإنسانُ كالفُسحة التي تتحرك فيها الدابة المربوطة بحبل طرفاه في قبضة مالكها . ومهما اقتربت الدابةُ أو ابتعدتْ فستظل تحت هيمنة صاحبها، لأنه يسيطر عليها بواسطة الحبل الذي لا تَقْدر على الإفلات منه . وكما أن الدابة لا تَقْدر على التخلص من قَيْدها ، فكذلك الإنسان لا يَقْدر على التخلص من قَيْده . والموتُ بمنزلة صاحب الدابة التي أرخى لها الحبلَ .
وَحَسْبَ منظور الشاعر ، فإن حياة الإنسان إنما هي وقتٌ مُسْتَقْطَع سَمَحَ به الموتُ . والإنسانُ يتحرك تحت عَيْن الموت الذي يُراقب تحركاتِ البشر ، بعد أن أعطى الإذنَ بممارستها . وبالتالي ، فالحياة الإنسانية برمتها تتحرك في ظلال الموت ، ولا يمكن الإفلاتُ من ساعة النهاية إذا حانت .
والشاعرُ يُعطي للموت مشيئةً ذاتية ، ويَجعله سيداً على الحياة ، وفاعلاً لا مفعولاً به . وهذه العقيدةُ نابعة _ بصورة غير مباشرة_ من عدم إيمان الشاعر باليوم الآخِر. فقلبُ الشاعرِ يَخلو تماماً من الإيمان بمَلَكِ الموت ، وأنه مُوَكَّل بقبض الأرواح ، وأن الموت مفعول به وليس فاعلاً .
فالموتُ _ في فلسفة الشاعر _ حالةٌ مستقلة قائمة بذاتها ذات سياق منفصل تماماً عن الإيمان بالغيب ، ومتى شاء الموتُ قاد الإنسانَ إلى نهايته الحاسمة ، لأن الإنسان واقع في شِباك الموت ، وقضيةُ النهايةِ قضيةُ وقتٍ _ لا أكثر ولا أقل _ ، وهذا الوقتُ يحدِّده الموتُ بأن يشدَّ الحبلَ .
وفي هذا السياقِ يَظهر عجزُ الإنسانِ المطْلقُ ، وتمركزه في أشد لحظات ضَعفه وانكساره . وأنه مجرد ردة فعل بلا حَوْلٍ ولا قوة ، يَستجيب _ رغم أنفه _ للفعل الأعلى ( الموت ) . وهذا الموتُ يمتلك السُّلطةَ المطْلقة على الحياة الإنسانية ، لأنه القوة المهيمنة ، والفعل القاهر الذي لا يَصمد أمامه شيء. ويَظهر _ أيضاً _ من سياق الفكر الشِّعري عند طَرَفة أن الحياة الإنسانية مجرد منحة من الموت الذي أرخى الحبلَ لكي تدور عَجلةُ الحياة . وبعبارة أخرى ، إن الموت له اليد الطولى في هذا الوجود ، لأنه أذنَ للحياة بالحركة والدوران ، وسمحَ للإنسان بالتحرك ، ولو بشكل مؤقَّت .
ويؤكد الشاعرُ زُهير بن أبي سُلمى استحالةَ الفرار من الموت ، وعدمَ إمكانية الهروب منه . ولكن الشاعر يُقدِّم منظورَه الخاص ، ويَطرح فلسفته الذاتية في الموضوع ، ويؤسس منظومةً شِعرية ذات علاقة وثيقة بالموت ، وعدم القدرة على الإفلات منه . يقول زُهير بن أبي سُلمى :
ومَن هَابَ أسبابَ المنـايا يَنَلْنَهُ وإنْ يَرْقَ أسبابَ السماءِ بِسُلَّمِ
الخوفُ من الموت شعورٌ إنساني طبيعي وغريزي . فالفِطرةُ الإنسانية متعلقة بالحياة وزينتها ، وتَنفر من النهاية القاصمة التي تتجلى في الموت ( النقطة على آخر سطر الوجود الإنساني ) . لكنَّ الخوفَ من الموت لا يُجدي نفعاً ، وليس له أي تأثير في مقاومة الموت أو منعه أو تأجيله . ولا يمكن لأحدٍ أن يتحصن من الموت . ولو أمعنَ الإنسانُ النظرَ في قضية الموت لآمنَ أنه ذاهبٌ إلى الموت بقدميه من حيث لا يَدري .
واللافت في الموضوع أن الخوفَ من الموت يصير موتاً بحد ذاته ، وهذا هو الموت في الحياة . وهناك أمواتٌ كثيرون يتحركون في الحياة ، قضوا حياتهم أمواتاً منتظرين المِيتة الكبرى النهائية الحاسمة . وفي أحيان كثيرة تكون الإجراءاتُ التي يتخذها الإنسانُ لحمايته من الموت هي سبب هلاكه . وكما قيل : مِن مَأمنه يُؤتى الحَذِرُ.
ومَن خافَ أسباب المنايا نالته ، ولا فائدة من خوفه وهيبته إياها ، ولو رامَ الصعود إلى السماء فراراً منها . وبعبارة أخرى ، مَن هابَ طرقَ المنايا أن يَسلكها تأتيه المنايا . إذن ، فالموتُ واقعٌ لا محالة ، تعدَّدت أشكالُه لكن المضمون واحد .
والإنسانُ محاصَرٌ بالموت من كل الجهات ، يَهرب من الموت إلى الموت. ولو قرَّر أن يَصعد إلى السماء بسُلَّم هروباً من الموت لأدركه الموتُ . وهذا أعظم حصار في تاريخ الوجود الإنساني . إنه الحصار الذي يَفرضه الموتُ على الإنسان الذي يَقف عاجزاً أمامه بلا حِيلة ولا وسيلة .
ويؤكد الشاعر لَبيد بن أبي ربيعة أن الموت لا يمكن الفرار منه ، وجميعَ المخلوقات تقف أمامه عاجزةً لا حَوْلَ لها ولا قوة ، فيقول :
صَادَفْنَ مِنْها غِرَّةً فَأَصبنَهـا إنَّ المنايا لا تَطيشُ سِهامُهـا
والشاعرُ يتحدث عن عالَم الحيوانات، ويصف في صدر البيت عملية الافتراس الأساسية في مملكة الحيوان . فهو يقول : صَادفت الكلابُ أو الذئابُ غفلةً من البقر فأصبنَ تلك الغفلة أو تلك البقرة بافتراس ولدها ، أي وجدتها غافلة عن ولدها فاصطادته . إنها الغفلة القاتلة التي أدَّت إلى القتل والنهاية. وهذا هو قانون الغاب ، حيث القويُّ يَقتل الضعيفَ ، وكلُّ مخلوقٍ يتربص بالآخر ويراقب نقاطَ ضعفه ، والكُلُّ ضد الكُل . إنه الصراعُ المأساوي في عالَم الحيوانات المنطلقة من الغريزة لا العقلِ .
ثم يؤسس الشاعرُ في عجز البيت فلسفةَ الموت . والموتُ لا يوجد في عالَم الإنسان فَحَسْب ، بل أيضاً موجود بكثافة في عالَم الحيوان ، ويملك حضوراً طاغياً بسبب الاحتكام إلى الغريزة ، والفِطرة المتوحشة ، دون وجود أي أثر للعقل أو المنطق .
وها هُوَ يؤكد الحقيقة الساطعة التي يَخضع لها كلُّ المخلوقات” إنَّ المنايا لا تَطيشُ سِهامُهـا ” . فلا مفر من الموت ، لأن الموتَ لا يُخطِئ هدفَه . وسِهامُ المنايا لا تَطيش ، أي لا تُخطِئ . ولفظُ “السِّهام ” يشير إلى قسوة الموت وخشونته ودقة إصابته ، فهذه السهام تَعرف طريقَها جيداً ، ولا تَحيد عنه . إن مسارَها مرسومٌ بدقة منذ نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول ( الإصابة ) ، وهي تخترق أجسادَ المخلوقات التي تقف عاجزةً تماماً أمام هجوم الموت الذي لا يَستسلم ولا يَتراجع .
7_ نشر خبر الوفاة :
إن العقليةَ الجاهلية محصورة في قيم الشرف ، والمجد ، وانتشار الصِّيت ، ونيل ثناء الناس وإشادتهم . فهي عقليةٌ دنيوية غارقة في الرياء والشُّهرة والسُّمعة، ولا يوجد في قاموسها الوثني قيمُ الإخلاص لله تعالى ، أو العمل ابتغاء وجهه الكريم . فهذه المعاني غائبة تماماً عن الفكر العربي في الجاهلية . وقد كانت نيةُ العربيِّ الباعثة على العمل ، هي صناعة تاريخه الشخصي ، وتاريخ قبيلته ، وتحقيق المكاسب الروحية والمادية في الحياة الدنيا _ لا أكثر ولا أقل _ . ووفق المنظور الجاهلي لا توجد حياةٌ بعد الموت ، ولا يوجد ثواب أو عقاب . إذن ، فالدنيا هي البداية والنهاية، وهي أكبر الْهَم ، ومَبْلغ العِلم ، ومنتهى الآمال والآجال. ومن هنا نفهم فلسفةَ الحرص على نشر خبر الوفاة، وإشاعته بين الناس .
يقول الشاعرُ طَرَفة بن العبد :
فإنْ مُتُّ فانعيني بما أنا أَهْلُــهُ وَشُقِّي عَليَّ الجَيْبَ يا ابنةَ معبَدِ
لا يُريد الشاعرُ أن يموت مجهولاً ، وهو يَرفض أن يكون نكرةً في هذه الحياة . لذلك يوصي ابنةَ أخيه ( معبد ) أن تنشر خبر وفاته مع الإطراء والتبجيل . إنه حريصٌ على خلود ذِكْره بين الناس بعد رحيله ، وحريصٌ أيضاً أن تُطبِّق شهرته الآفاق بعد موته. يريدُ إشاعةَ خبر هلاكه. وقد وكَّل ابنةَ أخيه بهذه المهمة بعد مماته . يوصيها أن تنعاه بما يستحقه من الثناء. والنعي هو إشاعةُ خبر الموت. ومن خلال هذا الرؤية ، يتضح حرصُ الشاعر على تلميع صورته بعد وفاته ، وترسيخها في الأذهان لكي تظل عصيةً على النسيان أو التجاهل . إنه في سباق مع الزمن ، ويحاول الاستثمار في التاريخ . يحاول صناعة تاريخه الشخصي ، والحصول على الخلود في كل الأزمنة ، والبقاء حياً بين الناس رغم رحيله جسدياً .
يقول لها : إذا هلكتُ فأشيعي خبرَ هلاكي بمدحي الذي أستحقه وأستوجبه . كما يوصيها أيضاً بشق الجيب حزناً عليه. ولا يَخفى أن حزن المرأة ممزوج بالبكاء .
والجيبُ ما يُفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس ، والمراد بشقِّه إكمال فتحه إلى آخره ، وهو أحد أشكال النياحة، ومن علامات السخط، ورفض القضاء والقَدَر ، وعدم التسليم بالأمر الواقع.
إن الشاعرَ يحس أن عمره قصير ، ويستشعر قُربَ رحيله . وقد كان إحساسُ الشاعر صادقاً ، فقد ماتَ طَرَفة بن العبد وهو في السادسة والعشرين من العُمر . وهذا ليس غريباً ، فالشاعرُ قد عاشَ حياته بشكل عابث متهور ، وأقحمَ نَفْسَه في مشكلات كثيرة ، وصنعَ له أعداء كثيرين .
وهذا الشعورُ بدنوِّ الأجل ملتصقٌ بالحنين إلى دفء الأنثى ، والحاجة إلى حنانها وعطفها ورعايتها . فالشاعرُ عندما يَسبح في مدار الموت ، يكون مكسوراً وعاجزاً وغارقاً في لحظة ضَعفه ، وربما تكون هذه أفضل لحظة لتذكر الدفء الأنثوي ، لذلك نراه في لحظة الضعف هذه ، يخاطب ابنةَ أخيه، ويبدو أنها كانت قريبةً من عَمِّها الشاعر، وتكنُّ له مشاعر الحب والاحترام . ولو كانت غير ذلك لَمَا ذَكَرَها في هذا الموقف الحرج . إنه يَستعين بها لكي تُكمِل مسيرته نحو المجد بعد مماته ، وهذا يتجلى في نَعْيه ومدحه والثناء عليه وترسيخ صورته ” المثالية ” في أذهان الناس . ولا يوجد أفضل من النساء في ندب الموتى ، والحزنِ على الأموات .
وهكذا يتضح الدورُ العبثي للمرأة الجاهلية . فهي مجرد بُوق لإيصال رسائل الجزع والسخط . وضعها المجتمعُ في هذه المهنة الدونية، وهي ارتضتها بلا أدنى اعتراض . فصار شَقُّ الجيوب أو اللطمُ أو النياحة من الصفات الملازِمة للمرأة العربية. وهذه الخِصالُ القبيحة صارت ماركة مُسجَّلة باسم المرأة، وصارت المرأةُ والسَّخط وجهَيْن لعملة واحدة صَكَّها المجتمعُ الجاهلي البدائي .
8_ ” الموت صُدفة” :
يمثِّل الموتُ صدمةً فكرية في المجتمع الجاهلي الوثني . والكثيرون لا يَقدرون على تحمُّل هذه الصدمة الشديدة ، وهذا قادهم إلى اعتبار الموت مجرد عملية عبثية ، ولعبة صبيانية ، لا طائل من ورائها . وهذه نظرةٌ نابعة من صميم العقيدة الوثنية التي لا تؤمن بالحياة بعد الموت . وأصحابُ هذه العقيدة الفاسدة يَضعون وجودَهم تحت شعار” أرحامٌ تَدفع وأرضٌ تَبلع “. فالموتُ_ عندهم _ هو نهاية المطاف ولا شيء بعده . يقول الشاعرُ زُهير بن أبي سُلمى :
رَأيتُ المنايا خَبطَ عَشواء مَن تُصِبْ تُمِتْه وَمَنْ تُخطئْ يُعَمَّر فيهـــرَمِ
إنه يَعتبر الموتَ مقامرةً غير محسوبة، متأرجحةً بين النجاح والفشل . والموتُ _ في نظر الشاعر _ سهمٌ قد يُصيب الهدفَ ، وقد يُخطئه . وهو بذلك لا يَرى أيةَ قوة محرِّكة للموت ومسيطرة عليه . وإنما يَنظر إليه باعتباره فِعلاً ميكانيكياً غامضاً ونابعاً من ذاته ، ومتذبذباً بين إصابة الهدف وعدم إصابته . والموتُ في منظور الشاعر كالقطار الذي قد يَلتزم بالسكة فيصل إلى وجهته، وقد يَنحرف عنها فلا يصل إلى المحطة المقصودة .
والشاعرُ عاشَ لمدة طويلة ، وامتدَّت به الحياة حتى قاربَ المئة أو كاد . وقد سئمَ من حياته الطويلة ، واشتاقَ إلى الموت لأنه اعتبره راحةً من الملل والسآمة والروتين . ولم يَجد تفسيراً لطول عُمره وبلوغه مرحلة الهرم إلا اعتقاد أن الموتَ أخطأه ، وأن سهمَه طاشَ هذه المرة . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مقدار القرف الذي وصلَ إليه الشاعرُ ، وجعله يستعجل الموتَ ، ويتمنى قدومَه بأسرع وقت .
ولا شك أن زُهيراً_ بسبب طول عُمره _ قد رأى الكثيرين من الأقارب والأصدقاء والأعداء قد ماتوا. إنهم يَتساقطون واحداً تلو الآخر على مرأى منه ومسمع . لذلك عندما يقول : (( رَأيتُ المنايا )) ، فهذا يدل على خبرة تراكمية . ولكنَّ هذه الخبرة لم تزده إلا انحرافاً وضلالاً وسآمةً . فهو يَعتبر أن المنايا تصيب الناس على غير نسق وترتيب وبصيرة كما أن الناقة تطأ على غير بصيرة. والعشواءُ هي الناقة التي لا تُبصِر ليلاً . ثم قال : من أصابته المنايا أَهْلَكَتْهُ وَمَن أخطأته أبقته فبلغ الهرم . إذن ، فالموت _ وفق هذه الرؤية _ نسقٌ عابث ، وعملية عشوائية تفتقد إلى البصيرة، ولا تتمتع بدقة الإصابة. ولا قوةٌ مسيطرة على الموت ، ولا منطقٌ يَحْكمه . والعمليةُ برمتها تُشبه لعبة القِمار ، قد يفوز فيها الشخصُ وقد يَخسر .
9_ لا أحد يَعود من الموت :
يُشكِّل الموتُ رحلةً بلا عودة. ذهابٌ بلا إياب. وكلُّ شخصٍ غابَ سَيَرْجع يوماً ما، إلا غائب الموت فإنه لا يَرجع. وهذه المفارَقةُ الصادمة تعكس عَظَمةَ الموت، وضآلةَ الإنسان الضعيف الذي سَيَرْحل رغمَ أنفه ، ولا أمل في عودته . فالموتُ هو السَّفرُ النهائي ، والرحلةُ الأخيرة .
يقول الشاعرُ عُبَيْد بن الأبرَص :
وكلُّ ذي غَيْبةٍ يَـؤوبُ وغائبُ الموْتِ لا يَؤوبُ
يُقسِّم الشاعرُ الغَيْبةَ إلى قِسْمَيْن: غَيبة يؤوب منها الإنسانُ ، أي يَرْجع . وغَيبة لا يؤوب منها.
والغَيبةُ الأولى يمكن أن تكون سَفَراً أو هجرةً أو رحلةً عادية .. إلخ . وهذه الأمورُ ليست نهاية المطاف ، ولا تُعَدُّ نقطة النهاية لحياة الإنسان . وكلُّ غَيْبةٍ من هذا النوع يَرجع منها الإنسان ، لأنها غَيبة وقتية زائلة سُرعان ما تنتهي ، ولا تشكِّل تهديداً لوجود الإنسان .
أمَّا الغَيبةُ الثانية ، فهي غَيبةُ الموت التي لا يمكن الرجوع منها إطلاقاً . فغائبُ الموتِ ذهبَ ولن يَعود . وهذا الأمرُ بديهي ، ويُعتبَر مُسلَّمة لا تَقبل النقاش عند جميع العقلاء _مهما كانت عقائدهم وأجناسهم _ .
وهذا البيتُ قد يَبدو للوهلة الأولى عادياً وتقريرياً ومباشِراً ، ولا شِعرية فيه . إلا أن المتأمل فيه يجد الشِّعرية كامنة في عملية المقارنة التي تحمل معاني الأضداد والتنافر والتعاكس . والمفارَقةُ الواضحة في البيت ( يَؤوب / لا يَؤوب ) هي فلسفة الخلاصة الشِّعرية . والمقارنةُ بين هاتين الغَيْبَتَيْن تُبْرِز معنى الموت وخصائصه بصورة شديدة الوضوح ، وبضدِّها تتبيَّن الأشياءُ .
10_ الموت مُقدَّر :
إن التفكر في الموت يؤدي إلى إدراك حقيقة أنه مُقدَّر، وخاضعٌ لقوة عُليا هي قوة الخالق تعالى. ولا يمكن أن يكون الموتُ عبثاً أو لعبةً عمياء . فلكلِّ مخلوقٍ أجلٌ محدَّد ، لم يمكن تقديمه ولا تأخيره.
يقول الشاعرُ عمرو بن كلثوم :
وإنَّا سَوْفَ تُدرِكنا المنايا مُقَدَّرَةً لنا وَمُقدَّرينــا
ومن هذا المنطلق الشعري، تبرز المعادَلةُ الوجودية الحاسمة : (( الموتُ خُلق للإنسان، والإنسانُ خُلق للموت/الموتُ مُقدَّر للإنسان، والإنسانُ مُقدَّر للموت )). وهذه التبادلية واضحةٌ في فلسفة الشاعر. فهو يقول: سَوْفَ تُدركنا مقاديرُ موتنا ، وقد قُدِّرت تلك المقادير لنا ، وقُدِّرنا لها .
إذن ، فالقضيةُ محسومةٌ منذ الأزل ، ودقيقة إلى حَد العِصمة من الخطأ . فالموتُ لا يُخطِئ هدفَه أبداً . فالموتُ سوفَ يُدرِك الناسَ أينما كانوا ، وهو مُقدَّر لهم ، كما أن الناسَ مُقدَّرون له . وهذا يشير إلى أهميةِ اللقاء بين الإنسان والموت ، وحتميةِ المواجَهةِ غير المتكافئة . واعتماداً على هذا المبدأ الأساسي يمكن القول إن الإنسانَ والموتَ وجهان لعُملة واحدة ، لا يَقْدر أيٌّ منهما على الهرب من الآخر. ومُنذ ولادة الإنسان ارتبطَ مصيرُه بالموت، فالولادةُ هي بدء العَد التنازلي ، وهي نقطة الانطلاق نحو لقاء الموت .
ولا يَخفى أن فِعلَ التقدير ( تقدير المنايا للناس، وتقدير الناس للمنايا ) لا يمكن أن يقوم بذاته، بل هو خاضعٌ للفاعل المسيطر على هذه العملية ، والفاعلُ هو اللهُ المقدِّرُ الذي وَضع كلَّ شيء في نِصابه الصحيح ، وقَدَّر أقواتَ الخلائق ومقاديرَ الموت منذ الأزل . ولن تَموت نَفْسٌ حتى تستوفيَ أجلَها كاملاً غير منقوص .
كاتب من الأردن