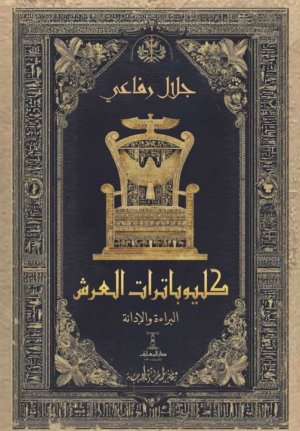﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف: 29)
"من بدل دينه فاقتلوه" البخاري (3017)
الملخص التنفيذي:
تتناول هذه الدراسة التوتر البنيوي بين الخطاب القرآني والحديث النبوي في مسألة حرية الاعتقاد، من خلال تحليل الآية: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}، وحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه». تكشف القراءة اللسانية والخطابية أن الآية تؤسس لحرية فردية محمية إلهيًّا تقوم على الاختيار وتحمل المسؤولية الأخروية، بينما يُستخدم الحديث في التراث الفقهي كأداة تنفيذية لضبط الجماعة وتقييد حرية العقيدة باسم الردة، رغم غموض سياقه ودلالاته.
وتخلص الدراسة إلى أن العقوبة على الكفر في النص القرآني أخروية لا دنيوية، وأن استخدام الحديث لتجريم التحول الديني يعكس انزياحًا سلطويًا لا تشريعيًّا. كما تؤكد أن إعادة الاعتبار للخطاب القرآني، وفهم الحديث ضمن سياقه التاريخي، تمثل ضرورة فكرية وأخلاقية لمواجهة الاستبداد الديني، وتجديد العلاقة بين الإنسان والدين على أساس الحرية، لا القسر.
المقدمة:
في قلب الجدل الديني والفكري حول حرية الاعتقاد في الإسلام، تبرز مفارقة لافتة: لماذا تتمسّك الجماعات الإسلامية والسلفية التقليدية بحديث «من بدّل دينه فاقتلوه»، وتُهمّش أو تتجاوز الخطاب القرآني الذي يقرر بوضوح مبدأ حرية الإيمان، كما في قوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}؟ لا يعود هذا التمسك إلى مجرد التقديس للنصوص النبوية، بل إلى توظيف حديث الردة كأداة سلطوية لضبط المجال الديني والسياسي، والحفاظ على تماسك الجماعة من خلال الردع والعقاب، في مقابل خطاب قرآني يتأسس على الحجة والاختيار لا على الإكراه والعقوبة.
هذا التفضيل للحديث على حساب الآيات التأسيسية في القرآن، يعكس بنية ذهنية فقهية تأسست في سياق السلطة، وليس في فضاء الإيمان. إذ تلتقي رغبة الجماعات في فرض الانضباط الجماعي مع نص وظيفي يُستخدم كأداة لضبط الخارجين عن الخطاب الرسمي للدين، ما يفسّر مركزية هذا الحديث في خطابهم الدعوي والسياسي، خاصة حين يتعلّق الأمر بمفهوم "الردة" أو "الخروج عن الملة". بينما يُهمل الخطاب نفسه آيات قرآنية واضحة تضع حرية الاعتقاد ضمن سنن الاجتماع البشري، لا كاستثناء مهدد بالعقوبة.
نشأ توظيف حديث «من بدّل دينه فاقتلوه» في سياق تاريخي حساس، تميز بتكوّن الدولة الإسلامية في مراحلها الأولى، وتحديدًا عقب وفاة النبي ﷺ وبداية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمع ظهور ما عُرف في التاريخ الإسلامي بـ"حروب الردة"، وتمرّد بعض القبائل على سلطة الدولة المركزية في المدينة، لم يكن الخلاف حول الإيمان أو العقيدة فقط، بل كان تمردًا سياسيًا يتعلّق بسلطة الزكاة والولاء للدولة الفتيّة.
في هذا السياق، جاء مفهوم "الردة" مرتبطًا بالخيانة السياسية أكثر من ارتباطه بالتحوّل العقائدي الفردي. فقد كان المرتدون – بحسب التصنيف السياسي آنذاك – يشكلون خطرًا وجوديًا على وحدة الكيان السياسي والديني الناشئ. وبالتالي، لم يكن الحديث يُستحضر بوصفه تعبيرًا عن قاعدة إيمانية مطلقة، بل كإجراء طارئ في مواجهة حالة تمرّد تهدد الدولة في طور التكوين.
لكن مع مرور الزمن، تحوّل هذا التوظيف السياسي الظرفي إلى حكم فقهي ثابت، تم إدراجه ضمن كتب العقيدة والفقه بوصفه جزءًا من "الحدود" الشرعية. وقد لعبت السلطة السياسية والمدرسة الفقهية الرسمية دورًا كبيرًا في تثبيت هذا الحكم، خاصة في العصور التي كان فيها الدين أحد أدوات السيطرة على الجماهير وضبط المجال العام.
وبذلك، فإن حديث الردة – الذي وُظف في البداية لأغراض تتعلق بوحدة الدولة وأمنها – تم سحبه إلى فضاء العقيدة، واستخدامه لاحقًا لقمع كل أشكال الخروج الفكري أو الاختلاف الديني. وقد ساهمت التيارات السلفية والجماعات الأصولية في العصر الحديث في استعادة هذا الحكم وتضخيمه، دون مراجعة لأصوله السياقية أو البنية الخطابية الأعم التي أسسها القرآن.
تسعى هذه الدراسة إلى تفكيك هذا التوتر بين النص القرآني والحديث النبوي من خلال مدخل لسانـي وخطابي، يرتكز على تحليل البنية النحوية والدلالية للآية الكريمة: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}، ومقارنتها ببنية حديث: «من بدل دينه فاقتلوه». كما سيتم رصد السياق التداولي لكل نص، وطبيعة السلطة التي يمارسها—هل هي سلطة الإقناع والاختيار، أم سلطة القهر والردع؟
ثم تنتقل الدراسة إلى تحليل آراء المفسرين التقليديين حول الآية، وإبراز كيفية تعاملهم مع مبدأ حرية الاعتقاد، وهل رأوا في الآية إقرارًا واقعيًا أم ترخيصًا؟ كما تُناقش تأويلات الفقهاء للحديث، من النووي والشافعي إلى ابن حجر، لتبيان مدى اتساق أو تناقض تلك التأويلات مع البنية القرآنية. وفي مقابل ذلك، تُستعرض مواقف المعتزلة ومفكرين معاصرين أمثال محمد عبده ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي، ممن قدموا قراءات تحررية تفصل بين الإيمان القلبي وسلطة الجماعة.
وأخيرًا، تطرح الدراسة سؤالها الجوهري: هل الكفر مباح؟ وهل العقوبة عليه دينية أم سياسية؟ وتحاول أن تبرهن، عبر تحليل الخطاب والبنية، أن الإيمان في القرآن لا يكتمل إلا بالحرية، وأن العقوبة الدنيوية على المعتقد تُمثل انزياحًا فقهيًا عن جوهر النص القرآني، وتعبيرًا عن هيمنة فكر سلطوي أكثر منه تعبيرًا عن إرادة الله في التعامل مع ضمير الإنسان.
تحليل البنية اللسانية والخطابية للآية القرآنية
التركيب النحوي والدلالي
في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾، تبدأ الآية بأمر إلهي موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بـ"قل"، وهو فعل يدل على التبليغ، ويُحمّله مسؤولية إعلان الحقيقة. كلمة "الحق" معرفة بأداة التعريف "أل"، مما يضفي عليها طابعًا مطلقًا وثابتًا، ويؤكد أن هذا الحق ليس رأيًا بشريًا، بل صادر من "ربكم"؛ أي أن مصدره إلهي غير قابل للنقاش من جهة الأصل، لكنه في الوقت نفسه لا يُفرض على الناس بالإكراه. هذا التقديم يُرسي قاعدة خطابية محورية: الحقيقة الإلهية قائمة، لكنها تُعرض لا تُكره، تُبيَّن لا تُفرض.
ثم تأتي الجملة: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، لتُبنى على بنية شرطية تكرّر "من شاء" مرتين، في إشارة قوية إلى تمكين الإرادة الفردية. استخدام هذه البنية يعطي كل إنسان الحق في اختيار مصيره بين الإيمان والكفر، مع إدراكه للعواقب. اللام في "فليؤمن" و"فليكفر" هي لام الأمر، لكنها هنا لا تدل على التحريض أو الإباحة، بل تستخدم في سياق إقرار الواقع مع تحمّل المسؤولية. المعنى التداولي للعبارة لا يدعو للكفر أو يشجع عليه، بل يقر بأن الإيمان لا يكون ذا معنى إلا إذا كان نابعًا من إرادة حرة، لا من إكراه سلطوي.
المعنى التداولي
المعنى التداولي للآية يعكس رؤية قرآنية دقيقة لعلاقة الإنسان بالحرية والمسؤولية. فهي لا تشرعن الكفر، ولا تقدّمه كقيمة إيجابية، لكنها أيضًا لا تنفي واقعه كخيار بشري ممكن، قائم بالفعل في سياق الإرادة الإنسانية. الكفر في هذه الآية ليس أمرًا محمودًا، بل هو نتيجة لاختيار حرّ، تحذّر منه الآية وتربطه بعواقب أخروية واضحة، دون أن تلجأ إلى نفي إمكانية حدوثه في الدنيا.
الخطاب هنا تشريعي تحذيري، وليس تنفيذيًا قسريًا. الله يعرض "الحق" بوصفه خيارًا مفتوحًا أمام الإنسان، يليه تنبيه صارم لمن يرفضه، في الآية التالية: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا...﴾، مما يدل على أن البنية الخطابية تقوم على استراتيجيتين: (1) الإقرار بحرية الإنسان في الاختيار، و(2) تحمّله لعواقب هذا الاختيار في الآخرة، أي أن الآية تنتمي لخطاب يُؤمن بإرادة الإنسان لكنه يُلزمها بنتائجها.
السلطة في الخطاب
في هذه الآية، السلطة الإلهية لا تمارس الإكراه المباشر، بل تعتمد على الخطاب المقنِع لا القمع. الله، في سياق هذه الآية، لا يقول: "آمن أو أُجبِرك"، بل يقول: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، مما يضع أمام المتلقي الخيار الحر، مع توضيح النتائج التي تترتب على كل اختيار.
السلطة هنا تمارس تحفيزًا بالإغراء الأخلاقي والروحي، وتحذيرًا بالعاقبة الأخروية، لكنها لا تُنزل العقاب الدنيوي بالكافر لمجرد كفره. هذا يُظهر تحولًا كبيرًا في مفهوم السلطة داخل الخطاب القرآني مقارنة بالتصورات البشرية عن الحكم والسيطرة. فالله لا يحتاج إلى القهر ليثبت سلطته، بل يطرح الحقيقة ويُحمّل الإنسان مسؤولية موقفه منها.
الخطاب إذن يقوم على سلطة تربوية أخلاقية، لا على سلطة بوليسية. إنّه خطاب يتعامل مع الإنسان ككائن عاقل حر، لا كعبد مرعوب أو تابع مسلوب الإرادة.
وهنا تتجلى قوة الخطاب القرآني كسلطة معنوية، لا سلطة إكراه، تضع أمام الإنسان الخيارات، وتُبقي الحساب للآخرة، لا لسيف الدولة أو سلطة المجتمع.
التحليل البنيوي والدلالي للحديث:
«مَن بدّل دينه فاقتلوه»
(رواه البخاري)
التحليل اللساني
يتكوّن الحديث من جملة شرطية، تبدأ بأداة الشرط "من"، وهي أداة عامة تشمل أي فرد، ويقابلها في جواب الشرط فعل الأمر "فاقتلوه"، وهو تعبير يحمل طابعًا حاسمًا وقاطعًا. لكن هذه الصيغة، على بساطتها الظاهرية، تخفي قدرًا كبيرًا من الإبهام الدلالي.
فالعبارة "بدّل دينه" تأتي دون تحديد دقيق للسياق: هل المقصود تبديل الإسلام إلى غيره؟ أم الخروج على الجماعة سياسيًّا؟ أم الانتقال بين أديان أهل الكتاب؟ هذا الغموض في التحديد يفتح المجال لتأويلات متباينة، ما يستدعي الرجوع إلى السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي قيل فيه الحديث، بدلًا من الاكتفاء بالفهم الحرفي أو المقطوع عن ملابساته.
سياق الحديث
عند النظر في السياق السياسي والفقهي الذي ورد فيه حديث «من بدّل دينه فاقتلوه»، يتبيّن أن المسألة لم تكن تتعلق بحرية العقيدة أو الانتقال الفردي من دين إلى آخر، بل كانت مرتبطة بظروف خاصة في بدايات الدولة الإسلامية. فـ"تبديل الدين" آنذاك كان يُنظر إليه بوصفه تمردًا سياسيًّا، وخيانة جماعية في زمن الحرب، لا مجرد قناعة شخصية. وكان المرتد غالبًا ما ينضم إلى معسكر الأعداء، أو يحرض عليهم، بما يهدد استقرار الكيان الوليد.
من هنا، فإن الحديث لا يُفهم – في ضوء معطيات عصره – على أنه تشريع دائم لكل من يترك الإسلام، بل كاستجابة استثنائية لسياق استثنائي. إنه لا يتحدث عن "الكفر" كخيار فردي أو حرية فكرية، بل عن الانشقاق السياسي والخروج عن الجماعة في لحظة تهديد وجودي للدولة، وهو ما يقرب المفهوم من "الردة السياسية" أكثر من الردة العقائدية المحضة.
مقارنة بالبنية القرآنية
يمثل الخطاب القرآني في مجمله تأكيدًا على حرية الإيمان والاختيار العقائدي، باعتبارها مبدأً ثابتًا في العلاقة بين الإنسان والدين. فالآيات القرآنية مثل: "لا إكراه في الدين"، و*"أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟"، و"لكم دينكم ولي دين"*، ترسّخ هذا المبدأ وتؤكد أن الإيمان لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى على القناعة الحرة.
في المقابل، يندرج حديث «من بدّل دينه فاقتلوه» في إطارٍ تنفيذيّ خاص، يعكس ظرفًا سياسيًّا محددًا، ولا يحمل طابعًا تأسيسيًّا عامًا كآيات القرآن. فبينما تمثل الآيات القرآنية خطابًا تشريعيًّا إلهيًّا دائمًا، يأتي الحديث ضمن سياق إخباريّ ظرفيّ، لا يمكن فصله عن معطياته التاريخية والمرحلية. ومن هنا، فإن تعميمه خارج سياقه يُعد خللًا في فهم المنظومة التشريعية الإسلامية.
التوتر البنيوي بين النصّين
يتجلى التوتر البنيوي بين النصين – الآيات القرآنية والحديث النبوي – في اختلاف نوعية الخطاب وطبيعته. فالآيات تنتمي إلى خطاب إلهي عام، يتسم بطابع توجيهي لا يحمل الإكراه، كما في قوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، و*"لكم دينكم ولي دين"*. هذا الخطاب القرآني يتأسس على حرية الإيمان كحق فردي، ويمنح الإنسان مساحة للاختيار وتحمل العاقبة الأخروية، دون تدخل سلطوي مباشر في اختياراته الدينية.
في المقابل، يأتي الحديث ضمن خطاب نبوي تنفيذي موجه لواقع ظرفي محدد، يتعامل مع "تبديل الدين" من زاوية سياسية جماعية تهدد كيان الدولة الوليدة. لذلك، يُظهر الحديث بنية سلطوية أكثر صرامة، قائمة على الردع والعقوبة، لا على الحرية والتحذير. فهو لا يعرض خيارات، بل يصدر أمرًا مباشرًا يُفهم ضمن آليات الحفاظ على تماسك الجماعة، لا ضمن إطار تنظيري للتعامل مع حرية الاعتقاد.
رأي المفسرين التقليديين في الآية والحديث
الآية: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾
رأى المفسرون التقليديون في الآية ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29] أنها لا تمثّل ترخيصًا للكفر، وإنما تعبّر عن إقرار واقعي بحرية الإنسان في اختيار طريقه، مع تحمّل تبعات اختياره. فالإمام الطبري (ت 310هـ) في تفسيره يرى أن الآية جاءت لتقرير المسؤولية الفردية أمام الإيمان أو الكفر، حيث قال: "إنّما معناه: افعلوا ما شئتم، فسيجزيكم الله على فعلكم"، أي أن الله يبيّن الطريقين، ولا يُكره أحدًا عليهما، بل يدعوهم لاختيار الإيمان، ويترك لهم القرار مع توضيح العاقبة. (الطبري، تفسير جامع البيان، ج16، ص29).
أما القرطبي (ت 671هـ)، فيؤكد على أن العبارة لا تفيد الترخيص أو الإباحة للكفر، بل تفيد "الوعيد والتهديد"؛ أي أن الله يخاطب الإنسان كأنما يقول له: افعل ما شئت، لكن اعلم أنك مسؤول، وأن من يختار الكفر سيكون جزاؤه العذاب. وهذا التفسير يؤكد على احتفاظ الله بالسلطة الأخروية دون تدخل مباشر في حرية الإنسان الدنيوية. (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج10، ص350).
ومن جهته، يعرض الرازي (ت 606هـ) في "التفسير الكبير" عدة آراء، لكنه يستقر على أن الآية تعبر عن مبدأ جوهري في العقيدة الإسلامية، وهو أن الإيمان لا يصح بالإكراه، وأن "الحق من ربكم" يتضمن الدعوة لاستخدام العقل في الاختيار، وليس فرض العقيدة. ويضيف الرازي أن حرية الاختيار جزء من امتحان الإنسان في الدنيا، حيث يُبتلى في أن يختار بين الحق والباطل بنفسه. (الرازي، مفاتيح الغيب، ج21، ص28).
الملحوظة الأساسية هنا، أن أغلب المفسرين التقليديين لم ينظروا إلى الآية بوصفها ترخيصًا للكفر، بل أولوها على نحو ينسجم مع العقيدة التي تفصل بين حرية الإنسان في الدنيا، ومحاسبته في الآخرة.
الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه"
يُعدّ حديث «من بدّل دينه فاقتلوه» من أبرز الأحاديث التي استُند إليها في تقرير حكم الردة في الفقه الإسلامي. الإمام النووي، في شرحه على صحيح مسلم، يرى أن هذا الحديث صريح في حكم المرتد، ويقرر أن "فيه دليل على قتل المرتد، وهو مذهب العلماء كافة إلا ما حُكي عن بعضهم من خلاف شاذ لا يُعتدّ به" (النووي، شرح صحيح مسلم، ج 1، ص 108). النووي يعتبر هذا الحكم مجمعًا عليه بين الفقهاء، ويربطه بالحفاظ على وحدة الجماعة المسلمة، لا بحرية العقيدة أو حق الفرد في اختيار دينه.
أما ابن حجر العسقلاني، في شرحه لحديث البخاري، فقد أبدى ملاحظة مهمة حين أشار إلى أن النصّ لا يوضح بجلاء ما إذا كان المقصود هو مطلق التبديل الديني، أم أنه متعلق بتبديل يحمل دلالة على الخروج السياسي أو التحاق بمعسكر الأعداء. ومع ذلك، فإنه يرجّح الرأي الفقهي الذي يفهم الحديث على إطلاقه، أي أنّ أي تغيير في الدين يُعدّ موجبًا للقتل، وفق التأويل الفقهي السائد (ابن حجر، فتح الباري، ج 12، ص 270).
الإمام الشافعي، من جهته، أقرّ بحكم قتل المرتد، لكنه قنّنه بإجراءات واضحة، أبرزها اشتراط الاستتابة قبل تنفيذ الحكم. في كتابه الأم، يشترط أن يُمهَل المرتد ثلاثة أيام، فإن أصرّ على موقفه بعد البيان والنقاش، جاز قتله. هذا الاشتراط يفتح نافذة للاجتهاد في فهم الحكم وتطبيقه، ويعكس حرصًا على التريّث وليس التسرع في إصدار العقوبة القصوى (الشافعي، الأم، ج 6، ص 147). ورغم هذا التباين في التفاصيل، فإن الإطار العام الذي تبنّاه أغلب الفقهاء يربط الحديث بسلطة الدولة في ضبط المجال العقدي، دون اتفاق تام حول طبيعة "التبديل" وما إذا كان يعكس حرية داخلية أم خيانة سياسية.
رأي المعتزلة – مدرسة العقل والمسؤولية
في مقاربة فكرية عقلانية، اتخذت المعتزلة موقفًا رافضًا تمامًا لفكرة الإكراه الديني، مستندين في ذلك إلى نصوص قرآنية صريحة مثل قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} (البقرة: 256)، و{أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} (يونس: 99). وقد اعتبروا أن الإيمان لا يكون إيمانًا حقيقيًا إلا إذا كان نابعًا من قناعة داخلية حرة، لا نتيجة خوف أو ضغط سياسي أو اجتماعي. ولذا، رفضوا الحكم الفقهي الشائع الذي يربط بين الردة والعقوبة الجسدية، ما لم يكن المرتد في حالة حرب فعلية ضد الدولة الإسلامية.
فرّق المعتزلة بوضوح بين ما أسموه "الإيمان القلبي" الذي هو مناط النجاة في الآخرة، و"الإسلام السياسي" أو الظاهري الذي قد يُفرض في بعض السياقات التاريخية، لكن دون أن تكون له قيمة أخلاقية عند الله إن لم يكن نابعًا من اقتناع. وأكدوا أن حرية الإنسان في الإيمان جزء من عدل الله، وأنه لا يصح أن يُحاسب الإنسان في الدنيا أو الآخرة على اختيار لم يكن حرًّا. ووفقًا لهذا المنظور، يكون تبديل الدين فعلًا من أفعال الحرية الفردية لا يوجب العقاب، ما لم يقترن بسلوك عدائي.
وقد عبّر القاضي عبد الجبار، أحد أبرز مفكري المعتزلة، عن هذه الرؤية بوضوح في كتابه "المغني في أبواب التوحيد والعدل"، حيث قال إن الله "لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة"، وإن إقامة الحجة لا تكون إلا في سياق حرية كاملة في التفكير والاختيار. كما فرّق القاضي بين الردة الفردية – التي تعني التحول الفكري أو العقدي – وبين الردة السياسية – التي تتخذ شكل العداء أو التحريض ضد الدولة، وهي وحدها التي يمكن أن تُقابل بإجراءات قانونية دفاعية.
النتيجة الجوهرية لهذا الطرح المعتزلي أن السلطة السياسية – في رأيهم – لا يجوز أن تُخضع حرية المعتقد لمنطق العقوبة أو القسر، لأن ذلك يُناقض عدل الله نفسه، ويحوّل الدين من دعوة أخلاقية إلى أداة للبطش. وبذلك، يقدم المعتزلة نموذجًا مبكرًا لفصل المجال الديني الأخلاقي عن سلطة الدولة، ويدعون إلى أن يكون الإيمان فعلًا حُرًّا لا يُراقب ولا يُعاقب، ما لم يتحوّل إلى عدوان صريح.
تأويلات المفكرين المعاصرين
الإمام محمد عبده، أحد أبرز رواد التجديد في الفكر الإسلامي، تعامل مع الآية القرآنية "لا إكراه في الدين" (البقرة: 256) باعتبارها قاعدة قطعية تؤسس لحرية الاعتقاد وتمنع الإكراه بأي شكل. في تفسيره لها، أكد أن الدين لا يقوم إلا على الاقتناع العقلي والقلبي، وأن الإكراه ينفي جوهر الإيمان. كما رفض بشكل صريح تطبيق حد الردة في العصر الحديث، إلا في حالة اقترانه بـ"الخيانة السياسية" التي تهدد المجتمع، أي أن العقوبة دنيوية تكون على الفعل السياسي لا على تغيير المعتقد وحده. (انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده، الجزء الثاني، ص 150–153)
المفكر نصر حامد أبو زيد قرأ النص القرآني من منظور حداثي، واعتبر أن "لا إكراه في الدين" تعكس مشروعًا تحرريًا كاملاً يهدف إلى تحرير الإنسان من الوصاية الدينية والسياسية. بحسبه، الخطاب القرآني يؤسس لفردانية دينية قائمة على حرية الضمير لا على إكراه جماعي. كما انتقد أبو زيد التوظيف المعاصر لبعض الأحاديث النبوية—خاصة تلك التي تُستخدم لتبرير قتل المرتد—مؤكدًا أنها أحاديث ظرفية ارتبطت بسياقات سياسية وعسكرية معينة، ولا يجوز تعميمها اليوم لتبرير خطاب تكفيري معاصر. (انظر: نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ص 82–85)
حسن حنفي، في مشروعه المعروف بـ"اليسار الإسلامي"، ذهب إلى أبعد من مجرد الدعوة لحرية الاعتقاد، حيث دعا إلى "نزع القداسة عن الفقه السلطوي" الذي نشأ في ظل تحالف بين المؤسسة الفقهية والسلطة. يرى حنفي أن القتل على أساس الفكر أو الردة يتناقض كليًا مع روحية القرآن، وأن الآية "لا إكراه في الدين" تشكّل نفيًا قاطعًا لسلطة الجماعة في قمع المخالفين دينيًا. من هنا، فإن الفرد وحده يملك الحق في تقرير مصيره الديني دون تدخل أو قهر من الجماعة السياسية أو الدينية. (انظر: التراث والتجديد، حسن حنفي، ج 1، ص 211–214)
يجمع هؤلاء المفكرون الثلاثة—عبده، وأبو زيد، وحنفي—بين احترام النص القرآني وبين ضرورة تأويله في ضوء العقل والواقع. كل منهم، بطريقته، يُعيد فتح آفاق التأويل ليؤكد أن الحرية الدينية مبدأ لا يمكن التراجع عنه، وأن سلطة الجماعة أو الدولة لا يجب أن تتغوّل على ضمير الفرد. وهو موقف يقدّم الإسلام بوصفه دينًا أخلاقيًا لا قسريًا، ويتماشى مع القيم الحديثة في الحرية والكرامة.
هل الكفر مباح؟ وهل العقوبة دينية أم سياسية؟
يتبدى من خلال تحليل الخطاب الإسلامي الكلاسيكي والمعاصر، وجود توتر واضح بين ما يمكن تسميته بـ"الخطاب القرآني"، الذي يميل إلى الاعتراف بحرية الإيمان، ويؤسس لفضاء من الاختيار والضمير، وبين "الخطاب الفقهي" التقليدي الذي غالبًا ما يُقيّد هذه الحرية باسم الحفاظ على وحدة الجماعة الدينية. في حين تنص الآيات بوضوح على حرية الاعتقاد – كقوله: "لا إكراه في الدين" و*"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"*– نجد أن كثيرًا من الأحكام الفقهية اللاحقة ارتبطت بفكرة الردة كجريمة سياسية أكثر منها خيارًا دينيًا، مما عكس توجهًا سلطويًا وظّف الدين لضبط المجال العام.
تؤسس الآية موضع البحث لبنية خطابية واضحة تُعلي من شأن الاختيار الفردي، وتضع الإيمان في موضع الفعل الحر، الواعي، غير القابل للإكراه أو المصادرة. فالإيمان – من المنظور القرآني – لا قيمة له إن لم يكن نابعًا من قناعة حرة، وهذا ما يجعل العقيدة علاقة خاصة بين الإنسان وربّه، لا بين الإنسان والجماعة أو السلطة. وهذا المنطق القرآني يعارض تمامًا الرؤية التي ترى أن الإيمان لا يتحقق إلا تحت رقابة الجماعة، أو أن الكفر يجب أن يُقمع بالقوة.
يُلاحظ أن الحديث النبوي الذي ينص على "من بدل دينه فاقتلوه" لم يُفهم عبر العصور بشكل موحد، بل كان دومًا موضع تأويلات متباينة. فبينما استُخدم هذا الحديث في تراث السلطة كمبرر لفرض عقوبات قاسية على من يختار الخروج من الإسلام، فإن العديد من المفكرين المعاصرين – مثل نصر حامد أبو زيد ومحمد عبده – أعادوا قراءته في ضوء السياق التاريخي الذي قيل فيه، ورفضوا تعميمه كتشريع خالد. بذلك، فإن سلطة النص ليست مطلقة، بل تخضع للتأويل، والتأويل بدوره يتأثر بسياق القوة والمعرفة.
ختامًا، يمكن القول إن الكفر، من منظور قرآني خالص، ليس "مباحًا" أخلاقيًا أو روحيًا، لكنّه أيضًا ليس ممنوعًا بالقوة أو الزجر. فالله، وفقًا للقرآن، قد منح الإنسان حرية الإيمان أو الكفر، على أن يتحمل وحده تبعات اختياره في الآخرة. هذه الرؤية تُفكك منطق العقوبة الدنيوية المرتبطة بالمخالفات العقدية، وتؤسس لفكرة أن التعدد والاختلاف في الإيمان جزء من سنن الاجتماع البشري. لذا، فالمعاقبة على "الكفر" دينيًا في الدنيا تمثل انزياحًا عن الخطاب القرآني نحو خطاب فقهي سلطوي، تلبّس بالدين لكنه خدم منطق الهيمنة أكثر مما خدم الإيمان.
خاتمة الدراسة:
تكشف هذه الدراسة عن التوتر العميق بين الخطاب القرآني المؤسس لحرية الاعتقاد، والخطاب الفقهي الذي تطور في سياق السلطة السياسية، والذي يُكرّس الردة بوصفها جريمة موجبة للعقوبة الدنيوية. الآية القرآنية {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} لا تشرعن الكفر كقيمة، لكنها تعترف به كاحتمال إنساني مشروع ضمن نظام الاختبار الإلهي. وهي بهذا تضع حرية الإيمان في صلب العلاقة بين الإنسان وربّه، دون تدخل من الجماعة أو الدولة. في المقابل، تم توظيف الحديث النبوي «من بدّل دينه فاقتلوه» في لحظة تاريخية معينة، ثم جرى تعميمه لاحقًا على نحو يهدد جوهر الإيمان ذاته.
من خلال التحليل البنيوي والدلالي للنصّين، تبين أن الآية تحمل بنية خطابية تداولية قائمة على التخيير والتحذير الأخلاقي، لا القهر أو التنفيذ العقابي. أما الحديث، فينتمي إلى حقل الخطاب التنفيذي السلطوي، المرتبط بحماية الجماعة أكثر من رعاية الإيمان. المفارقة أن هذا الحديث اكتسب مع الزمن سلطة تشريعية أعلى من موقعه الزمني والظرفي، بفعل التأويل الفقهي السلطوي الذي سعى إلى حماية وحدة الجماعة عبر تقييد الحريات الفردية، متجاوزًا الخطاب الإلهي الأكثر تسامحًا وواقعية.
وقد أظهرت المراجعة التاريخية والفكرية أن أغلب الفقهاء تعاملوا مع الحديث بوصفه نصًا تطبيقيًا قطعيًا، رغم وجود تباينات في شروط التنفيذ، بينما تبنّت المعتزلة والمفكرون المعاصرون موقفًا يدافع عن حرية الاعتقاد بوصفها جزءًا من عدل الله. كما أكدت مواقف محمد عبده ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي أن القتل على الفكر لا يُمكن أن يتسق مع روح النص القرآني، وأن توظيف الحديث في سياقات سلطوية حديثة لا يُنتج إلا خطابًا تكفيريًا عنيفًا يُقوّض حرية الضمير.
توصيات الدراسة:
إعادة الاعتبار للقرآن بوصفه المرجعية العليا في قضايا الإيمان والحرية، وضرورة قراءة الأحاديث النبوية في سياقها التاريخي والسياسي لا بوصفها نصوصًا تشريعية مطلقة.
دعوة المؤسسات الدينية والفقهية لتحديث مناهجها التفسيرية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الكبرى، وعلى رأسها الحرية، والعدل، وكرامة الإنسان، بدل التمسك بأحكام تراثية نشأت في سياق سياسي مغلق.
تشجيع قراءة لسانية وتحليلية للنصوص الدينية، تعتمد منهج تحليل الخطاب والتداولية، بما يسمح بفهم أكثر دقة لدلالات النصوص ومقاصدها، بدل الاكتفاء بالقراءة الحرفية التقليدية.
رفض تجريم التحول الديني في العصر الحديث، والتأكيد على أن العقيدة شأن خاص لا يجوز أن تخضع للقانون العقابي، إلا إذا اقترنت بأفعال عدائية مادية تهدد السلم الأهلي أو الأمن العام، لا لمجرد التحول في القناعة الفردية.
"من بدل دينه فاقتلوه" البخاري (3017)
الملخص التنفيذي:
تتناول هذه الدراسة التوتر البنيوي بين الخطاب القرآني والحديث النبوي في مسألة حرية الاعتقاد، من خلال تحليل الآية: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}، وحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه». تكشف القراءة اللسانية والخطابية أن الآية تؤسس لحرية فردية محمية إلهيًّا تقوم على الاختيار وتحمل المسؤولية الأخروية، بينما يُستخدم الحديث في التراث الفقهي كأداة تنفيذية لضبط الجماعة وتقييد حرية العقيدة باسم الردة، رغم غموض سياقه ودلالاته.
وتخلص الدراسة إلى أن العقوبة على الكفر في النص القرآني أخروية لا دنيوية، وأن استخدام الحديث لتجريم التحول الديني يعكس انزياحًا سلطويًا لا تشريعيًّا. كما تؤكد أن إعادة الاعتبار للخطاب القرآني، وفهم الحديث ضمن سياقه التاريخي، تمثل ضرورة فكرية وأخلاقية لمواجهة الاستبداد الديني، وتجديد العلاقة بين الإنسان والدين على أساس الحرية، لا القسر.
المقدمة:
في قلب الجدل الديني والفكري حول حرية الاعتقاد في الإسلام، تبرز مفارقة لافتة: لماذا تتمسّك الجماعات الإسلامية والسلفية التقليدية بحديث «من بدّل دينه فاقتلوه»، وتُهمّش أو تتجاوز الخطاب القرآني الذي يقرر بوضوح مبدأ حرية الإيمان، كما في قوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}؟ لا يعود هذا التمسك إلى مجرد التقديس للنصوص النبوية، بل إلى توظيف حديث الردة كأداة سلطوية لضبط المجال الديني والسياسي، والحفاظ على تماسك الجماعة من خلال الردع والعقاب، في مقابل خطاب قرآني يتأسس على الحجة والاختيار لا على الإكراه والعقوبة.
هذا التفضيل للحديث على حساب الآيات التأسيسية في القرآن، يعكس بنية ذهنية فقهية تأسست في سياق السلطة، وليس في فضاء الإيمان. إذ تلتقي رغبة الجماعات في فرض الانضباط الجماعي مع نص وظيفي يُستخدم كأداة لضبط الخارجين عن الخطاب الرسمي للدين، ما يفسّر مركزية هذا الحديث في خطابهم الدعوي والسياسي، خاصة حين يتعلّق الأمر بمفهوم "الردة" أو "الخروج عن الملة". بينما يُهمل الخطاب نفسه آيات قرآنية واضحة تضع حرية الاعتقاد ضمن سنن الاجتماع البشري، لا كاستثناء مهدد بالعقوبة.
نشأ توظيف حديث «من بدّل دينه فاقتلوه» في سياق تاريخي حساس، تميز بتكوّن الدولة الإسلامية في مراحلها الأولى، وتحديدًا عقب وفاة النبي ﷺ وبداية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمع ظهور ما عُرف في التاريخ الإسلامي بـ"حروب الردة"، وتمرّد بعض القبائل على سلطة الدولة المركزية في المدينة، لم يكن الخلاف حول الإيمان أو العقيدة فقط، بل كان تمردًا سياسيًا يتعلّق بسلطة الزكاة والولاء للدولة الفتيّة.
في هذا السياق، جاء مفهوم "الردة" مرتبطًا بالخيانة السياسية أكثر من ارتباطه بالتحوّل العقائدي الفردي. فقد كان المرتدون – بحسب التصنيف السياسي آنذاك – يشكلون خطرًا وجوديًا على وحدة الكيان السياسي والديني الناشئ. وبالتالي، لم يكن الحديث يُستحضر بوصفه تعبيرًا عن قاعدة إيمانية مطلقة، بل كإجراء طارئ في مواجهة حالة تمرّد تهدد الدولة في طور التكوين.
لكن مع مرور الزمن، تحوّل هذا التوظيف السياسي الظرفي إلى حكم فقهي ثابت، تم إدراجه ضمن كتب العقيدة والفقه بوصفه جزءًا من "الحدود" الشرعية. وقد لعبت السلطة السياسية والمدرسة الفقهية الرسمية دورًا كبيرًا في تثبيت هذا الحكم، خاصة في العصور التي كان فيها الدين أحد أدوات السيطرة على الجماهير وضبط المجال العام.
وبذلك، فإن حديث الردة – الذي وُظف في البداية لأغراض تتعلق بوحدة الدولة وأمنها – تم سحبه إلى فضاء العقيدة، واستخدامه لاحقًا لقمع كل أشكال الخروج الفكري أو الاختلاف الديني. وقد ساهمت التيارات السلفية والجماعات الأصولية في العصر الحديث في استعادة هذا الحكم وتضخيمه، دون مراجعة لأصوله السياقية أو البنية الخطابية الأعم التي أسسها القرآن.
تسعى هذه الدراسة إلى تفكيك هذا التوتر بين النص القرآني والحديث النبوي من خلال مدخل لسانـي وخطابي، يرتكز على تحليل البنية النحوية والدلالية للآية الكريمة: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}، ومقارنتها ببنية حديث: «من بدل دينه فاقتلوه». كما سيتم رصد السياق التداولي لكل نص، وطبيعة السلطة التي يمارسها—هل هي سلطة الإقناع والاختيار، أم سلطة القهر والردع؟
ثم تنتقل الدراسة إلى تحليل آراء المفسرين التقليديين حول الآية، وإبراز كيفية تعاملهم مع مبدأ حرية الاعتقاد، وهل رأوا في الآية إقرارًا واقعيًا أم ترخيصًا؟ كما تُناقش تأويلات الفقهاء للحديث، من النووي والشافعي إلى ابن حجر، لتبيان مدى اتساق أو تناقض تلك التأويلات مع البنية القرآنية. وفي مقابل ذلك، تُستعرض مواقف المعتزلة ومفكرين معاصرين أمثال محمد عبده ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي، ممن قدموا قراءات تحررية تفصل بين الإيمان القلبي وسلطة الجماعة.
وأخيرًا، تطرح الدراسة سؤالها الجوهري: هل الكفر مباح؟ وهل العقوبة عليه دينية أم سياسية؟ وتحاول أن تبرهن، عبر تحليل الخطاب والبنية، أن الإيمان في القرآن لا يكتمل إلا بالحرية، وأن العقوبة الدنيوية على المعتقد تُمثل انزياحًا فقهيًا عن جوهر النص القرآني، وتعبيرًا عن هيمنة فكر سلطوي أكثر منه تعبيرًا عن إرادة الله في التعامل مع ضمير الإنسان.
تحليل البنية اللسانية والخطابية للآية القرآنية
التركيب النحوي والدلالي
في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾، تبدأ الآية بأمر إلهي موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بـ"قل"، وهو فعل يدل على التبليغ، ويُحمّله مسؤولية إعلان الحقيقة. كلمة "الحق" معرفة بأداة التعريف "أل"، مما يضفي عليها طابعًا مطلقًا وثابتًا، ويؤكد أن هذا الحق ليس رأيًا بشريًا، بل صادر من "ربكم"؛ أي أن مصدره إلهي غير قابل للنقاش من جهة الأصل، لكنه في الوقت نفسه لا يُفرض على الناس بالإكراه. هذا التقديم يُرسي قاعدة خطابية محورية: الحقيقة الإلهية قائمة، لكنها تُعرض لا تُكره، تُبيَّن لا تُفرض.
ثم تأتي الجملة: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، لتُبنى على بنية شرطية تكرّر "من شاء" مرتين، في إشارة قوية إلى تمكين الإرادة الفردية. استخدام هذه البنية يعطي كل إنسان الحق في اختيار مصيره بين الإيمان والكفر، مع إدراكه للعواقب. اللام في "فليؤمن" و"فليكفر" هي لام الأمر، لكنها هنا لا تدل على التحريض أو الإباحة، بل تستخدم في سياق إقرار الواقع مع تحمّل المسؤولية. المعنى التداولي للعبارة لا يدعو للكفر أو يشجع عليه، بل يقر بأن الإيمان لا يكون ذا معنى إلا إذا كان نابعًا من إرادة حرة، لا من إكراه سلطوي.
المعنى التداولي
المعنى التداولي للآية يعكس رؤية قرآنية دقيقة لعلاقة الإنسان بالحرية والمسؤولية. فهي لا تشرعن الكفر، ولا تقدّمه كقيمة إيجابية، لكنها أيضًا لا تنفي واقعه كخيار بشري ممكن، قائم بالفعل في سياق الإرادة الإنسانية. الكفر في هذه الآية ليس أمرًا محمودًا، بل هو نتيجة لاختيار حرّ، تحذّر منه الآية وتربطه بعواقب أخروية واضحة، دون أن تلجأ إلى نفي إمكانية حدوثه في الدنيا.
الخطاب هنا تشريعي تحذيري، وليس تنفيذيًا قسريًا. الله يعرض "الحق" بوصفه خيارًا مفتوحًا أمام الإنسان، يليه تنبيه صارم لمن يرفضه، في الآية التالية: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا...﴾، مما يدل على أن البنية الخطابية تقوم على استراتيجيتين: (1) الإقرار بحرية الإنسان في الاختيار، و(2) تحمّله لعواقب هذا الاختيار في الآخرة، أي أن الآية تنتمي لخطاب يُؤمن بإرادة الإنسان لكنه يُلزمها بنتائجها.
السلطة في الخطاب
في هذه الآية، السلطة الإلهية لا تمارس الإكراه المباشر، بل تعتمد على الخطاب المقنِع لا القمع. الله، في سياق هذه الآية، لا يقول: "آمن أو أُجبِرك"، بل يقول: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، مما يضع أمام المتلقي الخيار الحر، مع توضيح النتائج التي تترتب على كل اختيار.
السلطة هنا تمارس تحفيزًا بالإغراء الأخلاقي والروحي، وتحذيرًا بالعاقبة الأخروية، لكنها لا تُنزل العقاب الدنيوي بالكافر لمجرد كفره. هذا يُظهر تحولًا كبيرًا في مفهوم السلطة داخل الخطاب القرآني مقارنة بالتصورات البشرية عن الحكم والسيطرة. فالله لا يحتاج إلى القهر ليثبت سلطته، بل يطرح الحقيقة ويُحمّل الإنسان مسؤولية موقفه منها.
الخطاب إذن يقوم على سلطة تربوية أخلاقية، لا على سلطة بوليسية. إنّه خطاب يتعامل مع الإنسان ككائن عاقل حر، لا كعبد مرعوب أو تابع مسلوب الإرادة.
وهنا تتجلى قوة الخطاب القرآني كسلطة معنوية، لا سلطة إكراه، تضع أمام الإنسان الخيارات، وتُبقي الحساب للآخرة، لا لسيف الدولة أو سلطة المجتمع.
التحليل البنيوي والدلالي للحديث:
«مَن بدّل دينه فاقتلوه»
(رواه البخاري)
التحليل اللساني
يتكوّن الحديث من جملة شرطية، تبدأ بأداة الشرط "من"، وهي أداة عامة تشمل أي فرد، ويقابلها في جواب الشرط فعل الأمر "فاقتلوه"، وهو تعبير يحمل طابعًا حاسمًا وقاطعًا. لكن هذه الصيغة، على بساطتها الظاهرية، تخفي قدرًا كبيرًا من الإبهام الدلالي.
فالعبارة "بدّل دينه" تأتي دون تحديد دقيق للسياق: هل المقصود تبديل الإسلام إلى غيره؟ أم الخروج على الجماعة سياسيًّا؟ أم الانتقال بين أديان أهل الكتاب؟ هذا الغموض في التحديد يفتح المجال لتأويلات متباينة، ما يستدعي الرجوع إلى السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي قيل فيه الحديث، بدلًا من الاكتفاء بالفهم الحرفي أو المقطوع عن ملابساته.
سياق الحديث
عند النظر في السياق السياسي والفقهي الذي ورد فيه حديث «من بدّل دينه فاقتلوه»، يتبيّن أن المسألة لم تكن تتعلق بحرية العقيدة أو الانتقال الفردي من دين إلى آخر، بل كانت مرتبطة بظروف خاصة في بدايات الدولة الإسلامية. فـ"تبديل الدين" آنذاك كان يُنظر إليه بوصفه تمردًا سياسيًّا، وخيانة جماعية في زمن الحرب، لا مجرد قناعة شخصية. وكان المرتد غالبًا ما ينضم إلى معسكر الأعداء، أو يحرض عليهم، بما يهدد استقرار الكيان الوليد.
من هنا، فإن الحديث لا يُفهم – في ضوء معطيات عصره – على أنه تشريع دائم لكل من يترك الإسلام، بل كاستجابة استثنائية لسياق استثنائي. إنه لا يتحدث عن "الكفر" كخيار فردي أو حرية فكرية، بل عن الانشقاق السياسي والخروج عن الجماعة في لحظة تهديد وجودي للدولة، وهو ما يقرب المفهوم من "الردة السياسية" أكثر من الردة العقائدية المحضة.
مقارنة بالبنية القرآنية
يمثل الخطاب القرآني في مجمله تأكيدًا على حرية الإيمان والاختيار العقائدي، باعتبارها مبدأً ثابتًا في العلاقة بين الإنسان والدين. فالآيات القرآنية مثل: "لا إكراه في الدين"، و*"أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟"، و"لكم دينكم ولي دين"*، ترسّخ هذا المبدأ وتؤكد أن الإيمان لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى على القناعة الحرة.
في المقابل، يندرج حديث «من بدّل دينه فاقتلوه» في إطارٍ تنفيذيّ خاص، يعكس ظرفًا سياسيًّا محددًا، ولا يحمل طابعًا تأسيسيًّا عامًا كآيات القرآن. فبينما تمثل الآيات القرآنية خطابًا تشريعيًّا إلهيًّا دائمًا، يأتي الحديث ضمن سياق إخباريّ ظرفيّ، لا يمكن فصله عن معطياته التاريخية والمرحلية. ومن هنا، فإن تعميمه خارج سياقه يُعد خللًا في فهم المنظومة التشريعية الإسلامية.
التوتر البنيوي بين النصّين
يتجلى التوتر البنيوي بين النصين – الآيات القرآنية والحديث النبوي – في اختلاف نوعية الخطاب وطبيعته. فالآيات تنتمي إلى خطاب إلهي عام، يتسم بطابع توجيهي لا يحمل الإكراه، كما في قوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، و*"لكم دينكم ولي دين"*. هذا الخطاب القرآني يتأسس على حرية الإيمان كحق فردي، ويمنح الإنسان مساحة للاختيار وتحمل العاقبة الأخروية، دون تدخل سلطوي مباشر في اختياراته الدينية.
في المقابل، يأتي الحديث ضمن خطاب نبوي تنفيذي موجه لواقع ظرفي محدد، يتعامل مع "تبديل الدين" من زاوية سياسية جماعية تهدد كيان الدولة الوليدة. لذلك، يُظهر الحديث بنية سلطوية أكثر صرامة، قائمة على الردع والعقوبة، لا على الحرية والتحذير. فهو لا يعرض خيارات، بل يصدر أمرًا مباشرًا يُفهم ضمن آليات الحفاظ على تماسك الجماعة، لا ضمن إطار تنظيري للتعامل مع حرية الاعتقاد.
رأي المفسرين التقليديين في الآية والحديث
الآية: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾
رأى المفسرون التقليديون في الآية ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29] أنها لا تمثّل ترخيصًا للكفر، وإنما تعبّر عن إقرار واقعي بحرية الإنسان في اختيار طريقه، مع تحمّل تبعات اختياره. فالإمام الطبري (ت 310هـ) في تفسيره يرى أن الآية جاءت لتقرير المسؤولية الفردية أمام الإيمان أو الكفر، حيث قال: "إنّما معناه: افعلوا ما شئتم، فسيجزيكم الله على فعلكم"، أي أن الله يبيّن الطريقين، ولا يُكره أحدًا عليهما، بل يدعوهم لاختيار الإيمان، ويترك لهم القرار مع توضيح العاقبة. (الطبري، تفسير جامع البيان، ج16، ص29).
أما القرطبي (ت 671هـ)، فيؤكد على أن العبارة لا تفيد الترخيص أو الإباحة للكفر، بل تفيد "الوعيد والتهديد"؛ أي أن الله يخاطب الإنسان كأنما يقول له: افعل ما شئت، لكن اعلم أنك مسؤول، وأن من يختار الكفر سيكون جزاؤه العذاب. وهذا التفسير يؤكد على احتفاظ الله بالسلطة الأخروية دون تدخل مباشر في حرية الإنسان الدنيوية. (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج10، ص350).
ومن جهته، يعرض الرازي (ت 606هـ) في "التفسير الكبير" عدة آراء، لكنه يستقر على أن الآية تعبر عن مبدأ جوهري في العقيدة الإسلامية، وهو أن الإيمان لا يصح بالإكراه، وأن "الحق من ربكم" يتضمن الدعوة لاستخدام العقل في الاختيار، وليس فرض العقيدة. ويضيف الرازي أن حرية الاختيار جزء من امتحان الإنسان في الدنيا، حيث يُبتلى في أن يختار بين الحق والباطل بنفسه. (الرازي، مفاتيح الغيب، ج21، ص28).
الملحوظة الأساسية هنا، أن أغلب المفسرين التقليديين لم ينظروا إلى الآية بوصفها ترخيصًا للكفر، بل أولوها على نحو ينسجم مع العقيدة التي تفصل بين حرية الإنسان في الدنيا، ومحاسبته في الآخرة.
الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه"
يُعدّ حديث «من بدّل دينه فاقتلوه» من أبرز الأحاديث التي استُند إليها في تقرير حكم الردة في الفقه الإسلامي. الإمام النووي، في شرحه على صحيح مسلم، يرى أن هذا الحديث صريح في حكم المرتد، ويقرر أن "فيه دليل على قتل المرتد، وهو مذهب العلماء كافة إلا ما حُكي عن بعضهم من خلاف شاذ لا يُعتدّ به" (النووي، شرح صحيح مسلم، ج 1، ص 108). النووي يعتبر هذا الحكم مجمعًا عليه بين الفقهاء، ويربطه بالحفاظ على وحدة الجماعة المسلمة، لا بحرية العقيدة أو حق الفرد في اختيار دينه.
أما ابن حجر العسقلاني، في شرحه لحديث البخاري، فقد أبدى ملاحظة مهمة حين أشار إلى أن النصّ لا يوضح بجلاء ما إذا كان المقصود هو مطلق التبديل الديني، أم أنه متعلق بتبديل يحمل دلالة على الخروج السياسي أو التحاق بمعسكر الأعداء. ومع ذلك، فإنه يرجّح الرأي الفقهي الذي يفهم الحديث على إطلاقه، أي أنّ أي تغيير في الدين يُعدّ موجبًا للقتل، وفق التأويل الفقهي السائد (ابن حجر، فتح الباري، ج 12، ص 270).
الإمام الشافعي، من جهته، أقرّ بحكم قتل المرتد، لكنه قنّنه بإجراءات واضحة، أبرزها اشتراط الاستتابة قبل تنفيذ الحكم. في كتابه الأم، يشترط أن يُمهَل المرتد ثلاثة أيام، فإن أصرّ على موقفه بعد البيان والنقاش، جاز قتله. هذا الاشتراط يفتح نافذة للاجتهاد في فهم الحكم وتطبيقه، ويعكس حرصًا على التريّث وليس التسرع في إصدار العقوبة القصوى (الشافعي، الأم، ج 6، ص 147). ورغم هذا التباين في التفاصيل، فإن الإطار العام الذي تبنّاه أغلب الفقهاء يربط الحديث بسلطة الدولة في ضبط المجال العقدي، دون اتفاق تام حول طبيعة "التبديل" وما إذا كان يعكس حرية داخلية أم خيانة سياسية.
رأي المعتزلة – مدرسة العقل والمسؤولية
في مقاربة فكرية عقلانية، اتخذت المعتزلة موقفًا رافضًا تمامًا لفكرة الإكراه الديني، مستندين في ذلك إلى نصوص قرآنية صريحة مثل قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} (البقرة: 256)، و{أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} (يونس: 99). وقد اعتبروا أن الإيمان لا يكون إيمانًا حقيقيًا إلا إذا كان نابعًا من قناعة داخلية حرة، لا نتيجة خوف أو ضغط سياسي أو اجتماعي. ولذا، رفضوا الحكم الفقهي الشائع الذي يربط بين الردة والعقوبة الجسدية، ما لم يكن المرتد في حالة حرب فعلية ضد الدولة الإسلامية.
فرّق المعتزلة بوضوح بين ما أسموه "الإيمان القلبي" الذي هو مناط النجاة في الآخرة، و"الإسلام السياسي" أو الظاهري الذي قد يُفرض في بعض السياقات التاريخية، لكن دون أن تكون له قيمة أخلاقية عند الله إن لم يكن نابعًا من اقتناع. وأكدوا أن حرية الإنسان في الإيمان جزء من عدل الله، وأنه لا يصح أن يُحاسب الإنسان في الدنيا أو الآخرة على اختيار لم يكن حرًّا. ووفقًا لهذا المنظور، يكون تبديل الدين فعلًا من أفعال الحرية الفردية لا يوجب العقاب، ما لم يقترن بسلوك عدائي.
وقد عبّر القاضي عبد الجبار، أحد أبرز مفكري المعتزلة، عن هذه الرؤية بوضوح في كتابه "المغني في أبواب التوحيد والعدل"، حيث قال إن الله "لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة"، وإن إقامة الحجة لا تكون إلا في سياق حرية كاملة في التفكير والاختيار. كما فرّق القاضي بين الردة الفردية – التي تعني التحول الفكري أو العقدي – وبين الردة السياسية – التي تتخذ شكل العداء أو التحريض ضد الدولة، وهي وحدها التي يمكن أن تُقابل بإجراءات قانونية دفاعية.
النتيجة الجوهرية لهذا الطرح المعتزلي أن السلطة السياسية – في رأيهم – لا يجوز أن تُخضع حرية المعتقد لمنطق العقوبة أو القسر، لأن ذلك يُناقض عدل الله نفسه، ويحوّل الدين من دعوة أخلاقية إلى أداة للبطش. وبذلك، يقدم المعتزلة نموذجًا مبكرًا لفصل المجال الديني الأخلاقي عن سلطة الدولة، ويدعون إلى أن يكون الإيمان فعلًا حُرًّا لا يُراقب ولا يُعاقب، ما لم يتحوّل إلى عدوان صريح.
تأويلات المفكرين المعاصرين
الإمام محمد عبده، أحد أبرز رواد التجديد في الفكر الإسلامي، تعامل مع الآية القرآنية "لا إكراه في الدين" (البقرة: 256) باعتبارها قاعدة قطعية تؤسس لحرية الاعتقاد وتمنع الإكراه بأي شكل. في تفسيره لها، أكد أن الدين لا يقوم إلا على الاقتناع العقلي والقلبي، وأن الإكراه ينفي جوهر الإيمان. كما رفض بشكل صريح تطبيق حد الردة في العصر الحديث، إلا في حالة اقترانه بـ"الخيانة السياسية" التي تهدد المجتمع، أي أن العقوبة دنيوية تكون على الفعل السياسي لا على تغيير المعتقد وحده. (انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده، الجزء الثاني، ص 150–153)
المفكر نصر حامد أبو زيد قرأ النص القرآني من منظور حداثي، واعتبر أن "لا إكراه في الدين" تعكس مشروعًا تحرريًا كاملاً يهدف إلى تحرير الإنسان من الوصاية الدينية والسياسية. بحسبه، الخطاب القرآني يؤسس لفردانية دينية قائمة على حرية الضمير لا على إكراه جماعي. كما انتقد أبو زيد التوظيف المعاصر لبعض الأحاديث النبوية—خاصة تلك التي تُستخدم لتبرير قتل المرتد—مؤكدًا أنها أحاديث ظرفية ارتبطت بسياقات سياسية وعسكرية معينة، ولا يجوز تعميمها اليوم لتبرير خطاب تكفيري معاصر. (انظر: نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ص 82–85)
حسن حنفي، في مشروعه المعروف بـ"اليسار الإسلامي"، ذهب إلى أبعد من مجرد الدعوة لحرية الاعتقاد، حيث دعا إلى "نزع القداسة عن الفقه السلطوي" الذي نشأ في ظل تحالف بين المؤسسة الفقهية والسلطة. يرى حنفي أن القتل على أساس الفكر أو الردة يتناقض كليًا مع روحية القرآن، وأن الآية "لا إكراه في الدين" تشكّل نفيًا قاطعًا لسلطة الجماعة في قمع المخالفين دينيًا. من هنا، فإن الفرد وحده يملك الحق في تقرير مصيره الديني دون تدخل أو قهر من الجماعة السياسية أو الدينية. (انظر: التراث والتجديد، حسن حنفي، ج 1، ص 211–214)
يجمع هؤلاء المفكرون الثلاثة—عبده، وأبو زيد، وحنفي—بين احترام النص القرآني وبين ضرورة تأويله في ضوء العقل والواقع. كل منهم، بطريقته، يُعيد فتح آفاق التأويل ليؤكد أن الحرية الدينية مبدأ لا يمكن التراجع عنه، وأن سلطة الجماعة أو الدولة لا يجب أن تتغوّل على ضمير الفرد. وهو موقف يقدّم الإسلام بوصفه دينًا أخلاقيًا لا قسريًا، ويتماشى مع القيم الحديثة في الحرية والكرامة.
هل الكفر مباح؟ وهل العقوبة دينية أم سياسية؟
يتبدى من خلال تحليل الخطاب الإسلامي الكلاسيكي والمعاصر، وجود توتر واضح بين ما يمكن تسميته بـ"الخطاب القرآني"، الذي يميل إلى الاعتراف بحرية الإيمان، ويؤسس لفضاء من الاختيار والضمير، وبين "الخطاب الفقهي" التقليدي الذي غالبًا ما يُقيّد هذه الحرية باسم الحفاظ على وحدة الجماعة الدينية. في حين تنص الآيات بوضوح على حرية الاعتقاد – كقوله: "لا إكراه في الدين" و*"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"*– نجد أن كثيرًا من الأحكام الفقهية اللاحقة ارتبطت بفكرة الردة كجريمة سياسية أكثر منها خيارًا دينيًا، مما عكس توجهًا سلطويًا وظّف الدين لضبط المجال العام.
تؤسس الآية موضع البحث لبنية خطابية واضحة تُعلي من شأن الاختيار الفردي، وتضع الإيمان في موضع الفعل الحر، الواعي، غير القابل للإكراه أو المصادرة. فالإيمان – من المنظور القرآني – لا قيمة له إن لم يكن نابعًا من قناعة حرة، وهذا ما يجعل العقيدة علاقة خاصة بين الإنسان وربّه، لا بين الإنسان والجماعة أو السلطة. وهذا المنطق القرآني يعارض تمامًا الرؤية التي ترى أن الإيمان لا يتحقق إلا تحت رقابة الجماعة، أو أن الكفر يجب أن يُقمع بالقوة.
يُلاحظ أن الحديث النبوي الذي ينص على "من بدل دينه فاقتلوه" لم يُفهم عبر العصور بشكل موحد، بل كان دومًا موضع تأويلات متباينة. فبينما استُخدم هذا الحديث في تراث السلطة كمبرر لفرض عقوبات قاسية على من يختار الخروج من الإسلام، فإن العديد من المفكرين المعاصرين – مثل نصر حامد أبو زيد ومحمد عبده – أعادوا قراءته في ضوء السياق التاريخي الذي قيل فيه، ورفضوا تعميمه كتشريع خالد. بذلك، فإن سلطة النص ليست مطلقة، بل تخضع للتأويل، والتأويل بدوره يتأثر بسياق القوة والمعرفة.
ختامًا، يمكن القول إن الكفر، من منظور قرآني خالص، ليس "مباحًا" أخلاقيًا أو روحيًا، لكنّه أيضًا ليس ممنوعًا بالقوة أو الزجر. فالله، وفقًا للقرآن، قد منح الإنسان حرية الإيمان أو الكفر، على أن يتحمل وحده تبعات اختياره في الآخرة. هذه الرؤية تُفكك منطق العقوبة الدنيوية المرتبطة بالمخالفات العقدية، وتؤسس لفكرة أن التعدد والاختلاف في الإيمان جزء من سنن الاجتماع البشري. لذا، فالمعاقبة على "الكفر" دينيًا في الدنيا تمثل انزياحًا عن الخطاب القرآني نحو خطاب فقهي سلطوي، تلبّس بالدين لكنه خدم منطق الهيمنة أكثر مما خدم الإيمان.
خاتمة الدراسة:
تكشف هذه الدراسة عن التوتر العميق بين الخطاب القرآني المؤسس لحرية الاعتقاد، والخطاب الفقهي الذي تطور في سياق السلطة السياسية، والذي يُكرّس الردة بوصفها جريمة موجبة للعقوبة الدنيوية. الآية القرآنية {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} لا تشرعن الكفر كقيمة، لكنها تعترف به كاحتمال إنساني مشروع ضمن نظام الاختبار الإلهي. وهي بهذا تضع حرية الإيمان في صلب العلاقة بين الإنسان وربّه، دون تدخل من الجماعة أو الدولة. في المقابل، تم توظيف الحديث النبوي «من بدّل دينه فاقتلوه» في لحظة تاريخية معينة، ثم جرى تعميمه لاحقًا على نحو يهدد جوهر الإيمان ذاته.
من خلال التحليل البنيوي والدلالي للنصّين، تبين أن الآية تحمل بنية خطابية تداولية قائمة على التخيير والتحذير الأخلاقي، لا القهر أو التنفيذ العقابي. أما الحديث، فينتمي إلى حقل الخطاب التنفيذي السلطوي، المرتبط بحماية الجماعة أكثر من رعاية الإيمان. المفارقة أن هذا الحديث اكتسب مع الزمن سلطة تشريعية أعلى من موقعه الزمني والظرفي، بفعل التأويل الفقهي السلطوي الذي سعى إلى حماية وحدة الجماعة عبر تقييد الحريات الفردية، متجاوزًا الخطاب الإلهي الأكثر تسامحًا وواقعية.
وقد أظهرت المراجعة التاريخية والفكرية أن أغلب الفقهاء تعاملوا مع الحديث بوصفه نصًا تطبيقيًا قطعيًا، رغم وجود تباينات في شروط التنفيذ، بينما تبنّت المعتزلة والمفكرون المعاصرون موقفًا يدافع عن حرية الاعتقاد بوصفها جزءًا من عدل الله. كما أكدت مواقف محمد عبده ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي أن القتل على الفكر لا يُمكن أن يتسق مع روح النص القرآني، وأن توظيف الحديث في سياقات سلطوية حديثة لا يُنتج إلا خطابًا تكفيريًا عنيفًا يُقوّض حرية الضمير.
توصيات الدراسة:
إعادة الاعتبار للقرآن بوصفه المرجعية العليا في قضايا الإيمان والحرية، وضرورة قراءة الأحاديث النبوية في سياقها التاريخي والسياسي لا بوصفها نصوصًا تشريعية مطلقة.
دعوة المؤسسات الدينية والفقهية لتحديث مناهجها التفسيرية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الكبرى، وعلى رأسها الحرية، والعدل، وكرامة الإنسان، بدل التمسك بأحكام تراثية نشأت في سياق سياسي مغلق.
تشجيع قراءة لسانية وتحليلية للنصوص الدينية، تعتمد منهج تحليل الخطاب والتداولية، بما يسمح بفهم أكثر دقة لدلالات النصوص ومقاصدها، بدل الاكتفاء بالقراءة الحرفية التقليدية.
رفض تجريم التحول الديني في العصر الحديث، والتأكيد على أن العقيدة شأن خاص لا يجوز أن تخضع للقانون العقابي، إلا إذا اقترنت بأفعال عدائية مادية تهدد السلم الأهلي أو الأمن العام، لا لمجرد التحول في القناعة الفردية.