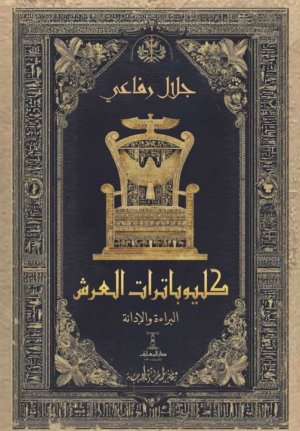كتب الدكتور عبد الراضي رضوان مقالاً بعنوان مسيخ الهوية والوعي الزائف، نشره في جريدة بوابة أخبار اليوم بتاريخ الثلاثاء 26 أغسطس 2025. قدّم الكاتب مقاله بوصفه دفاعاً عن "الهوية الدينية والفكرية" في مواجهة ما اعتبره تياراً من "أدعياء التنوير" الذين يسعون ـ من وجهة نظره ـ إلى تشويه الثوابت والعبث بالوعي الجمعي. منذ البداية يضع المقال نفسه في موقع الحارس الأمين على التراث والهوية، في مقابل "الآخر" الذي يتم تصويره باعتباره خطراً وجودياً يهدد البنية الثقافية والدينية للمجتمع.
وعند التمعّن في النص، يتضح أن المقال موجّه ـ وإن لم يصرّح بذلك مباشرة ـ ضد المفكر السوري فراس السواح، أحد أبرز الباحثين العرب في حقل تاريخ الأديان والأساطير. فالسواح قدّم على مدى عقود مشروعاً بحثياً متماسكاً حاول فيه إعادة قراءة النصوص الدينية والأسطورية في سياقها التاريخي والحضاري، مستفيداً من مناهج العلوم الإنسانية الحديثة. إلا أن المقال اختزل هذا المشروع العلمي في صورة "تهديد للهوية" و"زيف للوعي"، متجاهلاً البعد المعرفي والاجتهادي في أعمال السواح.
ويمكن القول إن المقال ينتمي إلى نمط من الخطاب الذي يعتمد على المواجهة الأخلاقية أكثر من اعتماده على المناقشة العلمية. فهو يلجأ إلى التوصيفات السلبية مثل "مسيخ الهوية" و"تاجر التنوير" بدلاً من الدخول في نقاش تفصيلي مع الأفكار والكتب التي طرحها السواح. وبهذا، فإن مركز الثقل في المقال لا يكمن في تفنيد أطروحات الخصم أو محاججته بالأدلة، بل في نزع الشرعية عنه من خلال التشكيك في سيرته ومساره الأكاديمي، وهو ما يحوّل النقاش من ميدان المعرفة إلى ميدان التشهير.
وبالاعتماد على منهج تحليل الخطاب يمكن تفكيك بنية هذا المقال وقراءة ما يحمله في طياته من تناقضات منهجية وادعاءات معرفية تفتقر إلى العلمية. فبدلاً من أن يكون المقال مساهمة في إثراء الحوار الفكري حول قضايا الهوية والدين والتنوير، نجده يتحول إلى نص يقوم على التحشيد الانفعالي والاتهام الأيديولوجي. وهكذا، يكشف المقال في جوهره عن أزمة أعمق تتعلق بكيفية إدارة الاختلاف الفكري في الفضاء العربي، وعن حضور ما يمكن وصفه بـ"الوعي الزائف" الذي يستبدل النقد العلمي بالوصاية الأخلاقية.
غلبة التوصيف الأخلاقي على البرهنة العلمية
يمكن ملاحظة أن الخطاب الذي تبناه الكاتب يقوم في جوهره على التوصيف الأخلاقي أكثر من اعتماده على البرهنة العلمية. فبدلاً من الدخول في نقاش معرفي جاد مع أفكار فراس السواح أو غيره من المفكرين، اختار الكاتب أن يتجه نحو إطلاق أوصاف قدحية تمس الشخص لا الفكرة. وهذه المقاربة تجعل النص أقرب إلى خطاب تعبوي انفعالي، بعيداً عن أدوات النقد المنهجي التي تستند عادة إلى تحليل المفاهيم ومساءلة البنى الفكرية.
إن استخدام تعبيرات مثل "مسيخ الهوية" أو "تاجر زائف التنوير" لا يندرج في إطار النقاش الأكاديمي الرصين، بل يعكس أسلوباً يستحضر لغة الشحن العاطفي. فهذه العبارات لا تقدم إضافة معرفية، بقدر ما تسعى إلى خلق صورة سلبية لدى المتلقي حول الخصم الفكري. بهذا المعنى، يتحول الحوار من مناقشة الأفكار إلى محاكمة النيات والذوات، وهو ما يفقد الخطاب قيمته التحليلية.
ومن خلال هذا الأسلوب، يبدو أن الكاتب ينطلق من هاجس هوياتي أكثر من انشغاله ببحث معرفي. إذ يتعامل مع مشروع السواح بوصفه تهديداً لهوية دينية أو ثقافية ينبغي الدفاع عنها، لا باعتباره مادة فكرية قابلة للدرس والمراجعة. ومن هنا يصبح الخطاب موجهاً نحو حماية الذات الجمعية من "الخطر" المزعوم، بدلاً من مساءلة النصوص والفرضيات بطريقة موضوعية.
إن مثل هذا النمط من الكتابة لا يسهم في إثراء النقاش الفكري، بل يعيد إنتاج مناخ الاستقطاب القائم على الثنائيات: "الأصيل" في مواجهة "الممسوخ"، و"المؤمن" في مواجهة "المزيف". وهكذا، تتحول المعركة إلى صراع هويات لا إلى حوار معرفي. والنتيجة أن المتلقي يُدفع إلى الاصطفاف عاطفياً مع أحد الأطراف، دون أن تتاح له فرصة التفاعل النقدي مع الأفكار ذاتها أو اختبار مدى وجاهتها العلمية.
التناقض بين رفض "الجدل الهامشي" والوقوع فيه
يقدّم الكاتب نفسه في بداية مقاله على أنه يرفض الدخول في أي "جدل هامشي" أو نقاشات جانبية لا تخدم جوهر الفكرة التي يسعى لطرحها. هذا الإعلان يمنح خطابه منذ البداية مظهراً من الجدية والترفع عن المهاترات، وكأنه يريد أن يميز نفسه عن غيره ممن ينشغلون بالخصومات الفكرية الشخصية.
لكن المدهش أن الكاتب، بعد هذا الإعلان، ينخرط مباشرة في تخصيص مساحة واسعة من مقاله للهجوم على مفكر بعينه، محولاً نصه إلى ما يشبه المحاكمة الفكرية لهذا الشخص. وهنا ينشأ تناقض واضح بين ما وعد به القارئ من ابتعاد عن المهاترات، وبين ما مارسه فعلياً من نقد شخصي مباشر خرج عن إطار النقاش الفكري المجرد.
هذا التناقض لا يعد مجرد زلة عابرة، بل هو ما يسميه محللو الخطاب بـ"الازدواجية التلفظية"، أي أن هناك فجوة بين ما يصرح به المتكلم (الموقف المعلن) وبين ما ينخرط فيه أثناء الممارسة (الموقف الفعلي). في هذه الحالة، يتبدل الخطاب من لغة المبدئية والتجرد إلى لغة الانفعال الشخصي والمهاترة، مما يضعف من قوة الحجة ويجعلها تبدو متناقضة داخلياً.
وعليه، فإن الخطاب يفقد اتساقه المنطقي عندما يرفع شعار "الابتعاد عن الجدل الجانبي"، ثم يقع في الجدل ذاته الذي حذر منه. هذا التناقض لا يضر فقط بمصداقية النص، بل يفتح الباب لتساؤلات حول جدية الكاتب وموضوعية خطابه، ويجعل القارئ أمام نص مزدوج الوجه: وجه يدّعي النقاء الفكري، ووجه يمارس ما نهى عنه.
تغييب أدوات التحليل المعرفي
أول ما يلفت النظر في الخطاب النقدي الموجَّه إلى فراس السواح هو أنه يتأسس على نفي أهليته العلمية قبل مناقشة أفكاره. فبدلاً من الدخول مباشرة في تفنيد أطروحاته، يضع الناقد معيار "التخصص الأكاديمي" كشرط مسبق للقبول أو الرفض. هذا الموقف يختزل البحث المعرفي في الشهادة والانتساب المؤسسي، ويتجاهل أن القيمة الأساسية لأي عمل فكري تكمن في الأدلة والحجج التي يقدمها، لا في هوية من يطرحها.
ثانياً، يعمد الناقد إلى مقارنة السواح بالعقاد لإبراز الفارق بينهما. غير أن هذه المقارنة، وإن بدت موضوعية على السطح، تُستعمل في الواقع لتجريد السواح من المشروعية الفكرية عبر إبراز شخصية أدبية كبرى وتقديمها كمقياس يقاس عليه الآخرون. وهنا يصبح معيار التقييم هو المقارنة بالشخصيات الرمزية لا اختبار المقولات في ذاتها، وهو ما يفتح الباب أمام خطاب يعتمد على الرمزية والسلطة الثقافية أكثر من اعتماده على التحليل النصي أو المنهجي.
ثالثاً، يتضح أن الرفض الموجه للسواح لا يقوم على نقاش الأدلة التي استند إليها في بحوثه، ولا على مساءلة المنهج المقارن الذي اعتمده في دراسة النصوص الدينية والأسطورية. بدلاً من ذلك، ينشغل الخطاب بترسيم حدود الشرعية: من المؤهل للحديث ومن غير المؤهل. هذا الانحراف عن جوهر النقاش يبعده عن الطابع العلمي، ويقربه أكثر إلى منطق إقصائي يستعيض عن الحوار النقدي بالتصنيف والهجوم الشخصي.
وأخيراً، فإن هذا المسار الخطابي ينقل النقاش من فضاء العلم القائم على البرهان إلى فضاء الوصاية القائم على سلطة "الأحقية بالكلام". وبذلك يتحول السؤال من "هل أطروحات السواح صحيحة أو خاطئة؟" إلى "هل يملك السواح الحق في الكلام أصلاً؟". هذا التحول لا يضيّق أفق البحث فحسب، بل يُفرغ الحوار من مضمونه المعرفي، إذ يجعل معيار قبول الفكرة خاضعاً لمصدرها لا لمحتواها.
التعميم الاستشراقي العكسي
يصف الناقد طرح السواح بأنه مجرّد إعادة إنتاج لما يسميه بـ"الاستشراق القديم"، لكن هذا الاتهام يبقى فضفاضاً وعاماً، إذ لا يقدّم للقارئ توضيحاً دقيقاً حول أي جوانب من الاستشراق يقصدها ولا كيف انعكست في كتابات السواح. مثل هذا التوصيف يختصر مشروعاً بحثياً معقداً في عبارة جاهزة، دون الدخول في تفكيك أدواته ومناهجه، وهو ما يجعل النقد أقرب إلى الانطباع منه إلى التحليل.
المفارقة هنا أن مشروع السواح الفكري انطلق منذ بداياته من موقف نقدي واضح تجاه الاستشراق الكلاسيكي. فقد عمل على تفكيك ثنائية "الغرب العارف/الشرق المبحوث عنه"، وبيّن محدودية كثير من أطروحات المستشرقين في فهم الظواهر الدينية والتاريخية ضمن سياقاتها الداخلية. بل إن أحد أهم إنجازاته هو محاولته التحرر من القوالب الاستشراقية الجامدة التي حصرت المجتمعات الشرقية في صور نمطية لا تاريخية.
بدلاً من إعادة إنتاج الطرح الاستشراقي، اعتمد السواح على مناهج حديثة في الأنثروبولوجيا والتاريخ المقارن، فوسّع من دائرة أدواته البحثية لتشمل الدراسات البنيوية والأنثروبولوجيا الدينية، وأدخل مقاربات جديدة لفهم النصوص والأساطير بعيداً عن القراءة الاختزالية. هذا الانفتاح المنهجي هو ما سمح له بالابتعاد عن إرث الاستشراق التقليدي، بل وبناء خطاب نقدي يفتح المجال أمام قراءات أكثر علمية وتعددية.
من هنا يبدو التوصيف الذي يضع السواح في خانة "الاستشراق" أشبه برد فعل دفاعي أو استخدام لملصق جاهز يوجَّه ضد كل باحث يخرج عن القراءة التقليدية المألوفة. فبدلاً من مواجهة أطروحاته بالحجج والتفصيل، يُكتفى بوسمها بأنها استشراقية، وكأن هذا كافٍ لإسقاطها. لكن في الواقع، مثل هذا الطرح لا يضعف السواح بقدر ما يكشف عن محدودية أدوات الناقد نفسه وعجزه عن تقديم قراءة تفكيكية متوازنة.
الالتباس في التعامل مع "القضاء" واللغة
أولاً، يثير الكاتب مسألة مركزية تتعلق بطريقة تعامل السواح مع دلالة كلمة "قضى" في القرآن الكريم. فالسواح – من وجهة نظره – قام بالاقتطاع من السياق القرآني والاكتفاء بمواضع محددة تدعم أطروحته، من غير النظر إلى الحقل الدلالي الأوسع للكلمة. هذا النقد يبدو للوهلة الأولى موضوعياً، لأنه يستند إلى مبدأ معروف في الدراسات النصية، وهو ضرورة قراءة المصطلح في ضوء استعمالاته المتعددة داخل النص القرآني.
ثانياً، غير أن الكاتب، وهو يوجّه نقده، يقع في المأزق ذاته. فبدلاً من أن يقدّم معالجة شاملة لحضور لفظ "قضى" في مجمل السياقات القرآنية، نجده هو الآخر ينتقي أمثلة بعينها ليدعم بها موقفه. هنا يصبح إشكاله مع السواح ليس في المبدأ نفسه، بل في تطبيقه الجزئي الذي أعاد إنتاج ما كان يرفضه.
ثالثاً، هذا الأسلوب يعكس خللاً منهجياً أعمق يتمثل في غياب الاعتماد على المقاربة اللسانية الحديثة، التي تنظر إلى الألفاظ بوصفها وحدات ضمن شبكة دلالية متكاملة، وليست مجرد أمثلة معزولة. فالمنهج اللساني يقضي بضرورة تتبع الاستعمالات كافة، ثم رصد التحولات السياقية التي تصنع المعنى، وهو ما لم يلتزم به الكاتب في قراءته.
رابعاً، نتيجة ذلك ظهرت المفارقة بوضوح: خطاب الكاتب جاء محمولاً على نقد "الاجتزاء"، لكنه في الوقت نفسه لم يستطع أن يقدّم نموذجاً مختلفاً أو بديلاً أكثر علمية. لقد انحصر هو الآخر في انتقائية مضادة، مما يجعل موقفه عرضة للاعتراض ذاته الذي وجّهه إلى السواح، ويكشف عن تناقض بين الادعاء النظري والممارسة التطبيقية.
خطاب الهوية في مواجهة خطاب الدولة الحديثة
ينطلق خطاب "الدفاع عن الهوية" عادة من فرضية أن أي قراءة جديدة للتراث أو أي محاولة لتجديد الفكر الديني تمثل تهديداً وجودياً، وكأن الهوية كيان هش يمكن أن يتلاشى أمام أي اجتهاد مختلف. هذا الخطاب يختزل الهوية في قوالب جامدة، ويجعلها أشبه بسجن فكري يمنع المجتمع من التفاعل مع التحولات المعرفية والإنسانية التي تفرضها الدولة الحديثة.
غير أن الدولة الحديثة، في بنيتها النظرية والتطبيقية، لا تقوم على إقصاء التنوع أو فرض رؤية واحدة، بل على إدارة هذا التنوع في إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التعددية. فجوهر مشروعها يقوم على تحويل الخلاف الفكري والديني إلى حالة من التعايش المنظم، حيث يتم احترام الاختلافات وإدارتها عبر الحوار والمرجعية القانونية، لا عبر النفي والتكفير.
إن تصوير أي اجتهاد أو نقد للتراث الديني باعتباره "مسخاً للهوية" لا يعكس حقيقة الخوف على القيم، بقدر ما يعكس رغبة في احتكار السلطة الرمزية والفكرية. هنا نستطيع الاستعانة بما طرحه بيير بورديو حول "الوعي الزائف"، أي الوعي الذي يوظّف الشعارات المقدسة لا لصالح المعرفة أو الإصلاح، بل لتثبيت مواقع النفوذ وإعادة إنتاج نفس البنى السلطوية التي تُعيق التطور.
وبذلك يصبح خطاب الهوية، حين يبالغ في التحصين ضد أي تجديد، أداة لإدامة الجمود الفكري والاجتماعي، بدل أن يكون قوة تحفيز لإحياء القيم في سياق جديد. إن الهوية الحقيقية لا تُصان بالانغلاق والخوف من التعدد، وإنما بقدرتها على التفاعل الخلاق مع معطيات العصر، والانفتاح على الأسئلة الجديدة دون فقدان جذورها التاريخية والثقافية.
التهجم الشخصي بدلاً من الحوار العلمي
إنّ اللجوء إلى المقارنة بين كاتب معاصر مثل فراس السواح وأعلام كبار كطه حسين أو العقاد ليس غرضه في كثير من الأحيان البحث عن قيمة فكرية أو قياس موضوعي، بل يتحوّل إلى وسيلة للتقليل من شأن السواح عبر إبرازه كقزم أمام عمالقة. هذه الاستراتيجية لا تخدم النقاش العلمي، بل تعمل على إقصاء الآخر بطريقة رمزية، وكأنها تقول للقارئ: "لا داعي لأن تأخذ هذا المفكر على محمل الجد، فهو لا يرقى إلى مستوى الكبار." وبذلك يتم استبعاد فكره قبل حتى الدخول في تفاصيله.
إنّ ما يحدث هنا هو عملية إسقاط شرعية فكرية بوسائل غير معرفية. فبدلاً من مساءلة أطروحاته أو تحليل منهجه في قراءة الميثولوجيا والدين، يتم اللجوء إلى أدوات الخطاب الإقصائي التي تركز على المقارنة الرمزية أو التلميح إلى ضعف الخلفية الأكاديمية. وكأن القيمة الفكرية تُختزل في الشهادات أو الألقاب، لا في الحِجَاج العقلي وقدرة النصوص على الصمود أمام النقد.
لكن النقد الحقيقي لا يمكن أن يقوم على مثل هذه الآليات، لأن جوهر النقد العلمي هو الدخول في صلب النصوص، واختبار فرضياتها، ومساءلة بنيتها المنهجية. فإذا أراد ناقد ما أن يبيّن هشاشة مشروع السواح، فالمجال مفتوح أمامه لمناقشة أعماله الأساسية، مثل مغامرة العقل الأولى أو الوجه الآخر للمسيح. هذان الكتابان يقدمان مادّة غنية للتحليل والنقاش، سواء من حيث منهجية قراءة الأساطير أو من حيث إعادة تأويل التراث الديني.
إنّ تجاوز النصوص والذهاب مباشرة إلى النيل من السيرة الذاتية أو المؤهلات الأكاديمية ليس سوى تفريغ للنقاش من محتواه المعرفي. وبهذا يتحوّل النقد من فعل فكري إلى نوع من الصراع الرمزي، هدفه تثبيت سلطة ثقافية معينة وإقصاء الأصوات المخالفة. والنتيجة أن القارئ يُحرم من جدل فكري حقيقي كان يمكن أن يفتح أفقاً أوسع للفهم، ويُستبدل ذلك بمعارك وهمية تقوم على المقارنات الجاهزة والتجريح الشخصي.
خاتمة
أولاً، يتضح أن ما يسميه الكاتب بـ"معركة الوعي" ليس في جوهره معركة من أجل المعرفة أو البحث الحر عن الحقيقة، بل هو محاولة لفرض تعريف محدد ومغلق للهوية. فبدلاً من الانفتاح على تعددية التجارب الفكرية والإنسانية، يسعى هذا الطرح إلى احتكار الحق في تحديد من يملك تمثيل الهوية ومن يحق له الحديث باسمها. وهذه المقاربة لا تفتح أفقاً للتجديد، وإنما تضيّق مجال التفكير النقدي وتحوّله إلى ساحة استقطاب.
ثانياً، مثل هذا الخطاب لا يسهم في بناء دولة حديثة قادرة على إدارة الاختلاف وتعدد الآراء، بل يرسّخ الانقسام الثقافي ويعمّق الشكوك حول إمكانية قيام فضاء حوار عقلاني. فالدولة الحديثة قائمة على الاعتراف بالاختلاف وعلى التنافس في المجال العمومي وفق قواعد عقلية، أما الخطاب القائم على مصادرة الهوية فإنه يحوّل كل اختلاف إلى تهديد، وكل نقاش إلى معركة وجودية.
ثالثاً، المفارقة أن "الوعي الزائف" الذي يدينه الكاتب بوصفه خطراً على المجتمع، هو في الحقيقة السمة البارزة لخطابه ذاته. ذلك أنه يستبدل النقد العلمي والتحليل الرصين بالتحشيد الأيديولوجي وتوزيع الاتهامات. وهنا يصبح الخطاب نفسه مثالاً على ما يحذر منه، إذ يغلق باب الاجتهاد المعرفي أمام أي قراءة جديدة أو مراجعة جادة، ويحوّل مهمة المثقف من الكشف والبحث إلى التعبئة والدفاع عن يقينيات مسبقة.
وأخيراً، لا يخلو المقال من رسالة ضمنية حين ختمه صاحبه بالإشارة إلى صفته الأكاديمية: "عميد كلية دار العلوم سابقاً". فالتذييل بهذه الصفة يهدف إلى إضفاء شرعية معرفية على خطاب يغلب عليه الطابع الدعوي والأيديولوجي. غير أن هذا التوقيع يكشف أيضاً عن التوتر القائم بين المؤسسة الأكاديمية التي يُفترض أنها مجال للنقد الحر والإبداع الفكري، وبين توظيفها كأداة لإكساب الخطاب التقليدي سلطة رمزية. ومن هنا تأتي خطورة المقال، إذ يقدّم خطاباً مغلقاً تحت عباءة المرجعية العلمية، في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون دور الجامعة هو فتح آفاق جديدة للتفكير لا إغلاقها.
وعند التمعّن في النص، يتضح أن المقال موجّه ـ وإن لم يصرّح بذلك مباشرة ـ ضد المفكر السوري فراس السواح، أحد أبرز الباحثين العرب في حقل تاريخ الأديان والأساطير. فالسواح قدّم على مدى عقود مشروعاً بحثياً متماسكاً حاول فيه إعادة قراءة النصوص الدينية والأسطورية في سياقها التاريخي والحضاري، مستفيداً من مناهج العلوم الإنسانية الحديثة. إلا أن المقال اختزل هذا المشروع العلمي في صورة "تهديد للهوية" و"زيف للوعي"، متجاهلاً البعد المعرفي والاجتهادي في أعمال السواح.
ويمكن القول إن المقال ينتمي إلى نمط من الخطاب الذي يعتمد على المواجهة الأخلاقية أكثر من اعتماده على المناقشة العلمية. فهو يلجأ إلى التوصيفات السلبية مثل "مسيخ الهوية" و"تاجر التنوير" بدلاً من الدخول في نقاش تفصيلي مع الأفكار والكتب التي طرحها السواح. وبهذا، فإن مركز الثقل في المقال لا يكمن في تفنيد أطروحات الخصم أو محاججته بالأدلة، بل في نزع الشرعية عنه من خلال التشكيك في سيرته ومساره الأكاديمي، وهو ما يحوّل النقاش من ميدان المعرفة إلى ميدان التشهير.
وبالاعتماد على منهج تحليل الخطاب يمكن تفكيك بنية هذا المقال وقراءة ما يحمله في طياته من تناقضات منهجية وادعاءات معرفية تفتقر إلى العلمية. فبدلاً من أن يكون المقال مساهمة في إثراء الحوار الفكري حول قضايا الهوية والدين والتنوير، نجده يتحول إلى نص يقوم على التحشيد الانفعالي والاتهام الأيديولوجي. وهكذا، يكشف المقال في جوهره عن أزمة أعمق تتعلق بكيفية إدارة الاختلاف الفكري في الفضاء العربي، وعن حضور ما يمكن وصفه بـ"الوعي الزائف" الذي يستبدل النقد العلمي بالوصاية الأخلاقية.
غلبة التوصيف الأخلاقي على البرهنة العلمية
يمكن ملاحظة أن الخطاب الذي تبناه الكاتب يقوم في جوهره على التوصيف الأخلاقي أكثر من اعتماده على البرهنة العلمية. فبدلاً من الدخول في نقاش معرفي جاد مع أفكار فراس السواح أو غيره من المفكرين، اختار الكاتب أن يتجه نحو إطلاق أوصاف قدحية تمس الشخص لا الفكرة. وهذه المقاربة تجعل النص أقرب إلى خطاب تعبوي انفعالي، بعيداً عن أدوات النقد المنهجي التي تستند عادة إلى تحليل المفاهيم ومساءلة البنى الفكرية.
إن استخدام تعبيرات مثل "مسيخ الهوية" أو "تاجر زائف التنوير" لا يندرج في إطار النقاش الأكاديمي الرصين، بل يعكس أسلوباً يستحضر لغة الشحن العاطفي. فهذه العبارات لا تقدم إضافة معرفية، بقدر ما تسعى إلى خلق صورة سلبية لدى المتلقي حول الخصم الفكري. بهذا المعنى، يتحول الحوار من مناقشة الأفكار إلى محاكمة النيات والذوات، وهو ما يفقد الخطاب قيمته التحليلية.
ومن خلال هذا الأسلوب، يبدو أن الكاتب ينطلق من هاجس هوياتي أكثر من انشغاله ببحث معرفي. إذ يتعامل مع مشروع السواح بوصفه تهديداً لهوية دينية أو ثقافية ينبغي الدفاع عنها، لا باعتباره مادة فكرية قابلة للدرس والمراجعة. ومن هنا يصبح الخطاب موجهاً نحو حماية الذات الجمعية من "الخطر" المزعوم، بدلاً من مساءلة النصوص والفرضيات بطريقة موضوعية.
إن مثل هذا النمط من الكتابة لا يسهم في إثراء النقاش الفكري، بل يعيد إنتاج مناخ الاستقطاب القائم على الثنائيات: "الأصيل" في مواجهة "الممسوخ"، و"المؤمن" في مواجهة "المزيف". وهكذا، تتحول المعركة إلى صراع هويات لا إلى حوار معرفي. والنتيجة أن المتلقي يُدفع إلى الاصطفاف عاطفياً مع أحد الأطراف، دون أن تتاح له فرصة التفاعل النقدي مع الأفكار ذاتها أو اختبار مدى وجاهتها العلمية.
التناقض بين رفض "الجدل الهامشي" والوقوع فيه
يقدّم الكاتب نفسه في بداية مقاله على أنه يرفض الدخول في أي "جدل هامشي" أو نقاشات جانبية لا تخدم جوهر الفكرة التي يسعى لطرحها. هذا الإعلان يمنح خطابه منذ البداية مظهراً من الجدية والترفع عن المهاترات، وكأنه يريد أن يميز نفسه عن غيره ممن ينشغلون بالخصومات الفكرية الشخصية.
لكن المدهش أن الكاتب، بعد هذا الإعلان، ينخرط مباشرة في تخصيص مساحة واسعة من مقاله للهجوم على مفكر بعينه، محولاً نصه إلى ما يشبه المحاكمة الفكرية لهذا الشخص. وهنا ينشأ تناقض واضح بين ما وعد به القارئ من ابتعاد عن المهاترات، وبين ما مارسه فعلياً من نقد شخصي مباشر خرج عن إطار النقاش الفكري المجرد.
هذا التناقض لا يعد مجرد زلة عابرة، بل هو ما يسميه محللو الخطاب بـ"الازدواجية التلفظية"، أي أن هناك فجوة بين ما يصرح به المتكلم (الموقف المعلن) وبين ما ينخرط فيه أثناء الممارسة (الموقف الفعلي). في هذه الحالة، يتبدل الخطاب من لغة المبدئية والتجرد إلى لغة الانفعال الشخصي والمهاترة، مما يضعف من قوة الحجة ويجعلها تبدو متناقضة داخلياً.
وعليه، فإن الخطاب يفقد اتساقه المنطقي عندما يرفع شعار "الابتعاد عن الجدل الجانبي"، ثم يقع في الجدل ذاته الذي حذر منه. هذا التناقض لا يضر فقط بمصداقية النص، بل يفتح الباب لتساؤلات حول جدية الكاتب وموضوعية خطابه، ويجعل القارئ أمام نص مزدوج الوجه: وجه يدّعي النقاء الفكري، ووجه يمارس ما نهى عنه.
تغييب أدوات التحليل المعرفي
أول ما يلفت النظر في الخطاب النقدي الموجَّه إلى فراس السواح هو أنه يتأسس على نفي أهليته العلمية قبل مناقشة أفكاره. فبدلاً من الدخول مباشرة في تفنيد أطروحاته، يضع الناقد معيار "التخصص الأكاديمي" كشرط مسبق للقبول أو الرفض. هذا الموقف يختزل البحث المعرفي في الشهادة والانتساب المؤسسي، ويتجاهل أن القيمة الأساسية لأي عمل فكري تكمن في الأدلة والحجج التي يقدمها، لا في هوية من يطرحها.
ثانياً، يعمد الناقد إلى مقارنة السواح بالعقاد لإبراز الفارق بينهما. غير أن هذه المقارنة، وإن بدت موضوعية على السطح، تُستعمل في الواقع لتجريد السواح من المشروعية الفكرية عبر إبراز شخصية أدبية كبرى وتقديمها كمقياس يقاس عليه الآخرون. وهنا يصبح معيار التقييم هو المقارنة بالشخصيات الرمزية لا اختبار المقولات في ذاتها، وهو ما يفتح الباب أمام خطاب يعتمد على الرمزية والسلطة الثقافية أكثر من اعتماده على التحليل النصي أو المنهجي.
ثالثاً، يتضح أن الرفض الموجه للسواح لا يقوم على نقاش الأدلة التي استند إليها في بحوثه، ولا على مساءلة المنهج المقارن الذي اعتمده في دراسة النصوص الدينية والأسطورية. بدلاً من ذلك، ينشغل الخطاب بترسيم حدود الشرعية: من المؤهل للحديث ومن غير المؤهل. هذا الانحراف عن جوهر النقاش يبعده عن الطابع العلمي، ويقربه أكثر إلى منطق إقصائي يستعيض عن الحوار النقدي بالتصنيف والهجوم الشخصي.
وأخيراً، فإن هذا المسار الخطابي ينقل النقاش من فضاء العلم القائم على البرهان إلى فضاء الوصاية القائم على سلطة "الأحقية بالكلام". وبذلك يتحول السؤال من "هل أطروحات السواح صحيحة أو خاطئة؟" إلى "هل يملك السواح الحق في الكلام أصلاً؟". هذا التحول لا يضيّق أفق البحث فحسب، بل يُفرغ الحوار من مضمونه المعرفي، إذ يجعل معيار قبول الفكرة خاضعاً لمصدرها لا لمحتواها.
التعميم الاستشراقي العكسي
يصف الناقد طرح السواح بأنه مجرّد إعادة إنتاج لما يسميه بـ"الاستشراق القديم"، لكن هذا الاتهام يبقى فضفاضاً وعاماً، إذ لا يقدّم للقارئ توضيحاً دقيقاً حول أي جوانب من الاستشراق يقصدها ولا كيف انعكست في كتابات السواح. مثل هذا التوصيف يختصر مشروعاً بحثياً معقداً في عبارة جاهزة، دون الدخول في تفكيك أدواته ومناهجه، وهو ما يجعل النقد أقرب إلى الانطباع منه إلى التحليل.
المفارقة هنا أن مشروع السواح الفكري انطلق منذ بداياته من موقف نقدي واضح تجاه الاستشراق الكلاسيكي. فقد عمل على تفكيك ثنائية "الغرب العارف/الشرق المبحوث عنه"، وبيّن محدودية كثير من أطروحات المستشرقين في فهم الظواهر الدينية والتاريخية ضمن سياقاتها الداخلية. بل إن أحد أهم إنجازاته هو محاولته التحرر من القوالب الاستشراقية الجامدة التي حصرت المجتمعات الشرقية في صور نمطية لا تاريخية.
بدلاً من إعادة إنتاج الطرح الاستشراقي، اعتمد السواح على مناهج حديثة في الأنثروبولوجيا والتاريخ المقارن، فوسّع من دائرة أدواته البحثية لتشمل الدراسات البنيوية والأنثروبولوجيا الدينية، وأدخل مقاربات جديدة لفهم النصوص والأساطير بعيداً عن القراءة الاختزالية. هذا الانفتاح المنهجي هو ما سمح له بالابتعاد عن إرث الاستشراق التقليدي، بل وبناء خطاب نقدي يفتح المجال أمام قراءات أكثر علمية وتعددية.
من هنا يبدو التوصيف الذي يضع السواح في خانة "الاستشراق" أشبه برد فعل دفاعي أو استخدام لملصق جاهز يوجَّه ضد كل باحث يخرج عن القراءة التقليدية المألوفة. فبدلاً من مواجهة أطروحاته بالحجج والتفصيل، يُكتفى بوسمها بأنها استشراقية، وكأن هذا كافٍ لإسقاطها. لكن في الواقع، مثل هذا الطرح لا يضعف السواح بقدر ما يكشف عن محدودية أدوات الناقد نفسه وعجزه عن تقديم قراءة تفكيكية متوازنة.
الالتباس في التعامل مع "القضاء" واللغة
أولاً، يثير الكاتب مسألة مركزية تتعلق بطريقة تعامل السواح مع دلالة كلمة "قضى" في القرآن الكريم. فالسواح – من وجهة نظره – قام بالاقتطاع من السياق القرآني والاكتفاء بمواضع محددة تدعم أطروحته، من غير النظر إلى الحقل الدلالي الأوسع للكلمة. هذا النقد يبدو للوهلة الأولى موضوعياً، لأنه يستند إلى مبدأ معروف في الدراسات النصية، وهو ضرورة قراءة المصطلح في ضوء استعمالاته المتعددة داخل النص القرآني.
ثانياً، غير أن الكاتب، وهو يوجّه نقده، يقع في المأزق ذاته. فبدلاً من أن يقدّم معالجة شاملة لحضور لفظ "قضى" في مجمل السياقات القرآنية، نجده هو الآخر ينتقي أمثلة بعينها ليدعم بها موقفه. هنا يصبح إشكاله مع السواح ليس في المبدأ نفسه، بل في تطبيقه الجزئي الذي أعاد إنتاج ما كان يرفضه.
ثالثاً، هذا الأسلوب يعكس خللاً منهجياً أعمق يتمثل في غياب الاعتماد على المقاربة اللسانية الحديثة، التي تنظر إلى الألفاظ بوصفها وحدات ضمن شبكة دلالية متكاملة، وليست مجرد أمثلة معزولة. فالمنهج اللساني يقضي بضرورة تتبع الاستعمالات كافة، ثم رصد التحولات السياقية التي تصنع المعنى، وهو ما لم يلتزم به الكاتب في قراءته.
رابعاً، نتيجة ذلك ظهرت المفارقة بوضوح: خطاب الكاتب جاء محمولاً على نقد "الاجتزاء"، لكنه في الوقت نفسه لم يستطع أن يقدّم نموذجاً مختلفاً أو بديلاً أكثر علمية. لقد انحصر هو الآخر في انتقائية مضادة، مما يجعل موقفه عرضة للاعتراض ذاته الذي وجّهه إلى السواح، ويكشف عن تناقض بين الادعاء النظري والممارسة التطبيقية.
خطاب الهوية في مواجهة خطاب الدولة الحديثة
ينطلق خطاب "الدفاع عن الهوية" عادة من فرضية أن أي قراءة جديدة للتراث أو أي محاولة لتجديد الفكر الديني تمثل تهديداً وجودياً، وكأن الهوية كيان هش يمكن أن يتلاشى أمام أي اجتهاد مختلف. هذا الخطاب يختزل الهوية في قوالب جامدة، ويجعلها أشبه بسجن فكري يمنع المجتمع من التفاعل مع التحولات المعرفية والإنسانية التي تفرضها الدولة الحديثة.
غير أن الدولة الحديثة، في بنيتها النظرية والتطبيقية، لا تقوم على إقصاء التنوع أو فرض رؤية واحدة، بل على إدارة هذا التنوع في إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التعددية. فجوهر مشروعها يقوم على تحويل الخلاف الفكري والديني إلى حالة من التعايش المنظم، حيث يتم احترام الاختلافات وإدارتها عبر الحوار والمرجعية القانونية، لا عبر النفي والتكفير.
إن تصوير أي اجتهاد أو نقد للتراث الديني باعتباره "مسخاً للهوية" لا يعكس حقيقة الخوف على القيم، بقدر ما يعكس رغبة في احتكار السلطة الرمزية والفكرية. هنا نستطيع الاستعانة بما طرحه بيير بورديو حول "الوعي الزائف"، أي الوعي الذي يوظّف الشعارات المقدسة لا لصالح المعرفة أو الإصلاح، بل لتثبيت مواقع النفوذ وإعادة إنتاج نفس البنى السلطوية التي تُعيق التطور.
وبذلك يصبح خطاب الهوية، حين يبالغ في التحصين ضد أي تجديد، أداة لإدامة الجمود الفكري والاجتماعي، بدل أن يكون قوة تحفيز لإحياء القيم في سياق جديد. إن الهوية الحقيقية لا تُصان بالانغلاق والخوف من التعدد، وإنما بقدرتها على التفاعل الخلاق مع معطيات العصر، والانفتاح على الأسئلة الجديدة دون فقدان جذورها التاريخية والثقافية.
التهجم الشخصي بدلاً من الحوار العلمي
إنّ اللجوء إلى المقارنة بين كاتب معاصر مثل فراس السواح وأعلام كبار كطه حسين أو العقاد ليس غرضه في كثير من الأحيان البحث عن قيمة فكرية أو قياس موضوعي، بل يتحوّل إلى وسيلة للتقليل من شأن السواح عبر إبرازه كقزم أمام عمالقة. هذه الاستراتيجية لا تخدم النقاش العلمي، بل تعمل على إقصاء الآخر بطريقة رمزية، وكأنها تقول للقارئ: "لا داعي لأن تأخذ هذا المفكر على محمل الجد، فهو لا يرقى إلى مستوى الكبار." وبذلك يتم استبعاد فكره قبل حتى الدخول في تفاصيله.
إنّ ما يحدث هنا هو عملية إسقاط شرعية فكرية بوسائل غير معرفية. فبدلاً من مساءلة أطروحاته أو تحليل منهجه في قراءة الميثولوجيا والدين، يتم اللجوء إلى أدوات الخطاب الإقصائي التي تركز على المقارنة الرمزية أو التلميح إلى ضعف الخلفية الأكاديمية. وكأن القيمة الفكرية تُختزل في الشهادات أو الألقاب، لا في الحِجَاج العقلي وقدرة النصوص على الصمود أمام النقد.
لكن النقد الحقيقي لا يمكن أن يقوم على مثل هذه الآليات، لأن جوهر النقد العلمي هو الدخول في صلب النصوص، واختبار فرضياتها، ومساءلة بنيتها المنهجية. فإذا أراد ناقد ما أن يبيّن هشاشة مشروع السواح، فالمجال مفتوح أمامه لمناقشة أعماله الأساسية، مثل مغامرة العقل الأولى أو الوجه الآخر للمسيح. هذان الكتابان يقدمان مادّة غنية للتحليل والنقاش، سواء من حيث منهجية قراءة الأساطير أو من حيث إعادة تأويل التراث الديني.
إنّ تجاوز النصوص والذهاب مباشرة إلى النيل من السيرة الذاتية أو المؤهلات الأكاديمية ليس سوى تفريغ للنقاش من محتواه المعرفي. وبهذا يتحوّل النقد من فعل فكري إلى نوع من الصراع الرمزي، هدفه تثبيت سلطة ثقافية معينة وإقصاء الأصوات المخالفة. والنتيجة أن القارئ يُحرم من جدل فكري حقيقي كان يمكن أن يفتح أفقاً أوسع للفهم، ويُستبدل ذلك بمعارك وهمية تقوم على المقارنات الجاهزة والتجريح الشخصي.
خاتمة
أولاً، يتضح أن ما يسميه الكاتب بـ"معركة الوعي" ليس في جوهره معركة من أجل المعرفة أو البحث الحر عن الحقيقة، بل هو محاولة لفرض تعريف محدد ومغلق للهوية. فبدلاً من الانفتاح على تعددية التجارب الفكرية والإنسانية، يسعى هذا الطرح إلى احتكار الحق في تحديد من يملك تمثيل الهوية ومن يحق له الحديث باسمها. وهذه المقاربة لا تفتح أفقاً للتجديد، وإنما تضيّق مجال التفكير النقدي وتحوّله إلى ساحة استقطاب.
ثانياً، مثل هذا الخطاب لا يسهم في بناء دولة حديثة قادرة على إدارة الاختلاف وتعدد الآراء، بل يرسّخ الانقسام الثقافي ويعمّق الشكوك حول إمكانية قيام فضاء حوار عقلاني. فالدولة الحديثة قائمة على الاعتراف بالاختلاف وعلى التنافس في المجال العمومي وفق قواعد عقلية، أما الخطاب القائم على مصادرة الهوية فإنه يحوّل كل اختلاف إلى تهديد، وكل نقاش إلى معركة وجودية.
ثالثاً، المفارقة أن "الوعي الزائف" الذي يدينه الكاتب بوصفه خطراً على المجتمع، هو في الحقيقة السمة البارزة لخطابه ذاته. ذلك أنه يستبدل النقد العلمي والتحليل الرصين بالتحشيد الأيديولوجي وتوزيع الاتهامات. وهنا يصبح الخطاب نفسه مثالاً على ما يحذر منه، إذ يغلق باب الاجتهاد المعرفي أمام أي قراءة جديدة أو مراجعة جادة، ويحوّل مهمة المثقف من الكشف والبحث إلى التعبئة والدفاع عن يقينيات مسبقة.
وأخيراً، لا يخلو المقال من رسالة ضمنية حين ختمه صاحبه بالإشارة إلى صفته الأكاديمية: "عميد كلية دار العلوم سابقاً". فالتذييل بهذه الصفة يهدف إلى إضفاء شرعية معرفية على خطاب يغلب عليه الطابع الدعوي والأيديولوجي. غير أن هذا التوقيع يكشف أيضاً عن التوتر القائم بين المؤسسة الأكاديمية التي يُفترض أنها مجال للنقد الحر والإبداع الفكري، وبين توظيفها كأداة لإكساب الخطاب التقليدي سلطة رمزية. ومن هنا تأتي خطورة المقال، إذ يقدّم خطاباً مغلقاً تحت عباءة المرجعية العلمية، في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون دور الجامعة هو فتح آفاق جديدة للتفكير لا إغلاقها.