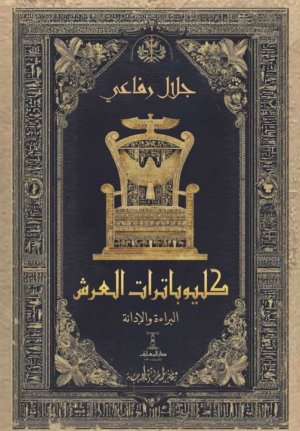يشكّل حضور الأعراب في الخطاب القرآني لحظةً دلالية كثيفة يتقاطع فيها الاجتماعي بالسياسي، والأنثروبولوجي بالروحي. فالمسألة لا تتعلق بمجرد توصيفٍ جغرافي لفئةٍ تسكن البادية، بل بموقفٍ قرآنيٍّ من بنيةٍ ثقافية تقف على هامش مشروع التمدن الديني والسياسي الذي دشّنه الوحي في المدينة المنوّرة. إنّ الآيات التي تناولت الأعراب تكشف عن صراعٍ رمزي بين منطق الوحي الذي يسعى إلى تأسيس مجتمعٍ مؤمنٍ منضبط بالقيم والقانون، ومنطق القبيلة الذي يقوم على العصبية والغزو والانتماء الدموي. بذلك يغدو حضور الأعراب في النص القرآني مفتاحًا لفهم التحول التاريخي من البنية القبلية المغلقة إلى الأفق الإنساني المفتوح الذي أراده الإسلام.
ومن هذا المنظور، فإن دراسة صورة الأعراب ليست بحثًا في الماضي، بل قراءة في ديناميات التحول الحضاري في الوعي الإسلامي. فالخطاب القرآني، حين يصف الأعراب بالشدة والجفاء أو بالانفصال عن روح الإيمان، إنما يرسم خريطةً رمزية دائمة لحالةٍ تتكرر في كل العصور: حالة الهامش الذي يقاوم المركز. ومن هنا يمتدّ مفهوم "الأعرابية" إلى ما بعد البادية، ليصبح استعارةً لكل نزعةٍ تعيد إنتاج العصبية داخل الدين، كما نراها اليوم في الإسلاموية المعاصرة التي تستعيد منطق القبيلة في ثوبٍ أيديولوجي حديث.
الأعراب بوصفهم "الهامش" في البناء الحضاري القرآني
يظهر في الخطاب القرآني أن لفظ «الأعراب» لا يشير إلى جماعة عرقية محددة، بل إلى حالة اجتماعية وثقافية تمثّل البنية الهامشية في المجتمع العربي زمن النبوة. فالأعراب هم البدو الرحّل الذين يعيشون في البوادي المحيطة بالمراكز الحضرية مثل المدينة المنوّرة ومكة، بعيدًا عن بنية العمران والمؤسسات. وقد أشار ابن كثير إلى هذا التحديد في تفسيره لقوله تعالى: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا» (التوبة: 97)، موضحًا أن المقصود بهم سكان البوادي الذين "لهم جفاء وغلظة لبعدهم عن العلم والعلماء" (تفسير ابن كثير، ج4، ص171). هذا البعد المكاني عن مركز النبوة أنتج أيضًا بعدًا معرفيًا وثقافيًا، حيث ظلّ الأعراب في أطراف الجغرافيا الإسلامية، غير مدمجين كليًا في المشروع المدني الذي بناه الإسلام.
وفي قوله تعالى: «وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة...» (التوبة: 101)، تتجلّى بوضوح هذه الثنائية بين المركز والهامش. فعبارة «من حولكم» تحمل دلالة مكانية تفصل بين المدينة (مركز الوحي والتنظيم السياسي) وبين محيطها من الأعراب الذين يعيشون في التخوم. غير أن هذه الإحاطة ليست مجرد تحديد جغرافي، بل رمزٌ دلاليٌّ على التباعد القيمي والمعرفي بين المجالين: فالمركز هو مجال الإيمان والوعي المؤسسي، في حين أن الهامش يمثّل فضاء الجفاء والتقلّب في الولاء. وهذا ما لاحظه الطاهر بن عاشور حين قال: "جعل الله الأعراب حول المدينة بمنزلة الحزام المحيط بها، فيهم المخلص والمنافق، ولكن الغالب فيهم الجفاء وقلة الفقه في الدين" (التحرير والتنوير، ج10، ص208).
إن الخطاب القرآني، من خلال هذا التمييز، لا يرسم خريطة جغرافية فحسب، بل يؤسس لبنية حضارية ومعرفية جديدة ترى في المدينة رمزًا للعقل الجماعي المنظّم، وفي البادية رمزًا للحالة البدائية التي لم تنخرط بعد في عملية التمدن الديني والسياسي. وبهذا يمكن القول إن «الأعراب» في النص القرآني يمثلون الهامش الذي لم يُستوعب بعد في نسيج الأمة المؤمنة، أي الطبقة الاجتماعية التي ما تزال واقعة على حدود الإيمان والسياسة، بين الخضوع الظاهري والممانعة الباطنة. وهو ما يجعل ذكرهم في القرآن تعبيرًا عن التوتر بين الوحي كمركز للعقلانية والتشريع والقبيلة كرمز للغريزة والعصبية.
المدينة كمركز للوحي مقابل البادية كفضاء للغزو
يشكّل القرآن الكريم، بوصفه نصًّا مؤسِّسًا للحضارة الإسلامية، نقطة تحول جذرية في البنية القيمية للعرب، إذ أعاد ترتيب العلاقة بين نموذجين ثقافيين متمايزين: المدينة والبادية. فالمدينة – ممثّلة في المدينة المنوّرة – صارت رمزًا للمركز الديني والسياسي والاجتماعي الذي انبثقت منه قيم الإيمان والنظام والتشريع. أما البادية، فظلّت تمثل الفضاء الخارجي، حيث تسود قيم العصبية والغزو والعفوية. وقد لاحظ ابن خلدون هذا التقابل حين قال إن «أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر» من حيث البساطة، ولكنهم في المقابل «أبعد عن السياسة والمدنية» (المقدمة، الفصل السادس والعشرون). بهذا التمايز، أعاد النص القرآني صياغة المفاهيم الاجتماعية، منتقلاً بالعرب من منطق القبيلة إلى منطق الأمة، ومن العصبية الغريزية إلى التشريع الإلهي المنظّم.
وفي هذا السياق، يبرز ما يمكن تسميته بـ «الصراع بين منطق الوحي ومنطق القبيلة». فالوحي، كما يُقدّمه الخطاب القرآني، يسعى إلى بناء جماعة إيمانية منضبطة بالقانون الإلهي، قائمة على المساواة والتكافل، لا على رابطة الدم والنسب. يتجلى ذلك في خطاب القرآن للمؤمنين: «إنما المؤمنون إخوة» (الحجرات: 10)، وفي دعوته إلى تجاوز العصبيات القبلية التي كانت تُقسِّم المجتمع الجاهلي. أما منطق القبيلة، فهو يعيد إنتاج الولاء على أساس الدم والمصلحة والغزو، وهي القيم التي ميّزت حياة الأعراب في البادية، حيث السلطة للغنيمة لا للشريعة. ولذلك، وصف القرآن هذا النمط الاجتماعي بغلظة القلب وجفاء الطبع: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة: 97)، وهو وصف لا يُقصَد به الذم الأخلاقي فحسب، بل تشخيص لواقع اجتماعي متخلّف عن البنية المدنية الجديدة التي أرساها الوحي.
إن الأعراب، بهذا المعنى، يمثلون في الخطاب القرآني رمزًا للثقافة القبلية السابقة على التمدن الديني والسياسي؛ فهم تجسيد لمرحلة ما قبل الدولة وما قبل الشريعة. وبهذا، فإن وجودهم في النص ليس عرضيًا، بل يحمل دلالة رمزية عميقة: فهم الحدّ الفاصل بين الجاهلية والإسلام، بين الفوضى والنظام. وكما يشير محمد عابد الجابري في تكوّن العقل العربي (ص. 123–127)، فإن التحول من «العقل البياني القبلي» إلى «العقل البرهاني التشريعي» لم يكن مجرد انتقال فكري، بل تحول حضاري في البنية الاجتماعية، مثّله الصراع بين المدينة والبادية في صدر الإسلام. وبذلك يمكن القول إن الأعراب، في الوعي القرآني، ليسوا مجرد فئة جغرافية، بل رمز مقاومة التحول التاريخي نحو الأمة المؤمنة التي تسعى إلى توحيد الناس على أساس القيم الإيمانية لا الروابط العصبية.
التحول من "القبيلة" إلى "الأمة"
عمل القرآن الكريم، بوصفه مشروعًا حضاريًا إصلاحيًا، على نقل المجتمع العربي من مرحلة القبيلة المغلقة إلى مرحلة الأمة المفتوحة. كانت القبيلة قبل الإسلام هي الوحدة الاجتماعية والسياسية الكبرى، تقوم على رابطة الدم والعصبية، حيث الولاء للأقارب مقدم على أي انتماء آخر. فجاء القرآن ليقوّض هذه البنية ويستبدلها بمنظومة عقدية تتأسس على الإيمان والقيم المشتركة، لا على النسب والقرابة. يقول ابن خلدون في المقدمة (الفصل الثالث والعشرون) إن "النبوة تحول العصبية من الغاية الدنيوية إلى الغاية الدينية"، وهو ما فعله الإسلام حين جعل رابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب. بهذا المعنى، مثّل تأسيس "الأمة" في المدينة المنورة — التي ضمّت المهاجرين والأنصار — لحظة ميلاد كيان فوق قبلي، يقوم على مبدأ العدل والمواطنة الإيمانية لا على التمايز القبلي.
غير أن الأعراب، بحكم موقعهم الجغرافي والثقافي، ظلّوا أبطأ الفئات استجابة لهذا التحول. فحياتهم في البادية كانت قائمة على الاكتفاء الذاتي والتنقل الدائم، بعيدًا عن مؤسسات الدولة والمدينة، مما جعل انتماءهم إلى الأمة الإسلامية انتماءً هشًا أو جزئيًا. وقد أشار الطبري إلى هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى: «قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا...» (الحجرات: 14)، مبينًا أن "الأعراب أظهروا الإسلام بألسنتهم ولم يواطئ الإيمان قلوبهم" (تفسير الطبري، ج26، ص119). فالآية تكشف عن تمييز قرآني دقيق بين الإسلام كخضوع سياسي وشكلي، والإيمان كتحول داخلي روحي. بمعنى أن الأعراب دخلوا في الإسلام بوصفه نظامًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا يفرض هيبته على الحجاز، لا بوصفه مشروعًا إيمانيًا وجوديًا غيّر منطقهم الداخلي.
ويظهر من هذا النص أن القرآن يتعامل مع الأعراب بحذر تربوي، لا بعقاب أو استبعاد؛ إذ يُقرّ بإسلامهم الظاهري ولكنه يدعوهم إلى ترقية هذا الإسلام نحو الإيمان القلبي. فقول الله تعالى: «ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» لا يحمل نفيًا مطلقًا، بل دعوة للتحول التدريجي من الانتماء السياسي إلى الانتماء القيمي. وهو ما يعكس رؤية قرآنية لبناء الأمة على مراحل، تبدأ بالانضواء تحت القانون ثم تنضج بالإيمان. وقد فسر الرازي هذا التدرج بقوله: "الآية دليل على أن الإسلام قد يتحقق في الظاهر دون الباطن، والإيمان هو الأصل المقصود" (مفاتيح الغيب، ج28، ص60). وبذلك يصبح الأعراب — في سياق التحول التاريخي — رمزًا للمرحلة الانتقالية بين الخضوع للنظام الإسلامي الجديد والاندماج الكامل في مشروع الأمة المؤمنة، أي بين الانتماء القسري والانتماء الاختياري.
المدينة والبادية – جدلية المركز والهامش في التصور القرآني
يميز القرآن الكريم بوضوح بين فضاءين اجتماعيين متمايزين: المدينة والبادية، بوصفهما تجسيدًا لبنيتين حضاريتين مختلفتين. فالمدينة في المنظور القرآني تمثل الفضاء المنظم الذي يقوم على الاستقرار، والتجارة، ونظام السوق، وتداول المعرفة، وتماسك الجماعة حول التشريع. إنها موطن للوحي والعقلانية الإيمانية التي أسست نواة الدولة الإسلامية في المدينة المنوّرة. وقد وصف الماوردي في الأحكام السلطانية (ص. 12–15) المدينة بأنها "موضع انتظام العمران واتصال السلطان"، ما يجعلها رمزًا للنظام السياسي المؤسسي. أما البادية، فهي على النقيض فضاء للحركة والتنقّل والاقتصاد الرعوي القائم على الضرورة والغزو. وهي بنية تقوم على علاقات الدم والعصبية لا على التشريع والقانون. وهذا ما أشار إليه ابن خلدون حين قال: "البدو أقرب إلى الشجاعة لبعدهم عن سياسة القهر، لكنهم أقرب أيضًا إلى الجفاء لبعدهم عن التعليم والتمدن" (المقدمة، الفصل التاسع عشر).
تنعكس هذه الجدلية في الخطاب القرآني في مواضع متعددة، منها قوله تعالى: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة: 97)، مقابل تصوير المدينة في سياق الإيمان والطاعة: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» (التوبة: 100). يظهر هنا أن المدينة تمثل شرعية القيم والوحي، في حين تمثل البادية شرعية القوة والغلبة. فالعلاقة بين المجالين ليست قطيعة مطلقة، بل تبادلية مشوبة بالتوتر: المدينة تحتاج إلى البادية في الغذاء والموارد الحيوية، والبادية تحتاج إلى المدينة في الاستقرار السياسي والاقتصادي. غير أن القرآن يقدّم مشروعًا لتجاوز هذه الثنائية عبر دمج الهامش في المركز من خلال قيم الإيمان والعلم. يقول الطاهر بن عاشور إن هذه الآيات "لم تذم الأعراب لذاتهم، وإنما لما تميز به أهل البادية من بعدٍ عن أسباب العلم، وهو ما يجعلهم أقرب إلى الكفر والنفاق" (التحرير والتنوير، ج10، ص210).
بهذا المعنى، يمكن القول إن القرآن الكريم أعاد ترتيب السلم الاجتماعي والثقافي الجاهلي رأسًا على عقب. ففي الثقافة العربية السابقة، كانت البادية تُعدّ موطن النقاء العرقي والفصاحة اللغوية، بينما كان أهل المدن يُتهمون بالترف والفساد. لكن الخطاب القرآني قلب هذا التصور جذريًا، فصار التمدن الديني والسياسي معيارًا للتفوق، لا الانتماء القبلي أو النقاء العرقي. يقول المفكر محمد أركون في الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد (ص. 88–90) إن القرآن "حوّل مفهوم النقاء من أصل الدم إلى صفاء الإيمان"، وهي نقلة فكرية هائلة في البنية الحضارية للعرب. وهكذا لم يعد التفوق يُقاس بالانتماء إلى القبيلة أو بالقدرة على الغزو، بل بالانتماء إلى الأمة المؤمنة المنظمة حول الوحي، لتتحول المدينة إلى رمز للعقل الديني والحضارة، والبادية إلى رمز للجهل والغريزة والانفصال عن القانون.
المدينة والبادية: انقلاب في السلم القيمي
شكّلت المدينة في الخطاب القرآني فضاءً مركزيًا للتمدّن والتشريع، حيث ارتبطت بظهور الوحي وبناء الجماعة المؤمنة ذات النظام والقانون. ففي المدينة المنوّرة نزلت معظم آيات الأحكام، ومنها تشكّلت البنية الأولى للدولة الإسلامية القائمة على مبدأ الجماعة والالتزام بالشريعة، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (الأنفال: 74). بهذا المعنى، أصبحت المدينة تمثل المركز الرمزي للشرعية الإيمانية والسياسية، فهي المكان الذي يُترجم فيه الإيمان إلى مؤسسات وسلوك وقانون، أي إلى "تمدن ديني" بالمعنى الحضاري.
في المقابل، تمثل البادية – أو فضاء الأعراب – النقيض الاجتماعي والفكري للمدينة. فهي بيئة تقوم على التنقل والاقتصاد الرعوي والعلاقات العصبوية، حيث يسود قانون الدم والغزو بدل القانون الإلهي. ولهذا وصفهم القرآن بأنهم ﴿أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ (التوبة: 97)، لأنهم يعيشون خارج منطق الدولة والوحي، ويصعب عليهم الانتقال من الولاء القبلي إلى الولاء الإيماني. فحياة البادية بطبيعتها تقاوم فكرة الضبط والتشريع، لأنها تقوم على الحرية المطلقة للقبيلة والفرد، أي على منطق ما قبل الدولة. ومن ثمّ، فإن موقف القرآن من الأعراب ليس عدائيًا بقدر ما هو تحذير حضاري من نمطٍ ثقافيٍّ يقاوم الاندماج في مشروع الأمة.
العلاقة بين المدينة والبادية في هذا السياق ليست قطيعة تامة، بل علاقة تبادلية مشوبة بالتوتر؛ فالبادية توفّر للمدينة الغذاء واليد العاملة، بينما تمنحها المدينة القيادة والشرعية الدينية. لكن هذا التبادل لا يلغي الصراع حول مفهوم الشرعية ذاته: فالأعراب يمتلكون شرعية القوة والغزو، بينما تمتلك المدينة شرعية القيم والوحي. وبهذا المعنى، أعاد القرآن ترتيب السلم الاجتماعي الجاهلي، إذ قلب المعادلة الثقافية التي كانت ترى في البادية مصدر النقاء والفصاحة، لتصبح في الخطاب القرآني رمزًا للجفاء والتخلّف عن مشروع النبوة (انظر: التوبة 97-99). لقد نقل القرآن مركز الثقل من النسب والدم إلى الإيمان والعمل، مؤسِّسًا بذلك رؤية حضارية جديدة تتجاوز منطق القبيلة إلى منطق الأمة.
يتضح من هذا التحليل أن القرآن الكريم لم يتعامل مع المدينة والبادية بوصفهما مجرد فضاءين جغرافيين، بل بوصفهما نموذجين ثقافيين متقابلين: نموذج المدينة الذي يمثّل ولادة العقل الجمعي المنظّم في إطار الوحي، ونموذج البادية الذي يجسّد العصبية والانغلاق القبلي. ومن خلال إعادة توزيع القيم بينهما، سعى النص القرآني إلى تفكيك البنية القبلية لصالح بنية الأمة، بحيث تنتقل الشرعية من رابطة النسب إلى رابطة العقيدة، ومن الولاء للقبيلة إلى الولاء لله ورسوله.
بهذا التحول، أراد القرآن أن يُنشئ ما يمكن تسميته بـ "المدنية الإيمانية"؛ أي مجتمعًا يوازن بين الانضباط الاجتماعي والمبادئ الروحية، حيث تكون القوة خاضعة للقيم لا العكس. فالوحي هنا لا يرفض البادية في ذاتها، بل يسعى إلى تهذيبها وإدماجها في مشروع الأمة عبر تحويل العصبية الطبيعية إلى طاقة أخلاقية منضبطة بقانون الإيمان. وهذا التحول هو ما أسّس، في نهاية المطاف، لنواة الحضارة الإسلامية الأولى التي تجاوزت الانتماء القبلي لتؤسس مفهوم "الإنسان المسلم" بدل "الرجل القبلي".
قراءة تأويلية معاصرة
تُتيح المقاربة الأنثروبولوجية الحديثة قراءة جديدة لمفهوم «الأعراب» في القرآن، تتجاوز الفهم التاريخي الضيق إلى رؤية رمزية تتعلق بالبنية الذهنية أكثر من الانتماء القبلي. فالأعراب، في هذا الأفق، لا يُمثلون فقط سكان البادية زمن النبوة، بل يرمزون إلى الذهنية التقليدية التي تقاوم الانتقال من العفوية القبلية إلى النظام المدني المؤسسي. هذه الذهنية – كما يشير الأنثروبولوجي إرنست غلنر في كتابه Muslim Society (1981) – تميل إلى رفض الانضباط الجماعي والنظام الرمزي الذي تفرضه المدينة، وتُفضل البنية اللامركزية القائمة على العصبية والولاء الدموي.
من هنا، يمكن فهم تمثيل الأعراب في الخطاب القرآني على أنه نقدٌ ثقافي لبنية اجتماعية مغلقة ترفض القانون الجمعي. فالآيات التي وصفتهم بالجفاء أو الشدة («الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا...» – التوبة: 97) لا تصف صفات وراثية، بل أنماطًا من السلوك والموقف الوجودي تجاه قيم الوحي؛ أي رفض الانتقال من منطق القوة والغزو إلى منطق القيم والعدالة. وقد أشار مالك بن نبي في شروط النهضة (1949) إلى أن مشكلة المجتمعات الإسلامية لا تكمن في العقيدة بل في "القابلية للتمدن"، وهو ما يعيدنا إلى صورة الأعراب كرمز للممانعة ضد مشروع التحضر القرآني.
بهذا المعنى، يصبح مفهوم «الأعراب» في التأويل المعاصر استعارةً متجددة لكل من يعيش على هامش الحضارة، ماديًا أو معرفيًا، ويقاوم التحول نحو ما يمكن تسميته بـ «المدنية القرآنية»؛ أي المجتمع الذي يجمع بين الإيمان والعقل، بين الشريعة والعمران. إنهم – بتعبير ميشيل فوكو في حديثه عن «الهامش» – يمثلون المنطقة التي يُختبر فيها مدى نجاح الخطاب في دمج المختلفين وتحويلهم من أطرافٍ إلى فاعلين داخل منظومة القيم. وهكذا يغدو الأعراب ليسوا فقط ظاهرة تاريخية، بل نموذجًا رمزيًا دائم الحضور في كل عصرٍ يرفض التمدن القيمي.
البعد الرمزي السياسي لـ«الأعراب» في الفكر الإسلامي
منذ القرون الأولى، أعاد الفقهاء والمفكرون المسلمون توظيف صورة الأعراب لتفسير ظواهر التراجع والانقسام داخل الأمة. فبعد أن كان الأعراب في النص القرآني يرمزون إلى الهامش الثقافي المقاوم لتمدن المدينة النبوية، صاروا في الخطاب الفقهي والسياسي لاحقًا استعارةً عن كل قوةٍ تنزع إلى تفكيك الجماعة أو الخروج عن النظام الشرعي. فقد استخدم بعض المفسرين – مثل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج 8، ص 239) – لفظ الأعراب ليشير إلى "من لم تهذبه الشريعة ولم يتأدب بآداب الجماعة"، أي كل من يظل في حالة ما قبل الدولة. وهكذا تحولت الدلالة من جغرافية إلى سياسية: من «من يعيش خارج المدينة» إلى «من يعيش خارج النظام».
وفي الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي، استُخدمت صورة الأعراب لتوصيف الانحطاط الحضاري والاضطراب السياسي. فابن خلدون، مثلًا، قدّم في المقدمة (ج 1، ص 130–138) قراءة أنثروبولوجية عميقة تربط بين "البداوة" و"الملك"، معتبرًا أن العصبية القبلية هي قوة التأسيس الأولى للدولة، لكنها تصبح – حين لا تُضبط بالقانون الشرعي والعمران المدني – سببًا في انهيارها. عنده، "الأعراب" ليسوا مجرد بدو، بل رمزٌ لدورة الهمجية التي تُعيد المجتمع إلى بداياته بعد كل نضج حضاري. ومن هنا نشأت فكرة أن الانحدار السياسي يبدأ دائمًا بـ"عودة البداوة إلى الدولة"، أي عودة الأعرابية بوصفها ذهنية لا مكانًا.
أما في الفكر الإسلامي الحديث، فقد استُعيد هذا الرمز في سياق نقد الانغلاق الأيديولوجي والتعصب الديني. فمحمد عابد الجابري مثلًا استخدم مصطلح "العقل البدوي" في تكوين العقل العربي (1984، ص 97–112) ليصف نمط التفكير الذي يعيد إنتاج منطق العصبية داخل الحركات الدينية والسياسية المعاصرة، معتبرًا أن هذا "البدوي" هو امتداد رمزي للأعراب القرآنيين في رفضهم للمؤسسة وللتعددية. وبذلك أصبح مفهوم الأعراب، في تطوره التاريخي، مرآةً سياسية للانقسام الداخلي: كل عودةٍ إلى العصبية، أو إلى منطق القوة على حساب القيم، تُقرأ كتجددٍ لـ"الأعرابية" داخل جسد الأمة.
الأعرابية السياسية في الإسلاموية المعاصرة
في ضوء التحليل السابق، يمكن القول إن الجماعات الإسلاموية المعاصرة — من الإخوان المسلمين إلى التيارات الجهادية كداعش والقاعدة — تمثل تجليًا حديثًا لما يمكن تسميته بـ «الأعرابية السياسية»؛ أي عودة الذهنية البدوية في ثوبٍ ديني. فهي، وإن حملت شعارات دينية، إلا أنها تستبطن في بنيتها العميقة منطق العصبية والولاء المغلق الذي يتعارض مع روح الأمة المفتوحة التي أرادها القرآن. إن رفضها لفكرة الدولة الوطنية الحديثة، ونزعتها إلى تكفير المخالف واحتكار الحقيقة، يعيدان إنتاج منطق “القبيلة العقائدية” الذي وصفه ابن خلدون بوصفه الطور الهمجي من دورة العمران (المقدمة، ج 1، ص 135).
بهذا المعنى، فإن الإسلاموية ليست استمرارًا للنبوة، بل ارتدادًا إلى البادية — إلى ما قبل الدولة وما قبل العقل المدني. فكما كان الأعراب حول المدينة يعيشون على هامشها دون الاندماج في نظامها القيمي، تعيش الحركات الإسلاموية اليوم على هامش الدولة الحديثة، تستفيد من مؤسساتها لكنها تنكر شرعيتها، تمامًا كما قال تعالى:
«قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» (الحجرات: 14).
هذه المفارقة القرآنية تظل قائمة: الانتماء الشكلي دون الإيمان العميق، والمشاركة المصلحية دون الاندماج الحضاري.
إن ما يميز "المدينة القرآنية" عن "البادية الأيديولوجية" هو أن الأولى تنتج نظامًا عامًا مبنيًا على القيم والعقل والتعايش، بينما الثانية تُعيد تدوير العصبية باسم الدين. وهكذا تتحول الإسلاموية الحديثة إلى النسخة السياسية من الأعرابية القديمة — حيث يُستبدل الولاء للدم بالولاء للتنظيم، والغزو بالسعي إلى السيطرة الرمزية على المجال العام. إنها أعرابية ما بعد حداثية، تُمارس الغزو عبر الخطاب والدعاية بدل السيف، لكنها تحتفظ بالبنية نفسها: رفض القانون، تمجيد الجماعة، وإقصاء الآخر.
خاتمة: من الأعراب إلى الأعرابية الأيديولوجية
لم يكن القرآن حين تحدث عن الأعراب يسجل ملاحظة أنثروبولوجية عن جماعة سكنت الصحراء، بل كان يرسم خريطة الوعي الإنساني بين الإيمان والعصبية، بين القانون والوهم، بين الوحي والغزو. فالأعراب، في عمق الخطاب القرآني، ليسوا أبناء البادية وحدها، بل أبناء الحالة التي ترفض التحول، وتخشى النظام، وتخاف من أن تُصبح جزءًا من المدينة التي تُنظمها القيم لا الغرائز.
لكن المفارقة أن التاريخ يعيد إنتاج هذه “الأعرابية” بأشكال جديدة. فما نراه اليوم من جماعات ترفع راية الدين لتقاتل به المجتمع، وتُقدّس الجماعة على حساب الأمة، وتُعيد تعريف العالم بمنطق “نحن وهم”، ليس إلا عودة متأخرة للأعرابي القديم في ثوب أيديولوجي حديث. لقد استبدلت الخيمة بالمقرّ الحزبي، والغزو بالغزو الإعلامي، والعصبية القبلية بعصبية التنظيم. إنها الأعرابية وقد لبست عباءة الدين والسياسة، تتحدث باسم الوحي وهي في جوهرها تمرّدٌ على روحه.
وهكذا يبقى الصراع بين المدينة والبادية — بين “المدنية القرآنية” و”الأعرابية الأيديولوجية” — صراعًا مفتوحًا في تاريخ الإسلام: صراعًا بين من يرى في الدين مشروعًا لبناء الإنسان، ومن يستخدمه ذريعةً للهيمنة على الإنسان. وإذا كانت المدينة النبوية قد انتصرت يومًا حين تحوّل الإيمان إلى نظامٍ عادلٍ يضبط القوة بالقيم، فإن معركة اليوم لا تزال تدور حول المعنى نفسه: هل نؤمن بالوحي بوصفه طريقًا للتحرر، أم نُعيد إنتاج الأعرابية كأداةٍ للسيطرة؟
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
مستشفى القصر العيني
ومن هذا المنظور، فإن دراسة صورة الأعراب ليست بحثًا في الماضي، بل قراءة في ديناميات التحول الحضاري في الوعي الإسلامي. فالخطاب القرآني، حين يصف الأعراب بالشدة والجفاء أو بالانفصال عن روح الإيمان، إنما يرسم خريطةً رمزية دائمة لحالةٍ تتكرر في كل العصور: حالة الهامش الذي يقاوم المركز. ومن هنا يمتدّ مفهوم "الأعرابية" إلى ما بعد البادية، ليصبح استعارةً لكل نزعةٍ تعيد إنتاج العصبية داخل الدين، كما نراها اليوم في الإسلاموية المعاصرة التي تستعيد منطق القبيلة في ثوبٍ أيديولوجي حديث.
الأعراب بوصفهم "الهامش" في البناء الحضاري القرآني
يظهر في الخطاب القرآني أن لفظ «الأعراب» لا يشير إلى جماعة عرقية محددة، بل إلى حالة اجتماعية وثقافية تمثّل البنية الهامشية في المجتمع العربي زمن النبوة. فالأعراب هم البدو الرحّل الذين يعيشون في البوادي المحيطة بالمراكز الحضرية مثل المدينة المنوّرة ومكة، بعيدًا عن بنية العمران والمؤسسات. وقد أشار ابن كثير إلى هذا التحديد في تفسيره لقوله تعالى: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا» (التوبة: 97)، موضحًا أن المقصود بهم سكان البوادي الذين "لهم جفاء وغلظة لبعدهم عن العلم والعلماء" (تفسير ابن كثير، ج4، ص171). هذا البعد المكاني عن مركز النبوة أنتج أيضًا بعدًا معرفيًا وثقافيًا، حيث ظلّ الأعراب في أطراف الجغرافيا الإسلامية، غير مدمجين كليًا في المشروع المدني الذي بناه الإسلام.
وفي قوله تعالى: «وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة...» (التوبة: 101)، تتجلّى بوضوح هذه الثنائية بين المركز والهامش. فعبارة «من حولكم» تحمل دلالة مكانية تفصل بين المدينة (مركز الوحي والتنظيم السياسي) وبين محيطها من الأعراب الذين يعيشون في التخوم. غير أن هذه الإحاطة ليست مجرد تحديد جغرافي، بل رمزٌ دلاليٌّ على التباعد القيمي والمعرفي بين المجالين: فالمركز هو مجال الإيمان والوعي المؤسسي، في حين أن الهامش يمثّل فضاء الجفاء والتقلّب في الولاء. وهذا ما لاحظه الطاهر بن عاشور حين قال: "جعل الله الأعراب حول المدينة بمنزلة الحزام المحيط بها، فيهم المخلص والمنافق، ولكن الغالب فيهم الجفاء وقلة الفقه في الدين" (التحرير والتنوير، ج10، ص208).
إن الخطاب القرآني، من خلال هذا التمييز، لا يرسم خريطة جغرافية فحسب، بل يؤسس لبنية حضارية ومعرفية جديدة ترى في المدينة رمزًا للعقل الجماعي المنظّم، وفي البادية رمزًا للحالة البدائية التي لم تنخرط بعد في عملية التمدن الديني والسياسي. وبهذا يمكن القول إن «الأعراب» في النص القرآني يمثلون الهامش الذي لم يُستوعب بعد في نسيج الأمة المؤمنة، أي الطبقة الاجتماعية التي ما تزال واقعة على حدود الإيمان والسياسة، بين الخضوع الظاهري والممانعة الباطنة. وهو ما يجعل ذكرهم في القرآن تعبيرًا عن التوتر بين الوحي كمركز للعقلانية والتشريع والقبيلة كرمز للغريزة والعصبية.
المدينة كمركز للوحي مقابل البادية كفضاء للغزو
يشكّل القرآن الكريم، بوصفه نصًّا مؤسِّسًا للحضارة الإسلامية، نقطة تحول جذرية في البنية القيمية للعرب، إذ أعاد ترتيب العلاقة بين نموذجين ثقافيين متمايزين: المدينة والبادية. فالمدينة – ممثّلة في المدينة المنوّرة – صارت رمزًا للمركز الديني والسياسي والاجتماعي الذي انبثقت منه قيم الإيمان والنظام والتشريع. أما البادية، فظلّت تمثل الفضاء الخارجي، حيث تسود قيم العصبية والغزو والعفوية. وقد لاحظ ابن خلدون هذا التقابل حين قال إن «أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر» من حيث البساطة، ولكنهم في المقابل «أبعد عن السياسة والمدنية» (المقدمة، الفصل السادس والعشرون). بهذا التمايز، أعاد النص القرآني صياغة المفاهيم الاجتماعية، منتقلاً بالعرب من منطق القبيلة إلى منطق الأمة، ومن العصبية الغريزية إلى التشريع الإلهي المنظّم.
وفي هذا السياق، يبرز ما يمكن تسميته بـ «الصراع بين منطق الوحي ومنطق القبيلة». فالوحي، كما يُقدّمه الخطاب القرآني، يسعى إلى بناء جماعة إيمانية منضبطة بالقانون الإلهي، قائمة على المساواة والتكافل، لا على رابطة الدم والنسب. يتجلى ذلك في خطاب القرآن للمؤمنين: «إنما المؤمنون إخوة» (الحجرات: 10)، وفي دعوته إلى تجاوز العصبيات القبلية التي كانت تُقسِّم المجتمع الجاهلي. أما منطق القبيلة، فهو يعيد إنتاج الولاء على أساس الدم والمصلحة والغزو، وهي القيم التي ميّزت حياة الأعراب في البادية، حيث السلطة للغنيمة لا للشريعة. ولذلك، وصف القرآن هذا النمط الاجتماعي بغلظة القلب وجفاء الطبع: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة: 97)، وهو وصف لا يُقصَد به الذم الأخلاقي فحسب، بل تشخيص لواقع اجتماعي متخلّف عن البنية المدنية الجديدة التي أرساها الوحي.
إن الأعراب، بهذا المعنى، يمثلون في الخطاب القرآني رمزًا للثقافة القبلية السابقة على التمدن الديني والسياسي؛ فهم تجسيد لمرحلة ما قبل الدولة وما قبل الشريعة. وبهذا، فإن وجودهم في النص ليس عرضيًا، بل يحمل دلالة رمزية عميقة: فهم الحدّ الفاصل بين الجاهلية والإسلام، بين الفوضى والنظام. وكما يشير محمد عابد الجابري في تكوّن العقل العربي (ص. 123–127)، فإن التحول من «العقل البياني القبلي» إلى «العقل البرهاني التشريعي» لم يكن مجرد انتقال فكري، بل تحول حضاري في البنية الاجتماعية، مثّله الصراع بين المدينة والبادية في صدر الإسلام. وبذلك يمكن القول إن الأعراب، في الوعي القرآني، ليسوا مجرد فئة جغرافية، بل رمز مقاومة التحول التاريخي نحو الأمة المؤمنة التي تسعى إلى توحيد الناس على أساس القيم الإيمانية لا الروابط العصبية.
التحول من "القبيلة" إلى "الأمة"
عمل القرآن الكريم، بوصفه مشروعًا حضاريًا إصلاحيًا، على نقل المجتمع العربي من مرحلة القبيلة المغلقة إلى مرحلة الأمة المفتوحة. كانت القبيلة قبل الإسلام هي الوحدة الاجتماعية والسياسية الكبرى، تقوم على رابطة الدم والعصبية، حيث الولاء للأقارب مقدم على أي انتماء آخر. فجاء القرآن ليقوّض هذه البنية ويستبدلها بمنظومة عقدية تتأسس على الإيمان والقيم المشتركة، لا على النسب والقرابة. يقول ابن خلدون في المقدمة (الفصل الثالث والعشرون) إن "النبوة تحول العصبية من الغاية الدنيوية إلى الغاية الدينية"، وهو ما فعله الإسلام حين جعل رابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب. بهذا المعنى، مثّل تأسيس "الأمة" في المدينة المنورة — التي ضمّت المهاجرين والأنصار — لحظة ميلاد كيان فوق قبلي، يقوم على مبدأ العدل والمواطنة الإيمانية لا على التمايز القبلي.
غير أن الأعراب، بحكم موقعهم الجغرافي والثقافي، ظلّوا أبطأ الفئات استجابة لهذا التحول. فحياتهم في البادية كانت قائمة على الاكتفاء الذاتي والتنقل الدائم، بعيدًا عن مؤسسات الدولة والمدينة، مما جعل انتماءهم إلى الأمة الإسلامية انتماءً هشًا أو جزئيًا. وقد أشار الطبري إلى هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى: «قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا...» (الحجرات: 14)، مبينًا أن "الأعراب أظهروا الإسلام بألسنتهم ولم يواطئ الإيمان قلوبهم" (تفسير الطبري، ج26، ص119). فالآية تكشف عن تمييز قرآني دقيق بين الإسلام كخضوع سياسي وشكلي، والإيمان كتحول داخلي روحي. بمعنى أن الأعراب دخلوا في الإسلام بوصفه نظامًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا يفرض هيبته على الحجاز، لا بوصفه مشروعًا إيمانيًا وجوديًا غيّر منطقهم الداخلي.
ويظهر من هذا النص أن القرآن يتعامل مع الأعراب بحذر تربوي، لا بعقاب أو استبعاد؛ إذ يُقرّ بإسلامهم الظاهري ولكنه يدعوهم إلى ترقية هذا الإسلام نحو الإيمان القلبي. فقول الله تعالى: «ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» لا يحمل نفيًا مطلقًا، بل دعوة للتحول التدريجي من الانتماء السياسي إلى الانتماء القيمي. وهو ما يعكس رؤية قرآنية لبناء الأمة على مراحل، تبدأ بالانضواء تحت القانون ثم تنضج بالإيمان. وقد فسر الرازي هذا التدرج بقوله: "الآية دليل على أن الإسلام قد يتحقق في الظاهر دون الباطن، والإيمان هو الأصل المقصود" (مفاتيح الغيب، ج28، ص60). وبذلك يصبح الأعراب — في سياق التحول التاريخي — رمزًا للمرحلة الانتقالية بين الخضوع للنظام الإسلامي الجديد والاندماج الكامل في مشروع الأمة المؤمنة، أي بين الانتماء القسري والانتماء الاختياري.
المدينة والبادية – جدلية المركز والهامش في التصور القرآني
يميز القرآن الكريم بوضوح بين فضاءين اجتماعيين متمايزين: المدينة والبادية، بوصفهما تجسيدًا لبنيتين حضاريتين مختلفتين. فالمدينة في المنظور القرآني تمثل الفضاء المنظم الذي يقوم على الاستقرار، والتجارة، ونظام السوق، وتداول المعرفة، وتماسك الجماعة حول التشريع. إنها موطن للوحي والعقلانية الإيمانية التي أسست نواة الدولة الإسلامية في المدينة المنوّرة. وقد وصف الماوردي في الأحكام السلطانية (ص. 12–15) المدينة بأنها "موضع انتظام العمران واتصال السلطان"، ما يجعلها رمزًا للنظام السياسي المؤسسي. أما البادية، فهي على النقيض فضاء للحركة والتنقّل والاقتصاد الرعوي القائم على الضرورة والغزو. وهي بنية تقوم على علاقات الدم والعصبية لا على التشريع والقانون. وهذا ما أشار إليه ابن خلدون حين قال: "البدو أقرب إلى الشجاعة لبعدهم عن سياسة القهر، لكنهم أقرب أيضًا إلى الجفاء لبعدهم عن التعليم والتمدن" (المقدمة، الفصل التاسع عشر).
تنعكس هذه الجدلية في الخطاب القرآني في مواضع متعددة، منها قوله تعالى: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة: 97)، مقابل تصوير المدينة في سياق الإيمان والطاعة: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» (التوبة: 100). يظهر هنا أن المدينة تمثل شرعية القيم والوحي، في حين تمثل البادية شرعية القوة والغلبة. فالعلاقة بين المجالين ليست قطيعة مطلقة، بل تبادلية مشوبة بالتوتر: المدينة تحتاج إلى البادية في الغذاء والموارد الحيوية، والبادية تحتاج إلى المدينة في الاستقرار السياسي والاقتصادي. غير أن القرآن يقدّم مشروعًا لتجاوز هذه الثنائية عبر دمج الهامش في المركز من خلال قيم الإيمان والعلم. يقول الطاهر بن عاشور إن هذه الآيات "لم تذم الأعراب لذاتهم، وإنما لما تميز به أهل البادية من بعدٍ عن أسباب العلم، وهو ما يجعلهم أقرب إلى الكفر والنفاق" (التحرير والتنوير، ج10، ص210).
بهذا المعنى، يمكن القول إن القرآن الكريم أعاد ترتيب السلم الاجتماعي والثقافي الجاهلي رأسًا على عقب. ففي الثقافة العربية السابقة، كانت البادية تُعدّ موطن النقاء العرقي والفصاحة اللغوية، بينما كان أهل المدن يُتهمون بالترف والفساد. لكن الخطاب القرآني قلب هذا التصور جذريًا، فصار التمدن الديني والسياسي معيارًا للتفوق، لا الانتماء القبلي أو النقاء العرقي. يقول المفكر محمد أركون في الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد (ص. 88–90) إن القرآن "حوّل مفهوم النقاء من أصل الدم إلى صفاء الإيمان"، وهي نقلة فكرية هائلة في البنية الحضارية للعرب. وهكذا لم يعد التفوق يُقاس بالانتماء إلى القبيلة أو بالقدرة على الغزو، بل بالانتماء إلى الأمة المؤمنة المنظمة حول الوحي، لتتحول المدينة إلى رمز للعقل الديني والحضارة، والبادية إلى رمز للجهل والغريزة والانفصال عن القانون.
المدينة والبادية: انقلاب في السلم القيمي
شكّلت المدينة في الخطاب القرآني فضاءً مركزيًا للتمدّن والتشريع، حيث ارتبطت بظهور الوحي وبناء الجماعة المؤمنة ذات النظام والقانون. ففي المدينة المنوّرة نزلت معظم آيات الأحكام، ومنها تشكّلت البنية الأولى للدولة الإسلامية القائمة على مبدأ الجماعة والالتزام بالشريعة، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (الأنفال: 74). بهذا المعنى، أصبحت المدينة تمثل المركز الرمزي للشرعية الإيمانية والسياسية، فهي المكان الذي يُترجم فيه الإيمان إلى مؤسسات وسلوك وقانون، أي إلى "تمدن ديني" بالمعنى الحضاري.
في المقابل، تمثل البادية – أو فضاء الأعراب – النقيض الاجتماعي والفكري للمدينة. فهي بيئة تقوم على التنقل والاقتصاد الرعوي والعلاقات العصبوية، حيث يسود قانون الدم والغزو بدل القانون الإلهي. ولهذا وصفهم القرآن بأنهم ﴿أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ (التوبة: 97)، لأنهم يعيشون خارج منطق الدولة والوحي، ويصعب عليهم الانتقال من الولاء القبلي إلى الولاء الإيماني. فحياة البادية بطبيعتها تقاوم فكرة الضبط والتشريع، لأنها تقوم على الحرية المطلقة للقبيلة والفرد، أي على منطق ما قبل الدولة. ومن ثمّ، فإن موقف القرآن من الأعراب ليس عدائيًا بقدر ما هو تحذير حضاري من نمطٍ ثقافيٍّ يقاوم الاندماج في مشروع الأمة.
العلاقة بين المدينة والبادية في هذا السياق ليست قطيعة تامة، بل علاقة تبادلية مشوبة بالتوتر؛ فالبادية توفّر للمدينة الغذاء واليد العاملة، بينما تمنحها المدينة القيادة والشرعية الدينية. لكن هذا التبادل لا يلغي الصراع حول مفهوم الشرعية ذاته: فالأعراب يمتلكون شرعية القوة والغزو، بينما تمتلك المدينة شرعية القيم والوحي. وبهذا المعنى، أعاد القرآن ترتيب السلم الاجتماعي الجاهلي، إذ قلب المعادلة الثقافية التي كانت ترى في البادية مصدر النقاء والفصاحة، لتصبح في الخطاب القرآني رمزًا للجفاء والتخلّف عن مشروع النبوة (انظر: التوبة 97-99). لقد نقل القرآن مركز الثقل من النسب والدم إلى الإيمان والعمل، مؤسِّسًا بذلك رؤية حضارية جديدة تتجاوز منطق القبيلة إلى منطق الأمة.
يتضح من هذا التحليل أن القرآن الكريم لم يتعامل مع المدينة والبادية بوصفهما مجرد فضاءين جغرافيين، بل بوصفهما نموذجين ثقافيين متقابلين: نموذج المدينة الذي يمثّل ولادة العقل الجمعي المنظّم في إطار الوحي، ونموذج البادية الذي يجسّد العصبية والانغلاق القبلي. ومن خلال إعادة توزيع القيم بينهما، سعى النص القرآني إلى تفكيك البنية القبلية لصالح بنية الأمة، بحيث تنتقل الشرعية من رابطة النسب إلى رابطة العقيدة، ومن الولاء للقبيلة إلى الولاء لله ورسوله.
بهذا التحول، أراد القرآن أن يُنشئ ما يمكن تسميته بـ "المدنية الإيمانية"؛ أي مجتمعًا يوازن بين الانضباط الاجتماعي والمبادئ الروحية، حيث تكون القوة خاضعة للقيم لا العكس. فالوحي هنا لا يرفض البادية في ذاتها، بل يسعى إلى تهذيبها وإدماجها في مشروع الأمة عبر تحويل العصبية الطبيعية إلى طاقة أخلاقية منضبطة بقانون الإيمان. وهذا التحول هو ما أسّس، في نهاية المطاف، لنواة الحضارة الإسلامية الأولى التي تجاوزت الانتماء القبلي لتؤسس مفهوم "الإنسان المسلم" بدل "الرجل القبلي".
قراءة تأويلية معاصرة
تُتيح المقاربة الأنثروبولوجية الحديثة قراءة جديدة لمفهوم «الأعراب» في القرآن، تتجاوز الفهم التاريخي الضيق إلى رؤية رمزية تتعلق بالبنية الذهنية أكثر من الانتماء القبلي. فالأعراب، في هذا الأفق، لا يُمثلون فقط سكان البادية زمن النبوة، بل يرمزون إلى الذهنية التقليدية التي تقاوم الانتقال من العفوية القبلية إلى النظام المدني المؤسسي. هذه الذهنية – كما يشير الأنثروبولوجي إرنست غلنر في كتابه Muslim Society (1981) – تميل إلى رفض الانضباط الجماعي والنظام الرمزي الذي تفرضه المدينة، وتُفضل البنية اللامركزية القائمة على العصبية والولاء الدموي.
من هنا، يمكن فهم تمثيل الأعراب في الخطاب القرآني على أنه نقدٌ ثقافي لبنية اجتماعية مغلقة ترفض القانون الجمعي. فالآيات التي وصفتهم بالجفاء أو الشدة («الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا...» – التوبة: 97) لا تصف صفات وراثية، بل أنماطًا من السلوك والموقف الوجودي تجاه قيم الوحي؛ أي رفض الانتقال من منطق القوة والغزو إلى منطق القيم والعدالة. وقد أشار مالك بن نبي في شروط النهضة (1949) إلى أن مشكلة المجتمعات الإسلامية لا تكمن في العقيدة بل في "القابلية للتمدن"، وهو ما يعيدنا إلى صورة الأعراب كرمز للممانعة ضد مشروع التحضر القرآني.
بهذا المعنى، يصبح مفهوم «الأعراب» في التأويل المعاصر استعارةً متجددة لكل من يعيش على هامش الحضارة، ماديًا أو معرفيًا، ويقاوم التحول نحو ما يمكن تسميته بـ «المدنية القرآنية»؛ أي المجتمع الذي يجمع بين الإيمان والعقل، بين الشريعة والعمران. إنهم – بتعبير ميشيل فوكو في حديثه عن «الهامش» – يمثلون المنطقة التي يُختبر فيها مدى نجاح الخطاب في دمج المختلفين وتحويلهم من أطرافٍ إلى فاعلين داخل منظومة القيم. وهكذا يغدو الأعراب ليسوا فقط ظاهرة تاريخية، بل نموذجًا رمزيًا دائم الحضور في كل عصرٍ يرفض التمدن القيمي.
البعد الرمزي السياسي لـ«الأعراب» في الفكر الإسلامي
منذ القرون الأولى، أعاد الفقهاء والمفكرون المسلمون توظيف صورة الأعراب لتفسير ظواهر التراجع والانقسام داخل الأمة. فبعد أن كان الأعراب في النص القرآني يرمزون إلى الهامش الثقافي المقاوم لتمدن المدينة النبوية، صاروا في الخطاب الفقهي والسياسي لاحقًا استعارةً عن كل قوةٍ تنزع إلى تفكيك الجماعة أو الخروج عن النظام الشرعي. فقد استخدم بعض المفسرين – مثل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج 8، ص 239) – لفظ الأعراب ليشير إلى "من لم تهذبه الشريعة ولم يتأدب بآداب الجماعة"، أي كل من يظل في حالة ما قبل الدولة. وهكذا تحولت الدلالة من جغرافية إلى سياسية: من «من يعيش خارج المدينة» إلى «من يعيش خارج النظام».
وفي الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي، استُخدمت صورة الأعراب لتوصيف الانحطاط الحضاري والاضطراب السياسي. فابن خلدون، مثلًا، قدّم في المقدمة (ج 1، ص 130–138) قراءة أنثروبولوجية عميقة تربط بين "البداوة" و"الملك"، معتبرًا أن العصبية القبلية هي قوة التأسيس الأولى للدولة، لكنها تصبح – حين لا تُضبط بالقانون الشرعي والعمران المدني – سببًا في انهيارها. عنده، "الأعراب" ليسوا مجرد بدو، بل رمزٌ لدورة الهمجية التي تُعيد المجتمع إلى بداياته بعد كل نضج حضاري. ومن هنا نشأت فكرة أن الانحدار السياسي يبدأ دائمًا بـ"عودة البداوة إلى الدولة"، أي عودة الأعرابية بوصفها ذهنية لا مكانًا.
أما في الفكر الإسلامي الحديث، فقد استُعيد هذا الرمز في سياق نقد الانغلاق الأيديولوجي والتعصب الديني. فمحمد عابد الجابري مثلًا استخدم مصطلح "العقل البدوي" في تكوين العقل العربي (1984، ص 97–112) ليصف نمط التفكير الذي يعيد إنتاج منطق العصبية داخل الحركات الدينية والسياسية المعاصرة، معتبرًا أن هذا "البدوي" هو امتداد رمزي للأعراب القرآنيين في رفضهم للمؤسسة وللتعددية. وبذلك أصبح مفهوم الأعراب، في تطوره التاريخي، مرآةً سياسية للانقسام الداخلي: كل عودةٍ إلى العصبية، أو إلى منطق القوة على حساب القيم، تُقرأ كتجددٍ لـ"الأعرابية" داخل جسد الأمة.
الأعرابية السياسية في الإسلاموية المعاصرة
في ضوء التحليل السابق، يمكن القول إن الجماعات الإسلاموية المعاصرة — من الإخوان المسلمين إلى التيارات الجهادية كداعش والقاعدة — تمثل تجليًا حديثًا لما يمكن تسميته بـ «الأعرابية السياسية»؛ أي عودة الذهنية البدوية في ثوبٍ ديني. فهي، وإن حملت شعارات دينية، إلا أنها تستبطن في بنيتها العميقة منطق العصبية والولاء المغلق الذي يتعارض مع روح الأمة المفتوحة التي أرادها القرآن. إن رفضها لفكرة الدولة الوطنية الحديثة، ونزعتها إلى تكفير المخالف واحتكار الحقيقة، يعيدان إنتاج منطق “القبيلة العقائدية” الذي وصفه ابن خلدون بوصفه الطور الهمجي من دورة العمران (المقدمة، ج 1، ص 135).
بهذا المعنى، فإن الإسلاموية ليست استمرارًا للنبوة، بل ارتدادًا إلى البادية — إلى ما قبل الدولة وما قبل العقل المدني. فكما كان الأعراب حول المدينة يعيشون على هامشها دون الاندماج في نظامها القيمي، تعيش الحركات الإسلاموية اليوم على هامش الدولة الحديثة، تستفيد من مؤسساتها لكنها تنكر شرعيتها، تمامًا كما قال تعالى:
«قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» (الحجرات: 14).
هذه المفارقة القرآنية تظل قائمة: الانتماء الشكلي دون الإيمان العميق، والمشاركة المصلحية دون الاندماج الحضاري.
إن ما يميز "المدينة القرآنية" عن "البادية الأيديولوجية" هو أن الأولى تنتج نظامًا عامًا مبنيًا على القيم والعقل والتعايش، بينما الثانية تُعيد تدوير العصبية باسم الدين. وهكذا تتحول الإسلاموية الحديثة إلى النسخة السياسية من الأعرابية القديمة — حيث يُستبدل الولاء للدم بالولاء للتنظيم، والغزو بالسعي إلى السيطرة الرمزية على المجال العام. إنها أعرابية ما بعد حداثية، تُمارس الغزو عبر الخطاب والدعاية بدل السيف، لكنها تحتفظ بالبنية نفسها: رفض القانون، تمجيد الجماعة، وإقصاء الآخر.
خاتمة: من الأعراب إلى الأعرابية الأيديولوجية
لم يكن القرآن حين تحدث عن الأعراب يسجل ملاحظة أنثروبولوجية عن جماعة سكنت الصحراء، بل كان يرسم خريطة الوعي الإنساني بين الإيمان والعصبية، بين القانون والوهم، بين الوحي والغزو. فالأعراب، في عمق الخطاب القرآني، ليسوا أبناء البادية وحدها، بل أبناء الحالة التي ترفض التحول، وتخشى النظام، وتخاف من أن تُصبح جزءًا من المدينة التي تُنظمها القيم لا الغرائز.
لكن المفارقة أن التاريخ يعيد إنتاج هذه “الأعرابية” بأشكال جديدة. فما نراه اليوم من جماعات ترفع راية الدين لتقاتل به المجتمع، وتُقدّس الجماعة على حساب الأمة، وتُعيد تعريف العالم بمنطق “نحن وهم”، ليس إلا عودة متأخرة للأعرابي القديم في ثوب أيديولوجي حديث. لقد استبدلت الخيمة بالمقرّ الحزبي، والغزو بالغزو الإعلامي، والعصبية القبلية بعصبية التنظيم. إنها الأعرابية وقد لبست عباءة الدين والسياسة، تتحدث باسم الوحي وهي في جوهرها تمرّدٌ على روحه.
وهكذا يبقى الصراع بين المدينة والبادية — بين “المدنية القرآنية” و”الأعرابية الأيديولوجية” — صراعًا مفتوحًا في تاريخ الإسلام: صراعًا بين من يرى في الدين مشروعًا لبناء الإنسان، ومن يستخدمه ذريعةً للهيمنة على الإنسان. وإذا كانت المدينة النبوية قد انتصرت يومًا حين تحوّل الإيمان إلى نظامٍ عادلٍ يضبط القوة بالقيم، فإن معركة اليوم لا تزال تدور حول المعنى نفسه: هل نؤمن بالوحي بوصفه طريقًا للتحرر، أم نُعيد إنتاج الأعرابية كأداةٍ للسيطرة؟
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
مستشفى القصر العيني